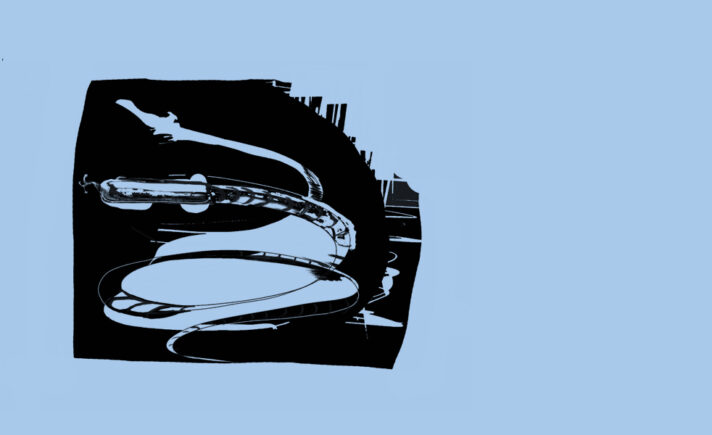سيقُولون ثلاثةٌ رابعُهم كلبُهم
ويقُولون خمسةٌ سادسُهم كلبُهم
ويقُولون سبعةٌ وثامنُهم كلبُهم
(الكهف 22)
سيقُولون واحدةٌ ثانِيها كلبُها. أنا كلبُها واسمي أدونيس. لم أَختَر هذا الاسم ولا أحبّه، لكنّني تعودّتُ عليه. كان عُمري أقلّ من شهرين عندما التقيتُها أوّل مرّة. لم أستطع النظر إلى وجهها ولا تمييز ملامحها إلاّ بعد فترة من الزمن. سمعتها تبكي عندما استمعتُ إلى مالكي وهو يقول بأنّ لا أحد يرغب في شرائي لأنّني أسود اللّون والبشر يتطيّرون من السواد. حملتني بين يديها وقبّلتني فوق رأسي ثمّ طلبت منّي توديع أمّي وأبي وإخوتي. لم أُرِد الذهاب معها. لم أُرِد أن أُحرَم بهذه السرعة من حليب أمّي الدافئ والحُلو. كان طعمه مثل العسل أو ربّما أفضل وكنت أتنافس وإخوتي على امتصاص تلك الحلمات الطريّة. أوّل ليلة قضيّتها في البيت الجديد كانت صعبة جدًا وقاسية جدًا. وضعَت أمامي صحنًا من حليب الأبقار البارد والمُعلّب. نظرتُ إليه باشمئزاز وقرّرت وقتها أن أخوض إضراب جوع وحشيّ علّها تُعيدني إلى عائلتي التي تُشبهني وأشبهها. كانت تُحدّق فيّ وكأنّني كائن فضائيّ وتتكلّم معي بنبرة مُشفقة. لم أحتمل نظراتها ولا حُزنها ولا صوتها. لم أكن مضطّرًا لذلك. أعتقد أنّني أكذب. كنتُ مضطرًا لذلك لأنّني كلب نجس وأسود لا أحد يرغب فيه. هي الوحيدة التي قرّرت اقتنائي من بين عشرات المُشترين الذين اعتقدوا بأنّني لطيف ولكنّني سأجلب لهم النحس واللّعنات بلوني الداكن هذا. لم أكن أسوى شيئ في سوق الكلاب. كنتُ الأقلّ جمالًا والأقلّ حظًا. لا أمتلك أنيابًا مُخيفة ولا أصلح للحراسة ولا للتبجّح. مُجرّد كلب صغير ينتمي إلى سلالة القُلطيّ (الكانيش) التي تُعدّ من أعرق السُلالات التي رافقت البشر منذ الأزل في عمليّات الصيد لأنّ حاسّة سمعنا خارقة ولأنّنّا أذكياء ويَسهُل تدريبنا على أيّ شيء. مع مرور الزمن صرنا كلاب القصور والفيلات الفخمة والشقّق الضيّقة، نُرافق أصحابنا أينما ذهبوا ولا نفعل شيئًا سوى الأكل والتغوّط واللّعب. ضاعت أمجاد سلالتنا وسط رغبة البشر المحمومة في تحويلنا إلى نُسَخٍ مُشوّهة عنهم.
في تلك اللّيلة المشؤومة لم أستطع النوم، كلّ شيء كان غريبًا عليّ. رائحتها مُنفّرة ولا تُشبه رائحة أمّي، كما أنّها لا تمتلك حلمات مزروعة وسط بطنها يُمكنني امتصاصها وقتما أشاء. كانت نائمة بعمقٍ غير مبالية بي. عرفتُ بعدها بأنّها تتناول أدوية للاكتئاب تُحوّلها إلى جثّة هامدة. لم أسامحها لأنّها انتزعتني مبكّرًا من عائلتي فقط كي تُحسّ هي بالأمان. قرّرتُ أن أتجوّل في البيت. كنتُ مُجهدًا وأتحرّك بصعوبة وغير قادر على تحديد المسافات. وصلتُ بعد رحلة دامت طويلًا إلى غرفة هيفاء صديقتها وشريكتها في السكن آنذاك. كانت نائمة هي الأخرى. لا أفهم لماذا ينام البشر باكرًا مثل الدّجاج. أردت أن أصعد إلى السرير لكنّه كان عاليًا جدًا. لم تُسعفني سيقاني الصغيرة في القفز. ظللت مرابضًا هناك أحدّق فيها إلى أن انتبهت لوجودي. حملتني بلطفٍ شديد ووضعتني إلى جانبها. أخبرتني بأنّها لم تكن نائمة وبأنّها خائفة من أن تدهسني لأنّني بحجم كرة الصوف وغير قادر على النباح كي أنبّه سكّان هذا البيت إلى وجودي. أحسستُ في تلك اللّحظة بالذّات بأنّه عليّ المحاولة للتعوّد على هذه الحياة الجديدة ولتحمّل تلك الجثّة الهامدة المُكتئبة في الغرفة الأخرى، وقرّرت أن ألغي فورًا إضراب الجوع الوحشيّ الذي بدأته منذ ساعات. نعم، نحن الكلاب نتراجع بسهولة وبسرعة عن قراراتنا الأكثر خطورة ومصيريّة، لكنّنا لسنا جبناء. نحن فقط نحسّ بالضغط ولا نحتمل لعنة الذنب التي تطوّق رِقابنا. يكفي أن يبكي أحدهم أمامنا أو يتكلّم معنا بلطفٍ كي نسامحه على جميع أخطائه، فنلعق وجهه كي نُطمئنه بأنّنا مازلنا طيّبين ومُخلصين ولا نفكّر في الهروب.
لا أحبّ حكاية الكلب والذئب في أساطير لافونتين (Fables de La Fontaine). أعتقد أنّها حكاية ظالمة وسخيفة وساهمت بشكلٍ كبير في تشويه سمعتنا وتعريضنا للسخرية. يلتقي ذئب نحيف جائع بِكلب قويّ البنية مُطوّق بحبل، فيهزأ منه الذئب قائلًا: «ربّما تأكل أحسن منّي ولكنّك لا تستطيع الركض أينما تُريد ووقتما تشاء. لن أقايض حرّيتي ببقايا الطعام»، ويفرّ الذئب بجلده تاركًا الكلب الوفيّ يحرس مزرعة صاحبه. لا أفهم صراحةً جدليّة الجوع والحريّة هذه وكلّ تلك الاستعارات الرومانسيّة التي تدور في فلكها، ولا أفهم لماذا يقوم البشر بهذه الإسقاطات الأخلاقيّة علينا. تختزل أساطير لافونتين ومن قبلها كتاب كليلة ودمنة للمقفّع كلّ الكليشيهات والتنميطات عن الحيوانات، فالذئب حكيم والثعلب ماكر والغراب جبان والكلب مُنبطح والحمار ساذج والأسد ملك والأفعى خبيثة والضفدع حسود والثور مغرور والجمل صبور إلخ. الوحيد الذي فهم طباعنا وعبّر عنها بالطريقة المناسبة هو الجاحظ عندما قال بأنّنا كُرماء. نحن الكلاب كرماء ولسنا مُنبطحين، وكَرَم روحنا هذا تحوّلَ في نظر البشر إلى خضوعٍ يجلب الاحتقار والاستهزاء عوضَ أن يكون خِصلة تُقدَّر وتُحترم.
يعتقد الكثيرون بأنّ عدوّنا الأزليّ هو القطّ وهذا غير صحيح. ربّما لا نتّفق في الكثير من الأمور مع القطط وربّما نكره بعضنا البعض لأسباب كثيرة يطول شرحها، لكنّنا لسنا أعداءَ بالفطرة. عدوّنا الأوّل والأخير هو الذئب الذي يظنّ بأنّه سيّد العالم. يُقال إنّنا نُشبهه كثيرًا وإنّنا في الأصل ذئاب هجرت البراري وقرّرت أن تستكين وتألف البشر. نحن لسنا ذئابًا أليفة، نحن كلاب ولا شيء آخر غير ذلك. سأكون أكثر جرأة وأقول بأنّ بعض سُلالات الكلاب يُمكن أن تتغلّب على الذئاب. صحيح أنّ عضلات فكّها أقوى منّا ولكنّنا أكثر شراسة، وشراستنا هذه تتمثّل في أنّنا نخوض قتالاتنا فُرادى على عكس الذئاب التي تتحرّك ضمن قطيع وتهجم على الخصم جماعةً. تقوم الذئاب التي تشعر بأنّ أحدهم يُهدّد أرضها بوضع خطّة للهجوم. توزّع الأدوار فيما بينها وهكذا تنتصر في المعارك. قطيع من الذئاب الجائعة ضدّ أيلٍ صغير ووحيد. قطيع من الذئاب الغاضبة ضدّ خروف. قطيع من الذئاب المُتحمّسة ضدّ نعامة أو بقرة أو حتّى ديك. ضع أمامي ذئبًا واحدًا رأسًا لرأس وسأقطّعه بأنيابي الحادّة المُتعطّشة للدّماء. أنا أبالغ قليلًا الآن ولا أتكلّم عن نفسي بالضرورة، لكنّني أتكلّم نيابةً عن معشر الكلاب الأجلاّء. حجمي الصغير وشكلي الأبله الشبيه بدبدوب أطفال لا يسمحان لي بقتل دعسوقة، فما بالك بمُبارزة ذئب مُفترس.
نسيتُ أمّي التي أنجبتني ونسيتُ حلماتها الطريّة. تعودّت بسرعة على حياتي الجديدة مع تلك التّي ظننتها جثّة هامدة ومُخدَّرة طيلة الوقت بسبب أدوية الاكتئاب. في الحقيقة لم تكن شخصًا كئيبًا بشكل مُفزع، كنّا نستمتع برفقة بعضنا البعض. أحببتُ عائلتها وجميع أصدقائها. كانت تقضّي وقتًا طويلًا في المطبخ. تطبخ لقبيلة مع أنّها تعيش بمفردها، وكلّما أحسّت بالوحدة تُعِدّ لنا كعكة شهيّة. صحيح أنّها تُعطيني مجرّد قضمة أو قضمتين منها بتعلّة أنّني كلب وأنّ السكريّات مُضرّة لي، لكنّني كنت أرضى بالقليل. ألِفتُ رائحة الكعك في البيت. يُمكنني أن أقول الآن بأنّه بيتنا. كبرتُ فيه وأكلت أكلًا طيّبًا. تبوّلتُ في جميع أركانه. تعافيتُ فيه ونمتُ تحت سقفه جنبًا إلى جنب معها. قلتُ بأنّ رائحتها كانت مُنفّرة في أوّل لقاء بيننا، هذا لأنّني وقتها لم أكن متعوّدًا على رائحة البشر. هل سبق وأن شمّ أحدكم سُرّته؟ لا أعتقد. روائحُكم تنبعث من هناك نحو أنفي الأفطس بقوّة، وكأنّني أمام جبل من الخميرة. أريد أن أصف رائحتها ولكنّني لن أفلح في ذلك، ما يُمكنني قوله أنّها مزيج من الصندل والليمون والسمك المُجفَّف ويُمكنني تمييزها من بين كلّ روائح النّاس الذّين التقيتهم في حياتي.
لا نفترق أبدًا إلاّ عندما تخرج لمقابلة أصدقائها أو للعمل. أعلم الآن بأنّها كانت تخرج وتتركني وحيدًا فقط لقضاء حاجياتها، لكنّني وقتها كنت أعتقد بأنّها هجرتني. أصبر لبضع ساعات ثمّ تنتابني نوبة من الهلع لا تُفارقني إلاّ عندما تُدير المفتاح في القفل وتفتح الباب فأركض نحوها وأقفز مثل المعتوه وأنبح بصوت عالٍ. هكذا كنتُ أُعبِّر عن غضبي وليس عن سعادتي بلقائها. دائمًا ما تجثو أمامي على ركبتيها قائلة: «سامحني أدونيس، سامحني خلّيتك وحدك». يا إلهي، لا أستطيع احتمال مشاعرها الفيّاضة كطوفان. أبدأ بلعق وجهها كي تفهم بأنّني غفرتُ ذنبها. كانت بكّاءة وتُقبّلني بنهمٍ دائمًا وتُشمشم رأسي مثل كلب.
أحببتُها لأنّها أفلحَت للحظات في تقمّص دور الكلب، وأحبّتني لأنّني أفلَحتُ طيلة خمس سنوات ونصف في تقمّص دور ابنها.
*****
سيقُولون واحدةٌ ثانِيها كلبُها. أنا تلك الواحدةُ واسمي ريم. عندما كنتُ في السابعة من عمري أهدانا قريبُ أمّي كلبةً سميّتُها لايكا. كان يقول مُتفاخرًا بأنّها من سلالة الرّاعي الألمانيّ، لكنّها في الحقيقة كلبة سلوقيّة. صَدّقته لأنّني لست خبيرة في الكلاب ولا تعنيني مسائل العائلات والأعراق والسُلالات. كانت الكلاب جميعها واحدة في نظري ولا أُفرِّقُ بينها سوى بالحجم، فأقول هذا كلب صغير وهذا كلب كبير. ما كان يهمّني حقًّا هو اسم كلبتي الذّي حرصتُ أن يكون غريبًا وصعبًا وذا خلفيّة لا يقدر الأطفال في سنّي على كشفها وتقديرها. كنتُ الوحيدة في الحيّ وربّما في القرية كلّها من تعرف بأنّ أوّل كلبة سافرت إلى الفضاء تُدعى لايكا. لم يكن ممكنًا أن أحتفظ بهذه المعلومة النادرة لنفسي، خاصّة بعد قدوم كلبتنا الجديدة التي سميّتها لايكا وصرت أتبجّح أمام الجميع باسمها. أجمع أطفال حيّي والأحياء المُجاورة في حلقةٍ وأقف في الوسط كمُعلّمة قديرة. أسألهم بصوت مُنخفض وكأنّني بصدد إفشاء سرّ خطير: «هل تعرفون لماذا سميّتُها لايكا؟»، فيُومؤون برؤوسهم الصغيرة «لا»، ثمّ تشرئبّ أعناقهم لمعرفة السرّ. أَسردُ عليهم القصّة وندخل بعدها في نقاشات لا أوّل لها ولا آخر عن الكلبة لايكا وكيف قادت الطائرة نحو الفضاء بمفردها؟ وهل تستطيع الحيوانات قيادة الطائرات؟ وهل بقيت تعيش في الفضاء أم عادت إلى الأرض؟
كبرتُ قليلًا وعرفتُ بأنّ أسماء جميع كلاب العالم إمّا لايكا أو راكس، فقرّرتُ أن أسمّي كلبنا الثاني الذي أهداه لنا جارنا المُغترب في فرنسا؛ صليح. كان هذا الاسم موضع خلاف جوهريّ بيني وبين أبي الذي رفضَ رفضًا قاطعًا أن نسمّي الكلاب بأسماءٍ عربيّة. في أواخر التسعينات نُشر خبر إهدار دم الفنّانة اللبنانيّة نجوى كرم على الصفحات الأولى في الجرائد مثل النار في الهشيم لأنّها سمّت كلبها حمّودي، في إشارةٍ إلى الرّسول محمّد. تناقلنا الخبر في القرية ولم تنقسم الآراء بين مؤيّد ومُعارض، فالجميع اعتبر نجوى كرم مُرتدّة عن الإسلام بالرّغم من أنّها مسيحيّة. بصراحةٍ، لم أكن قادرة على استيعاب النعرات والحروب الدينيّة. أحببتُ فقط فكرة أن نُسمّي كلابنا الأحبّاء بأسماء نعرفها وتُشبهنا. ولأنّ غضب أبي غير محمود العواقب، فضّلت أن أنادي كلبنا بـ راكس في حضوره وصليح عندما أكون بمفردي. أصيب صليح بمرض في الجلدة أقعده، فأحضر أبي رجال الشرطة كي يقتلوه في بيتنا بالرّصاص. كان عُمري تسع سنوات ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم وأنا أكره رجال الشرطة. في سنّ الثانية عشرة وتحديدًا سنة 2003 أحضر أبي كلبًا جديدًا. تزامن ذلك مع بداية الغزو على العراق. طبعًا سمّاه راكس ولكنّني اخترت اسم بوش كتعبيرٍ عن بداية تشكّل وعيي السياسيّ. كنتُ أكره ذلك الكلب المسكين وأتفنّن في تعذيبه. لم أكن أضربه، وإنّما كنتُ أشتمه وأحقد عليه وكأنّه مُجرم حرب.
كتبتُ أوّل نصّ «سياسيّ» في حياتي بعد أشهر من الغزو الأميركيّ تحت عنوان «سقوط العراق». مازلتُ أحتفظ به إلى اليوم في دفتري السريّ:
«وبعد كلّ هذا الصمود الشنيع، وبعد كلّ هذه الآمال التي غمرت نفوسنا وجعلت آفاق الانتصار مفتوحة، وبعد أن فتحت لنا أبواب العزّة والكبرياء على مصراعيها، وبعد كلّ هذا النضال العراقيّ القصير جدّا والذي أعاد الاعتبار للعرب، وبعد كلّ المعارك الضارية التي عاشتها المدن العراقية من نينوى إلى الكوفة والتي خلّفت وراءها دمارا وخرابا غمر المواطنين فكثر عدد الضحايا الأبرياء الذين سُفكت دمائهم من دون اقتراف أيّة خطيئة، وبعد أن واجه القائد صدّام حسين كلّ التهديدات الأمريكيّة الدنيئة، وبعد إقسامه أنه لن يرمي السلاح إلا بعد النصر، يأتي يوم لم يكن في حساباتنا أبدا، يوم لم نفكّر فيه حتّى. اليوم الذي خرج فيه كلّ مواطن عراقي وقح لهدف تحطيم وتمزيق تماثيل ومعلّقات وصور تخصّ قائدهم الشهم، نعم أقول أنه شهم وأؤكّد أيضا أنّه شجاع لأنّه لا يوجد أي حاكم عربي قام بما قام به هو فكلّهم جبناء سفهاء عاشوا ويعيشوا وسيعيشوا تحت أقدام أمريكا، ملطّخين بقذارة الذلّ (…) هل يرضى أحد لهذه المدينة العربية المنتمية إلينا أن تُدمّر وتضمحلّ صورتها العظيمة؟ طبعا نرضى وفرحين كذلك لأننا جبناء والجبن مصطلح جديد غزانا وغزا أفكارنا وسلوكاتنا منذ أن تخلّينا على عزّة النفس والكرامة ورميناها في ساحة الخردة. وكل هذه الحماقات التي تقال يوميا في نشرات الأخبار عن تضامن الشعوب العربية على اختلافها وكثرتها مع الشعب العراقي فهي إن دلت على شيء فهي تدلّ على الترحيب بأمريكا وأمثالها من الدول الرأسمالية في بيوتنا. بئس عربي لا يفعل ما يقول وبئس حاكم لا يعي ما يفعل».
فلنتّفق أوّلًا أنّ هذا الكلام كُتب وأنا في سنّ الثانية عشرة فقط، ولنتّفق أنّني حشوته بعبارات مُنمّقة حفظتها كما هي من الأخبار وكُتب المنفلوطي وجرجي زيدان وجبران ومصطلحات لا أعرف معناها بشكلٍ دقيق مثل «الرأسماليّة». أوّل مرّة سمعت فيها كلمة رأسماليّة من عند جارنا صالح الذي يكبرني بكثير. كان صالح طالبًا بالجامعة وينشط ضمن اتّحاد الطلبة. وكان يُحبّ ذكائي وفضولي ويحشو رأسي دائمًا بأحاديث عن السياسة والقوميّة العربيّة. تأثّرتُ بكلامه وحَفِظته عن ظهر قلب مثل أيّ تلميذة مُهذّبة ونجيبة. كان هذا النصّ بمثابة فرمان طرد كلبنا بوش أو راكس من البيت. قرأته على أبي فأحسّ بالفخر والعزّة بابنته الصغيرة. استغلّيتُ نشوته وأخبرته عن كرهي لكلبنا فأصدر قرار ترحيله.
بعد سنوات طويلة غادرتُ القرية كي ألتحق بكليّة الصحافة في العاصمة. انقطعت صلتي بالكلاب إلى أن قرّرت في سنّ السادسة والعشرين أن أشتري كلبا يُؤنسني سميّته أدونيس. لم أفكّر كثيرًا في هذا الاسم ولا علاقة له بأدونيس الشاعر. ارتجلتُهُ بشكل عفويّ من وحي لحظة اللّقاء الأوّل. خُيِّلَ لي أنني سمعته وهو يقدّم لي نفسه: «أنا أدونيس».
وُلد أدونيس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وتُوفيّ في 5 ماي (أيّار) 2022، أي منذ ثلاثة أشهر فقط. ما زال الجُرح غائرًا ولم تُساعدني خبرتي مع الموت على التقبّل والتجاوز. أجد فكرة الحِداد قاسية أكثر من الموت نفسه لأنّها غارقة في الشكلانيّات والإجراءات. نحزن ثمّ نغضب ثمّ نتقبّل ثمّ ننسى، هذه هي أصول الحِداد كما أملاها علينا التحليل النفسيّ وكما تعلّمناها اجتماعيًّا وثقافيًّا. هناك أصلًا من قام بتثوير فكرة الحِداد وأخذها إلى الطرف النقيض وصار يتكلّم عن الحِداد السعيد وإجراءاته الجديدة، كأن نستغلّ الموت لإعادة بناء ذواتنا ونتعلّم أشياء عن أنفسنا لم نتعلّمها من قبل ونتواصل روحيًّا مع الموتى ونختبر معهم تجارب ممتعة جديدة. حاولت في لحظة ضعفٍ وهشاشة أن أطبّق تعليمات مُنظّري الحِداد السعيد. زرتُ مُختصّة في التنويم المغناطيسيّ علّني ألتقي من جديد بأدونيس في فضاء أرحب وأكثر شساعة وامتدادًا. جلست فوق الكرسيّ أمامها وتحدّثنا في كلّ شيء إلاّ عن سبب قدومي إلى مكتبها. سألتني عن طفولتي ودخلنا في متاهات لا قرار لها. طلبت منّي أن أنظر إلى لوحة مُعلّقة أمامي وأركّز على تفصيل واحد. صفّقت بعدها بيديها وطلبت منّي أن أنام. أغمضت عينيّ مُجاراةً لها وأملًا في لقاء أدونيس ولكنّني لم أرَ شيئًا سوى الظلام.
– أنتِ لستِ ريم، أنتِ الآن أليس في بلاد العجائب، في غابة كبيرة وجميلة…
حاولتُ جاهدة أن أتخيّل نفسي أليس في بلاد العجائب والغرائب. حاولتُ تَخيُّلَ تلك الأرانب الضاحكة وهي تقفز في الغابة والأشجار الملوّنة والفطر الضخم مُنتشرٌ في المروج. أصابني الملل وكدتُ أن أشتمها. عن أي أليس تتحدّث ونحن قضيّنا العقد الأخير من حياتنا نُشاهد صليل الصوارم ومجازر داعش وضحايا القصف الإسرائيلي على غزّة والبراميل المتفجّرة التي أسقطها الأسد على رؤوس السوريّين وانفجار مرفأ بيروت والحرب على اليمن وميلّيشيّات ليبيا والاغتيالات السياسيّة في تونس؟ عن أيّ أليس تتحدّث هذه البرجاوزيّة بفرنسيّتها ولكنتها الباريسيّة المُصطنعة؟ لم أقرأ قصّة أليس في بلاد العجائب عندما كنتُ طفلة ولم يقرأها أطفال قريتي. كنّا نلعب في المقابر ونسرق المشمش من عند الجيران ونلعبُ بالعصيّ والكجّة والزربوط (الخذروف). لا نعرف البحر ولا الملاهي ولا المسارح ولا المكتبات وأقصى طموحاتنا أن نجمع القليل من المال أو نسرقه كي نشتري البسكويت وأرخص أنواع البوظة.
لا أفهم حقًّا لماذا يُصرّ أحفاد وحفيدات فرويد على العودة دائمًا إلى الطفولة بحثًا عن أجوبة لأسئلتنا الرّاهنة. من قال بأنّ الحلّ يكمن في النبش في أعماق ذاكرتي والعودة إلى سنّ الطفولة؟ كان يُمكن أن نتحدّث عن لحظة 2011 وعن عقدٍ من الأحلام والخيبات والانتصارات والإخفاقات أدمت قلوبنا. سنوات الثورة أحرقت جلدي وغيّرتني كثيرًا، وريم المرأة الثلاثينيّة ليست نفسها ريم الطفلة. ما أعيشه من كآبة وكَدَر وهَمّ هو نتاج واقعنا السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ. كان يُمكن أن يكون حِدادي «سعيدًا» لو أنّني كنتُ قادرة أن أدفن كلبي الصغير بكرامة في وضح النهار. كان يُمكن أن يكون حِدادي «سعيدًا» لو لم أكن مُضطرّة لكتم مشاعري والاستمرار في العمل لأنّ لا أحد سيفهم معنى أن نفقد كائنًا غير بشريّ. كان يُمكن أن يكون حِدادي «سعيدًا» لو لم أتعرّض أنا وكلبي إلى كلّ ذلك الأذى من الجيران والأغراب في الشارع. كان يُمكن أن يكون حِدادي «سعيدًا» لو كنتُ أمتلك شرعيّة الأمومة وشرعيّة الحُزن وشرعيّة العزلة وشرعيّة الكلام. لا يُسمَح لنا في تونس بدفن رفاقنا الحيوانات، لذا نُضطرّ إلى رميهم في الزبالة أو دفنهم خلسة بعيدًا عن أعين البوليس الذي يقتل الكلاب السائبة بدمٍ بارد.
الحيوانات لا تموت بل تنفُق. لا تمتلك شرعيّة الموت ولا حياة لها بعده. لا أعرف إلى أين ذهب أدونيس، وعندما فكّرت جديًّا في الالتحاق به، عُدت إلى ابتلاع أدوية الاكتئاب وصرتُ جثّة هامدة غير قادرة على تحريك إصبعي فما بالك بالقفز من الشرفة. لم أكن في وضعٍ يسمح لي بالعقلنة والتبصّر. بحثتُ عن أجوبة ميتافيزيقيّة لأسئلتي الحارقة لكنّها لم تُشفِ غليلي. تُحشَر الحيوانات أو «الوحوش» كما جاء في القرآن مثل البشر، ولأنّ الله عادل وحكيم فإنّه يسمح لكلّ الحيوانات «المظلومة» بأن تقتصّ من الحيوانات «الظالمة» مثلها وليس من البشر الظالمين. يعني لو أنّ كلبًا عضّ ذيل قطّة في الحياة الدُنيا فإنّها تنتقم منه في الآخرة وتردّ له العضّة وهكذا دواليك، ثمّ تصير جميع الحيوانات ترابًا ولا تدخل إلى الجنّة. الحيوانات التي تدخل إلى الجنّة بشكل عام هي حيوانات الأنبياء. يعني أنّ حوت يونس وهدهد سليمان وذئب يعقوب ونملة سليمان وناقة صالح وحمار العُزير أفضل منك يا أدونيس الكلب.
على الأقلّ هناك حمار آخر سيدخل إلى الجنّة غير حمار قيس سعيّد الذّي صدَّعَ رؤوسنا بقوله: «خوفي على الدستور القادم أن تأكله أتان جديدة أو حمار من سلالة الحمار الأوّل». حِمار قيس سعيّد الشهير هو اقتباس من مسرحيّة غُربة السوريّة التي تناولت الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة خلال السبعينات. انتظرنا هذا الحمار الموعود ولكنّه لم يأتِ، فأكل الرّئيس البطل دستور 2014 بنفسه وتقيّأ دستورًا جديدًا لا يُعبّر عن روح الثورة ومطالب المُفقّرين. يَحضُر المُعجم الحيوانيّ بقوّة في خطابات الرّئيس، فتارة يتكلّم عن الضباع والسباع الضارية التي حوّلت مؤسّسات الدولة إلى غنيمة، وتارة أخرى يُشبّه الفاسدين بالتماسيح والقروش. أحيانًا يستعير من أحمد شوقي قوله: «متى كان للثعلب دِينٌ» في إشارةٍ إلى مُحتكري السلع. الحيوانات هي مُجرّد استعارة تُزيّن خطابًا مشحونًا بالوعيد والتهديد. حتّى في ديباجة الدستور الجديد، حاول أن يُضفي البُعد البيئيّ إلى جُمله المتراصّة والرّكيكة لكنّه اختزله في مشكل التلوّث.
رافقني أدونيس في صولاتي وجولاتي وكان شاهدًا على سنوات مهمّة من تاريخي الشخصيّ ومن تاريخ البلاد. لن أنسى أبدًا ذلك اليوم الذي تعرّضتُ فيه إلى التحرّش في الميترو. عُدت إلى البيت مُنهارة وأقفلت على نفسي باب الغرفة. ظلّ ينتظرني أمام الباب مُراعيًا رغبتي في الانزواء، وعندما خرجت من الغرفة قفز نحوي يَلحسُ دموعي بلسانه. كان اليد التي تُربّت على أكتافي وتُطمئنُني. كان القلب الكبير الذي يحتويني ولا يصدّني. لن أنسى أيضًا ليلة 17 جانفي (كانون الثاني) 2021 عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين المُحتجّين ورجال الشرطة في الأحياء الشعبيّة في مختلف مناطق البلاد. لم أكن قادرة على الانخراط في تلك الاحتجاجات الليليّة التي أعادت رسم الفضاء العامّ، لكنّ شقّتي تقع مُباشرة أمام أحد مراكز الشُرطة التي كانت مسرحًا لتلك المواجهات. خرجتُ إلى الشرفة كي أصوّر عمليّات الكرّ والفرّ بهاتفي الجوّال صُحبة أدونيس. انتبه إليّ بوليس فنهرني وطلب منّي الدخول إلى البيت، لكنّ أدونيس الصغير كان له بالمرصاد. نبح عليه وكأنّه كلب شوارع مُتمرّس ومُدرّب على مُعاداة الشُرطة. أعتقد بأن أدونيس رأى في الشرطي ذئبًا ضمن قطيعٍ واسع من الذئاب. أكاد أجزم بذلك.
تشاركنا كلّ شيء؛ الطعام والسرير والكعك والدموع. كان أدونيس رفيق دربي وطفلي الذي لم ألده. أمومتي حقيقيّة وفيّاضة، خيار حرّ لم يفرضه أحدٌ عليّ، تتحرّك داخل مربّع ضيّق، هشّة وغير مُعترف بها. أمومة مُثيرة إمّا للشفقة أو للسخريّة ولم يُقدّرها غير أصدقائي وعائلتي الذّين حرصوا أن أدفن طفلي بشكل لائق وكريم. عندما مات أدونيس أحسستُ بأنّ العالم انهار وعُدتُ مثلما كنتُ قبل أن ألقاه؛ وحيدة وخائفة. ألعابه منتشرة في كلّ مكان، رائحته، طيفه، حركاته، البطّة البلاستيكيّة الصفراء التي يلعب بها عندما أحمّمه، قارورة الشامبو، أدويته المُضادّة للبراغيث والقراد وكلّ أشيائه. البيتُ بارد ومُوحش من دونه والحفرة التي حفرها الموت داخل روحي تتسّع مع كلّ يوم يمرّ دون أن أشمشمه وأقبّله وأتكلّم معه.
لم تكن علاقتي بأدونيس علاقة حيوانيّة. حاولتُ أن أكون كلبة ولم أفلح. حاولتُ أن أحترم مساحته وحيوانيّته ولم أفلح. لم أستطع أن أكون «الحيوان الذي أنا عليه»، (L’animal que je suis) مثلما عبّرَ عن ذلك جاك دريدا. كلّ ما استطعت القيام به هو ألاّ أربّيه وألاّ أدربّه على أيّ شيء وألاّ أحوّله إلى دمية أتسلّى بها. فقط علّمته ألاّ يتبوّل وسط المنزل، وكانت تلك حربًا ضروسًا بيننا انتصرتُ فيها عليه، لكنّه دائمًا ما يتبوّل على الأرضيّة عندما يغضب ليُذكّرني بأنّه حيوان. كنتُ أغضب في البداية لكنّني تعودّت على أساليبه الاحتجاجيّة مع مرور الوقت. ابتدع ديكارت الكوجيتو واستندَ إلى العقل لتبرير وجود وفاعليّة البشر، وعليه فإنّ الحيوانات كائنات غير موجودة بالمعنى الفلسفيّ في هذا العالم. الحيوانات كائنات بلا عالم لأنّها لا تفكّر، يُمكن أن تنفعل أو تردّ الفعل لكنّها غير قادرة على الإجابة. حاول هايدغير أن يعدّل قليلًا هذه الفكرة فاعتبر أنّ الصخور بلا عالم لأنّها غير حيّة، وأنّ الحيوانات فقيرة في هذا العالم والإنسان هو الوحيد الذي يمتلك مفاتيح العالم. فقرُ الحيوانات يأتي أساسًا من الحرمان، فهي محرومة من صناعة عالمها وامتلاكه بسبب تَدخُّل البشر. يأتي بعدها جيل دولوز ليقول بأنّ امتياز العقل عند الإنسان يسقط أمام القدرة الإعجازيّة لدى الحيوانات في التنسيق والتوليف وخاصّة في الهروب. الحيوانات تهرب من أقاليمها وأراضيها وعوالمها لبناء عوالم أخرى، لا تخشى الموت ولا تخشى التجديد ولا تخشى المفاجآت.
لم يكن لأدونيس أيّ عالم، كنتُ عالمه الوحيد أو هذا ما أردتُه.
أحببته لأنّني كنتُ أعتقد بأنّه الحيوان الوحيد على وجه الأرض الذي يرفض أن يكون حيوانًا، وأحبّني لأنّني صيرورة ممكنة في «عالمٍ حُرم منه» حاولَ تسييجه بالبول حفاظًا على ما تبقّى منه.