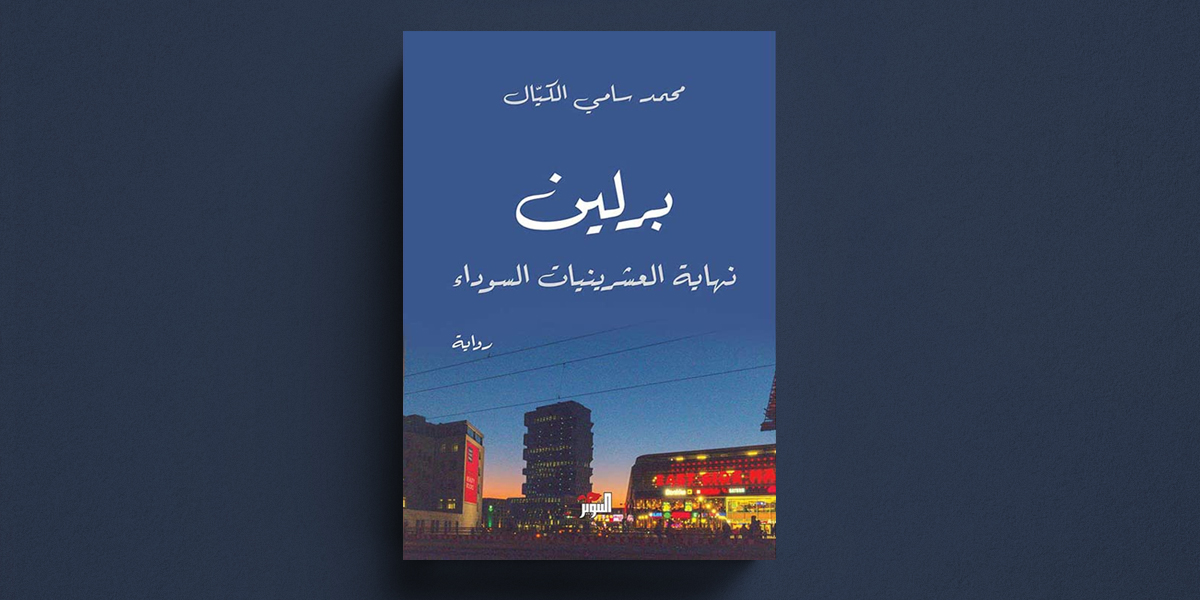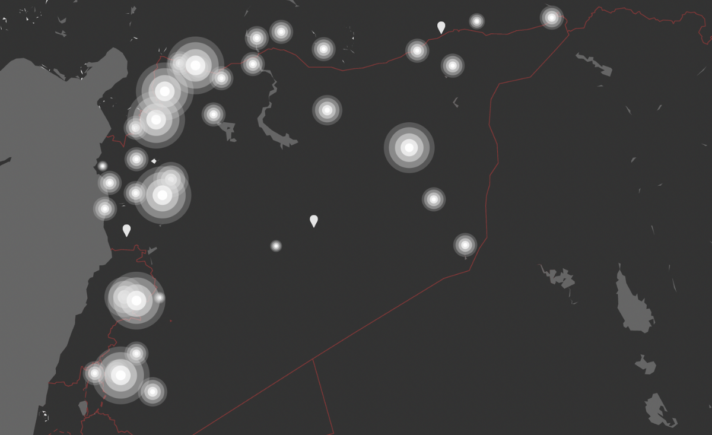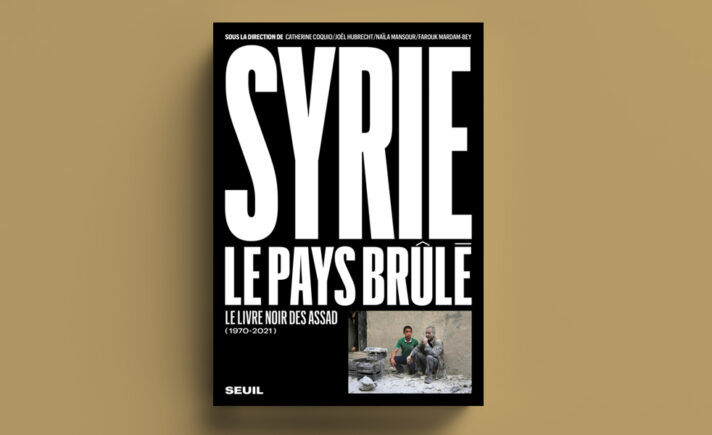برلين… نهاية العشرينيات السوداء عنوان رواية محمد سامي الكيال الأولى، الصادرة هذا العام عن دار التنوير، وقبل الحديث عن الرواية نشير إلى عتباتها، إذ يحمل العنوان إحالة إلى السنوات العشرين الأولى من القرن العشرين في برلين، أو ما يسمى بالسنوات الذهبية/ المجنونة، والتي يعيد الكيال تخيّلها بعد مئة عام، أي عشرينيات الألفية الثالثة التي تدور فيها أحداث اغتيالات وحروب عصابات وأنشطة أحزاب مشبوهة. تتضح معالم هذه الأحداث ما إن نفتح الكتاب، إذ نشاهد خريطة جديدة لمدينة برلين، تتحول فيها منطقة نويكولن – المعروفة بانتشار المهاجرين فيها – إلى ما يسمى «شام»، يتوسطها «قصر الشعب» مقر «مامو» أو «أبو عمار» أو «محمود الأسود» زعيم المنطقة، يلي ذلك تجهيزات لـ«يوم المسيرة»، الذي يحتفل فيه الزعيم بسيادته وسطوته، لكن أبو عمار لم يغادر مكتبه يومها، ويقول الشهود أنه «كان يرقص، يُداعب قضيبه، يغني كالمعتوه…يضحك ببلاهة، ويهز ردفيه وعلى الأرض فضلات بشرية» للمفارقة، لم يتزحلق بسببها ويقع متمرغاً بها، بل بقي واقفاً بصورة كوميدية.
نكتشف لاحقاً أن مصائب «يوم المسيرة» لم تنته عند جنون القائد، إذ وقعت شبه مجزرة، واشتعل الاقتتال بين رجال الزعيم، و«الجولياردين الجدد» ورجالات الشيخ إسماعيل. حقيقة لا نعلم بدقة ما حصل يومها، خصوصاً أن المشاكل تتوالى وتتعاظم لاحقاً، ليتحول الحي إلى ساحة قتال ومن ثم مساحة للتظاهر، ثم (hub) ثقافي، لكن طيف الحقيقة بعيد، فالصحف الألمانية والحكايات الشعبيّة والشهود قدموا روايات متناقضة ومختلفة، كلّ بحسب هواه، الراوي فقط هو الذي يعلم ما حصل.
تقدم الرواية مُتخيلاً عن برلين بعد «انتصار» المهاجرين، أو نهايات هذا الانتصار، حين استفاد المهاجرون من عددهم وعلاقاتهم لتنظيم أنفسهم ضمن حزب مشبوه، استولى على جزء من المدينة أصبح يحمل اسم شام. هذا الاستيلاء ليس سياسياً فقط، بل هو براغماتي أيضاً، يقف بوجه استراتيجيات السلطة الاتحاديّة نفسها، إذ تغلغل المهاجرون ضمن التشكيلة السياسية القائمة، وقاوموا السياسات الاقتصادية التي تحاول طردهم، أو بصورة أدق «استبعادهم» من المدينة عبر زيادة أسعار المنازل، كما استفادوا من التنويعات التقاطعية المعاصرة لأهداف سياسية عبر تحريك الجموع «لاجئين، كويريين، ليبراليين وما إلى ذلك» ضد المتعصبين والشرطة لخدمة أهدافهم. أي يمكن القول، إن كانت الحكومة الاتحاديّة في ألمانية تتغنى بمفاهيم الاندماج، ففي شام هناك نفي كليّ لها، والاستفادة من التقنيات السياسية كالاحتجاج واحتلال المنازل وقطع الطرق والتشكيل الحزبي، والتقنيات اللاقانونية كتنظيم العصابات ومحاصرة الأحياء، للوقوف بوجه القيم التي تريد السلطة أن يتأطر بها الأفراد، لتبدو برلين أشبه بخشبة للصراع، مساحة يمكن ضمنها للفئات المختلفة تنظيم نفسها، ضمن أحزاب وعصابات في ذات الوقت.
هل من داع للاستطراد في الحديث عن الرواية وأحداثها؟، نظرياً نعم!، من المُفترض وصف ما يحصل من أحداث، وتشريح المُتخيل الذي يقدمه الكيال عن المدينة التي تحول جزء منها إلى غيتو – وهذه كلمة لا تفي شام حقها – ولكن، وهذا أول ما يلفت الانتباه أثناء القراءة، الراوي يفرط في استعمال عبارات: «لا داعي للاسترسال، لا داع لذكر التفاصيل، ليس من الواجب الاستطراد أكثر». هوية الراوي المجهولة تحرك داخلنا الفضول، من هو هذا السارد الذي يمتلك معارف غير متناهية، ويحكم على الشخصيات، ويعرف دواخلها، ويكشف غموض الأحداث العامة، يقرأ ما وراء العناوين الصحفية، ويحلج سرائر النفوس حد أدق التفضيلات الجنسية، «يتحدث» وكأنه ينزع قشرة البلاغة السياسة والتسامح والصوابية السياسية ليخبرنا بـ«الحق» فلا لزوم لما يلزم ولا ما يلزم، ولا بهرجات، هناك أكاذيب وحذلقات لابد من الإشارة إليها، ثم تجاوزها كي نعرف ما حصل.
الصيغة السابقة للراوي الذي يعرف كلّ شيء تشابه تقنية الحكواتي، بوصفه سارداً كُلي الحضور، يسخر منا نحن القرّاء الأقل علماً، إذ يبذر معالم «أثر الواقع» ثم يبطلها لأن الجميع يكذب ويتقنّع، وهنا يمكن أن نطرح سؤال هوية الراوي مرة أخرى، هل هو مشارك في أحداث العشرينيات السوداء؟ مراقب هامشي كصاحب الدكان الهندي في الرواية مؤلف الحكايات والأساطير؟ أم هو «الشاهد الخائن» إن صح التعبير؟ تتبع الراوي لأشخاص شديدي التنوع والاختلاف لرصد حكاياتهم وتواريخهم، والقفز بين الماضي والحاضر هدفه أن نعرف ما هو «مهم» عن كل شخصية في هذه المدينة، لا بما يخدم السرد نفسه، بل بما يخدم الملفت في الرواية هو حكاية قصر الشعب، ولا نقصد تحوله من مقر زعيم شعبي ورئيس حزب مشبوه إلى مركز ثقافي مفتوح أمام الجميع، بل مفهوم القصر نفسه، فإن كان القصر الكافكاوي – أو قصر الجبلاوي في قراءة أشد تأويلاً – منيعاً حصيناً لا يمكن الدخول إليه، يُترَك خارجه أولئك المنفيون من قبل السيادة، العالقون على الأبواب خارج القانون. فإن القصر لدى الكيال، يُفتح على مصراعيه، تنهار سطوته بجنون قائده، ويمر بتحولاتٍ يعجب لها أهل الحي أنفسهم. أي إن كان القصر في حي شام، مساحة عصية على الشرطة وقوات مكافحة الشغب في فترة ما، أشبه باستثناء داخل مساحة سيادة القانون، فلابد لهذه الوضعية أن تنهار، وكأي حالة استثناء – نتحذلق هنا حول نظريات منشأ السيادة – لابد من استثناء آخر لقلب المعادلة وإعادة توزيع القوى، ويتمثل ذلك في الرواية بجنون صاحب القصر، أي سيده أبو عمار واختفائه الذي يؤدي إلى تغير «كل شيء»، لكن لا، لنتمهل، هذه برلين، لا ثبات فيها، هي تُغير وجهها دائماً، لا زعيم لها، ولا دوام لحال.«الحقيقة»، وكأن الراوي يحاول الإجابة عن سؤالي: «ما المهم الآن ؟» «وما الذي يجب أن نعرفه في هذه اللحظة؟»، أو بصورة أخرى، «ما هي الحقيقة وراء كل هذه الأقنعة ؟».
كل من في الرواية «أشرار»: زعران، سرسرية، انتهازيين، سفلة، باحثون عن الشهرة، لاهثون وراء السلطة، جوليادريون جدد، عنصريون، أشباح، شعراء حالمون، كتّاب متلصصون. إلا أنهم لم يطردوا من المدينة التي «احتوتهم» بصورة أو بأخرى إلى حد موتهم المجازي والحقيقي. إذ لم تكن حصناً منيعاً. حتى حي شام، وعلى الرغم من كل مخاطره، وتسهيل رحيل البعض منه، لم يطرُد سكانه، إلى حد أن الكلّ حاول فرض سيطرته عليه. لكن الملفت أن جيلاً واحداً فقط هو من يُسيطر، ثم ما يلبث أن يتلاشى، وكأنه لا توجد أرض ثابتة، خصوصاً تحت أقدام المهاجرين، فلا تملّك، ولا ميراث، تنتقل الأخلاق جيلاً واحداً ثم تختفي، ليعود سكان المدينة للمراقبة بفضول متخفف من الماضي، يقرضون حكايات عجائز وإشاعات لا نعلم مدى حقيقتها.
لا يتردد سامي الكيال في إطلاق الأحكام والصفات على شخصياته، فدور الحكواتي يحرر السارد من الالتزام بمنطق شخوصه، هو «يصنف» بالشكل الذي يراه مناسباً، لتظهر سخرية كيال كتعليق على سياق ثقافي عربي/مهاجر- ألماني يسعى بصورته الرسمية للتصنيف وخلق الفئات، لكن كيال يكسر هذه النماذج، إذ يحضر مثلاً اللاجئ السوري دون أن يكون مأساوياً أو نوستالجياً، أو غارقاً في دوامة استخراج إذن العمل، بل زعيم عصابة يتحدث الألمانية وقادراً على فرض سيطرته، ليبدو كيال هنا كمن يهزأ من الاندماج ومراكز دراسات الشرق أوسطيّة، ويتهكم على عمليات احتواء الناشطين والناشطات، وعلى القضايا الكبرى والثقافات الهامشية والمهيمنة ومحاولات المصالحة بينهما، تلك الأفكار التي تحولت إلى منظمات مجتمع مدني أثبتت فشلها مراراً وتحولت إلى مصدر للرزق. لكن، وهنا ما يثير الاهتمام، ينتصر كيال للمدينة، تلك التي تحتوي الجميع «ربما»، تستعرض صراعاتهم، وتهملهم حد التلاشي، فاتحة الباب أمام «لاعبين» جدد.
هناك سؤال لابد من طرحه على لسان «ناقد» ألماني متخيّل، ومحنّك، وهو: « من هذا هير موهميد كيال ليكتب عن برلين المستقبل التي تحول جزء منها إلى شام؟» نحتار إن أردنا الإجابة، هل نقرأ الرواية بسطحية بوصفها ديستوبيا تُشبع غرور اليمين المتطرف عن المهاجرين الذين لم ولن يندمجوا، كحالة رواية ميشيل هولبيك خضوع التي تحول فيها برج إيفل إلى مئذنة؟ أم نقرأ الرواية بالعربية ضمن نزعة ذاتيّة بوصفنا مهاجرين/منفيين/لاجئين نعرف التهجير السوري والصراعات التي تشهدها برلين؟ أم، نراهن على حسن النيّة والذوق الجمالي والتحرر من اسم المؤلف وجنسيته، لنقرأ الرواية بوصفها ساتيرية، وتعليقاً سياسياً – ثقافياً ساخراً على مشكلات الهجرة، وتحول الأجساد إلى منبع للأخلاق والأحكام، في زمن كل هوية قادرة على تشكيل حزب وعصابة ومركز ثقافي ممول؟
لا نمتلك إجابات عما سبق، قد تظهر هذه القراءات لاحقاً، لكن ما يمكن أن نقوله الآن أننا أمام راوٍ منقطع النفس، نسبة الأدرينالين في دمائه عالية، يدرك بدقة أنه لا يستطيع أن يحكي «كلّ» ما في «برلين»، لذا تتناسل الحكايات على لسانه، بصورة أدق، يحاول ضبط الأنماط التي يتحرك بينها، تلك التي لكل منها نهاية مرسومة مسبقاً: «شاعر أسيء فهمه فيسجن، أزعر لابد أن يموت غيلةً، سياسي ألماني يريد أن يصبح رئيس وزراء، محقق مهووس، تاجر مخدرات يريد أن يصبح زعيماً وما إلى ذلك» نهاية شديدة السخرية، إذ يموت «الجميع»، أما من بقي فيتنزه ويقرأ شعراً رومانسياً مبتذلاً.