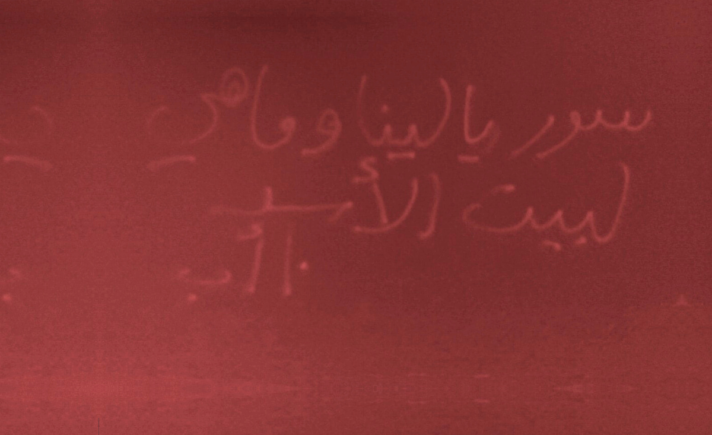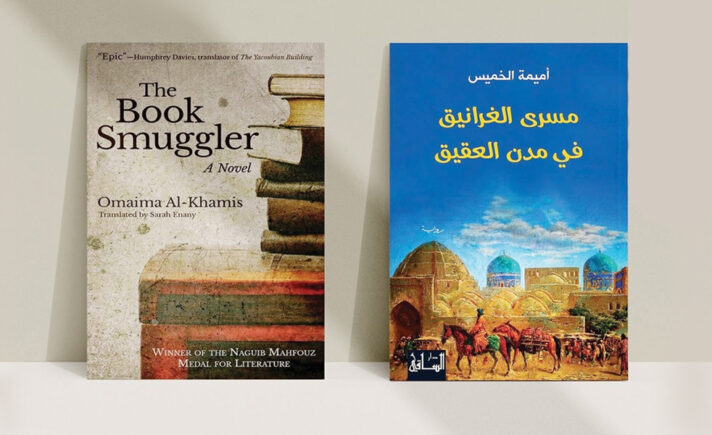هناك رغبة مُتجددة لترجمة نوفيلا الغريب «1942» للكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو كما يبدو، فقد تُرجمت أربع مرات إلى الإنكليزية، كما أنها ثاني أكثر رواية فرنسيّة مُترجمة إلى لغات مختلفة بعد نوفيلا الأمير الصغير لأنطوان دي سانت إكزوبيري، التي صدرت بعدها بعام فقط باللغتين الفرنسية والإنكليزية.
تشترك الأمير الصغير مع الغريب في صِغر الحجم واللغة البسيطة الواضحة والغاية الفلسفيّة وراءها. كما أن الاثنين تُرجما عدة مرات إلى العربية، بما يتضمن ترجمة إلى العامية المصرية، لكن الأمير الصغير لم تُثِر زوبعة من الجدل كما حدث حين صدرت الغريب بالعاميّة المصريّة من ترجمة هكتور فهمي.أوضح لي المترجم في مكالمة شخصية أنها من اختيار الناشر.
هذه الرغبة المتجدِّدة لترجمة الغريب، وكذلك الجدل المثار حول ترجمتها الأخيرة هذه، يطرحان أسئلة تستحق التوقف عندها، قد تكون سهولة لغة النَص مع شهرته الواسعة، وصِغَر حجمه النسبي من أولى الإجابات التي تتبادر إلى الذهن كإجابات للسؤال الأول، وكأسباب تجعل هذه الرواية مُغرية للمترجمين من الفرنسيّة، والناشرين معهم.
هذه السهولة، على أيّة حال، لا تأتي دون إشكاليات وتحديّات تخصها، فالعمل مصنوع بقصدية ووضوح شديدين، مما يدخله في تصنيف «العمل الكلاسيكي» كما يشير رولان بارت.الدرجة صفر للكتابة (1953). فإن كانت الأعمال الحداثية تؤشكل الشكل الأدبي واللغة المُستخدمة، فالكتابة المحايدة، كما أسماها، والتي استخدمها كامو في الرواية، تُعيد اكتشاف الشرط الأساسي للفن الكلاسيكي، أي الأداتيّة، لكن ليس في سبيل الإيديولوجيا المسيطرة، بل سعياً نحو وضع جديد للكاتب الفرد يتواجد فيه. فالهدف هنا هو تجاوز «الأدب» باللجوء إلى حديث بدائي، يبتعد عن اللغة المحكيّة كما يبتعد عن اللغة الأدبيّة القياسيّة. أي يبتعد عن «الأسلوب» وبالتالي يتصدَّر الفكر المسؤوليّة دون التعطل بقيود التاريخ الأدبي. يُقصى الأدب في سبيل التناول المباشر لإشكاليات الوجود الإنساني، ولو أن بارت يرجع ليُعلِن فشل ذلك المسعى، بدخول القولبة والتنميط على هذا الموقف اللغوي عند المستوى صفر.المصدر السابق.
هذه القصديّة في استخدام اللغة لها وظيفة أساسيّة: أن تكون اللغة شفَّافة للأشياء ومُعتمة للمعاني، أي تقديم الحقائق «الخام» قبل تحولها إلى ظواهر أُضفيَ عليها المعنى، وذلك بقطع الروابط بين ما يحدث في الحاضر وجذوره في الماضي وتوابعه في المستقبل، وذلك لإثارة الشعور بالـ«عبثية» عند القارئ كما سنرى.
في لغة الأدب الفرنسي زمن الأفعال المعتاد هو الماضي البسيط (Passé Simple)، ولا يتم استخدامه في لغة الحياة اليومية، وهو مناسب لسرد أشياء حدثت في وقت ما في الماضي. أما الأفعال في رواية الغريب – باستثناء أول فقرتين في الرواية – فمكتوبة بالماضي المركب (Passé Composé)، المستخدَم في اللغة المحكية لأي فعل عموماً وقع في الماضي. نحوياً، يشير هذا الزمن إلى أفعال تم اكتمالها والانتهاء منها، لكنه بلاغياً يوحي بالآنية، بأن الأحداث لا تزال على صلة بالحاضر – في الأدب الفرنسي هناك قاعدة الـ ’24- ساعة‘، أي استخدامه إذا وقع الفعل خلال تلك المدَّة – لا قصة من الماضي مثلما يوحي الماضي البسيط. الأهم أنه يعطي الانطباع بعدم الرسمية في الكلام، ومع حضور الجمل القصيرة الوصفيّة، يدل على بساطة المتكلّم وعدم تكلفه، وبإمكاننا القول: براءته.
هذا الزمن، الماضي المُركَّب، غير موجود في الإنكليزيّة ولا العربيّة، وعادة ما يستخدم الفعل الماضي العادي عوضاً عنه، وهذا ما يجعل الأصل الفرنسي عصّياً على النقل الكامل والتام، مما يجدِّد الرغبة في الترجمة. وهناك سبب آخر لهذا التجدُّد يتعلق بالمضمون أيضاً، وهو كون الرواية لا تتيح نفسها للفهم بسهولة، بل هي مليئة بالإبهام وتعدد التأويلات – كأي عمل أدبي غني وعميق – والترجمة في جزء أساسي منها فعل تفسيري، فكلما زاد الوعي بعملٍ كلاسيكي من خلال التأويلات المختلفة، اُعيدت ترجمته بحسب الفهم الجديد والمُشارِك أيضاً في هذه العملية التفسيريّة.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، أي لِمَ أثارت ترجمة هذه الرواية بالعاميّة المصريّة – وهي مغرية لفعل ذلك في الحقيقة – هذا الانزعاج، على خلاف الأمير الصغير والأعمال الأخرى التي تُرجمت للعامية أيضاً في الفترة الأخيرة، ففي ظني أن السبب هو أن الرواية نَص «فلسفي» وله مكانة مُهمة في سياقه الأصلي، وفي السياق العالمي والمحلي،وافقني على هذا التفسير المترجم هكتور فهمي. وكونه تحديداً فلسفيٌ فهو يستدعي حِس النخبوية الذي يريد أن يتمايز باللغة العاليّة في نصوصه التي يستهلكها وينتجها ولا يريد أن «يُبتذَل» ما يخصّه بلغة «العامة».
* * * * *
مُرسو، بطل الغريب، هو مُستوطن في الجزائر من أصل فرنسي. قتل رجلاً عربياً في إشكال مع جاره، وتمت إحالته إلى المحاكمة. هذه الحبكة البسيطة، المشحونة بإيحاءات سياسية – استعمارية وقانونيّة، ليست مركز النَص، بل يقع المركز في غرابة مُرسو نفسها، كونه غير مبالٍ بالتقاليد الاجتماعيّة، وعقاب المجتمع له على ذلك.
يقول كامو في تمهيد كتبه للرواية سنة 1955، أي بعد صدورها بثلاثة عشر عاماً، بأنه قد لخَّص الغريب فيما سبق بملحوظة متناقضة: «في مجتمعنا أي رجل لا ينتحب في جنازة أمه يُعرَّض لخطر أن يُحكم عليه بالموت».يقول المحامي لمُرسو إنهم عرفوا بعد التحريات أن أمه ماتت في دار مُسنين، وأنه كان يبدي ‘غِلظة كبيرة’ في جنازتها. وعنى بها أن بطل كتابه أُدين «لأنه لا يلعب اللعبة». ولذلك بدا في حياته المنعزلة الخاصة بالنسبة لبعض القرّاء كـ «حطام اجتماعي».
يضيف كامو أن مُرسو لا يلعب اللعبة عن طريق رفض الكذب. لا الكذب بمعنى ألّا يقول الصدق فقط، بل أن يقول «أكثر مما هو صدق»، وبالنسبة للعواطف، أن يعبّر أكثر مما يشعر به. يقصد كامو أننا نحاكي أداءات في حياتنا الاجتماعية، حتى لو لم تطابق مشاعرنا الداخلية، لكي نكون مقبولين. أما مُرسو فيقول ما هو عليه، ويرفض إخفاء مشاعره، مما يُشعِر المجتمع بالتهديد.
بسبب براءته في التعامل مع اللعبة الاجتماعيّة، يبدو مُرسو شخصيّة غامضة في وضوحها الحاد. إنه غريب أيضاً بالنسبة لنا. وبإمكاننا إدانته أو الدفاع عنه أو إعطاء تفسير لما يفعله. هو شخصية «حقيقية» بهذا المعني.
* * * * *
«اليوم ماتت ماما. أو ربما أمس، لا أعرف».
الجملة الافتتاحية في الرواية، وهي من أشهر الافتتاحيّات في تاريخ الأدب، جملة لا مُبالية، مُستفزّة، تكاد تكون سلبيّةً -عدوانيّة. وككل الافتتاحيات الناجحة تجذب الجملة القارئ وتستنفره، والأهم تؤسس نغمة العمل ككل؛ نغمة انفصال، براءة، وربما بعض الحُمْق.
تطرح الافتتاحية الكثير من الأسئلة: هل الصوت الذي يتحدث لا يستطيع ضبط مسافات الوقت وتعاقب الأيام؟ متأخر ذهنياً؟ سيكوباتي؟ لماذا يبدأ الراوي كلامه بخبر وفاة أمه؟ هذه النهاية، نهاية حياة، هي بداية ماذا؟ بداية جريمة قتل؟ هل الغريب قصة جريمة قتل؟ إذا اعتبرنا الغريب كذلك فـ«القاتل» يبدو في جملته الأولى منفصلاً، بارداً، بسيطاً، وبلا مشاعر.
الجملة التالية: «استلمتُ برقيّة من الدار: الأم توفت. الجنازة غداً. تعاطف عميق» تكشف فوراً، إذا أضفناها على الجملة الأولى، شيئاً مثيراً: يتحدث الراوي بأسلوب البرقيّات. جمل قصيرة، مكثفة، تقريرية، بدون صفات ونعوت.
سرعان ما نكتشف صفات أخرى للراوي؛ إنه شخص عيني، مادي: «بالنسبة للآن: يكاد يكون الأمر إن ماما لم تمت فعلاً. ستوصل الجنازة لي الأمر، تضع ختماً رسمياً عليه، إذا جاز التعبير». إنه «لا يفهم» موت أمه لأنه محض فكرة مُجردة، لا يوجد مُدخل حسّي مباشر يتصل بهذا الحدث. يحتاج هذا الشخص إلى دليل جسدي ومادي كي «يصل إليه الأمر».
يمكننا ملاحظة المبالغة في أمرين: التقليل من قدرة اللغة على توصيل «حقيقة» ما للإنسان، فاللغة قادرة على استحضار الغائب بشكل مُجرَّد في ذهن الإنسان، والتأثير عليه نفسياً نتيجة ذلك. والمبالغة في الإنكار النفسي الذي يكون دفاعياً في حالات قصوى مثل وفاة عزيز. يبالغ كامو في هذين الأمرين ويظهرهما خلال شخصية مُرسو في وضوح بارد. يضيف إليهما مبالغة ثالثة أيضاً، وهي أنه شخص عملي بدرجة تغيظ، فزيارة أمه في دار المسنين «كانت تعني أيضاً، خسارة ’إجازة‘ الأحد – دون ذكر عناء الذهاب للباص، وقطع تذكرة، وقضاء ساعتين في الرحلة ذهاباً وإياباً».
* * * * *
ينحِّي كامو علاقة مُرسو بأمه، أو بأمه الميتة، فبهذه العينيّة والعمليّة، بجانب صبغة البراءة والتقريريّة، يصف مُرسو غرفة الموتى بالتفصيل، ثم ينتقل للتابوت، دون ذكر لجثة أمه. بل يرفض أن يراها. حين يُسأل عن السبب فلا يعرف إجابة. يتابع مُرسو هذه الطريقة على مدار الفَصل في الوصف الدقيق للأشياء والأشخاص، كأنه لا يوجد ضغط عاطفي أو نفسي للموقف الذي فيه. بل صفاء ذهن ووضوح انتباه حادين، على عكس المعتاد أو المتوقع في هذا الظرف. وعلى الرغم من دقة مُرسو في وصف الأشياء، فهو لا يعرف عمر أمه.
تتجلي هذه الحالة الذهنية الغريبة في تعليق مثل: «كانت هناك بوادر يوم رائع جداً. لم آت للريف منذ فترة طويلة، وضبطتُ نفسي أفكر في التمشيّة اللطيفة التي كان يمكن القيام بها لولا أني أتيت من أجل ماما». تلامس المبالغة في الانفصال العاطفي حد الهزليّة؛ فسبب حضوره نفسه أصبح عائقاً لحضوره.
على نفس الخط يتعمَّد كامو تسارع الوصف في نهاية الفصل، لكي يذكر لحظة دفن الجثّة، كذِكر عابر وخاطف، وسط أشياء أخرى، يبدو لها نفس الأهمية، وربما تأثير أكبر على بطله: «وأستطيع تذكر منظر الكنيسة، القرويين في الشارع، زهور الجرمانيوم الحمراء على القبور، إغماء بيريز – تكوَّم مثل دمية من القماش – طقطقة التراب طوبي اللون على تابوت ماما، بعض من الجذور البيضاء ممتزجة به؛ ثم أشخاص أكثر، أصوات، الانتظار خارج الكافيه من أجل الباص، هدير المحرك، ورعشة المتعة الصغيرة حين دخلنا أول شوارع مُنارة في الجزائر، وتصورتُ نفسي ذاهباً مباشرةً للسرير لأنام أثني عشر ساعة مرّة واحدة».
يصنع كامو هذه الحيل كوسيلة ليسلط ضوءاً من «العبثيّة» على الموقف. بكلمات أخرى، إذا انتزعت المحتوى العاطفي من مواقف مثل الجنازات وطقوس الموت، فستكون عبثيّة بالكامل. لكن ألا يصح للقارئ، بعد كل هذا، استنتاج أن مُرسو هو وحش غريب بلا مشاعر؟ كل العلامات تشير إلى الإجابة بنعم. مع ذلك، يحتاج الأمر إلى تدقيق أكثر.
* * * * *
كتب كامو قبل الغريب بأربع سنوات رواية باسم الموت السَعيد «1938» لكن لم تنشر إلا بعد موته. بطل الرواية هو باتريس مِرسو – باختلاف طفيف في التهجئة – وهي تُعتبر بمثابة تاريخ شخصي للـ«غريب» وعلى الأغلب لكامو نفسه، وبها بعض التفاصيل والمشاهد مثل أحداث يوم الأحد التي نجدها في الرواية الثانية. كما أن البطلين كلاهما موظف فرنسي الأصل في الجزائر، يعملان في ميناء شحن، ويقتلان رجلاً آخر.
تُسرَد الموت السعيد بضمير الغائب، على خلاف الغريب التي تسرد بضمير المتكلم، وتبدو أكثر إفصاحاً عن علاقة مُرسو بأمه. نعرف من الرواية أن الأم ماتت في سن الخامسة والستين، امرأة جميلة استمتعت بحياتها، لكنها في سن الأربعين أصيبت بمرض السُكري، الذي تفاقم نتيجة لإهمالها العناية به. وفي فقرة شبيهة نجد مشهد جنازة أمه:
«شعرَ الناس في الحي بالأسف لمِرسو. توقعوا الكثير من الجنازة. تذكروا المشاعر العميقة للابن تجاه أمه. نبهوا الأقارب البعيدين ألا يندبوا كثيراً، حتى لا يشعر باتريس بحزنه بشكل حاد.التشديد من عندي: الكاتب. سُئلوا أن يحموه ويعتنوا به. لكن باتريس، لابساً أفضل ثيابه وقبعته في يده، شاهد الإعدادات. مشى في الموكب، سمع الصلوات، رمى حفنة التراب، وطوى يديه. بدا متفاجئاً مرة واحدة فقط، حيث عبّر عن ندمه أن هناك قليل جداً من السيارات من أجل الذين حضروا الصلاة. هذا كان كل شيء. اليوم التالي، ظهرت لوحة في إحدى نوافذ الشقة: ’للإيجار‘. الآن يعيش في غرفة أمه».
نرى أن الانفصال العاطفي في الجنازة تقريباً هو واحدٌ في الروايتين، ولكن هنا يُذكر بوضوح مدى العلاقة الشعوريّة العميقة للابن مع أمه، لدرجة أن الجيران خافوا عليه من شدّة الحزن. وفي حين أن هناك «أداء عملي» يكاد يكون مُهيناً في الجنازة، وإعلانه للإيجار اليوم التالي، كعلامة على تجاوزه السريع للغاية للحدث، إلا أن كامو يتأمل في فكرة أن مِرسو أصبح يعيش في غرفة أمه:
«في الماضي، كان الفقر الذي تشاركاه له حلاوة ما… لكن الآن أصبح الفقر في العزلة بؤساً. وحين فكّر مِرسو بحزن في المرأة الميتة، كانت شفقته في الحقيقة هي على نفسه. كان يمكن أن يجد غرفة أكثر راحة، لكنه تشبث بهذه الشقة ورائحة فقرها.التشديد من عندي: الكاتب. هنا، على الأقل، حافظ على الاتصال مع ما كانه، وفي حياة حاول فيها عمداً محو نفسه، ساعدته هذه المواجهة الشحيحة والصبورة أن ينجو من ساعات الحزن والندم الخاصة به. لقد ترك على الباب البطاقة الرمادية المهترئة التي كتبت عليها أمه اسمها بقلم أزرق».
هنا أيضاً نجد خلف العمليّة الباردة والقاسية سنتمنتالية تتعلق بالماضي والذكريات الصغيرة – بقية الفقرة تذكر أشياء لها قيمة عاطفية وتذكيريّة فقط -وساعات من الحزن والندم كان يمكن أن تقضي عليه. يقول مُرسو في الفصل الثاني من الغريب عن موت أمه: «لا يزال، سواء كان الأمر حُمقاً أو لا، بشكل ما، لا يقدر الواحد على مقاومة الشعور بالذنب بعض الشيء، على ما أظن».
يعيد كامو فكرة الشفقة على الذات من خلال شخصية ثانية في الموت السعيد وهو كاردونا جاره، الذي يرفع صورة أمه ويحدق فيها ويقبلها قائلاً: «ماما المسكينة»، فيعلق الراوي: «لكنها نفسه التي كان يشفق عليها.» ويضيف جملة أخرى «دُفنت في مقبرة بشعة يعرفها مِرسو جيداً، على الجانب الآخر من البلدة».
لماذا يؤكد كامو على هذه الفكرة؟ لأنه يريد أن يشير إلى عبثية الشعور بالحزن من ناحية: الشخص الميت هو غير موجود، وتواجده المادي المحض في أقصى الظروف بشاعة. ومن ناحية أخرى يركز على الجزء الذي يخص الحزن، بأنه بالأساس شفقة على الذات: حين نبكي موتانا فنحن في الحقيقة نبكي أنفسنا التي تعاني من فقدان من نحبهم. أي أن مظاهر الحزن والقهر في الجنازات ما هي إلا مظاهر أنانيّة.
بالطبع هناك مبالغة مُراهقة في توكيد العنصر الأناني المكوِّن في المشاعر الإنسانية -دعونا لا ننسى أن رواية الموت السعيد كُتبت حين كان في الرابعة والعشرين من عمره- لكنها مُبالغة مقصودة تضاف إلى المبالغات الأخرى كي تُجلي عبثية المشاعر التي يتصورها المجتمع ويطلبها من أفراده في أوقات الفُراق، ويطلب تحديداً إظهارها له، وبذلك يكون نوع من الصدق عدم الاهتمام بإيضاحها أو إظهارها «رجوعاً إلى تعريف كامو في تمهيده للرواية حيث الكذب هو أيضاً قول أكثر مما هو صدق».
لكن هناك مشاعر تقيم ولا يمكن كبتها بسهولة مثل الشعور بالندم، الذي يذكره كامو في أكثر من موقع. هنا يمكن أن تساعدنا معلومات من حياته الشخصية، فأمه كاثرين التي أحبها كثيراً،لكامو تعليق شهير على الصراع الجزائري-الفرنسي بقوله: «لو هذه هي العدالة، فأنا أُفضّل أمي». وتعليقات شديد العاطفية مثل: «حين لم تكن عيون أمي مستقرة عليّ، لم أكن أستطيع النظر إليها دون أن تطفر الدموع من عينيّ». وراعته في فقرهم المدقع كعاملة تنظيف في البيوت بعد وفاة والده المبكّرة وهو لم يبلغ بعد العام، كانت نصف صمَّاء ولديها عثر في الكلام، ولا تعرف القراءة والكتابة. يمكننا تخيل الحِمل الذي تمثله أم كهذه لشخص كبير الإمكانيات وشديد الطموح مثل كامو، والشعور الملازم للرغبة من التحرُّر من هذا العبء من أجل الانطلاق في تحقيق ذاته وعيش حياته. إن مِرسو ومُرسو هما ما تمنى أن يكون عليه: شخص شديد العملية، يدفن أمه الغالية بهدوء ليعاود حياته مرّة أخرى. لأن أي شيء آخر سيكون عبثياً.
لكننا نواجه عبثية من نوع آخر في الحياة الواقعية، فأم كامو، كاثرين هيلين سينته، قد ماتت في حادث، بعد وفاته بثمانية أشهر.
* * * * *
رجوعاً إلى افتتاحيّة الرواية: لماذا بدأ مُرسو حكي قصته من هذه اللحظة إذا كانت غير مهمة بالنسبة له؟
الإجابة التي يمكن أن تقال هي أن التفاصيل التي وقعت في الجنازة اتُخذت كدليل ضده في المُحاكمة، ولذلك كان من الضروري حكيها كي تُفهم القصة. لكن الرواية لا تبدأ من الجنازة، بل قبل ذلك بقليل، من خبر وصول وفاة أمه. كما أن كامو فعل شيئاً مايز به تلك اللحظة عن بقية الرواية ككل، وهو أنه جعل الزمن في أول فقرتين مُضارعاً، مثلما تشير الظروف الزمنية في أول جملة «اليوم/أمس»، وأفعال المستقبل prendrai/ arriverai/ pourrai/ rentrerai على خلاف الزمن في باقي الرواية وهو الماضي المركَّب، والذي يبدأ من الفقرة الثالثة «أخذتُ باص الساعة الثانية….» مما يُفهَم أنها كُتبتْ/قيلتْ من قِبل مُرسو في وقت لاحق، بعد رحلة الباص.
يُفهم من خط الزمن السردي أن الحَكي يبدأ من لحظة ما بعد المُحاكمة وقبل تنفيذ حكم الإعدام. وهي لحظة وجوديّة بامتياز. بوضع هذا في الاعتبار، يمكن التخمين بأن كامو رجع في مسودة تالية وغيّر زمن أول فقرتين، التي تخص وصول خبر الوفاة وجعله إلى المضارع.
لا يفيد المُضارع تضخيم الوَقع النفسي فقط، بل إنه يُمايز أيضاً خبر موت الأم كحدث استثنائي، بالاستخدام الفريد غير المُتكرر له في العمل. ويجعله دافعاً للشخصيّة كي يبدأ في سرد حكايته، بل وربما سبباً خفياً للأحداث التي تلت هذه اللحظة.
اختار كامو أيضاً لفظة تعبر عن الحميميّة والقرب على خلاف روح الجفاء والعملية في مضمون الكلام وهي لفظة (Maman)، والتي اخترت أن اترجمها هنا بـ«ماما» وربما تُترجَم أيضاً إلى «مامي»، فهي لفظ يُستخدم من قِبل الأطفال لمخاطبة أمهم في اللغة الفرنسيّة.
يمكننا ملاحظة وجود مشاعر لمُرسو ناحية أمه، وإن كان غير مُفصَح عنها، بقوله حينما سمع جاره ينتحب على كلبه الأجرب القبيح الذي هرب، والذي وضع كامو قصته كي تقوم مقام المقارنة؛ شخصٌ يبكي على هروب كلبه الأجرب مقابل برود مُرسو في فقدان أمه: «لسبب ما، لا أعرفه، بدأت أفكر في ماما. لكن كان عليّ أن أستيقظ مُبكراً اليوم التالي». هنا مشاعر لا-واعية تظهر على السطح، لكنه يكبتها لأسباب عملية؛ الاستيقاظ مُبكراً للعمل اليوم التالي.
يبدأ أيضاً الفصل السادس – الفصل الذي تقع فيه جريمة القتل – بتشبيه مثير للاهتمام: حين يستيقظ مُرسو بصعوبة تقول له ماري إنه يبدو «مثل مفجوع في جنازة»! ويؤكد هو الشعور بالضعف والإعياء.
الصباح هو صباح إجازة، وسيذهب للبحر للعوم مع خليلته ماري. ما الذي يجعله مثل مفجوع في جنازة؟ يمكننا تفسير ذلك بحسب التحليل النفسي بأنه عودة المكبوت. عودة للمكبوت أثناء نومه حيث تضعف آليات الكبت وترتخي الرقابة الواعية على المشاعر. سردياً، ينتهي الفصل السابق بحديثه قبل النوم مع جاره الذي فقد كلبه ويعاني من فقدانه، بعدما حكى له أنه رباه بعد موت زوجته. في تضاد يبدو متهكماً، يرى ماري مرتديةً فستاناً أبيض، مُطلِقة شعرها. هي في عُرس، وهو في جنازة، «يختار» مُرسو العُرس.
نستنتج من ذلك أن هناك مركزيّةً للأم وحضوراً لمشاعر عميقة عند مُرسو ناحيتها، لكنها مكبوتة، عن وعي، كخيار عملي. إنه ليس وحشاً عديم المشاعر. وتلك المشاعر تتسلل خلف المثال الجامد الذي تمنّاه كامو لنفسه في شخصية الغريب.
* * * * *
يبدأ الفصل الثاني باستجلاء سوء فهم حدث في الفصل الأول: اعتقد مديره في العمل أنه يحتاج إلى أربعة أيام إجازة وليس اثنين.
يعلق مُرسو بأنه «لا يمكن للواحد التوقع بأن يعجبه ذلك». هذه الالتفاتة تشير إلى أمر عبثي في المجتمع: إنه نفسه لا يتوقع/يسمح بالحزن والحداد على من فقدناهم أطول من مدة مُحدَّدة سلفاً؛ لديك فترة مُحددة للشعور بالحزن وبعدها فهو أمرٌ «لا يمكن للواحد التوقع أن يتم الاعجاب به». والمفترض أن الحزن شعور تلقائي وغير مُتحكَّمٍ به؛ المجتمع في ضوء هذه الالتفاتة هو مُرسو نفسه.
يزيد كامو بذكاء من هذه المفارقة العبثية بتعليق مُرسو بأنه ليس ذنبه أن أمه «دُفنت الليلة الماضية وليس اليوم»، مما كان سيجعله يقوم بهذا الطقس في إجازته الأسبوعيّة، أي دون أخذ إجازة عارضة وإزعاج المدير. في الفصل الخامس يبلغه مديره أنه يمكنه الترقي والذهاب للعمل في باريس، ويجده غير مكترث بذلك فيسأله إذا كان «تغيير الحياة» لا يستهويه، فيجيبه بأن «الواحد لم يغيِّر حياته أبداً؛ وحياةٌ ما هي بنفس جودة الأخرى، وحياتي الحالية تناسبني بشكل جيد جداً».
يثور المدير ويقول له إنه متوانٍ وعديم الطموح، وهو «عيب قاتل، بالنسبة له، في مجال العمل». مرّة أخرى يشير كامو إلى عبثية منطق المجتمع الرأسمالي: لمَ الطموح في الترقي الوظيفي والحياتي إذا كان الواحد راضياً عن حياته، لِمَ يكون الرضا في حد ذاته عيباً قاتلاً؟ يقول مُرسو، وربما هي إحالة للحياة الشخصية لكامو،في سن السابعة عشر أصيب كامو بالسلّ وذهب لعيش مع عمه، وأثَّرَ ذلك على دراسته، بجانب اضطراره للعمل في مهن متواضعة لكسب العيش. كان عنده مثل هذا الطموح الذي يتحدث عنه المدير حين كان طالباً، ثم حين اضطر لترك دراسته أدرك أن كل ذلك بلا جدوى.
الإشارات للعمل وضغطه على مُرسو وتداخله مع حياته الشعوريّة الداخليّة يبدأ من اللحظة الأولى في الرواية، بشكل يستدعي بقوة قصة التحول لفرانز كافكا، حيث لم يفكر البطل، الذي وجد نفسه قد تحول إلى حشرة في الصباح، إلا في عمله وكيفية الذهاب إليه والأعذار التي سيقولها لمديره وردة فعله. هناك موازاة بين وقوع حادث حاد والتفكير الفوري في العمل ورد فعل رئيس العمل.
التعليق على العمل اليومي الثابت يظهر بوضوح أكثر في رواية الموت السعيد، الذي يتركه مِرسو حين حصوله على المال، ويظهر بشكل مباشر في كتاب أسطورة سيزيف حيث يعدَّده كامو من مظاهر الحياة الاجتماعيّة العبثيّة: «يحدث أن ينهار ديكور المسرح. النهوض، ترام، أربع ساعات في المكتب أو المصنع، وجبة، ترام، أربع ساعات من العمل، وجبة، نوم والاثنين، الثلاثاء، الأربع، الخميس، الجمعة، والسبت، وفقاً لنفس الإيقاع – هذا المسار سهل تتبعه معظم الوقت. لكن في يوم ما تبزغ الـ ‘لماذا’ ويبدأ كل شيء في هذا الكلل المشوب بالتعجُّب.»
في الفقرة التالية على مقابلة المدير في الغريب، تأتي رفيقته ماري وتسأله إذا كان سيتزوجها فيَرُدُّ بأنه لا يمانع. يتطور الحوار بينهما فتقول له إن الزواج أمر خطير وينفي هو ذلك، فتغمغم بأنه «شخص غريب الأطوار». في هذا الموقف أيضاً يصنع كامو مرآة مع الآخر؛ هي لا تحب مُرسو رغم تكرار سؤالها إذا كان يحبها، فهي في النهاية تريد زوجاً، والمجتمع يجعل طريق الزواج هو الحب أو الرغبة المتبادلة، ورغم أنها تشير بانزعاج أنه كان سيأتي برد الفعل نفسه – عدم ممانعة الزواج – مع أي فتاة غيرها، ندرك بشكل خفي أن الأمر نفسه ينطبق عليها أيضاً.
بعد هذا الحوار والاتفاق على الزواج، يسألها وهما سائران إذا كانت لاحظت أن النساء العابرات جميلات، فتوافقه دون غضب أو امتعاض، بعدها يدعوها للعشاء فتقول إن لديها موعد فيقول لها «مع السلامة»، تسأله إذا كان لا يريد أن يعرف مع من، ثم تضحك وتمد فمها من أجل قُبلة. هي لا تحبه، وهذه العلاقة الاجتماعية النمطية بكليتها عبثية.
لا يتوقف كامو عن رصد المظاهر العبثية للمجتمع، فيقدم نموذجاً آخر هو شخصية المرأة الروبوت كما يسميها، التي رآها في المطعم بعد ذلك حين ذهب للعشاء؛ امرأة تتحرك بتخشّب مثل الروبوتات، تتحدث بسرعة ودقة وتحسب ثمن العشاء بآلية، تجلس لتُعلِّم بتركيز على كل برامج الراديو للأسبوع المقبل في كتيب البرامج. تسير في الشارع بسرعة فائقة دون النظر في أي اتجاه. هي شخصية عملية ومنظمة لكنها أيضاً شخصية عبثية – بالمعنى السلبي – بامتياز: شخص «فعّال ونشيط ودقيق» دون أي معنى أو غاية، وفي الوقت نفسه يتصرف كما لو أن هناك شيئاً من ذلك القبيل.
* * * * *
على الجانب الآخر، مُرسو شخصية غريبة بالفعل: في اليوم التالي لجنازة أمه، يذهب للعوم، ويبدأ علاقة، ويمارس الجنس مع فتاة يذهب معها أيضاً لمشاهدة فيلم كوميدي. لكن مُرسو لا يفعل ذلك لأنه من دون مشاعر كما أوضحتُ، بل لأن مشاعره بلا معنى أبعد، مشاعر تتواجد فقط في واقعيتها وآنيتها، كما يظهر حين يقول مثلاً عن ماري: «حين ضحكت أردتُها مرّة أخرى. اللحظة التالية سألتني إذا كنت أحبها. قلتُ إن سؤلاً كهذا ليس له معنى، فعلاً؛ لكنني أحسب أني لم أفعل». هو يرغب فيها ببساطة، ولكنه لا يستتبع ذلك بأنه يشعر بالحب، الذي هو المعنى الأبعد للرغبة.
ربما كان هذا هو سر جاذبيّة شخصية مُرسو في الوقت الراهن، فهو شخصية تبدو ما بعد حداثيّة في عدميتها: زاهداً فيما سيأتي ناسياً ما قد مضى، بعد أن جرّب السعي والطموح واكتشف زيف الآمال. يظهر هذا بوضوح حين يتحدث مِرسو عن نفسه في الموت السعيد: « منذ سنوات قليلة مضت، كان لديّ كل شيء أمامي- كلمني الناس عن حياتي، عن مستقبلي. وأنا قلتُ نعم. حتى أنني فعلت أشياء ينبغي عليك فعلها حتى تحصل على تلك الأشياء. لكن حتى وقتها، كان الأمر كله غريباً علي. أن أكرِّس نفسي للا – شخصية – هذا ما عناني. لا أن أكون سعيداً، لا أن أكون ’ضد‘».
يبدو مُرسو أو مِرسو في جانب منه مثل شخصية جيفري الشهيرة من فيلم ليبوسكي الكبير – كما يبدو في المخيال الجمعي حالياً – حين يكمل ويقول: «حتى الآن، لو امتلكتُ الوقت، سوف أُطلق نفسي. كل شيء آخر سيحدث لي سيكون مثل المطر على الحجر. يبرد الحجر وهذا حسن. يوم آخر، تحمّصه الشمس. لطالما ظننتُ أن هذه هي السعادة بالضبط». وحين يشرح اللا-شخصية بعد ذلك، يذهب إلى أن يعيش الواحد «بشفافية وتقبل المصير».
يدرك مِرسو أنه لم يفكر ولا مرة في فيينا في الرجل الذي قتله. و«أدرك في نفسه أن لديه القدرة على النسيان التي يمتلكها الأطفال فقط، والعباقرة، والبريئون». تستهوي ما بعد الحداثة مفاهيم مثل النسيان، والبراءة، والخفة؛ الذاكرة والخبرة وصراع القدر يثقلون الكاهل دون داع مقنع، الانتقال الخفيف المستمر بين الأشياء متساوية الشِدة والأهمية هو التحرك المثالي.
بذلك تكون هذه الشخصية قادرة على فعل الشر. لا لأنها بلا مشاعر أو أخلاق، لكن لأنها تحديداً في براءتها لا تربط الأفعال بغايات، وفي نسيانها لا تصلها بدوافع. وبذلك يستطيع مُرسو في الغريب كتابة الرسالة المهينة لخليلة -وعاهرة- جاره القوّاد والبلطجي، ومساعدته في الإفلات من عقاب ضربها، والإدلاء بشهادة رسمية ضدها، والموافقة أيضاً على تعذيب كلب جاره الآخر. ذلك لأنه يتحتم عليه في كل موقف الاختيار، لا ترك الأحداث تحصل مثل «المطر على الحجر». هو يختار أيضاً أن يسير خلف صديقه الغاضب، وأن يتابعه رغم إعلانه أن يريد أن يكون بمفرده. شخص لا- مكترث بالفعل كان سيترك الآخر وشأنه حين يُعلن ذلك صراحة، لكن مُرسو يترك لا-اكتراثه ويقرر تحمل مسؤولية الصداقة، بل ويطلب منه بعد ذلك أن يُمسِك بالمسدس إذا حاول العربي الآخر التحرك، وكنتيجة طبيعيّة يصل في النهاية للقتل.
يدرك المجتمع بحدسه الجمعي كل هذا، ويستشعر الخطر من مُرسو وبراءته ونسيانه ويقرر محاكمته بشراسة.
* * * * *
تتحول البراءة مع الجزء الثاني، الذي يبدأ بعملية استجوابه، إلى ما يشبه السذاجة التامة. يفعل كامو هذا لكي يضع مسافة مع هذه الإجراءات الاجتماعيّة – القانونيّة وينظر إليها دون اعتبارات مُسبقة، بل لكي يستطيع قول جملة كهذه: «كل الأشخاص الطبيعيين، أضفتُ بعد تفكير، رغبوا بشكل ما في موت من أحبوهم، في وقت أو آخر». والتي تجد صداها بعد ذلك في قوله: «حين سُئل [حارس الدار] لو كانت اشتكت أمي من سلوكي، قال نعم، لكن هذا لا يعني الكثير؛ كل نزلاء الدار تقريباً يشتكون من أقربائهم».
يشير كامو أن المجتمع ليس أفضل حالاً من مُرسو الذي يخاف منه. بل إنه يهابه وينفر منه أكثر حتى من شخص قتل أبيه، ويمكننا تفسير ذلك بصفته يمثل مبدئاً لا-اجتماعياً، لا مجرد خرق لقاعدة اجتماعيّة. يجعل كامو مُرسو في الجزء الثاني أقرب إلى الحَمَل الوديع، كالمسيح في محاكمته وهو يقول ببراءة: «لماذا تلطمني؟»يشير كامو في التمهيد الذي كتبه إلى أنه حاول أن يصوِّر في مُرسو «المسيح الذي نستحقه». في مقابل عبثية الإجراءات المتخذة ضده: «حقيقة أن الحكم قد أذيع في الثامنة مساءً بدلاً من الخامسة، حقيقة أنه كان يمكن أن يكون شديد الاختلاف، أنه أُعطي من قبل رجال يغيرون ملابسهم الداخلية، ونُسب إلى كيان غامض جداً مثل ’الشعب الفرنسي‘، لماذا ليس إلى الشعب الصيني أو الألماني؟»
يربط كامو بين البراءة، والحسيّة والماديّة؛ لا يقبل مفاهيم مجردة مثل «الشعب الفرنسي» وقدرتها على تقرير إنهاء حياة فرد حي. والمعطيات الحسيّة المعنية هنا تبدو شديدة التفاهة؛ هي غير مربوطة بشيء، لأن الأفعال لا ترتبط بدوافع أو غايات؛ لا تاريخ لها. هؤلاء ليسوا قضاة درسوا وتدربوا واختارهم المجتمع لكي يمثلوا قدرته على الحكم في شأن جنائي، وتباحثوا قضيته وتداولوها في عملية قانونيّة استغرقت شهور، هم فقط رجال يغيرون سراويلهم الداخلية ونطقوا حكمهم بشكل اعتباطي الساعة الثامنة.
* * * * *
قرب نهاية الجزء الأول وبشكل أوضح في الجزء الثاني، تأخذ جُمَل السرد في الحركة بشكل أكبر وأكثر استمراريّة، وتصبح لغة مشحونة بالصور البلاغية، وتُحاكي في مواضع الشعرَ النثري. يصبح المنظور أكثر تأملاً واستبطاناً، والأسلوب أكثر تركيباً، واللغة أكثر علواً، وتشبه بذلك كتابة أسطورة سيزيف والموت السعيد.
حين يفكر مُرسو في الموت وحتميته، لا يفكر فقط في تفاهة وعبثية الحياة، بل بكونها أيضاً غالية جداً، لأنها لا تستمر أو تعوَّض. يرفض في ماديته تأكيدات رجل الدين الميتافيزيقيّة، التي «لا تساوي خصلة واحدة من شعر امرأة»، ويراه يضيّع عمره بالعيش كجثة. يُصرّح بوضوح: « كل إنسان حي محظوظ؛ هناك طبقة واحدة فقط من البشر، وهي الطبقة المحظوظة». أي شيء خارج هذا بالنسبة له غير مهم -لأنه غير مادي ولا حسي- مثل موت الآخرين، حب الأم أو الإله.
يصل مُرسو قرب النهاية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة في فلسفة كامو العبثية، وهي «القبول». يوضَح ذلك من الإشارات المتكررة لجمال الطبيعة والكون والاتحاد معهما. على سبيل المثال: « لابد أني نمت طويلاً، لأني حين استيقظت، كانت النجوم تلمع على وجهي. أصوات الريف دخلت خافتة، وهواء الليل البارد، المعبأة بروائح الأرض والملح، هب على خديّ. السلام الرائع لليل الصيف النائم غمرني مثل مَدِ». والحرية التي شعر بها، وفهم بها تَصرُّفَ أمه بأن أخذت لها خطيباً قبيل موتها، الحرية السيزيفيّة التي بلا أمل: « وأنا، أيضاً، شعرت بأني مستعد أن أبدأ الحياة من جديد. كان الأمر كما لو أن الاندفاع العظيم للغضب قد غسلني نظيفاً، وأفرغني من الأمل».
تشير نهاية الرواية إلى استكفاء الإنسان العبثي الذي يكمل مراحله الثلاث بنفسه واستغنائه عن الناس، وعدم اكتراثه التام برأيهم ومشاعرهم ناحيته، فمُرسو في آخر الرواية يتمنى يوم إعدامه أن يأنس بحضور كبير العدد، يقوم بتحيته بصياحات اللعنة.
تبدو النهاية مع ذلك بطوليّة بشكل مراهق، بتحويل الفزع إلى شموخ، والضعف إلى كرامة، والاحتياج إلى استكبار. بهذا تبتعد الرواية عن دعاية العدميّة، وتقترب بمنطقها الخاص من الفكر الوجودي. لكنها تُغفل أيضاً أن الشر يأتي من نوع لا-مكترث من الفرديّة، وأن الإنسان إذا لم يُدخِل الآخر في حساباته بدافع الشعور وبحسابات المنطق، سيكون بالضرورة مؤذياً وشريراً، حتى لو أدّعى أنه محايد. لأنه لا يمكن للواحد عن يعيش بمنأى طوال حياته، التي تتطلب في كل موقف ومنعطف قراراً منه ينحاز به إلى جهة ما. وأن الإنسان يعيش في مجتمع لأنه يحتاج إلى ذلك، حتى لو كانت كلمة «مجتمع» تدل لغوياً على مفهوم مجرَّد.