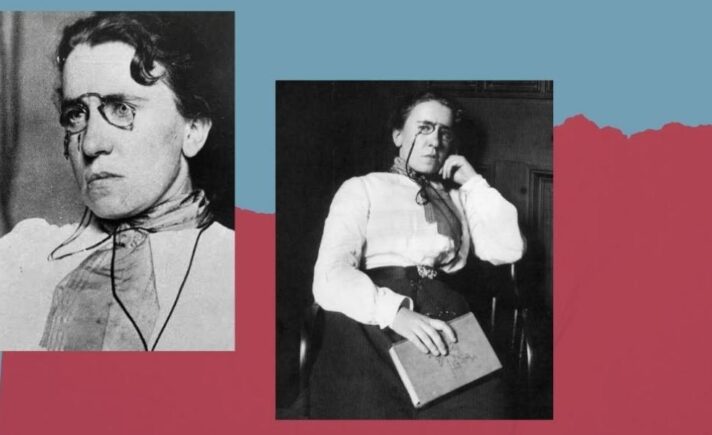بعيداً عن المشهدية الجنائزية المُعتادة، دعوني أستعير دُعابات هيثم وظُرفه. افترِضوا أننا استعدناه للحظةٍ وسألناه رأيه، لابتسمَ وقال: «يا عمّي حلّوا عن ربّي! وفّروا وقتكم وأوقات البشر لما هو أجدى وأفضل».
أما وقد ضاقت أرض سوريا بقبور الشهداء والضحايا، وانتصبت شواهد قبورِهم في المنافي، فإنّ جدار تخليد أسمائهم وصورهم كبشرٍ، وليس كأرقام، لا يزال يتّسع ويتمدّد!
تساءلَ كثيرون كيف وافت المنيةُ هيثم؟ وأين ومتى؟ وما ملابسات ذلك؟ سيّان عنده، فلم يكن ذلك بالنسبة إليه مهماً! كان السؤال المهم وقتها والآن أيضاً: كيف عاش؟
لو كان بيننا اليوم، لاكتفى بالقول، كما باحت إحدى صديقاته وهي تحكي عن تواضعه وهو يُقدّم نفسه: «هيثم نعّال، سبعة وعشرون عاماً في السجن»، ولواصلَ قائلاً: «علّمتني الحياة أنّ الفعل هو الأصل وليس الكلام. فِعليَ الوحيد أن أحاول.» نقطةٌ تنهي السطر قبل أن يكمل «شكراً لحضوركم، وداعاً!». لَمَا زادَ عن ذلك حرفاً، أمّا أنا فأكملُ نيابةً عنه: «عشتُ ثورياً وفيّاً لانحيازي لإنسانية الإنسان… وهكذا مضيت».
منذ سبعة وأربعين عاماً عرفتُه، قرابة نصف قرن… يا له من زمنٍ حافل قلَبَ الدنيا رأساً على عقب! لم يُتِح الزمن لأحزاننا أن تبصر النور كما تستحق… لم يُمهلنا الوقت ونحن نلهثُ كيما نسابقَه، فتراكمَت أوجاعنا حتى باتت جزءاً لا يتجزأ من أرواحنا ووشماً لا يمّحي من أجسادنا! منذ ذلك الوقت عرفته، وتعاهدنا وبقية الرفاق على ألّا نفترق!
وإن افترقنا؟
لم يكن السؤال وقتها مطروحاً، أقلّه بالنسبة للرفاق الأربعة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبّدة، تلكَ الجملةُ التي تجعل الموت يتربّص بنا في كلّ منعطفٍ ودورةٍ من دورات الزمن. بعد خمسة عشر عاماً، غادرَنا أربعةٌ من رفاقنا إلى السجن الكبير، سجن الوطن، وبعد عام لحقتْ بهم رفيقتنا التي لم نتمكّن من رؤيتها طوال تلك المدة! حينها طُرِحَ سؤالُ الفراقِ جدّياً فكان الجواب: إذاً، لا بدّ من أن نلتقي…
عرفتُهُ أثناء المحاكمة أولاً، وأَسرتني شجاعتُه آنها، ثمّ بعدما غادَرنا رفاقنا الخمسة الذين قضوا على أعمدة المشانق، أو هكذا قيل، فلا جثامين ولا قبورٌ ولا شهادات وفاة… حدث ذلك في سيارة السجن التي التقينا فيها للمرة الثانية وهي تنقلنا إلى تدمر خريف العام 1975. كأنّ ذلك حدثَ بالأمس. لم يكن توقفاً للزمن بالنسبة لنا… ففي ذلك الصباح الضبابي وطوال الطريق إلى تدمر، طَغَت أصوات أغانينا وأناشيدنا على ضجيج العربات المدجّجة بالأسلحة، والتي رافقت عربتنا وكأنّ معركة انتشالنا من براثنهم ستنشب في أيّ لحظة… ضَحِكنا… كان خوفُ الموت يملأ قلوبهم وكنّا ننبض بالحياة. صدْحُ أغانينا كان عهدَنا الصامت بألّا ندفنهم، وأن نعهد بهم لأفئدتنا كي يظلّوا نجمة صبحٍ تُضيء لنا الدرب، وقوةً حيّةً نستمد منها العزيمة والصمود في هوّة الجحيم التي سنعرفها بعد حين رويداً رويداً، وأن نبقى أوفياء لمبادئنا الثورية وأحلامنا بالحرية والعدالة الاجتماعية ومناهضة الطغيان، تلك الأحلام التي تعمّدت لتوّها بالدم!!! كانت تلك صرخةَ الغضب الأولى على الجريمة البشعة، تحيتَنا لهم كي نواصل الرحلة معاً…
تلكم هي بداية الرحلة التي راكمتْ في ثناياها قُرابة قرنين من سنوات سجن أعضاء المنظمة الشيوعية العربية في سوريا وحدِها!!!! طيلة تلك السنوات، لم نتوقف في أي سنةٍ عن الاحتفاء برفاقنا الشهداء بالطريقة نفسها في التاريخ نفسه، الثاني من آب من كلّ عام، فنشعلُ حيثما أُوتينا شموعاً كأعمارهم. هكذا بقينا أحياءَ، وهكذا ظلوا أحياء.
لعلّ البداية كانت قبل ذلك بقليل، حين حدّد كلٌّ منا خياراته وصنع بيديه قَدَرَه المضرج بالدم والمفتوح على فضاءات الموت. تلكم هي البداية الحقيقية لهيثم والتي لم تعد فيها مآلاتها الدموية، لا سيما في العقد الأخير، مهمةً إلّا من حيث صِلَتُها بالوفاء للمبادئ والانحياز للثورة…
أيّ ثورة وأيّ مآلات؟ هكذا تعارفنا وتعاهدنا، اختلفنا واتفقنا، لكنّه كان صخرةَ اليقين وبوصلة الأمل والإصرار على إمكانية تحقّق الثورة مهما طال الزمن. في ذلك الوقت المبكر، عارضَ عصياناً رأيناه ضرورياً لتحسين شروط عيشنا، وأَنذَرَنا: ستكون العواقب وخيمة! لكنّه كان أولَ المدافعين عن متراسنا البدائي، وصمدَ وراءه بجسده وروحه حتى النهاية… كان يخفي وراء خجله ودماثته انحيازاً شديداً للفقراء، ولم تكن الثورة بالنسبة له إلّا أداةً لتحريرهم من قيودهم وذُلّهم وبؤس عيشهم. كان جزءاً لا يتجزأ منهم وأراد أن يكون مثلهم في حياته ومعاشه، وكان يرى مقتَله في ابتعاده عنهم… ووراء بساطته ومودّته، أخفى مقتاً للسياسة بألاعيبها وأكاذيبها وصفقاتها ومساوماتها وبازارتها وكلّ القذارات التي تكتنفها، وإصراراً على بلورة سياسةٍ نقيةٍ كنقائه… تتساوقُ فيها الغاية والوسيلة، أملى عليه نقاؤه ألّا تبرر الغايةُ الوسيلةَ بأيّ حال من الأحوال. هكذا كان حلمه… فكان مقتلُه الثاني، لا سيما في العقد الأخير. إذ لاذَ بصمته كيلا يسمح للجدران بأن تُصدِئ روحَه وتفترسَ وداعتها.
بقدر ما ضاقت جدران الزنازين بجسده، ظلّت تتمدد لتتسع لرؤاه وأحلامِه. ازدرد قناطير من الصبر بصمتٍ وهو يعلم أنّ الشمس تنتظره خلف الجدران ذاتها. وحين أزفت لحظة خروجه، ودّعنا بأسىً اخضوضلت به عيناه وأعلن ضاحكاً: سنلتقي قريباً.
حين التقينا بعد عشرين عاماً، أخفى كعادته حزنه على إصابتي التي أتاحت لقاءنا… عانقني، ضحكَ من كل قلبه: التقينا إذاً، لم نُخلِف العهد، سنطوي مرحلة، ونستهلّ أخرى كما كنا نفعل في كلّ مرة. رغم كلّ المرارات والفجائع والكوارث التي أحاقت بوطننا وأطاحت بأحلامنا وآمالنا إلى حين (وهذا حال كلّ ثورة)، ضحكَ مرةً أخرى بغبطة وعذوبة وعانقني بقوة: ها نحن نستعيد أرواحنا، لنطوي مرحلةً ونبدأ من جديد.
في منفاه لم يخدعه حلمه أبداً، غير أنّ مآلات تحقّقِه أكرهته على الإقرار بالهزيمة! تحمّلَ بصدق مسؤوليته عنها ولم يُلقِها على عاتق الآخرين أيّاً كانوا، وعاد مجدداً ليلوذ بجدران صمته الذي لم يستوطن فيه على الإطلاق.
الذين عرفوه عن قربٍ وسبروا غور صدقه ونقائه ومحبته، وخبروا عفّة نفسه وإيثارَه الآخرين عن كفافٍ، لم يفجِعهم رحيله المفاجئ فحسب، بل بكوه بصمت يليق بالإنسان الكامن في أعماقه. الأعماق التي اتسعت لإشعال ملايين الشموع على ضحايا بلده. في أيامه الأخيرة، واظبَ على شرب قهوة أمّه الصباحية، مازجاً بها صحيفةً تلمّ شتات بلده بين يديه… ليحاول مرة أخرى رسم ملامح وطن!
نأى بنفسه خوفَ أن تأسرَه لعبة السياسة وتلوّثَه… أراد أن يبقى وحيداً كيلا يَخون نفسه!!! لكنّه بموته همسَ لنا بوصيته الأخيرة: آن أوان طرح الأسئلة، لنحاول أن ننهي مرحلةً ونبدأ أخرى!
هل أَجّلَ موته كي يفي بعهده؟ هل أخفى موته عنّا كيلا يُفجعنا على حين غرة، وكي يعفيَنا من نكئ جراحنا وأعباءِ مواراته الثرى؟ لا أحد يعلم، ما أعرفه أنا ورفاقه وأصدقاؤه أنّه لم يَخُن نفسَه يوماً… ولم يلتمس عذراً لأخطائه، رحلَ ليظلّ فينا تاركاً لنا البقية والختام.
لم يعد مُهمّاً كيف مات، المهمُّ حقاً أنّه عاش!