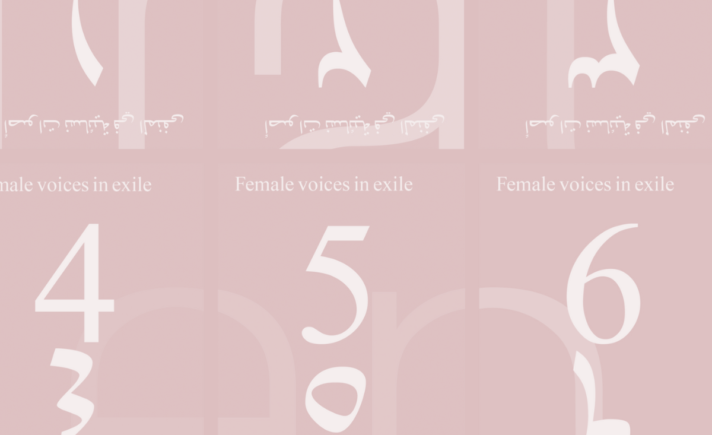الملجأ كمفهوم تاريخي
لم يكن الطريق إلى الحماية القانونية التي توفّرها حقوق اللاجئين سهلاً على الإطلاق. وليس مردّ ذلك إلى الصعوبات التي تواجه طالبي اللجوء أثناء رحلاتهم من أوطانهم وحسب، بل أيضاً لأن إقرار حقوق اللاجئين كما هي مُحدَّدةٌ اليوم بشكل واضح في اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951، وفي دساتير دول حديثة كثيرة، استغرقَ وقتاً طويلاً بعد تاريخ من الحروب والنزاعات، وذلك رغم أنّ اللجوء كعُرف إنساني يرجع إلى عصور قديمة جداً.
في اليونانية يشير مصطلح (Asylos) إلى محلّ اللجوء غير الخاضع لسلطة الدولة، وهو مكان لحماية الهارب من الاضطهاد يقع تحت حكم الآلهة المباشر، وفيه تنتهي السلطة البشريّة وتتوقف القدرة السياسيّة للحاكم على اعتقال الإنسان أو احتجازه. وثمّة وثيقة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد تُعَدُّ كأقدم دليلٍ على حماية اللاجئين، وتعود إلى عصر الحيثيين (امبراطورية ضمّت الأناضول وشمال بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين). وتنص الوثيقة على أنّ أي لاجئ يأتي إلى أرض الحيثيين لا يمكن إعادته إلى موطنه الأصلي. وفي العصور التي سادت فيها المسيحية، اعتُمِد هذا الحق من قبل الكنيسة ولم يُسمح في محلّ اللجوء بحدوث أي انتقام أو نوع من أنواع الثأر (…)Gundi Biebe: Weltgeschichte des Asylrechts, 2017.
في الثقافة العربية قبل الإسلام مثَّلَ «الجِوار» مفهوماً مقابلاً لمفهوم محلّ اللجوء. فالجِوار هو طلب الحماية من شيء يخافه المرء، وله دلالة ثقافية تتعلق بحسن الضيافة والكرم. وقد لعبت الكعبة بمكانتها الدينية دوراً كمحلٍّ للّجوء، ومنحت ملاذاً للهارب وحقاً بالحصانة دون النظر فيما ارتكبه. وفي العصر الأول للإسلام بحث النبي محمد وأصحابه عن الأمان والحماية من تعذيب وتنكيل قريش. وخاطبَ النبي محمد قبائل العرب طلباً للجوار، وهاجرَ المسلمون الأوائل إلى الحبشة بحثاً عن الحماية كأول هجرة جماعية في التاريخ الإسلامي هرباً من الاضطهاد الديني. وبعد أن تأسست الدولة الإسلامية ظلَّ مفهوم الجِوار قائماً واحتفظت مكة بمكانتها الدينية الوثنية كمحلّ للّجوء، مع استحداث استثناءات تعلّقت بعدم منح الأمان لمن يخالف أحكاماً أساسية في الشريعة الإسلامية. ورغم تشعب المصطلحات في الخطاب الإسلامي مثل «الجار» و«الذمي» و«المهاجر» و«المستأمن»، ورغم تمييز الفقهاء بين هذه الأوضاع المتعددة، إلا أن معانيها تدور في فلك طلب الحماية والأمان سواء خصَّ ذلك المسلمين أو غيرهم من أتباع ديانات أخرى.حنطاوي بوجمعة، الحماية الدولية للاجئين بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، 2019.
حق اللجوء والسياسة
منذ العصور الوسطى ارتبطَ حق اللجوء بشكل وثيق بالعهود والمواثيق، وبسيادة الامبراطوريات والممالك، وبالاتفاقيات التي تبرمها الممالك بين بعضها. في الحالة الإسلامية ثمّة مثال بارزٌ يتعلّقُ ببنود صلح الحديبية حين ردّ النبي محمد من جاءه مسلماً بغير إذنٍ من وليه، تنفيذاً لأحد بنود الصّلح التي اتفق عليها الطرفان، وهو ما أثار خلافاً وجدالات حول مفهوم «الجوار» مقابل «المنفعة السياسية». في أوروبا ورغم تشبثها بالتقليد المسيحي لمفهوم اللجوء، في القرن الحادي عشر بالتحديد وتحت شعار «هواء المدينة يجعلك حرّاً» منحت بعض المدن الحقوق المدنية للعبيدِ الذين فرّوا إليها. لكن وبالمقابل، وعندما كان الحكّام يتبادلون المصالح والعلاقات، كثيراً ما كان يترتب على ذلك تسليم الخصوم والهاربين وإعادتهم إلى أقاليمهم، الأمر الذي كان تعاوناً معلناً بين هؤلاء الحكام للقضاء على خصومهم. وإنّ تحالف الحكّام المستبدين كان دافعاً لتوحّد الحركات الثورية والإصلاحية التي ناهضت الحكم المطلق في أوروبا، ومع قيام الثورة الفرنسيّة ارتفعت الأصوات لمنع تسليم اللاجئين بسبب ما كان يعرف «بالجرائم السياسيّة» رغم عدم توفّر تعريف واضح لهذا المصطلح.كانت معارضة الحاكم تعتبر جريمة وفق أدبيات عصور الاستبداد. ومع انتهاء ذلك العصر طغت ألفاظ جديدة مثل خصوم ومعارضين سياسيين. تاريخياً تعلَّقَ الأمر كذلك بنتائج الثورة الفرنسيّة على الصعيد الاجتماعي، فأحداثُها أنتجت موجة كبيرة من اللاجئين من طبقة النبلاء الذين تم نفيهم لاعتبارات سياسيّة، ولأن حركات الإصلاح الثوري مانعت بشدة تسليم المعارضين السياسيين سادَ في نهاية الأمر مبدأ عدم تسليم المعارضين، وأصبح بمثابة قاعدة وعرف عام تعزَّزَ في القرن التاسع عشر بعد اندلاع ثورة آذار (مارس) عام 1848 في ألمانيا، والتي انطلقت كجزء من ربيع أوروبي هدفه المزيد من الحريّات السياسيّة والليبرالية. فمع إخفاق الثوار في ألمانيا نشأت موجة لجوء واسعة نحو إقليم زيوريخ في سويسرا، فأقرّ الإقليم قانوناً خاصاً باللاجئين السياسيين، ومُنِحَ الفارون حق الإقامة لأسباب سياسيّة، الأمرُ الذي حمل مضامين ذات دلالة إيجابية تتعلق بالاعتراف الواضح بحق الشعوب في الثورة ضد الظلم، وبأنّ الهاربين لأسباب سياسيّة ليسوا مجرمين.Gundi Biebe, 2017. وبهذا تكون الحركات الثورية والإصلاحية قد وضعت حداً لإمكانية تعاون الحكام مع بعضهم البعض قبل أن يفل عصر النظام السياسي القديم. وبالمحصلة فإنّ الأحداث السياسيّة في أوروبا في القرنين الثامن والتاسع عشر سعت إلى تعزيز حق الحماية من الاضطهاد السياسيّ والديني، وإلى تداوله على نطاق أوسع خاصة بعد أنّ تبّنت حركات الإصلاح الواجب الأخلاقي القائم على ضرورة حماية من يتعرض للاضطهاد في وطنه، وهذا انطلاقاً من تجربتها التاريخيّة منذ القرن السابع عشر.
غير أنّ القرن التاسع عشر شهد بالمقابل تقييدات على حركة الهجرة والتنقل. فالتطورات البارزة على صعيد الإنجازات الصناعية والسكك الحديدية والنقل البحري سهّلت حركة الأفراد. صحيحٌ أنّ هذه الإنجازات سهَّلَت على الفارين من الاضطهاد السياسي والديني إيجاد مكان آمن، والهجرة من مكان إلى آخر بسلاسة لا سيمّا وأنّ حركة التنقل لم تكن منظمة بعد كما هي عليه اليوم من خلال الفيزا أو حق الإقامة للأجانب، لكن ومن ناحية ثانية فإنّ سهولة التنقل وتطور وسائل النقل زاد من أعداد المهاجرين واللاجئين، ووضع الدولة في تحديات على الصعيد الأمني (في هذا الصدد يجدر الإشارة بأنّ المتهمين بجرائم جنائية كالقتل والسرقة قد استفادوا أيضاً من وسائل النقل الجديدة وسهولة الفرار من دولة إلى أخرى دون عقبات)، وبالتالي كان على الدول أن تواجه هذه التحديدات الأمنية فأبرمت فيما بينها اتفاقيات خاصة تقتضي بتسليم المتهمين بجرائم جنائية، واستثنتهم من قوانين الحماية. وعلى صعيد تنظيم قوانين الهجرة والأجانب والتنقّل كانت بريطانيا العظمى أول من أقرّ القانون الأول للأجانب عام 1905 بعدما تدفق المهاجرون إليها والراغبون بالهجرة إلى أميركا من خلال أراضيها، فحظرت بريطانيا دخول الأجانب إلا من خلال تصاريح الإقامة، واستثنت من الحظر من وقع عليهم أي اضطهاد سياسي وديني، إذ استقبلت اليهود الفارين من المذابح المنظمة في روسيا دون أن يكون لذلك تأطيرات حقوقية ودولية على الصعيد العام.Gundi Biebe, 2017. وإلى بدايات القرن العشرين لم تعتبر الدولُ نفسَها ملزمةً بعد بـ «حقوق اللاجئ» وكان القصد من حماية اللاجئين والهاربين من الاضطهاد متعلِّقاً بتأكيد الدولة على إرادتها ومزاجها وميلها السياسي، ولم يشهد اللجوء كحقّ قانوني حتى ذلك الزمن أي معالجة دولية جادة وفاعلة.

اللجوء بين حربين عالمتين
في العام 1914 وقعت حادثة اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند أثناء زيارته سراييفو. وكان الاغتيال هو المحرك الظاهري لاندلاع الحرب العالمية الأولى التي مات فيها نحو تسعة ملايين جندي وملايين المدنيين. في ألمانيا وحدها قُدِّرَ عدد المعاقين بما يزيد على اثنين ونصف مليون إنسان إلى درجة أن مشاهدة الأطراف الصناعية باتت أمراً عادياً وجزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.Tod und Verwundung. Das Lebendige Museum Online. انتهت الحرب برسم خرائط جديدة في العالم، ومآسيَ أثقلت كاهل الإنسانية، وساد شعور مخادع بأنّ البشريّة قد تعلّمت من هذا الصراع المريّر، وأنّ زمن السلام يجب أن يسود عوضاً عن الاقتتال. في عام 1919 تأسست عصبة الأمم وارتبطت مهمتها بالحفاظ على السلام العالمي، وبمحاولة بناء مجتمع سلمي للأمم تطبيقاً لطرح فلسفي تحدَّثَ عنه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في كتابه إلى السلام الدائم (1795)، وبالفعل تولّت عصبة الأمم مهمة تحقيق السلام، وبالإضافة إلى ذلك وقع على عاتقها مساعدة اللاجئين بسبب الحرب. وعينت لهذا الغرض مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين تولَّى بشكل خاص ملف اللاجئين الروس، فاندلاع الثورة الروسية عام 1917 خلق حوالي مليون لاجئ. وفي وقت لاحق توسعت مهامه لمساعدة اللاجئين الأرمن الذين فروا من تركيا، وتمكنت المنظمة من تزويد اللاجئين ببطاقات إثبات الهوية عُرفت باسم «جواز سفر نانسين»، واعترفت به 52 حكومة كأول وثيقة سفر مخصصة للاجئين وعديمي الجنسية. نقيضاً لهذا التطور المهم في تاريخ اللجوء، وبسبب الأزمات الاقتصادية، حاولت بعض الدول طرد اللاجئين من أراضيها عوضاً عن إعادة توطينهم، وباءت محاولة مساعدتهم من قبل المفوض السامي بالفشل إذ أخفق في إيجاد صيغة تعاون مع هذه الدول، وفي كثير من الأحيان نقلت بعض الدول اللاجئين الذين كان من الصعب حقاً عودتهم إلى ديارهم إلى السجون.Gundi Biebe, 2017. بالمقابل اتفقت ثماني دول على تعديل وضع اللاجئين على أراضيها وتعاقدت على عدم إعادتهم قسراً والسماح لهم بالبقاء إذا لم تتبنَ دولة ثالثة عملية استقبالهم.

كانت ظاهرة اللجوء الإنساني بعد الحرب العالمية الأولى أحد أكبر الإشكالات المأساوية التي ضربت على وجه الخصوص القارة الأوروبية، إذ قُدِّرَت أعداد اللاجئين بقرابة عشرة ملايين كانوا قد عبروا حدود الدول الأوروبية بالتزامن مع التغيرات الجغرافية المرافقة لتشكيل الدول القومية بعدما أعيد تصميم خريطة أوروبا من جديد، خصوصاً مع الإطاحة بالأنــظمة الملكية الحاكمة في كل من روسيا والنمسا والمجر وألمانيا. وقد رافق ذلك تغيرات جذرية على الصعيد الاجتماعي والثقافي، والحرب كانت نقطة تحول غيّرت مسار التاريخ البشري عموماً والأوروبي على وجه الخصوص.
في ألمانيا تسلّم الاشتراكيون القوميون السلطة بزعامة هتلر الذي بدأ بالتحضير خلال الأشهر الأولى من توليه السلطة للحرب العالمية الثانية. وضاعفت سياسات النازية أزمة اللجوء بعدما اضطر قسم كبير من اليهود والمعارضين لهتلر إلى الفرار من ألمانيا والنمسا. وبمبادرة أميركية تشكلت IGCR كلجنة دولية مشتركة ترعى بشكل خاص الفارين من نظام هتلر بسبب آرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وانتمائهم العرقي، لكن اللجنة أخفقت في التفاوض مع النظام النازي لأجل تنظيم هجرة اليهود، ولم تحقق أي إنجاز بخصوص ذلك. أما في إيطاليا فالحال لم يكن مغايراً عن ألمانيا، ذلك أن صعود الفاشيّة فيها بعد الحرب العالمية الأولى بدا كإنذار وقرع لطبول حرب جديدة. ونادى الفاشيون الإيطاليون باستعادة ما اعتبروه «الأراضي الإيطالية» وامتلكتهم الرغبة في توسيع نفوذهم، واحتذى موسوليني بالنموذج الإمبراطوري الذي تم إحياؤه في الأدبيات السياسية كمفهوم روحي وأخلاقي، وجندت الفاشية قواتها العسكرية على هذا الأساس، فالسلام لدى الفاشي هو فتورٌ لا ينتمي للواجب. وبالطبع صادقَ موسوليني كلَّاً من هتلر وفرانكو. وهذا الأخير قادَ انقلاباً عسكرياً عام 1936 للإطاحة بالجمهورية الإسبانية الثانية، وكان سبباً رئيسياً في نشوب الحرب الأهلية الإسبانية.
«أنا أرى الخنجر في القلب» كتب الشاعر الإسباني لوركا ذات مرة قبل أن يغرس الفاشيون خنجرهم في قلبه، وفي قلب البشريّة بأكملها. وأدت المطامع التوسعية بقيادة الفاشية الأوروبية إلى انفجار الوضع الإنساني باندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 وأودت بحياة 70 مليون ضحية على الأقل.Bernhard WeidenbachZahl der Toten nach Staaten im Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1939 bis 1945. Statista 2022. وبدعوة من الويلات المتحدة الأميركية، تأسّست الوكالة الدولية للإغاثة والتأهيل (UNRRA) عام 1943 وكان الهدف منها إغاثة ضحايا الحرب وتوفير الملاذ والغذاء والخدمات الطبية المناسبة لهم. وعلى الرغم من أنّ صوت المعركة قد توقف مع نتائج كارثية على المستوى البشري والاقتصادي ودمار المدن إلا أنّ حركة اللجوء استمرت، وأحداث الحرب ونتائجها قلبت مصير العالم، وطال البؤس الإنساني أغلب بقاع الأرض، وكان الهرب واللجوء أحد هذه الوجوه البائسة بعد أن شردت الحرب 30 مليون إنسان من منازلهم.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لم تحقق عصبة الأمم الهدفَ المنشود من تأسيسها على صعيد حفظ السلام العالمي. لذا جاء تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 لإنجاز التعاون بين الدول على أساس العلاقات الودية، ولدعم القانون الدولي كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية، ولفرض سيادة جديدة على العالم تبناها المنتصرون في الحرب. إلى جانب ذلك كان على الأمم المتحدة أن تتعامل مع ملف اللاجئين الأوروبيين المتأزم في قلب القارة الأوروبية لا سيما على ضوء الخلافات السياسية بين دول الحلفاء الغربيين والاتحاد السوفييتي.
بالتزامن مع جهود الحلفاء الغربيين لأجل محاكمة النظام النازي بأسره، وكنتيجة لتوجّه جديد نحو الأنسنة في السياسة، صدرَ في باريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 كمعيار مشترك ينبغي لكل الأمم والشعوب أن تهتدي به. وتبنت الأمم المتحدة الإعلان رداً على الفظائع المرتكبة بحق الإنسانيّة خلال الحربين الماضيتين، ورداً على الديكتاتورية التي سادت سابقاً في العالم الغربي وعموم العالم. وتناول الإعلان الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان التي من شأنها الحفاظ على الكرامة الإنسانيّة التي انتُهِكَت بوحشية جرّاء أفعال النظام النازي وأقرانه. وارتكز محررو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صياغته على الحقوق الفردية: الحريّة والحق في الأمان وفي العائلة والسكن، والحق في اللجوء والجنسية. كما تضمّنَ الإعلان في بنوده الحقوق السياسية مثل حق التعبير وحرية الاعتقاد وحق المشاركة في التجمعات والتصويت. وقد نُظِرَ إلى بنود البيان كتطور إيجابي على صعيد حقوق الإنسان، ولعلّه كان التطوّر الأهم منذ أن تم نحت هذا المصطلح في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي مع قيام الثورة الفرنسية.

اتفاقية جنيف عام 1951 للاجئين
اعتُبِرَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة حقوقية تاريخية أضاءت على جوانب متعددة تتعلق بالحياة الإنسانيّة والحقوق المدنية، ودفعت إلى تطوير دساتير الدول. وبعدما أشار الإعلان إلى قضية اللجوء في المادة 14 منه وأقرَّ لكل فرد حقه في التِماسِ ملجأ آمن في بلدان أخرى خلاصاً من الاضطهاد، وكفله كحق شخصي لكل إنسان، سوف تلعب الصياغة الدستورية في الدول الديمقراطية دوراً إيجابياً في حماية حقوق اللاجئين خلافاً لأوضاعهم في الدولة الاستبدادية.
ومن أجل حماية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيّما ما يتعلّق بحقوق اللاجئين، تأسست تحت مظلّة الأمم المتحدة عام 1950 المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة بـ UNHCR كأكبر منظمة إنسانية في العالم، واهتمت بتنسيق المساعدات الدولية للاجئين، وتأمين حق الحماية لهم، وتصدير خطابات الحماية لمنع الترحيل ودمجهم في المجتمعات المضيفة أو دعم عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم. وتكللت جهود المفوضية بتوقيع اتفاقية جنيف عام 1951 كأول اتفاقية دولية شاملة تناولت النواحي الجوهرية المتعلقة بحياة اللاجئ، وتعريفاته وحقوقه التي يجب أن يحصل عليها ويتمتع بها في الدول التي لجأ إليها مثل حق الإقامة والتعليم والرعاية الصحيّة. لكن تلك الاتفاقية لم تحمل طابعاً عالمياً إذ خصّت فقط اللاجئين على إثر الأحداث الحاصلة في أوروبا، ووقعت عليها 149 دولة من أعضاء الأمم المتحدة من أصل 192 فيما امتنعت 44 دولة عن التوقيع وكانت معظمها من دول الشرق الأوسط وآسيا كالعراق ولبنان والأردن وسوريا ودول الخليج، وكذلك باكستان وماليزيا وإندونيسيا.مايا ينمير، الدول غير الموِّقعة ونظام اللاجئين الَّدولي، 2021. وثمّة أسباب دفعت هذه الدول إلى عدم التوقيع تتعلق بنقص المرجعية التشريعية والتنظيمية لكيان الدولة، فمثلاً ورغم أن سوريا كانت إحدى المشاركين في اللقاءات التشاورية غير أن دستورها لا ينص على منع تسليم اللاجئين. ومن ناحية أخرى خشيت بعض الدول من الحقوق الممنوحة للاجئين وفق الاتفاقية، وارتأت أن هذه الحقوق مدعاة لإثارة أزمات في داخلها من خلال منافسة اللاجئين لمواطنيها الأصليين لا سيمّا في موضوع الخدمات الاجتماعية كالتعليم والسكن والرعاية الطبية.
عربياً لم تنظر الدولة إلى قضايا اللجوء والهجرة كوضع إنساني راهن ومعقد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. وفي السياسة لم يكن العالم العربي بعيداً عن النديّة السلبية إذ لم تكن الفاشية حكراً على أوروبا وحدها، وصعدت في بلدان عربية عديدة أنظمة قومية ذات نزعة فاشية، وانتهكت معايير حقوق الإنسان. ومن الطبيعي ألا تتخذ حكومات هذه الدول إجراءات قانونية واقتصادية لتطوير المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين رغم أنّ الدساتير المستحدثة في معظم الدول العربية هي دساتير حديثة ورثتها من دول الانتداب، وقامت بتطويرها مع إضافة طابع إسلامي عليها عبرَ ما عرف اصطلاحاً بـ «أسلمة الدستور» من خلال الديباجة والمواد التي تشترط الإسلام كدين للدولة أو الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي لتشريع. وفي مناخ متأزم برزت القضية الفلسطينية على مسرح الأحداث. وبعد النكبة 1948 وصل الفلسطينيون إلى الجوار العربي في طور تشكل الدول الوطنية وأزماتها الاستقلالية، وعاشوا معاناة قاسية من ضيق الأفق والمكان في حياة المخيم. أودت هذه الأوضاع باللاجئين الفلسطينيين إلى منفى دائم تم استقبالهم فيه على أساسيين: ديني وقومي، يرتبطان بالوضع السياسي المتعلق بالخطاب التحرري والسائد آنذاك ضد الانتداب، وكذلك الروحي الذي يتلخص باستعادة الهوية العربية والإسلامية لبناء الدول الناشئة بعد مرحلة الاستقلال والتي ترأست قيادتها الأنظمة الاشتراكية القومية.

إسلامياً ورغم أنّ الغرض من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان عابراً للجنسيات والثقافات والأديان إلا أنّ دولاً إسلامية عديدة انتقدت الوثيقة، وردَّت عليها بالبيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1981، وبإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990. واعتراضاً على مبادئ الحقوق الفردية الواردة في الإعلان العالمي، ومن منطلق «التحفظات الشرعية» رفضت معظم الدول الإسلامية الإعلان على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والحقوقية المتردية في هذه الدول التي طغت فيها سياسة محافظة وتقليدية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذو طابع ليبرالي وعلماني، والحقوق الواردة فيه حقوقٌ تشمل كل الأديان والمعتقدات، والتوجهات الفكرية، والثقافية والسياسية. ويأتي هذا في جوهر النزاع الثقافي بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقتين الإسلاميتين. فحقوق الإنسان في التعريف الإسلامي كما جاء في البيان «هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي» وعلى هذه الحقوق وفقاً لمصدرها أن تطابق قوانين الشريعة الإسلامية. وأقحم البيان في مواده الرؤية الإسلامية للكون والعلاقات البشرية، ومنح المرأة والطفل حقوقاً تتناسق مع التبعيّة والتكافل ومبدأ الوصاية وأسبقية الرجل في السلّم الاجتماعي والأُسري. أما الحريات بموضوعاتها فارتبطت بطبيعة المجتمع الذي من المفترض «أن يؤمن فيه الفرد بأن الله وحده مالك الكون…» وعلى هذا الأساس فإن لحرية التعبير والتفكير والاعتقاد قيوداً تلتزم بالحدود العامة التي أقرتها الشريعة التي تخدم «الأمة المسلمة» والمجتمع الذي يتقاضى أفراده حول الحقوق والوجبات أمام الشرع الإسلامي وعقيدته. في هذا الصدد ينتقد رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لبنان الموقف الإسلامي بالقول بأنّ «الإعلانات الدولية تَذكُرُ أموراً كثيرة باعتبارها حقوقاً طبيعية بينما يؤصل الإعلان الإسلامي نفسه على القرآن والسنة وعلى الشريعة». ويرى السيد أنّ واضعي البيان الإسلامي امتلكوا إصراراً على إبراز خصوصية الشريعة الإسلامية واستقلالها وكان ذلك في إطار «سباق النديّة».رضوان السيد، حقوق الإنسان والفكر الإسلامي المعاصر.
وبالتالي لم تعالج الدولة العربية شؤون اللاجئين (سواء الفلسطينيين أو غيرهم) وفق خطاب إنساني وقانوني بعيداً عن هذه الإشكالات، بل تأثرت المعالجة دائماً بالمناخ السياسي والديني دون النظر إلى أهمية تطوير قوانين ملزمة لحق اللجوء كوضع بشري تفاقمَ في القرن العشرين الذي وُصِفَ بقرن الحروب بعد أن شهد حروباً أخرى كارثية منها: الحرب الصينية اليابانية 1937 والحرب الكورية 1950، وحرب فيتنام 1954، والحرب العربية الإسرائيلية، والحرب العراقية الإيرانية 1980، وحرب البوسنة والهرسك 1992. ورغم تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية ظلّت التشريعات القانونية غائبة. وحلّ فراغٌ قانوني أدى إلى سوء أوضاع اللاجئين في البلدان العربية التي وإلى جانب كونها من أكثر الدول المصدرة للاجئين (الفلسطينيين واللبنانيين. وفي الوقت الراهن السوريين والعراقيين واليمنين والليبيين)، كذلك فإنّ بعض دولها مثل الأردن ولبنان استقبلت بالمقابل أعداداً كبيرة من اللاجئين، ما جعل هذه الدول تنظر إلى اللجوء كخطر يهدد كيان الدولة. وهكذا لم يتم الدفع نتيجة كل هذه الأسباب إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين، وحفظ كرامتهم في ظّل عنصرية وطنية متصاعدة.يعيش اللاجئون السوريون والفلسطينيون ظروفاً إنسانية صعبة في لبنان مع تزايد خطاب الكراهية والعنصرية ضدهم. انظر بيان البروفيسور أوليفييه دي شوتر مُقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عن زيارته إلى لبنان عام 2021.
عولمة حقوق اللاجئ: برتوكول 1967
سيطرت فكرة كانط في كتابه إلى السلام الدائم على أوضاع استقبال اللاجئين في أغلب البلدان طوال معظم تاريخ اللجوء الحديث، إذ إنّه اقترح صيغة الضيافة كحق للغريب، والذي له حق العيش بسلام طالما أنه لا يتصرف بعدوانية. هذه صيغة يمكن اختصارها بالمثل العربي «يا غريب كُن أديب»، وقد أطلقها السوريون أنفسهم عندما استقبلوا اللاجئين اللبنانيين والعراقيين. وتعاملَ الجوار السوري مع السوريين لاحقاً على هذا الأساس الثقافي الاجتماعي المتعلق بالمزاج العام والأوضاع السياسية والاقتصادية، والتغافل بأنّ مسألة حقوق اللاجئين غدت مسألة حقوق لا علاقة لها لا بكرم الضيافة ولا بالعطف. والأهم في ذلك هو التأكيد على أنّ اللاجئ إنسان له الحق في أن يتمتع بحقوق المواطنين الأصليين، وهي الرؤية التي ساهمت في تطوير العدالة الدولية، إذ سوف يمحو برتوكول 1967 الحدود الجغرافية التي وضعتها اتفاقية جنيف 1951.جاي س. جودوين – جيل: اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول التابع لها، 2010. فالحق في الحماية يجب أن يشمل جميع الناس، ولعولمة هذا المفهوم على أوروبا أن تخرج هي الأخرى من قوقعتها التاريخية من خلال تعميم التجربة الإنسانية تحت مظلة دولية. وهكذا انطبقت بندود اتفاقية جنيف على جميع الناس بالتساوي دون أن يتم استثناء أحداً منها من خلال برتوكول 1967 الذي شكَّلَ ومعه اتفاقية 1951 مرجعين أساسيين في القانون الدولي فيما يخصّ اللاجئين، وذلك بعد تاريخ طويل من الحياة الإنسانيّة الشاقة.

لكن هل رسخت هذه القيمة الإنسانية الجديدة في الضمير العالمي؟
هذا السؤال المطروح يفتح شهية الباحثين اليوم خاصة وأزمة اللجوء أصبحت في الأعوام العشرة الماضية مثل كرة لهب يتقاذفها الجميع. فالأزمات والحروب أعادت تموضع سياسات الدول بخصوص اتفاقية جنيف، ودولٌ كثيرة بما فيها دولٌ موقعةٌ على الاتفاقية والبروتوكول عمدت إلى التملّص من التزاماتها القانونية. في العام 2015 بلغت موجات اللاجئين إلى أوروبا من سوريين وغيرهم ذروتها، وبعد عدة أشهر عمدت الدول الأوروبية إلى إغلاق حدودها في وجه اللاجئين، وتملّصت أغلبية الدول (عربية وأجنبية) من مسؤوليتها الأخلاقية والدولية إزاء حقوق اللاجئين، واتهمت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين الدولَ باتخاذ عراقيل لمنع اللاجئين من الوصول، وبرزت سياسات متناقضة في السلوك السياسي والبيروقراطي لأغلب الدول بالتعامل مع ملفّ اللاجئين.
في تركيا مثالٌ بارزٌ على السياسات المتناقضة، فهي واحدةٌ من الدول الموقِّعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 ومنحت اللاجئين الأوربيين من خلالها حق اللجوء. بالمقابل، تعاملت تركيا مع اللاجئين السوريين على أساس مختلف يستند إلى مبدأ الضيافة، والتهرّب من الالتزامات القانونية الدولية بخصوص أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، وذلك تذرّعاً بعدم توقيعها على الصيغة النهائية لبرتوكول 1967، واعتبارِ أن أغلب اللاجئين على أراضيها (ما عدا أولئك القادمين من دول الاتحاد الأوروبي) لا يملكون صفة «اللاجئ»، وبالتالي فإن تعامل الدولة التركية معهم مرهونٌ على هذا الأساس القانوني الذي لا يمنحهم سوى «الحماية المؤقتة»، ومن ثم فإن إمكانية إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم قانونياً ممكنة، وهذا الوضع ذريعةٌ تركيةٌ لعدم تحسين ظروفهم ومنحهم الحقوق الكاملة المترتبة بالاعتراف بهم كلاجئين. وللتغطية على جانب الإنكار القانوني،سبق وأنّ تعاملت تركيا مع اللاجئين الأكراد الفارين من مجزرة حلبجة عام 1988 بالطريقة نفسها، ولم تمنحهم صفة لاجئ. ورحّلت أعداداً منهم إلى مدن إيرانية، واحتفظت بالبقية تحت بند الحماية المؤقتة. ربط أردوغان علاقة السوريين بالأتراك بعلاقة المهاجرين بالأنصار واستحضر الخطاب الإسلامي عوضاً عن خطاب الحقوق والواجبات. وبعد سنوات تراجع المجتمع التركي عن سياسية الأحضان المفتوحة، وتعرَّضَ السوريون للاستفزاز والعنصرية والاعتداء على ممتلكاتهم، والقتل أحياناً من قبل أتراك متعصبين وشعبويين يعتقدون بأنّ السوريين نافسوهم على مجالات الدراسة والعمل والمسكن. وبعدما طال أمد بقاء السوريين، اتخذت الدولة التركية إجراءات قانونية حددت من حركة اللاجئين السوريين، وقامت بإبعاد بعضهم إلى الأراضي السورية ضمن إجراءات تعسفية دون أن تلتزم بحقوقهم كما فعلت مع اللاجئين الأوربيين سابقاً، وتهاوت سردية «مهاجرون وأنصار» مع انحياز الدولة التركية في ملف اللاجئين لمصالحها الإقليمية.في شباط 2016 وقّعت الحكومة التركية اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى معالجة تدفق اللاجئين نحو أوروبا، وقد جاء الاتفاق ضمن استمرار مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لرغبتها في الانضمام إليه.

غيمة من العدم
يوجد تشكيكٌ مُحقٌّ في القول إن البشرية قفزت خطوات واسعة نحو أنسنة حقيقية في مواضيع الهجرة واللجوء.
فأولاً، إنّ الاتفاقيات الدولية المختصة بقضايا اللاجئين، ومن ضمنها اتفاقية جنيف 1951 وبرتوكول 1967 مُلزِمةٌ للدول الموقعة عليها، كما أن الدول غير المُوقِّعة مُلزَمة بحماية اللاجئين تجاه المفوضية السامية، لكن الخلل الأكبر يقع في عدم توافر رغبة سياسية دولية بحماية بنود الاتفاقية، التي رغم إلزاميتها إلا أنّه لا توجد هيئة دولية متخصصة تتخذ أي عقوبات بحق الدولة المخالفة لها.
وثانياً، إن الالتفاف على حقوق اللاجئين في السياسة الدولية بات لعبة الأقوياء والضعفاء. عندما أرادت أوروبا التملّص من حقوق اللاجئين، ورغم الخلافات السياسية المرتبطة بملفّ انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عقدت مع الحكومة التركية اتفاقية خاصة أرادت من خلالها التخلص من أعباء اللاجئين بمنعهم من الوصول إلى أراضيها.
ثالثاً، إنّ رفض المجتمعات المستقرّة للاجئين كان بمثابة صفعة جديدة لعالم ما بعد العولمة. فالعنصرية والاعتداءات على مخيمات وتجمعات اللاجئين في دول كثيرة مؤشرٌ حقيقيٌ على كراهية الآخر (مثلاً في لبنان وتركيا ودول شرق أوروبا يوجد عداء غير مسبوق ضد اللاجئين)، كما أن الدولة القومية تتّبِعُ سياسات دافعة نحو تعزيز هاجس الخوف من «الآخرين» عندما يصبّ ذلك في مصالحها السياسية والاقتصادية، ودون مراعاة أوضاع ومشاعر اللاجئين التي تُختزَن في غيمة من العدم يلخّصها طفل أفغاني في قصيدة ألقاها في مهرجان الثقافة العالمي للشعر في برلين قائلاً: «تُحِب وأنت لا تُحَب، تحسّ بالقرب وليس هناك من أحد تستند إليه».