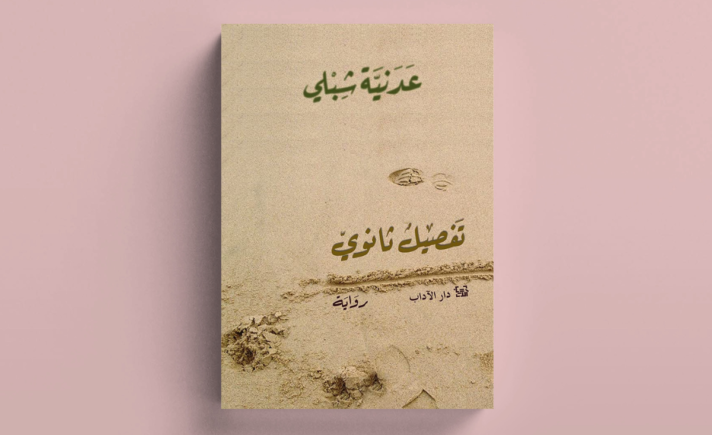تستهويني كمؤرخة ذاكرة الأُسَر ومساهمتها في مواجهة التاريخ القومي الذي يؤطر قصصنا الشخصية ويوجّهها، فيملأ المساحات المنسية من سِيَرنا الذاتية. فهي تسمح للأفراد العاديين بالمساهمة في الروايات الكبرى وإنتاج الذاكرة الوطنية بشكلٍ مختلف، وكتابة تاريخٍ بديلٍ للأفراد والجماعات.
تُقدِّم ذاكرةُ الأسر نظرةً ثاقبةً حول كيفية سرد التاريخ الوطني وتداوله وتفسيره داخل العائلات، وبالتالي فإن تاريخ العائلة وذكريات الأحداث الماضية لا تتعلق فقط بتاريخ الأسر بحد ذاتها، ولكن أيضاً بدورها عموماً في صناعة أحداث الماضي وسردها وتشكيل الذاكرة الوطنية. لتصبح العائلة مكاناً لسرد التاريخ أو إسكاته، وأحياناً وسيلةً للتحرر أو لإعادة تشكيل الماضي وفهم الذات وإعادة بنائها. ذاكرة الأسر وسيلةٌ لمراجعة التاريخ الوطني من الأسفل، تضفي طابعاً فردياً على الماضي يُمكّننا من النظر إلى التاريخ الحميم وإعطاء الصوت للناس العاديين وحياتهم اليومية، فيصبح التاريخ الوطني مأهولاً بالناس، لا مجرد أسماء وتواريخ وأماكن.
أعود اليوم إلى ذاكرة أسرتي بحثاً عن معنى لماضينا ولحاضرنا وسط الانهيار في لبنان والغربة وانتفاء المنطق. أحاول كتابة قصة مدينةٍ من خلال سيرة جدي وعائلته، مستندةً على ذاكرة والدي، لرصد قصص بيروت الحميمية وعلاقتها بالأطراف، والاستغلال الذي عانى منه الوافدون إليها من الأرياف وعائلاتهم، والأوهام التي بُنيت عليها المدينةُ عبر الأجيال، ووصولاً إلى يومنا هذا. أغوص في سيرة ثلاثة أشخاصٍ لفهم تجاربهم المختلفة في المدينة وتشابكها والإرث الذي تركوه. وأتقفّى أثر رجلٍ ضريرٍ من جبل عامل، حاول إيجاد مكانٍ له في هذه المدينة التي شهدت تغييراتٍ اجتماعيةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ عميقة خلال القرن الماضي، وسعى إلى تشكيل عائلةٍ رغم الظلم العام والخاص الذي تعرّضَ له. لأتعمّق بما شهده هو وجدتي، ولاحقاً أبي، من أفكارٍ وأحداثٍ وتغييراتٍ كانت تجتاح المدينة، وانتهت بتشكيل العالم الذي نعرفه اليوم.
أقرأُ بعض النصوص عن ذاكرة الأُسَر وأهميّتها، وأحاولُ التِماسَ الدافع الأساسي خلف بحثي عن تاريخ أسرة والدي، فأنا أبحث ضمن عملي عن تاريخ الثقافة الشعبية والمغنيات والموسيقى في بيروت ومدن المنطقة، لكن تستوقفني القصص والسير الشخصية. هو شيءٌ في داخلي ما بين الفضول الشخصي والرغبة بالعودة إلى ماضٍ بديل، لإعادة كتابة تاريخٍ من الأسفل، يُمكّننا من دراسة المُهمَّشات والمُهمَّشين والناس العاديين من خلال نقل وقائع حياتهم اليومية وتجاربهم الشخصية. تاريخ يقدّم نظرةً مختلفةً عن فئاتٍ ظلّت خارج وجهات نظر التاريخ الرسمي، مما يسمح بفهم تفاعل الناس العاديين مع المدينة، في محاولةٍ للبحث عن الماضي المنسي وأوقات الصمت فيه.
أرغب إذاً بالعودة إلى أشخاصٍ كانوا جزءاً من النسيج الاجتماعي والثقافي لبيروت وجنوب لبنان، ومن العلاقة ما بين تلك المنطقتين، وساهموا في رسم واقع المدينة، ولكنّهم بقوا على الهوامش رغم ارتباطهم بتاريخ الشيعة عموماً، والخطاب الذي انبنى حول هذا التاريخ وهذه الهوية. فالخطاب السائد حول تاريخ الشيعة الوافدين من الجنوب والبقاع الى بيروت بحثاً عن العمل في المدينة وما سُمّي بأحزمة البؤس التي تشكّلت في بعض أحياء وضواحي بيروت، يتمحور كثيراً حول فكرة التهميش. لكن السردية المهيمنة تتحدث عن تهميشٍ لـ«الجماعة» و«الطائفة»، ولا تعبأ بأصوات وقصص المُهمَّشات والمُهمَّشين أنفسهم كأفرادٍ وعائلات، والتي غالباً ما كان يتّم التكلم بأصواتهن من دون إعطاءهن فعلاً الكلام أو ذكرهن كأشخاص. وهي بأي حال قصصٌ لا تنحصر بالضرورة بطائفةٍ او جماعةٍ ما، بل تتشاركها الفئات الأكثر استغلالاً وتهميشاً. من هنا تنبع رغبتي بالعودة إلى قصصهم المنسية لتفكيك المركزيات التقليدية المهيمنة، والتعامل مع الحاضر وإعادة إنتاج الذات والهوية والذاكرة الشخصية والجماعية.
ما بين نهاية السلطنة العثمانية وولادة لبنان الكبير
ولدَ جدي الشيخ علي أوائل القرن العشرين، عام 1907 حسب التذكرة، في جبل عامل، ضمن السلطنة العثمانية، في قرية «اليهودية» (التي غيّر أهاليها اسمها إلى «السلطانية» خلال ستينيات القرن الماضي). لم يولد ضريراً، فهو فقدَ نظرَه خلال الحرب العالمية الأولى عام 1914، عندما اجتاح مرض الرمد المنطقة وأصاب الناس بأعينها. لم يتعالج الكثيرون بسبب الإهمال وقلّة المعرفة، ففقدوا نظرهم، وجدي كان من بينهم. كان الشيخ خليل عبّاني، والد جدي، فلاحاً وأحد مشايخ «اليهودية». درس عند شيخٍ معروفٍ من قرية تبنين اسمه أحمد بري، زوّجه ابنته وأنجب منها خمسة أولاد.
عندما فقد جدي نظره وهو بعمر السبع سنوات، لم يعد له دورٌ في العمل العائلي للأرض. أرسله أهله إلى بيروت مع الذين كانوا ينزلون إلى المدينة للتسوّل، بما أنّه ضرير فيتصدّقون عليه. توّجه الكثير من فلاحي القرى إلى المدينة في تلك الفترة هرباً من الفقر المحدق وبحثاً عن فرص عملٍ أفضل، خصوصاً بعد أن أدخلتْ الدولة العثمانية زراعة التبغ في شبكة العلاقات الرأسمالية العالمية نهاية القرن التاسع عشر. إذ منحت احتكارها وشراءها لشركةٍ فرنسية: «الريجي»، لعدم امتلاكها رأسمالٍ كافٍ لتطوير حقول التبغ، ولمراقبة وحصر الإنتاج في أماكن معيّنة، ممّا أثّر على وضع الفلاحين عموماً في جبل عامل، والذين رضخوا لشروط الريجي وباعوا محاصيلهم بأسعار زهيدة. وبسبب أُميّتهم وعدم احترافهم لصنعةٍ ما، انتهى المطاف بالوافدين الجدد إلى ممارسة أعمال صغيرة وهامشية، كمسح الأحذية والعتالة وبيع الكعك والتسوّل على طرقات مدينةٍ لم تعرف دائماً كيف تستقبل زائريها الكثر.
على الأرجح وصل جدي بيروت بعد الحرب العالمية الأولى. لا يعرف أبي تفاصيل تلك السنين، فجدي لم يتكلّم عنها وأبي لم يسأله. لا أدري شيئاً عن إحساسه يوم أُرسِلَ إلى المدينة للتسوّل بعد أن فقد نظره وتخلّت عنه عائلته. كيف تعامل ولدٌ صغيرٌ ضريرٌ من الأرياف مع مدينةٍ كانت تشهد تحوّلاتٍ عميقةً من تمدّنٍ وتطوّرٍ معماري وسياسي وثقافي؛ مدينةٍ كانت تتخلى تدريجياً عن معارفها ومهاراتها المحلية تحت وطأة التوسع الاستعماري والانفتاح على العالم. هل انبهر بأصوات المدينة العصرية وسرعة الحياة فيها، أم حنّ إلى هدوء القرية ورتابة الحياة هناك؟ هل بكى مصيره وتعبَ من التسوّل على الطرقات ورغبَ بالعودة إلى بيته لكنّ العودة كانت محالة؟
تعرّف جدّي بعد سنوات على جمعيةٍ مسيحيةٍ للمكفوفين، بقي لسنين معهم. أخذوه إلى المدرسة الإنجيلية للمكفوفين، أو «مدرسة الإنكليز» (حيث مبنى مدرسة الليسيه عبد القادر) في حي زقاق البلاط في بيروت، والتي كانت مجّانية. تأسست مدرسة المكفوفين عام 1868، وكانت تُعلِّم المكفوفين وتدرّبهم على مهن مختلفة. كانت المدرسة تضم عدة صفوفٍ ابتدائية، حيث يتم تعليم الطلاب قراءة وكتابة طريقة البرايل العربية والإنكليزية، إلى جانب الحساب والتاريخ والجغرافيا والدين. يتابع الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن اثني عشر عاماً ورش عملٍ خلال فترة بعد الظهر لتعلّم تقشيش وإصلاح الكراسي والسلل، بينما يُسمح للطلاب الأصغر سناً بحضور ورشة عمل واحدة مرةً في الأسبوع، ويُمضون باقي الوقت في غرفة الترفيه حيث يوجد ألغاز وألعاب كالدومينو، كما يتوفّر راديو وبيانو وآلة الكمنجة للتدريب على الموسيقى.
*****
رغم المسار الأوحد الذي كانت تعطيه هذه المدرسة للمكفوفين، عبر تعليمهم مهارات تؤهلهم للانخراط في سوق عملٍ ذي أجر متدنٍّ، صقلت هذه المدرسة شخصية جدي ونمّت مواهبه، وأعطته فرصةً لبناء حياةٍ لم يجدها في محيطه وضمن عائلته. تعلّمَ قراءة البرايل لفترة، ولكنّه لم يمارسها. كما تعلم تقشيش الكراسي، وهي صنعةٌ مارسها طوال حياته. ومن أهم ما تعرّفَ عليه هناك هو التعليم الديني الإنجيلي، الذي استهواه وطبع شخصيته وتأثّر به لدرجة اعتناقه الدين المسيحي. كان عمره آنذاك بين التاسعة عشرة والعشرين سنة. جنّ جنون العائلة وأهالي القرية، فكيف لابن الشيخ خليل الشيعي أن يصبح مسيحياً بروتستانتياً!
ضغطوا عليه لـ«يرتد» أخيراً عن ديانته الجديدة و«يرجع متوالي». غالباً ما كانت نكتة العائلة عن مدى تأثّر حياتنا ونشأتنا في ضاحية بيروت الجنوبية لو بقي جدي على بروتستانيته. ولكنّ أكثر ما يشغلني اليوم هو العودة إليه لفهم أسباب تأثّره بالإرسالية البروتستانتية، وخياره باعتناق دينٍ آخر والعودة عن هذا الخيار في النهاية. هل وجد ضالتّه هناك؟ وما الذي جذبه إلى هذه الديانة ولم يجده في محيطه؟ هل عاد واقتنع «بشيعيّته» أم خضع للأمر الواقع؟ وهل مارس أيّاً من هاتين الديانتين أصلاً؟
أمّا على الهوية، فقد كان جدي علي سنّياً. خلال إحصاء عام 1932، والذي يعدّ من أسس بناء الدولة في لبنان الحديث والقاعدة التي بُني عليها تسجيل السكان وتشريع المواطنية خلال فترة الانتداب الفرنسي، وصلت لجنة الإحصاء بيت جدي في بيروت، وسألته «إنت شو؟». قال لهم بكل ببساطة: «أنا مسلم»، وسجلّوه كمسلم، ما يعني آنذاك مسلماً سنّياً، وليس شيعياً. لم يكن يعرف جدي ذلك، وعلى الأرجح لم يكترث أحدٌ من لجنة الإحصاء بالتأكّد، خصوصاً أنّ نتائج الإحصاء خضعت لإخفاقاتٍ بيروقراطيةٍ عديدة، وكانت مُسيّسةً إلى حدٍّ كبير.
اكتشف ذلك مع والدي لاحقاً. كانت سنة انتخابات، ربما عام 1968. يومها لم يجد أبي أسماءهم في قلم الاقتراع الشيعي، وبحث عنه ليجده في قلم السنّة. لم يكترث أبي لذلك، بإعتبار أنّه كان يومها «يسارياً لا يأبه بالطوائف!»، لكن عندما أراد أبي الزواج بأمي الشيعية بعدها بسنوات، رفض والداها بعد أن عرفا أن أبي سنّيٌّ على الأوراق، رغم أنّهما من القرية ذاتها، وطلبا منه تغيير مذهبه. اضطر والدي إلى الرضوخ وذهب إلى المحكمة الجعفرية لإصلاح الخطأ. لكّن الشيخ هناك رفض، فوالدي كان موظف دولة، واتّهمه الشيخ بأنّه يريد أن يأخذ منصباً شيعياً لزيادة عدد الموظفين السنة. بعد إصرار أبي بأنّه شيعي أباً عن جد، طلب منه الشيخ إحضار أبيه الشيعي، الذي كان قد مات حينها، فاقترح أبي إحضار والدته وعمّه. قبِل الشيخ، واستعاد أبي «شيعيّته»، لكّننا إلى اليوم ما يزال إخراج قيدنا الشيعي عند السنّة! تُسلّيني خيارات وهفوات جدي التي بقيت موجودةً بعد أكثر من نصف قرنٍ على موته في هذه المدينة والمجتمع السُرياليّين، وتلفتني تحولات الدول الحديثة، حيث تساهم في تحديد هويتك ورقةُ سجلٍ وليس فقط الممارسة الحياتية.
يوم أصبح جدي ابن المدينة
كان جدي قد أصبح في الأربعين من عمره حين ولدَ أبي، بضع سنينٍ بعد الاستقلال، عام 1947، وهو الصغير لأختين. رغم فقره، أصّر على تعليم أبي وأختيه اللتين حصلتا على السرتفيكا (شهادة انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي)، ممّا كان يُعدّ إنجازاً بالنسبة لمكانته الإجتماعية. كان جدي يعمل حينها في تقشيش الكراسي. وعلى الأرجح، خلال تلك الفترة، دبّر له الإقطاعي الشيعي أحمد عبد اللطيف الأسعد عملاً في شركة الريجي في بيروت، والتي كانت توظف المكفوفين لفصل أوراق السجائر، إلى جانب استعانتها بالعديد من فلاحي الأرياف الذين ساهمت أصلاً في إفقارهم ودفعهم للهروب إلى المدينة. واستمر جدي بالعمل هناك طيلة حياته.
لا أعرف الكثير عن ظروف عمله، لكن بالطبع لم يكن العمل في الريجي سهلاً، نظراً لاستغلال وهشاشة العمّال في القطاع الصناعي عموماً، وظروف العمل الرديئة والمفتقرة للخدمات الأساسية والمعدات في المصانع. يخبرني أبي أنّ جدي قدّم يوماً استقالته، لا يذكر تحديداً لماذا، وأخذ تعويضه الذي كان لا يكفيه لأكثر من شهر. علَت صرخةُ العائلة التي ناشدت أحمد الأسعد من جديد لإرجاعه. عاد جدي وأرجَع التعويض.
رغم تخلّي جدي عن اعتناقه للديانة الإنجيلية، إلا أنّه حافظَ على نشاطاته مع جمعية المكفوفين المسيحية التي كان مركزها في كنيسةٍ قرب الجامعة اليسوعية في الأشرفية في شارع مونو، حيث كانوا يجتمعون دائماً. خلال انتخابات رئاسة الجمعية، كانوا يختارون جدي رئيساً لساعتين أو ثلاثة، وذلك حتى انتهاء الإنتخابات، بما أنّه المسلم الوحيد، ليرجع بعدها لكونه الشيخ علي.
كان والدي يرافقه أحياناً إلى جمعية المكفوفين ليوصله، لكن بالواقع، جدي هو الذي كان يجرّ أبي من منطقة المصيطبة إلى اليسوعية، ويرشده إلى الطريق التي يجب أن يتّبعها: «فوت من هون وطلاع من هناك»، كان يقول له طوال الطريق. إذ كان «يرى» تماماً أزقة المدينة التي يمشي فيها بكل ثقة حاملاً عصاه الخشبية. وعندما كان يذهب إلى معمل الريجي في مار مخايل، كان يستقلّ الترام من البسطة إلى الدورة، وينتظره والدي أحياناً عند عودته أمام الترام إنْ لم يكن في المدرسة. لكنه لم يكن بحاجة فعلاً إليه، فهو كان يتميّز بالذكاء وببصيرته القوية، مدركاً تماماً كيف يتنقل وحده في بيروت التي أصبحت مدينته.
فهذه المدينة سحبته من بيئته، وكانت قاسيةً عليه. لكنّها، كباقي المدن، أتاحت له التعرف على عوالم مختلفة، مما جعل أفكاره السياسية منفتحةً نسبياً. تعرّف جدي على الصحافي خليل نعّوس (1935-1986)، القيادي في الحزب الشيوعي في لبنان، والذي كان جاره وتأثّر بصحبته. كان جدي ثورياً بطبعه، فهو قد عانى من فقدان نظره وظروفه الإجتماعية في منزل أهله أولاً، ثم في بيروت وفي الريجي. لم يلتزم أو ينتسب إلى الحزب الشيوعي، لكن آراءه وأفكاره كانت متأثرةً بالتغيرات الاجتماعية والعمّالية في المدينة. فهو قد عاشر تلك الأفكار، إذ إن أغلب تحركات الأحزاب خلال تلك الفترة كانت في معامل الريجي وغندور، حيث العمال. حسب والدي، كانت لدى جدي ميولٌ يساريةٌ واشتراكية «جيدة» بالنسبة لشخصه وبيئته ووضعه العام. لم يتكلّم مع والدي عن أفكاره، ولكنّه كان متقبّلاً لتوجّهات أبي اليسارية آنذاك. وعندما كبر أبي وبدأ بالمشاركة بالنشاطات السياسية، لم يمانع جدي. كان أبي يكلّمه عن الدولة والاشتراكية ولينين، وجدي يتقبّل أفكاره. كما تعرّفَ على أغلب رفاق والدي، إذ كان يحبّ دائماً أن يجالسهم ويناقشهم ويتدخّل في شؤونهم.

*****
لم أعرف أنا جدي، فهو قد مات قبل أن أولد بسنواتٍ عديدة. كان ما يزال يعمل بالريجي ووالدي قد بدأ العمل في التدريس. كلُّ رجال العائلة ماتوا بأمراض القلب، أعمام أبي ووالده، وعانى جدي فترةً قبل مماته. عندما كان أبي بالبريفيه، عام 1964، أُصيب جدي بأول سكتةٍ قلبية، نُقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد، حيث تعالجَ وخرج. أصبح مريض قلب. كان جدي يعرف أنّه مريض، ويخاف على نفسه، وغالباً ما كان يقول لستي: «عم يوجعني قلبي، عمليلي كباية نعنع».
عام 1971، نهار جمعة، كان أبي قد تعيّنَ حديثاً في التعليم الثانوي، وكان ما يزال يتردد على كلية التربية. وهو عائدٌ من كافيتيريا الجامعة، وجد جدي في المنزل متعباً. طلب منه أن يأخذه إلى المستشفى. ما إن وصلا، أُدخل جدي إلى غرفة الطوارئ.. دقائق وخرج الطبيب وقال لأبي: «العوض بسلامتك، ذبحة قوية». إلى اليوم، يلوم والدي نفسه، فهو لم يأخذه بسيارة إسعاف. لم يكن لديه سيارة، استقلّ سيارة أجرة أوصلتهم باب المستشفى، حيث مشيا إلى داخل العيادة. لم يكن لوالدي التجربة أو المعرفة عن كيف يجب نقله وبمن يجب الاتصال. كان عمر جدي 63 سنة، مات قبل عامٍ من تقاعده.
عن جدي والموسيقا والراديو
من أكثر الأمور التي تثير فضولي هي تفاعل جدي الثقافي مع المدينة وتشكيل ذائقته وخياراته الموسيقية، فهو قد أصبح ابن المدينة، يمشي على وقعها ويتفاعل مع ثقافتها. كان جدي يعشق عبد الوهاب، هو من «مناصريه»، يُسمعهم عبد الوهاب دائماً في البيت، ويكره أم كلثوم. يحب أن يسمع «أنا والعذاب وهواه» و«يا وابور قولي رايح على فين»… وأسمهان أيضاً. ولكن كالعديد من أبناء جيله، أكثر ما كان يهواه، هو سماع الأغاني اللبنانية الشعبية «البلدي»، مثل إيليا بيضا وأوديت كعدو. «ينتظر برنامج الأغاني البلدية حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر»، يقول لي أبي.
أركض الى أرشيف الإذاعة الذي أعمل عليه بحثاً عن البرنامج، أصحّح معلومات أبي، على الأغلب كانت الأغاني البلدية تذاع ما بين السادسة والسابعة. يسعدني هذا اللقاء ما بين عملي وجدي، أحسّ بأنّه يقرّبني منه ويجعل من عملي أكثر حميميّةً. أسأل أبي عن الراديو والموسيقى، أفرح بأن جدي كان يعزف وينطرب وينفعل، ممّا يفسّر لي الكثير عنه وعن شخصيّته التي كانت جامدةً في ذاكرتي، ومتعلقةً فقط بصورةٍ شمسيةٍ وحيدةٍ بالأسود والأبيض لرجلٍ عجوزٍ مطفأ العينين. يخبرني أبي أنّه تعلّم مع جمعية المكفوفين العزفَ على آلة الكمنجة، واشترى آلةً له ليعزف عليها في المنزل، لكنّه عقب فورة غضبٍ كسّرها مرةً على الطاولة بعد أن «تقاتل» مع جدتي. لا يذكر أبي لماذا اختلفا، ربما على موضوع أكلةٍ ما أو لسببٍ آخر. كسّر الكمنجة ولم يشترِ غيرها ولم يعزف مجدداً.

يذكر والدي بيته وهو صغير والراديو موجودٌ فيه رغم تواضع المنزل والعائلة. جدي هناك، يسمع أخبار إذاعة لندن وصوت العرب. يحب عبد الناصر كثيراً، يضع الراديو دائماً جنب رأسه على «الكوموندينا»، يسمع موسيقى ويدخن. كان يدخن بشراهة. يستمع للراديو وهو جالسٌ على السرير، ملقياً رأسه على الحائط، أو يشتغل بتقشيش الكراسي في البيت. علّم جدتي تقشيش الكراسي، أمّا أبي فقد علّمه فقط كيف يُركِّب ظهر الكرسي ومقعده عندما ينتهي.
هذا الراديو هو نفسه الراديو القديم الذي عرفته أنا لاحقاً في بيت أبي، والذي كانت تكرهه أمي. لا تحب أمي أي شيءٍ قديم «يكركب لها المنزل»، فكانت لا تترك فرصةً للتذمر من وجوده ومحاولة التخلص منه. تمكّنتْ لسنواتٍ من إخفائه في العليّة، إلى أن «راح مع ما راح» في بيتنا في بئر العبد خلال حرب تموز 2006. كنت أحزن كثيراً على هذا الراديو، وعلى العديد من الأغراض الشخصية والصور التي فقدناها هناك. ولكن اليوم وأنا أتنقل بين مدينةٍ وأخرى ومنازل عدة، لم أعد أعبأ فعلاً بما حلّ بها، فالخسارة مستمرة، وهناك شعورٌ بالارتياح في القدرة على التخلي عن الأشياء. التخلي يُسهّل الرحيل. لا صور أحملها معي ولا أغراض أَتعلّقُ بها. لدي بناتي وبعض الحاجيات، آخذهن معي أينما تنقّلت، أغادر منزلاً تلو الآخر وأغلق الباب من خلفي. على عكس أهلي الذين رغم التهجير المتكرر الذي طالهم خلال سني الحرب وفيما بعد ـ أو بسببه ـ كانت فكرة المغادرة مستحيلة، ووجود منزل ثابت لهم من أساسيات الحياة.
جدي أيضاً، منذ أن غادر قريته، لم يتنقّل كثيراً في بيروت، ولم يسكن مجدداً في الجنوب. فهو لم يرث في قرية السلطانية أياً من أراضي العائلة، فكان ارتباط عائلة أبي بقرية جدتي لا بقرية جدي، وذلك حتى عام 1964. يومها، كان لجدي ابنة عمٍّ عطفت عليه وأعطته قطعة أرضٍ صغيرةٍ في السلطانية لا تصلح لشيء، وقالت له: «إذا فيك تعمّر بيت فيها عمّر». بنى عليها جدي غرفةً صغيرة، أرجعته إلى قريته في زياراتٍ سريعة خلال العطل، وسمحت لأبي أن يصبح من زوّار القرية الدائمين، ويعيد علاقة الأسرة بالقرية. ورث أبي هذا البيت وأضاف إليه طابقاً لاحقاً، ليصبح هذا المنزل منزل أهلي الذي أمضينا فيه عطلنا الصيفية والمدرسية، وتململنا من صغره وشكله الغريب وموقعه البشع والمزعج في وسط الطريق.
أمّا في بيروت، وكالعديد من الشيعة الذي نزحوا إلى المدينة خلال عشرينيات القرن الماضي، سكن جدي في منطقة المصيطبة، على أبواب المدينة القديمة، بينما استقبلت الضواحي الأبعد الأجيال اللاحقة. سكن أولاً في بيتٍ في حي آل المناصفي في المصيطبة، ومن ثمّ انتقل إلى بيتٍ في حي اللجا بالقرب من خالَتَي والدي اللتين ساعدتا جدتي على تربية والدي وأختيه، فجدتي كانت عمياء أيضاً.
ستّي ماريا شعيب وصمت النساء في ذاكرة الأُسر
ستي ماريا من جبل عامل أيضاً، من قرية الشرقية. كجدي، لم تولد ضريرة، لكن وهي بعمر العشر سنوات كانت تعمل بحراثة الأرض خلف بقرة، رفستها على أعينها وأفقدتها نظرها. وبما أنّ جدي وجدتي لا يريان منذ الصغر، كان من الصعب أن يتزوجا زيجةً تقليدية، فقرّرت عائلتيهما البحث عن شريكٍ ضريرٍ لهما، وهكذا تمّ تزويجهما. طبعاً لم يكن وقتها السؤال مطروحاً عن مدى قدرتهما على تسيير أمورهما وتربية الأولاد.
رغم فقدان نظرها، أو بسببه، كانت جدتي مدبرةً تماماً لأمور العائلة والمنزل. تصعد على سطح المنزل المكشوف وغير المحمي، تستعين بسلّمٍ خشبي لتصل إلى العلية ومن ثم بسلمٍ آخر للصعود إلى السطح ونشر الغسيل على الحبال دون مساعدة أحد. كانت ماهرةً بالطبخ، ومغدقةً أولادها بالحب والدلال. تتنقّل بحرية في الحي عند أختيها ودكانة الحي وبعض الأقرباء، ولكنّها لا تخرج بعيداً.
هكذا وصفها أبي لي. لا قصص كثيرة عنها كجدي، فقط عن مدى طيبتها وبساطتها وإيمانها الكبير، فهي كانت تقضي وقتها بالصلاة، ومع ذلك كانت متقبلةً لابتعاد أبي عن تعاليم الدين. تُحزنني ندرة قصصها، فلا ذكريات محددّة عنها في ذاكرة أبي. كالعديد من النساء، لا تفاصيل عن يوميّاتها ونضالها الشخصي في مدينةٍ كانت أيضاً جديدةً بالنسبة لها، مدينة لا تعرفها ولا تراها، لكن قد تشعر بنبض الأحياء التي تجول بها وتسمع بعضاً من ضوضائها. حنان وطبخ وإيمان، ثلاث كلماتٍ تختصر ستّي. حتى أمي عندما سألتها عنها، أجابتني: «كانت امرأةً جنوبيةً تقليديةً معترة وبسيطة».
لم أعرف جدتي أيضاً، فهي ماتت عام 1976. كانت يومها مع والدي في القرية هاربةً من الحرب في بيروت منذ 1975. انتابها وجعٌ شديد، لكنّها، كأغلب النساء، لم تشتكِ وتحمّلت الآلام طويلاً، إلى أن أخذها والدي الى مستشفى تبنين المجاور، حيث أخبره الطبيب أنّ لديها تشمّعاً بالكبد. لم يعرف أبي ما هو تشمّع الكبد، ويذكر كيف فُسّر له إنّه سرطانٌ بالكبد. لا أدوية لمرضها آنذاك، فقط بعضاً من المسكنات لتخفيف الأوجاع والآلام. عندما أصبح الوجع لا يحتمل، أخذها والدي إلى قريتها الشرقية، ليعاينها دكتور تخرّج من فرنسا، لكّنها كانت تنازع وتحتضر. هي كانت تعلم ذلك، وحاولت إخفاء الأمر عن أبي. لم تصمد طويلاً، وماتت بصمت. أرادت عائلتها دفنها في الشرقية، ولكن والدي أصرّ أن يدفنها إلى جانب جدي في السلطانية. يحزن اليوم لدفنها هناك بعيداً عن عائلتها وقريتها الشرقية.
أحاول الحفر عميقاً في ذاكرته بحثاً عن قصصها وتفاصيل شكلها، لكّن القليل بقي من ذكراها، فكل قصصها مرتبطة إمّا بأخبار جدي أو بأخبار أبي. يخبرني والدي كيف تشاجر جدي معها مرة و«حرد»، فأحضر زجاجة نبيذ وشربها في المنزل. «فش خلقه»، أحضر ما طاب له من أكلٍ وشرب، وهي بقيت صامتةً، لم تقل له شيئاً. أو يقصّ لي كيف أعطته حصّتها الصغيرة من ميراث جدي البسيط من كثرة عطفها وطيبتها.
هي أيضاً كانت من عائلةٍ فقيرة، لها أخٌ من الأب، أخذه العثمانيون وذهب إلى «السفر برلك» ولم يعد. ولها إخوةٌ من أبٍ آخر، بعد أن تزوجت أمّهما من جديد وانتقلت إلى بيروت. كحال جدي، لم تنصفهم العائلة في الميراث، وبقي خال أبي في الشرقية. لا أعرف عائلة جدتي كثيراً، بالكاد أذكر بعض اللمحات عن الأوقات التي كان أبي يأخذنا إلى الشرقية لزيارة خاله وأولاده. كان خال أبي فلاحاً علّمَ أولاده جميعاً، وكلّهم اشتغلوا معه في زراعة الدخان، حتى أبي، الذي كان يمضي أوقاتاً طويلةً عنده خلال العطل المدرسية.
خال أبي هو الصلة الثالثة في ذاكرة أبي بجدتي. متى ذكرها، كان يخبرني عن عائلتها في الشرقية، وتحديداً عن منزل خاله حيث تربى. خال أبي هو والد الشهيد علي شعيب، بطل عملية الإستيلاء على «بنك أوف أميركا» عام 1973، حيث احتلّ مع ِثلاثة فدائيين المبنى احتجاجاً على تمويل المصارف الأميركية لإسرائيل في حربها على سوريا ومصر، قبل أن تقتله قوى الأمن الداخلي اللبناني بطلبٍ من الأميركيين. لطالما حدّثنا أبي بفخرٍ ورومانسية عن ابن خاله علي شعيب. وكما يكتب عباس بيضون في قصيدته يا علي، التي كتبها له بعد مقتله وغناها مرسيل خليفة، بقي أبي «يروي سيرة» هذا الشاب الشاعر ابن الفلاح، والذي تعلّم في القرية ومن ثمّ دخل دار المعلمين في بيروت.
يخبرني كيف كان يلتقي بوالدي وصديقَين آخرَين لهما في قرية الشرقية ويتكلّمون عن السياسة. بالنسبة لأبي، كان علي أكثر تطرّفاً بآرائه، وتخطى منظمة العمل الشيوعي ولبنان الإشتراكي، ليشكل تنظيم الحركة الثورية الاشتراكية اللبنانية مع شابّين آخرَين، بهدف محاربة الرأسمالية والإقطاع السياسي والديني. يروي أبي كيف ابتعد علي تدريجياً عن والدي وأصدقائه فكرياً، وصار العنف الثوري بالنسبة له هو الحل، ومارسه، ليصبح بالنسبة للعائلة شهيد الحركة المطلبية وشهيد الثورة الفلسطينية.
وبينما يتكلّم أبي عنه وعن الفئات المهمّشة في الجنوب وبيروت ومحاربة الإقطاع والرأسمالية، أحزن كيف ينتهي أي حديثٍ عن ستي بالتكلّم عن رجال العائلة والحنين إلى زمنٍ مفقود. كم كنت أتمنى أن أعرفها وأتحدث معها، أسألها عن حياتها آنذاك؛ علّها تخبرني هي قصصاً عنها وعمّا واجهته في القرية وبيروت، وعن صعوبة العيش في مجتمعاتٍ قاسية، وتشاركني قصصاً ترويها النساء فقط عن حياتهنّ، وعن رجال العائلة وتاريخهم. لكنّ كل ما لدي هو ذكريات والدي، وسيلتي الوحيدة للعبور نحوها ونحو جدي، يقصّها لي عبر الإنترنت على «الزووم»، تجلس بجانبه والدتي، تستمع لنا هي أيضاً بصمت، تشارك أحياناً بعض القصص التي تتذكّرها، وأنا في مدينةٍ أخرى أحاول التقاط النفرات من هنا وهناك.
الجيل الثاني والأفكار «اليسارية العربية»
لم يشعر أبي يوماً بالاختلاف كون والديه ضريرين، نظراً لقوة شخصية جدي وتدبير ستي. أكثر ما كان يزعجه هو كلام الناس حين يعلّقون قائلين: «انظروا إلى هذا الولد الشاطر، رغم أنّ أهله ضريرون»، أو يتساءلون إن كان هو يرى أم لا. يكنّ أبي احتراماً كبيراً لوالده، ويقدره على وعيه. فبالنسبة له، هو تربية «جيل تعتير» كما يقول، حاول أن يبني لنفسه عائلة، ولم يرضَ أن يترك والدي المدرسة. العديد من جيل أبي كانوا يبيعون الخبز، فأهل السلطانية كانوا معروفين ببيع الخبز في بيروت، لكنّ والدي لم يشتغل بذلك. أصّر جدي على تعليمه في مدرسةٍ خاصة.
بدأ والدي علمه في مدرسة الشيخ علي حوماني. لم يكن هناك مدرسة رسمية قريبة في أحياء الشيعة، فأقرب مدرسة، المدرسة العسكرية، كانوا يعتبرونها سيئة. كان الشيخ علي حوماني سيئاً أيضاً ويطلب منهم فرنك يومياً. عام 1957، وهو بعمر العشر سنوات، علِم والدي أنّ مدرسةً رسميةً جديدةً فتحت أبوابها في المصيطبة، اسمها مدرسة الغول. ذهب لوحده، وتسجّل بالصف الخامس، ومن ثم أخبر والده. وقعت خلال تلك السنة حرب 1958، وتوقفت الدراسة لثلاثة أشهر، ممّا أجبرهم على إجراء امتحانات السرتفيكا متأخرين، خلال شهر كانون الأول (يناير).

بعدها، تعلّم أبي في مدرسة رمل الظريف الرسمية المفتوحة حديثاً آنذاك. لكنّها كانت سيئةً جداً؛ لا كراسي ولا طاولات أو طبشور. كل تلميذ يحضر معه كرسيه. لم يتعلم والدي شيئاً خلال تلك السنة، وأمضى وقته يلعب في الخارج. توّجه جدي حينها إلى أحد أقاربه كان يعمل عند عائلة بيضون الذين أسّسوا الكلية العاملية (نسبةً لجبل عامل) برأس النبع، والتي كانت أول مدرسة تهدف لتعليم الشيعة في بيروت، وطلب منه تسجيل والدي فيها.
دخل أبي مدرسة العاملية عام 1960، وهناك تحوّل تماماً من تلميذٍ غير مكترث بالدراسة والتعليم إلى تلميذٍ مجتهد. وكالعديد من الشيعة الذين تعلّموا في العاملية، بدأ وعيه السياسي فيها، حين قابل مع زملائه وضّاح شرارة، أستاذ اللغة الفرنسية الذي شدّهم إلى لبنان الإشتراكي، حيث تعرفوا على أحمد بيضون وفواز طرابلسي وحسن قبيسي؛ مفكري لبنان الإشتراكي ومن ثمّ منظمة العمل الشيوعي.
لم يكن غريباً انتساب والدي إلى تلك الأوساط، فالعنصر الجنوبي الشيعي كان طاغياً في تلك المجموعات، وظروفهم المادية والاجتماعية سهّلت انجذابهم إلى تلك الأفكار. وقد عرفت المدينة بعد الاستقلال نمواً صناعياً، خصوصاً بعد إقفال قناة السويس عقب حرب حزيران (يونيو) 1967 وانفتاح أسواق الخليج على السلع اللبنانية، فتزايدت الطبقة العاملة المدنيّة المأجورة، ونادت العديد من الشرائح بالتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والطبقي، خصوصاً بعد فشل المشروع الشهابي (1958ـ1964) بإصلاح النظام اللبناني الطائفي على أساس المساواة.
بعد المدرسة، دخل أبي عام 1967 إلى كلية التربية- قسم الرياضيات، والتي كانت قد تأسّست قبل سنةٍ فقط. كبر هناك انخراطُ أبي السياسي، فكليّة الحقوق والعلوم والتربية شكلت معاقل النشاطات السياسية اليسارية في الأوساط الطلابية، خصوصاً كلية التربية التي استقطبت العديد من الفقراء الذين حصلوا مثل والدي على منح (قدرها 200 ليرة) ناهزت معاش جدي العمّالي الذي كان لا يتعدى 300 ليرة. يتكلّم أبي بحنين عن ذلك «العصر الذهبي» لكلية التربية، حيث خرّجت خلال أول عشر سنوات من تأسيسها «أهم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذي انبنى عليهم التعليم الحديث»، يبتسم بحزن ويضيف «كلّهم أو أغلبهم اليوم متقاعدون أو ماتوا».
كالعديد من يساريي تلك الفترة، رفع أبي شعاراتٍ عديدة، كالحرية والمساواة والصراع الطبقي والقومية العربية، والتي لم تتعدى كونها خطاباً سياسياً مجرداً لا فعلاً اجتماعياً مارسوه في حياتهم اليومية والشخصية. شارك أبي في الخلايا العمّالية التي كانت تهدف إلى تنظيم الكتل العمّالية المتزايدة وتعريف العمّال، كوالده، بحقوقهم وآليات تنظيمهم، وذلك ضمن مشروعهم الثوري العام للتحويل الراديكالي للمجتمع اللبناني. رغم بحثهم عن أطر فكرية وتنظيمية جديدة وتأثّرهم بالفكر الماركسي ورغبتهم بتحويل المطالب العمّالية إلى مشروع سياسي يهدف الى تشكيل هويّات جماعيّة جديدة، لم يخرجوا من قيم الأحزاب القومية التقليدية، التي ارتكزت على تمجيد الزعيم والعسكر والعائلة والأدوار النمطية لكل فردٍ من أفرادها. أعطوا الأولوية للإصلاحات السياسية على حساب الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ولم يناقشوا فعلياً موضوع تحرير المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فاصطدموا بالستاتيكو والبنية السياسية الأبوية للنظام، المبنية على العلاقة العضوية بين الدولة وأصحاب العمل ورأس المال والنقابات التقليدية، والتي أنتجت حملاتٍ قمعية ضد مظاهرات وإضرابات العمال والطلاب والمدرسين في النصف الأول من السبعينيات. بأي حال، لم يدم نشاط أبي السياسي طويلاً، وسرعان ما ترك المنظمة بعد نشوب الحرب وانزلاق المنظمة الطائفي، إلى جانب مسؤولية العائلة التي كانت تكبر. لم يبقَ اليوم الكثير من هذا الماضي أو تلك الأفكار، تغيرت المدينة من جديد وانشغل العديد من سكّانها بهموم الحرب اليومية، ومن بعدها بوهم إعادة بنائها. لكن بقي إرث تجاربهم حملاً ثقيلاً عليهم وعلينا لزمنٍ ليس ببعيد.
البحث عن معنى
أمضى والدي حياته في التعليم الرسمي والخاص، وتقاعد منذ بضع سنوات. عاش وبنى أسرةً له في بئر العبد في الضاحية، حيث نأى بنفسه عن التغيير التدريجي لكافة الأوجه فيها، منذ صعود حزب الله ومقاومته وسيطرته على المنطقة بالتوازي مع التغيير النيوليبرالي العام في المدينة ومجتمعها. ونحن، أحفاد جدي وجدتي، نشأنا هناك، لكن بين عوالم مختلفة: ما بين بيروت والضاحية، ما بين الجنوب وبيروت، ما بين رواسب اليسار والتقاليد، ما بين المقاومة ورفض سيطرة الحزب على المنطقة، ما بين الطبقة الوسطى وفاحشي الثراء. هنا وهناك… لا هنا ولا هناك.
لطالما اعتبر والدي أن التعليم والوظيفة هما المفتاح الذي مكّنَ جدي من الصعود الطبقي والخروج من الفقر. سنين مضت، ابتلعنا التوليف النيوليبرالي والخطابات القومية، وسقطت هالة المقاومة. لم يعد من معنى لتلك الوظيفة بعد الانهيار المالي، أو أي من تلك الخطابات والسرديات القومية أو الطائفية التي عرفتْها المدينة. وما زالت أماكن كثيرة، كحي اللجا والضاحية والجنوب، التي ارتبطت بذاكرة أسرتي، منمّطةً بشكلٍ كبير بالخطاب السائد عن أحزمة البؤس قديماً وبيئة حزب الله اليوم. البعض منه صحيح والكثير مبالغٌ فيه.
لا أعرف إن كان أبي يعي ذلك فعلاً، لكن ها أنا اليوم، والعديد مثلي، حلمنا بمدينةٍ لنا تكسر أشباح الماضي وتاريخهم «اليساري» والحنين إليه؛ مدينة لا مكان فيها لسيطرة رأس المال وأحزابه مختلفة الأوجه وعمليات نهبهم المتراكمة، وإذ بنا نُسحق مجدداً فيها ونهرب الى منافٍ مختلفة. ورثنا الغبار من تاريخهم ولم نصنع عالماً أفضل لنا، هو عالمٌ لم يكن يوماً لنا، أو لهم. رغم ذلك ـ أو بسبب ذلك ـ تخلّصنا اليوم من إرثهم، ولم نعد نحمل تجاربهم على أكتافنا. نحاول فقط البحث عن معنىً جديد لحاضرنا، وعن ماضٍ لنا يمنحنا شعوراً بالانتماء والمعنى والاستمرارية في ظل الغربة والتشتت وسريالية البقاء.