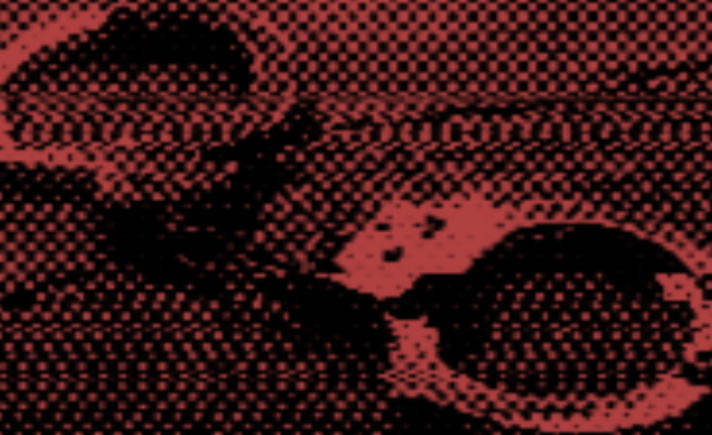منذ استشهاد عبد الباسط الساروت مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، درجت الأوساط المؤيدة للنظام وأجواء الممانعة في لبنان وفلسطين وغيرها من الدول العربية على استخدام «أيتام الساروت»، في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كنعتٍ لمؤيدي الثورة السورية ضد النظام الأسدي. وإذ لا يتوقع المرء عمقاً فكرياً ولا أخلاقياً من هكذا أجواء، تدعو هذه التسمية للتأمل فيها وفي أحوال المنعوتين بها، وأيضاً في أحوال مُطلِقيها.
يُفترَض أنَّ في إطلاق لقب «يتيم الساروت» على أحدهم نقيصةً له حسب منطق مطلقيه. لا نعلم هنا على ماذا يستند التعيير. هل يُعيَّر اليتيم بيتمه؟ في شتى الحضارات والثقافات البشرية، وعلى مرّ العصور، حُصِّنَ اليتيم وحقه ومشاعره بعناية فائقة في الأخلاق العامة والأعراف والتقاليد والأمثال والحكم الشعبية، إلى درجة لا يُتوقع معها أن يُشتق تعييرٌ ما باليتم، ولا حتى في أجواء ممانِعة. هل التعيير إذاً بشخص الساروت؟ ما هو المخجل في شخصية بطولية وتراجيدية كهذه؟ شقٌّ متذاكٍ من مطلقي التعيير قد يتحذلقُ بتلخيص كامل الشخصية وكامل سيرتها في انزلاقاتها الجهادية والطائفية، منزوعة عن سياقها وعن أثرها الحقيقي على الشخص وعلى محصلة أفعاله وسيرته. هذا غير أمين، ولكنّه أيضاً غير مفاجئ، بالذات ممن يتلفحون برايات جهادية تنضح بالكراهية الطائفية من العراق إلى سوريا فلبنان. أم أن التعيير يأتي احتفاءً بموت الساروت فحسب، بوصفه تجرّأَ على الثورة ضد النظام الأسدي، مُستحِقاً بذلك الموت، بغضّ النظر عمّا فعله أو قاله هنا أو هناك؟ في هذه الحالة، ليس «أيتام الساروت» نعتاً بقدر ما هو حسرةٌ على أن هؤلاء الأيتام ما يزالون على قيد الحياة.
يتوجب علينا الاعتراف بأن «أيتام الساروت» توصيفٌ لا يخلو من دقّة لوصف أهل الثورة السورية، على اختلاف مآلاتهم ومناطق تواجدهم في سوريا وخارجها اليوم. الساروت، بكل معانيه، وبكل تعقيدات سيرته، وبمآله ومآل أهله، تكثيف رمزي شديد البلاغة لاندلاع وسيرورة ومآل هذه الثورة. ونحن، «أيتام الساروت»، أيتامٌ فعلاً، إذ إن اليتم درجةٌ أبعد من الهزيمة. لم نعد مهزومين فحسب، بل أيتام، ذلك أن حالنا المتكسّر غير قابل للإصلاح ولا حتى بالقضاء التام والكامل على النظام السوري اليوم. الأجيال السورية التي حلمت بسوريا غير أسدية، وانحازت لهذا الحلم بالتمنّي أو القول أو الفعل، «تشرّكت» حيواتها بشكل لا عودة منه، ليس فقط لمقدار العنف المتواصل الذي شهدته، بل لأن حيواتها باتت مشروطة بشرط المجزرة. تهيمن المجزرة على كل تفاصيل أي تفكير عامٍ يمكن أن يفكروا به، وبات الهاجس الأكبر هو إنقاذ الأجيال اللاحقة مِن مركزية المجزرة. أكان بالابتعاد عنها جسدياً، أو بالسعي لعدم لفت انتباهها بالصمت. الحيطان لها آذان، حيث بقي هناك حيطان أصلاً. أهل الثورة السورية أيتام فعلاً، وقضيتهم اليوم ألّا يرثهم أيتام مثلهم. ألّا يعيش من يأتي بعدهم، جسدياً أو نفسياً، حبيسة أو حبيس حافة الحفرة التي رمى فيها أمجد يوسف ضحاياه في مجزرة التضامن.
لكن ما يخلو من دقّة هو توهّم مطلقي النعت المبتهجين بأنهم لا يعيشون، هم أنفسهم، على حافة الحفرة نفسها. هم أيضاً أيتام إلى حدٍّ كبير، وإن رفضوا الإقرار. يسكنهم وهمٌ بأن «الأبد» الأسدي يترك أيّ حيّز لمستقبلهم أو لمستقبل بناتهم وأبنائهم، ومع ذلك يعتبرون شعار هذا الأبد وعداً لهم، وكأنه يخصّهم. في حاضر هؤلاء المحتفلين بيَتمنا لا نجد أثراً لانتصارات «الأبد» التي يحتفون بها على صعيد معيشهم وكرامتهم وإنسانيتهم، بل إن كثيرين منهم لا يقلّون هشاشةً عن أي «يتيم ساروتي» إن أوقعهم حظّهم العاثر في طريق أمجد يوسف، أو سليمان هلال الأسد، مهما صرخوا «الله، سوريا، بشار وبس» خلال سقوطهم على الدواليب والأجساد المتكومة في حفرة حيّ التضامن.
يودّ المرء لو يستجمع ما تبقّى لديه من قوّة وصبر، لكي يتخيل نفسه محاولاً محاججة هؤلاء بأن فرصتهم الوحيدة للتخلّص ممّا هم فيه من يَتم هشّ هو بأن يصيروا أيتاماً بشكل كامل. أن يُقضى على أبيهم، «المُيتِّم العام»، وأن يُحطَّم بُنيان عالمه. عساهم هكذا يضطرون لأن يروا أن ثمة فسحة لنجاةِ من يأتي بعدهم من أجيالٍ من اليتم، وأنهم لذلك يحتاجون علاقة مختلفة مع الحياة والعالم، ومع الحق، ومع الكرامة، ومع الأبوّة والأمومة حتى. أن يكتشفوا صعوبة اليتم، وأن الوقاية من اليتم لا تكون عبر تيتيم آخرين.
والأهم، أن يتعلم من يأتي من بعدهم أن لا كرامة ولا عزّة ولا شجاعة في معاداة أيتام. سيما أيتام عبد الباسط الساروت، شاب شجاع قُتل على جبهات ريف حماة الشمالي في السابعة والعشرين من عمره منذ ثلاث سنوات، بعد أن قضى ثلث عمره وهو يشهد استباحة ثم حصار ثم تدمير بيته وحيّه وبلده، وتحطيم أهله بالتقتيل والتهجير.