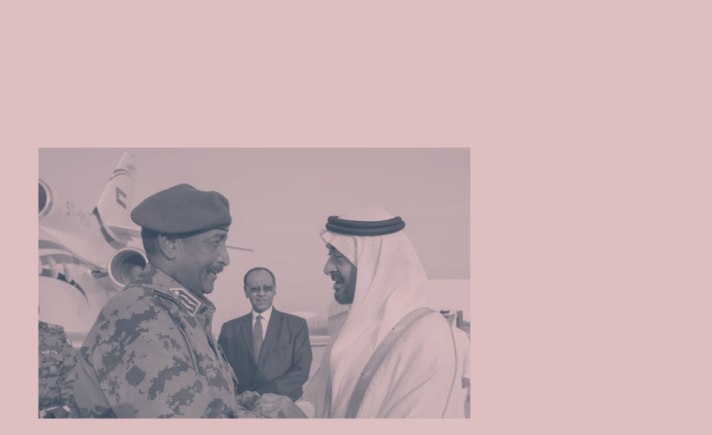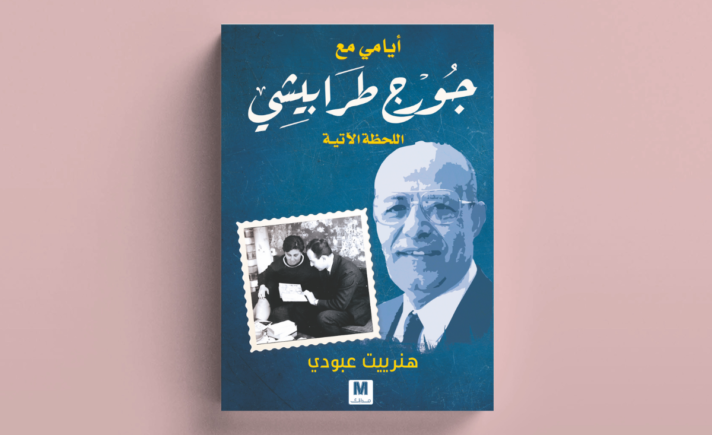تمر اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد الكاتب والمؤرخ والأكاديمي «اللبناني» سمير قصير، الذي قضى اغتيالاً في 2 حزيران (يونيو) 2005 بعبوةٍ ناسفة زُرعت أسفل سيارته.
تغيّرت البلاد التي قضى سمير في سبيل حريتها، وتحولت مصائر البشر فيها بعد ثورة عام 2011 في سوريا وتداعياتها وتأثيراتها على لبنان، ومشاركة خمينيّي هذا الأخير في قمع تلك الثورة، ثم انتفاضة مدنية في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وانهيار اقتصادي وتفكك مجتمعي وتغوّل لسلطة أوليغارشية تحكمت باللبنانيين وما تزال.
هذا المقال تحية إلى سمير في ذكراه، ومحاولة لنقد بعض ما قيل ويقال حول الاغتيالات في لبنان والمنطقة، ونقل قضية تصفيته من سماء التنظيرات العامة غير المحدِّدة لدى البعض، إلى أرض الواقع، حيث للجريمة مسبباتها وحيزها ودوافعها، ومن ورائها تقيم أنظمة وأجهزة ارتكبتها ولا تزال تمعن في الاغتيالات وآخرها اغتيال لقمان سليم.
كلام ممتاز وناقص
في كتاب صغير الحجم بعنوان المفكّر في مواجهة القبائل، يوجه المثقف البارز والسياسي الفرنسي ريجيس دوبريه رسالةً إلى سمير هي مضمون الكتاب الذي يقع في 60 صفحة، وصدرَ بعد استشهاده. الكتيّب يقول الكثير عن العلاقة بين المثقف والسلطة، وعن المثقف والخروج من وعن الجماعة.
يعود دوبريه إلى قضية دريفوس، الضابط اليهودي في الجيش الفرنسي الذي اتُّهم ظلماً بالتجسس لصالح الألمان في القرن التاسع عشر، وولادة مصطلح المثقف مع مقال إميل زولا إني أتهم وبيان المثقفين الذي نشره جورج كليمنصو صاحب يومية الفجر بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 1898، ثم تأثير البيان والمقال في قضية دريفوس وتعريتهما وإحراجهما السلطات العسكرية والسياسية والدينية (الكنيسة) التي تواطأت في القضية. ومن دون أن ينسى الإشارة إلى دور كليمنصو نفسه في إنشاء دولة لبنان، يذهب إلى عقد مقارنة بين الناشر والسياسي الفرنسي صاحب «الفجر» وبين صاحب ومدير مجلة «لوريان أكسبريس»، سمير قصير، من حيث دور المثقف وفاعليته.
والحال أن سمير كان فعلاً ذا دورٍ كبير كمثقف وكمناضل سياسي، تشهد على ذلك الطريقة الوحشية التي تمت تصفيته بها بهدف إسكاته. وهو كان في مواجهة على أكثر من جبهة، وعلى رأسها مواجهته المفتوحة مع النظام السوري وشراذمه في لبنان حتى بعد انسحاب هذا النظام، شكلياً، من ذلك البلد في نيسان (أبريل) 2005، إلى جانب معارضته لسياسات ولغة كثيرين من «حلفائه» السياسيين في جبهة 14 آذار، حين دعا إلى انتفاضة في الانتفاضة بعد عودة زعماء وقيادات الحركة إلى مواضعهم الأولى، مُديرين ظهورهم لكل الدعوات إلى تحالفات وطنية تحمي مكتسبات تلك الحركة الاستقلالية.
نكوصُ وتراجُع هؤلاء إلى مواقعهم «الطبيعية»، الطائفية والعائلية والإقطاعية، جعل سمير وأمثاله مكشوفين أمام آلة القتل، كما جعل المناخ مواتياً (أكثر) لهجمة أسديّة ضد فاعلين ومؤثرين في «انتفاضة الاستقلال»، وهي جدلية ليست جديدة من حيث التواطؤ المباشر أو غير المباشر للأهلي والعصبي أو لـ«نظام القرابة» باستعارة تعبير ياسين الحافظ، مع السلطة.
لا يهمل دوبريه دور نظام العصبيات وأهمية مواجهة المثقف له، فهو يفرد مساحاتٍ واسعة من كتابه للحديث عنه مستحضراً صديقه سمير. فـ«نحن لا نجرح رأياً بل نناقشه وننتقده، بينما نجرح معتقداً لأنه ملتصقٌ بلحمنا. وكما أن الخلافات في الرأي وتضارب المصالح تُسوّى بالاقتراع، فإن الحروب الدينية تحسم بالدم». ويتابع: «الرجل والمرأة اللذان لا يريدان الالتزام بأي مذهب أو طائفة أو عقيدة، يجدان نفسيهما في موقفِ منتهِك الحرمات، الخائن لقومه والحقيقة، وفي أفضل الحالات حالة الغافل وعديم المسؤولية، أما في أسوأها فحالة المرتد الذي تحدده النيات الخبيثة والمنحرفة».
هذا كله صحيح، لكنه ناقص.
صحيحٌ لأنه يحيل إلى إشكاليةٍ تحضر في نقاشات وكتابات عددٍ من المثقفين العرب حول الثقافي والسياسي؛ دور العصبية الذي لا يُفترض أن يقلَّل من شأنه أو أن يُغيّب لصالح شعاراتٍ نضاليةٍ تعِدنا بالسحر والخلاص بعد التغيير السياسي أو تردّ العصبي إلى النظام السياسي فقط. وهي نقاشاتٌ تنتشر، وإن بخجل حتى الآن، مع هزيمة الثورات العربية وخصوصاً السورية، وتقدُّم الثورات المضادة، ومع «ازدهار» التلويح بالطائفة والمذهب والدين والتقاليد والخصوصية والعرف الاجتماعي، في مواجهة الخارجين عنها أو المناضلين من أجل بدائل تُمأسس العلاقة مع الآخر المختلف في مؤسساتٍ حديثة.
لكنّ سميراً، والحال على ما هي عليه، لم يسقط بعبوةٍ زرعتها الطائفة أو الدين أو ألصقها العرف الاجتماعي بسيارته، بل قتله بشار الأسد، هذا مع العلم أن الطائفة والدين والعرف الاجتماعي والعائلة قتلت كثيرين أيضاً على مدى عقود وربما قرون سابقة وسوداء في تاريخ هذه المنطقة، وما تزال تفعل فعلها، ودمّرت حيوات أفراد كثيرين حاولوا الخروج منها وعليها، وهنا موضع النقص والنقص الفادح.
فإذا صحّ أنه لا يجوز إغفال دور انتماءاتٍ وعصبياتٍ فاعلةٍ في سوريا ولبنان (والعراق و..) قد تكون متحالفةً مع الأنظمة الحاكمة حيناً أو على تضادٍّ معها ومعارضة لها، بل وثائرة عليها حيناً آخر، وولدت قبل تلك الأنظمة بكثير، فإن الركون إليها لوحدها والكلام العام عنها وتفسير كل شيء بها فقط، يبقى الوجه الآخر لتفسير كل شيء بالسياسة وبالأنظمة فقط، مع العلم أن بقاء أنظمة كالنظام السوري سيكون ولّادَ موتٍ ودمارٍ مستمرين، وسيجعل كل إمكانات مواجهة العنف الاجتماعي والديني ومصادره، إمكاناتٍ تقيم على خط الأفق البعيد، حيث تلتقي السماء مع سطح البحر للناظرين إلى هناك، وحيث يطالَب كل ناقدٍ لتلك الموروثات وكل خارجٍ عن الإجماعات البليدة بإشهار صكوكه «الثورية» وأوراق براءته تحاشياً لاتهاماتٍ توجه له بـ«خدمة النظام»، أو بـ«تغيير جلده».
النظام الشيفري وفقدان السياسة
لا يجانب المثقف الفرنسي الصواب بالقول «حيث سيكون المثقف الناشط مفيداً أكثر، فإن الشروط المطلوبة لممارسته هي الأصعب. إذ هناك أيضاً تتركز المحرمات والكوابح والرقابة الذاتية». وللرقابة الذاتية قصةٌ مع سمير قصير نفسه، محددةٌ وواضحةٌ ومختلفةٌ هذه المرة أيضاً عن عموميات دوبريه.
ففي واحدٍ من نصوصه المكتوبة عام 1996 وغير المنشورة باللغة العربية، وهو بعنوان «تعلّم النظام الشيفري وفقدان السياسة»، نشرته جريدة الحياة بعد اغتياله وقدّم له كينيث براون، محرر مجلة Mediterraneans في باريس، يتحدث قصير عن تطويع الكاتب نفسه وقلمه لصالح ما أسماه بـ«النظام الشيفري في الكتابة». فإذا كانت الحرية الكاملة في الكتابة وهماً، فإنه لم يكتب في تلك الفترة، كما يقول، إلا مرةً أو اثنتين في مواضيع لبنانية تتعلق أيضاً بقضية المفاوضات العربية الإسرائيلية التي كانت تعالجها ثلاثة أرباع مقالاته. لكن حتى في موضوع المفاوضات «كان لا يمكن الاستغناء عن النظام الشيفري بسبب هيمنة المعاني الضمنية التي تنطبق على سوريا».
لا تمنع المعاني الضمنية من قول كل شيء بحسب سمير، ولكن لفعل ذلك يكمن الشرط في اللجوء دائماً إلى أساليب دوران ومواربة ومراجع تاريخية ذات معنى.. ونكتشف في كل مرة أن في إمكاننا قول المزيد، أقله حتى سقف معين لا شك أنه الاتهام الشخصي للرئيس الأسد.
هذه الـ«لا شك» في كلامه تجعل من الكتابة بالشيفرة، ومن هيمنة النظام الشيفري، أموراً «عاديةً» في لبنان أيام الوصاية السورية عليه، إلا أن شهيد الكلمة الحرة، وكما هو معروف لمن يقرأ مقالاته منذ نهاية التسعينات وحتى اغتياله، لم يركن إلى هذا النمط في الكتابة إلا لفترةٍ قصيرة، على عكس لبنانيين كثيرين في ذلك الوقت، ونعني المعارضين للحكم الأسدي في البلدين الجارين وليس الصحفيين والكتّاب اللبنانيين المستفيدين منه أو المدافعين عنه.
ومع اغتيال الحريري ثم انتفاضة الاستقلال وما سمّي بـ«انسحاب النظام من لبنان»، انهار النظام الكتابي إياه فوق رؤوس حماته من أهل السلطة في لبنان، لكنه استمر في سوريا حتى اندلاع الثورة فيها عام 2011، عندما لم يعد الاتهام المباشر للأسد والنيل الضروري منه خطاً أحمر.
هذه مسائل لم يمرّ عليها دوبريه، علماً أن بعضها قد قيل على لسان سمير الذي كُتب كتاب المفكّر في مواجهة القبائل من أجله وكمساهمة إضافية من صديق لتخليد ذكرى صديقه. لكن كائناً ما كان الحال، يبقى صحيحاً أن اغتيال قصير كان اغتيالاً من قبل أجهزةٍ ونظامٍ وأدواتٍ تابعةٍ له في لبنان، وهو ما لا تنفع النصوص العامة في جعل المطلعين على تلك الحقبة ينسونه أو يذهبون إلى أمكنةٍ أخرى في تأويله، كما لا تنفع محاولات وضع اغتياله واغتيال لقمان وآخرين ضمن «الحرب التاريخية ضد المعتزلة وابن رشد و…» على ما يرى أدونيسيون كثر.
أية راهنية لسمير اليوم؟
من الصعوبة ومن المؤلم في آن، أن يحاول المرء استحضار راحلين يحبهم ليتخيّل مواقفهم اليوم، رغم أنها محاولةٌ لا تخلو من وجاهةٍ ومن مشروعية في حالة سمير قصير.
فإذا كان من المؤكد أنه كان سيكون رأس حربة في الدفاع عن الثورة السورية قبل تحولها إلى حربٍ عامة، داخلية وخارجية، وأهلية، وكان سيلعب دوراً في تحدي ومجابهة السلطة في دمشق والسلطات في لبنان، والتنظير والكتابة والتشبيك مع رفاق وأصدقاءٍ له سوريين دعماً للمعركة، فإن الانهيار الهائل والتحول الذي عاشته وما تزال تعيشه سوريا، وهو تحول من سوية وجودية تقريباً تتعلق بإمكانية استمرار الكيان نفسه وقابليته للحياة -كما الانهيار الذي يسير إليه لبنان اليوم رغم محاولات الإنقاذ التي تُبذل- تجعل من مقالات سمير السابقة وكتبه وكتاباته عن سوريا ولبنان.. كتاباتٍ هي ابنة ذلك الزمن وتلك الظروف والأحلام الكبرى التي كانت تخيم على كثيرين.
لكنها في الوقت عينه تجعلنا نفتقد مع كل سنةٍ تمرُّ فيها ذكراه، قلماً ورؤيةً وثقافةً ومناقبيةً في الكتابة نادرة، كلما انهار جدارٌ آخر من الجدران المتصدعة أصلاً في البلدين الجارين معاً.