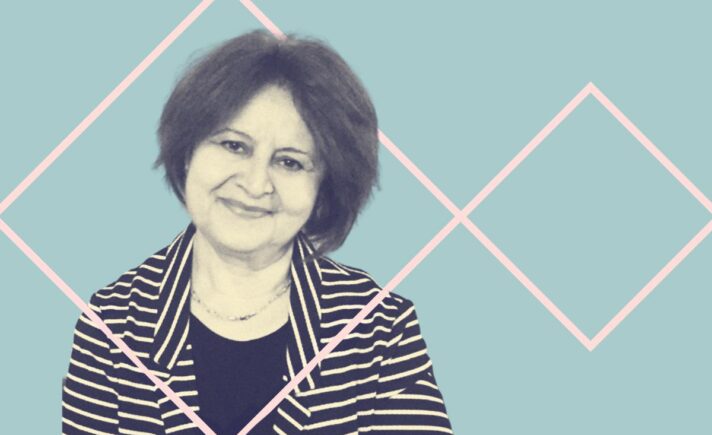أين كنتِ في آذار 2011 يا سميرة، وأين أودت بك دروب الثورة والحرب؟
في آذار 2011 كنت بصدد إنهاء أطروحتي الدكتوراه في العلوم البيئية، والتي ناقشتها في بداية نيسان من ذلك العام في فرنسا. بعد ذلك التاريخ، أفضت دروب الحرب بي إلى الاستقرار في فرنسا، فيما أدت انطلاقة الثورة السورية إلى تبني دربها. ومنذ ذلك الحين تتقاطع المسارات السابقة بين البحث العلمي والتهجير والثورة لتحدد خطوات مساري في الحياة.
في كتابكِ «الشهيدة السورية الأولى» تخطين تاريخ عائلتك التي هُجِّرت من لواء اسكندرون عام 1936، فاستقر بعضها في دمشق. تتابعين فيه التحول المكاني المترافق بتحول اجتماعي وثقافي، والمترافق على حد تعبيركِ ببدء التلاعب السياسي الناجم عن تحول سوريا إلى دولة يقودها الكذب في عهد النظام البعثي/ الأسدي. كما تروين كيف ذهب ثلاثة من أفراد تلك العائلة ضحية المنظومة الأسدية التي قتلتهم عمداً، ومن بينهم عمتك التي تحملين اسمها سميرة جوزيف مبيض. كيف ارتبط ذلك التاريخ بحياتك الشخصية؟ وإلى ماذا كنت تطمحين بالضبط من خلال النبش في تاريخ عائلتك؟ وهل تغير شيء بالنسبة لكِ بعد رواية القصة؟
تاريخ عائلتي لم يكن غائباً، بل حاضراً باستمرار في الذاكرة الجمعية لطيف واسع من السوريين والسوريات، ليس لأنه حدث مرتبط بجرائم القتل والاضطهاد التي ارتكِبت بحق العائلة فحسب، بل لكونه نموذجاً عن الضرر الهائل الذي حلّ بنا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد توسّع ذلك الضرر بعد الحرب العالمية الثانية، وأثناء الحرب الباردة، جراء السياسات العالمية التي فُرضت على المنطقة نتيجة تقاسم مصالح القوى المُتحاربة، فضلاً عمّا أدت إليه هذه الصراعات من فرض نظم قمعية وتبني سياسات كارثية المآل بحق سوريا والشعب السوري. وذلك التاريخ الذي بدأ مع التهجير القسري بعد تقسيم الحدود السورية قد استمر في كافة الحقبات المتتابعة في القرن الماضي، وصولاً إلى ما بعد انطلاقة الثورة السورية، معبّراً بقوة ووضوح عبر الزمان والمكان عن حال أهل هذه الأرض وحقهم المهدور بالحياة بأمن واستقرار.
هدفي الأساسي من توثيق تاريخ عائلتي كتابةً هو نقله من الإرث الشفهي ليصبح وثيقة سورية تُضاف إلى آلاف الوثائق التي تكتب تاريخنا، كعِبر إنسانية ومرتكزات لبناء المستقبل بما يقطع كُلياً مع هذه الحقبة المُظلمة المفروضة على الشعب السوري. كانت كتابة هذا التاريخ واجباً بالنسبة لي، كي لا تندثر تضحيات السوريين-ات وشجاعتهم، بل تبقى راسخة ومستمرة. لقد أديتُ واجبي وحسب.
سبق لكِ أن درّستِ مادة العلوم البيئية في جامعة دمشق. غير أن الاهتمام بشؤون البيئة في سوريا كان قبل الثورة والحرب في مستوى منخفض للغاية. الحجة التي كان الناس يأتون بها هي كيف نهتم بالبيئة إذا كنا غير قادرين أساساً على حماية أنفسنا من القمع والتنكيل. واليوم يزداد الأمر سوءاً مع انحدار ظروف الحياة على جميع الأصعدة، وتدمير الحرب للبيئة السورية بشكل مباشر. يبدو لي أن القضية البيئية في حال أسوأ من القضية النسوية، أليس كذلك؟ إلى أي مدى تأثرت البيئة في سوريا بالوضع السياسي والديكتاتورية؟ وهل من أمل أن توضع القضية البيئية على الأجندة السورية في المستقبل القريب أو المتوسط المدى؟
في العقود الماضية لم يكن هناك أي اهتمام بالبيئة في سوريا أو على صعيد المنطقة عموماً. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، من بينها تناول هذا المنظور بشكل سطحي، وعدم إدراك تأثيره وتأثّره المباشر بالمجتمع والسياسات المحلية والعالمية. أما اليوم، فتفرض التحدياتُ التي تنتظر البشريةَ التوجه للتركيز على البيئة والانطلاق منها معرفياً لإيجاد حلول مستدامة لكثير من الكوارث، من بينها ارتفاع درجة حرارة المناخ، والأمن الغذائي والأمن الصحي العالميين. وبالتالي، فإن السياسات البيئية لم تعد خياراً، بل مساراً حتمياً للمستقبل.
يعرّف علم البيئة بدراسة علاقة الإنسان بمحيطه، وانعكاس تلك الروابط عبر تاريخ الإنسان وتطوّره ومحيطه الذي يؤمّن له متطلبات الحياة وأدواتها ومصادرها. حيث يرتبط ذلك المُحيط بالتضاريس والمناخ والنباتات والحيوانات ومجموع الكائنات الحية ضمنه. إن الإنسان الحديث، الذي تمتد منه مجتمعاتنا القائمة اليوم، يمثّل نوعاً واحداً فقط من بين حوالي تسعة ملايين نوع حيّ يقطن الأرض.
يكمن الخلل الذي تواجه البشرية نتائجه اليوم – من تلوث واحتباس حراري وأوبئة وغيرها من الكوراث المرتبطة بالمحيط الحيوي – في أن الإنسان يتعامل مع محيطه البيئي كنظام بسيط، ويستخدم الموارد انطلاقاً من ذلك المنظور، معتمداً مبدأ إدارة النظم البسيطة باتجاه واحد استهلاكي مفرط، متجاهلاً محدودية الموارد في المدى الزمني، ومتغافلاً عن الكم الهائل من الوظائف التي يقوم بها المحيط، والتي اختلت مع انعدام التوازن البيئي. فالمحيط البيئي نظام مركب مترابط ومتماسك في حالة الاستقرار، وسوف يقود أي اختلال في توازنه إلى تغييرات أوسع أثراً. ويشكل الإنسان جزءاً من هذا المحيط البيئي، أي أنه يؤثّر ويتأثر به. غير أن الحقبة البشرية الحالية تشهد فصلاً بين الإنسان ومحيطه الحيوي، واعتبار هذا المُحيط الحيوي مادة للاستهلاك في خدمة المجتمعات البشرية، وهذا انحراف كبير عن الواقع.
تُعتبر المنظومة البطريركية السلطوية التي تُدار بها المُجتمعات البشرية، في كافة الدول دون استثناء، عاملاً أساسياً في ترسيخ هذا المنظور المنحرف تجاه المحيط الحيوي، والذي يضع الطبيعة في موقع التسخير لخدمة الإنسان، مما يدفع نحو استغلال الموارد الحيوية من منطلق التملك والتقييد. وهكذا تتلاقى قضية البيئة مع قضايا الحريات الإنسانية، ومن بينها القضية النسوية، وتحتويها. ذلك أن انحراف السياسات العالمية حيال توازن المجتمعات الإنسانية داخلياً أو ضمن محيطها كان شاملاً.
كذلك يمكننا القول إن تأثّر البيئة في سوريا بالسياسات الاستبدادية هو جزء من تأثير المنظومة القائمة في المحيط والمجتمع، ولا ينفصل عنه. تعتبر سوريا نموذجاً عن السياسات البيئية التي تعكس منظور النظم الاستبدادية، حيث انتَهجت في جميع مناطقها سياسة الإهمال وسرقة الموارد الأحفورية التي لم تستخدم أرباحها للتنمية، بل لزيادة الأرصدة البنكية لشريحة الفساد المرتبطة بالسلطة. غير أن ذلك ليس محصوراً في سوريا، بل غدَت مصادر الطاقة الأحفورية في الحقبة السابقة مُنتجة للسياسات العالمية، فانعكس ذلك على فرض نظم بعيدة عن الديمقراطية في البلدان التي تمتلكها في المنطقة، وتقييد هذه الموارد بيد الحكومات.
لذلك أعتقد أن وضع القضية البيئية على الأجندة السورية هو مسار طبيعي اليوم، وبخاصة ضمن وجودها على الأجندة العالمية سلفاً، والذي سيتعزز في المستقبل القريب، بحكم الضرورة التي يفرضها الواقع على مسار التغيير السياسي في سوريا والمنطقة.
ثمة ربط متزايد على مستوى العالم بين قضية المرأة والبيئة، حتى أن هناك من يقول إنه لا يمكن إنقاذ البيئة من دون تمكين النساء في مجتمعاتهنّ المحلية. ما الصلة بين النسوية والقضية البيئية برأيكِ؟
الصلة بين قضايا النساء في المجتمعات الإنسانية وقضية البيئة هي صلة وثيقة يمكن تناولها من محورين: الأول هو بكون القضيتين، أي تخريب البيئة وعدم وجود مساواة إنسانية، نتاجاً لمنظور واحد ناجم عن المنظومة البطريركية السائدة عالمياً، والتي تقوم على أسس الوصاية والتحكم والاستغلال. وينعكس هذا المنظور في السلوكيات المجتمعية والاقتصادية والسياسية بين الدول، وضمن الدولة الواحدة، وضمن جميع البنى المجتمعية. مرّ زمن طويل على بدء الحراك المطالب بحقوق النساء في جميع أنحاء العالم، ورغم وجود عدد كبير من القوانين والمنظمات الدولية التي تسعى في هذا السياق، إلا أن لا تأثير حقيقي لها حتى في أكثر دول العالم تقدماً، لأنها تعمل ضمن منظومة تسلطية تتبنى مفاهيم بعيدة عن التوازن. ومن هنا تأتي ضرورة العمل على تمكين المنظور التعددي وضمان الحريات الفردية المترافقة بالمسؤولية تجاه الحياة عامة، والذي يصبّ في المضي قدماً بمسار حماية البيئة وتحقيق التوازن الجندري.
أما المحور الثاني فهو قائم على اختلاف منهجية التفكير بين الرجل والمرأة، وهذا نتاج طبيعة التطور الوظيفي لكل منهما تبعاً للدور الذي أسنِد إليهما خلال تاريخ البشرية. حيث اتسم دور الرجل بمهام الصيد والحصول على الفرائس والحروب والتوسع والصراع على النفوذ، في حين كان دور المرأة هو تأمين استمرار حياة المجموعة بشكل مستدام اعتماداً على قطف الثمار، بالإضافة إلى دورها الهام في صناعة الأدوات التي ساهمت في تحسين حياة المجموعة على صعد الزراعة والمسكن والكساء وغيرها.
الاعتماد على الفكر الذكوري في النظم البطريركية التي فُرضت لاحقاً على المجتمعات البشرية، عبر أيديولوجيات مُستفيدة منها، انعكس في تكريس الفردية والمنافسة والصراع والمكاسب الآنية، وانعدم ضمنها المنظور المُستدام وبعيد المدى. كما انعكس هذا المنظور في تفاعل الإنسان مع محيطه بالآلية ذاتها. لذلك يعتبر تقويمُ المفاهيم الجندرية والبيئية، وإعادتهما للتوازن، مسارين مرتبطين.
هل تتوقعين أن يكون للنساء السوريات دوراً مميزاً في إحياء قضية البيئة؟ وهل لديهنّ الوعي الكافي بهذه الأمور؟ وكيف يمكن تعزيز الصلة بين النسوية والقضية البيئية من الناحية العملية؟ أي: ماذا ينبغي على النسويات أن يفعلن؟
الاختلاف شاسع بين النسوية السورية بمفهومها القائم اليوم وبين النسوية كجزء من القضية البيئية. فالنساء النسويات في الوسط السوري يتبنين مفاهيم ذكورية فرضتها المنظومة القائمة، ويعملن ضمنها، وتتسم بها سلوكياتهن بشكل غالب، وأهمها: محاباة المتنفذين وأصحاب السلطة، والتنافسية العدوانية تجاه النساء المُتمكنات، والتبعية الفكرية، وعدم امتلاك منهج حر، والتبعية المتعددة الأوجه على حساب مصلحة النساء السوريات، وغير ذلك من انحرافات طفت على السطح خلال عقد من الزمن ولا زالت. ومن تتبنى هذه المفاهيم لا يمكن لها حمل قضية البيئة واحترام الحياة.
لذلك أعتقد أن الاعتماد الأكبر سيكون على من يحملنَ مفاهيم مختلفة بالدرجة الأولى، ومن ثمّ على تنشئة جيل مُدرك لأهمية البيئة وارتباطها بالمجتمعات الإنسانية السوية، ليُصبح مفهوماً حيّاً وقائماً بشكل طبيعي ضمن المجتمع. وذلك أمر ممكن التحقيق وله ركائز، بحكم أن المنطقة السورية ارتبطت تاريخياً بحضارات نشأت على أرضها، واعتمدت على علاقة وثيقة بالطبيعة، وأسّست بناء على هذا الارتباط نظمَ حوكمة وتحضّر ذات أهمية وأثر كبيرين في التاريخ الإنساني. فعوامل تبني مفهوم سويّ تجاه البيئة وكافة قضايا المجتمع حاضرة في الإرث المعرفي والإنساني السوري، غير أن النهوض بمستقبل القضايا البيئية في المنطقة يتطلب بناء ركائز معرفية، وإعادة النظر بالمفاهيم النسوية من منظور حيوي، والانفكاك عن الأطر السابقة الذكورية في العمل النسوي.
أختصر مجمل هذا التصور بما أتبناه كتوجه سياسي «نحو سياسة عالمية تحترم الحياة»، والذي يعبّر عن أن لا انفكاك بين هذه المفاهيم: السياسة واحترام الحياة والإنسان كجزء منها.
أنتِ عضوة في اللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني. لطالما تساءلتُ كيف يتم العمل ضمن هذه الظروف الرديئة على دستور يساوي بين الرجل والمرأة. هل تشتغلون على كل بندِ على حدة، فتُستنفَذون أمام القوى الرجعية التي تريد أن تحافظ على دونية مكانة المرأة؟ أم أنكن-م تتسلحون بمبادئ فوق-دستورية تساعدكم على فرض الحد الأدنى من العدالة؟ وإذا لم تكن ثمة مبادئ فوق-دستورية، فما سبب غيابها؟ وماذا حققتم حتى الآن من أجل المرأة في مسودة الدستور؟
لغاية هذا التاريخ، وبعد سبع جلسات للجنة المُصغرة، لا يوجد عمل على دستور سوري حديث. كما أن الاجتماعات تقتصر على نقاشات بين أطر من المنظومة القديمة ذاتها. بغياب العمل الدستوري الجدي لا يمكننا الحديث عن بنود تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، فهو منظور متكامل مع تبني الاعتراف بتعددية سوريا وشكل الدولة المستقبلية ومفاهيم الحريات الفردية والمصلحة العامة، أي ببناء دستور مدني تعددي. وذلك ليس هدف التشكيلة الحالية للجنة الدستورية، لأنها قائمة على مرتكزات الماضي، ولا يمكن أن تحقق أهدافاً للمستقبل.
لكن العمل من أجل المرأة لا يرتبط بالدستور فقط، بل إن الدستور هو نتيجة لاحتياجات المجتمع. فما أسعى إليه في هذا السياق هو إدراك متطلبات العودة للتوازن الإنساني وفق المعطيات المحلية، والتي ترتبط بعوامل مجتمعية واقتصادية وثقافية متمايزة بين المناطق السورية، ولا يمكن شملها بطرح واحد. من الأهمية بمكان أن يتم العمل عليها من منطلقات تبايناتها الحيوية، سعياً للوصول إلى إعادة الدور الطبيعي للنساء في كافة المناطق، وإنهاء الانحرافات القائمة ضمنها اليوم.
تدينين، في أكثر من موضع في كتاباتكِ، ارتهان منظمات المجتمع المدني للتمويل الخارجي المصدر، مما يحدّ من طموحها ويجعلها أقل جذرية وفاعلية مما تتطلب ثورة. هل ينسحب ذلك على المنظمات النسوية كذلك؟ وكيف كان تأثير التمويل عليها برأيك؟ والأهم: هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ بمعنى آخر: هل كان (وما زال) بإمكاننا إنشاء منظمات متماسكة ومستدامة ومرتكزة بالدرجة الأولى على الجهد الذاتي للسوريين والسوريات ضمن الأوضاع الحالية للحرب والعنف والشتات؟ وما هي توصياتكِ بهذا الخصوص؟
أثبتت آليات تمويل منظمات المجتمع المدني القائمة لغاية اليوم أنها تُضعِف أثر منظمات المجتمع المدني. ليس في سوريا فحسب، بل في جميع المناطق التي تواجدت فيها. وقد شكّل النموذج الأفغاني جرس إنذار في هذا المجال، حيث شهدنا هشاشة وسرعة انهيار هذه المنظمات. رغم الدعم الذي قُدم لها على مدى عقدين من الزمن، لم يكن يوجد أي امتداد مترسخ لها في أرضها.
عدة عوامل سلبية يمكن الإشارة إليها في هذا السياق، وأهمها هو تبني توجهات وصائية للمنظمات لتطّبق على الشعوب والمجتمعات المحلية باعتبارها لا تمتلكها أو غير قادرة على بنائها، وهذا أمر خاطئ بالمطلق وأثبت فشله. فجميع الشعوب والثقافات والمجتمعات دون استثناء تمتلك مرجعيات قيمية وإنسانية ناتجة عن تراكم تاريخي وجغرافي ومعرفي وثقافي لكل منها. هذه القيم هي مرتكز الانطلاق محلياً بالبحث عن جذورها وإحيائها، ونفض التراكمات السلبية عنها، لتكون فاعلة في مكانها وذات أثر في النهضة والتنمية. من العوامل السلبية أيضاً انعدام الشفافية المالية في عمل غالبية منظمات المجتمع المدني مما يحيل التمويل إلى حالة ضبابية، ومصدر تساؤلات مشروعة، على الأخص بعد أن تمّ خلط مصادر التمويل. فهناك منظمات عالمية كبرى ذات تمويل عالمي وأهداف تنموية واضحة وعمل مؤسساتي شفاف، وهناك التمويل السياسي التابع لخارجيات الدول أو للأحزاب العابرة للحدود، والتي سادت بالحالة السورية ودفعت إلى توجهات محددة شكلت مصدر استقطابات سياسية بعيدة عن الحالة المدنية السوية والقادرة على تجميع السوريين-ات حول المصلحة العامة، وليس شرذمتهم كما هو حاصل اليوم.
لقد قيّدت هذه العوامل بدورها عوامل اختيار القائمين على هذه المنظمات، وزادت من تضاؤل إمكانياتها للتأثير والفاعلية. الأثر الأكثر ضرراً من وجهة نظري كان في العمل النسوي، فعوضاً عن أن تمنح هذه المنظمات إطاراً آمناً لعمل السيدات السوريات الفاعلات جميعهنّ، فقد شكلت تكتلات شللية واصطفافية تنطق في كثير من الأحيان بأصوات وأفكار أحزاب أيديولوجية بطريركية نابذة للمرأة وبعيدة عن إمكانية تحقيق دفع هام في العمل النسوي.
أعتقد أن المستقبل يتطلب التحرر مما يُفرض على السوريات من أطر نسوية، نحو تبني ما ينجم بشكل طبيعي عن احتياجات المجتمعات المحلية، ودعمها للوصول إلى أهداف مترسخة ومتماسكة وقادرة على الحياة والاستمرارية بشكل ذاتي ومستدام في المجتمع.
أنتِ رئيسة منظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام؟ ماذا يمكنكِ أن تخبرينا عن تاريخ تأسيس هذه المنظمة؟ وما الذي تهدف إلى تقديمه لسوريا المستقبل؟ وهلا أعطيتنا مثالاً عن نشاط قمتم به مؤخراً وكيف كانت نتائجه؟
عمل النظام على الترويج لادعاءات حماية المكوّنات السورية، ومن بينهم المسيحيين، واستخدم هذه الادعاءات لتشويه الحراك السوري ومهاجمته. إن هذا التلاعب الذي قام به على الصعيد المجتمعي يعتبر على درجة عالية من الخطورة، سواء بدوره في نشر الكراهية والفتنة في المجتمع، أو مما يكشف عنه من نهج تواطؤ النظام مع التنظيمات الإرهابية، بهدف ترهيب المسيحيين ودفعهم للتهجير القسري. بمواجهة هذه الظاهرة لم يكن ممكناً الاعتماد على المؤسسات الكنسية للتصدي لهذه الأكاذيب، لأنها خاضعة لسياسات النظام. ومن هنا برز دور ضروري لوجود منظمة تتصدى لهذه الادعاءات، وتكشف زيفها وخطرها وتأثيرها السلبي على المجتمع، وتكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الذي عمل على تهجير المسيحيين طيلة عقود بشكل مباشر وغير مباشر، وحارب التنوع السوري بجميع أشكاله، وحابى الإرهاب الذي يدعي محاربته.
من أهم النشاطات التي قامت بها المنظمة على مدى سنوات هو رفع الغطاء عن منظمات مدنية تنشط في أوروبا وتروج لادعاءات النظام تحت مسمى حماية المسيحيين، وساهمت في تحقيقات صحفية حولها أدت إلى تحريك القضاء الفرنسي لإيقاف نشاطها. كما ساهمت المنظمة في التأكيد على أمر بدهي مُغيّب، وهو أن المكوّن المسيحي، كغيره من المكونات السورية، تعرّض للقمع والاستبداد والانتهاكات الجسيمة، وأنه جزء لا يتجزأ من السعي للتغيير في سوريا.
يلفتني في اسم منظمتكم «مسيحيون سوريون من أجل السلام» استخدامكم لكلمة «السلام». حسب ملاحظتي، فإن هذه الكلمة الجميلة قد تغيّر معناها أثناء الحرب، حتى صار الذي يدعو إلى السلام كما لو أنه غبي أو يضع نفسه في أحسن الحالات خارج المسار السياسي. على سبيل المثال وليس الحصر، هناك كثير من الناس الذين تستفزهم مقولة «نساء من أجل السلام»! هل السعي من أجل السلام عمل سياسي برأيك؟ وكيف يكون ذلك؟
يعرّف السلام بمعانٍ كثيرة، فهي كلمة لا تقدَّم دائماً بالمعنى نفسه، بل تختلف حسب ما يؤمن به من يحمله ويقدّمه ويسعى لتحقيقه. هناك من يرى أن السلام يقتصر على توقف الحرب أو إنهاء الصراعات العسكرية، وهذا المنظور تطرحه غالباً القوى العسكرية، بهدف تثبيت حالة المكتسبات الناجمة عن الحرب. ولستُ ممن يؤمن بهذا المفهوم السلبي للسلام بكونه «اللاحرب»، فأنا أرى أن الحروب والصراعات العسكرية هي وجه واحد فقط مما ينقض السلام. فالكثير من المجتمعات لا تعيش بسلام رغم عدم وجود صراع عسكري مباشر في أرضها. والمجتمع السوري هو أحد هذه المجتمعات التي لم تقتصر معاناتها مع الحرب، بل افتقد السوريون للسلام منذ عقود طويلة.
من جهتي أتبنى مفهوم السلام بكونه السعي لتحقيق الوضع الأفضل الذي يسمح بتطور المجتمع واستقراره ونهوضه إنسانياً، ويتضمن ذلك نبذ العنف بكافة أشكاله. ومن هذا المنطلق، فإن السلام الإنساني هو برنامج سياسي متكامل، ويتضمن العمل المدني الساعي لبناء الفرد المتصالح مع ذاته، والمجتمع المستقر ضمن أسس حفظ ثقافاته وتنوعه وتناغمه وتكامله، فيصبح بدوره مصدر استقرار لدول الجوار والعالم أجمع. ويسعى ذلك المسار التنموي الاقتصادي إلى التنمية المستدامة، وتبني مبدأ تساوي الفرص للجميع، بما يسمح ببناء الحياة بمسارات مختلفة ونتائج مختلفة، لكن من نقاط انطلاق على سويّة واحدة. حيث إن تساوي الفرص يعني أيضاً المساواة في المقدرة على الوصول إلى الموارد الأولية للحياة وما توصل إليه التقدم العلمي والصناعي، والمساواة في التعلم المعمّق القادر على إحداث الفرق، وتساوي حق الجميع بالحصول على بيئة مناسبة للحياة والعيش في محيط آمن. وجميعها أسس استقرار المجتمع، وهي ما تقود إلى السلام.
فسواء ما أتبناه كمفاهيم سياسية بيئية، أو ما أعمل عليه في الإطار المدني الساعي لإيجاد أطر للتناغم بين مكونات وأطياف المجتمع السوري، جميعها تصبّ في مسار صناعة السلام. وأرى أنه مسار علمي ومعرفي سيستند على تراكم وتوظيف المعارف البشرية لبنائه وتمكينه.
معظم كتاباتك تعبّر عن أمل بمستقبل أفضل للمرأة السورية ولسوريا عموماً؟ على ماذا تبنين ذلك الأمل؟
لا أعتمد على الأمل، بل على إدراك مرحلة التطور العالمي التي نمر بها اليوم، وعلى العمل بأن تكون سوريا جزءاً من هذا المسار العالمي. غير أن ذلك لن يُكتسب دون عمل حثيث، وينبغي أن تكون إرادة السوريين والسوريات بالتغيير حاضرة. هو مسار يتطلب المثابرة والحرية والاستقلالية بالفكر والخروج من الصناديق المُغلقة ومن قيود الماضي نحو رحابة المستقبل. كما يتطلب ذلك وجود المرأة السورية بشكل فاعل، فهي المُحرّك لهذا التغيير ورافعته الرئيسة.