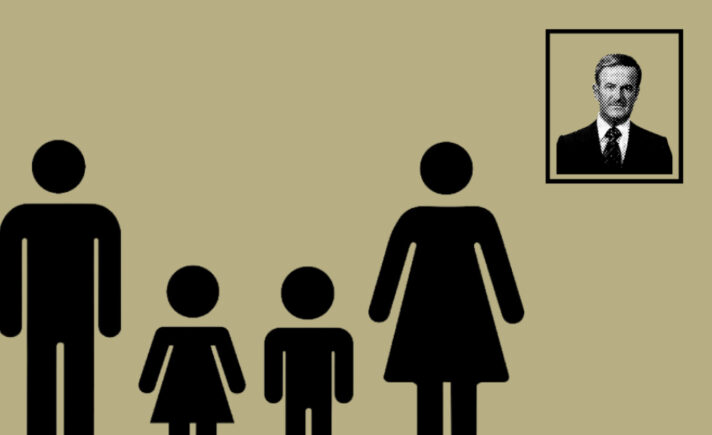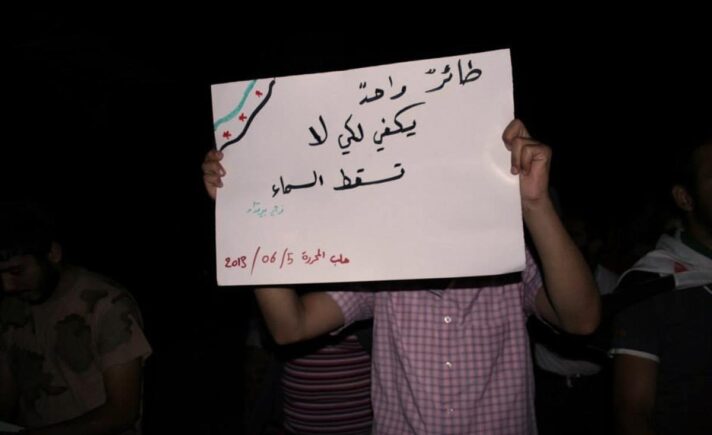أتابع صفحات منى سيف باستمرار. منى هي أخت علاء عبد الفتاح، الكاتب المصري والناشط الحقوقي ذو الأربعين عامًا، قضى منها سبع سنوات تقريبًا داخل سجون مختلفة لجميع السلطات التي حكمت مصر خلال حياته. أجد نفسي أحيانًا واضعةً لمنى تفاعل القلب، المزعج والدافئ العاجز، مرارًا وتكرارًا على النص نفسه في منصاتٍ مختلفة؛ تويتر وإنستجرام وفيسبوك. أريد أن يصلها الحب، أن يصل لهم جميعًا: علاء ومنى وسناء وليلى.
منذ أيام قليلة نُقِلَ علاء إلى سجن آخر، ولكن قبل ذلك احتُجز في سجنٍ طرة شديد الحراسة منذ عام 2019، تُمنع فيه الزيارة إلا لفرد واحد من العائلة لمدة 20 دقيقة، ولمرة واحدة في الشهر. تناوبت العائلة على الزيارة، وعلى سطور رسائل إليه قد تمر أو لا تمر.
تابعت تحديدًا عناد سجّاني علاء ضد الكتب. رفض سجّانو علاء دخول أي كتب إليه، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك مجلة «ميكي» التي يحبها علاء. رفضوا السماح له بالقراءة من مكتبة السجن. لسنوات، علاء ممنوعٌ من القراءة.
أتابع عناد عائلة علاء، الحب الذي يتعب حتمًا في التكرار اليومي للمحاولة، والقرع المتكرر على أبواب السجن. يُرهقهم حتمًا تراجع صحة علاء وطول سجنه. لكنهم كل مرة يُعدّون الكتب: رواية وشعر ومجلة «ميكي»، بالإضافة إلى تيشرتات نظيفة، ويعودون إلى الزيارة. يتعب فيهم كل شيء: الجسد والأمل والإرادة والثقة بأنفسهم وبنا وبقدرة علاء على الاستمرار. لكنهم استطاعوا أن يخبرونا يوميًا أن التعب ليس بديلًا عن الاستمرار بالمحاولة، عن ثبات الإيمان بأنّ لنا حق بما هو أفضل من أن تزورنا أمهاتنا في السجون، وأفضل من أن تمنع أمهاتنا حتى من إعطائنا «تيشرتات نظيفة».
تتكرر خيبتي كلما رفض سجّانو علاء إدخال الكتب. أضعُ قلوبًا، أشارك المنشور عن الزيارة الأخيرة مع الأصدقاء الذين يشارك عددٌ كبيرٌ منهم الصوت ذاته عبر صفحاتهم الافتراضية. وأتنهد ارتياحًا بأنني -ورغم فهمي سبب منع السجانين الكتب عن علاء- لا أسأل: «لماذا يأخذ أهل علاء الكتب إليه في كل مرة؟» على العكس تمامًا، أقول في سرّي: «لدينا نعمة الأمهات اللواتي يأخذن إلينا الكتب كل مرة». أعرف جيدًا ألمَ أن أكون محور قلقِ وخوفِ أمي من «نشاطاتي السياسية وكتاباتي»، وألم أن أشتاق حتى إلى خوفها.
احتجاجًا على أوضاعه اللا-إنسانية داخل السجن، ربما حتى تعبًا وإرهاقًا منها، أعلن علاء إضرابه عن الطعام منذ 50 يومًا، وصحته في تدهور. ازدادت شراسة سجانيه ضده وضد الدكتورة ليلى، والدته، قبل نقله منذ أيام إلى سجن آخر أقل قسوة. لقد بدأتْ متابعتي لصور علاء وصور ابنه تغرقني في شعور عارم بالعجز.
يبدو شعور العجز منطقيًا. هناك الكثير من الهواجس العامة التي تشغلني: صورٌ أهالي معتقلين تحت جسر الرئيس في دمشق ينتظرون عفوًا من ظالمهم، فيديو لـ«مجزرة التضامن»، أخبار مؤلمة من فلسطين. يبدو العجز منطقيًا أمام خبر إضافي.
ولكننا، كلنا، علاء وأهله، لسنا خبرًا إضافيًا. جزءٌ من المقاومة أن نرفض أن نصبح مجرد خبر إضافي. يراهن الطغاة في كل مكان على قدرتهم على تقليصنا إلى خبر إضافي. يراهنون على أن يجعلنا الوقتُ خبرًا إضافيًا يتراكمُ فوق الخيبات السياسية. نقاوم بألّا ننسى، نقاوم بأن نقاوم أثر الوقت. نقاوم بإيماننا بفرادة كل منا، بفرادة علاء، بفرادة منى وسناء والدكتورة ليلى.
يحاول الطغاة بأساليب شتى تقليص فكرنا إلى مجرد الاهتمام بأساسيات حياتنا؛ بأكلنا وشربنا وأوراقنا الرسمية وعدد ساعات الكهرباء والماء. لذا، يصبح دخول الكتب إلى علاء في سجنه مقاومةً لذلك كله، مقاومة لتقليصنا مرة أخرى إلى ما هو أقل من إنساني.
لذلك كله، يزعجني إحساسي بالعجز. الإحساس بالعجز مليءٌ بالموت والغياب. أوليسَ ذاك هدف السجون والمجازر والإخفاء القسري؟ غيابنا كلنا، موتنا كلنا، أن نختفي؟
يمرُّ في خاطري بين ذاك كله السؤال عن جدوى فعل شيءٍ في مواجهة التغييب. سؤال فلسفي لأوقاتٍ أخرى. ما أعرفه أن الإحساس بالعجز هو إحساس بالموت، وأن المحاولة بأن «نُصرّ أن ننتصر للحق، مش مطلوب مننا أبداً إننا ننتصر في انتصارنا للحق»، كما يقول علاء، هي إِشعارٌ بأننا لم نختفِ، لم نمُت، ولم نُبَد.
يزعجني الإحساس بالعجز، والذي قد يكون مريحًا للنفس إذ ليس بالإمكان أفضل مما كان. يزعجني أنه لا يشبه تجربة علاء السياسية في شيء، ولا يشبه مقاومة عائلته. يجدون لغةً مُرمَّزةً لتبادل الرسائل، وينتجون كتابًا باللغتين الإنجليزية والعربية من كتابات علاء، يسموّنه «لم تُهزم بعد». يزورونه، يرفضون المغادرة، يكتبون ويترجمون. إحساسنا بالعجز لا يشبههم في شيء. وأجمل ما نفعل هو نضال يشبه من نناضل معهم ولأجلهم، ولذا تصبح جنازة شيرين أبو عاقلة، الهادرة والوطنية والمقاومة والموحِّدة لقلوب الفلسطينيين، أصدق مقاومةٍ لقتلتها.
أحاول أن أعود بالذاكرة لمعرفة متى كانت المرة الأولى التي عرفت فيها علاء، أو للدقة عرفت عنه. شهرٌ ما من زمان 2011 لا أذكره بدقة. شيء يشبه معرفتي عن لينا عطا الله وعبد الرحمن منصور وباسل صالح ورشا حلوة ومريم الخواجة. زمنٌ امتلكنا فيه جميعًا حلمًا بمنطقة لا يشكل السجن والتعذيب عُرفًا متوقعًا فيها؛ حلمًا ديمقراطيًا.
يشبه علاء في ذاكرتي تلك الثورة بنزاهة حلمها؛ أن نعيش بكرامة. يعادي الطغاة تلك اللحظة وشبابها بشراسة وإمعان في الإذلال، ويسعون لمحو تلك اللحظة، للقفز فوقها، لتحميلها ذنوب عنفهم، لاعتبارها خطًأ أو نزوة. يشبه علاء أجملنا وأجمل ما كنا، ولذلك يحتجزه الطغاة في سجون مشددة الحراسة. يصبح الإمعان بقهر علاء وعائلته ليَّ ذراع لنا، نحن رفاق دربه الذين يعرفنا أو لا يعرفنا، ليّ ذراع بالمشاهدة. تأمل بأن نتذكر -وكأن من الممكن أن ننسى- الثمن المرافق لأن نتجرأ على الحلم بحرية ما في بلادنا.
أدرك فرادة علاء، كمفكّر ومدوّن وكاتب وصديق وأخ وابن وأب. ولكنني كذلك أدرك من كتاباته رفضه اعتباره «استثناء». ينتمي علاء لمئات الآلاف من المناضلين من أجل حلم ديمقراطي، يعرفهم أو لا يعرفهم؛ ينتمي لأجيال ستأتي، تكبر معنا اليوم، أو لم تلد بعد. هو يأمل أن يكتب ليقنع القادمين حتى أن يناضلوا لأنهم «لم يُهزموا بعد».
ويحرضني ذلك كله على رفض إحساسي بالعجز. أبحث عن حساب لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، على فيسبوك ماسنجر. رسالة مختصرة، كعادتي الغريبة بعدم البدء بالتحية، «عندي فكرة بس تفضي احكي معي». بيني وبين لينا رسالتان وحيدتان قبل هذه الرسالة، الأولى عندما تم اعتقالي، أرسلت لي لينا «أنا ما بعرفك بس حضن كبير»، ورددتُ عليها بالكثير من القلوب. الثانية عندما اعتُقِلَت هي، أرسلت لها «أنا ما بعرفك بس حضن كبير»، ووضعت لي الكثير من القلوب.
كانت رسالتي هذه المرة: «أريد أن أرسل كتبًا لعلاء، أعتقد أننا نستطيع أن نطلق حملة للقراءة مع علاء. ربما نرسلها إلى عنوان السجن مباشرةً، ربما إلى عنوان منى». طبعًا، في تسارع الأفكار داخل رأسي لا تستوقفني المحاذير الأمنية من نشر العناوين على العلن.
أشعر بغرابة رسائلي المنهالة بعد انقطاع سنين. أطلب من الأصدقاء المشتركين إيميل سناء أخت علاء وإيميل لينا. نتبادل الأفكار، وأقترح عنوانًا طويلًا للحملة «كتابي المفضل إلى علاء في السجن»، تعدّلها لينا إلى «نقرأ مع علاء». تضيف صديقة فنانة، اسمها سارة رفقي، فتأتي بشيء يشبه كل شيء إلا العجز، لنقرأ مع علاء. تتابع المجموعة، التي لا أعرف معظمها، عملها على إطلاق الحملة.
مقاومةً مرة أخرى لتقليصنا لمجرد خبر إضافي، نحن كتّاب وقراء، أصدقاء وأحبّة، أمهات وأخوات وآباء، ورفاق نضال عابر للمعرفة الشخصية أحيانًا، وللقارات واللجوء والحدود.
أكتب لهم، «منحكي مع وعد، منحكي مع وفا، منحكي مع جمان»، تقول لي سناء «يا قلبي عليكن، أنتو المهجّرات بهالدنيا».
ثلاث نساء في حياتنا السورية، للفخر والنضال والحب.
وتبدأ الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تشارك تلك المناضلات، وعد ووفا وجمانة صوتَ علاء وعائلته، دون حتى أن نتواصل معهن. يتبادل الناس صورهم مع كتاب يتمنون قراءته مع علاء، ويقترحون على علاء قراءته. أتساءل إن وضعت صور الكتب بعضًا من الدفء في قلب منى. ولو قليلًا؟ أخجل أن أسألها.
أفرح البارحة على وقع خبر نقل علاء إلى سجن وادي النطرون. ينام علاء للمرة الأولى على سرير له فرشة منذ سنوات. وللمرة الأولى أيضًا أخذوا الكتب من والدته. أتخيل أن تصله كتبنا ومحبتنا قريبًا. أحزن لأفراح عائلته. أحزن للواقع السياسي في بلادنا التي يصبح الفرح فيها إثرَ نقل إلى سجن أقل قسوة.
أعرف بلا تردد ما الكتب التي أودّ إهداءها لعلاء: كتاب موقّع من ياسين الحاج صالح، بالخلاص يا شباب؛ طمعًا بخلاص علاء، واحتفاءً بخلاص ياسين الحاج صالح وما يعنيه ذاك الخلاص لنا كسوريين، ولي شخصيًا كصديقته المشاكسة. كتاب يحاول ياسين فيه تفكيك تجربة اعتقاله السياسي الطويلة. أتأمل أن يعطي هذا الكتاب أملًا لعلاء بالخلاص.
أختار هذا الكتاب مدفوعة بقلق على أخبار تدهور صحة علاء النفسية. كرسالة بأن الاستمرار ممكن، أن سنوات السجن الطويلة ليست النهاية. التماسًا مني بأن يصل صوتنا إلى علاء: إن ما يحدث اليوم، على كارثيته وسواده، ليس النهاية.
أختار كتابًا ثانيًا، لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، لمحمود درويش، لأجل جملة واحدة: «إننا أحياء وباقون وللحلم بقية». تبدو الجملة دعاءً بالسلامة لعلاء، وبالطاقة لليلى ومنى وسناء ليستطيعوا حمل بقية الحلم الثقيل جدًا.
«لنا أحلامنا الصغرى، كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة. لم نحلم بأشياء عصية» ربما حلمنا بأن نمتلك ابتسامة على وجه أم علاء. ربما يكفي أن تكون صورة كتبنا سندًا لمنى وسناء. حبٌ عارم يتسرب بين الرسائل إلى علاء.
أكتب هذا النص مقاومةً للعجز، وأملًا بأن تدخل الكتب إلى علاء فعلًا، أو على الأقل «جواب» يصله في السجن يحمل أخبار مشاركتنا إياه الكتب. أكتبه دعوةً لكل الكتّاب والقرّاء للمشاركة معنا، لنملأ العالم ضجيجًا. لأننا، نحن الذين نعشق اللغة، نفهم قسوة أن يُمنع شخص من القراءة.
لنقرأ مع علاء. هل لهذا جدوى؟ هل سيغير مجرى الأمور؟ ليس بالضرورة. لكننا نشارك على كل حال.. لأن ليس لليلى، أمه، ترف أن تسأل عن جدوى حمل الكتب في كل زيارة. لنحملها نحن معها بطريقتنا.
شاركوا معنا. أخبروا تجمعات الكتّاب في العالم العربي، أو ربما حتى في شتاتنا، لترسل كتبها لعلاء. لنقرأ جميعًا مع علاء.
تحديدًا، نحن المهجّرون والمهجّرات، الذين ندرك أن تَحمُّّلُ شتاتِنا يصبح أقل إيلامًا إذا تحولنا إلى قوة صراخ من أجل حريتنا جميعًا.
ولتكن الصرخة هذه المرة صرخةً من أجل علاء.