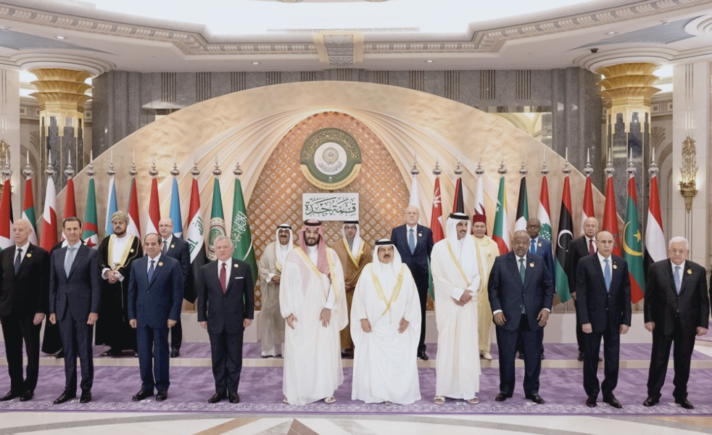في صباح الرابع من كانون الثاني (يناير)، استيقظتُ لأمارس عادتي السامّة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أطوف بينها باحثةً إما عن أجوبةٍ لأسئلتي، أو محتوىً قد يثير اهتمامي، فإذا بي ألمح صوراً نشرها مصورون فوتوغرافيون من مدينة جدّة على إنستَغرام، لمنازل قد كُتب عليها باللون الأحمر «إخلاء». لم يَبدُ الأمر غريباً في البداية، فقد ظننتُ أنهم موظفو أمانة جدّة يمارسون هواياتهم اليومية المعتادة، إما بالشخبطة على جدران بعض المنازل وتهديد ساكنيها بالطرد، أو بمباغتة أصحاب المحلات التجارية وتنكيد عيشهم، حتى بدأتْ مزيدٌ من الصور والحسابات بالظهور. التقط المصورون لقطاتٍ لمظاهر الحياة في تلك المناطق، لسكانها المنحدرين من جنسياتٍ متنوعة، وثّقوا عاداتهم وأفراحهم ورقصاتهم الشعبية، وحواريهم وبعض مباني جدة القديمة ذات التصميم العمراني العتيق نسبياً، والتي يعود بناء بعضها إلى فترتي السبعينات والتسعينات. حينها، تذكرت أخباراً قد تم تناقلها قبل ثلاث سنوات، حين كنتُ ما أزال مقيمةً في جدة عن خطة لهدم «الأحياء العشوائية» كما تدأب على تسميتها الجهات الحكومية الرسمية. لم أتوقع أن تتحول هذه الأخبار إلى واقع. كان الخبر صاعقاً.
خلفية تاريخية
جدّة هي مدينة ساحلية تتشابه في خصائصها العمرانية مع كثيرٍ من المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر من حيث شكل البناء والتخطيط، وتُعتبر مركزاً اقتصادياً وسياحياً للمملكة، كما يمكن اعتبار تخطيطها العمراني مثالاً عن التخطيط العمراني الإسلامي للمدن العربية في العصور الوسطى، وهو ما يُسمى «النظام العمراني المتضام»، الذي تنمو فيه المباني بشكلٍ طبيعي ومتقارب، وغالباً غير منظم، وتجسّد مدينة دمشق القديمة أبرز أمثلته.
خلال القرن التاسع عشر، كانت مساحة مدينة جدة لا تتجاوز 1.5 كيلو متر مربع، مُكوّنةً من أربع حارات رئيسية تتموضع في قلب مدينة جدة الحالي، وهي: حارة الشام، وحارة المظلوم، وحارة اليمن، وحارة البحر. ويُحيط بهذه الحارات سورٌ فيه عدة بوابات ومنارات تستعمل في حالة الحرب. في تلك الفترة، عاش فقراء المدينة داخل أسوار جدة في أكواخ، وكان أغلبهم ينحدرون من أصول إفريقية، استُقدموا كعبيد ثم استوطنوا في المدينة. بينما كانت العائلات الحجازية الثرية تعيش في بيوتٍ من الحجر المَنقبي الذي كانت تُبنى به عموم البيوت الحجازية تقريباً. وفي منتصف التسعينات، استبدل الأهالي الصخرَ المَنقبي بالطوب، وذلك لغلاء ثمن الأول وصعوبة الحصول عليه. وبمرور عقدٍ من الزمن استُبدل الطوب بالأسمنت، وخاصةً لبناء المساكن منخفضة التكلفة.
التطور العمراني
ابتداءً من عام 1947 وحتى عام 1956، شهدت جدّة تغيراتٍ جذرية، وانتقل العديد من السكان الأصليين للمدينة التاريخية نحو الضواحي، ثم بدأت المدينة بالتوسع، وشهدت موجة هجرةٍ من جميع أنحاء الجزيرة العربية وبعض الدول الأجنبية، وتزايدَ عدد سكان مدينة جدة بشكلٍ كبيرٍ ومتسارع. وارتفع التعداد السكاني في جدة بين عامي 1962 و1971 ليصل إلى قرابة 267 ألف نسمة. وكان عدد السكان يتضاعف مرةً كل خمس سنوات، وذلك نتيجة عوامل عديدة؛ منها اكتشاف النفط، الذي ساهم في تدفق المستثمرين والأيدي العاملة للمدينة، بالإضافة إلى استقرار بعض العائلات التي جاءت لأداء فريضة الحج في المدينة. وفي النتيجة، حدث تمدّدٌ عمرانيٌّ غير مُنظَّم، حيث بدأ العمال ببناء مساكنهم بنفسهم حول المدينة التاريخية، من دون أي خبرة وبمواد قليلة التكلفة وبشكل عشوائي، فتشكّلت أغلب الأحياء التي شملها الهدم اليوم؛ مثل حي الرويس شمالي جدة، وأحياء النزلة اليمانية والكندرة والهنداوية جنوبها.
واستعانت الحكومة السعودية بمهندسين وعمال بناء من الخارج لبناء مساكن جديدة، وظهر نوعان جديدان للتخطيط العمراني في جدة: الأحياء المنظمة مع مساحات متباعدة وتصميم الفيلات، غالباً في المنطقة الشمالية من المدينة، وأحياء مكتظة بمساكن متقاربة تمتد من وسط جدة وشرقها إلى جنوبها. وخلال الفترة نفسها، تحولت جدة تدريجياً من مدينة صغيرة إلى مدينة ضخمة، ومع تدفق العمال إليها تغيرتْ تركيبتها السكانية وتضاعفَ عدد المهاجرين، فحصل نقصٌ كبيرٌ في البيوت والمرافق العامة، وازداد الازدحام المروري. ونظراً لخروج الوضع عن السيطرة، فشلت الحكومة السعودية في إيجاد حلول متعلقة بالبنية التحتية للمدينة، فاستعانت بالأمم المتحدة لإيجاد مهندس معماري يصمم المدينة، فوقع الاختيار على عبد الرحمن مخلوف، وهو مصمّم معماري مصري حصل على الدكتوراه من جامعة ميونيخ، ولكن الخطة التي وضعها لم تشمل أي تطويرٍ يُذكر للمناطق «العشوائية»، واقتصر التطوير على الطرق السريعة في المدينة وعلى المرافق العامة.
الأحياء المُهدَّدة بالزوال
بدأت عملياتٌ لهدم بعض أحياء المدينة الجنوبية، وهو ما وصفته الحكومة على أنه «عملية تطوير للعشوائيات». ولا تزال العملية قيد التنفيذ بالرغم من استياء وحيرة ورفض السكان، بل شملت الخطة نطاقاً أوسع، حيث تسعى الخطة الحالية إلى إخلاء قرابة 34 حياً من أحياء جدة، وهدم مبانٍ بمساحة 5 ملايين مترٍ مربع، وتهجير قسري لقرابة نصف مليون إنسان. وقد بدأت أمانة جدة بإنذار ساكني العشرات من أحياء المدينة بوجوب إخلاء منازلهم بشكلٍ مُستعجل، وتمّ قطع الكهرباء والخدمات عن المنازل والمحلات التجارية كوسيلة ضغط قبل الإخلاء. في بعض الحالات، وخصوصاً في حي غليل، أُعطي الأهالي إنذارات قبل عملية الهدم بأربعٍ وعشرين ساعة فقط، وهي مهلةٌ لا تكفي حتى لاستيعاب هكذا خبر، فما بالك بجمع ما يمكن جمعه من أثاث ومقتنيات. وانتشرت مقاطع فيديو التقطتها طائرة بدون طيار لمساحات هائلة جرت تسوية مبانيها بالأرض في أحياء غليل وبترومين ومدائن الفهد، وشبّه بعض المغردين على تويتر مشاهد الهدم بمشاهد الدمار في المناطق التي تشهد حروباً. وما تزال عمليات الهدم مستمرةً، كما أنها ستشمل أحياءَ أخرى في المستقبل.
وأطلق ناشطون سعوديون العديد من الهاشتاغات على منصة تويتر تحت عنوان «#هدد_جدة»، حيث شاركوا مقاطع لعمليات الإخلاء، ووثّق البعض لحظات وداع منازلهم وشوارع حواريهم. ونتيجة النزوح المُفاجئ لعددٍ كبيرٍ من السكان، تسبّبت خطة الهدم بأزمة عقارية في المدينة، إذ ارتفعت أسعار العقارات بشكلٍ مفاجئ وكبير.
وتنوي السلطات السعودية إنشاء مشروع قلب جدة الترفيهي على ركام أحياء وسط جدة المحيطة بالمدينة القديمة، مركز النشاط فيها وأكثر أحيائها نبضاً بالحياة، وهي منطقةٌ اجتمع فيها الحس التاريخي للمدينة القديمة بالأحياء التي نشأت حولها بشكلٍ عضوي. ويتميز هذا الجانب من المدينة بالتنوع والتمساك، وبروح اجتماعية تفتقر إليها أغلب أحياء منطقة جدة الشمالية الحديثة، التي تتسم بتخطيطها العمراني المتباعد وبمجتمعها قليل التواصل. فعلى الرغم من ضعف البنية التحتية والتخطيط غير المنظَّم لهذه الأحياء، إلا إن البيئة الفيزيائية المتقاربة فيها ساهمت بتعزيز شعور الانتماء والاندماج بين سكانها، وذلك بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والثقافية المختلفة.
العولمة وتأثيرها على العمران الخليجي
حتى نفهم ما يحصل الآن في مدينة جدة، علينا أن نطرح الموضوع في سياقٍ خليجي معاصر. في العقدين الأخيرين شهدت منطقة الخليج موجةً من التغيير والعولمة العمرانية، ابتداءً بمدينة دبي التي سعت جاهدةً لشغل مكانٍ على ساحة التطور العالمي وجذب المستثمرين والمشاريع والسياح، عن طريق دمج الطابع العمراني العالمي بهويتها المحلية العربية. وقد خلقت هذه المدينة حلماً مغرياً جداً للمخيلة الغربية المتعطشة للشرق منذ عقود، فنشأت علامة عمرانية حملت لاحقاً اسمها. وقد سارت الدوحة عاصمة قطر على النهج نفسه، فأصبحت المدن الخليجية تنافسُ شنغهاي وهونج كونج في بناء ناطحات السحاب. وبدورها سعت الحكومة السعودية مراراً، وفي محاولاتٍ فاشلة، لمحاكاة تجربة دبي، كانت أبرزها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض، والتي هُجِرَت بعد مدةٍ قليلةٍ من بنائها، ثم مشروع المدينة الذكية The line في شمال المملكة.
في حالة جدّة خصوصاً، تشكل العولمة والتطوير العمراني الحديث تهديداً مباشراً على هوية المكان، باعتبار أن العمران هو أحد طرق تعبير السكان عن الهوية والثقافة للمكان. ويكمن التهديد في إمكانية طمس التراث الأصيل للمدينة، وفي ذوبان الثقافة الوطنية المحلية في ثقافاتٍ أخرى. لا أفهمُ حقيقةً تصور السلطات بأن النموذج الغربي للعمران هو الشكل المُطلَق للحداثة، وإصرارها على تطبيقه في مدنٍ لا تتناسب مع هذا النموذج بيئياً ومناخياً، وبالرغم من إثبات فشله على مر العقود الماضية.
السياق السياسي
شركة JDURC المُنفِّذة لعمليات الهدم مملوكةٌ لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وولي العهد محمد بن سلمان هو رئيس كلا الكيانين. وجاءت الخطة باستغلال هذه الأحياء وإعادة بنائها ليتم بيع عقاراتها بسعر أعلى، وهو ما حدث مع المساحات المحيطة بالمساجد المقدسة في مكة والمدينة.
تم اقتراح هدم عشوائيات جدة للمرة الأولى عام 2007، ولكن لم يُنفَّذ المقترح لصعوبة العملية وقلق السلطة من ردة فعل السكان. والآن تم اقتراح وتنفيذ خطة «لإعادة تطوير مناطق وسط وشرق وجنوب جدة»، ليتم هدمها وإعادة أعمارها وتحسين بنيتها التحتية بشكلٍ يتناسب مع رؤية 2030. وتتلهف السلطة لجذب السياح الأجانب والمستثمرين و«تحسين المنظر العام»، بحيث لا يشمل هذا المنظر أيّاً من سكان هذه المناطق البسطاء والفقراء ومتوسطي الدخل، أو المقيمين غير الحاملين للجنسية السعودية. وتحاول الدولة جاهدةً منذ عقود إخفاء الفقر والتعتيم عليه، ولكنها غير مهتمة على ما يبدو بالقضاء على أسبابه وتوفير مستوىً معيشي أفضل لسكان هذه الأحياء الفقيرة، فعندما قررت السلطات تطوير البنية التحتية، جاء قرارها بناءً على فوقية طبقية واستغلال لهذه المساحة، ليتم إعادة بنائها واستغلالها لإنشاء مشاريع تدرُّ الأموال على ولي العهد السعودي وحلفائه.
في عام 2020 حدثت واقعةٌ مشابهة في شمال المملكة، وجرى إجبار سكان حي المسورة من قبيلة الحويطات على مغادرة منازلهم، وذلك بحجة إنشاء مشروع نيوم السياحي. رفض المواطن عبد الرحيم الحويطي المغادرة، وأعلن العصيان المدني داخل بيته، فأطلقت عناصر الشرطة عليه النار حتى أردته قتيلاً. اتُّهم عبد الرحيم بالمبادرة بإطلاق النار ورمي زجاجات حارقة على عناصر الأمن، وجرى تشويه سمعته عبر الإعلام الرسمي الحكومي. كما اعتقلت السلطات الأمنية بعد ذلك العشرات من هذه القبيلة، ومن بينهم شقيق عبد الرحيم، كما جرى اختطاف ابن أخيه من مكان دراسته، والسبب هو رفض العائلة الرحيل عن قريتهم.
وحدات سكنية بديلة للمتضررين
أعلنت أمانة جدة عن تجهيز 4781 وحدة سكنية مع نهاية عام 2022 كتعويض للمتضررين من مُلّاك الصكوك العقارية المُتضررين من عمليات الهدم، وهو رقمٌ لا يغطي عدد سكان حيٍّ واحدٍ من الأحياء المهدومة. شخصياً، تدهشني في بعض الأحيان قدرة السلطة وسرعتها في اختلاق المشاكل مقارنةً بتخاذلها الشديد وبطئها المتعمد في إيجاد الحلول. سيتحمّل نصف مليون إنسان عواقب وخيمة لقرارات طائشة وغير مسؤولة، فقد تأثرت حياة سكان المناطق المنكوبة من جوانب متعددة: فبالإضافة إلى مشكلة إيجاد مأوى، عبّر الكثير من الأهالي عن قلقهم بسبب توقف أبنائهم عن الدراسة بعد هدم مدارسهم وعجزهم عن إيجاد مقاعد في مدارس أخرى. يُحدِّثنا أحد المتضررين باكياً، في مساحةٍ فُتحت لمناقشة الموضوع في تويتر، عن الكيفية التي خسر بها منزله وعمله في الوقت نفسه، حيث أن مكان عمله في المنطقة المُقرَّر هدمها، ولم يعد قادراً على تسجيل أبنائه في مدرسة أخرى.
بالمقابل، واجهت السلطات شكاوى المتضررين بالنكران والتعتيم والتضليل، فمنذ أن بدأ النشاط الحقوقي ضد مشاريع الإزالة على تويتر من قبل بعض سكان هذه المناطق وبعض الناشطين، مثل أعضاء حزب التجمع الوطني السعودي، بدأ الذباب الإلكتروني السعودي بنشر الشائعات واستخدام لغة تهيمن عليها العنصرية والطبقية لتبرير هدم الأحياء وتشريد سكانها، وجرى وصف المناطق بـ«بؤر المخدرات والجرائم ومأوى ‘المقيمين غير الشرعيين’».
ولم توفر الحكومة السعودية تعويضاتٍ كافية للمتضررين، أو لم تعوّضهم إطلاقاً في حالات كثيرة، فالحصول على التعويضات مشروطٌ بتوفّر صكوك ملكية كانت الدولة قد أوقفت منحها منذ قرابة ثلاثين عاماً في بعض هذه المناطق. أما الحل المُقدَّم من الدولة فهو عبارة عن شقة على أطراف مدينة جدة تُمنح بموجب عقد استئجار مؤقت، ويُشترط للحصول عليها دفع 90 بالمئة من إيجارها مقدماً. وبغض النظر عمّا إذا كان العقار المهدوم منزلاً أو بناءً من طوابق عديدة، فلن يتجاوز التعويض شقةً واحدة، وذلك إلى حين انتهاء الدولة من تشييد الوحدات السكنية المُخطط لها على أطراف المدينة، وهو ما قد يستغرق أكثر من أربع سنوات.
إن قلة الحيلة ممزوجةً باليأس هو الشعور الذي اختبرتُه أول مرة عندما كنتُ ممسكةً بهاتفي في المنفى، وأنا أشاهد مقاطع لعمليات هدم جزءٍ كبرتُ وترعرعتُ فيه من مدينتي. راودني حزنٌ شديدٌ بعد استيعابي أن المدينة التي نُفيت منها مرغمةً منذ قرابة ثلاث سنوات ستتغير ملامحها إلى الأبد، وبأن أملي في العودة إليها يوماً قد لا يكون مُجدياً حين لا يعود بإمكاني التعرف على مبانيها وشوارعها، أو التجول في أسواقها الشعبية، وشراء البليلة الساخنة من بائعها الجدَّاوي المُسن، أو البسبوسة من باعتها اليمنيين. من الصعب عليَّ تَخيُّلُ التغيير الجذري الذي سيحل بديموغرافية المنطقة، واستبدال سكانها بمجموعة من الأثرياء المُدللين الذين لا يُدركون عمق المكان وعمق ثقافته الراسخة في ذاكرة سكانه القدامى المقصيين والمهمَّشين، أولئك الذين قضوا طفولتهم يلعبون حفاةً في أزقة تلك الحواري، وحفروا على رمالها في مراهقتهم حدود ملاعبهم ليلعبوا كرة القدم، واجتمعوا بعد ذلك في كل عصريّة ليتسامروا مفترشين طرقاتها.
سألتُ إحدى صديقاتي في جدة عما إذا كان قد شمل القرار منطقتهم السكنية، وإذا ما كانت تراودها نفس مشاعر الخيبة. ردّت علي بنبرةٍ يكسوها الحزن: «إيه، القرار شمل حارتنا. الموضوع يُضيّق الصدر. أتمنى ما يجي يوم على جدة ما تصير مدينتنا ونحس فيها بالغربة». شاركتنا صديقةٌ أخرى مقاطع لإخلاء «العمارة الزرقاء»، وهي مبنى في حي الكندرة بجدة قد ارتبط بمظاهر الفرح في ذاكرتي؛ مُجمّع لخياطين متخصصين في تصميم فساتين الزفاف والمناسبات، كنت دخلته لأول مرة في سن العاشرة، حاملةً فستاني ليوم زفاف أختي، كما دخلته في سن الثامنة عشرة لاختيار فستانٍ سأحضر به زفاف أخي، ثم في الرابعة والعشرين لأُصمم روب تخرجي من الجامعة. غريبٌ كيف أنّ هذه الذكريات التي كانت تثير فيّ البهجة أصبحت تثير في قلبي شعوراً شنيعاً بالألم.
في بلدي يزداد الوضع سوءاً يوما بعد يوم، ففي كل مرة تصعد السلطة درجةً على سلّم الاستبداد في ظل صمتٍ عالمي. أتساءل أحياناً: إلى أين سيصل بنا الحال، وماذا بعد تقييد الحريات واعتقال الناشطين والصحفيين والمفكرين والاقتصاديين؟ ماذا بعد هدم المنازل وتغريب سكانها؟ ماذا بعد طمس كل ما يمثّل ثقافة السكان وهويتهم؟ بالرغم من الظلم والقهر ما زال الأهالي خائفين من الصراخ بكلمة «لا» في وجه المعتدي، وإعلان المقاومة والعصيان. أفكر إذا ما كنا سنثور يوماً في وجه هذه الأنظمة الاستبدادية الجائرة، أم أننا سنظل مراقبين نتجرع الظلم بصمتٍ ومرارة.