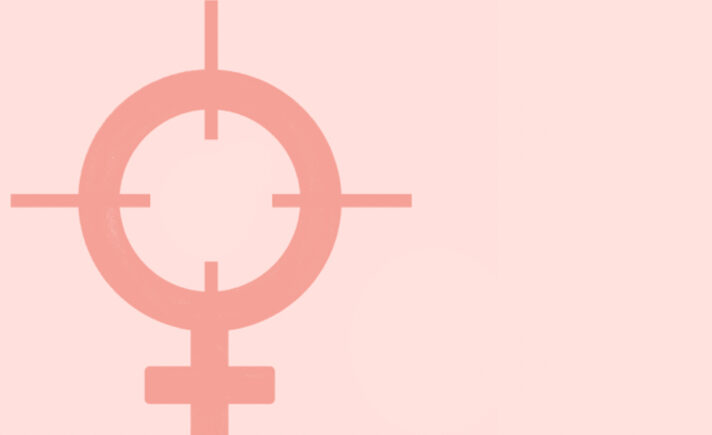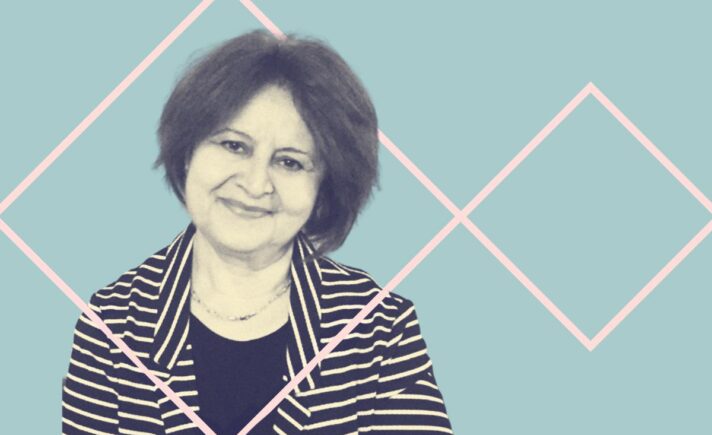أين كنتِ في آذار 2011 يا صبيحة، وأين أودت بكِ دروب الثورة والحرب؟
كنتُ أعمل مدرّسة للغة الإنكليزية في حلب، وأتابع نشاطي النسوي بصمت في مملكة الرعب سوريا، حيث التوجس والشك والريبة والخوف في المدرسة والشارع وفي كل مكان. كنت شاهدة على انطفاء شعلة الحياة لدى أجيال بكاملها، بسبب التسلط والإهمال المتعمد وتدجين العقول. كما كنتُ شاهدة على استعادة بريقها في 2011. بعد المظاهرات في تونس لم تعد الأرض تسعني، أحسستُ أن الهالة حول الديكتاتوريات سقطت، فانتظرتُ بفارغ الصبر أن تنتقل عدوى مطالبات الحرية والكرامة إلينا. رأيتُ بأم عينيّ كيف كان بعض تلاميذي وتلميذاتي يعودون بعد عطلة نهاية الأسبوع من ريف إدلب وريف حلب الغربي الثائر منتشين بالصرخات المنادية بالحرية.
استعدتُ هويتي السورية التي سلبنا إياها نظام البعث بعدما خرج الشباب والشابات وهتفوا: الشعب السوري الواحد! وبعدما نادوا بشعارات تمثّل كل ألوان الطيف والتنوع السوري. قلتُ لنفسي حينها: «إن حزب البعث خدعنا، وإن النظام لم يكن يريد لألواننا أن تظهر، ولكنها ظهرت أخيراً دون أن نضطر لتغيير جلودنا ودمائنا». يقول البعض إن هذه الألوان ضعف، ولكني أراها قوة، لقد حبس النظام مكوّنات البلد في حواضن مهترئة، ومنعهم أن يحسّوا بانتمائهم لبلدهم الأوسع. وُلِدَت سوريتي في اليوم الذي انطلقت فيه الثورة السلمية.
تتخذين في نشاطكِ النسوي والسياسي موقفاً سورياً بالدرجة الأولى، مع أخذ قوميتكِ الكردية بعين الاعتبار بشكل دائم. هذا الموقف المزدوج قد يضعك في مشاكل مع الطرفين أحياناً، فهناك من سيجدكِ لستِ وطنية سورية بما فيه الكفاية، وهناك من سيجدكِ لستِ قومية كردية بما فيه الكفاية. شخصياً أقدّر جداً الشخصيات القادرة أن تجمع بين هوياتها المختلفة وتصبح جسراً بين الأطراف. هل تصويري لموقفكِ صحيح؟ وإلى أي درجة تواجهين صعوبة في تطبيقه فعلاً؟ وما هي الثمار التي تتوقعين أن تجنيها من خلاله؟
توصيفكِ دقيق. لو كنا سنذعن لمقاييس الفئتين اللتين وصفتِهما، سنكون بالطبع بدون هوية من وجهة نظرهم، لأنهم ببساطة أحاديو الوجهة. سأحاول أن أجتهد في تفسير الأسباب التي تقف وراء موقف كلا الطرفين، وهو ما أختلف معه. من يرون أن سوريتي منقوصة ما لم أتنكر لكرديتي هم أصحاب النهج القومجي العربي الذين يختصرون سوريا في العروبة، أي أن السوري-ة هو/هي العربي-ة فقط، وكل المكونات إما أن تنصهر أو أنها ليست سورية بما يكفي! جميعنا أُجبِرنا على قراءة منطلقات حزب البعث في المناهج المدرسية التي تدعو إلى صهر كل المكونات في بوتقة الأمة العربية. اليوم يدرك قسم كبير من السوريين-ات أن مثل هذه المصطلحات التي تدعو إلى جحيم الصهر وتشكيل قوالب الأمة المتجانسة ليست سوى نسخة من الفاشية والنازية التي باءت بالفشل، لا بل يخجل منها مبتكروها في الغرب، وباعتقادي يجب أن يخجل منها الشرق أيضاً، إن أراد أن يخطو نحو مستقبل ديمقراطي يؤمن بالتعددية.
أما الطرف الثاني، فيتمثل ببعض الجهات الحزبية الكردية التي اختزلت القضية الكردية في سوريا بضرورة الابتعاد عن الهوية السورية، لأنهم يعتقدون أن الهوية السورية تقتضي حصراً التنازل عن هويتنا الكردية الأولى التي ولدنا بها، وهذا ليس صحيحاً. وهنا يكمن الفخ الذي وقعت فيه هذه الفئة، واكتملت الحلقة بين الطرفين النقيضين، أَقصدُ القومجيين العرب والكرد، والتي أدت بالكثير من الكرد السوريين إلى الاغتراب واضطراب الهوية. وبطبيعة الحال بتنا نشهد اليوم اضطرابات الهوية السورية ليس لدى الكرد فقط، غير أنها كانت موجودة لدى الكرد سلفاً بفعل التمييز العنصري الذي مارسه النظام على مدى عقود ضد المكون الكردي.
بدأت هيمنة حزب البعث مع انقلاب حافظ الأسد عام 1970، حيث نصّب البعث نفسه قائداً لكامل الدولة والمجتمع، أي أنهما صارا رهينتين لديه. فيما بعد أصبح كل شيء رهينة عند الديكتاتور فقط، الذي اعتُبِر رمز الوطن، وأصبحت سوريا مزرعته الخاصة. فراحت أجهزة الأمن توزع صكوك الوطنية، بل غابت الهوية الوطنية وحلت محلها الاتهامات والطعن بوطنية أي شخص لمجرد الاختلاف معه بالرأي السياسي. لقد أثّر ذلك على كل الناس، واضطرت المكونات الإثنية أو الطائفية أو الدينية أن تخفي هوياتها الفرعية كما لو أنها وصمة عار. استطاع النظام أن يجعل الهوية إما حميدة (هوية الدكتاتور وحزبه)، أو شيطانية (بقية الرعية)، وفق فرز أمني حسب درجة الخطورة.
صحيح أن الشعب السوري ثار على نظام القمع، لكننا لا نقدر اليوم أن نغيّر بجرّة قلم كل شيء ونضع نقطة على السطر، ونقول إن السوريين-ات باتوا متصالحين-ات مع هويات بعضهم بعضاً، فهويتنا اليوم على صفيح نار ساخن، وبدل أن تأخذ فرصتها بالتشكل، نراها تتشظى من جديد نتيجة العسكرة التي بدأها النظام وزكّتها تدخلات الدول، ومفاعيل الثورة المضادة.
أجل، ليس سهلاً أن تحملي أكثر من هوية، وتكوني رغم كل شيء سورية، دون أن تتبرئي من هوية على حساب الأخرى. هويتاي الإثنتان كانتا مقموعتين، حيث لم يكن مقبولاً أن نقول نحن سوريون-ات، لأن السوريين-ات كانوا على درجات، فقط المقربون من السلطة يحملون الهوية الوطنية ويشكلون رموزاً للوطنية. وكذلك هويتي الكردية مقموعة بالأساس وليست مُعترفاً بها، لا بل كانت مجرّمة. كان هناك دائماً قمع يذكّرك بأن حمل تلك الهوية ليس بالأمر السهل. لا أرى أننا كسوريين-ات مطالبين-ات بالتخلي عن إحدى هوياتنا، وأفكر الآن أننا اختلفنا بما فيه الكفاية ويجب أن نوجد التوافقات، لدينا اليوم هوية سورية جديدة تتشكل، وبات السوريون-ات جميعهم يعرفون من أين تمّ الطعن بهم. حتى ولو كان القمع على أساس إثني أو طائفي أو ديني، إلا أنه يصبّ في آخر المطاف في مجرى الصراع السياسي على السلطة. لذلك سخّر النظام الهويات كذريعة ليحكم حيواتنا مروّجاً أن الحرية لا تليق بنا.
إن كان هناك ميزة للهوية التي أحملها، فهي صفة التنوع. فالهوية المركبة المتصالحة مع كلا انتمائيها، دون أن تُحدث إحدى الهويتين إلغاءً للأخرى، تعبّر عن صلابة الجسر الذي يشكله الأشخاص الذين يتميزون بهذه الميزة. هم قادرون على نقل الرسائل الإيجابية على طرفي النقيض، من أجل خلق أجواء التقارب وسبل العيش المشترك والاحترام المتبادل.
تكلمتِ حتى الآن عن مصادرة النظام للهوية الوطنية، ولكن هل تواجهين صعوبات بالجمع بين الهويتين السورية والكردية من قبل السوريين أنفسهم؟
أعتقد أن الأزمة السورية الهوياتية باتت ظاهرة للعيان، وهذا قدر كل الشعوب التي تسممت بالحروب الأهلية. صحيح أننا استهللنا الربيع العربي بثورة ضد الاستبداد، لكن علينا أن نرى الحقيقة المُرّة التي وصلنا إليها، والتي لن أدخل في تفاصيلها الآن، ومفاعيلها على الهوية، التي أدت إلى مزيد من التشظي، ولذلك فالصعوبات موجودة. هناك حرب هوياتية على الجغرافية السورية، وعمليات تنحية حد الإبادة، وبعض الصحوات الموغلة في التاريخ الآسن لصراعات طائفية وإثنية، وكأن مقارعة الاستبداد لدى البعض تعني العودة إلى أسفل درك من التاريخ الدامي الغابر. دعيني أقول شيئاً أؤمن به بقوة: إن لم توفر الهويةُ الكرامةَ للإنسان ولم تصُن الحرية، فستبقى تفصيلة تضاف إلى باقي التفاصيل الصورية التي يعج بها المشهد السوري. باختصار أنتمي إلى حيث تصان كرامتي الإنسانية، وأحلم بسوريا الوطن التي تحتض كل مواطنيها-اتها على القدر نفسه من المساواة، بدون أي شكل من أشكال التمييز.
هناك فكرة مفادها أن وضع المرأة الكردية أفضل نسبياً من وضع نساء المنطقة الأخريات. من أين جاءت تلك الفكرة، وهل هي صحيحة في رأيكِ؟ وكيف تقيّمين وضع المرأة الكردية مقارنة مع نساء المنطقة الأخريات قبل 2011 وبعدها؟
تتأثر الثقافات المتجاورة ببعضها بعضاً، إن كان في تعاملها مع النساء أو مع أي قضية أخرى. ولكي لا أذهب بعيداً، سوف أطرح مثالاً رغم قسوته، لكنه يبقى الأفضل لإثبات وجهة نظري: جرائم قتل النساء التي تحدث بين الفينة والأخرى في عفرين وإدلب المتجاورتين. أظن أن نسب جرائم قتل النساء في تلك المنطقتين أعلى من بقية المناطق. فعفرين بغالبيتها الكردية، حيث ترتدي النساء ملابس عصرية منذ سبعينات القرن الماضي، تقتل نساءها باسم الشرف. وكذلك إدلب المعروفة بطرازها المحافظ تجاه النساء تسلك التقليد نفسه ولذات الحجة. هذا يقودنا إلى أن ثمة تشابه في أشكال القمع الواقع على المرأة. وما ينطبق على جرائم قتل النساء يسري على قضية حرمان المرأة من الميراث أيضاً، فالمرأة الكردية مثلها مثل بقية نساء الريف السوري عموماً لا ترث إلا لماماً. ويمكنني الاستشهاد بمقاربة أخرى من محافظة السويداء، حيث كنتُ مقتنعة حتى زمن قريب أن النساء فيها حاصلات على حقوقهن، لكن حين احتككتُ من خلال نشاطي النسوي مع ناشطات من السويداء، سرعان ما أظهرن لي الصورة الحقيقية لواقع النساء هناك، والذي يصل أيضاً حد القتل والحرمان من الميراث. وفي مثال السويداء هناك تشابه في بعض الفرص الإيجابية، كالتعليم وحرية ارتداء الملابس العصرية، التي تشبه نساء عفرين. إذن الأمر أعقد من مجرد الحكم على المظهر الخارجي، بل يجب أن نتعمق في جذور التحكم البطريركي الذي يعتبر النساء جزءاً من ممتلكات الأسرة والقبيلة والمجتمع.
نعم، هناك مجالات حققت فيها المرأة الكردية قفزات ملموسة. ويمكننا القول إنها تقدّمت من ناحية التعليم وحرية الملبس، إلا أني لا أدري إلى أي درجة يمكننا اعتبار الزي مقياساً. صحيح أن طريقة الخروج في الفضاء العام، أو في المساحات الممنوحة خارج المنزل، يمكن أن تكون مقياساً، ولكن طريقة التحكم الذكورية لم تشهد تغيراً ملحوظاً من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية. فالمرأة الكردية هي ملك الأسرة والحزب والمجتمع، وهنا تتقاطع مجمل هذه الدوائر في فرض سطوتها بوسائل مختلفة.
هل تغيّرَ وضعُ المرأة الكردية بعد الثورة. هل اتسعت أو تقلّصت الفجوة بينها وبين نساء المنطقة الأخريات؟
التغيير الذي طرأ على المرأة الكردية يشبه ما حصل مع سائر المجتمع السوري، ولكن ثمة أمراً يزيد سوءاً عنه. أقصد هنا عسكرة المرأة الكردية والمجتمع الكردي. في بقية المناطق تمت عسكرة الرجال فقط، أما لدينا فقد تمت عسكرة النساء والرجال على حدٍ سواء. وهذا يضعنا أمام آفة مجتمعية كبيرة، توسّع الفجوة بين الذين انضموا إلى العسكرة والذين لم ينضموا. بعض الناس يقولون إن المرأة اكتسبت القوة عبر العسكرة، وخرجت من دور الضحية، ولكني أرى الأمور بطريقة مختلفة، فحين يتمدد النمط العسكري في حياة المجتمعات، تقلّ فرص الحوار والتوصل إلى حل المشاكل عبر الوسائل السلمية.
تقولين في بحثكِ «واقع المرأة الكردية وبدعة النسوية الأبوجية» إن تكريس نمط عسكري للنسوية الكردية عمِل على إجهاض أي حراك نسوي كردي. كيف تم ذلك؟ وألم يتبقَ فعلاً أي مجال لنوع آخر من النشاط النسوي الكردي المدني؟
يأتي إجهاض النمط المدني من انبهار الناس بالعسكرة التي تم الترويج لها داخل سوريا وخارجها. صار حاملو السلاح متحكمين بمقاليد الأمور، والعسكرة هي الأمر الواقع في كل مكان في سوريا. لو أخذنا أي منطقة سورية، سوف نرى أن حامل السلاح هو المتحكم بحيوات الناس، وهو صاحب الصوت الأعلى، وقراراته هي النافذة. ولهذا السبب تضطر الأصوات المدنية أن تعارك كي تجد لنفسها موطئ قدم، أو تنكفئ على نفسها. البعض يقول من باب الاستخفاف بالشأن المدني: «إذا أردتَ أن تفعل شيئاً، فاحمل السلاح! هذا الزمان ليس زمان العمل المدني». العِبرة في هذا الكلام هي أن تكون إما قاتلاً أو مقتولاً! هذا كله نتيجة وعي قاصر ورؤية قاصرة لمقاليد الأمور، وفي استسهال العمل العسكري، لأن استخدام الأدوات الذكورية أهون من الاشتغال التدريجي، فالعمل المدني بطيء ومضن، ويستهلك جهداً أضعاف ما يتطلبه العمل العسكري.
ارتبط العمل العسكري بالنسبة للنساء والرجال بمنظومة كاملة لها علاقة بأسطورة الاستشهاد ورفع الأموات/ الضحايا إلى مصاف الملائكة والقديسين. هذه القداسة تجعلهم غير قابلين للنقد، وتمنع الناس من النقاش، حتى ولو كان الشهيد قد حارب دون إرادته أو تمّ اختطافه بالأساس. العمل العسكري في أحد أوجهه، هو صناعة قديسين وقديسات غير قابلين للنقد والنقاش، لصالح حزب أو جماعة، وكلما ازدادت أعداد الضحايا، كلما ازداد نفوذ ذاك الحزب. أما العمل المدني البشري، فلا يوصل أصحابه بهذه السهولة للتقدير المجتمعي المطلوب. وقد وصلت الأمور أنه صار من الصعب أن تعملي دون أن تحصلي على رضا أصحاب السلاح، وهذا حال كل سوريا، وليس مناطق الإدارة الذاتية فحسب: أي عمل مدني يحتاج إلى موافقة حَمَلة السلاح.
تفصلين في بحثكِ بين المقاتلات الكرديات والنسوية، بل تشككين بانتماء المقاتلات إلى التيار النسوي بالعموم. ما السبب؟ وهل هذا يعني أنك لا توافقين على أن النسوية يمكن أن تترافق مع حمل السلاح؟ هل النسوية حراك سلمي بالضرورة؟
حاولتُ أن أبحث إن كان ثمة تواجد لجذور العسكرة في الفكر النسوي والفلسفة النسوية، وتناقشتُ مطولاً مع نسويات، وكنتِ واحدة منهن. ولكني لم أجد رابطاً بين النسوية والإيمان العسكري، بل على العكس، فقد ثبت لي انتقاد روزا لوكسمبورغ للعسكرة، وكذلك حنة آرنت انتقدت اتباع العنف بشدة.
لدينا اليوم القرار 1325 للأمم المتحدة الذي يتحدث عن مشاركة المرأة في عملية السلام والأمن. ولكن حتى هذا القرار يقول إن الحكومات هي المعنية بالدرجة الأولى بأن تأخذ المنظور الجندري في موضوع الأمن والسلم، وإصلاح مؤسساتها لتكون مهيأة لإدماج النساء واتباع منظور النوع الاجتماعي، عبر مشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني، وليس عبر تشكيل ميليشيات نسائية مؤسّسة على الطريقة الذكورية، والتي تُقحَم فيها النساء وفق منظور أيديولوجي.
أرى النسوية كتيار لا عنفي، ومن خلال قراءاتي ونقاشاتي توصلتُ إلى أنه ليست ثمة جذور عسكرية للنسوية، ومن هنا فصلتُ بين المقاتلات الكرديات والنسوية، حاولتُ أن أكون موضوعية قدر الإمكان وتوخيت الحذر في طرحي.
أنتِ تفصلين بين السلاح والنسوية معتمدة على قراءاتكِ ونقاشاتكِ. ولكن ماذا يقول حدسكِ الخاص؟ إذا نسيتِ كل ما سبق، وحاولتِ أن تحللي المسألة من داخلكِ، هل ستتوصلين إلى أن النسوية حراك سلمي بالضرورة؟
إن لم تكن النِسوية حراكاً سلمياً بالضرورة، فلن يكون ثمة خلاف بيننا وبين الذكوريين. أعتقد أنه فات على النسوية أن تستخدم الأساليب العنفية، لأن العالم وصل اليوم إلى حد التخمة من التسلح، وأخذ كفايته من العنف، إلى درجة أننا صرنا أمام احتمال انفجار الكوكب من شدة التسلح والتسمم التكنولوجي. لذلك لن تأتي النسوية لتزيد هذا التسمم تسمماً. لا أعتقد أن ثمة نسوية عنفية، فأحد أوجه الخلاف النسوي مع النظام البطريركي هو تقديسه للقوة والعنف، ومحاكاة أسلوبه سيفضي بالتأكيد إلى خسارة الشرط الأخلاقي الذي تستخدمه النسوية في تبرير كفاحها ضد البطريركية. وما ينطبق على المنظور النسوي لا يعني بالضرورة أن النساء جميعهن حمامات سلام، هن بشر مثلهنّ مثل الرجال تماماً، منهن المسالمات والعنيفات. غير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يطال المرأة بسبب نوعها الاجتماعي هو ما نكافح لانتفائه في مجتمع يسوده العدالة والمساواة التامة.
تحيط المقاتلةَ الكرديةَ هالةٌ من الرومانسية في المخيلة الغربية، حتى تكاد صورها الجميلة في الإعلام الغربي تغطي على الألم والنواحي الأخرى من القضية. يحصل ذلك رغم أن الإعلام الغربي لا يحيد في الحالات الأخرى عن تفضيله الشكلي للكفاح اللاعنفي في الشرق الأوسط. من أين جاء ذلك الافتتان في رأيكِ؟ وما تقييمك للظاهرة ككل؟
أرى أنه نوع من الرياء الغربي تجاه الجميع عموماً. بالنسبة للكرد، كان هناك ترويج كبير وواضح لدفعهم نحو القتال، وتحديداً قتال داعش. المعادلة غير عادلة وخالية من الأخلاق، ذلك أنه معروف عن الأكراد أنهم يحملون مظلومية تاريخية جرّاء تقسيم الغرب لمنطقة الشرق الأوسط إلى دويلات وتجاهله حلّ القضية الكردية، ليتركها مثاراً للحروب والتدخلات والنزاعات المستقبلية. ويأتون اليوم بعد أكثر من مائة عام ليهللوا لصور المقاتلات الكرديات، مع أنهم يدركون أنها سوف توضع جانباً ولن تكون مفيدة على طاولات مفاوضات السلام.
في المقابل، وكما قلتِ، يبرز الغرب دائماً ميله للكفاح اللاعنفي، هذه الصورة المتناقضة رأيتها عشرات المرات وواجهتها هنا في أوروبا. النساء الغربيات يحتفين بنا لأننا نحارب داعش، بينما أرى عيونهنّ تبحث عن السلاح الخفي على كتفي، كما لو أن كرديتي تستوجب أن أكون مسلحة حتماً. إن كنتُ كردية، فيجب أن يكون ثمة سلاح على كتفي، وإن كنتُ محجبة، فيجب أن يقبع خلفي سيف من سيوف داعش. هذا تنميط استشراقي، أو سَمِّه ما شئتِ. من المفروض أن يكونوا أخلاقيين معنا كما هم أخلاقيون مع أنفسهم، لأن القيم الإنسانية لا تتجزأ، بمعنى أنه ما يصحّ من الكفاح اللاعنفي في أوروبا، يجب أن يصحّ كذلك في الشرق الأوسط. ولكي يكونوا صادقين مع أنفسهم، ينبغي أن يروّجوا له عندنا أيضاً. نحن نستحق الحياة مثلهم، ونستحق أن نختلف مع بعضنا بعضاً بطرق سلمية، وأن نحلّ خلافاتنا بطرق سلمية، كما يحلّون خلافاتهم بطرق سلمية. من المهم أن نسأل إلى أي درجة يفكرون أننا جديرون باستخدام وسائل الحل السلمي والسبل اللاعنفية في حل خلافاتنا.
لا بد من التطرق كذلك إلى كتابات أوجلان، وبخاصة كتابه جينولوجيا (علم المرأة) الذي تناولتِه في بحثك. من أين جاء اهتمامه بالمرأة إلى درجة أنه كتب عنها أكثر ممّا فعلت أي امرأة في التاريخ الكردي الحديث والقديم؟ وهل ثمة تقاطع فعلي بين الهم القومي والهم النسوي لدى أوجلان؟ أم أنه استثمار نفعي لقضية المرأة؟ وهل يمكننا القول إن وضع المرأة تحسّن فعلاً في المناطق التي سيطر عليها؟ وكيف؟
تصعب مناقشة كتابات عبد الله أوجلان فيما أنصاره يعتبرون كل أقواله بمثابة مقدسات. مناقشة كتاباته بالنسبة لهم بمثابة المساس بالنصوص المقدسة. ومع ذلك سوف أحاول أن أقترب من هذه القضية في مخاطبة العقول، وفي تناول خلاف فكري بالدرجة الأولى.
قبل أن أتكلم عن الجينولوجيا، أريد أن أعود إلى كتاب آخر لأوجلان صدر في تسعينات القرن الماضي. إن لم تَخُنّي الذاكرة كان عنوانه «كيف نعيش؟». قرأته في وقتها، ولم يكن وعيي النسوي قد نضج إلى هذا المستوى. لم يعد الكتاب متداولاً حالياً، يوجد موقع إلكتروني يحتوي غالبية كتبه، ولكن هذا الكتاب غير موجود بينها. سأحكي لكِ مضمونه، ولكني سأستقي من ذاكرتي فقط.
في جزء من ذلك الكتاب يحكي أوجلان عن علاقته بوالدته. لم تكن علاقته مع والدته جيدة، هو منحاز لوالده ضدها. لم يكن يراها وفيّة، لأنها بحسب ما أورده، تسرق من بيت زوجها لتعطي بيت أهلها. وقد شبّه والدته بطير حمام أو دجاجة تستحق نتف ريشها، لأنها تبيض في بيت الجيران. كان هناك تشبيه بين صورة والدته وصورة ذلك الطير. فضلاً عن قوله حرفياً إن المرأة الكردية تنبعث منها رائحة كريهة. ما يقوله في كتابه ذاك يجعلكِ تستغربين ما كتبه عن المرأة بعد دخوله السجن، ذلك أنه راح يكتب عن الأمة الديمقراطية وسوسيولوجيا الحرية، ومن ضمنها الجينولوجيا.
أما بالنسبة إلى النساء اللواتي تواجدن في دائرة أوجلان المباشرة، فقد كانت هناك امرأتان أو ثلاث نساء فاعلات حين تأسّس حزب العمل الكردستاني. الغريب في الأمر هو أنه صار على خصومة مع هؤلاء الكادرات المؤسِّسات، ومن بينهن زوجته كسيرة يلدريم، وطالها بالتخوين، وثمة قصصٌ ما زالت تُروى عنها. ما أريد قوله هو إن علاقة أوجلان مع النساء شائكة جداً، وأعني بالتحديد تلك الدائرة القريبة من النساء الحزبيات. لقد حوّلهن جميعاً إلى خصوم، ونال منهن بطرق تخوينية. فضلاً عن أن القارئ يلاحظ من كتاباته نوعاً من أنواع تسخير للمرأة. يقول البعض إن هذا التسخير هو في سبيل نهضة شعب، ولكني كامرأة أرى أن ثمة مشكلة حين يتناول رجل ما قضية المرأة بهذه الدرجة من التدخل، ولكن من دون مشاركة المرأة ذاتها.
ولكن هناك من يقول إن وضع المرأة تحسّن في المناطق التي بسط أوجلان سيطرته عليها. ما رأيكِ؟
هناك من يقول إن الوضع تحسّن، وهناك من يقول إن الشرخ بيننا وبين المجتمع ازداد اتساعاً، وهناك من يقول إن ثمة فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق. فمشكلة الكوادر الأميّة، على سبيل المثال، خلقت مشاكل لا حصر لها. الأمر أشبه بتنفيذ عملية جراحية معقدة من قبل ممرضين مبتدئين.
منذ فترة تواصلتُ مع نساء من داخل منطقة الجزيرة. سألتهنّ عما يسمّى ببيت المرأة، وما إذا كنّ يلجأن إليه إن تعرضنَ للعنف، وقد أجبنني أنهنّ لا يفعلنَ ذلك خشية أن تُستثمر قضاياهنّ بطرق سياسية. فإذا كان زوج المرأة ينتمي إلى كوادر حزب PYD، فمن الممكن أن يتم تجاهل القصة. أما إذا لم يكن الزوج من الحزب، فسوف يصبّون مزيداً من الزيت على الموضوع، فيصبح التدخل نوعاً من التشفي، وليس مسألة تحقيق العدالة.
فضلاً عن أن عسكرة النساء شكّلت فجوةً بين المقاتلات والمجتمع. من ناحية تدهور وضع النساء اللواتي كنّ في القاع أصلاً، ومن ناحية أخرى شكلت المسلحّات طبقة مختلفة تماماً. طالما الغلبة هي لصوت السلاح، فلا أحد سوف يستفيد شيئاً. على سبيل المثال، بتُ أسمع مؤخراً عن أطفال وطفلات ينتحرون، ولا أدري هل ينتحرون فعلاً بسبب توفر السلاح، أم يتم نحرهم؟ لعلّ جرائم القتل باسم الشرف تحوّرت في شمال شرق سوريا إلى قصص انتحار. يبدو أن المجتمع صار يمتلك أدوات جديدة لقمع المهمشين جرّاء الشر المتوفر على الأرض، أي السلاح. لا شك أن ثمة طبقة جديدة استفادت من الظروف وشكلت حولها فئة من المستفيدين والراضين بالقوانين الحالية، إلا أن القاعدة المجتمعية غير قادرة على الاستفادة من الأوضاع الراهنة. أما موضوع خطف وتجنيد القاصرات من كلا الجنسين، فقد باتت تقضّ كاهل المجتمع الكردي هناك. باعتقادي المجتمع الذي يعجز عن حماية الأطفال لن يكون له محاسن، إلا إذا كانت المحاسن تبنى بالضرورة على كاهل أحلام الطفولة ومصادرة حقهم في حياة كريمة تحميهم من العنف.
كيف تقيّمين التعاون بين النساء الكرديات والنساء المنتميات للإثنيات الأخرى بشكل عام؟ وهل ثمة «أفق» تعاون فعلي بين الكرديات والعربيات على المستوى الفردي والمنظماتي؟ وما هي العقبات التي قد تقف في وجه ذلك التعاون من الجهتين الكردية والعربية؟ وما هي توصياتكِ بهذا الخصوص؟
من خلال تجربتي النسوية والسياسية لم أعزل نفسي يوماً عن الفضاء السوري العام، هذا هو فضائي الذي أتحرك فيه. من ناحيتي، أرى أن هذا التعاون موجود رغم الانتكاسات التي مررنا بها جراء الظرف الحالي، وحين أقول الظرف الحالي، فلا أستثني ظروف الاستبداد القهرية لعقود، والتي جعلت الناس متقوقعة على نفسها وغير شفافة أو منفتحة على الآخر.
كانت حواضننا السابقة لا تجاهر بعدم التعاون، وكان هناك نوع من الكمون، الجميع مقموع في ظل الاستبداد. أما بعد تحول سوريا بأسرها إلى ساحة صراع، فقد بدأ المزج المجتمعي. وكما أشرت، فالسوريون بدأوا يتعرفون على بعضهم بعضاً، وصرنا نندهش ببعضنا بعضاً، ثمة صور نمطية أُلغيت، وصور نمطية جديدة تشكلت. ورغم مختلف الظروف نشأ هذا التعاون، واستطعنا ملامسته على أرض الواقع فعلاً. كنتُ من أوائل النساء اللواتي انخرطن في العمل مع منظمات نسوية سورية، وكذلك بتأسيس منظمة نسوية كردية مستقلة في عام 2005، ودون تبعية حزبية كما جرت العادة.
حين دعتني بعض الصديقات لتشكيل مبادرة «أصوات نسوية كردية»، وافقت على الفور، ورحبتُ بالفكرة لأن النساء راغبات بالخروج عن الجانب الكردي الرسمي، أي ما يدور في إطار الأحزاب السياسية. هذا الفضاء خلق نوعاً من التعاون والانسيابية في الانخراط مع العديد من المنظمات السورية الأخرى. تقييمي لهذه التجربة وغيرها من التجارب إيجابي، لأنها تترك مساحات التلاقي الحرة مفتوحة، وتحفّز على البناء التشاركي، وتضمين رؤية الجميع، وتظهير التنوع بصورته اللائقة في الفضاء النسوي السوري، الذي أصبح يشكل وزناً على الساحة السورية عموماً.
هل لديك توصياتِ بخصوص التعاون بين النسويات الكرديات والنسويات العربيات؟
كتبتُ منذ فترة عن أن النسويات مطالبات اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يشكلن ما أسميه بالسور النسوي. لا بد أن جميع النسويات لاحظن مؤخراً تلك الهجمة المضادة التي تجرّم النسوية وتضع كل شرور الوضع السوري في الحراك النسوي تحديداً، هذا يتطلب من النسويات أن يتحملن مسؤولية التضامن. ينبغي أن تكون إلى جانب كل نسوية فاعلة عين ثالثة ترى بها. كيف يحصل هذا التضامن؟ على سبيل المثال، إذا رأينا أن واحدة تتعرض إلى شكل من أشكال التنمر أو التعنيف، فالحراك النسوي مطالب أن يخلق سوراً آمناً للتضامن معها، حتى ولو حصل ذلك مبدئياً على صفحات التواصل الاجتماعي فقط. هذا التضامن يجعل واحدتنا لا تنزوي وتواجه المشاكل بقوة. هذه القوة تستمدها من القوة الجماعية للحراك النسوي، والتي ستجعل كل من تسوغ له نفسه الاستسهال في ممارسة شكل من أشكال العنف أن يحسب حساباً لموجات الغضب والتضامن التي ستكبح هذا السلوك، بالوقوف إلى جانب الضحايا والناجيات.
أوافقكِ على كل كلمة قلتِها، ولكنكِ تتكلمين عن النسوية بالعموم. لا أدري لماذا توقعتُ منكِ كلاماً حول الوصائية التي تمارسها بعض النسويات العربيات على نظيراتهن الكرديات، والتي ذكرتِها باقتضاب في بحثكِ الأخير عن واقع المرأة الكردية.
في بحثي سردتُ حادثة جرت معي في 2004 إثر المظاهرات الكردية بعد افتعال حادثة الملعب من قبل استخبارات النظام السوري. قلتُ إن البعض يرى نفسه وصياً في الحراك النسوي، كان غرضي بالدرجة الأولى هو تدوين سردية كانت شفاهية، ودونتها لحفظ الذاكرة.
نحن نعلم أن أول من تكلّمن بشكل علني عن هذه الوصائية هن النسويات السوداوات، في انتقاد للنسوية البيضاء التي ترى نفسها مالكة المساحة، وتمنح جزءاً منه للسوداوات لكسب الشرعية، وإطلاق صفة التنوع على نفسها، وقد أشارت كرينشو إلى ذلك بوضوح. الوصائية سلوك ذكوري يتخذ من المركزية جذراً لفرض هيمنته. وانتقال هذا السلوك إلى الضفة النسوية، أي انتعاش بذور الذكورية في بيئة يفترض أنها تؤسس للمساواة والعدالة وانتفاء التمييز، هو أمر خطير ينبغي كبحه.
بشكل عام الوصائية في سوريا كانت موجودة دائماً، حيث الديكتاتور يعتبر نفسيه وصياً على المجتمع بأسره، وهكذا يكون حزبه وصياً على الجميع من بعده. هذه الهرمية المتغلغلة في النظام السوري تجعل الوصائية تنزل من الأعلى إلى الأدنى وتصل كذلك إلى المنظمات. فحين يكون المجتمع بطريركياً، ستفرض الهرمية تقسيماً عمودياً وأفقياً، وحين يكون أحدهم أعلى منكِ بنصف سنتمتر، سيتحكم بكِ بهذا النصف سنتمتر الذي يعلوك به. أخمّن أن زميلاتي اللواتي استجوبنني إثر المظاهرات الكردية كنّ واقعات تحت نفس التأثير الهرمي. سألنني: «لماذا نزل الأكراد إلى الشارع؟ ومن نادى بالشعار الفلاني؟ ولماذا نظمتِ ورشة عن الجندر في تلك الأثناء؟». وقتها كان هامش الحراك المدني والحقوقي أضيق من أن تدرك المنظمات السورية على قلّتها أن هذا السلوك محاكاة لسلوك النظام، وليس جزءاً من مهامها في تحقيق المساواة التامة بين الجميع أفراداً وجماعات دون تمييز.
لكن ما يبشّر بالخير ورغم المآسي، هو أن هذه الوصائية قد كُسِرت ضمن القوالب التي كُسِرت منذ انطلاقة الثورة في 2011، وكتابتنا عنها هي نوع من رفع الغطاء عن هذه السلوكيات التي لم تعد مقبولة، ويجب أن تموت مثلها مثل كل ما يمت لإرث الاستبداد بصلة.
تعملين حالياً ضمن منظمات نسوية تتبنى خطاباً سورياً شاملاً قدر الإمكان لجميع أفراد المجتمع السوري. هل فِعل تلك المنظمات وأفرادها يتطابق مع خطابها في رأيكِ؟
لا يمكن أن نتوقع أداءً مثاليّاً لمنظمات المجتمع المدني، والاقتتال اليومي بين مختلف الفصائل والتشكيلات العسكرية لسان حال الميدان، فالحرب التي تدار بالرصاص على الأرض يديرها البعض الآخر بالمال السياسي والولاءات العابرة للحدود في مجالات أخرى. ولكي لا ننظر إلى الجانب القاتم فقط، ينبغي علينا التركيز على الفئة التي عاهدت نفسها، رغم كل شيء، أن تجتمع على لململة جراح السوريين-ات جميعاً، والمنظمات النسوية تحاول فعل ذلك عبر بناء توافقات ضمن الخلاف الواسع الموجود على الأرض. تلك التوافقات ليست سهلة على الإطلاق، ولكن على الأقل نحن نحاول أن نفتح الحائط المسدود الذي بناه الاستبداد لعقود، وأجّجته سنوات الحرب الإحدى عشرة. نحن نشتغل يومياً على بناء إجراءات الثقة المفقودة بسبب ما ذكرتِ. حتى الآن نحن قادرات أن نحقق هذا التوازن في المنظمات النسوية، أو على الأقل على مستوى الحركة السياسية النسوية. نشتغل منذ عام 2017 واستطعنا أن نقف على أرجلنا أخيراً. هذا ليس سهلاً، ولكني أعتقد أننا استطعنا خلق ذلك التوافق، المبني على معادلة بسيطة، وهو أن تكون بوصلتنا الوقوف مع السلميين-ات، وعدم الانجرار خلف التخندق العسكري الذي أثبت أن ولاءه لا يقف عند حدود سوريا، بل خلفها. مثلما أثبت جيش النظام أنه قاتل الشعب، وليس حاميه. من جهة أخرى هناك العديد من المنظمات النسوية التي باتت تسعى إلى خلق شبكات عريضة تجتمع على أهداف مشتركة، لأن الجميع أصبح يقرأ صورة الضعف في التشتت الحاصل.
هل تتوقعين أن يكون للنسوية دوراً في معالجة تشظي الهوية السورية على المدى البعيد؟ وكيف؟
في رأيي إذا استمرينا بهذا الزخم، فسوف يكون للنسويات مساهمات في صياغة دولة سوريا الحديثة، بما في ذلك الهوية السورية. ولكن إذا خطر لنا في لحظة ما أن نترك الساحة العامة، فلن يتحقق شيء من ذلك، لذلك نحن لا نملك رفاهية تركها في الوقت الراهن. من ورائنا يتمرس إرث نظام استبدادي متوحش، يحاول بكل ما أوتي من تسلط العبور إلى مستقبل البنات والأبناء، وراهننا محكوم من قبل قوى أمر واقع تزيد بؤس المشهد، هي الأخرى نسخ قزمية من ذاك النظام، حتى لو اختلفوا بالتفاصيل، لكنهم متفقون على الشكل الاستبدادي الهرمي والقمعي. اليوم باتت محاولاتهم أشد وضوحاً في إجهاض أجنة التغيير، ورفض القطع مع الاستبداد، أولئك هم أنفسهم من شرعن حرق البلد لصالح بقاء الأسد (الأسد أو نحرق البلد)، أو علل فشله ووجهّه صوب لباس المرأة (تبرجك يؤخر نصرنا)، أو الذين اختصروا حرية المرأة في شخص الزعيم (حرية المرأة هي حرية القائد آبو).
من المؤسف أنهم ماضون في تأهيل أنفسهم لحكم مستقبل البلد، إذا انسحبنا من المساحة التي خلقناها، والتي يجب أن تبقى موجودة، فسلطات الأمر الواقع موجودون في جميع الأحوال. وبطبيعة الحال لاحظ السوريون-ات دورهم الفتاك المدمر، المنسجم والمكمّل لدمار النظام ضد شعبه. وذلك ما أدى إلى تدمير روابط الهوية السورية وتفكيكها إلى عوامل بدائية عبر القهر والظلم الذي مارسوه بحق المدنيين-ات العزل، وخلق حواجز رسموها بالدم في فوضى انتشار السلاح.
شخصياً، ومنذ أربع سنوات، لدي تجربة في صياغة أوراق سياساتية في الحركة السياسية النسوية السورية وما زالت مستمرة. نجري خلالها مشاورات وطنية مع النساء السوريات من مختلف المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة شتى قوى الأمر الواقع. أستطيع القول إن النساء بفطرتهنّ أكثر جرأة في توصيف الواقع بدون رتوش، ومن ضمن المواضيع الكثيرة التي ناقشناها كان موضوع «الهوية الوطنية والعقد الاجتماعي والسلم الأهلي». ومن المفارقات المحزنة أن السوريات اللواتي شاركن في النقاش التقين على رابط الألم والأمل بالهوية السورية، حيث ليس هناك من لم يخسر في هذه الحرب الدامية، والجميع يأمل بوقف الحرب والعيش بكرامة. لذلك أرى أن إيصال هذه الأصوات إلى صناع القرار واستنباط المستقبل من رؤيتهن هي مهمتنا في منظماتنا النسوية، عبر تكريس بصمة النساء السوريات في صياغة الهوية الوطنية السورية.
لا شك أنكِ كجميع السوريين والسوريات عانيتِ من القهر والحزن والفقدان، ما هو الشيء الذي يجعلكِ تواصلين رغم كل شيء؟
ما يدفعني للاستمرار هي تلك المساحة التي ذكرتها منذ قليل، والتي ينبغي ألا نتركها لأمراء الحرب أو لنظام الاستبداد، كي لا يعيدوا تأهيل أنفسهم. نحن لدينا مساحة شغلناها بجهدنا وتعبنا، وأثبتنا أننا جديرات أن نكون بالموقع المناسب من أجل التغيير، وجودنا ضمانة للتغيير الديمقراطي الحقيقي، وليس مجرد لعبة لتبديل صور الطغاة. يعتبر وجودنا كنساء حاملات للفكر النسوي صمّام الأمان نحو الدولة الديمقراطية التعددية لجميع السوريين والسوريات.