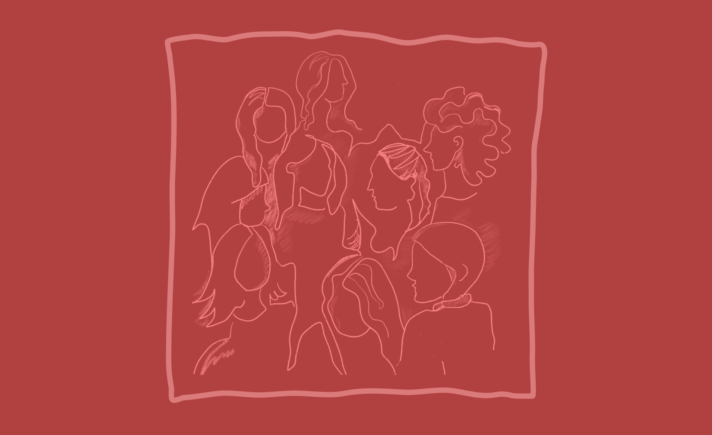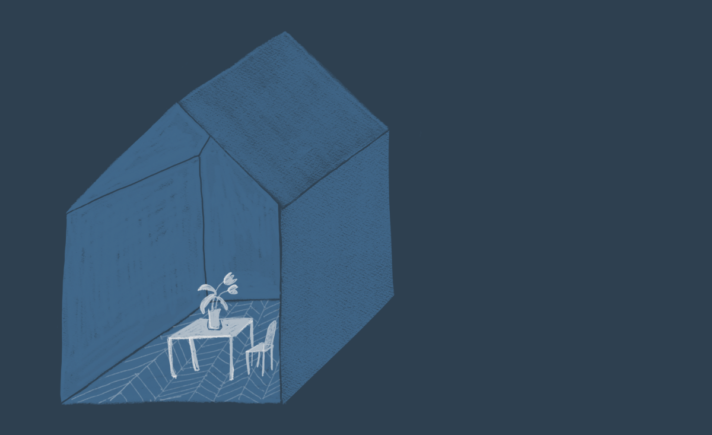مثّلت ثورة كانون الأول (ديسمبر) 2010-كانون الثاني (جانفي) 2011 علامة فارقة ومنعرجاً حاسماً في تاريخ الأدب التونسي المعاصر، لما وفّرته من هامش واسع لحريّة الرأي والتعبير، وما أتاحته من ممكنات تعبير ما كانت لتتوفّر بالقدر الكافي طيلة الحقبة التي سبقتها، بسبب الرقابة السياسيّة المفروضة على دور النشر والمحاذير المضروبة على أقلام الكتّاب. فشهدت الساحة الأدبيّة طفرة هائلة في الإنتاج والتلقّي، وتنوّعت مواضيع الكتابة التي غطّت كافة المجالات من سياسة ودين ونقد ورواية وشعر وقصّة، وبرعت عديد الأقلام التي كانت تتنتظر اللحظة المواتية ليبرز إنتاجها لجمهور القرّاء. كانت الثورة لحظة تاريخيّة مناسبة لذلك، وتحرّرت الكثير من الأقلام من هاجس السلطة والوصاية وكسرت جلمود المسكوت عنه وأطلقت العنان لسلطة الكلمة، وتمكّنت قلّة عُرفت بمخالفتها السائد من فتح سُبل أوسع في انتقاد الواقع ومعالجة قضاياه والانتقال من التلميح إلى التصريح ومن المواربة والترميز إلى الإشارة والنطق صراحة. وهو ما يدفعنا إلى الوقوف عند هذا المنجز الأدبي وتجويد النظر في خصائصهِ وسماتهِ باعتباره ظاهرة ثقافيّة مميّزة نظراً للظرفيّة التي تشكّلَ خلالها، أي ظرفيّة الانتقال من نظاميْن والانعتاق من منظومة الاستبداد نحو الانفتاح والحريّة.
وكان اختيارنا خلال هذه الورقةِ للمنجز القصصي للمرأة غداة الثورة لاعتبارات عدّة، أوّلها مساهمتها الفاعلةِ منذ اندلاع شرارة الثورة من مواقع مختلفة كانت المرأة خلالها بمثابة العمود الفقري الذي يدفع المحتجين ويستحثّ هممهم، وحتّى بعدها بحماية الثورة والحفاظ عليها من كل أشكال الوأد أو التمييع أو السطو عليها من القوى المضادّة. ولا يمكن بأيّ حال تغييب دور المرأة الكاتبة في تصوير الثورة ورصد كافة مراحلها وتمفصلاتها التاريخيّة، وأثرها في وجدان التونسيين والتونسيات وهم يشقّون الطريق نحو عهد جديد. ويمكن في هذا السياق ذكر بعض محاولات الكاتبات التونسيات على غرار حفيظة قارة بيبان في يومياتها: النّجمة والكوكوت، من يوميّات كاتبة وفنّان، ورفيقة البحوري في سيرتها الذاتيّة: في المياه المالحة، وآمنة الرميلي الوسلاتي في مجموعتها القصصية ألوووووو…
وثاني هذه الاعتبارات هو ما تعرّضت له المرأة التونسيّة إثر الثورة من موجة عنف رمزي واسعة، لا سيما إثر بروز الإسلاميين على الساحة وارتفاع شعبيتهم لدى فئات كثيرة من المجتمع التونسي، وتعويل العديد من المحافظين والأصوليين ممن يبحثون عن التموقع داخل الساحة السياسيّة إلى ضرب رموز وطنيّة أسهمت في الدفاع عن المرأة والدعوة إلى تحريرها، وعلى رأسهم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ممّا ولّدَ خوفاً لدى الكثيرات من خطر العودة إلى الوراء وضياع مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من الحقوقيات والناشطات النسويات والمصلحين والمدافعين عن المرأة. وهو ما جعل من الكتابة مساحة للتعبير عن هذا الخوف، وسلاحاً ضدّ كافة أشكال الاعتداء على المرأة. أما ثالث هذه الأسباب التي تبرر لاختيار القصّة، والقصة النسائية على وجه التخصيص، فيكمن في إقبال الكاتبات التونسيات على كتابة القصّة والزهد في كتابة الرواية التي شهدت إقبالاً ذكورياً واسعًا غطّى وحجب إسهام المرأة في هذا الجنس الكتابيّ.انظر: محيي الدين حمدي، من مظاهر التجديد في القصة القصيرة عند فوزية العلوي وحفيظة القاسمي، مجلّة قصص، العدد 142، نوفمبر 2007، ص 100، إذْ يقولُ: «عددُ كاتبات القصّة القصيرةِ أوفرُ من كاتبات الرواية عندنا. فالوقتُ الذي تحتاجهُ القصّة القصيرة أقلُّ معاناة من الذي تحتاجهُ الروايةُ». إذْ لم يتجاوز عدد الروايات النسائيّة إلى حدود 2006 «ستاً وثلاثين رواية، من جملة إنتاج وطني في هذا الصّنف يُقاربُ 260 رواية، وبذلك تكون نسبة الرواية النسائيّة ضمن الرواية التونسيّة في حدود 14%، وهي نسبة ضعيفة تعكسُ عديد العوامل المتحكّمة في الساحة الثقافيّة والتي تأتي في مقدّمتها ضآلة عدد الكاتبات مقارنة بمثيلهنّ من الرّجال».أحمد ممو، الاهتمامات الأساسيّة للرواية النسائيّة التونسيّة، مجلة قصص، العدد 142، نوفمبر 2007، ص 74.
نحاول عبر هذه المقالة رصد ملامح وخصائص القصة النسائيّة في تونس بعد الثورة، انطلاقاً من بعض النماذج هي كالآتي: ألوووووو… لآمنة الرميلي الوسلاتي، شرفة على البحر لنافلة ذهب، الرحيل إلى تسنيم لمسعودة بوبكر وميتة مبتكرة لبلقيس خليفة. وهي مجموعات قصصيّة صدرت خلال السنوات العشر التي تلت الثورة، اتّسمت بطرافة الطرح والانزياح الواضح عن مرجعيات الكتابة النسائيّة كما ترسّخت طيلة عقود، ولن تكون مقاربتنا لهذه النصوص مقاربة جندريّة نبحث خلالها عن ملامح الاختلاف والخصوصية في النصّ النسائي باعتبار اختلاف الجندر من شأنه أن يُسهم في اختلاف الخطاب والإشكالات التي يرمي هذا الخطاب إلى علاجها أو إثارتها، وإنّما ستكون مقاربة تحليليّة وصفيّة تؤصّل النصّ في سياقات إنشائه، وتبحث في أثر السياق في إنشاء الخطاب. نعني بذلك سياق الثورة وتداعياتها على المجتمع التونسي.
الخطاب القصصي النسائي بتونس: حصيلة نصف قرن
تُعتبرُ القصّة القصيرة من أقدم الأجناس الكتابيّة التي طرقتها المرأة في تونس، إذ تعود أولى محاولات كتابة المرأة للقصّة إلى منتصف القرن العشرين. وترسّخَ ذلك بوضوح إثر الاستقلال عندما تدعّمت مشاركة المرأة في الحياة الثقافيّة استجابة للتحوّلات الاجتماعيّة، كصدور مجلّة الأحوال الشخصيّة وإقرار إجبارية ومجانية التعليم للفتيات ومنح المرأة حق المشاركة في الحياة السياسية من خلال التصويت، والاجتماعية من خلال دخول مجال العمل، والثقافية عبر المشاركة في النشر والتظاهرات الثقافية. وقد بدأت المرأة بتجريب الكتابة في الشعر والسرد القصصي لسببين؛ أوّلهما سهولة التجريب على هذين النوعين من الكتابة لما يتّسمان به من مرونة وقدرة على استيعاب مختلف القضايا والإشكالات التي تؤرّق هاجس المرأة وتتحرّج من طرحها في مجتمع لازال ينظر للمرأة بوصفها كائناً ثانويّاً، ويُسقط عليها مجموعة من المفاهيم والقيم وفق حدوده وتمثّلاته الاجتماعيّة، ويرى في إمساك المرأة سلطة القلم خلخلة للثوابت وزعزعة للمسلّمات. ولِقِدَم المرأة ورسوخها في هذين المجاليْن، فقد عُرفت المرأة بنظم الشعر منذُ القدم كما عُرفت حكّاءة تجيد القصّ وحبكهُ وحافظةً للذاكرة الجماعيّة وما تنطوي عليه من أخبار ومرويات وأمثال. وأما السبب الثاني فهو يُسر انتشار الشعر والقصّة ورواجهما بين جمهور القرّاء عبر المجلّات والصُّحف، عكس الرواية التي يحتاجُ إصدارها من الإمكانات الشيء الكثير.
فشهدت تلك الفترة بروز المحاولات الشعريّة لزبيدة البشير (1938-2011)، وهي من أولى الشاعرات التونسيا، إذ تمكّنت من إصدار ديوان شعري تحت عنوان حنين،زبيدة البشير، حنين، الدار التونسية للنشر، 1968، 93 ص. وعرف خلالها القرّاء الكاتبة ناجية ثامر، رائدة القصّة النسائيّة، من خلال نصوصها التي بدأت تنشرها متفرّقةً في الصحف والمجلات، وتُعتبرُ قصّة الشاقوريّةناجية ثامر، الشاقوريّة، مجلة الأديب، العدد 10، أكتوبر 1954، ص 41-42. من أوّل القصص التي نشرتها في حدود ما توصّلنا إليهِ، غير أنّ هذه القصص لم يتمّ تجميعها ضمن مجموعات قصصية إلا في مرحلة لاحقة، تحديداً سنة 1956 عند إصدارها كتابها عدالة السماء،ناجية ثامر، عدالة السماء، دار الكتب الشرقيّة، 1956، 120ص. وهو مجموعة قصص ومسرحيات نشرتها الكاتبة على نفقتها الخاصّة، وأعقبته بمجموعتها القصصيّة أردنا الحياةناجية ثامر، أردنا الحياة، دار الكتب الشرقيّة، 1956، 108ص. في السنة نفسها.

تتالت إثر ذلك المحاولات القصصيّة وتتابعت الإصدارات، التي يُمكن تبويبها ضمن ثلاثة أجيال:
الجيل الأوّل: ويضُمُّ عددا من الأسماء كهند عزوز التي بدأت النشر سنة 1967 عبر أعمدة الصحف بقصّتها أسلم السير في الضياء. ونشرت مجموعتها القصصية الأولى: في الدرب الطويل سنة 1969. ونافلة ذهب التي نشرت قصتها الأولى الساعة سنة 1968، ونتيلة التباينية: شيء في نفسك سنة 1970، وحفيظة قارة بيبان: ست لوحات إلى أمي سنة 1975، وحياة بن الشيخ: الشارع الثاني سنة 1976.
الجيل الثاني: ونذكر منه عروسية النالوتي: انتعاش الأيام القادمة (1983)، وحياة الرايس: صلاة سمراء (1984)، وآمال مختار: سحابة صيف (1986)، ومسعودة بوبكر: الحبل السرّي (1989)، رشيدة الشارني: امرأة تتوسل الزمن (1993)، وحفيظة القاسمي: الظلّ (1994)، وآمنة الرميلي: القلم والعصا (1995).
الجيل الثالث: ومن أهم أسمائه بسمة البوعبيدي التي أصدرت مجموعتها تغريد خارج السرب سنة 2001، بلقيس خليفة التي نشرت قصتها الأولى حكاية عربي في 2009، وصفيّة قم بمجموعتها يشتاقني الحنين في 2013.
وقد تميّزت القصّة النسائيّة التونسية مع هذه الأجيال الثلاثة، التي تمسح ما يزيد عن نصف قرن بقليل، بجملة من الخصوصيات والاهتمامات، «وتتراوح هذه الاهتمامات بين ماهو ذاتي مرتبط بشخصيّة المرأة ومكانتها الاجتماعيّة وأحاسيسها الداخليّة، وماهو اجتماعي يُسلّط أضواء على المجتمع بمختلف شرائحه ومستوياتهِ من العائلة إلى المجموعة بأكملها، ولكن ما ينعكسُ بصورة أوضح من خلال هذه النصوص هي اهتمامات ألصق بشخصيّة المرأة من أحاسيس وتطلّعات وموقف من المجتمع ومن الآخرين».أحمد ممو، الاهتمامات الأساسيّة للرواية النسائيّة التونسيّة، مجلة قصص، العدد 142، ص 77. بعض هذه الخصويات ثابتٌ بمثابة الخيط الناظم الذي يشُدُّ هذه الأجيال الثلاثة إلى بعضها البعض، ويمنحُ هذه النصوص فرادة تتميّز بها عن المنجز القصصي للرجل، فـ«رغم اختلاف التجارب الفرديّة، فبيْن كاتبات القصّة القصيرةِ تشابهٌ في مناحي الشّكل الفنّي والمحتوى».محيي الدين حمدي، من مظاهر التجديد في القصة القصيرة عند فوزية العلوي وحفيظة القاسمي، مجلّة قصص، العدد142، ص 101. وبعضها الآخر متحوّل، وقد اقترن هذا التحوّل بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيّة الطارئة على المجتمع التونسي، وحتى العربي أحياناً عدّة (كهزيمة 1967، الانتفاضات الفلسطينية الثلاث…). على سبيل المثال: ميل كاتبات الجيل الأوّل من القاصّات التونسيات لـ«الاتّجاهُ إلى معالجةِ بعض الظّواهر الاجتماعيّة والنزعات النفسيّة التي استشرت في المجتمع التونسي في الفترة التي تلت الاستقلال».عبد القادر عليمي، تحوّلات الخطاب السردي في تونس: المضامين، البُنى، الدلالات والرؤى، دار ميّارة للنشر والتوزيع، ط 1، تونس 2018، ص45. أمّا عن ملامح الفرادة التي اختصّت بها مدوّنة القصة النسائية التونسية، فاتّخاذها المرأة ثيمة رئيسية في الكتابة، إذ تناولت كافّة الكاتبات من مختلف الأجيال المرأة قضيّةً وموضوعاً بدراسة مشاغلها وتطلعاتها وأدوارها، فأعدنَ الاعتبار لها بتصويرها ربّة عائلة تحسن إدارة شؤون بيتها وأماً حنوناً وزوجةً وفيّة، بل كثيراً ما تمّ تجاوز دورها التقليدي داخل العائلة وتصوير أدوارها النضاليّة ضدّ المستعمر، ونضرب مثلاً على ذلك قصتي «الخائن الأمين» و «من شظايا الثورة» لهند عزوز، ففي الأولى تؤازر المرأة زوجها في نضاله ضدّ المحتلّ وفي الثانية تعمل الأمُّ على حماية ابنها المناضل وتساند تحركاته النضالية ضد المستعمر. إضافة إلى فضح كافة أشكال الاستغلال والانتهاك التي تتعرض لها المرأة اقتصادياً، كقصّة «الفرن» لرشيدة الشارني التي تتعرّض خلالها إلى استغلال جهود العاملات في المؤسسات الصناعيّة ذات نظام السلسلة، و«بائعة الحمّص» لمسعودة بوبكر التي تعالج عبرها أزمة البائعات المهمّشات اللائي يتعرّضنَ لكافة أشكال الجور والانتهاك. واجتماعيّاً إذْ تطرّقت هند عزوز إلى أزمة عاملات الجنس في قصّتها «صفعة من يد القدر»، وكشفت حياة الرايس في قصة «طقوس سريّة وجحيم» شكلاً من أشكال الهيمنة الذكورية داخل مؤسسة الزواج عندما يطمسُ ويُغيِّبُ الزوج الجامعي المدافع عن حقوق المرأة والحريات بشكل عام موهبةَ زوجته الشاعرة، ويجعلها مجرد أداة لخدمته والنهوض بأعباء الأسرة. أو داخل العائلة بشكل عام بتصوير تسلّط الرجل أباً أو أخاً أو عماً على المرأة، كقصّة «قرار وقرار» لمسعودة بوبكر التي تصوّر تسلّط العم وتصرّفه في ممتلكات العائلة دون أيِّ مشورة من باقي الورثة، إلى جانب مسألة الحب والعلاقات بين الجنسين والعلاقات الأسرية داخل العائلة ومقاربة قضيّة الصراع بين الأجيال.

وظلّت هؤلاء الكاتبات مشدودات إلى واقعهنّ، يتأثّرنَ بالغ التأثر بكافة المتغيّرات التي تحدثُ محليّاً، كتجربة التعاضد وتداعيتها الاقتصادية والاجتماعيّة، وأثر صدور مجلّة الأحول الشخصيّة وما تضمنته من قرارات كمنع تعدد الزوجات، وأثر ذلك في بنية التونسي الذهنية والنفسيّة، وغير ذلك من الموضوعات التي تشغل الرأي العام. راوحت الكاتبات في ذلك بين الفردي الذاتي والجماعي، ما جعلَ من تجربة كتابة القصّة لدى المرأة تجربة ثرية متنوعة تنفتح على الإنسانية في أفاقها الرحبة الواسعةِ. «وقد حقّقت القصّة التونسيّة في هذه الفترة المديدة تطوّراً هائلاً تجلّى في المحاولات الدؤوب لتنويع الأساليب الفنّيّة والأدوات الإبلاغيّة، والنّزوع إلى انتهاج مسالك التجريب والخروج عن الأنموذج والنمطيّة اللذين كانا سائديْن في التعاطي مع كتابة القصّة شكلاً ومضموناً وتشكيلاً ورؤية».عبد القادر عليمي، تحوّلات الخطاب السردي في تونس: المضامين، البُنى، الدلالات والرؤى، ص 51-52.
الخطاب القصصي النسائي بعد الثورة: بين الانزياح والتجديد
مثّلت الثورة التونسيّة فرصة للانعتاق من ربقة الاستبداد السياسي والانفتاح على الديمقراطيّة وحريّة التعبير، وقد شكّلت الكتابة الإبداعيّة تمريناً مهماً على ممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي وترسيخهما، فتتالت المحاولات القصصية التي برهنت عن وعي ونضج فائقيْن لدى المرأة الكاتبة، وتمثّلٍ واضحٍ للحظة الثورة الفارقة. وقد انعكس هذا الوعي على مستويات مختلفة في القصة فنياً ودلالياً، ويمكن ضبط هذه المستويات في النقاط التالية:
بنية القصّة
يُعتبر البناء القصصي من أهمّ المستويات السرديّة التي يُعنى بها النقّاد لدى تحليل النصوص القصصيّة والسرديّة عموماً، ومَردُّ الاهتمام هو ما أحدثهُ هذا المفهوم من نقلة نوعيّة في السّرد، وما أقامهُ من حدٍّ دقيق بين المادة الحكائية الخام والقصّة التي تُصاغ فيها هذه الحكاية وتتشكّل، من خلال ما يعتمدهُ المؤلّفُ من تقنيات ومؤشّرات سرديّة في صياغة الأحداث وبنائها، وسنركّزُ في تحليلنا للبناء القصصي على نقاط ثلاثٍ هي الآتية:
– البداية المُلغَّزة: يُعَدُّ وضع البداية أو ما يَصطلحُ عليه الإنشائيّون بالتوازن/الهدوء من أهمّ مكوّنات المقطع السردي أو النصّ القصصي، لما يتحدّدُ خلالهُ من معلومات هامّة وعناصر ضروريّة تضعُ القارئ في الإطار العام للنصِّ، من أُطر مكانية وزمانية وشخصيات وبرامج سرديّة. لكنّ الملاحظ في المدارس والتيارات الأدبيّة الحديثة ميل العديد من المنظّرين والمبدعين إلى كسر وخلخلة المفاهيم والنظريات التقليديّة، من قبيل الانزياح عن وضع البداية التمهيدي الذي يؤصّل الأحداث ويؤطّر لها والميْل إلى وضع أولي سمته الغموض والإلغاز. ويُمكن اعتبار هذه الخصيصة الإنشائيّة سمة من سمات الكتابة القصصية الأنثوية عامة، وميزة طبعت المنجز القصصي للكاتبات التونسيات غداة الثورة. ومن النماذج التي نضربها على ذلك، وضع البداية في قصّة «القاتل» لآمنة الرميلي الوسلاتي: «صَدْر الولد كان شهِيًّا، كان شهِيًّا صدر الولدِ… مُستفِزًّا كان تحت مريولهِ المُخطّط المتواضعِ، اللعنةُ.. ما الّذي جعلني أنظرُ إلى صدرهِ؟ منذُ الأمس جاءت التعليمات.. سنضربُ.. نظرتُ إلى سلاحي على جنبي، أحسستُ أنّني أقفُ على رأس الهاويةِ.. القانون هو القانون».آمنة الرميلي الوسلاتي، آلوووو…، دار آفاق برسبكتيف للنشر بتونس، ط 1، 2018، ص 15. لقد اِفتقدت هذه المقدّمة السرديّة كافّة مقوّمات التأطير للقصّ، بل إنّها تُبهمُ أكثر مما تُعلنُ وتُوضّحُ للقارئ، وتحملهُ على التساؤل والحيرةِ وتكرار السّؤال حتّى نهاية النصّ، عندما نكتشفُ هويّة الشخصيّة المتلفّظة داخل النصّ (شخصيّة القنّاص) وشخصيّة الفتى (أحد المتظاهرين في أحداث جانفي 2011)، والحدث الذي يدور حولهُ القصّ وهو عمليّة اقتناص الضحيّة من أحد أسطح عمارات وسط العاصمة بناء على التعليمات الصّادرةِ بتصفية المتظاهرين وتعقّبهم.
ينضاف إلى الانزياح السابقِ شكل ثانٍ من أشكال التحوّل البنائي في القصّة القصيرةِ، وهو ما عمدت إليه آمنة الرميلي في «قصّة حبّ في ساحة القصبة» عندما قصدت تجزئة القصّة إلى عناصرها الثلاثة وعنونة كلّ جزء، فقدّمت النهاية على المتن الحكائي الذي بنته باعْتماد تقنية الاسترجاع، وجاءت هذه القصّة مخالفة في بنيتها الحدثيّة لما هو مألوف ومعتاد.

– النهاية الساخرة: ونقصد بذلك نوعاً من الخواتيم القصصيّة التي تكسرُ اُفق انتظار المتلقي وتخيّب انتظاراتهُ بإفراغها من محتواها الجادّ، وشحنها بمعانٍ هزليّة ساخرةٍ، على غرار قصّة «آلوووو…» لآمنة الرّميلي، إذْ توهمنا الكاتبة طوال القصّة بأنّ الشخصيّة البطلة في قصتها لم ينفكّ طوال الرحلة على متن سيارة الأجرة عن التحدّث عبر الهاتف مع عشيقتهِ طالباً منها وصف عضوها الجنسي، مُطلِقاً التأوّهات والإشارات الجنسية الفجّة التي أزعجت وأحرجت كافة الراكبين معهُ، ويظلُّ القارئُ متوهّما ذلك إلى أن يتغيّر مجرى القصّ عند النهاية، عندما تقطعُ الشخصيّة ذهول الركّاب قائلاً: «سامحوني يا جماعة.. المادام طبخت كسكسي بلحم العلوش، منذُ شهورٍ لم نذُق لحم الخروف…».آمنة الرميلي الوسلاتي، آلووو…، ص 91.
– النهاية المفاجئة: يُعتبرُ هذا النوع من النهايات ميزة اختصّت بها قصص الكاتبة بلقيس خليفة في مجموعتها مِيتة مبتكرة، حيثُ عمدت إلى اِتّخاذ الموت ثيمة رئيسيّة في الكتابة، وفي كلّ قصّة تُفاجِئنا بنهاية غير متوقّعة، كأن يُتبيّن أنّ الشخصيّة التي كانت تروي الأحداث على لسانها كامل النصّ في عداد الأموات، وأنّ من كان يتحدّث هو روحها التي تطوف في الأنحاء. ذلك على غرار قصّة «إسعاف»، فقد تحدّثت الشخصيّة عن حادث المرور الذي كانت شاهدة عليه عندما وقع، وعن كافّة أطوار عمليّة إسعاف المُصاب الذي تبيّن أنّها كانت تعرفهُ منذُ كان طالباً في الجامعة وجمعتهما قصّة حبٍّ. نُدرك في نهاية القصّة أنّ من كان يتحدّث هو روحها المنفصلة عن جسدها. ورغم ما قدّمته الكاتبة من إشارات نصيّة واضحة كتجاهل كل من تخاطبهُ الشخصيّة لها، أو التظاهر بعدم سماعها أو عدم رؤيتها، فإنّ القارئ لا يُدرك كنه ذلك إلا ختام النصّ عندما ذكرت الشخصيّة قائلةً: «في طريقي إلى الخروج من غرفة العمليّات مررتُ بالكهل الراقدِ في السرير الأوّل، كانت عيناهُ مفتوحتيْنِ ورأيتهما تتبعانني أثناء مروري بهِ، ابتسمتُ لهُ مُشجّعةً فانفرجت شفتاهُ وهمس يشكرني. كان الجهازُ الموصولُ بقلبهِ يرسمُ خطًّا متواصلاً».بلقيس خليفة، ميتة مبتكرة، دار ميّارة للنّشر والتوزيع، ط 1، 2021، ص 51. وفي قصّتها «عبدو يبتلعُ البحر»، تفتحُ الكاتبة القصّة بالجُملة التالية: «عندما رأيتهُ صباحاً قادماً من بعيدٍ انتابني الهلعُ، لم أكُن مُستعدّة لملاقاتهِ، فمازالت أمامي أشياءُ كثيرةٌ يتعيّنُ عليّ القيامُ بها»،المصدر نفسهُ، ص 109. إنّ هذه الافتاتحيّة تبدو في ظاهرها أمراً عادياً، وأوّل ما يتبادرُ إلى ذهن المتلقّي حديثُ السّاردةِ عن شخصٍ ما تجمعها به معرفة ما، وتتحاشى الالتقاء بها لأسباب كثيرة تُعدّدها، ثمّ تمرُّ الساردة إثر ذلك للحديثِ عن وفاة جارها عبدو مع استطرادات متنوّعة تعرّج أثناءها على الشخصيّة وحياتها وما عاشتهُ من صعوباتٍ نتيجة يُتمه وإعاقتهِ. ثمّ تكون النهاية صادمة مروّعة في آن، عندما تقرّر الكاتبة الكشف عن هويّة الشخصيّة صاحبة القبّعة الذي رأته صباحاً وتحاشت الالتقاء بهِ؛ إنّه مَلَك الموت وقابضُ الأرواح ومفرّق الجماعات.
السّخرية السوداء
«السّخرية السوداء» مصطلحٌ ابتدعهُ الشاعر الفرنسي رائد السرياليّة أندريه بروتون، وهي ضربٌ من الكوميديا يعالج موضوعات سودواوية راهنة تؤرق الإنسان، كخطر التكنولوجيا والحروب والتلوث البيئي والعنف، في قالب كوميدي هزلي يحمل الإنسان على الضحك، لكنه ضحك مرّ كالبكاء، ضحك على الانكسار والألم والعجز. لذلك هي سخريّة سوداء، لقاتمتها ومرارتها. وقد تميّزت من ضمن الكاتبات التونسيات في هذا اللون من الكتابة الساخرة الكاتبة بلقيس خليفة من خلال كتاباتها الرقميّة التي تنشرها على صفحتها في فيسبوك، وكذلك الورقيّة المنشورة. وتُعدُّ قصّة «ميتة مبتكرة» خير تجسيد لذلك عندما تحوّل الكاتبة حدث الموت وما يعنيه من حزن ولوعة ومأساة إلى حدث عادي مُفرَّغ من كل معنى. تقول الكاتبة مُشيرةً إلى ذلك: «لم يعُد الموتُ حدثًا مُثيراً، وصار الأهلُ يكتفونَ بتنزيلِ نعيٍ للفقيدِ على صفحة الفايسبوك، يُحصونَ بعد نشرهِ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع المنشور. يستغرقُ هذا يوماً أو يوميْن ثمّ ينتهي الأمر».بلقيس خليفة، ميتة مبتكرة، ص 79.
كذلك الكاتبة آمنة الرميلي، التي أبدعت خاصّة في قصّة «تعود معي.. أو أعود معك» في مجموعتها ألوووو…. عندما تُحوّلُ مأزق وقوع صحفيٍّ تونسي في قبضة المجاهدين الأفغان، والتقاءه بأحد المجاهدين هناك من أصول تونسية، إلى ضرب من الفكاهة والتندّر يُسلّي القارئ ويُضحكهُ، لكنه يُبطن ضرباً من المأساة ونقداً صارخاً مدوياً. إضافة إلى القاصّة نافلة ذهب في قصّتها «قاتل النّمل» من مجموعتها شرفة على البحر، عندما تُبدع الكاتبة في تحويل فوبيا الشخصيّة من النمل والحشرات إلى مصدر من مصادر الإضحاك في القصّة: «انقادَ وراء نملةٍ أَبصرَها وجعل يرفسها بحذائه المطاطي ثمّ شاهدها وهي تتلوّى ثمّ تذوبُ وتندثرُ تحت نعلهِ دون صوتٍ… كان النّملُ يفرُّ بعد لسعهِ إلى الأقاصي ويركضُ جحافل سوداء بينما يترنّحُ هو في مشيتهِ كالجريحِ وقد تلطّخت ملابسهُ بالتّراب».نافلة ذهب، شرفة على البحر، تبر الزّمان، تونس، 2017، ص ص 24-25.

الثورة موضوعاً للكتابة
لم تُمثّل الثورة التونسيّة مجرّد لحظة انتقاليّة من نظام كليانيٍّ مُستبدٍّ نحو نشدان نظام ديمقراطيّ سمته التنوّع والاختلاف والحريّة، بل مثّلت لحظة إلهام نفثت روح الإبداع في عديد الكتّاب الذين تخيّروا الثورة ثيمة رئيسيّة في كتاباتهم أو موضوعاً جزئيّاً لها. وسنُسلّطُ الضوء هنا على أحد نماذج من المدوّنة القصصيّة محلّ الدّرس، وهو نموذج القاصة آمنة الرميلي الوسلاتي التي جعلت مجموعتها القصصية ¼ (ربع) تتمحور حول الكتابة عن الثورة، ففي قصّة «آخر لحظات البوعزيزي… في كفّ الشّمس»، تُحوّلُ الكاتبة مشهديّة حرق البوعزيزي نفسهُ نصّاً سرديّاً ينبضُ بالتفاصيل في دقّتها، لا سيما الحوار الذي دار بينهُ وبين أمّه في لهجة محليّة بسيطة معبّرة وموحية. وفي قصّة «القاتل» ترصدُ مشهد انتشار القناصة فوق الأسطح والعمارات لتصفية المحتجّين، وتوغل الساردة في سبر أغوار شخصيّة القنّاص الذي يجد نفسه يمتثلُ لتطبيق القرارات والإملاءات التي ترده دون حول منه ولا قوّة، وتأرجحه بين ما يمليه عليه ضميره وما تقتضيه ضرورة العمل: «ضربتُ التحيّة ثانيةً وجسدي قبضة من التوتّر، كلُّ هذه الأيام الكلبة وجسدي قبضة من التوتّر، كلّ هذه الأيام الكلبة وجسدي قبضة من التوتّر…».آمنة الرميلي الوسلاتي، ألوووووو…، ص 15. وفي «قصّة حبّ في ساحة القصبة» تجعل المؤلّفة موضوع القصّة واقعة من الممكن أن تكون تكرّرت عديد المرات خلال اعتصامات القصبة التي عقبت الثورة، ومضمون هذه الواقعة قصّة حبّ نشأت بين متظاهرين: شابٌ وافدٌ من إحدى الجهات مرابطٌ في القصبة وفتاةٌ من سكّان العاصمة، وتعمد الساردة إلى تجزئة هذه القصة كرونولوجياً حسب تطوّرها رويداً رويداً.
الإرهاب
مثّلَ الإرهاب أحد الظواهر التي اجتاحت المجتمع التونسي غداة الثورة، وفي ظلّ حالة الانفلات الأمني ومحاولة الجماعات الأصولية التموقع ضمن المشهد وتكريس نظرياتها وفرضها على المجتمع التونسي. ولمّا كان الأدب شأنه شأن الفن حمّال رسالة وشكلاً من أشكال التوقي من التطرّف العنيف، فقد انخرط عديد الكتّاب، المسرحيين والروائيين والقصصيين، في مقاربة الظاهرة ومحاولة الوقوف عند أسبابها والتنبيه إلى تداعياتها القريبة والبعيدة.
وإن كانت معالجة ظاهرة الإرهاب، ومحاولة فهم البناء النفسي والذهني للإرهابي لدى عديد الكتاب والفنانين، كلاسيكيّة تنساق وراء الكليشيهات والأفكار النمطيّة، فإنّ عدداً من المثقفين والكتاب لا سيما من النساء تمكنّ من توظيف مختلف الآليات لفهم تكوينية شخصيّة الإرهابي. ففي قصّة «ذبحتُ… سيّدتي»، تُجري الوسلاتي الكلام على لسان أخصّائيّة نفسيّة تُحدّث الساردة عن أحد المتطرّفين دينيّاً العائدين من العراق، حيث كان يُجاهدُ على حدّ تعبيرهِ، وتتعمّقُ المتكلّمةُ في رسم هذه الشخصيّة وما يحكمها من تناقضات مُركِّزة على حالة الاضطراب التي يعيشها بعد أن أقدم على قتل أحد أفراد مجموعته التي يتدرّبُ معها: «مشكلتي يا دكتورة الصّفير الساكنُ برأسي منذ سنتيْن.. منذ ذلك الصباح الذي نفّذتُ فيه.. في الليلة السابقة كدتُ أقتلُ أحد عناصر الوحدة، افتكّوه من يديّ هاتيْن… اللحظات التي سبقت الذّبح.. لا أعرفهُ يا دكتورة.. كان نصفه الأعلى عاريا يختلطُ بياضهُ ببقع زرقاء تحت البرد القارصِ.. كانت عيناهُ معصوبتيْن وفمهُ مكمّماً وكلُّ أطرافه مقيّدةً.. كان يئنُّ ويتملّصُ ويحرّك رأسهُ بعنف».آمنة الرميلي الوسلاتي، ألوووووو…، ص 42-46. وتتساءل المتكلّمة –أي الأخصائيّة النفسيّة- في خضمّ ذلك عن مصيره الذي ينتظره، وعن مدى استعداد المجتمع لتقبله وتقبل إدماجه، لا سيما وهو لا يزال شاباً عمره أربع وعشرون سنة وبضعة أيام.
وفي قصّة «أنا وأنت و…» تسلّط الكاتبة النظر على إحدى أكثر الظواهر الاجتماعية تفشياً في العشرية الأخيرة، وهي ظاهرة صراع الأجيال وتقويض الروابط الأسرية، بين جيل نشأ تنشئة دينيّة وسطيّة وجيل آخر تفتّحت بصيرته على خطابات دينيّة مغالية في التطرّف تتعارض والثقافة المعتدلة الشائعة في تونس، لا سيما الخطابات الوافدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومضمون هذه القصّة قطيعة بين فتاة وأمّها وهجرانها البيت بعد تعرفها على شاب من الجماعات الأصولية المتطرّفة: «كنتُ مرميّة في الصالون حين خرجتِ ملفوفةً في السّواد من غرفتك، رأيتُ الحقيبةَ تطلُّ قليلاً قليلاً فابتلعتني موجةٌ من حزن لم أذق طعمهُ من قبل.. أو تتركني وتذهبُ فعلاً؟ .. لم تُجيبي عن سؤالي: إلى أين؟ قلتِ فقط: ربّي يهديك.. وجذبتِ الباب وراءك… تحرجينني أمام رجال الحيّ.. قُلتِ، أحسُّ بالخجلِ وأنت تعرضين ساقيْك وزنديك وشعرك على بائعي الخضر والجرائد.. اتّقي الله فيّ وفي نفسك..».آمنة الرميلي الوسلاتي، ألوووووو…، ص 57-58. وتعمّق الساردة وصف حالة الإحباط التي تعيشها الأمّ إزاء التحول المفاجئ من حولها، وحالة التديّن الغريبة التي اجتاحت المجتمع التونسي ففرّقت بين أفراد البيت الواحدة وقسّمت المجتمع إلى متديّن ملتزم ومنبتٍّ كافرٍ وفق نظرة المغالين والمتطرّفين دينيًّا.
الهجرة غير النظامية / السرّية
تُعتبر ظاهرة الهجرة غير النظاميّة نحو الضفّة الأخرى من الحوض المتوسّطي من الأمور الرائجة لدى بلدان شمال إفريقيا، خاصة بتونس والجزائر والمغرب، وباتت تتّسعُ رقعتها شيئاً فشيئاً خلال العقد الأخير، فلم تَعُد مطمحَ العاطلين عن العمل أو المهمّشين اجتماعيّاَ فحسب، بل أضحت مشغلاَ لكافّة شرائح المجتمع بنسائه وشبابه وشيوخه، مثقّفيه وعوامه. تقول مسعودة بوبكر في قصة «حيث لا ظلّ يتبعني» على لسان البطلة: «ركوب هذا الزورق الجهنّمي اختيار منشود ومسبق مائة بالمائة. باتّجاه رحلة جهنّميّة مجهولة. إلى أملٍ معلّق على فنن أخضر، لا تتجلّى له تربة ثابتة بعد. تنشط الألسنة بعد أن تلعق الملح المتكلّس على اللهاة والشفاه.. تتنافر الكلمات. تمرقُ الأصوات لترسم هويّتها البشريّة المسحوقة. هنا في قاع زورق في عرض بحر لا نُدرك حدوده بعد، دُويبة متحرّكة على ظهر عملاق هادر، غامرت في ظلمة الكون بحمل الهاربين من ظلمة الحال إلى غبش المصير».مسعودة بو بكر، الرحيل إلى تسنيم، ص 36. مركّزة على مآسي من اختاروا الهجرة في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر زورق متهالك، بحثاَ عن الخلاص بعيداَ عن البلدان التي لفظتهم وفيهم من يحمل شهادة جامعيّة، وفيهم من هي حاملٌ تريد أن يرى مولودها الضوء في بلاد أوروبيّة. لقد استطاعت الساردة في هذه القصّة أن تركّز على الهجرة غير النظامية باعتبارها قضيّة إنسانية، وأن تُخرجها من حيّزها المحلي الضيّق، خاصة وأن هذه الرحلة تضمّ أجناساً وأقواماً مختلفة: «يعلو صوت بعض النسوة بيضٌ وزنجياتٌ ملتفات حول بعضهنّ البعض.. يجحظ الفزع من محاجرهنّ.. تتداخل اللهجاتُ فرنسيّة، إفريقيّة وإنجليزيّةً…»،مسعودة بوبكر، الرحيل إلى تسنيم، ص 38. باعتبار أنّ الهجرة السريّة ظاهرة كونيّة عالمية، أتت على كلّ الشعوب المهمّشة والمنسيّة، ولم تقتصر على جهة بعينها.

في قصّتها «آخر الناجين»، تركّز بلقيس خليفة على عمليات الاحتيال التي يتعرّض لها الراغبون في الهجرة، فخلال هذه الرحلة وعلى تخوم السواحل الإيطاليّة يتعرّضُ المركبُ إلى ثقب كبير في قعرهِ يهدّد بغرق المركب بمن فيه، ما يدفعُ بصاحبه إلى أن يأمرهم بالتخلص من أمتعتهم وكل ما لا يحتاجونه، ومواصلة المسافة سباحة دون أي رأفة بمن لا يُحسن السباحة: «لا أحسن السباحةَ، قال صوت نسوي مُرتجفٌ. التفتُّ ناحيتهُ فإذا هو لشابّةٍ تكوّر بطنها أمامها، وابتلعتُ ريقي بصعوبةٍ… كنت أسمع في الأثناءِ صياح رفاق الرحلة وهم يتخبطونَ بين الأمواج الباردة طالبين النجدة، منادين بأسماء أحبتهم، مستغيثين بالله».بلقيس خليفة، ميتة مبتكرة، ص 66،67. إنّ مثل هذه القصص هو من الأمر الرائج المتكرّر في عرف منظمي الهجرات السرية، التي عادة ما تكون على ظهر قارب مسروق أو متداعٍ يكون همُّ صاحبِه الأساسي تكديس المال على حساب سلامة أرواح المهاجرين.
أمّا في قصّة «الحرقة»، فتولي نافلة ذهب الاهتمام بمأساة أهالي المهاجرين، خاصة الموتى منهم أو المفقودين، فتصوّر معاناة عجوز ابتلع البحر ابنها المهاجر خلسةً، والتي بلغ بها الألم وعدم استيعاب الحقيقة إلى الانتحار شنقاً. من خلال الومضة الورائيّة، وعلى لسان بقّال الحيّ الذي كان يراها باستمرار تتردّد على البحر، تنقلُ لنا الساردة تفاصيل الحكاية: «كنتُ أراها تأتي كلّ يوم بعد شيوع خبر فقدان ابنها تجلسُ على حافّة الشاطئ بين أصداف المحار ترقبُ الأفق في حيرةٍ… كانت تجمّع ملابس ابنها المفقود، وهي تطفو خرقًا عبر الأمواج…»،نافلة ذهب، شرفة على البحر، ص 50. لينتهي بها الأمر في النهاية إلى شنق نفسها بهذه الخِرَق.
*****
تُعتبر تجربة كتابة القصّة القصيرة النسائيّة فريدة من نوعها وطريفة في آن، لما تكتنز به من حمولة دلالية تُلامس المرأة ومشاغلها وطموحاتها، وما تواجهه من تحديات متنوّعة وما تتميّز به من فنيات في الكتابة تمتح من معين التجربة الذكوريّة وتتجاوزها عبر التأسيس لتقنيات مُحدَّثة في القول القصصي. ما يجعل من هذه التجربة حقيقةً بالدرس والبحث والتنظير. وقد أفضى بنا البحث إلى الوقوف على جملة من الملاحظات، أهمّها التحولات الطارئة على النص القصصي النسائي في تونس بعد الثورة، شكلاً ومضموناً، إلى جانب انشداد المرأة وانشغالها البالغ بما حكم به الوضع الاجتماعي والسياسي خلال عقد من الاضطراب والفوضى، كانت المرأة خلاله لسانُ حال قومها وبنات جنسها، تثير المسكوت عنه وتُعرّي كثيراً من الانتهاكات والخروقات.