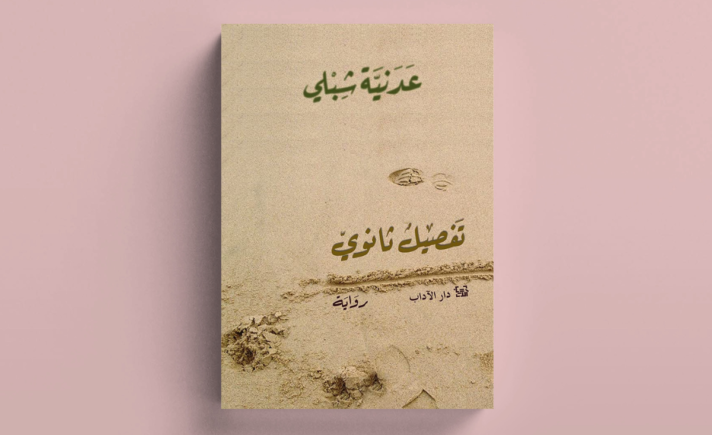سمعتُ باسم ف. ج. زيبالد لأول مرة عندما أرسل لي الصديق والمترجم أحمد فاروق رابطاً لكتابه حلقات زحل، في ذلك الوقت كنت أعمل محرراً في دار التنوير، وكنت قد طلبت من فاروق أن يرشح كتباً باللغة الألمانية للترجمة إلى العربية. لم أقرأ حلقات زحل حينها، لكني قرأت مقالات قليلة عن زيبالد وأسلوبه وكتاباته. بعد سنوات اتفقت مع فاروق على ترجمة حلقات زحل إلى العربية. وبحسب العُرف المُتّبع في هذه الحالات، طلبت منه أن يرسل أول فصل مترجَماً إلى العربية، بعد القراءة الأولى صُدمت لأني لم أفهم شيئاً! ولم أتمكن من تفكيك ذلك الفصل إلا بعد القراءة الثالثة.
الدوامة التي لا تهدأ، العاصفة الناعمة، بحر الرمال المتحركة الدافئ، كلها أوصاف لهذا الفصل الأول العصي على الفهم. بعد شهور انتهزت أول فرصة واقتنيتُ الكتاب نفسه بالإنجليزية. استمرت قراءتي للكتاب متوسط الحجم خمسة شهور، وهو معدل أبطأ كثيراً من المعتاد. كنتُ أضطر إلى إعادة قراءة الصفحات عدة مرات، فقط كي أفهم عمّا يتحدث ماكس بالضبط، فقط كي أجد أي رابط بين كل ما يحكيه. وبعد ما يقرب من ستين صفحة اتضحَ لي أخيراً ما المشكلة.
نشر زيبالد ثمانية كتب في الفترة من 1988 وحتى 2001. يمكن بسهولة ضم معظم ما كَتب إلى ما يُعرف عادة بتيار الوعي؛ طريقة تتابع الأفكار التي أشار لها وليم جيمس -كعالِم نفس- أولاً في القرن التاسع عشر، ثم لاحظها نقّاد الأدب عند دوروثي ريتشاردسون في القرن العشرين، وبعد ذلك ارتبطت بأسماء لامعة مثل فيرجينيا وُلف وجيمس جويس ومارسيل بروست.
قبل قراءة زيبالد بسنوات عديدة واجهتُ صعوبة كبيرة أثناء قراءة كتابات الثلاثة، حينها لم أفهم سرّ الاهتمام بهذه الطريقة «الغريبة» لسرد ما يأتي على ذهن المرء، كنتُ حينها مغرمًا بقراءة الأعمال الروائية الضخمة، مدن الملح لعبد الرحمن منيف وثلاثية نجيب محفوظ. كنتُ أظن أن على الكاتب أن «يهذب» ما يفكر فيه قبل أن يكتبه. طبعاً اهتمَّ جويس وبروست ووُلف بتهذيب ما كتبوا، لكنهم لم يروا أن نسخ تتابع الأفكار نفسه كما حدث في أدمغتهم – أو أدمغة شخصياتهم – عيباً، بل هي ربما ميزة يختصون بها.
يتفرد زيبالد عن اللامعين الثلاثة باهتمامه بإمتاع القارئ، فبدلاً من حزن وُلف العارم، وغرابة جويس موضوعاً وتفصيلاً، ووَداعة بروست بالغة الطول، يحرص زيبالد على أن يتنقل بخفة من فكرة إلى أخرى، على ألّا يزيد تعمقه في وصف ما يريد على صفحة أو اثنتين. مع القراءة الأولى سيلاحظ قارئ كِتابه دوار أحاسيس أنه يبدأ بوصف إحدى رحلاته، يذكر اسم المدينة وتاريخ زيارتها، ثم يصف أول ما رأته عيناه فيها، ثم تَحدُثُ القفزة غير المتوقعة، ينتقل بخفّة نَشّال إلى موضوع تاريخي مرتبط بما وصفه للتو، ثم يقفز قفرة أخرى منتقلاً بالخفة نفسها إلى موضوع ثالث، ثم إلى رابع، وفي لحظة ما يُدرك القارئ الكلاسيكي أن زيبالد ابتعد تماما عن موضوعه الأول، وأن لا رابطَ حقيقياً بين ما يحكيه زيبالد بين الموضوعين، حينها لا يمكن لذلك القارئ إلا أن يتوقف ويعود فقرات -أو صفحات- إلى الخلف، وربما يصعب عليه العثور على لحظة النشل الزيبالدية، فيترك الكتاب إلى حين.
لكن يمكن للقارئ الكلاسيكي الإمساك بهذه اللحظة مع قليل من الصبر والفضول. تتمثل اللحظة غالباً في جملة واحدة، أو مشهد واحد بسيط. يظل زيبالد متنقلاً بين مشهد وآخر طوال الكتاب، وبينما يظن ذلك القارئ أن هناك موضوعاً واحداً رئيسياً للكتاب كله، يدرك أخيراً أن هذا غير صحيح تماماً ويستسلم لطريقة السرد تلك مستمتعاً باستطرادات زيبالد اللانهائية، وهو غاية ما يريد زيبالد؛ أن يمتع القارئ.
حتى الآن لا أعرف الألمانية، وبحساب بسيط يمكنني أن أستنتج بسهولة أني لن أعيش لأقرأ زيبالد باللغة التي كان يكتب بها حتى إن حرصت على تعلمها. بعد قراءته بالعربية والإنجليزية، وبسبب طريقة السرد الزيبالدية، أظن أن زيبالد يجب أن يُقرأ بالألمانية أولاً، أو بترجمة مايكل هُلز إلى الإنجليزية التي كان يُشرف عليها بنفسه، أو بترجمة أحمد فاروق إلى العربية التى سعى بكل الطرق لجعلها مرآة للأصل الزيبالدي، وهي الترجمة التي قرأتها بشغف لا ينتهي.
مع آخر صفحة في دوار أحاسيس فكرت أن ما كتبه زيبالد منذ ثلاثين سنة صالح تماماً للقارئ المعاصر. نحن الآن لا نستطيع الحفاظ على مدى انتباهنا ممتداً إلا لدقائق قليلة. يُعتقَد أن مدى الانتباه قلَّ كثيراً لدى معظم الناس بسبب استخدام الانترنت، ثم قلَّ أكثر بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً. فبعدما كان المرء قادراً على قراءة ثلاثين أو أربعين صفحة من كتاب واحد في جلسة واحدة قبل أن يتحول انتباهه إلى شيء آخر، صار يقرأ صفحة واحدة «ما يساوي عدد السطور المعروضة على شاشة كمبيوتر» على موقع إخباري قبل أن ينتقل إلى صفحة أخرى، ثم صار الآن يقرأ منشوراً على فيسبوك أو تغريدة على تويتر «ما يساوي حركة واحدة للإبهام على شاشة المحمول من أسفل إلى أعلى» ثم ينتقل إلى منشور أو تغريدة أخرى. قِصَر مدى الانتباه هذا يجعل من السهل تماماً علينا أن نقرأ زيبالد الآن، الحريص على ألّا يكتب عن موضوع واحد أكثر من صفحة أو اثنتين.
بالطبع لم يتنبأ زيبالد بقصر مدى انتباهنا الآن، لم يتوقع ذلك أي إنسان. أيضاً، لم يكن إمتاع القارئ غاية زيبالد دائماً، بل كان تتابع الأفكار في وعيه دافعه الأول لاستخدام طريقة السرد تلك. في غرفته منفرداً، كتب زيبالد واصفاً تأملاته التي شغلته لساعات: «…فيما غرقت معظم الوقت في تأملات تدور في حلقات دائماً ما تأخذ في الاتساع، ثم تعود لتضيق أكثر فأكثر، وكنت أحيانًا أيضًا محاطاً بفراغ تام». ثم يظهر شغف زيبالد الأساسي، شغفه بالموت؛ يخرج في الجملة التالية خارج وعيه ليصف لنا طريقته الخاصة للانتحار: «بدا لي آنذاك وكأن بإمكان المرء أن يقتل نفسه من خلال التأمل والتفكير وحدهما».
تتكرر جمل وأفكار كهذه في دوار أحاسيس؛ مثلاً، يصف وفاة إحدى السيدات في قريته القديمة: «وقد نعمتْ بموت جميل في خلال الليل»، كما يصف حال رجل آخر: «أما بينديكت فقد قضى عليه البلاء»، أو يصف ضوضاء اصطدام الأمواج بالصخور: «بمرور السنين توصلتُ لاستنتاج مفاده أن من هذه الضوضاء تُنشِئُ الحياة التي ستأتي بعدنا وستقضي علينا ببطء، كما قضينا نحن ببطء على من كان قبلنا بزمن طويل»، أو يصف حاله وقد أنهكته الأجواء الغرائبية التي مرّ بها: «تحللت ملامح الصور التي سعيت للتشبث بها، وتفتت الأفكار حتى قبل أن أمسك بها بشكل صحيح»، ثم يصف كيف يتجاوز جسدياً قلقه المزمن من الموت: «ورغم أنني كنت أحياناً أخشى من بوادر شلل أو مرض دماغي، إذا ما استندت إلى حائط، أو اضطررت للجوء إلى مدخل بيت، فلم أجد وسيلة أخرى لمواجهة ذلك إلا بإنهاك نفسي تماماً بالمشي حتى وقت متأخر من الليل».
الرابع عشر من ديسمبر العام 2001. زيبالد يقود سيارة بصحبة ابنته إلى نورويتش في إنجلترا. ينحني الطريق لكن السيارة لا تتبع الانحناء. تنتقل إلى الجانب المقابل من الطريق. يحاول سائق الشاحنة الضخمة المقبلة بسرعة إيقافها. يصطدم جانب السيارة الذي يحوي جسد زيبالد بالشاحنة. تدور السيارة حول نفسها ثم تستقر. بعد شهور سيعلن طبيب نورفولك الشرعي أن ف. ج. زيبالد مات بنوبة قلبية قبل أن تصطدم سيارته بالشاحنة.
تثير كُتُب زيبالد دائماً أسئلة من قبيل: أيكتب عن نفسه؟ ماذا يريد أن يقول؟ ما تصنيف كتبه؟ وهي أسئلة مُحيّرة حقاً لكن يمكن الإجابة عنها إن فكَّرنا ببساطة: نعم هو يتكلم عن نفسه، في كل فقرة وفي كل سطر. يريد أن يمتع القارئ وأن يظل خفياً في الوقت نفسه، يريد أن يقول إنه قلق بخصوص الموت. كتبه غير مُصنَّفة، لا لأنه يكره تصنيف ما يكتب، بل فقط لأنه يطبع على الورق نسخة من ما في وعيه، ووعيه – كوعي كلٍّ منا – غير مُصنَّف.