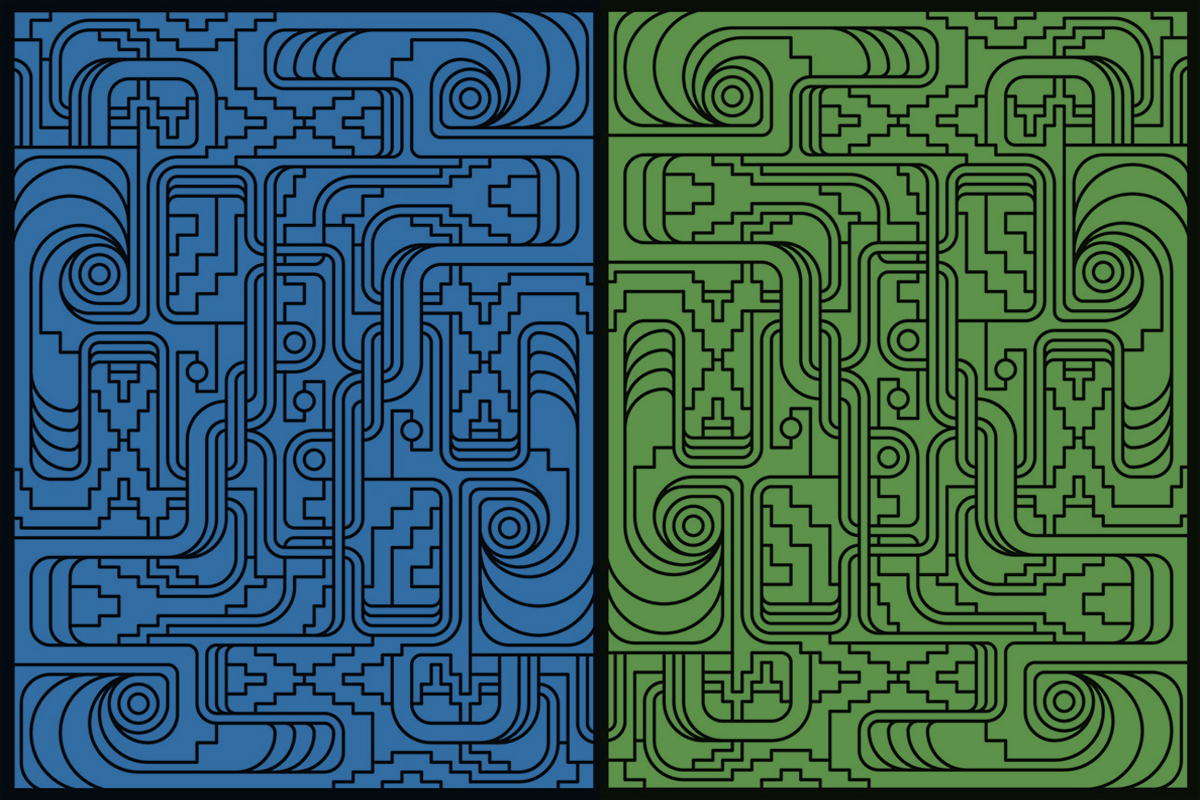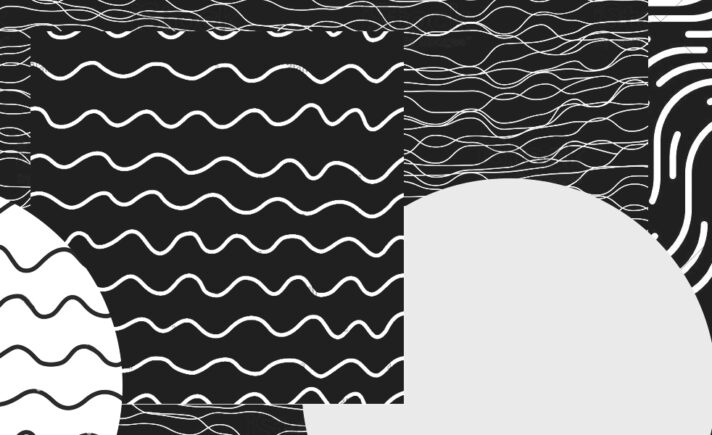الطريق إلى الفاشيّة مُعبَّد بالأشعار البديعة والخُطَب الحماسية المُبْهرة. البلاغة سلعة فاخرة، والعالم كلّه متجر كبير. لا فرق في زماننا الإلكتروني بين سوق البضائع وسوق الأفكار وسوق المعارك، والتسويق فنّ وليس عِلماً. دائماً ابدأ من «نقطة الألم عند الشريحة المستهدفة»، ولا تتوقّف حتى بعد دفعها للشراء؛ أَشعِرها أيضاً بالانتماء.
يتعاطف المرء أحياناً مع اليمين واليسار المتطرّف. ليست كل الخُطَب خالية من حرارة العاطفة الصادقة، وشجاعة التمرّد العادل، والولاء العميق لقضايا المقهورين والمظلومين. ولكن آفة النضال الجهل. والجهل يعني أن تَحرق الحرارةُ الصدق، وأن تَجتاح الشجاعةُ العدل، وأن تأكل القضيةُ مقهوريها ومظلوميها. الجهل والجاهلية هنا معنىً واحد.
الاسم الدارج للجاهلية اليوم: الشعبوية، وعن الشعبوية الإسلامية سنتحدّث.
لكن ليس تماماً عن «الإسلام السياسي». هذه الكلمة مشنوقة بحبال السلطة التي تطاردها الحركات والزعامات الدينية، والتي تخيّر الناس بين مساجد السلاطين وسلاطين المساجد. إن أهل السلطة لم يتركوا في الدين فسحة للروح أو للأخلاق، ولا في الدنيا دعوة لمعرفة حرّة أو قانون عادل، ولذلك لن نتحدّث عنهم ولا معهم. حديثنا سيكون عن «الإسلام الثقافي»، والذي يجري استدراجه إلى حرب مفتوحة مع العالم الحديث، يخوضها تقدّميّون سابقون ومُحافظون جُدُد منذ نصف قرن.
الفصل الأول
مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيه
وَقَعتُ قبل مدّة على هذا المنشور المثير والممتع، والذي سأختلف معه اختلافاً حارّاً. أقدّر للغاية ما يكتبه ويقدّمه الشاعر والمترجم أسامة غاوجي، ولكني أراه قد شَطَحَ في ما قاله شَطْحاً بعيداً. لو كان الغرب شخصاً لتعجّب كيف يكرهه الناس نُصرةً للإسلام، أو كيف يُناصرون الإسلام كرهاً له. ولكن الغرب ليس شخصاً، بل هو خرافة كما سأبيّن أدناه.
للأسف، ما تزال أحزان عبد الحميد الثاني هي البوصلة الروحية لذلك الوعي السياسي المعطوب؛ الوعي الذي يتصوّر عالمنا شيطاناً أشقر بعينَين شرّيرتَين تحدّقان بالمسلمين، ويرى العلاقات الدولية ثغراً من ثغور الجهاد ضد «الروم». ما يُدهشني تلك اللغة الجديدة الوافدة إلى قاموس هذا الوعي، والتي تنهل من أعمال المستشرقين الجُدُد المُولَعين بـ«المقاومة». يريد هؤلاء تحويل مليار من المسلمين والمسلمات إلى سكّان أصليّين في مواجهة الحضارة. وما الحضارة؟ «آلة قتل ذكية»، تبطش بالبشر وتزيّف وعْيهم لحماية جنّتها الأرضية.
يحذّر صديقنا من النقد الذاتي، ويؤكّد على الصلة الصميمة بين الاستبداد والاستعمار، حتى كاد يقول إن الاستعمار أبو الاستبداد وأمه. ثم يتساءل: لم البحث عن العَطَب الذي فينا، ألم تقاتل شعوبنا المستعمرين بشراسة؟ يترحّم على مالك بن نبي، يستدرك بأن الاستعمار هو الذي يمنعنا من الانتصار عليه، وأن «القابلية للاستعمار» – المفهوم التي يضيء على المسؤولية الثقافية وضرورة المبادرة التاريخية – غَدَت هي أيضاً مِن صُنع المستعمِر. طيب لماذا الترحّم على الرجل إن كنت ستغتاله في قبره بهذه الطريقة؟
يحدّق في اليورانيوم والنابالم، يتضامن مع اليابان وفيتنام، يحزن على العراق، ويقرّر أن «الحداثة» هي هذه الحروب والقذائف الحارقة. بلادنا ساحة الحرب، وبلادهم مختبراتها الأنيقة. لا ينتبه أن أغلب الأخبار والتقارير التي تتناول أفاعيل الغربيين صادرة في الغرب. ماذا عن هوشات المتعصّبين الهندوس ضد مسلمي الهند؟ التطهير العرقي الذي يرتكبه بوذيون في ميانمار؟ الإبادة التي تنفّذها الصين الشيوعية في تركستان الشرقية؟ يغيب ذلك بشكل غريب، فيما «أنت أيها العربي المسلم» مشكلتك مع «شعوب العالم النظيف». موظّفون عنصريّون ومؤسّسات قاصرة يعني أن السويد تضطهد المسلمين: نظام الأسد يعذّب جسدياً والسويد تُعذّب «نفسياً»! أي نعم، سوريا كالعادة كرة يركلها نقد الحداثة على مرماه المفضّل… أصلاً «هم» الذين يتواطؤون على بقاء الأسد وتمدُّد الإيرانيين، هم وحدهم لا شريك لهم.
يفتح قوسَين ويذكر غرْز الدبابيس في العيون والأعضاء التناسلية. أي دبابيس؟! دبابيس محاكم التفتيش الأوروبية قبل خمسمئة سنة. النسيان يغزونا، وواجب المثقّفين حراسة الذاكرة. مع ذلك لا حاجة لأي تضخيم، فنحن نعيش جحيم الحداثة كل يوم، «شرايين بلادنا المفتوحة» تشهد.
يبلغ النصّ ذروته الميلودرامية حين يزعم أن «البديل» الصيني والروسي ينهل من نفس مَعِين الغرب المتوحّش. يا لَتلك الفاحشة الفكرية التي يقع فيها دون أن يفكّر مرتين! ألا يرى البيّنة الدامغة التي هي تصويت الناس بأقدامهم وهجرتهم المتواصلة إلى تلك البلاد؟ أيُخيَّل إليه أن كل الغرب إسرائيل؛ وطن قومي لكل البيض البروتستانت، وأن أهلنا الذين فيه عبيد وعمّال سُخرة؟ لا يجد قارئ تلك السطور فرقاً بين سويسرا وقاعدة عسكرية أميركية.
يجزم بثقة أن العالم الحديث يسير بلا غاية أخلاقية ولا رؤية للوجود والإنسان. أين الغايات والرؤى إذاً؟ في خندق الثوّار الذي يعيش فيه هذا الوعي، طبعاً.
أخيراً، يقول إن «الإبادة ليست حدثاً بل بنية»، ولكنه يعجز عن شرح ذلك خارج التفكير الهويّاتي الضيّق. لنضعْ إبرة على هذه الجملة، ولْنعُد إليها بعد قليل.
الفصل الثاني
وَلَو يَشَاءُ اللهُ لَانتَصَرَ مِنهُم
قلّما أنتج الانشغال بالهويّة فكراً سياسياً حسّاساً للواقع، مستقلاً عن مشاعر أصحابه وحقائقهم المتخيَّلة. وذلك لأن القومية قلّما تكون فكراً، بل هي غالباً قصائد في تمجيد المتألّمين وهجاء الأوغاد وتنبيه الغافلين، وطبعاً استعمال الثقافة ضد الثقافة.
يتوقّف الشعر حين نخرج من أنفسنا إلى الواقع ونتحدّث عن أشياء محدّدة. بالفعل تفوّق الأوروبّيون، لكن ليس بالسلطة الاستعمارية العارية فحسب، بل أيضاً عبر فُسحة واسعة للروح والأخلاق، وعبر الكثير من القوانين العادلة والمعارف الحرّة، ومن هنا يكون تشبيه الصين بالولايات المتحدة فاحشة فكرية. فلنشرح:
أول ملامح التفوّق أنهم مواطنون، وأنهم يحكمون فيما بينهم بالعدل – إلى حد كبير على الأقل. وسبب ذلك عمق الفقه العمومي الذي نما فيهم وجذّروه على مئات السنوات، اقتصادياً ثم سياسياً. هذا الفقه عنوانه الحكم الديمقراطي الليبرالي، وهو يستمدّ جذوره من شعارات الحرية والمساواة والإخاء، وينمو بالتمرّس المتواصل لعموم الناس في شؤونهم العامة. تطوَّر هذا الفقه منذ نشوء الشركة الرأسمالية ذات الأسهم والبيرقراطية والعلاقات التعاقدية أولاً، ثم نشوء الدولة-الأمة ذات الشعب والبرلمان والحكومة المنتخبة ثانياً، وصولاً إلى كفاح العمّال فالنساء فالأقليات فالمهاجرين على أنواعهم للدخول إلى قلب مجتمعات ومؤسّسات هذه الدول – وهي عملية ما تزال جارية. والحصيلة أن هذه الدول يملكها الناس بالانتخاب وفصل السلطات ودفع الضرائب، والضرائب تُنفَق على الرفاه العام والاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. هذا بوجه عام، والتفاصيل كثيرة جداً. لكن أهواء المثقّفين تأمرهم أحياناً بالقفز فوق الاختلاف المهول بين الديمقراطيات الليبرالية، وهي كيانات فقهية تحفظ الحقوق وتقبل الترويض، وبين آلات عنفية ظالمة وكاذبة ولا تخضع لأي مساءلة.
أما ثاني ملامح التفوّق فهو الإنتاج الثقافي الدؤوب، والفكر الواثق المنفتح على كل الدروب والشعوب. إن الفقه المذكور لم ينشأ في فراغ، ولا هو نتيجة عبقرية خاصة. يدّعي الجميع أنهم استثناء، ولكن نهضة الأوروبيين بدأت بالضبط بعد مغادرتهم لأنفسهم؛ بعد خروجهم من بلادهم وتعلّمهم من غيرهم وانفتاحهم على بعضهم: بدءاً من الترجمات اللاتينية عن العربية والعبرية في القرنين الحادي والثاني عشر، ثم انتشار الجامعات انطلاقاً من اللاهوت ثم الطب ثم سائر العلوم الأخرى، وفي غمرة ذلك اختراع المطبعة، ثم الصحافة، ثم المجال الفكري والسياسي العام، وتكاثر الرحلات والاكتشافات التجارية والجغرافية، والتعرّف أكثر على مكتبات العرب وسياسات الآسيويينمنذ سنوات ومدرسة «التاريخ العالمي» تبحث في علاقة النهضة الأوروبية بعوالم غير الأوروبيين، ولعل الجزء الأول من ثنائية النظام السياسي لفرانسس فوكوياما أصبح من كلاسيكيات هذه المدرسة. يشرح المثقف الذائع الصيت كيف تعلّم الغربيون مأسسة الحكم والتعليم من الصين، والمساءلة وتوازن السلطات من الهند، والبيرقراطية المخلصة لجهاز الدولة من الأتراك المسلمين. وحريات السكان الأصليين.للمزيد حول نقطة السكان الأصليين، يراجَع الفصل الثاني من كتاب غريبر ووينغرو الأخير فجر كل شيء، والذي يجادلان فيه أن نقد سكّان أميركا الشمالية لنمط حياة المستوطنين الأوروبيين، المنغلق والمتزمّت وقتذاك، هو الذي ولّد الأسئلة المتعلقة بالحرية الفردية والمجال العام ومساءلة النظام الإقطاعي. الكتاب ردّ شبه صريح على كتب هراري وبينكر. كل ذلك صبّ في الثورات العلمية والصناعية في القرنين الثامن والتاسع عشر، ثم الإعلام الجماهيري وثورات التواصل في القرن العشرين. وقد واكبت مؤسسات أكاديمية وإعلامية وفنية ذلك كلّه، وعملت وما تزال على إنتاج معارف وتمثيلات نقدية حوله – بما في ذلك التنقيب في الجرائم والسّرقات والتحيّزات التي لطّخت معظمه.
يسألونك عن قلّة التقوى؛ قل هي أن تسمع القوم يُحدَّثون بعيوبِهم في عُقر دارِهم، فترجع إلى قومك تنقلها لهم كأنها كلمة الحق والفتح المُبين. إن أصدقاءنا نقّاد الحداثة هم تلاميذ كل تلك المؤسسات الحديثة التي يَمقَتونها، ونيويورك هي الكبيرة التي علّمتهم السحر: دراسات ما بعد الاستعمار.يعيش كل من طلال أسد وحميد دباشي وجوزيف مسعد ووائل حلاق في نيويورك، وكذلك رائدة الحقل غاياتري سبيفاك، وكان شريكها الراحل إدوارد سعيد قد توفّي في المدينة نفسها عام 2003.
ليس التفوّق عِرقياً أو «طبيعياً» بأيّ شكل، بل هو تطوّر تاريخي تماماً، سياسي وثقافي بالعمق، ويمكن فهمه دون تلك الدموية المزعومة في الحضارة الحديثة دون غيرها. هل التفوّق عسكري إلى حد شديد ومؤلم؟ بدون شكّ. ولكن هل يمكن مقاومة العسكر وكسر شوكة وزارات الدفاع، بدون تحويل بلادنا وأرواحنا إلى قلاع؟ هذا هو السؤال. ليست العسكرة المتمادية للحضارة قدَراً على الإطلاق، ولا يجب أن نقبلها كقدَر، والأهم ألّا نتوهّم أن «الغزوات» بداية مناسبة لأي حكاية.
الفصل الثالث
وَلَو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً
ألا يشعر مُصارعو الحضارات بالغُبن حين ينتمي الأميركيون إلى الرومان والإغريق، دوناً عن العراقيين والشاميين والمصريين؟ منذ متى طارت إيطاليا واليونان من بحرنا المتوسّط وحطّتا على المحيط الذي يتذكره الفرنسيون والإسبان باسمه العربي: بحر الظلمات؟
لا «أُقدّس» الغرب بل أشكّ في وجوده. مخترعو سحر الشرق هم نفسهم مخترعو الغرب المقدَّس والمدنَّس، ونفسهم من رسموا خطاً وهمياً يصرخ على ضفّتيه شيوخ المؤامرات ومناهضو الإمبريالية. لقد كانت بلادنا جزءاً من أمّة رومانية واحدة تمتدّ من تبوك إلى لندن، وكانت تُنجِب فيها الشعراء والثوّار والفلاسفة والأباطرة. وبعدما سقطت روما، كانت دمشق هي التي ورثت ولاياتها الشرقية والجنوبية. أما أهلنا وأجدادنا في الشمال فغادروا تاريخنا خمسمئة سنة، إلى أن عادوا إلى سواحلنا يحملون الصليب كالتوحيد على رايات داعش. ثم راحت إمارات الصليبيين تتساقط عن مدن الشام، ومحاكم التفتيش تتلقّط الموريسكيين في صقلية والأندلس، وبعدها راحت الثقافة الإسلامية تزحف إلى أوروبا مرتديةً ثياب القساوسة. بعبارة أخرى، ثمة تقاطعات تاريخية كثيرة بين تاريخ العرب المسلمين وتاريخ النهضة الغربية: من إحياء التوراة وتحليل المُتَع والطيّبات من الرّزق، إلى كسر الكهنوت وتمكين عموم المؤمنين من قراءة الوحي، إلى التوحيد الصارم العنيد، والتبشير الديني المحموم، ثم الحروب الطائفية المؤسفة، والأمجاد العسكرية الدامية، والنزعة التجارية التوسّعية، ناهيك عن الجهد التأليفي والتشريعي المدهش، وأعمال الترجمة والنقل الحثيث عن المغلوبين، ومزاوجة الديانات الإبراهيمية بالفلسفة اليونانية، وحتى «الاستشراق» والولع بتراث العرفان الهندي والفارسي.ديفيد غريبر، مقالات في التراتبية والثورة والرغبة، لندن 2007، ص340.
وهكذا فإن الغرب الأطلسي ليس سوى ابن عمّ الشرق المتوسّطي. والنتيجة أنه لثالث مرة، بعد الرومان وبعد المسلمين، بنى الليبراليون عالماً موحّداً تحكمه شريعة متجدّدة، تقوده مجتمعات حيوية تزداد ثراءً وتعقيداً وفهماً للطبيعة من حولها، فشدّ الناس إليها الرحال وتعلّموا لغتها وترقَّوا في صفوفها. شيءٌ مثل ذلك حدث في القرن الهجري الأول، بعدما ربّى إمام المتّقين ورسول ربّ العالمين جيلاً من العلماء والقضاة والحكّام الراشدين. لكن لا تاريخنا بدأ بعد الإسلام – كما يقول من يظنّون أن الله خلقهم وحدهم – ولا الشمس أشرقت علينا بعد دخول نابليون إلى القاهرة – كما يقول من يخلطون بين التنوير وحرق المصاحف – ولا الأرض يوماً توقفت عن الدوران أو دارت مع قوم دون آخرين. جرت قطيعة فكرية بين الحضارات الثلاث، ولكن التواصل التاريخي لم ينقطع البتّة.توجد آثار نقود عربية كثيرة في غرب أوروبا منذ زمن هشام بن عبد الملك على الأقل، ما يفسَّر برحلات الحج المسيحي التي لم تنقطع في العصور الوسطى. لكن اللافت تداخل التقاليد القصصية والأخيلة الشعبية بين أبناء العصور القديمة المتأخرة: في شمال إنكلترا، مثلاً، رأى راعي غنم مغمور مناماً تعلم فيه كتابة الشعر، فجأةً ومن غير سابقِ علم، فذهب إلى أهله والرهبان في قريته وحدّثهم بما جرى، وتلا عليهم قصيدة في مديح الرب خالق السماوات، فاتفقوا أن الله اصطفاه لتأليف الترانيم الكنسية. هذه قصة شاعر الإنكليزية الأول كيدمون كما رواها بيدا الراهب (672-735)، والمشابِهة لقصة نزول الوحي كما وردت عن ابن إسحاق (704-766). للمزيد، يراجع الفصل الأخير من كتاب شان أنثوني محمد وإمبراطوريات الإيمان.
ولا أقول ذلك تمجيداً للذات ولا تقرّباً من الآخر، بل تشكيكاً في أن الآخر آخر أصلاً، وتحدّياً لحاملي لواء الغالب وحاملي لواء المغلوب، وتذكيراً بحقائق قد ينساها من يعدّون القتلى ويبْنون المتاريس ويسنّون سيوف الثأر. إن ما يسمّى الحضارة الغربية ليست مِلكاً للغربيين كما يشاء يَمينُهم أن يقول ويحشد، ولا هي عدوّ للمسلمين كما يشاء يَمينُنا أن يقول ويحشد. وما من عصور ظلام وانحطاط، بل نور ممتدّ يسير ما شاء الله له أن يسير، ومعه يسير البشر بخيرهم وشرّهم. ولولا مئات الحروب طوال آلاف السنين لما أورثنا المؤرّخون ذلك الحقد وهذه الغِشاوة، ولَمَا رسموا تلك الحدود الآثمة بين القارّات والكتب المقدّسة وجعلونا نقول كنّا وصاروا أو كانوا وصرنا.كان طه حسين من أشهر المدافعين عن الجذر الحضاري المشترك بين مصر واليونان، بل ومركزية المشرق العربي الإسلامي في نهضة أوروبا الحديثة، رافضاً فكرة الحضارات المتعدّدة ومؤكّداً أن الحضارة البشرية واحدة.
إن تغييب المشترك الأخلاقي والثقافي لا يعني عدم وجوده أو انعدام جدواه، بل يعني أن العَطَب الوحيد الذي فينا هو تواطؤنا مع هذا التغييب؛ وهو سقوطنا في دوّامة العنف والطغيان الذي يأكل قلوبنا قبل بلادنا؛ وهو غضُّنا الطرْف عن أنجع الطرُق لانتزاع تفوُّق المستعمِرين منهم: المزيد من الفقه العمومي، والمزيد من المعرفة الكونية.
الفصل الرابع
بِحَبلٍ مِنَ اللهِ وَحَبلٍ مِنَ النَّاسِ
تحدّثْت عن جذرين سياسي وثقافي للحضارة المعاصرة، وبيّنْت امتدادهما العميق في العالم الواحد الذي بناه المسلمون ومن قبلهم الرومان. الآن لنُبعّدْ قليلاً ونتحدث عن بدء التاريخ وأوّل العنف، لنَعُدْ إلى: بنية الإبادة.
تنشأ الحضارة من تسخير الأرض لما فيه مصلحة الإنسان، وهكذا تولد الثروة. ثم يأتي من يسخّر الذين يسخّرون الأرض، لما فيه مصلحة أصحاب المصلحة، وهكذا تولد القوّة. تتطوّر أشكال الإنتاج الاقتصادي والتنظيم السياسي كل بضعة قرون، وهكذا تنمو السلطة وتزيد الفوارق ويخضع الإنسان للإنسان. منذ عشرين ألف سنة وحتى اليوم، لم تتغير مأساتنا المزدوجة مع الحضارة: الجوع والخوف، ثم صناعة الجوع وصناعة الخوف نتيجة الاستئثار بالثروة والقوّة وما يجرّه ذلك من استضعاف واستقواء. كل الدول التي نشأت وتوسّعت في التاريخ بدأت عصابات قتل ونهب، تقريباً بلا استثناء، وكل عُصبةِ رعايا التفّت حول دولتها شاركت في أعمال قتلها ونهبها.بالتقابل مع تعريف ماكس فيبر المثالوي للدولة بوصفها «مؤسسة احتكار العنف»، يُعتبر تشارلز تيلي أشهر أصحاب التعريف الواقعي التاريخي: الدولة مؤسسة حربية بالأساس، وهي في نشأتها لا تختلف عن عصابات الجريمة المنظّمة، من استخراج الموارد إلى فرض الخوّات لقاء الحماية وحتى الغزو العسكري لأراضٍ جديدة. يبلغ ذلك ذروته في الحصارات والفتوحات الإمبراطورية، لا يشذّ في ذلك أوروبّيو الألفية الماضية ولا أسلافهم في الألفيات السابقة. الأمر أشبه بقانون «اصطفاء طبيعي» حتمي ومفجع: فارق السلطة = فائض العنف، وكلما اتّسع الفارق فاض العنف أكثر.
وحدها الشريعة، تلك الروح الإلهية في مستوطنات البشر، تُغيّر المعادلة لتصبح: فارق السلطة + الحكم الشرعي = انحسار العنف، وكلما رَسَخ الحكم دارت الثروة في الاقتصاد ودالت القوّة بين أهل السياسة. بذلك تَحَوَّل الأحناف والصعاليك وقطّاع الطرق حول يثرب إلى أمّة هائلة يحكمها إمام فقير، وبذلك نشأ أول عقد اجتماعي وتحقّقت أول مساواة أمام القانون في التاريخ. يبدو معنى «الحكم الشرعي» مزدوجاً: ما يأمر به الدين الإسلامي أو النظام الذي يتمتع بالشرعية، لكن لا فرق على الإطلاق ولا يجوز أن يكون هناك فرق.
وهكذا يتنزّل الوحي على قلوب الأنبياء: فكراً وكفاحاً وأدباً، ونداءً أبدياً إلى المزيد من الحق والعدل والجمال.حاول عدد من المفكّرين المسلمين تفسير ظاهرة النبوّة، علماً أن الكثير من أعمال القُدامى لم يصلنا. قرّب الفارابي بين النبي الذي يتلقى الحقائق متجلّيةً بشكل حسّي بصور وأشكال وقصص، وبين الفيلسوف الذي يستخرجها نفسها بالتجريد العقلي. وكان جودت سعيد من أشهر الأصوات التي أكّدت مركزية النشاط الاجتماعي والسياسي في رسالة الأنبياء من أجل الأمر بالقسط ونزع العنف. أما نصر حامد أبو زيد فاشتغل على عقلنة علوم القرآن وتحليل الخطاب القرآني بأدوات النقد الأدبي والجمالي. رحمهم الله جميعاً. وهكذا يكتسب البشر القدرة على المعرفة، أي الإدراك والتخيّل، أي نسج القصص ورسم الحقيقة باللّغة، أي فهم الوجود الطبيعي وتجاوزه بحثاً عن المعنى، ثم التساؤل عما يمكن للسلطة أن تفعله كي تعتدل وبعدما تعتدل. بقيت المعرفة البشرية تتضاعف كل بضعة قرون، ومعها تتطوّر تقنيات الكتابة وأشكال توثيق العلم والمال والقانون. ثم نزل الكتاب السماوي الأخير وتعهّد للعرب بهموم الأمم الكاتبة من قبلهم: الأسئلة الفكرية والاجتماعية والتشريعية، ما جعلهم أمّة مثقّفة ذات شأن. وفي الألف التالية لانقطاع الوحي اختُرِعت المطبعة، التي دُوِّنت بها فلسفة الألمان وثورات الفرنسيين وبيرقراطية الإنكليز، ما جعلهم أمماً مثقّفة ذات شأن. وما تزال نسبة الأمّيّة في أي قوم متناسبة عكساً مع ما يحوزونه من قُوتٍ وقوّة. ولعلّ أصل الاستعمار في التاريخ هو فيضان السلطة والمعرفة من الأمم الكتابية على الجماعات الشفاهية، بالحَسَن الذي يحمله ذلك وبالسيّئ والقبيح.تُعتبر الشعبوية الإلكترونية اليوم ردة فعل عميقة وعنيفة على الاستعمار الكتابي، ولا سيما من جانب المحكيّات العامية المهمّشة ضد اللغات الرسمية الحاكمة. المثير في الشعبوية العربية-الإسلامية أنها تنطق بلغة «حاكمة سابقة». قبل سنوات من صعود دونالد ترامب، نوّهت عالمة الاجتماع التركية-الأميركية زينب توفكجي بـ«الديناميات النفسية الشفاهية» التي خلقها التواصل الجماهيري، مُحيلةً بوجه خاص إلى أعمال المؤرّخ فالتر أونغ حول تاريخ الشفاهة وتكنولوجيا الكتابة. أما الحُكْم فهو بالضبط «الحكمة» التي تمنح المعنى للسلطة والمعرفة وتزكّيهما بما فيه رضا الله وهناء الناس، ولا فرق على الإطلاق ولا يجوز أن يكون هناك فرق.أصل كلمة حُكْم في العربية القول الصادق المطابق للحقّ؛ ثم أعمال القضاء والفصل بين المتخاصمين؛ وبعدهما – وفق معجم الدوحة التاريخي – نشأ معنى المُلْك والسياسة و«الأمر».
لا يرضى الله حين لا يهنأ الناس، ولا تتطبّق الشريعة حين لا تتحقّق المصلحة، ولا تعيش المذاهب الدينية خارج علم النفس والاجتماع، ولا بالطبع غصباً عنهما. مع ذلك، إلى جانب سطوة أرباب الاقتصاد والسياسة، ثمة سطوة حرّاس المعنى والعقيدة والهوية. وكثيراً ما تفقد الشرائع عُمقها العمومي والكوني، فتتوشّح بها المصالح والجماعات – أو تتوشّح بها المصالح والجماعات، فتفقد عُمقها العمومي والكوني – فتصبح «خادمة لذاتها» وتنقلب إلى سلطات باغية ومعابد معزولة. تُوصَف الحداثة بأنها انتقال شرعية الدولة من الآلهة إلى الشعب، لكن لم تكن الحداثة لتحدث لولا انتقال الدين نفسه من الوحي إلى التدبير. فالأديان أطول عمراً من الدول، وحياة المحكومين هي مضمار الفهم والتأويل وليس مكانة الحاكم. ومن هنا يمكن اعتبار كل العقائد السياسية الحديثة مذاهب دينية: محاولات في الحكمة، تُجدّد الاقتصاد والسياسة عبر الثقافة، من أجل الانتقال من المستوطنة إلى المجتمع.
وعلى هذه الأرضية يتفوّق المذهب الليبرالي الديمقراطي على ما عداه، وذلك لأنه أكثر المعارف السياسية استنارةً بأحوال المجتمع وأقدرها على التجدّد والتناغم مع الواقع. أما الليبرالية فقد أعلت قيمة الحرية، وانشغلت بنزع العنف وتعزيز الفعل الاقتصادي، فاكتشفت المسؤولية الفردية وقوّة التعاقد الرأسمالي. ولذلك لم ينجح اقتصاد الإمبراطورية الإسبانية في القرن السادس عشر في منافسة الشركات الهولندية والإنكليزية الناشئة، التي كان يقودها مستعمرون هم أيضاً مستثمرون. وأما الديمقراطية فأعلت قيمة المساواة، وانشغلت بوقف التمييز وتعزيز الفعل السياسي، فاكتشفت الهوية الجماعية وقوّة التعاقد الجمهوري. ولذلك لم تتمكن الممالك الألمانية والإيطالية أول القرن التاسع عشر من الصمود في وجه المدّ الثوري الفرنسي، والذي عمّم قيم الحقوق والإخاء الوطني والترقية حسب الكفاءة.
ورغم تأسيسها للمجال العام كما نعرفه اليوم، بقيت الليبرالية عاجزة عن درء عنف عميم، ناعم أو خشن أو حتى دموي، نتيجة تعايشها مع تاريخ من الاستعلاء العنصري، ومع المصالح المالية العملاقة، وبالتالي التفاوت الفاحش بين المجتمعات وضمنها.من أهم ما كُتب في مثالب الليبرالية كتاب التاريخ المضاد لدومينيكو لوسوردو، وثمة الكثير من الكتابات الناقدة لـ«النيوليبرالية» لكن يكثر فيها الغثّ والبليد للأسف. والنيوليبرالية مذهب متطرّف، أقرب إلى ماركسية مقلوبة، تطوّر كردّ فعل رأسمالي علمي على تغوُّل دول ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا ما استدعى ويستدعي «إصلاحاً دينياً» متواصلاً. وقد تشكّلت الفكرة الديمقراطية كردّ فعل على قصور الليبرالية العمومي والكوني، لتبني على عقود من النضال العمّالي والنسائي ومعارك نزع الاستعمار. ولكن حتى الديمقراطية كثيراً ما انقلبت على نفسها أو على الليبرالية في خضمّ بحثها عن الحرية والمساواة.استفدت كثيراً من كل أعمال ياسين الحاج صالح. أُحيل بالذات إلى مقالاته «الليبرالية والديمقراطية والحداثة السياسية» (2006) و«الإصلاح الإسلامي: من ’الدين الصلب‘ إلى ’الدين المرن‘» (2010) و«من ’الإسلام‘ إلى المجتمع: مقاربة جمهورية علمانية» (2013). وما من سبيل واضحة ومباشرة للتوزيع العادل والضبط المتين لفوارق السلطة، بل ألف سبيل مواربة ومُستعصية. وكثيراً ما تتحول السياسة «الخادمة لذاتها» من الفقه العمومي إلى القانون الخصوصي، ومن المعرفة الكونية إلى الجهالة القومية، ومن تعزيز المشترك الإنساني إلى تثبيت الاستثناءات والامتيازات. وما يهمّنا هنا أن التبصّر الاجتماعي الرشيد هو ترياق تلك الثقافوية القاسية والزائفة، من الممارسات العنصرية بحق اللاجئين والمهاجرين، إلى الجبروت العسكري النووي في مجلس الأمن. أما المقاومة بمنظور اجتماعي ضامر فلن تنجح ولن تنجع. وهذا دون أن نشكّ لحظة بحقّ المقاوِمين في الغضب وردّة الفعل.
ليست مشكلة بلادنا الطغيان «الغربي» الماضي أو الحاضر، بل فارق السلطة المريع الذي يحرسه هذا الطغيان لمصلحة الدول القويّة والثريّة. إن مشكلة إسرائيل ودول الخليج هي مشكلة المستوطنات الأوروبية القديمة: أنها معادية للديمقراطية بشراسة، تحتقر المساواة وتمجّد التمييز وتُبيح لنفسها الاستيلاء على الأرض والتاريخ. وفي المقابل هناك مشكلة الدول المصابة بجنون العظمة مثل إيران وتركيا: أنها معادية للّيبرالية بشراسة، تحتقر الحرية وتمجّد العنف وتُبيح لنفسها الاستيلاء على الهويات والقضايا. وفي كل الحالات ثمة فكر قومي مسلّح يريد أن يحارب العالم، وثمة قوى غربية واقعة في غرام هذا الحريق أو ذاك، وثمة نحن الذين لا يُلهمنا ويُلهبنا إلا فكر قومي مسلّح أو أقوياء مُغرَمون بنيراننا.
إن الفوارق بين البشر هي أصل كل المجازر والحروب، والدولة المسلّحة هي عدوّ الإنسان الأول، والاستقواء والاستضعاف هما الخطيئة البشرية الأقدم، والقوّة غير ذات الدستور هي ما ينبغي أن تتوجّه إليه السّهام بلا توقّف، وليس هوية هذه القوّة أو دينها وأصلها. وإن الدستور الأوفى لروح الشريعة – التي هي هي السلام على الأرض والمسرّة في الناس – هو كل ما يحمي من العنف والتمييز، ويدافع عن المزيد من العموم والكونية. وهذا الدستور يكون ديمقراطياً وليبرالياً، أو لا يكون.
الفصل الخامس
اُدخُلُوا فِي السِّلمِ كَافَّةً
فلنتوقّفْ عن انتقاء أنصع ما في تاريخنا وأقذر ما في تاريخ الآخرين، ولننظرْ في مرآتنا الكونية بصدق: هذا العالم كلُّنا منه، وكلُّه منا، ونحن جميعاً مسؤولون عن الفساد وسفك الدماء فيه. إن المشروع الحداثي العربي والإسلامي، ومثله الروسي والصيني، هو الذي يختزل الحضارة الحديثة في التجارب والتقنيات دوناً عن الشرائع والآداب، وهو الذي يستورد العلم الذي تُبنى به الجيوش دوناً عن الفقه الذي تُبنى به الشعوب. وذلك بالضبط ما يفعله كل طغاة المال والسلاح والهوية، من غربيين وغيرهم، وكلّهم عدوّ أهلنا وأهلهم. يريد هؤلاء دفن الفلسفة والتاريخ، وسرقة ثمار الحرية والعقل، وتهميش الإلهيات والإنسانيات التي بها يُعرَف الحقّ ويُؤمَر بالقسط ويُسعى إلى الخير والحبّ والسكينة.
يتطلّب تجديد الشريعة الإسلامية التأكيد على أنها نهج روحي وأخلاقي وليست مشروعاً سلطوياً. وهو ما يتطلّب الفصل بين فقه العبادات الذي يخصّ المؤمنين المتعبّدين، وبين فقه المعاملات الذي يعمّ الناس كافّة، على أن يحكم هذا وذاك «الفقه الأكبر» – أي علوم اللغة والكلام المستنيرة بالمعارف الحديثة. هذا الفقه وحده ما سيحمي حقوق غير المؤمنين، ويُصلِح أزمة التديُّن الإسلامي العضوض، ويستعيد القرآن بلاغاً كونياً لا متاعاً لأهل الجهل والجاهلية.
لم تكن رسالة الله سوى أمل بأن وراء الحياة ما وراءها، بأن شقاء البشر قابل للنهاية، وبأن العدل والإحسان أبقى من الظلم والإساءة. ولم تكن «أسلِمْ تسلمْ» سوى دعوة إلى ميثاق اجتماعي عالمي يُلقى فيه السلاح ويُرفَع الإكراه خارج أشكال الدفاع عن المجتمع والعالم. ولا يحول بيننا وبين الأمل والميثاق سوى أن مقاصد الشريعة – وأهمّها رحمة العالمين وتعارف الشعوب والبرّ بين الناس – مدفونة تحت أطنان الوعظ وفتاوى المِلَل والسَّفَه المسلَّح.
ليس علينا «تغيير العالم» كأنه غرفة نوم، بل إعمار الأرض بما يمكث فيها وينفع الناس: أي بناء مجتمعات أفضل. يُعرَّف المجتمع بالاقتصاد والسياسة والثقافة: فالاقتصاد محوره الكَسْب والثراء العام، والسياسة محورها التسوية والتمكين العام، والثقافة هي ما وراء ذلك من حكمة فردية وعامة. لا تنفع التسويات دون أساس للكَسْب، ولا هي تدوم دون حكمة جديدة أو متجدّدة. وفيما الثراء والتمكين وسيلتان لإسعاد أو إتعاس الناس، فإن الحكمة هي الغاية القصوى وهي السعادة عينُها؛ بها يُعرَف اللهُ ويُعبَد، وبها يترقّى المرءُ ويَسعَد.قدّم ابن سينا رؤية «تطورية» لمراتب النفس البشرية: فالمرتبة الأولى «نباتية» تتم بها وظائف التغذية والنمو والتوليد، والثانية «حيوانية» لها قوى الإحساس والحركة وإدراك جزئيات الطبيعة، والثالثة «ناطقة» تدرك الحقائق الكلية عن طريق الاستقراء والاستنتاج، والرابعة الأعلى «قدسية» تدرك الحقائق الأزلية بشعور باطني وإلهام داخلي. وترتبط الحكمة، كلمة سرّ الفلاسفة والمتصوّفة، بالترقّي من النفس الناطقة إلى النفس القدسية. وهو ما يشرحه ببراعة المدوّن الأميركي توم إيربان في تدوينته المصوّرة «الدين لغير المتديّنين»، ويدافع عنه المفكّر السويسري-البريطاني آلان دو بوتون في دعوته إلى فكر إلحادي جديد يتجاوز المراهقة التي تبدأ وتنتهي عند تسخيف التديّن. وإنه من أجل الحكمة يعيش الناس على هذه الأرض، لا من أجل آلات عنف يبنونها مئة عام ثم تزول كما تزول الدول. وإن من أعظم الحكمة في عالمنا الحرية والمساواة والدساتير العادلة، وأكاد أجزم أن الأنبياء لو قرأوا من هذه الدساتير لسجدوا لله حامدين ومُسَبّحين. فهلّا أدركْنا شيئاً قريباً أو أحسن من ذلك، بدل وقْف أنفسنا لحَسَنات الماضي وسيّئات الحاضر؟ وهلّا تملّكْنا هذه الحداثة بالعلم والعمل، كما تَمَلَّك آباؤها علوم وأعمال أجدادنا؟
هناك من يريد جرّ المسلمين إلى الخنادق كي يكدِّسوا السلاح ويصمدوا في وجه المدافع والطائرات، مُحْتَمين ومُحَطَّمين؛ وآخرون يريدون حبْسهم في أحياء عشوائية على ضفاف الحضارة كي يقبضوا على جمر التديّن والهويّة، مُرتاحين ومُرتابين. وكم يعزّ على من اتّسعت لهم أرض الله فهاجروا فيها أن يقولوا أي شيء، سوى الحزن والخشوع والدعاء لأهلهم وإخوانهم. ربما فُرِض القصف والتهميش علينا دون أن يختاره أحد، وربما كان عنف الحضارة وقسوتُها البالغة هما السبب في حُطام منازلنا وكآبة مناظرنا. ولكن فكْرنا الإسلامي صار قائماً بأكمله على هَزْم النفس وإعادة إنتاج الذِّلّة والمَسْكَنة، حتى صرنا نستغفر الله من النّور ونحمده على إدمان الظلام. ولا بد أن يصرخ أحد في وجه هذا الجنون: نحن أكرم من كل تلك الخنادق والعشوائيات، وواجبنا أن نغادرها بأسرع طريقة ممكنة.