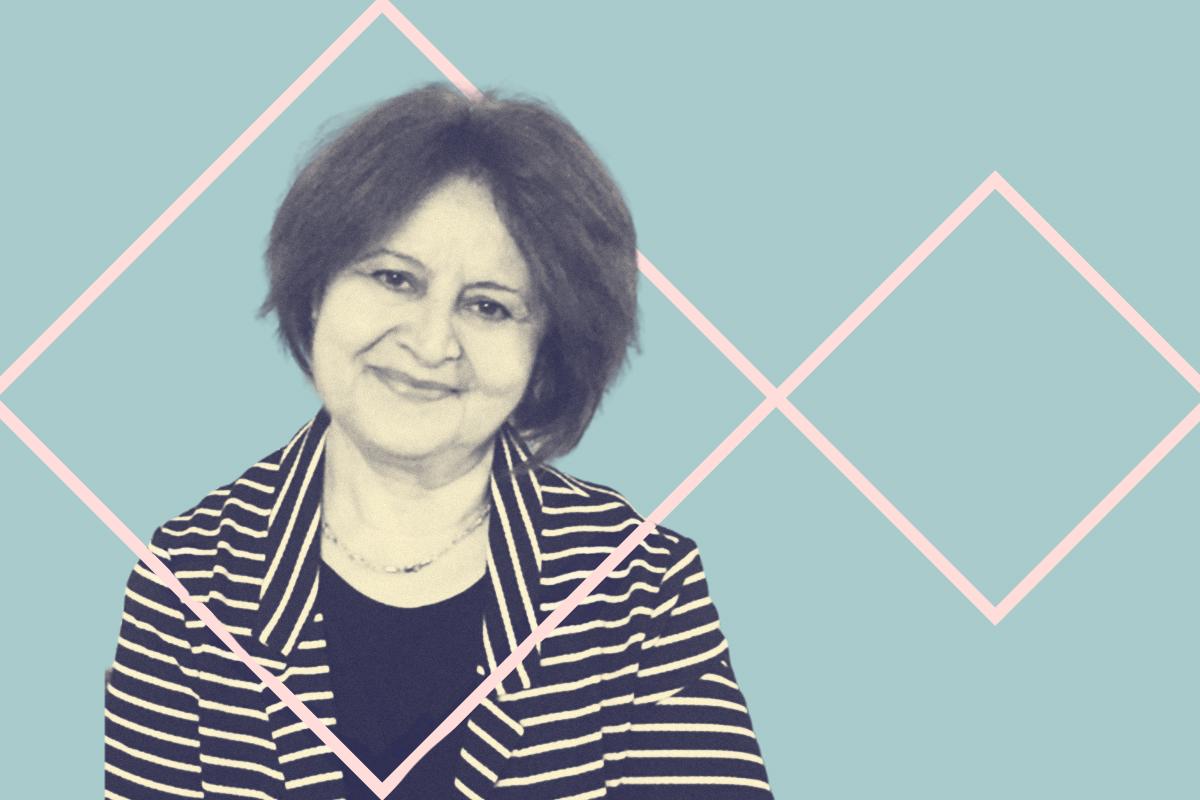أين كنتِ في آذار 2011 يا ندى، وإلى أين أودت بكِ دروب الثورة والحرب؟
أذكر أني كنت في 15 آذار (مارس) 2011 جالسة أحفر كوسا لأطبخ قبل سفري في اليوم التالي للمشاركة في الاعتصام المقرر أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وإذ بالهاتف يرن، ويبدأ حديثي عبر التلفزيون. قلتُ حينها إن سوريا مثل بقية الدول العربية، وإن لم تقم القيادة السياسية بإصلاحات سريعة، وأهمها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، فإن الثورة قادمة لا محالة. وحين انتهت المكالمة، فوجئتُ بتواجد الأمن تحت منزلي في مصياف، وكأن هذا الاتصال أطلق ساعة الصفر.
كنتُ في تلك الفترة ممنوعة من السفر، ولكن المنع زال بعد انطلاق الثورة، فسافرتُ في كانون الأول 2012 لحضور ولادة ابنتي المتزوجة في الأردن. وما زلتُ مقيمة هناك منذ ذلك الحين. وقد حوّلني النظام السوري إلى محكمة الإرهاب إثر حضوري مؤتمر «كلنا سوريون» في 2013. كذلك تمت مصادرة كل ما أملك وتجميد راتبي التقاعدي. توفي زوجي العام الماضي ودُفِن في الأردن. لم أفكر لثانية واحدة بالدفن في بلدي الذي هُجِّر أهله، وما زال يعاني من بطش الأسد.
دخلتِ معترك السياسة في سن مبكرة، وانتسبتِ بعد ذلك لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي. هل وجدتِ ضالتكِ في السياسة؟ وهل كانت المرأة في تلك الأيام قادرة على ممارسة السياسة وتجاوز العقبات التي يضعها المجتمع أمام خروجها إلى المجال العام؟
بدأتُ بالعمل السياسي في سن مبكرة، فأنا أعيش في الأصل في بيئة يمكننا وصفها بالسياسية. أبي خريج حقوق، ومهتم بالسياسة، ومحسوب على التيار القومي البعثي. أمي درست فقط إلى الصف الرابع، ولكن هذا ليس قليلًا لامرأة من جيلها. كانت قارئة جيدة للروايات العالمية، ولديها اهتمام بالوضع العام. عشتُ في بيئة تهتم بالأخبار العامة وماذا يحصل في فلسطين وسوريا.
كنتُ صغيرة أثناء حرب الـ67، ومع ذلك حرّضت لدي تساؤلات كثيرة، فبدأتُ أبحث عن موقعي. كانت بلدتي مصياف تحتوي على جميع التيارات السياسية، ومن المعروف أن ناسها كانوا يختلفون سياسيًا، ولكنهم لا يختلفون عائليًا أو طائفيًا. جاءت حركة حافظ الأسد حين كنتُ في سن الرابعة عشرة. أذكر أني ذهبتُ مع والدي إلى المركز الثقافي، حيث طُرِح اسم حافظ الأسد أثناء النقاش. وبما أني كنتُ لا أزال بريئة حينها، فقد رفعتُ يدي لأقول إنه ليس من المعقول أن يصبح الشخص الذي سلّم الجولان رئيسًا لسوريا. أذكر كيف توجهت الأنظار إلى والدي، وطلبوا منه أن يُسكتني. ناداني والدي بلطف، وقال لي إنه سيجيبني على سؤالي في البيت. ما أريد قوله إن اهتمامي بالسياسة بدأ في سن مبكرة.
دخلتُ النشاط السياسي في الصف العاشر، وكان اهتمامي منصبًا على الفكر القومي العربي. حيث انتشرت بيننا كتب المفكرين القوميين، كنديم البيطار، وعصمت سيف الدولة، ومطاع الصفدي، ومنيف الرزاز. في يفاعتي لم يكن التلفزيون متوفرًا في جميع البيوت، واقتصرَ البث على أوقات محددة، لذلك كانت تسليتنا هي قراءة الكتب ومناقشتها لاحقًا. وقد طرح عصمت سيف الدولة وقتئذٍ ما يسمى بـ«بيان طارق»، وهو عبارة عن فكرة تشكيل حركة إعدادية لتهيئة الكوادر التي سوف تشتغل على نفسها فكريًا وثقافيًا على مستوى الوطن العربي. يمكنني اعتبار حياتي الفكرية والثقافية بنتَ هذه الحركة أكثر من كونها بنتَ تجربة حزبية. كانت حركة الإعداد عبارة عن تجمعات كبيرة، وكانت أعداد الفتيات فيها كبيرة. يمكنني القول، دون أي مبالغة، إن معظم عائلات مصياف كان فيها بنت أو بنتان ضمن تلك الحركة. كان عددنا في بداية السبعينات حوالي الخمسين بنتًا.
وحين دخلتُ جامعة دمشق، اكتشفتُ أن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي هو الأقرب لي فكريًا. لعله ينبغي أن أحكي شيئًا عن البيت الذي نشأتُ فيه: والدي لم يكن يحب عبد الناصر أبدًا. أما أنا فقد كنتُ، على عكسه، مقتنعة أن لعبد الناصر مشروعًا تحرريًا. بيد أنه لم يكن مقدّسًا بالنسبة لي، فالمشروع العربي التحرري هو الذي كان يشغل بالي بالدرجة الأولى، واعتبرتُ أن عبد الناصر قَدِرَ على تحريك الجماهير. ورغم تقييم والدي السلبي له، إلا أنه كان يجلب لي كتبًا عنه كلما سافر إلى حماة. كان يقول لي: «خذي، أنتِ عقلك تعبان، وتصطفلي!». ولكنه كان سعيدًا باهتماماتي العامة. وهكذا تسنّى لي أن أتعرّف على ما لعبد الناصر وما عليه.
بدأتُ تجربتي مع حزب الاتحاد الاشتراكي في دمشق إذن. وقد كان للحزب علاقات قديمة مع ريف دمشق. على سبيل المثال، كنا نعقد اجتماعاتنا في دوما والمعضمية والجديدة وقطنا. وكانت نسبة الفتيات لا بأس بها. أنا لستُ محجبة، وألبس البنطلون، ولكن ذوقي باللباس يميل للحالة المحافظة. كانت مدينتي مصياف منفتحة، ولكن اللباس لم يكن «فري». فضلًا عن اهتمامي السياسي الذي أثَّرَ على قناعاتي بخصوص الملابس. يصعب عليّ أن أليس قميصًا إلا إذا كان طويلًا بعض الشيء وعلى الأقل ثلاثة أرباع الكم. لذلك لم أواجه أي صعوبة في الذهاب إلى ريف دمشق، بل نشأت علاقة اجتماعية متينة بيني وبين فتيات المنطقة اللواتي كنتُ أجتمع معهنّ.
نشأ بعد ذلك خلافٌ ضمن الاتحاد الاشتراكي، وراحوا يسموننا «مجموعة عصمت سيف الدولة». كان البعض يقول إننا لسنا ناصريين، ويجب ألا نكون ضمن الاتحاد الاشتراكي. وهكذا بدأت تفسد علاقتنا التنظيمية بهم، حيث كان انتماؤنا للفكر القومي أكبر من ولائنا لحزب. الحزب هو دائمًا وسيلة، وحين لا تحقق غاياتها، فسوف نبحث عن وسيلة أخرى. الحزب ليس مقدسًا لدي، والأمر نفسه ينسحب على عبد الناصر. فرغم أني كنتُ ولا زلت أعتبره زعيمًا، وصاحب مشروع، إلا أني كنتُ أرى سلبياته وأُحاكمه وفق المشروع في زمانه. أما إذا أردتُ أن أقيّمه الآن بمفهوم القرن الحادي والعشرين، فسوف أكتشف أنه كان ديكتاتوريًا. ولكن في تلك الفترة كانت مفاهيم الديمقراطية مختلفة. كان هناك نموذجان في العالم: النموذج الاشتراكي والنموذج الرأسمالي. مالت الدول التي تريد نوعًا من العدالة لشعوبها إلى النهج الشيوعي، وبالتالي إلى مركزية السلطة وشموليتها. بينما أسّس أتباع النهج الآخر لمفاهيم مختلفة بالحرية والديمقراطية. لم يكن لدينا حالة الوسط. أنا أتكلم عن فترة الخمسينات والستينات. فيما بعد تطورت المفاهيم حول ما يسمى بالدولة الوطنية الديمقراطية التي ليست بالضرورة رأسمالية أو شيوعية. علاقتي مع الاتحاد الاشتراكي كانت خاضعة إلى مدّ وجزر، لأنهم كانوا يرفضون وجودنا أحيانًا. وحين انتقلتُ من جامعة دمشق إلى جامعة حلب، انقطعت علاقتي بهم، وظل تواصلي بحركة إعداد الطليعة العربية.
بالنسبة للعمل السياسي في سوريا، بتنا نعرف الآن أنه لم يكن هناك عمل سياسي حقيقي. كانت هناك مجموعات تجتمع في غرف مغلقة، حيث يدور نصف حديثها حول الإجراءات الأمنية وكيف ينبغي أن تحمي نفسها، والنصف الثاني عبارة عن تبادل بعض الأخبار التنظيمية. وتتكرر اللقاءات، ويمر الزمن، فنتساءل كيف لا يفرز عملنا السياسي على مدار أربعين أو خمسين عامًا أي قيادات فعلية حين تحلُّ الأزمة بسوريا. هذا يعني أنه لم يكن ثمة عمل سياسي، فمن المفترض أن يفرز العمل السياسي قيادات عليا، وقيادات متوسطة. كان لدينا مناضلون دفعوا أثمانًا باهظة في السجون، ولكن لم يكن لدينا سياسة.
تقرر السياسة عادة أن تفرمل أو تقتحم في مرحلة معينة، ولكن ما فعلناه كان عبارة عن ردود أفعال. حصل في الثمانينات ذلك الصدام بين قوات طليعة الأخوان المسلمين والنظام السوري، فقامت القوى الوطنية برد فعل، وشكلت التجمع الوطني الديمقراطي. ولكنها لم تنجح إلى تحويله إلى فعل سياسي يستغل لحظة ضعف النظام. لذلك استطاع هذا النظام تدمير مدن وبعض أحياء مدن. وإذا كان محتملًا أن تتطور حركة سياسية سوريّة في مرحلة السبعينات، ففي الثمانينات تحوّل كل العمل السياسي إلى السرية. غير أننا اكتشفنا لاحقًا أن كل الحركات كانت مكشوفة ومخترقة من قبل النظام الذي اعتقل عددًا كبيرًا من السياسيين، فلجم القواعد، وأنهى السياسة في سوريا.
عَرفَ مساركِ السياسي بعض التقلبات. فبعد انكفاء مؤقت بسبب جمود السياسة السورية، عدتِ مع ربيع دمشق. حيث تمّ انتخابك كعضوة أمانة عامة في إعلان دمشق. وحين انسحب الاتحاد الاشتراكي، أعلنتِ موقفك المستقل عنه، وبقيتِ في الإعلان. ولكنكِ قررت لاحقًا أن تنسحبي مجددًا بهدوء. ما هي خلفية هذه القرارات التي اتخذتِها في مرحلة ما؟ وماذا تخبرنا تلك الأحداث عن دوافعكِ الحقيقية في العمل السياسي؟
ظلّ اهتمامي بالشأن العام في ذروته، ولكني كنتُ أبحثُ كيف يمكنني التحرك سياسيًا بشكل فعلي. تركتُ الاتحاد الاشتراكي، أما حركة إعداد الطليعة العربية، فلم يكن لديها أي خطة سياسية. في التسعينات كنتُ موظفة، وأمًا لثلاثة أطفال صغار. وبما أن الوضع السوري كان مقلقًا، أخذتُ على عاتقي مهمة نقل الاهتمام بالسياسة إلى أطفالي. اعتبرتُهم جزءًا من المجتمع، وسوف يُكوّنون ثلاث أسر في المستقبل. كنتُ أطمح أن يكون اهتمامهم بالشأن العام أمرًا عاديًا كالأكل والشرب. كنتُ أتحايل عليهم، لأنه من الصعب الكلام معهم في السياسة السورية كي لا يأخذوا الحديث ويتعاملوا معه بطريقتهم. أذكر أني كنت أطلب منهم أن يكتبوا: فلسطين عربية وعاصمتها القدس، وأشرح لهم عن فلسطين. لم يكن ذلك مخيفًا، لأن النظام يتبنى موضوع فلسطين. كنت أرسم مع أطفالي خريطة الوطن العربي، وأشرح لهم كيف كان أجدادنا أيام زمان يتنقلون بين الحدود من دون عائق.
انتهت فترة التسعينات، ومات حافظ الأسد. وبوفاته انتعشت سوريا، رغم حالة الخوف الفظيعة التي لاحظتها في مصياف. فمصياف مدينة توجد فيها طائفتان: السنة والشيعة الإسماعيليون. الإسماعيليون النزاريون هم سكان مصياف الأساسيون، وليس الآغاخانيون كما في السلمية. هذا يعني أنهم لم يكونوا يختلفون كثيرًا عن السنة من ناحية طقوس العبادات. كان لدينا مسجد واحد، وجميع الناس يصلون فيه. بعضهم يصلي إسبالاً، والبعض الآخر يضمّ يديه أثناء الصلاة. لا أحد يتوقف عند هذه الأمور، والناس متعايشون مع بعضهم عمومًا. أما ريف مصياف، فقد كان علويًا بالكامل. توجد ثلاث قرى صغيرة مسيحية، ولكن الباقي كله علوي. لذلك حين توفي حافظ الأسد نشأت حالة من الاستنفار الفظيع. كان بعض الناس سعداء في أعماقهم، ولكنهم غير قادرين أن يعبّروا عن فرحهم أمام مظاهر الحزن التي ظهرت عند الطائفة العلوية، والتي شكلت بالنسبة لي نقطة علام على أن سوريا مُقدِمة على شيء في غاية الخطورة. كان هناك اصطفاف طائفي فظيع في الحزن أمام ابتهاج وفرحة بقية الناس. حتمًا لن يكون الأمر مريحًا فيما إذا انفجر الموقف. أنا كنتُ من الذين اعتبروا أن الأجهزة الأمنية لم تجد أنسب من بشار الأسد حتى يستمر الاطمئنان للطائفة العلوية من جهة، والتحكم بقواعد الحكم من جهة ثانية. هذا كان تقييمي، ولم أكن أرى حالة إيجابية.
اختفى العمل السياسي في مصياف تمامًا. مصياف التي كانت معروفة بتواجد جميع الأحزاب فيها، تحوّلت إلى تنوع يعبّر عن نفسه بالرموز الطائفية. صار إذا دعيتِ إلى سهرة ذات طبيعة سياسية، فلن يلبيكِ سوى المهتم جدًا والذي يثق بكِ كثيرًا. لن تتمكني من جمع أكثر من عشرة أشخاص، بينما أي محاضرة دينية بمقدورها أن تستقطب مئة أو مئتي شخص. بدأت ملامح التغيير تظهر في مدن صغيرة كمصياف. كنتُ أذهب في تلك الفترة إلى حمص ودمشق كي أحضر المنتديات، أغامر لأعرف ماذا يحصل. ولكن المشكلة أن التنقل في مصياف ليس سهلًا، وللأسف لم أتعلّم قيادة السيارة، مما جعل حركتي مرهونة بالمواصلات العامة.
انطباعي أن ربيع دمشق عبارة عن حركة مثقفين، ولم يتغلغل إلى عمق المجتمع. كنتُ أقابل الأشخاص أنفسهم في جميع المنتديات. للمنتديات أسماء مختلفة، ولكن الأشخاص الذين يرتادونها لا يتغيرون، قد يضاف واحد، وينقص واحد، ولكن بالعموم الوجوه هي نفسها في كل مكان، مع غياب للشريحة الشبابية والعنصر النسائي. لقد أثرت الثمانينات سلبًا على تواجد النساء في السياسة. خذي على سبيل المثال الاتحاد الاشتراكي العربي. تصوري أني كنتُ المرأة الوحيدة في الاجتماعات التي كانت تعقد في حماة. كنت أسأل الرجال: أين نساؤكم وبناتكم؟ تريدون أن تتوسعوا في المجتمع، ولا يوجد عنصر نسائي؟!
أفهم منكِ أنكِ أعدتِ في تلك الفترة تواصلكِ مع الاتحاد الاشتراكي؟
سأحكي لكِ السبب الذي جعلني أعيد النظر بالاتحاد الاشتراكي. في 2006 ظهرت مشكلة طائفية بين سائقي تكسي مصيافيين وسائقي تكسي علويين من دير صليب. وصل هذا النزاع إلى درجة أن جاء مسلحون من دير صليب، وراحوا يدورون في شوراع مصياف مهددين بأنهم قادرون على فعل أي شيء. فظهرت إثر ذلك حركةٌ احتجاجيةٌ في مصياف، حيث رفع الإسماعيليون ما يسمى برايات إسماعيلية، رغم أنه لم يسبق أن كانت لهم رايات خاصة، ومع ذلك رُفِعت. أحسستُ بالخوف الكبير على شريحة من الشباب الذين كانوا في عمر أولادي. قلتُ لنفسي: لا يوجد شيء يمنعهم من الانجراف الطائفي سوى انضباطهم بحزب. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي هو الأقرب إلى أفكارنا. ناقشتُ الموضوع مع عدد من الناس الذين كانوا من عمري، وجميعهم اعترضوا على إعادة تجربة الاتحاد الاشتراكي. أجبتهم أن ذلك في سبيل الشباب. دعوا الشباب يتواصلون مع شباب حلب ودمشق. كان في ذهني أن يخرجوا من قوقعة مصياف والفرز الطائفي الذي فيها. كانت علاقتي مع شريحة الشباب قوية منذ أيام حرب العراق. كنا نأخذ الباصات سوية من مصياف إلى دمشق، نعتصم هناك ونعود بعدها. وطبعًا الأشخاص الذين يتحملون عناء سفر ثلاث ساعات ذهابًا، وثلاث ساعات إيابًا، يكونون غالبًا عناصر شبابية. كنتُ أذهب معهم، مما جعل علاقتي معهم قوية. وحين رجعتُ إلى الاتحاد الاشتراكي، انضم معي عددٌ لا بأس منهم. هذا يعني أني نجحت نوعًا ما في تجنيبهم دخول اللعبة الطائفية التي بدأت تظهر ملامحها في مصياف. وحسبما رأينا لم يحصل هذا في مصياف فقط، ولكن على مستوى سوريا.
دعينا نعود إلى سؤالي بخصوص إعلان دمشق، وانتخابك كعضوة في الهيئة العامة، ومن ثم انسحابك.
بدأ النقاش حول الإعلان في حماة، حيث شكلنا مجموعة على مستوى المحافظة سميناها «مجموعة إعلان دمشق»، وكان هدفها التحضير للمؤتمر الذي سيُعقد فيما بعد. أنا موجودة ضمن حزب، ولكني باشرتُ نشاطي في إعلان دمشق كمستقلة. يوجد شيء غير مفهوم في الحركة السياسية السورية، أو بالأحرى لا يمكننا فهمه إلا بتوصيف أنه لا توجد أحزاب فعليًا. إذ ينبغي أن يمتلك الحزب قواعد، ويكون على علم بالمناصب التي يتبوأها أعضاؤه. ولكن كل واحد يشتغل على كيفه. رغم أني اشتغلت ضمن مجموعة حماة التحضيرية لإعلان دمشق، إلا أنه لم يتواصل معي أحد من الحزب، ولا أنا تكلمتُ مع أحد. وفي مؤتمر إعلان دمشق رَفعتُ يدي وعرّفت عن نفسي كمستقلة، ولم تعترض قيادة حزبي ولا أحد من الأحزاب الأخرى. وبالتالي، رشحتُ نفسي وفزتُ كمستقلة.
يكمن الخلل برأيي في أن إعلان دمشق هو إعلان توافقي بين الأحزاب، لذلك ينبغي على قيادة الاتحاد الاشتراكي أن تشتغل على أن يدخل أحد قياداتها في الإعلان، لأنه سوف يتخذ قرارات على المستوى الوطني. على الأرجح أنه حصل لعب بالانتخابات، ولكني لم أدرك حينها، لأني كنتُ أشتغل بنية بريئة. يبدو أن النساء ما زلن بعيدات عن خبايا السياسة: إن لم تكن المرأة من طباخيّ السياسة، وهي غالبًا ليست كذلك، فلن تفهم اللعبة. في النهاية لم ينجح الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات، رغم ترشيحات لشخصيات محترمة على مستوى النضال الوطني السوري. عبد المجيد منجونة هو أحد الشخصيات التي يجب أن تكون موجودةً. وهنا بدأت عمليات الترضية، وقيل إن ندى الخش من الاتحاد الاشتراكي، فقلتُ إني عرّفت عن نفسي أثناء الانتخابات كمستقلة. كيف تنظم عملًا سياسيًا توافقيًا، ولا تدرس كيفية دخول شخصيات من جميع الأحزاب؟ في هذه اللحظة جمّد كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي نفسيهما.
هذا الموضوع لا يخصني فقط. أحد قيادات حزب العمل الشيوعي، عبد العزيز الخيّر، كان موجودًا على أساس أنه مستقل. ولكن ربما هو مثلي. أنا قدمت نفسي كمستقلة، ولكني لستُ مستقلة. ضاعت المسافات بين ما يسمى حزبيًا ومستقلًا، ودخلت سوريا ما أسميها بمرحلة المستقلين. أشخاص يرشحون أنفسهم كمستقلين، ولكن إذا بحثتِ في خلفيتهم، فلن تجدي أحدًا مستقلًا. جميعهم لديهم ارتباط عبر نشاط حزبي مباشر أو يُحسَبون على تيار معين. من الناحية الأخلاقية أزعجني عدم نجاح الاتحاد الاشتراكي، ليس لأنه حزبي، ولكن لأني أدركت أن عملًا لم ينظم أموره منذ البداية لن يكون قادرًا أن يقود التغيير.
وحين تم اعتقال اثني عشر شخصية من إعلان دمشق، أعلنتُ أني ما زلت داخل صفوف الإعلان، وظللتُ أحضر اجتماعات الأمانة العامة. بودي الآن أن أحكي شيئًا لم يسبق لي أن قلته بشكل علني: لقد استدعيتُ إلى فرع أمن الدولة بعد اعتقال فداء الحوراني، والذي حقق معي كان رئيس الفرع بنفسه. كان محتدًا بطريقة فظيعة، وواجهني بأحاديث دارت في اجتماعات مغلقة للإعلان. حين استُدعيت للتحقيق، كنت أعرف إلى أين أنا ذاهبة، وحاولت أن ألعب على الموضوع ببرودة أعصاب. ولكن في الوقت نفسه كنت مستغربة من حجم الاختراق.

أما النقطة الثانية، فهي أني عدتُ للاجتماعات مع قيادة الإعلان باعتباري عضوة في الأمانة العامة. كانت قيادة الإعلان تعلم أني أخالف حزبي باجتماعي معهم. كنتُ أعود إلى مصياف في الساعة الثانية عشر ليلًا، أنتِ تعرفين ماذا يعني أن تقف امرأة ليلًا في الكراج؟ إما أن تكون من بنات الهوى، أو أحد الاحتمالات الأخرى. خروجي متأخرًا كان كفيلًا لوحده بكشفي أمنيًا. ومع ذلك لم يقل لي أحد ألّا أرجع إلى مصياف في هذا الوقت المتأخر. كان المحقق يؤكد على أني ما زلت أحضر اجتماعات الإعلان رغم إنكاري.
في النهاية لم يكن هناك قرار باعتقالي لأسباب متعلقة حسب تقديري بمدينة مصياف، وباعتبار أن المرأتين اللتين برزتا في الإعلان هما من حماة (أنا وفداء). وبالتالي اعتقال شخصين سوف يؤلّب الجو العام على شيء فارغ. هي اعتقلوها، ولكن ماذا فعلوا بي؟ أنا مهندسة، وأعمل في مشفى مصياف كمديرة مكتب، في حوالي الثاني والخمسين من عمري، وعلى أبواب التقاعد. ومع ذلك نقلوني من مشفى مصياف إلى مديرية صحة حماة ككاتبة في ديوان مع مراقبة تحركاتي وكتابة تقارير يومية عني. جاء أمر نقلي إلى مدير مدير مشفى مصياف الذي كنتُ على زمالة معه لأكثر من عشر سنوات. ولقد أراني الورقة من بعيد، لوّح بها خائفًا دون أن يسمح لي بقراءة محتواها.
نقلوني بهذا الشكل التعسفي بعد بحث شهر في مشفى مصياف دون أن يتمكنوا أن يمسكوا علي أي موقف طائفي أو محاولة لممارسة السياسة داخل المشفى. كنتُ أتكلم عن الفساد بصوت عال، ولكن هذا سيكون لصالحي إن أرادوا محاكمتي. لذلك لم يتمكنوا من نقلي لأسباب وجيهة، وحصل النقل تعسفيًا. هذا يعني أنهم حرقوا ورقتي اجتماعيًا في مصياف. كان ثمة تجييش طائفي كبير في مصياف في تلك المرحلة، ويكفي أن تكوني حاضرة في اجتماع ويعاقبوكِ بالنقل لينسفوكِ. أنا أحرقوني في حاضنتي الاجتماعية. صار غير الواثق بي، أو الذي لا يحبني لشخصي، يتجنب التواصل معي. واجهتُ عزلة كبيرة في تلك المرحلة. قد يحوّلكِ الاعتقال إلى بطلة، أما أن تمشي الأمور بهذه الطريقة، فهذا يجعلكِ تواجهين المرارة لوحدكِ.
حين انتقلتُ إلى حماة، قررتُ أن أستقيل مباشرة، فأنا أعاني من ديسكات في الظهر، ولا يمكنني السفر كل هذه المسافة. الموضوع يفوق طاقتي الجسدية. ولكنهم لم يوافقوا على الاستقالة إلا بعد مرور سنة كاملة. واشتغلتُ بعدها في مكتب خاص في مصياف.
انسحابك من الإعلان كان في تلك الفترة، أليس كذلك؟
انسحبتُ من الإعلان بعد الثورة. ففي عام 2014 عقدنا مؤتمرًا في اسطنبول حضرته جميع قيادات الإعلان. قالوا حينها إنهم يريدون تنظيم انتخابات لقيادات المهجر، مع أن جميع قيادات الداخل صارت في الخارج. قلت لهم إن هذا لم يحصل قبل الآن في أي حزب في العالم، أو أي حركة سياسية! جميع قيادات الإعلان صارت في الخارج. أنا في الخارج، وكذلك فداء الحوراني وسمير نشار وغيرهم. كيف نحضّر لانتخابات قيادة المهجر إذا كنا جميعنا في الخارج؟ هذا لا يدخل العقل. صار ضروريًا أن نعترف أنه لم يبقَ شيء اسمه قيادات الداخل وقيادات الخارج، ولكن هذه التسميات ما زالت موجودة حتى الآن.
معظم اللواتي اشتغلن في السياسة أيام حكم حافظ الأسد، وحكم ابنه قبل الثورة، اعتبرن أنفسهنّ سياسيات بالدرجة الأولى. وقلمّا طرحت إحداهنّ نفسها كنسوية. ولكن بعد 2011، وعلى وجه الخصوص في العامين الأخيرين، علت أصوات تطالب بإدراج المطالب النسوية ضمن الشغل السياسي. وصار من غير المقنع أن نفصل النسوية عن الحراك العام. ما علاقة السياسة بالنسوية والنسوية بالسياسة برأيك؟ وهل شهد موقفكِ وعملكِ واهتمامك تطورًا من هذه الناحية مع الأيام؟
هذا سؤال مهم. بصراحة، لم تشغلني النسوية كفكرة إلا بعدما شعرتُ بأن السياسة لا يمكن أن تُحدِث تغييرًا في المجتمع. هذه القناعة ليست جديدة لدي، فلطالما اعتبرتُ تواجد النساء في السياسة عنصرًا أساسيًا. غير أن الحالة النسوية لم تكن ناضجة عندي على المستوى الفكري. كنتُ أبحث عنها بتعابير بسيطة، لأنها لم تتواجد في الدوائر التي ترعرعتُ فيها، ولا ضمن الكتب التي قرأتها.
ولكن ثمة حادثة أشعرتني بأهمية التفكير بطريقة مختلفة. أذكر أننا نظّمنا اعتصامين أثناء حرب العراق. غالبية الحضور كانوا من الرجال، بالإضافة إلى عدد محدود من النساء. لم يزعجنا الأمن حينها. في إحدى المرات، اتفقنا أنا وفداء الحوراني على تنظيم اعتصام كبير من النساء والأطفال. وفعلًا نزل معي عدد من نساء وأطفال مصياف. وكذلك فداء، التي تعمل كطبيبة ولها سمعتها الطيبة في حماة، تمكنت من حشد عدد لا بأس به من النساء والأطفال. كان منظرنا مخيفًا حين اجتمعنا في الساحة. الأطفال ليسوا كالكبار، فإذا طلبتِ منهم أن ينشدوا أناشيد ملتزمة، فلن يتوقفوا لمدة ثلاث ساعات متتالية. حين رآنا الأمن، شرع بتفريقنا مباشرة. وقالوا لبعض الأشخاص الذين كانوا معنا إن هذا إنذار نهائي، هذه آخر مرة تعتصم فيها النساء مع الأطفال! ممنوع!
قلتُ إن لم تتواجد النساء في السياسة، فسوف يبقى تأثيرها على السطح الخارجي ولن تدخل في العمق. أنا مصرّة أن السياسة ليست مجرد مجال يبحث في الحكم وتغيير الحكم، بل تطمح إلى تغيير المجتمع بأسره. يجب أن يكون هناك خطط على كل الأصعدة الفكرية والثقافية والاجتماعية. حين تدخل امرأة في السياسة بهذا الزخم، فهي لا تقبل أن تبقى لوحدها، بل ستجرّ معها كل من حولها. لا أدري ما السبب: هل هو في تكوين المرأة؟ أم أنه مرتبط ببيئتنا الشرقية؟ أنا لا أقطن في الغرب كي أتمكن من المقارنة والتأكد ما إذا كان هذا الفرق هو نتيجة ارتباط المرأة بالأسرة والأهل والجيران، ولذلك هي قادرة أكثر من غيرها على نشر فكرها. المرأة لا تترك قناعاتها السياسية حبيسة الغرف الضيقة كما يفعل الرجال الذين يحضرون الاجتماعات كما لو أنهم يمارسون عملًا ما. وإن تكلموا، فهم يكررون المواضيع نفسها. لاحظي أنه حين تجلسين بين مجموعة كبيرة من الناس، يكون أحيانًا من غير المناسب أن يدور الحديث عن حرب. تحاول المرأة عادة إشراك الجميع وحتى الأطفال بالحديث، فيصبح الجو اجتماعيًا. أما الرجال، فهم مستعدون أن يتكلموا ساعات عن تهديد روسيا لأوكرانيا، حتى ولو بقي الآخرون ساكتين.
انتبهتُ في سن مبكرة إلى ضرورة تواجد النساء في السياسة. وبدأتُ فيما بعد أتعامل مع النسويات، ولكن يبدو أن مفهوم التشبيك وتكامل الأدوار لم يكن ناضجًا بعد. حضرتُ على سبيل المثال الاجتماع الأول لهيئة التنسيق، ورأيتُ هناك مية الرحبي وخولة دنيا وأخريات لا أذكر أسماءهنّ حاليًا. ولكننا لم نحاول التعرف على بعضنا بعضًا أو التشبيك فيما بيننا. تُعتبر مية الرحبي من رائدات الحركة النسوية، وخولة دنيا إحدى النشيطات. في هذه الحالة كان علينا ألا نسلم على بعضنا فقط، بل أن نتحدث ونتناقش ونتداول المواضيع. حين عدتُ بعدها إلى منزلي، شعرتُ بارتياب من اجتماع هيئة التنسيق بالعموم، كما لاحظتُ أني لم أستفد من لقائي مع هؤلاء النساء.
كان ثمة حراك نسوي في دمشق والمدن الكبيرة، ولكني لم أشعر به، ولا عشته، ولا أعتقد أنه كان يلامس المجتمع. ولكن مع قيام الثورة، وخروجي من البلد، ومتابعاتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضوري بعض اجتماعات شبكة المرأة السورية، ازدادت قناعتي أنه من المفروض بالنساء أن يكنّ في مقدمة الحراك، ويتخلينَ عن الشللية الموجودة حاليًا. لأنه إذا استمرت الشللية، فسوف تنتقل أمراض السياسة إلى النسوية، فيزداد التشرذم والتشظي. أقولها لكِ يا رحاب، أول مرة أتعامل مع امرأة نسوية مهتمة ومقتنعة بشيء اسمه تكامل الأدوار هو أنتِ. أتمنى أن تكتبي ذلك، لأني أقصد ما أقول.
حاليًا أفكر بالاطلاع على نصوص متخصصة بالنسوية، فقراءاتي كانت حتى الآن في السياسة والقضايا العامة. كان من الممكن أن تشغلني القضية الكردية أكثر من القضية النسوية، أما الآن فأنا أشعر أنها بذات الأهمية، بل إن التشبيك مع النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار سوف يساعد على بلوغ حالة تغيير لن يقدر عليها الرجال أبدًا. تطورت الحالة النسوية لدي إذن، ولكني لستُ موجودة ضمن حركة أحسب نفسي عليها. وبرأيي، ما زال النشاط النسوي عبارة عن انشغالات لها طابع فردي. كما أن الشللية التي لمستها لا تختلف كثيرًا عن عالم السياسة، وأنا لستُ مستعدة أن أعيش تشظيًا في الحالة النسوية كالذي عشته في السياسة. لذلك أمشي كالسلحفاة. ولكني صرتُ مقتنعة بالحركة النسوية، وأنه يجب أن ينشغل عليها على أكثر من صعيد، كي تدخل إلى عمق مجتمعاتنا العربية المختلفة عن باقي المجتمعات.
نحن الآن في حالة انكسار وخذلان وعودة للمدّ الديني الذي يروّج لفقهٍ ليس لصالح حركة النساء. ولكن في الوقت نفسه جعلت الثورةُ النساءَ يشعرن بأنهنّ فاعلات. صارت المرأة تقول إنها تريد إدارة البيت، وتدبير الأمور. لم يعد بإمكانها أن تيقى حبيسة البيت. ولكن كيف تصلين إلى تلك المرأة؟ إن لم تنزلي معها إلى العمق، وتتقني مفاهيمها، وتكوني مقتنعة بإنسانيتها، وتحترمي قناعاتها، وتقدري على إيصال الأفكار بأسلوب غير معقد، فسوف تظن أنه من الأفضل لها أن تبقى على ما هي عليه، فتستمع إلى داعية إسلامي، لأن ذلك أريح لبالها. توجد أمامنا تحديات كبيرة، وما يشغلني هو كيف ستلامس النسوية هذا الانكسار والخذلان الذي يعيشه المجتمع، والمرأة تحديدًا.
شاركت السوريات في الثورة على الديكتاتورية، غير أن شيئًا لم يتحقق من طموحهن إلى نظام ديمقراطي يضمن لهن حقوقهن الأساسية كمواطنات. وقد لاحظتُ في الآونة الآخيرة أن خطاب بعض النسويات، وحتى بعض المنظمات النسوية، بات ليس رافضًا للعمل على تغيير قوانين الأحوال الشخصية عبر ما يسمى بـ«مجلس الشعب». هل بإمكاننا اعتبار النظام الذي يصنع العنف في المجتمع السوري طرفًا جديًا في التفاوض حول هذه الأمور؟ وإن كان جوابك نفيًا، فما هي البدائل إذن للنساء العالقات في بؤس الداخل؟ وأليس أي تغيير، مهما كان صغيرًا ومؤقتًا، أفضل من لا شيء؟
لدي موقف جذري في القطيعة مع النظام. هذا النظام غير قابل للحياة، وأي نشاط تحت مظلته هو محاولة لضخه بالأوكسجين لأطول فترة ممكنة. أنا ضد أي نضال عن طريقه، لأنه مسؤول عن تقهقر حالة النساء في المجتمع، منذ أن اتخذ لنفسه واجهة علمانية، وسمح في العمق للحركات الدينية المتخلفة أن تشتغل وتسود. على سبيل المثال، كانت حركة القبيسيات قادرة في يوم من الأيام أن تجمع قرابة ثلاثين ألف امرأة في مدينة مثل حماة. يتحمل النظام اجتماعاتهن في المركز الثقافي، ولكنه لا يتحمل اعتصامنا الذي وُجد فيه ما لا يزيد عن مئة شخص، ما بين امرأة وطفل.
إن لم نرَ هذه الأمور، سوف نظل نفكر أن شعرة من طيز الخنزير مكسب، ويكفينا أن نحقق بعض التغييرات في بعض القوانين. ولكن القانون معطل أصلًا، فمهما تغيرت القوانين، سوف يبقى المجتمع متروك لأقداره، وللناس أن تحل مشاكلها بالطريقة التي تجدها مناسبة، وهذا يفسر ازدياد الجريمة وتنوعها.
لقد انكشفت لي بعض قوانين الزواج السوري وأنا في الأردن. يتم الزواج عرفيًا في كثير من الأحيان، ولا يسجّل إلا بعد مرور فترة طويلة. والمشكلة التي يواجهوها السوريون الآن هي كيفية إثبات أن هؤلاء الأطفال هم أطفالهم، وليسوا أولاد العمة أو الخال أو الجد. خربطات فظيعة ليس سببها الثورة فحسب، بل كشفَ التهجيرُ كثيرًا من الحالات الموجودة سلفًا. كذلك لدينا زواج القاصرات اللواتي لا يتجاوزن الأربعة عشر عامًا. ما يحصل الآن في المخيمات، كان يحصل في أجزاء كبيرة من سوريا، كأرياف حلب وحماة. يعتبر الناس أن الفتاة دخلت العنوسة حين تتجاوز سن الخامسة عشرة.
في رأيي، ينبغي أن ينصبّ الشغل الحالي على توعية النساء بحقوقهن، وتنمية إرادة النضال لديهنّ، وتهيئة مسودات لمواد الأحوال الشخصية، كي لا نحتاجها لاحقًا فلا نجدها. هذا الأمر لا يعود للجنة الدستورية، وإنما للمنظمات النسوية والنسويات. لا شك أن هناك منظمات اشتغلت على هذه المواضيع، ولكننا نحتاج أن يتوسع هذا الشغل ويتعمم على عدد أكبر.
تكلمتُ منذ قليل حول تكامل الأدوار. أنا، مثلًا، مهتمة طيلة عمري بالسياسة، ولكني بعيدة عن هذه الأمور. لا مانع إذن أن أطّلع على شغل هؤلاء النساء، وأضيف لهنّ خبرتي كسياسية. أنا أمدّ يدي لهن، وهن يمددن أياديهن لي. لا أتكلم على المستوى الشخصي، وإنما على مستوى الفكرة. ينبغي أن تكون هناك علاقة تشابك بين النسوية والسياسة.
قلتِ لي مرة إنك فضّلت الإقامة في الأردن على أن تغادري إلى أوروبا رغم توفر الفرصة في إحدى المرات، وذلك لأنكِ أردتِ أن تبقي قريبة من سوريا. كيف ترين إلى دور الشتات السوري بالتغيير؟ وهل صحيح ما يقوله البعض حول إن التغيير لن يأتي سوى من داخل سوريا؟ أم أن سوريي الداخل مشلولون تمامًا، فيقع الاعتماد الأكبر حاليًا على عاتق السوريين والسوريات الذين يتمتعون بهامش من الحرية وتتوفر لهم بعض فرص التعلم والعمل خارج سوريا؟ وكيف يمكن تكثيف التشبيك والتعاون فيما بينهم؟
سافرتُ في 2013 إلى السويد لمدة خمسة عشر يومًا. أذكر أن قسمًا من المدعوات بقين حينها هناك أو انتقلن إلى بلد أوروبي آخر. وحين سافرتُ لاحقًا إلى ألمانيا، عُرِض علي أن أبقى ولا أرجع.
الفكرة التي كنتُ ولا زلت مقتنعة بها هي أنه من المفروض على الرموز المحسوبة على المعارضة أن تبقى في البلد أو قريبة منه. لا أعتبر نفسي من قيادات المعارضة، ولكني محسوبة عليها. ذكرتُ آنفًا أن تلفزيون أورينت اتصل بي في ما أصبح لاحقًا اليوم الأول من الثورة، فأعلنتُ بشكل واضح أن الثورة قادمة لا محالة في حال بقي النظام يتعاطى مع الأمور بهذا الشكل. حين أقول هذا، لا يمكنني في رأيي أن أنتقل إلى أوروبا في 2013، وأترك ملايين السوريين في سوريا أو دول الجوار. أحسستُ أن الأمر لن يكون صحيحًا. كيف لشخص يشتغل في السياسة، ويقارع النظام، أن يحاول في أول فرصة تأمين نفسه في الخارج في الوقت الذي من المفترض أن تكون القيادات موجودة، إن لم يكن في الداخل، فعلى الأقل في دولة مجاورة، كي تكون قريبة في حال حصل أي تغيير.
أحد مآخذي على المعارضة السورية هو أنها كانت أول من خرج. إذا استعرضتِ الآن الأسماء في المجلس الوطني أو الائتلاف، سوف تجدين أن كثيرين خرجوا مع عائلاتهم في 2012 أو 2013، أي في مرحلة مبكرة جدًا. ولم يخرجوا إلى مكان قريب، بل إلى أوروبا. لا بد أن الناس استنتجوا حينها أن لا أمل من الثورة، وإلا لما خرجت المعارضة لتؤمّن على نفسها.
هذا لا يعني أن السوريين في الخارج ليس لهم دور في السياسة. حين تكون أحد أولئك الذين خرجوا منذ زمن طويل من البلد، وتدخل في قيادة المعارضة، فلن أسألك أبدًا ما دخلك بالسياسة؟ هؤلاء خرجوا من زمان، وهم مظلومون من حينها. أما المعارضات التي كانت أصلًا في الداخل، ومرّت بمرحلة صار الناس يعتبرون فيها أن ثمة مناطق محررة، فإذا لم يكن لديها خطة، فعلى الأقل تبقى على الحدود السورية ونعيش الظروف كما يمر بها الناس. كموقف أخلاقي وضميري: أنا لا يمكنني فعل شيء، لذلك أفضّل أن أبقى في الأردن. حتى الآن قراري مستمر، وأرفض تجديد جواز سفري. ليس لدي القدرة أن أدفع دولارًا واحدًا للنظام الذي يقتل السوريين. أنا مقيمة في الأردن، ولا أريد السفر إلى أي مكان، رغم أن أولادي في الخارج ويتمنون أن أزورهم هناك.
هل صحيح ما يقال عن أن التغيير لا يأتي إلا من الداخل؟
برأيي الموضوع أعقد من هذا الطرح. الداخل الآن منهك إلى درجة صار من الصعب فيها أن يشتغل أحدٌ في السياسة. كل الهموم منصبة حاليًا على تأمين الغاز، ومتطلبات الحياة. الذل الذي يعيشه سوريو الداخل يفوق تصور الطبيعة. وبالتالي، تقع مهمة مقارعة هذا النظام وإيجاد البدائل له على عاتق الذين خرجوا. كما ينبغي دعم الداخل كي يتوقف مسلسل التهجير، لأنه في حال بقي التهجير على هذا المنوال، سوف نصل إلى نقطة نتساءل فيها عن جدوى التغيير. الناس خرجت، فلِمَ التغيير إذن؟ الوطن هو الناس أيضًا، وليس مجرد مساحة جغرافية. التهجير يضرب قلبي، رغم أنه لا يمكننا أن نطلب من الناس ألا يخرجوا. الوضع الذي يعيشونه كالجحيم، لا أتوقع أن جهنم التي يتكلمون عنها ستكون أقسى من حياتهم.
التغيير في سوريا مهمة الجميع، الداخل والخارج معًا. ومهمة الذين صاروا في الخارج مضاعفة، لأنهم يتمتعون على الأقل بأدنى مقومات الحياة.
شهدت سوريا في الآونة الأخيرة عدة حالات قتل نساء متلاحقة. هذه الأحداث تجعلنا أحيًانًا نشعر بالعجز، فنسائل جدوى ما نقوم به من شغل على الإنتاج المعرفي. أذكر أن السؤال الذي راودني حينها هو: إن لم يكن العقل العادي والحس السليم كافيين لردع حالات قتل وحرق وضرب النساء حتى الموت، فهل تؤثر أي ثقافة أو نظرية نسوية على الواقع الرديء؟ ما رأيك؟
من المعروف أن الجرائم تزيد في زمن الكوارث والحروب، وهذا لا يحصل في سوريا فقط. دعينا لا ننسى حجم الانتهاكات التي لحقت بالنساء أثناء الحربين العالميتين. كثيرات قتِلن، أو تحوّلن إلى الدعارة حتى يعشن ويطعمن أطفالهنّ. حضرتُ منذ فترة فيلمًا يروي قصة النساء الألمانيات، وقد شعرتُ حينها أنه بالكاد توجد امرأة لم تُنتهك كرامتها من قبل جميع الأطراف في سبيل لقمة العيش.
ما يحصل الآن في سوريا كان موجودًا قبل الحرب بشكل أو بآخر. كان النظام ممسكًا بالبلد أمنيًا مع تغييب القانون. جرائم قتل النساء موجودة قبل الحرب، انظري على سبيل المثال إلى محافظة السويداء التي تُقتل فيها النساء اللواتي يتزوجن من خارج الطائفة الدرزية. لا تمر سنة من دون أن نسمع عن حادثة قتل بطريقة شنيعة. تُضرب النساء بالحجر على الرأس حتى الموت، أو يتم ذبحهنّ. هذه هي السويداء التي تعتبر منطقة منفتحة نسبيًا، ولكن التعامل صارم مع حالات الزواج من خارج الطائفة. أما أثناء الحرب، فقد صرنا أمام مجتمع لم يتبق فيه أي قانون يضبطه، ولا حتى القيم الاجتماعية بحدودها الدنيا. فحتمًا سوف تزيد الجريمة!
التنوير لا بد منه، من المستحيل أن تحصل أي عملية تغيير بدون فكر وثقافة. ولكن حين نرى الناس تعيش في هذه الظروف، ندرك أن الكلام في الثقافة صعب. ليس الآن يا رحاب، ولكن فيما بعد. لماذا نحن مصرّون على تغيير هذا النظام إذن؟ لأننا نحتاج إلى دولة وطنية تمتلك إعلامًا وبرامج موجهة إلى تعليم الناس حقوقهم وواجباتهم. ينبغي أن تدخل عملية المساواة والجندرة في المناهج الدراسية بشكل فعلي. من دون دولة وطنية لديها مشروع لرفع الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، سوف يقتصر الشغل على مجموعات صغيرة، أو فكرة معينة. ولكن هل سندخل في عمق المجتمع؟ من خلال تجربتي الشخصية واطلاعي على تجارب الشعوب، يمكنني أن أجزم أن هذا مستحيل.
أقصى ما نفعله الآن هو التشبيك مع مجموعات من النساء، ومساعدتهن بتأمين موارد عمل، كي تخفّ الضغوطات عليهن، ويتنورن. ولكن ليس بمقدورنا أن نغير أو نمنع الجرائم من دون دولة وطنية. لذلك يجب أن تنصب جهود جميع المنظمات والهيئات، ومن بينها النسوية، على تغيير هذا النظام.
هل يمكننا القول إنكِ اليوم بعيدة عن العمل السياسي المباشر؟ ما السبب يا ترى؟ وكيف تحاولين القيام بدورك رغم كل الصعوبات؟
أنا ما زلتُ أرصد ما يحصل في سوريا والعالم. ما زلت مقتنعة أنه طالما ابن آدم على قيد الحياة، ينبغي أن يواصل التفكير بكيفية الدفع بالتغيير نحو الأفضل. بالنسبة لي النظام العالمي بأسره يحتاج إلى تغيير، لأنه لو لم تكن القوى المتوحشة متغلبة عليه، لما سمح بهذا الطغيان والخذلان الذي تعيشه الشعوب العربية والكردية والأفغانية، خذي أوكرانيا على سبيل المثال، لماذا يصرون إلى الآن أن يعتدوا عليها؟ هؤلاء الكبار المتوحشون يختلفون فيما بينهم على ثروات معينة، ويحاولون كسر إرادات بعضهم بعضًا، ولكن الشعوب هي التي تدفع الثمن.
أنا ما زلتُ أرصد، ولستُ بعيدة إلّا بمعنى التواجد في الأجسام السياسية، كالائتلاف أو هيئة التنسيق. أنا خارج جميع الهيئات السياسية، ولكني لستُ بعيدة عن حوارات كثيرة ما زالت تبحث كيف يكون البديل في سوريا. حين يكون هذا البديل ناضجًا وبعيدًا عن المهاترات والتبعية لأجندات غير وطنية، فسوف أتواجد فيه كما تواجدت في مرحلة سابقة. صحيح أننا لم ننجح حينها، ولكن يبدو أنه لا بد من المحاولة دائمًا. لذلك يمكنكِ أن تعتبرينني بعيدة وموجودة في الوقت ذاته.
اسمحي لي أن أنهي حواري بسؤال شخصي بعض الشيء. في الحقيقة أكثر شيء لفتني حين كنتُ أتتبع عن بُعد منشوراتكِ وتعليقاتكِ على وسائل التواصل الاجتماعي هو ذلك الحب الكبير لزوجكِ وأبنائكِ وأحفادكِ. تكتبين دون كلل أو ملل عن الحب والطقوس المنزلية الدافئة. أحببتُ كتابتكِ وصور شبابك الجميلة مع زوجكِ تيسير الذي توفي العام الماضي. ولكني كنسوية أدرك في أعماقي أن هناء الحياة الأسرية أقرب للاستثناء، وليس قاعدة، وسط التمييز المجتمعي الذي يطال المرأة على كافة الأصعدة. هل كانت حياتك الأسرية مختلفة؟ هل كان تيسير يختلف عن معظم الرجال؟ وماذا كان يفعل كي يحافظ على الحب؟
أنتِ تخوضين بالمواضيع الحساسة يا رحاب! لطالما عبّرتُ عن كوني من النساء المحظوظات جدًا. عشتُ مع أب ديمقراطي، ولا يفرّق بين أولاده الصبيان والبنات. نحن ثلاث بنات ولدينا أخ واحد يصغرنا. حين ولِد أخونا، لم يختلف تعامل والدي معه عنا، بل كان ينحاز لنا أكثر، إلى درجة أني كنتُ أنتصر لأخي الصغير بين الحين والآخر. تربى أخي في هذا الجو، لذلك لم نعاني من استبدادية الذكر في البيت، بل أشعر أحيانًا أننا تمادينا عليه أثناء طفولتنا أكثر من العكس.
كنتُ في صف البكالوريا، حين أحببتُ تيسير. أمي هي أول شخص أخبرتها بعلاقتي معه، وكان رأيها أني ما زلتُ صغيرة. أذكر أنها سألتني: «أنتِ كم شاب تعرفين؟ أنتِ لا تعرفين سوى أربعة أو خمسة شباب واخترتِ تيسير من بينهم. حين تذهبين إلى الجامعة، سوف تتعرفين على مئة شاب، وتكون فرصة الاختيار أوسع». في الحقيقة فاجئتني بطرحها، فقلتُ لها: «إذا شعرتُ أنه غير مناسب، فسوف أغيّره». تصادمنا، أنا وهي، حول الموضوع. كانت تسألني دائمًا: «ماذا أعجبكِ به؟ أنتِ أحسن منه!»، لأني كنتُ حينها متفوقة بالمدرسة، بينما هو كسول وميّال للولدنة والشبابية، ولكنه مهتم بالسياسة وينتمي إلى الحركة التي كنتُ أنتمي إليها. كنتُ أجيبها: «يعجبني عقله!». في النهاية لم تكن أمي سعيدة، ولكنها تركتني، وكذلك والدي لم يكن سعيدًا، ولكنه تركني، على أمل أن ينتهي الأمر من تلقاء نفسه.

بدأت علاقتي مع تيسير في فترة كنتُ أقرأ فيها كتاب الإيديولوجية الانقلابية لنديم بيطار. وبصراحة، عمِل هذا الكتاب انقلابًا عارمًا في شخصيتي، ودفعني إلى حالة من التمرد والثورة على كل شيء. ترافقت علاقة الحب باهتمامي المتزايد بالسياسة. وبينما كنتُ من الأوائل في مرحلة الثانوية، صرتُ في الجامعة أنجح عامًا وأرسب عامًا. درستُ هندسة الكهرباء، وهو فرع يتطلب المتابعة الجدية، ولا يتحمل ذلك التشتت.
حين أفكر بعلاقتي مع تيسير، أشعر كما لو أني أمام أسطورة. ظللنا دائمًا بالدرجة نفسها من اللهفة والحب، رغم مرورنا بأزمات شديدة، وتفكيرنا مرتين بالطلاق. لم تكن علاقتنا خالية من الخلافات، ولكن يبدو أن الشيء الذي كان يحميها هو أننا أدرناها بطريقة صحيحة. كانت تدور بيننا حوارات، وهذه الحورات توصلنا إلى قرارات مشتركة ننفذها نحن الإثنان.
الأمر الذي وجدته في تيسير، ولم أجده في الرجال الآخرين، هي أنه متصالح مع ذاته. على سبيل المثال، في الفترة التي أحببته فيها، كانت أخته تعشق رجلًا فلسطينيًا. لم يتعامل معها بأسلوب العيب والحرام والمسموح والممنوع، بل أعطاها الحرية التي منحها لنفسه معي. وبعدما جاءت ابنتنا الكبيرة تيماء، راح يتعامل معها كما كان يتعامل معي. تيسير ديمقراطي في داخله. لم يسمح لقيم المجتمع أن تضغط عليه.
من ناحية أخرى، قالت لي صديقتي مرة: «أنتِ يا ندى، بقدر ما هي أفكارك ثائرة، إلا أنك تقليدية جدًا في مظهرك. حجم الضوابط التي تضعينها على نفسك، لم أجدها عند شخص آخر». ربما كان هذا أحد الأسباب، ولكن لا يمكنني أن أناقش تيسير بها، لأنه كان قد توفي. كنتُ طيلة حياتي أغامر في السياسة، أذهب وأجيء، وكان تيسير يقلق عليّ أمنيًا، ولكنه لا يقلق من الناحية الاجتماعية على الإطلاق. وهذا الأمر متبادل بيننا، إذ أنه بعد منعه أمنيًا من ممارسة التدريس، صار يشتغل مع أهله في تجارة الأقمشة. وبالتالي، كان معظم تعامله مع النساء. ومع ذلك لم أشعر بالغيرة في حياتي. فالرجل الذي يريد أن يقيم علاقة مع امرأة ثانية وثالثة ورابعة، لن تقدر مئة امرأة على منعه. ساعتها الله معه، ولا داع أن تقعدي ناطورة. هذه النقطة منحتنا هامشًا من الحرية.
كنا ندير خلافاتنا بالحوار، رغم أننا مختلفان تمامًا. الذي يعرفنا عن قرب، يستغرب كيف عشنا سوية. ارتبطنا في 1973، وتوفي في 2021. قضينا هذا العمر في حبٍ مستمر، واختلافٍ كامل بالأمزجة. يقول أولادي أحيانًا إن لدي قدرة عجيبة على التعامل مع المتناقضات. لعل هذه السِمة، بالإضافة إلى تصالحه مع ذاته، ساعداني على تقبله كما هو، دون أن أرسم أحلامًا أخرى. أنجبنا ثلاثة أولاد، وكبروا، وتحولوا إلى أصدقاء. أتعامل معهم بصداقة حقيقية، فأنا لا أملك عقل الوصاية. نختلف في كثير من الأشياء، ولكن تبقى علاقتنا ممتازة. أتعامل مع أولادي مثلما أتعامل معكِ. بأي حق أكون وصية عليكِ؟ وهكذا أتعامل مع أولادي أيضًا.
لا أعرف تمامًا ما سبب دوام الحب بيني وبين تيسير، ولكن يمكنني أن أعزوها إلى كونه ديمقراطيًا ومتصالحًا مع ذاته. وهذا ليس أمرًا بسيطًا في حياتنا الشرقية!