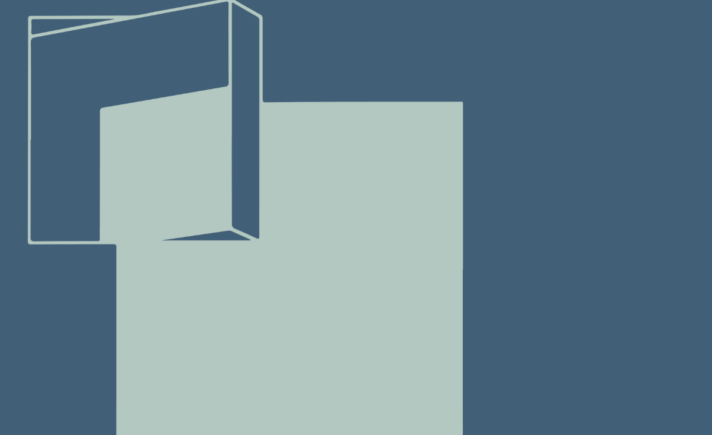تمتلئ آداب مختلف اللغات بقصص وشهادات عن صداقات متينة بين أعلام وشخصيات مُبجّلة، ومُثُلٍ عن الولاء والوفاء اللذين ظهرا في هذه العلاقات، العابرة أحياناً للمواقف السياسية والإيديولوجية، وإن تكن عادةً قائمة على أرضية خُلقية رفيعة مشتركة. ولا شك أن لهذه القصص والمُثُل أهمية كبيرة في الشأن العام للمجتمعات، ودوراً ممتازاً في المناهج التربوية. لكنها ليست الأمثلة الأفضل للتفكير في الصداقة ومعناها، فمع أنها أمثلة عن صداقات حقيقية ورائعة، إلا أنها ليست صداقة «حاف»، إذ إن فيها عناصر من اهتمامات مشتركة، أو رفاقية حزبية، أو زمالة عمل، أو شراكة مادية أو إيديولوجية.. إن أردنا التفكير بما هو العامل الفارق بين الصداقة وأي نوع آخر من العلاقات السامية، وحاولنا عزل «أصنص» الصداقة مخبرياً، إن صحّ التعبير؛ فعلينا التفكير بها من زاوية أخرى، مغايرة لهذا النوع من الصداقات المعقلنة والمفهومة والقابلة للشرح بالكلام: علينا أن نفكر بالصداقة التي لا يُمكن تفسيرها.
بعضنا لديه، أو لا شك يعرف أحداً لديه، أصدقاء لا يعرف بالضبط لماذا هم أصدقاؤه، لكنه يحبهم ويثق بهم «رغم كل شيء». أصدقاء «ما ينطلع بيهم»، لا أساس واضح لهذه الصداقة، المليئة غالباً بمشاحنات ومشاجرات وفترات فراق لا تؤثر في الودّ والحنان المتبادل. لا نتحدث هنا عن أصدقاء متفقين على أرضيات أخلاقية ونفسية معقلنة ولكنهم مختلفون إيديولوجياً أو فكرياً؛ ولا عن علاقات سُمّية فيها نُواسٌ بين الأذية والإدمان. صديقك الذي لا شيء فيه من الأشياء القابلة للتحويل إلى كلام يعجبك، وتصرفاته وكلامه وسلوكه قد يكون مدعاةً للخجل، وغالباً ما لا تضيّع أي دقيقة في تبرير أي من سلوكياته أو محاولة شرحها للآخرين الغاضبين منه غضباً يشيع أن يتوجّه نحوك من باب مساءلتك: لماذا هذا الشخص صديقك؟. قد يحصل أن تتشاجرا، وأن «يضربلك على عصبك»، وأن تفترقا، لكن يبقى رغم ذلك أنك تحب هذا الصديق، وتثق به، ورغم أي خلاف لا ترضى له الضيم، وتحرص على كرامته. كثيراً ما تحرص على كرامته أكثر من حرصه هو نفسه عليها، وعادةً ما يكون هذا الأمر سبباً لشجار متكرر بينكما.
أعتقد أن هذه المشاعر، غير المعقلنة وغير القابلة للتفسير بالكلام، هي الصداقة المحضة، الصداقة «الحاف». غالباً ما تتراكب معها اتفاقات نفسية وفكرية، وربما شراكات وزمالات ورفاقيات، وكل هذه مُهمة وأساسية لحياة الإنسان، لكن كل هذه الشؤون، هذه الشراكات المعقلنة، تعاقديةُ الطابع وقد تكون مؤقتة، وإن بُنيت علاقة بين شخصين عليها فقط فإن هذه العلاقة تنتهي مع نهاية «العقد» هذا.
ليس سهلاً التمييز بين شراكة فكرية متينة متراكبة مع معرفة وودّ شخصيين، وبين صداقة صَدَفَ أن تراكبت مع شراكة، حين تكون هذه الشراكة قائمة. سيحصل التمييز فقط عند انتهاء الشراكة: هل يبقى عامل «الصداقة الحاف» الخفي؟ أم أنه لم يكن موجوداً من الأصل؟
الصداقة علاقة ما قبل تعاقدية. ليست أبدية، وليست خالية تماماً من الشروط والأسس، لكن هذه الشروط غير معقلنة وغير قابلة للتحويل إلى كلام، وربما لهذا السبب هي أمتن من الشروط التي يمكن كتابتها بالورقة والقلم، وأكثر هشاشةً منها في الوقت عينه: قد تنكسر، ولن تستطيع تفسير لماذا انكسرت حتى لنفسك، لكنك ستعلم جيداً أنها انكسرت، وسيعلم الطرف الآخر ذلك أيضاً. وعلى عكس الشروط المعقلنة، يكاد يكون من المستحيل إعادة العمل بالاتفاق حسب شروط الصداقة إن كُسرت.
* * * * *
لا تقصد السطور السابقة بناء تراتبية بين الصداقة والشراكة (الفكرية،الإيديولوجية، المهنية، بالاهتمامات…إلخ). المعتاد أن يتعايش النوعان في العلاقة نفسها، وكلاهما ضروريان، بل إن تعايش النوعين من الاجتماع شرطٌ أساسي للتوازن: حياة مقتصرة على الصداقات دون الشراكات، حتى لو كانت صداقات مرتبطة بشراكات، هي حياة متوجّهة نحو نفسها بشكل «مطمّش»، وفاقدة لتوجّه الموضوع المستقل؛ وحياة ليس فيها إلا شراكات هي وَحدانية روبوتية.
في الشراكات تبقى ذاتك بداخلك. لا يعني هذا أنها لا تتغيّر، أو لا تؤثر أو تتأثر، لكنها تبقى بداخلك، واضحة المعالم وذات حدود بيّنة. الشراكة اصطفافُ ذوات بشكل مرتب، وصانع للمعنى العمومي، وقابل للفهم والحساب: 1+1= 2. وهناك بطبيعة الحال أطياف مختلفة من المرونة لاستيعاب تغيّرات وتحولات، كما أن الشراكات تستوعب مقادير مختلفة من الاختلاف، لكن دائماً وفق معادلات قابلة للفهم: لا أقصد أنها دوماً نفعية، ولا أنها تبادلية تجارية، لكنها قابلة للفهم، وقابلة للشرح أيضاً.
في الصداقة، كما في الحب، لا يساوي واحد زائد واحد اثنان. لا تبقى الذات حبيسة حدودها، فجزء منها يخرج ليتداخل مع ذوات أخرى داخل حدودها هي؛ كما أن الذات لا تبقى وحيدة داخل حدود النفس، إذ تستضيف أجزاءَ من ذوات أخرى. لعلّ هذا ما يفسّر أن الأصدقاء يحتاجون لكلام أقل كي «يفهموا» على بعضهم، خاصةً ما يتعلق بأوضاع نفسية وآلام ومتاعب لا تَسهُل ترجمتها إلى كلمات. قد يفسر هذا أيضاً أن الصداقات أكثر مقاومة لفترات البُعد وانقطاع التواصل من أيّ نوع من آخر من العلاقات الإنسانية.
الرقابة الذاتية في الصداقة أقل بما لا يُقاس منها في الشراكة، مهما كانت شراكة ودودة. ربما لأن هناك ارتياحاً لانخفاض وطأة الرقابة الخارجية ضمن الصداقة، وربما أيضاً للارتياح إلى أن الصداقة، بالتعريف، لا تحتاج إلى عقلنة كل ما يحدث داخلها. مساحات ممارسة الشراكات قد تكون واسعة جداً، لكنها مضلّعة، لها شكل هندسي ثابت، ومتنوعة العتبات والمستويات، ومن الممكن تخيّل أن فيها إشارات مرورية وضوئية، ومسارات اتجاه إجباري أيضاً. مساحات الصداقة أصعب للتخيّل، ولكن أسهل للحركة.. لا عتبات فيها، ومساحتها وشكلها قابلان للتغيّر بفعل الاعتناء بالصداقة. صداقة مرعية ومحروص عليها هي نبع لا ينضب من المساحة، ومن اللوينات، ومن التفهم والاحتواء والتِماس الأعذار.
* * * * *
لم يمنع نظام الأسدين الصداقة وشبكاتها خلال تاريخ حكمه، لكنه خنق الأجواء والمساحات التي يمكن أن يظهر فيها طابع عام ما للصداقة، أو يمكن أن تنشأ فيها شبكات موسّعة تستفيد مما يُبنى على الصداقة من ثقة ودعم وتفهّم وصون كرامة. عدا حلقات ضيقة من النشطاء السياسيين والمثقفين والمعتقلين السابقين (وبدرجة أكبر المعتقلات السابقات) كانت صداقاتنا شخصية، محبوسة في المجال الخاص ما بين القرابة العائلية وزمالة المهنة والدراسة، وربما الجيرة أو الصُدف.
بشبكاتنا الضيقة والشخصية، وبضعف مَعيننا من العامل العام للصداقات، دخلنا لحظة الثورة قبل أكثر من عقد. بعض هذه الشبكات لم تحتمل وطأة اللحظة الثورية وتمزّقت، فيما تمتّن بعضها الآخر. نشأت صداقات ثورية بنت اللحظة، ومنها أيضاً ما بقي ومنها ما «فرط» بعد حين. سنوات طويلة من العنف والفقد والتهجير والشتات، والشدّة النفسية والترقّب وإحساس حافة الهاوية، كان فيها مَعينُنا من الصداقات ضعيفاً ويزداد ضعفاً، فتلك الصداقات التي لم تتمزق بالكاد بقي هناك همة لرعايتها وسقايتها تحت وطأة كل هذه الظروف.
وقد عشنا كل هذه الأوضاع في عين عاصفة ثورة رقمية أدّت إلى كثافة تواصل غير مسبوقة في التاريخ، لكن هذا التواصل، على أهميته وعلى دوره الهائل على الصُعد العامة والخاصة، لم يسد فجوة عوز الصداقات لدينا. بدا أحياناً أنه يفعل ذلك جزئياً، لكنه لم يفعل. «الصداقة الفيسبوكية»، الناشئة في ظرف الثورة والانخراط السياسي، ليست صداقة. ربما هناك صداقات عمر كثيرة قد نشأت بفضل وسائل التواصل، فيسبوك أساساً في حالتنا؛ وربما يمكن قول أن ما سأعرّف به الآن «الصداقة الفيسبوكية» دارج حتى في علاقات حديثة لم تولد أو تعش مجرياتها افتراضياً حكماً. مع ذلك، أعتقد أن تسميتها «الصداقة الفيسبوكية» مفيد للإشارة إلى ضرب من «روح العصر». هذه «الصداقة الفيسبوكية»، كما قلت، ليست صداقة.. هي جذر تربيعي مخفف بالماء لشراكة. هي تواطؤ نفسي ومواقفي حصل في لحظة ما، تجاه موضوع ما -الثورة السورية في حالتنا-. مشكلة هذه التواطؤات أنها قائمة بشكل كامل على جهد أدائي فيسبوكي، وكلّ أداء فيه بالتعريف رقابة شديدة على الذات وترصّد حسّاس لردود أفعال المتلقين وحاجة لنيل رضاهم. أداءٌ سرعان ما يتحول فيه «الكلام الصح» في لحظة ما إلى واجب، وتنكمش فيه مساحات الاختلاف، أو مجرد الحيرة، حتى تكاد تتلاشى، تحت إحساس شديد الوطأة برقابةٍ بعضها متخيل لكن أغلبها حقيقي، وهي ليست رقابة أعداء، بل رقابة «أصدقاء فيسبوك». مراجعة خبراتنا خلال السنوات الماضية تقول أنه يبدو ألّا «طلاق بإحسان» من صداقة فيسبوكية: الانتقال من الاتفاق الأدائي وسط جو رقابي إلى عداوة وتناهش سهلٌ للغاية، وكثيراً ما يحصل في جو تشككي ومراجعات قاسية تشكّل نقضاً لكل المُعاش السابق. لم تحصل تراكمات وخبرات مشتركة تستدعي افتراض حسن النية أو تدعو لسِعة الصدر. لأنها لم تكن يوماً «صداقة».
* * * * *
على عكس ما تصرخه قسوتنا على أنفسنا في آذاننا، ليس فينا كسوريين ما هو بنيوي في تكويننا من عجز عن العمل العام المشترك. أقلّه مقارنةً بوسطنا المحيط من مجتمعات. رغم الظروف القاسية على اجتماعنا العام خلال نصف القرن الماضي، والقيامية خلال العقد الأخير، لم نعدم نشوء علاقات شراكة، ولا أفكار، ولا أخلاق عمل، لكن مع ذلك فشلت محاولات إنشاء تجمعات ومنصات عمل كبيرة وعابرة. أكانت جمعيات شتاتية كبرى، أو أحزاب وتجمعات سياسية. وما نجح في الولادة والرسوخ من مبادرات جماعية بقي صغيراً، على مستوى عدد قليل من الأفراد، «أصدقاء» غالباً فيما بينهم، من نوع المجموعات التي يُقال عنها على سبيل الذمّ أنها «شلل».
ليست مشكلتنا في الأخلاق ولا في المعرفة ولا في الأفكار، أقله -أكرر- مقارنةً بالمجتمعات المحيطة بنا. ولا مشكلتنا في هذا الدّال الفارغ المسمّى «شللية».. بل أن مشكلتنا في أن «شللنا» قليلة، وصغيرة الحجم.
أفكر أحياناً أن الشرط الأولي لأي اجتماع سياسي سوري هو إنشاء «تنظيم سريّ» يجمع أكبر عدد ممكن من السوريات والسوريين على عهد التصرف بين بعضهم وفق مقتضيات «الصداقة الحاف»: ودّ لا محدود، متسامٍ على أي ضرب على العصب؛ وصون كرامة وحرص على القيمة والروح المعنوية، واهتمام واستماع، وتفهّم وصبر، وحنان. «تنظيم سرّي» هو عبارة عن عهد واسع على عناصر من الصداقة.
لكن هذه ليست صداقة تماماً. الصداقة حميمية وفيها الكثير من الذات، ولا يمكن أن تحاول أن تكون صديقاً لأناس لا تعرفهم. ماذا يمكن أن نسمّي هذا الإحساس بالعهد الطوعي بالتعامل مع كثيرين وفق هذه العناصر الحنونة من الصداقة، دون أن تكون هذه العلاقة صداقةً فعلاً؟
لسنا قلّة من سنجيب على السؤال أعلاه أن هذا اسمه الحياة على مذهب حسّان عباس.
* * * * *
قبل عامٍ من اليوم توفي رجل طيب وشهم، ذو خلق نبيل وأفضال لا تُنسى على عدد كبير من السوريات والسوريين من مختلف الأعمار. هذا أكثر التعريفات الممكنة اختصاراً للدكتور حسان عباس. وككل اختصار فإنه يترك الكثير من التفاصيل خارجه، وحسان عباس رجلٌ ذو تفاصيل كثيرة..
حسان عباس كان أنيقاً أناقةً خاصة. سمّيتها حينها أناقة «تحت-جلدية». لم تكن أناقة ملابس أو أداء، بل كانت ملتصقة بشدة بمألفه: نبرة صوته، حركة جسمه، ابتسامته المتواطئة، نظرته المتسائلة بحنان، ضحكته تحت شاربه المميز. هذه الأناقة تحت الجلدية كانت دعوة فورية لمُجالِسه كي يشعر بالأمان والاسترخاء. والحديث مع حسان عباس، أي حديث، سيُدخلك سريعاً في هذا الإحساس الحميم بأنك تسارر أحداً، أو أنك تتواطأ معه على شيء. قد يكون حديثاً عاماً، أو قد يكون مجرد مزاح، كتوبيخه المتكرر لي على موقفي المتوجس من اللحمة بكرز.
كان حسان عباس رجلاً طيباً ومُحباً للناس. هذا صحيح، لكنه كان يتميز بخطوة أبعد، لخّصتها نسرين الزهر في رثائها له العام الماضي بأنه، عكس جلّ مثقفينا، كان متخلياً بالكامل عن هذه الطبقة المغناطيسية المحيطة بذاته. بلطفه، وبطريقة سؤاله الحنون، لم يكن حسان يأخذ منك بعض ذاتك سريعاً فحسب، بل تشعر أنه منحك بعضاً من ذاته أيضاً. ذاتٌ كانت مبنية من انتباهٍ حنون لا ينضب. لم يكن حسان عباس بارعاً فقط في أن يجعلك تحبه، بل كان قادراً على جعلك تحب نفسك حين تراها عبر عينيه.
يخطر لي أن حسان عباس كان واعياً لدوره كعامل تمديد لشبكات «صداقة حاف» بين أجيال مختلفة من السوريات والسوريين، تولد وتنمو حول دوره مع طلابه كأستاذ وأكاديمي وباحث؛ ونشاطات ثقافية واجتماعية اجتهد على الدوام لأن يكون مؤسساً وراعياً لها، كنوادي السينما والرابطة السورية للمواطنة، أو بالشراكة مع مؤسسات ثقافية مثل اتجاهات وغيرها، عدا عن مجالسه الدمشقية أولاً فالبيروتية لاحقاً. دورٌ بقي مثابراً عليه رغم كلّ الظروف القاسية التي أحاطت به وبالبلد وبناسه، ولعبه حتى لحظات حياته الأخيرة.
يوماً ما، سيتوجب أن يُقام معهد موسيقي في دمشق باسم حسان عباس. معهد مفتوح للناس ومجاني، ومتوجه بالذات للّذين واللواتي لم تسنح لهم فرصة مادية لتعلّم الموسيقى وعنها. هذا أقل الواجب تجاه ذكرى رجل أحبّ البلد وأهله حباً غير مشروط ولا محدود. رجل سيبقى صديقاً لهذا البلد ولأهله.
حتى حينه، فليخيّم طيف حسان عباس علينا جميعاً، ولنكن أصدقاء أكثر لأنفسنا ولبعضنا. سيحب أن يرانا حنونين على أنفسنا وبعضنا، وسيبتسم برضى تحت شاربه المميز الجميل.