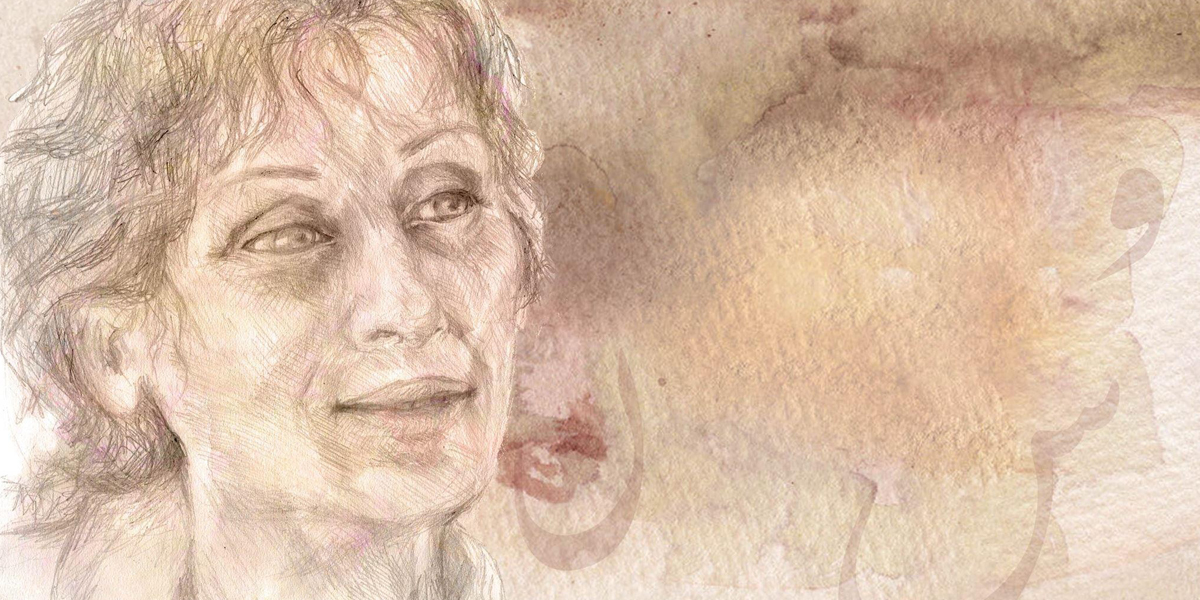يحدث بين حين وآخر أن ينالني اللوم على المثابرة على إثارة قضية زوجتي سميرة الخليل، التي اختطفها وغيبها جيش الإسلام في دوما، قبل أكثر من ثمان سنوات. بعض اللائمين هم من ذوي الهوى الإسلامي الذين يجدون حرجاً في حقيقة أن مُغيِّبي سميرة، مع رزان ووائل وناظم، هم من جماعتهم، مع ما هو معلوم من أن لسميرة ورزان ووائل وناظم تاريخ في معارضة النظام أعرق وأعدل من تاريخ مغيبيهم من الإسلاميين. وفي هذا ما يدفع إلى ترجيح أن هذا الطرح كيدي، وأنه لو كان الأربعة مغيّبين عند النظام لما سُمعت هذه الأصوات.
على أن هناك من يبدون مقتنعين بوجوب أن أنشغل بقضية مغيبي وشهداء الثورة السورية عموماً، وليس بما يحدث أن يسميها بعضهم قضيتي الشخصية. وقد تصاغ حجتهم كالتالي: هناك مليون شهيد، أليس هناك غير زوجتك؟ قبل كل شيء، زوجتي ليست شهيدة رسمياً، فهي مع شريكتها وشريكيهما أحياء إلى أن تصير أجسادهم المقتولة بين أيدينا. فلو كانت سميرة شهيدة، وهو احتمال لم أعد قادراً على إنكاره بعد طول كبت، لعملنا، نحن أحبابها وأصدقاؤها، على أن نودعها الوداع اللائق، ونقيم الحداد الذي يتيح لنا استعادة قدر من السلام في نفوسنا. وإذا لم تكن سميرة شهيدة، فإن بناء قضية عامة حول تغييبها طوال هذه السنوات، دون معرفتي ومعرفة أحبابها شيئاً عن مصيرها، هو أقل ما يحق لها علينا وما تتوقعه منا في غيابها الطويل. سميرة مجهولة المصير، ومجهولية المصير هي دعوة مستمرة إلى الكلام.
هي كذلك جوهر التغييب القسري. التغييب ليس حرماناً من الحياة فقط، وإنما هو حرمان من الموت أيضاً. ليس حرماناً من الحب فقط، وإنما هو حرمان من الحِداد كذلك.
ثم إن تغييب سميرة ليس محض قضية شخصية. فهي شخصية عامة قبل الثورة، وقد غُِيبت في سياق عام معلوم هو الثورة السورية، ومُغيِّبوها طرف عام، صعد على كتف الثورة العامة قبل أن يغدر بها ويعمل على تسخيرها لمصالح فئوية بالغة الضيق لا تختلف في شيء عن تسخير النظام للدولة والموارد السورية العامة. وهذا دون قول شيء عن رمزية عامة لسميرة، تناولتُها غير مرة في سنوات ماضية. دون قول شيء كذلك على أن الشخصي والعام يتمازجان بشدة في أوقات الاضطراب العام الذي يعصف بمصائر الملايين، مهما حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عنه.
وليس واضحاً بعد ذلك ما يريده المُؤاخِذون لي على اهتمامي بقضية امرأتي: أن أهتم بجميع ضحايا الثورة مثل اهتمامي بقضيتها، أم أن أذيب قضية سميرة في كلام عمومي عن «مليون من الشهداء».
فإن كانت الأولى، فإن الأمر يتجاوز قدرة أي شخص أو حتى منظمة كبيرة. أما إن كانت الثانية فإن سياسةً تُذيب قضية سميرة أو أي مغيبين ومعتقلين وشهداء آخرين في مقولة عامة عن ضحايا الثورة هي سياسة خاطئة جذرياً. من الذي يستفيد من تحويل خسائرنا ومآسي حياتنا إلى أرقام أو معلومات مُجمَلة، ربما تذكر لنُحرِّضَ على عدونا، على افتراض أنه ليس لنا غير عدو واحد؟ لا أحد غير هذا العدو الذي يستطيع أن يواجه الأرقام المجردة والمعلومات المجملة بالتكذيب أو بمعلومات مضادة. النظام الأسدي هو من لا يريد أن تروى بتفاصيلها قصصُ جرائمه، وشركاؤه في الإجرام من الإسلاميين هم من لا يريدون أن تروى سِيَرُ جرائمهم. أما نحن، فالواجب أن نعمل على حراسة الذاكرة العامة من النسيان والتزوير والتهويل، إن لم يكن بأمل أن يؤون أوان الحساب يوماً، فمن أجل الاعتبار وأخذ الدروس.
السياسة الصحيحة هي بالعكس مما يدعو المُجمِلون: أن نُفرِّد ضحايانا ونشخِّصهم، نروي قصة كل منهم بالاسم والصور وبأكبر قدر من التفاصيل. هذه القصص المفصلة ليست بدورها ممتنعة على الإنكار من طرف الراغبين في الإنكار أو أصحاب المصلحة، لكن إنكارها أصعب قليلاً لما تحتويه من أسماء وصور وتفاصيل حية. هذا فوق أن القصص المفصلة تصلح أرضية لإعطاء قضيتنا وجهاً وملامح وكياناً إنسانياً.
سيكون أمراً طيباً أن توجد جهات عامة تقوم بجانب من هذا العمل، لكن هذا الواجب يقع أولاً على أحباب المغيبين والمعتقلين والشهداء وأهاليهم. فهم الأعرف من غيرهم بِسيَر أحبابهم، وهم المعنيون بقوة ببقاء ذكرى أحبابهم حية، وهم المعنيون كذلك بأن تكون رواية السير مفتوحة على تطلّع إلى العدالة مأمولٍ يوماً. وعلى هذه الجهود العائلية يمكن أن تُبنى يوماً رواية عامة مفصلة، وربما متحف جامعٌ لتفاصيل الضحايا ولما بقي منهم.
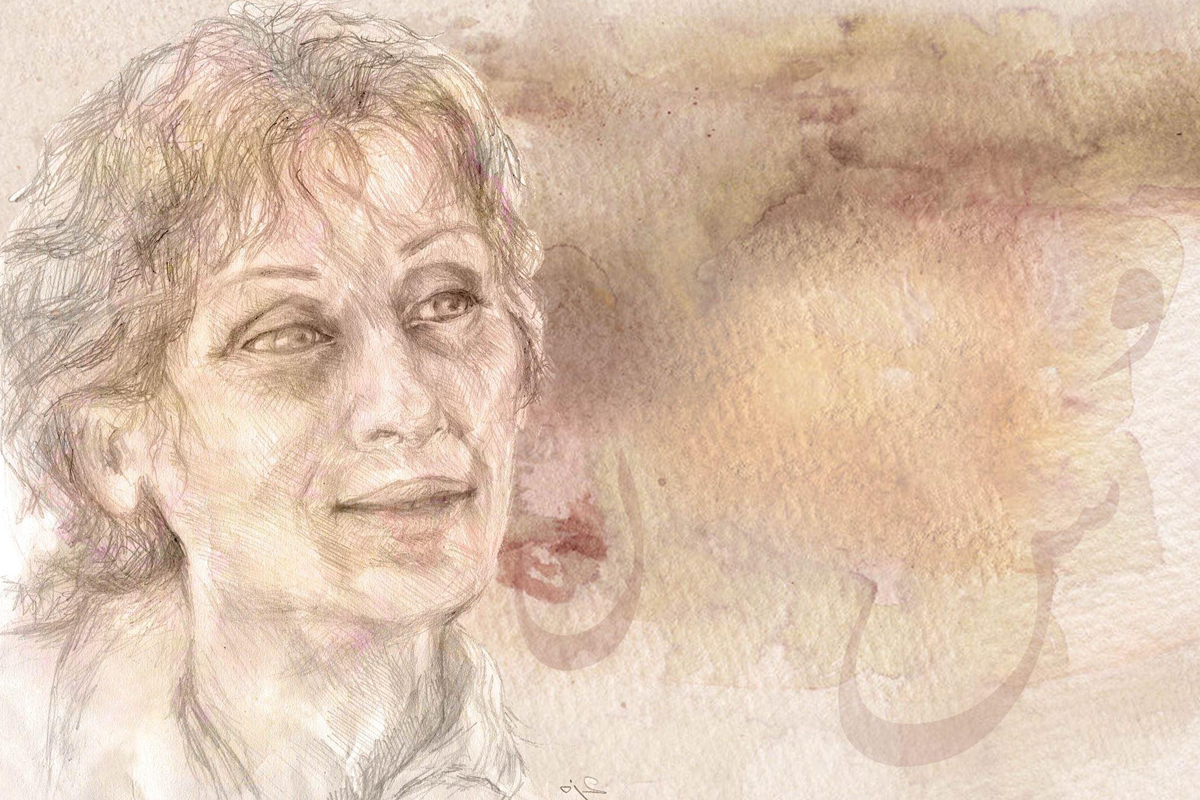
إلى ذلك، فإن إجمال قضيتنا نفسه يتغير وفقاً لما إذا كان إجمالاً مبنياً على وفرة من الأسماء والمعلومات الموثوقة والتفاصيل، أو كان إجمالاً مرسلاً مجرداً، من نوع ما يتواتر قوله دون سند إلا التقديرات الذاتية عن مليون شهيد للثورة السورية أو مليون ونصف المليون. من شأن مسعى منظم، يجمع بين جهود العائلات وجهود جهات عامة في التوثيق والتحقق، أن يعطي فكرة أقرب إلى الصواب عن عدد الضحايا، فلا ننساق وراء المبالغات الكبيرة التي يدفع التشكك المشروع بها إلى إهمال رواية الضحايا كلياً. 350 ألفاً من الضحايا الموثقين بالأسماء، على ما قالت منسقة الأمم المتحدة قبل حين (ورجَّحت أن يكون العدد الحقيقي أكبر)، أكبر من الأرقام الكبيرة، المليونية، التي لا يحب غيرَها محبو الإجمال.
لا أعتني بقصة امرأتي المغيبة بفعل برهنة مسبقة قمت بها وفق الخطوط المذكورة للتو. أفترض أن الأمر لا يحتاج إلى برهنة أو تبرير. سميرة امرأتي، شريكة في الحياة والنضال لنحو 13 عاماً، وهذا يكفي كي لا أكفّ عن تناول قضيتها. وفا علي مصطفى ليست محتاجة لتبرير مثابرتها طوال ثماني سنوات ونصف على رفع صورة أبيها المغيب عند النظام والتذكير به (وبغيره)، ولا كذلك أيّ من بنات أو أخوات أو زوجات المغيبين الآخرين. ما يحتاج إلى تبرير هو بالأحرى مطالبتنا بتبرير اهتمامنا بسيَر أحبابنا المظلومين ورواية قصتهم.
وفضلاً عمّا سبق، فإن الشغل على قصة سميرة هو استمرار لعملنا معاً من أجل حياة سياسية تقوم على المواطنة، أي على أن كل فرد منا هو صاحب قصة ومصير متفرّد، وأن كلاً منا مركزُ مبادرة وفاعلٌ أخلاقيٌ مسؤول، أن لنا حقوقاً بهذه الصفة، وأننا لا ننحل في أي هويات جمعية موروثة. لا يستطيع الواحد منا أن يناضل من أجل الديمقراطية، بينما هو ينزع الشخصية عن ضحايا هذا النضال ويردهم إلى أرقام مجملة أو بنود في خانات عامة. ما كنا نقاومه قبل أن يطرأ أمثال زهران علوش وسمير كعكة وعمر الديراني وأبو محمد الجولاني وبقية شلّة الشرعيين- الأمنيين الدموية، هو بالضبط اعتبارنا أرقاماً أو بنوداً، مما هو مميز للأنظمة الشمولية المعاصرة.
وللحكم الأسدي الذي يحتكر الشخصية والصورة والسيرة فيه حافظ ثم وريثه، ولا يتقابل معه غير ملايين الناس الذين بلا وجوه ولا ملامح ولا أسماء، يصفقون ويرقصون ويبكون بأوامر، ويخرجون في «مليونيات» تدعم من لا يعترف لهم بكيان.
الواحد منا مستحقٌ للّوم إن لم يستطع أن يجد أساليب متجددة للاستمرار في بناء القضية، وتسليمها لجيل أصغر لا يعرف بما جرى أو لديه انطباعات مشوشة عنه، وبالتالي مقاومة النسيان. ما نلوم أنفسنا عليه، نحن أسر المغيبات والمغيبين بالخصوص، هو أن جهودنا لم تثمر إلى اليوم. وتعرف أننا لا نستطيع الأمل بأي ثمرات إن لم نواظب على الكلام على الأحباب الغائبين. لا نفقد فرصاً فقط لمساعدة أحبابنا بالانقطاع عن رواية قصصهم، وإنما نفقد معنانا كذلك.
تقارن سميرة في أوراقها التي صارت كتاباً بعد غيابها بين تجربتَي السجن والحصار، وترى أن الحصار أقسى لأنه يشمل الجميع، ولأن الموت ملازم له. كانت خبرت السجن السياسي لأكثر من أربع سنوات، وفي دوما نفسها، على يد نظام حافظ الأسد. عبر ذلك أنتجت سميرة معنى عاماً لتجربة الحصار، يمكن أن يشارك فيه من خبروا هذه التجربة كما من لم يَخْبَروها مباشرة. أما أنا، زوج سميرة، فأقارن بين السجن وغيابها، وأجد غياب شريكتي أقسى وأعمق حفراً في النفس. في سنوات السجن كانت الأوضاع قاسية على تفاوت، لكنه كان من توقعاتنا، سميرة وأنا والألوف من أشباهنا، وكنا مهيئين سلفاً لإدراجه في قصص حياتنا. على قسوته، كان السجن تجربة مُكوِّنة ومانحة للمعنى. غياب سميرة تجربة مُكوِّنة بصورة مغايرة، والعمل من أجل قضية سميرة، رواية القصة على الأقل، هو صراع من أجل المعنى، معنى حياتنا وألمنا وموتنا، فوق أنه جزء من القصة السورية العامة التي لا وجه عادلاً لوضعها في تقابل ضدي مع قصصنا الشخصية. من يفعلون ذلك منا يختزلون أنفسهم إلى هويات معطاة سلفاً، دينية أو قومية أو غيرها، ولا تؤول سياستهم بحال إلى غير صراع هويات، تأكيد هويات ضد هويات ونفي هويات لهويات.
لكن لهؤلاء قضيتهم ولنا قضيتنا.