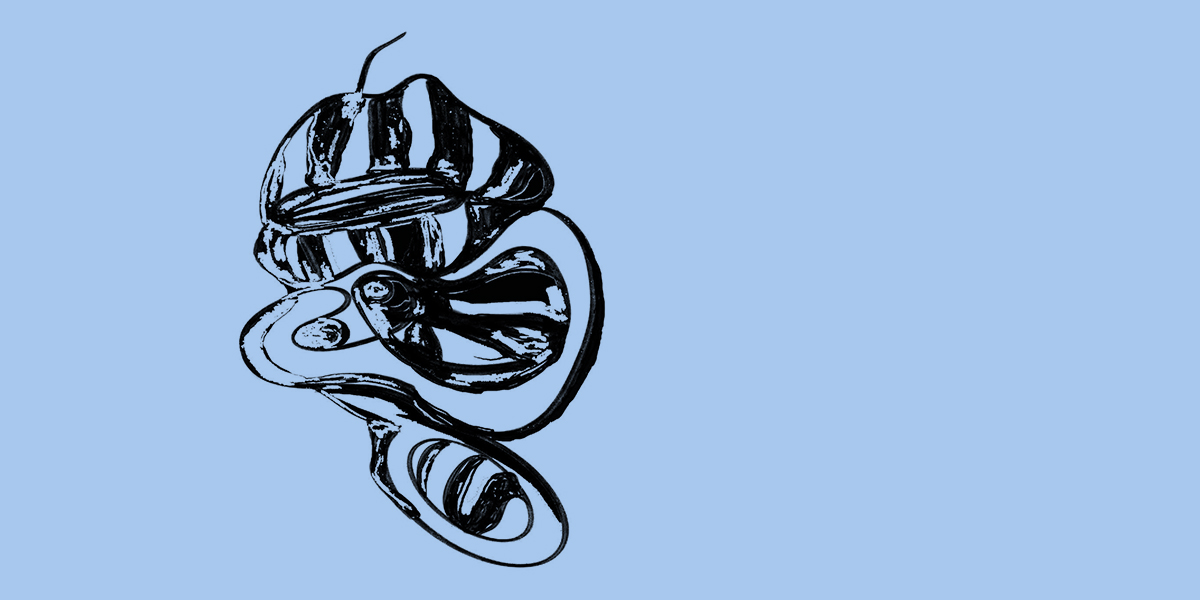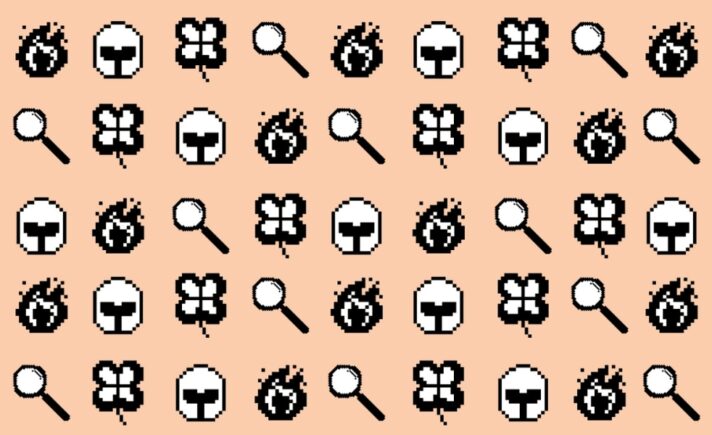في مجالات معينة، أبرزها تحقيقات النيابة، يأخذ المستمع دور السلطة والمتكلّم دور الخاضع للسلطة، غير أن هذين الدورين يتبدّلان في مجالات أخرى، أكثر رثاثة وأقل عملية، مجالات تعنى بالاستعراض أكثر من اعتنائها بالفهم أو المعرفة، ويأخذ الكلام فيها معنى السلطة، والسمع معنى الخضوع للسلطة.
نقول في مصر «سمع الكلام» أي أطاعه، وعندما تبلغ سلطوية الآباء أشدها ينهون أبناءهم عن الرد عليهم، إذ لا يتمثل دور الخاضعين إلا في الاستماع بلا توقف.
في 2012، بالتزامن مع فوز الإخوان المسلمين برئاسة مصر، تولى مجدي العفيفي رئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب التي أعمل بها، وبدأت ألاحظ ثرثرته اللانهائية في الاجتماعات، وأربطها بثرثرة رئيس الجمهورية الجديد محمد مرسي في مؤتمراته المتتالية، كأن المسكينين ظلا محرومين لعقود من الكلام ولم يسعيا للمنصب إلا ليخرجا أخيراً مكنونات نفسيهما.
بعض الناس يسعون للسلطة ليتمكّنوا من الكلام، وبعضهم يتصورون الكلام وسيلة لفرض السلطة، يدهشني حضور الندوات الأدبية الذين لم يتجشّموا مشقة المجيء إلا للإمساك بالميكروفون وشرح نظرياتهم، منبتة الصلة، عن الوجود والعدم والموت والميلاد، كما يدهشني من يريد أن يصبح كاتباً «لكي تصل كلمته الجميع»، دون أن يكون قد شغل باله أصلاً بمعرفة ماهية كلمته هذه.
فقط الكلام، بغض النظر عن مضمونه، هو موضوع رغبتنا، أن نظل نتكلم ونتكلم ولا يقاطعنا الناس سوى بالتصفيق.
وإذا أراد الجميع أن يصبحوا فتوات، فمن الذي سينضرب؟ وإذا أراد الجميع أن يتكلّموا، فمن الذي سيسمع؟
أنا سأسمع.
أتباهى بيني وبين نفسي بكوني مستمعاً جيداً، أمنّي نفسي طول الوقت بالعثور على الجوهرة في الركام، وطالما ذكّرني من يصرُّون على عدم السمع لأعدائهم بمن أراد إغاظة زوجته فقطع قضيبه؛ من يسمع يفهم، ومن لا يسمع يحكم على نفسه بالجهل، ها أنا أمنحك سلطة الكلام، أنصب لك خشبة المسرح لدقائق، وفي مقابلها آخذ فهماً يدوم معي للأبد، ليس فقط فهم ما تريد قوله عن نفسك، ولكن أيضًا كيف تقوله، كلماتك وتعبيراتك وثأثآتك وحركات عيونك.
أخاطر، في جولات سمعي الطويلة، أن أبدو بلا شخصية، وقد أكون بلا شخصية فعلاً، الله أعلم، ولكن ما أنا موقن منه أني لا أكن للطاعة احتراماً مماثلاً لما أكنه للسمع، وبالتالي أحاول تطوير تكنيكات لسماع الناس، لا أفقد بها نفسي أو آرائي.
أقدّم بعض هذه التكنيكات بالأخص لزملائي من الكتّاب، والذين أفترض، بما أن لديهم عمرهم كله للكتابة، أنهم لا يتضوّرون جوعاً للكلام في حياتهم اليومية، كما أفترض كذلك أن احتياجهم للسمع هو احتياج أكثر عملية من احتياج الآخرين له، إذ يعني هذا عندهم، كما عند محقق النيابة، الفهم والمعرفة اللذين سيأتي دورهما لاحقاً ليُدوَّنا في الروايات والقصائد والمقالات والأوراق البحثية.
الكلام الممل: الهمهمة بالشفتين، من دون قول شيء محدد، هي حل سحري في حالة الكلام الذي سمعته ألف مرة، سواء من جانب الشخص نفسه أو من جانب آخرين.
يمكن اعتبار الكلام، خاصة لو كان هاتفياً، خلفية صوتية لا تلزمك بشيء، وتستطيع ممارسة كل أنشطتك المفضلة وقتها، الطهي مثلًا، القيادة، تركيب قطع البازل أو حتى مشاهدة فيديوهات صامتة، وكان صديق لي قد ظل يثرثر لربع ساعة وأنا أهمهم، ثم أنّبني ضميري لعدم التعاطي الجاد معه، فقررت طرح سؤال أرد به على نقطة قالها، وعندما رأيته يتجاهل سؤالي مواصلًا الثرثرة، عاودت الهمهمة دون أي إحساس بالذنب، وقد بدا لي هذا وقتها عقاباً له أو جزاء من جنس العمل، كأنه كلامه لا يستحق التعامل الحقيقي، لا يستحق – في أفضل الأحوال – سوى الإعجاب وليس التعليق، تمثال ميت لا يؤثر ولا يتأثر، وإنما جل ما يفعله الناس هو أن يرفعون لهم إبهامهم ثم ينصرفون سريعاً.
تفاجؤك أحيانًا نقطة إشكالية في سيل الكلام الممل، نقطة يفقد بها الكلام إملاله ويصبح موضوعاً للموافقة أو الاعتراض، ويمكن حينها تسجيل الاعتراض بأرق الطرق الممكنة؛ «أوكي هفترض إنك صح»، كمثال، و«مش معاك أوي بس كمّل»، كمثال آخر، ذلك أن الهدف النهائي والذي لا يجب نسيانه من السمع هو الاستفادة؛ كسب أكبر قدر من الكلمات أو القصص أو الأفكار لنفسك، دون أن تخسر شيئاً منها، من الكلمات أو القصص أو الأفكار ولكن بالأساس من نفسك.
الكلام المدهش: إذا كان مجرد الإنصات فضيلة في حالة الثرثرة والكلام الممل، فالانبهار مطلوب في حالة الكلام المدهش، وعلى المرء منا، مع صعوبة هذا، التدرب على عدم البخل في التعبير عنه.
عن نفسي أفتح عينيّ، أهز رأسي أو أدوّر شفتيّ تعبيرًا عن الـ(wow)، ومع هذا، ولأني أريد أن أسمع لا أن أطيع، ولأني تعلّمت بأقسى الطرق أن تصنع الفهم غير مفيد، أحاول قدر الإمكان السؤال عن كل ما لا أفهمه.
في حال بدت الفكرة معقولة ولكن مناقضة لقناعاتي، يمكنني الرد بشيء غير الموافقة والاعتراض، يمكنني القول ببساطة إني لم أفكّر فيها من قبل، ولأن المنطق المدهش يتطلب منا التمعن فيه أولاً قبل الاعتراض عليه، فتتحتّم ممارسة تدريبات شاقة لعدم البدء بـ«لا»، العفوية التي تعوّدنا على البدء بها إزاء الكلام الجديد علينا.
في حالات بعينها، ولخروج الموضوع عن دائرة اهتمامي بالكامل، أقرّر ترييح عقلي قليلاً، فأقول حينها إني، للأسف، لا أفهم إطلاقاً في موضوع الكرة هذا مثلًا، أو الاقتصاد، وكثيراً ما تكون مكافأتي على هذا الاعتذار الدفاعي أن يضطر محدّثي لتبسيط كلامه أمامي، فتظل الكلمات تدخل أذني، من دون أي وعد مني بالتركيز، ممهّدة الطريق في عقلي، ولو قليلاً، لأن أفهم ذات يوم موضوع الكرة أو الاقتصاد هذا.
الكلام الشرير: لا مفر في بلادنا، أو حتى في كل بلاد العالم، من التعرض لكلام يميّز بين البشر لأسباب لم يختاروها، وكان هذا يعصّبني إلى أن أخذت أكبر وأفقد بالتالي القدرة على التعصّب، فبدأت في ترجمة آرائي، التي أعتقد أنها تقوم على المساواة، إلى كليشيهات رائجة، وأتصور أنني اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الترجمة هذا.
إذا سخر سائق التاكسي، مثلًا، من ملابس امرأة عابرة، أهزّ كتفي كجدة طيبة قائلًا «مالناش دعوة، كل واحد حر في نفسه»، وإذا أطلق آراء استعلائية ضد شعب ما أرد عليه بأن «كل حاجة فيها الحلو والوحش».
مثل هذه العبارات يفهمها الجميع، وهي تقدمية، ومركبة كذلك، ولو شفعتها بتنهيدة لا مبالية فسيكون أثرها رائعاً فيما أعتقد، تعلن بها موقفك وترحمك من الصداع وتوحي إليه أن منطقه ليس مثيراً بما يكفي، إذ من المهين – بالنسبة لي – الاعتقاد بأن الآراء الشريرة تنتشر بفضل شراستها، وإنما في ظني بفضل إثارتها، وبالتالي فأفضل وسيلة لمواجهتها هي تحييد عنصر الجاذبية فيها، ووحدها الكليشيهات تساعدنا في تحقيق هذا الطموح المعقد.
الكلام غير المعقول: ربما لا يغضب الناس من الاتهام بالمبالغة قدر غضبهم من الاتهام بالكذب مثلاً، أو بالغباء. أذكر أن امرأة دخلت المصعد مرتدية الكمامة، فاستهجن منظرها عامل المصعد، وإن لم يعبّر عن رأيه سوى بعد مغادرتها، إذ التفت إلينا، نحن سائر الركاب، قائلاً إن الكمامة غير مجدية، لأن الكورونا لا تصيب الإنسان إلا بأمر الله، وأخذته الحماسة فقال إنه بالعكس، فمن لا يرتدونها هم من يسترها الله معهم، فما كان مني إلا أن نظرت إليه بابتسامة، مش للدرجة دي يا عم، المعقول حلو برضه، فابتسم بدوره وقد بانت نظرة خجل في عينيه.
أعتقد أن «عدم مقاطعة محدّثك»، كواحد من «آداب الاستماع الجيد» هو شرط مستحيل، إذ لا مفر من المقاطعة في أحيان كثيرة، كل ما في الأمر أنه كلما قصر أمدها، وكلما صيغت على هيئة سؤال، كانت أرشق وأكثر تأثيرًا، وأبسط سؤال هو إعادة نطق الكلمة الإشكالية، مدعيًا عدم سماعها جيدًا، فتنبّه محدّثك بهذا أنك منتبه وأنه لم يشتر عقلك ولا أذنيك، وإذا كان حساسًاً بما فيه الكفاية، فسيتراجع عن كلمته هذه، أما إذا كان غليظًا فسيعيد التأكيد عليها، وستنبهر بأي مستنقع يمكن للإنسان الغرق فيه، فقط كي لا يعتذر أو يعترف أنه بالغ.
ما يُسكب على مسامعنا ليس بالضرورة بديهياً، وإن بدا كذلك، وللتشكيك في هذه البداهة هناك سؤالا «كيف» و«لماذا» القصيران الرشيقان، والذان يرغمان المتكلم على العودة للسياق الأوسع، وبالتالي على عقلنة قصته قليلاً، كما أن هناك أيضاً السؤال عن مصدر الكلام، وأذكر أن رئيس التحرير إياه، بميوله الإخوانية التي تزامنت، للصدفة، مع فوز الإخوان بالرئاسة، ادعى أن كارل ماركس «اعترف» بنبوة النبي محمد، وكان هناك حلان، إما السخرية منه أو الثورة عليه، أما أنا فقد اخترت حلاً ثالثاً، إذ سألته ببراءة: «في أنهي كتاب قال دا؟» ، ولما بان ارتباكه ومحاولته لتعويم الموضوع لم أتنازل عن سؤالي البريء: طيب ابقى بص حضرتك وشوف هو قال كدا فين، لإني مهتم بالموضوع دا.
صحيح أنه لم يعد لي بعدها قط، ولكن كانت اللحظة قد تثبّتت، على الأقل، في دماغي.