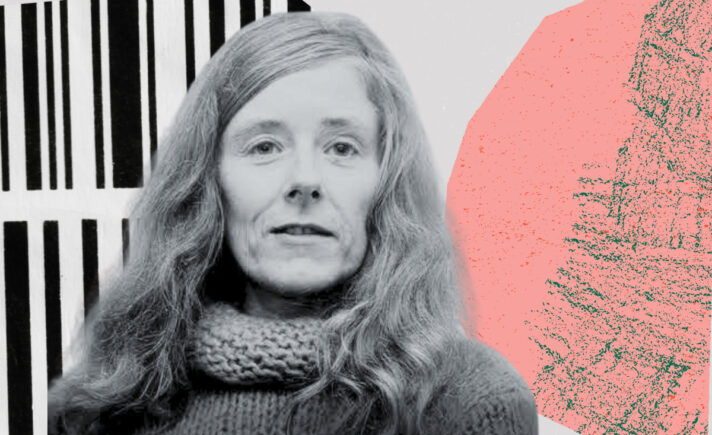بعد الانتخابات كتبت عضوةٌ رسالة غاضبة إلى هيئة تحرير المجلة الشهرية التي يُصدرها حزب العمل، حيث عبّرت فيها عن استيائها من قلة عدد النساء المُنتخَبات. وقد نُشِرت الرسالة مرفقةً بتعليق تحريري مفاده أن الرغبة موجودة، إلا أنه من الصعب العثور على المرشّحات. هذا الجواب ليس خطأ، بقدر ما هو غير كامل. ولو كان كاملاً، لقِيل كذلك إن الحزب لم يحاول قط أن ينظّم المجتمع بطريقة تسمح للنساء ترشيح أنفسهنّ، ولم يفكر جدياً كيف يصنع المرشحات. إن الجهود التي يبذلها حزبنا (والأحزاب الأخرى) لا تتجاوز اختيار لجنة التقييم لعدة شخصيات نسائية معقولة من بين القائمة المختصرة، وتقديمهنّ بكلمة تشجيعية، لا تخلو من شعارات التحرر، يلقيها رئيس اللجنة.
في الحالات المشابهة غالباً ما نتلقّى ثلاثة أنواع من ردات الفعل:
1-إذا كانت النساء يطمحن إلى تلك الدرجة إلى التغيير، فيجب تحقيق ذلك بأنفسهنّ.
2-لا فرق بين الرجل والمرأة، مهارة المرشّح أهم من كل شيء.
3-ألا يستطيع الرجال الدفاع عن مصالح النساء كما تفعل النساء بأنفسهنّ؟
ردة الفعل الأولى تعبّر عن ضيقٍ بالنساء اللواتي لا يكفنّ عن التذمر، ولكنهنّ ينسحبنَ حين يأتي وقت الجد. ردة الفعل هذه مفهومة، ولكنها تدلّ على قصر نظر. لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن ثمة تقسيماً للأدوار والمهام بين الرجال والنساء في مجتمعنا، وأن نظام التربية يهيئ البنات للعناية بالآخرين ويعلمهنّ أن البقاء في الظل هو أجمل ما يمكن أن يَعِشنه على وجه الأرض، بينما يتعلّم الصبي ألا يخشى المعركة إن أراد أن يصبح رجلاً حقيقياً. كما أنها لا تأخذ بالحسبان أنَّ على النساء اجتياز سلسلة من العراقيل المادية والنفسية الإضافية. واللافت أن ردة الفعل تلك تختفي في ظروف ومجموعات أخرى مشابهة. لا أحد يقول مثلاً إن على بلدان العالم الثالث أن تحلّ أمورها بنفسها، ولا بد أننا سنعتبر الذين يرفضون تزويد الأحياء الفقيرة ببرامج تعليم اللغة والمعلمين أوغاداً رجعيين.
ترتكز ردة الفعل الأولى على سوء فهمٍ مفاده أن النساء والرجال متساوون في هذا العالم. غير أن هذا يبرز أكثر في ردة الفعل الثانية: نريد مرشحاً ماهراً. الأشخاص الذين يقولون ذلك ينظرون إلينا بوجهٍ مشرق، لأنهم برأيهم تجاوزوا تلك التقسيمات النافلة. ولكن نتيجة ذلك الإشراق هي أن على الجماعة الأضعف أن تشارك وفق شروط الجماعة الأقوى: أهلاً بك في حال كنتَ جيداً مثلنا. ومن يفترض أن الرجال قادرون كالنساء على الدفاع عن مصالح النساء، فهو محق مبدئياً. غير أن ذلك أصعب مما قد يبدو للوهلة الأولى.
يحتاج الأمر إلى طاقة ووقت كي تتحوّل الأفكار الجديدة إلى سياسة. في المرحلة الأولى سوف يكون الشخص الذي يتكبد العناء كالمُنادي في الصحراء. في المرحلة الثانية سوف يكثر المنتصرون للفكرة، وتتم الدعوة إليها بشتى السبل وإلى ما لا نهاية، ولكنها لن تُنفّذ قبل بلوغ المرحلة الثالثة. بين المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة قد تمضي سنون طويلة.
ينسحب ما سبق على الأفكار «الحيادية»، أي الأفكار التي يتطلب تحقيقها المال والعمل الفكري والشورى وانزياحات صغيرة أو كبيرة في موازين السلطة. إلا أن ثمة نوعاً من الأفكار يحمل شحنة إضافية. هي أفكار تتعلق بالجنس والأسرة وتوزيع الأدوار والمكانة بين الجنسين، وغالباً ما توجد صلة بين هذه الأمور الثلاثة. تتولّد الشحنة الإضافية عن المحرّمات، لذلك لا يكون الذي يدعو إليها كالمنادي في الصحراء فحسب، بل سوف يجلب الضرر لنفسه، ويرى ردود أفعال الآخرين المرعبة منعكسة عليه. مَن لا يعتبر الخيانة أساساً للطلاق، فهو ليس نظيفاً تماماً. ومَن ناضل مؤخراً في سبيل نشر الوعي الجنسي، فلا بد أنه يسلك سلوكاً منحطاً. ومَن صرّح حديثاً أنه ينبغي اعتبار المثلية الجنسية أمراً طبيعياً، فلا شكّ أنه يشكو بنفسه من تلك الميول. أما المرأة التي تطالب بدُور الحضانة، فهي أم منحلّة.
طبعاً لن يُعبَّر عن تلك الأمور بصراحة أو حتى يُشعر بها عن وعي، إلا في حالات الخروج عن نطاق السيطرة. ولكنها تلعب دوراً، وسوف تكون السبب في أن السياسيين لن يتمكنوا من الشغل على هذا النمط من الأفكار إلا بعد أن يقطعوا شوطاً من المرحلة الثانية. أي بعد أن يهضم الوسط، الذي يحسب نفسه طليعةً متنورة، تلك الأفكار.
وحين يترافع الرجل عن مصالح النساء في المجال العام، سوف يحدث أمر مشابه للوضع السابق. وقتئذ سوف تنقلب المحرّمات المرتبطة بالتقسيمات الجنسية – التي نتستر عليها دون أن تختفي – على رأس المترافع.
في الحقيقة، ثمة أمر غريب في تلك التقسيمات الجنسية. يقال إنها ترتكز على فروقات جسدية غير واضحة. غير أن اللافت هو أنها ليست مهمة بالضرورة. أحياناً تُمنَح هذه الفروق معانٍ اجتماعية، وأحياناً لا يحصل ذلك. يوجد في هولندا أناس شقر وآخرون بشعر داكن، ولكن فقط أثناء الحرب كان لذلك الفرق أهمية معينة، حيث أحسّ اليهود أن الهولنديين الشقر «ينتمون إلى المعسكر الآخر». كان الشعر الأشقر/الداكن يميز مؤقتاً بين «نحن» و«هم»، بيد أن للفرق بين لون البشرة الأبيض والأسود وظيفة تمييزية أكثر استدامة. ومع ذلك يحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يرى الأطفال البيض والسود بعضهم بعضاً كمختلفِين.
غير أن التقسيمات الجنسية أكثر تغلغلاً في البنى الاجتماعية من التقسيمات حسب لون البشرة. أول شيء نُخبِره عن المولود هو ما إذا كان ولداً أو بنتاً. وفي حين تظهر التقسيمات بين الأبيض والأسود في بعض زوايا اللغة النائية، ينتشر التمييز بين هو وهي في صلب المنظومة اللغوية.
لذلك ليس مستبعداً أن يُعتبَر الرجل الذي يدافع عن مصالح النساء مرتداً،لا ضير في أن يدافع الرجل عن امرأة واحدة، لأن ذلك يعتبَر سلوك الفرسان [الكاتبة]. فهو يشكل تهديداً لنفسه وللجماعة. لا أحد يأخذ امرأة تلبس طقماً رجالياً على محمل الجد، ولكن ينبغي على الصبي أن ينسى عادة طلاء الشفاه، وألا يهزّ المثلي وركه أثناء المشي، ورجاءً امنعوا ذلك الغلام عن رقص الباليه، لأن هؤلاء يركزون على جسمانيتهم كما لو أنهم نساء، وسوف يُعرِّضون جميع الرجال إلى السخرية.
كما توجد طريقة أخرى يخسر الرجل فيها مكانته في حال دافع عن مصالح النساء. فهو سيثير انطباعاً خفيفاً أنه يسمح للمجموعة الأدنى أن تأمره، وهذا ما يسمى بظاهرة الطنطات. لذلك يحاول الذين يفضّلون قول كلمة الحق أن يحموا أنفسهم. يتعاملون بشيء من العداوة مع النساء في محيطهم أو يتندرون بهنّ. وبما أن الأمر ينطوي على مخاطرة، فهم لا يسمحون لأنفسهم أن يدافعوا عن النساء أو يترافعوا من أجل تغيير تقسيم الأدوار بين الجنسين إلا حين يتعلق الأمر بمسألة تنضوي سلفاً تحت شعار الأعمال النبيلة. وينسحب ذلك على السياسة أكثر من أي شيء آخر، لأنها ما زالت مجالاً يمنح للتراتبية الذكورية والرجولة أهمية قصوى.
كذلك تَواجُد النساء في المجموعات الرجالية ليس أمراً بسيطاً. يحق لها أن تشارك، شريطة أن تتبع قوانين اللعبة وتمثّل دور الفتاة اللطيفة. أما إذا فتحت أحاديث عن عدم المساواة بين الجنسين، فستُعتبر عاملاً معطِّلاً يطمح إلى الكشف عن المستور ويهدد تماسك الفريق. ولن تكون ردود الأفعال فاترة، بل ستتراوح بين عدوانية مباشرة واستهزاء. وهكذا تتحول الفتاة اللطيفة إلى امرأة ممتعضة، وقد يفضي الأمر إلى الرقابة الذاتية التي نلمس أثرها في إعلام البلدان التي تحكمها أنظمة مفرطة الحساسية. هذه هي الآلية الأولى المسؤولة عن ضعف الاهتمام بمصالح النساء في السياسة. الصمت يجعل الحياة أسهل لجميع المعنيين.
وللآلية الثانية أصل تاريخي. إذ حالما تمكنت النساء أن يصبحن نائبات، صار من الضروري أن يثبتن أنفسهن وأنهن قادرات على الخروج من الغيتو. فقد كان هناك ميل لحبس النساء في خانة النساء. حتى حين وصلت روزا لوكسمبورغ إلى ألمانيا، أراد البعض إرسالها إلى أشغال النساء. ولكن روزا رفضت، لأنها لم ترغب بدورٍ من الدرجة الثانية.
الجيل الأول من السياسيات اضطررن أن يثبتنَ جدارتهنّ من خلال الانشغال بالسياسة العامة. كُنّ يعتقدنَ أنهنّ الطليعة التي تجرّ وراءها جيشاً غفيراً: في حال عبرت نعجةٌ واحدةٌ السياجَ، فسوف تتبعها الأخريات. لذلك لم يكنّ معنيات باستثمار السياسة – وما ينسحب على السياسة، ينسحب كذلك على القطاعات الأخرى – بغرض رسم خطة لصالح بنات جنسهنّ (حتى ولو كنّ يتحرّكنَ عند الضرورة)، لأنهنّ حسبنَ السياسة وسيلةً لإثبات أن النساء قادرات على القيام بأعمال الرجال: حالما يقدّمن الدليل، سوف يكون السبيل معبّداً نحو الكرامة.
ولكن بعد مرور خمسين عاماً، بات واضحاً أن الأمور لم تسِر حسب المتوقع. وما زال لدينا حتى الآن نعجة واحدة فقط، وهي ما يسمى بين الكواليس بالتمثيل الرمزي. والسبب هو أننا ننتمي إلى الأقليات: إذا نجحت إحدانا فسوف تُعتبر الاستثناءَ الذي يثبت القاعدة، أما إذا فشلت، فسوف يتمتمون «ألم نقل ذلك؟!». المادة الإيجابية لا تؤخذ بعين الاعتبار، أما المادة السلبية فهي دليل قاطع. الشيء الوحيد الذي سوف تحصل عليه المرأة التي تنجح هو أن يُقال لها: أجل، ولكنكِ تختلفين عن الأخريات.
على مدى خمسين عاماً أثبتت النساء السياسيات والأخريات إرادتهنّ الطيبة. وعلى مدى خمسين عاماً اشتغلن وفق شروط «المهنة». والمحصلة هي أنهنّ ما زلن غائبات أو مجرد استثناءات في المناصب العليا، وما زالت الفتيات يدخلنَ سن البلوغ قبل أن يستدركنَ تخلفهنّ الدراسي، وما زالت المتزوجات أو الحوامل يُقَلنَ من أعمالهنّ،استغرق الأمر حتى عام 1976 إلى أن تمّ إدراج منع إقالة النساء جرّاء الزواج أو الحمل أو الإنجاب في كتاب القانون المدني [ملاحظة المحرر]. وما زال البرلمان قادراً على الإقرار بقانون ضد العنصرية دون أن يُذكر فيه كلمة الجنس أو الحالة العائلية،ولا حتى الميول الجنسية: على ما يبدو لا يعاني المثليون من شيء [الكاتبة]. وما زالت الأحزاب تتخلى عن الاقتراحات التي تخص النساء حالما تستلم الحكم (الحزب الليبرالي والإجهاض) أو تتركها حبراً على ورق حين يحتاج الأمر إلى التمويل (التركيز التقدمي ورياض الأطفال)، أي باختصار: ما زالت النساء يحصلنَ على الفُتات المتبقي من الميزانية، هذا إن افترضنا أنهنّ مشمولات فيها أصلاً.
«أنتِ مختلفة!». لاشك أن القصد من هذا التعبير هو الإطراء، إلا أن الرسالة الضمنية تقول: أنتِ لا تنتمين إلى الأخريات. ونكون هنا قد وصلنا إلى الآلية الثالثة التي تجعل النساء مترافعات سيئات عن جنسهنّ: آلية الولاء المتذبذب. حيث أن النساء اللواتي يُحسَب حسابهنّ قد تعلّمنَ أشياء لم تتعلمها الأخريات، فهن يعرفنَ أكثر، ويستطعنَ أكثر، ويفهمنَ أكثر، ولذلك ينفصلنَ عن جماعتهنّ ويشرعنَ بالتذمر من الجهل والمحدودية والسلوك الأخرق الذي تعاني منه الأخريات. ولذلك ينشأ لديهنّ ميلٌ إلى محاربة جماعتهنّ، وإنكار موقع الأقليات الذي تحتله النساء (لم ألمس أي تمييز ضدي)، والتعامل مع مكانتهنّ الخاصة بمزيج من التواضع والغرور، مما يجعلهنّ يخاطبنَ بنات جنسهنّ قائلات: لو بذلتنّ أفضل ما عندكن مثلي، سوف ننتهي من هذا النقّ! ولكن من أجل أن تتمكني من الانتماء إلى المجموعة الأخرى، لا يكفي أن تطالبي بنات جنسكِ أن يتصرفن «جيداً»، بل عليك أن تُظهري سلوكاً حسناً بنفسكِ. ومن هنا تعاني «الرموز النسائية» من بعض الإسراف في السلوك التعويضي، ويتصرفنَ كما لو أنهنّ ملكات أكثر من الملك نفسه. لذلك يلاحق أعضاء/عضواتَ الأقليات صيتُ الحقد، وأنهنّ يبالغن ويعظّمن صغائر الأمور. ولذلك تحاول «الاستثناءات» إظهار أنهنّ عاقلات ومتعاليات على ذلك الأسلوب الطفولي، وقادرات على تقدير الأمور بحجمها الطبيعي. البرلمانيون الرجال الذين يطرحون مشاكل النساءولكنهم غالباً ما يرفضون ذلك. وإن فعلوا، فسوف يتبين أنهم ليسوا على اطلاع كافٍ. وأحياناً يكونون لا يعرفون شيئاً عن سلوك رئاسة الحزب بهذا الخصوص، وبذلك يكشفون عن مدى اهتمامهم بالنساء اللواتي انتخبنهم [الكاتبة]. هم يعبرون عن وجهة نظرهم فقط، أما بعض البرلمانيات فلا يفعلن ذلك دون التأكيد على أن ثمة مشاكل أخرى تتمتع بالأولوية القصوى. وهكذا يبدون كما لو كنّ متربعات على عرش الله، ذلك المكان غير المناسب لأبناء الأقليات، وللنساء على وجه الخصوص.
النساء في المناصب العليا، أي في الهيئات السياسية، لسنَ بالضرورة نعمة لبنات جنسهنّ، بل على العكس. فمن ناحية يُستخدَمن كعذر – لدينا امرأة تعمل معنا –، ومن ناحية أخرى يُجبَرن من خلال الآليات الموصوفة أعلاه على أن يتنكرنَ لجماعتهنّ، ويُعززن موقف الأكثرية في أنه ليست ثمة مشكلة. بمعنى آخر، هؤلاء النساء يقدّمنَ الذريعة التي تحافظ على المنظومة الحالية.
لذلك أَفترضُ أن مجرد تواجد «امرأة» على لائحة الانتخابات أو في اللجان ليست نقطة انطلاق جيدة. فإذا كان هدفنا أن يعيش الرجال والنساء على قدم المساواة في المجتمع، أي أن ينشأ مجتمع يجعل ذلك ممكناً ومرغوباً، فسوف نحتاج أن نرحّب بالتواجد السياسي لنِسويات يَعتبرن أنفسهنّ مبعوثات جماعتهنّ ضعيفة التمثيل.
مَن النِسويات؟ هنّ النساء الواعيات لانتمائهنّ إلى جماعة من الدرجة الثانية ولا يحاولنَ أن يتملّصنَ منها كأفراد. واللواتي يتضامنّ مع بنات جنسهنّ، ولا يقبلنَ ببداهة الأولويات والنسب وقواعد اللعبة التي تحددها الجماعة الأخرى، ولا يسمحنَ باستخدامهنّ من قبل الحزب السياسي الذي يكتفي بالكلمات دون الأفعال. واللواتي يعتبرنَ السياسة وسيلةً مفتوحة لخلق فرص متساوية لنصف البشر، ويدركنَ أنه لطالما تمّ تناسي مصالح بنات جنسهنّ في خطط المستقبل الإصلاحية أو الثورية، فيطالبنَ بإعادة التفكير بذلك. واللواتي يقلنَ لأنفسهنّ حين يلاحظنَ استغلال النساء: إلى متى نسمح بفعل ذلك بنا؟ ويدركنَ أنهن سوف يبقين أشخاصاً من الدرجة الثانية في السياسة. ذلك أن شيئاً قد تغير منذ أن دخلت روزا لوكسمبورغ مكاتب الاشتراكيين في ألمانيا، غير أنه لا علاقة لأنديرا غاندي وجولدا مائير بالنسوية.
لن يَكنّ من الدرجة الثانية فحسب، وإنما مدعاة للاستهزاء أيضاً. فهناك مواطنو الدرجة الثانية النبلاء، أي البروليتاريا والسود، الذين يصلحون دائماً كمادة للفكاهة. وهكذا استطاع عضو مجلس الشيوخ الأميركي سميث أن يقدم مقطعاً ترفيهياً على شكل طلب تعديل لقانون المناهضة للعنصرية الجنسية.في عام 1964 اقترح عضو مجلس الشيوخ أثناء مناقشة قانون تكافؤ فرص العمل (ضد العنصرية على أساس العرق) إضافة «وعلى أساس الجنس» إلى نص القانون.كان قصده أن يسخر من النص القانوني، إلا أنه تمّ الإقرار بالقانون مع الإضافة التي اقترحها [ملاحظة المحرر]. وكذلك فعل رئيس وزرائنا بيسهوفل حين أعلن عن تنصيب امرأة في حكومته.كان بيسهوفل رئيس وزراء هولندا في تلك الفترة. ولم يتعين في حكومته سوى امرأة واحدة (س. فان فينيندال)، وقد استلمت منصب وكيلة وزارة الثقافة والترفيه والمجتمع [ملاحظة المحرر]. فالسياسة هي ملعب الرجال، أي أنها منطقة تسمح لهم بتبادل النكات والتغامز فوق رؤوس النساء. ذلك أن العبيد لا يملكون عيوناً وآذاناً.اقرأوا ما قاله بيسهوفل لفريق «مينا المجنونة» حين زرنه من أجل الاعتراض. لقد انهمر سيلٌ من النكات الذكورية الموجهة لآذان الصحفيين الموجودين حينها [ملاحظة المحرر]. إن النِسويات يواجهن كل تلك الأمور برأس مرفوع، ويتجرأنَ، حسب تعبير سارتر، أن يكنّ حقيقيات.
نحتاج إذن إلى الترحيب بهؤلاء النِسويات. هذا يعني أن يُمنَحنَ المساحة المادية والنفسية. أولاً، النفسية من خلال توقع المبادرات منهنّ بدلاً من التسامح معها. وثانياً، المادية من خلال منحهنّ الوقت للشغل على رسم السياسات. ما زلنا بأمس الحاجة إلى رسم السياسات، فمن ينقّب في أعمال البرلمان واللجان لن يجد شيئاً يُذكر عن النساء. ومن أجل الشغل على ذلك، نحتاج أن نتنقّل ذهاباً وإياباً بين السياسة والأرض الخلفية. لذلك ينبغي أن يتوافر الوقت للنساء، وهو غير موجود في نظام العموميات الكافي لوحده أن يلتهم أسبوع عمل مزدحم بأكمله. والمحصلة هي تقييد جذري للمهام الأخرى، وحاجة إلى اجتذاب مزيد من المساعدة. المساواة تكلف مالاً.
ولكن ما هي الأرض الخلفية؟ يبدو الجواب للوهلة الأولى هو: النساء الأخريات والحلقات النسائية داخل الحزب. ولكن بعد التمعّن، نرى أن الأمر ليس بتلك البساطة. لأن المرء لا يؤمن بأسطورة العموميات في الحلقات الداخلية للسياسة فقط، بل كذلك في الدوائر النائية. من الأسهل أن تتصنّعي أنك إنسانة لا ينقصها شيء من أن تشعري بصليب يثقل كاهلكِ كامرأة. سياسة النعام تجعل معظم النساء لا يفقهنَ وضعهنّ، وفي حال غضبنَ ذات مرّة، فسوف يسمحن ببرطلتهنّ بالكليشيهات التي تقفل باب النقاش. أما إذا دار الحديث حول فئات النساء الموضوعات في خانة الاتهام، فلا شك أنهنّ يتحملن مغبّة تصرفاتهنّ.
أولى مهام المتنقِّلات ذهاباً وإياباً هي إيقاظ الدوائر النائية، وشرح أن الأمر ليس مجرد أخطاء فردية، وإنما نابع عن بنية خاطئة. وقد تكون المنظمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية نافعة في هذا المجال. غير أننا سوف نواجه مشكلة جديدة، لأن تلك المنظمات لم تُؤسَّس من أجل منح مصالح النساء فرصة عبر السياسة، وإنما من أجل منح السياسة فرصة عبر النساء. والمحصلة هي أنها باتت تشكّل ثقافة جانبية لا تصدر الضوضاء ولا تزاول الهوايات المزعجة، كما تفعل أحياناً بعض المنظمات الشبابية على سبيل المثال.
في ظل نظام العموميات، سبق أن علت أصواتٌ اقترحت إلغاء المنظمات النسائية. لا شك أنها محقة إن نظرنا إلى المشاكل العامة، لأن أثر المحرّمات لا ينسحب عليها، أو على الأقل لا ينسحب عليها بالضرورة. حالما نستطيع التخلص من مكانة الأقليات التي نحتلها، سوف تفقد المنظمات النسائية ضرورتها. ولكن إلى ذلك الحين، سوف نبقى بأمس الحاجة إليها.
حين نقرر سلفاً أن نتخذ موقعنا كأقلية كنقطة انطلاق لممارسة السياسة، سوف ينفتح الطريق للوصول إلى النساء والمجموعات النسائية في الأحزاب الأخرى كي نتشارك على صياغة باقة من المطالب ونحدّد الفترة الزمنية لتحقيقها. لأنه مهما كانت الاختلافات الإيديولوجية والسياسية، إلا أنها حسب تجربتي لا تنسحب على هذا المجال.
في حال تحقق ذلك التعاون، سنتمكن من ترجمة الأماني إلى اقتراحات سياسية. لطالما تمّ تجاهل رغبات النساء بحجج من قبيل «غير ممكن!» أو «قولوا لنا كيف نتصرف!». ولطالما قسَم ظهرَنا نقصُ المعرفة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية العامة. إلا أن المعرفة يمكن شراؤها أو الحصول عليها مجاناً إن اشتغلنا على مشروع مفيد ومدعوم من قبل عدة جهات تضمن نجاحه. حين تنجح المجموعات النسائية بصياغة باقة مشتركة من المطالب، ستكون الخطوة التالية في الحصول على وعد بالالتزام بها من قبل إدارات الأحزاب، والمطالبة بتشكيل لجنة تنسيق من أجل وضع خطة للسنوات القادمة. وفي حال تشاركت تلك المجموعات على ذلك، وكانت مستعدة أن تستخلص النتائج، فسوف يصعب على أي تحالف حكومي، مهما كان تشكيله، أن يتغاضى عن رغبات النساء. هذا يستوجب العمل الجماعي والمنظّم لتحقيق موقع تفاوضي، كالذي بنتهُ النقابات لنفسها.
هذا ليس مهماً من الناحية السياسية فحسب، وإنما نفسياً أيضاً. لأن دور النساء يملي علينا أن نعتبر السلطة «قذرة» أو أمراً يزاوله الأنذال من قبيل نيكسون وغيره. إن التطلع إلى السلطة لا يليق بالذين يعتقدون أن مهمتهم هي السهر على راحة الآخرين. والمحصلة هي أن تصبح فعّاليتنا السياسية معدومة تماماً، ونتمتم بحذر «أليس من الأفضل أن … »، ونرسل في آخر لحظة تلغراماً، ليَخيب بعد ذلك أملنا لأننا لم ننجح للمرة الألف. أن نمارس السياسة يعني أن نكون قادرات على تشكيل التكتلات، ورسم الاستراتيجيات، والاتفاق الجماعي على العقوبات. وأن نكون مستعدات أن نغضب علناً على حزبنا، ونعلن عند الضرورة أننا سوف نمنح التضامن مع النساء الأولية فوق التضامن مع الحزب. لأن الأحزاب وسيلة من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدلاً، وليست هدفاً بحد ذاته.
وتبعاً لحبل الأفكار نفسه، سوف يسترد شعار «تصويت النساء للنساء» رونقه. ففي ظل نظام العموميات، كان قد أصبح مشبوهاً. كما أنه لم يظهر للتصويت على النساء تأثير فعلي، نظراً لعمليات الاحتواء التي يقوم بها ذلك النظام. ولكنه سيغدو مهماً، حالما نكرّس أنفسنا لصناعة النساء السياسيات. وقتئذ قد نحتاج إلى قوة العدد، ولكن إلى ذلك الحين ينبغي أن نستبق الأمور بالتخطيط لحملات نعمل عليها سوية. كما نحتاج إلى الترويج للشعار، لأن الناس ملّوا من «العنصر النسائي»، على الأقل مجازياً.
ليس هذا سوى جزء من القصة. إذ لا يحق للأحزاب السياسية ترك مهمة تحقيق مثُلهم العليا على الكادر النسائي. بل ينبغي أن تسعى جدياً إلى هدم تقسيم الأدوار وتزويد النساء بما يَحتجنه. في السياسة، بالمعنى الضيق، لا ينبغي ترك مجرى الأمور لرب العالمين. فالنساء لن يدخلن البرلمان إن اعتمدنا اللغة البناءة للشخصيات البارزة فقط. لذلك يجب أن يكون الحزب واضحاً بخصوص خطط الرفع التدريجي لمعدل مشاركة النساء في لوائح الترشيح. على الأرجح ألا يبلغ المعدلُ المستهدفُ الربعَ في عام 1974-1975، ولكن في 1978-1979 سيكون ذلك ممكناً.في 1977 أدخل مجلس حزب العمل إلى قواعد الحزب أن قائمة المرشحين سوف تشمل خمسة وعشرين بالمئة من النساء [ملاحظة المحرر]. يا ليتنا نباشر منذ الآن بالتناوب على العمل التأسيسي، فيتضمن ما يلي:
-حملة منهجية لتنظيم دورات لإعداد الكوادر الحزبية، والحرص على أن يكون نصف المشاركين من النساء، وعلى أن يتعلمنَ رفع صوتهنّ كما الرجال، ويقيّمنَ جميع الدورات بعد انتهائها (أين هي العقبات، وأين تكمن الفجوات في المعرفة؟).
– التحضير بشكل جيد لاستبيان رأي بين عضوات الحزب بغية معرفة من أين جاءت مقاومتهنّ للعمل السياسي بالضبط.
لا يُستبعَد أن تشجع نتائج هكذا استبيان على التفكير بنموذج خاص للتنظيم السياسي. ذلك أن التعامل مع الطاقة البشرية والحماسة ما زال حتى الآن مخيباً للآمال وغير فعال. في التنظيم الحالي تسيطر الأقسام والمناطق عبر الهيئات العامة التي يسيرها الشباب الصغار أو الرجال الذين لم يبلغوا سن الرشد حتى الآن، وما زالوا يلعبون لعبة الأولاد المتنافسين على أكبر مساحة ممكنة عبر الكلمات. والمحصلة أن تتحول اللقاءات السياسية إلى لعبة مشاعر تفضي إلى لعبة مشاعر.
وهذا ما يخيب آمال النساء، لأن الكلمات في المجال العام بالنسبة لهنّ عبارة عن مقالة وظيفية نستخدمها من أجل الفضفضة عمّا في قلوبنا. لذلك تختصر النساء عادة أثناء الكلام – في مؤتمرات الرجال غالباً ما يضطر رئيس الجلسة أن يذكّر المتحدثين بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة، أما في مؤتمرات النساء فقلما يحتاج الأمر إلى ذلك.
حتى ولو كانت النساء مهتمات بالسياسة، إلا أنهنّ سوف ينزعجنَ من أسلوب الاجتماعات الرسمي. لا يحبذنّها، ولا تبرق عيونهن من شدة الاستمتاع بـ«اللعبة». ولكن هذا ينسحب كذلك على كثير من الرجال الذين بلغوا سن الرشد. هؤلاء رجال يرون السياسة كوسيلة من أجل تغيير العالم أو تحسينه، وهم محقون جزئياً حين يكتشفون أن الأمر لا يحتاج إلى الأحزاب السياسية (إن نفور مجموعات العمل من السياسة الرسمية له دلالات واضحة). هؤلاء رجال يسرّهم أن يتشاركوا في معرفتهم واهتماماتهم، ولكنهم يتضايقون من النقاشات التي يسيطر عليها الغباء والصراخ. يصبر البعض من أجل القضية، إلا أن غالبيتهم تختفي بسرعة. في السياسة سرعان ما تتبدل الشخصيات.
لعل الحلّ يكمن في تركيز تنظيم الحزب على العلائق الأشبه بورشات العمل. ففي ورشات العمل الناجحة ثمة توازن بين الأخذ والعطاء، كما أنها بمثابة النعمة على نوّاب الشعب المضطرين أن يكونوا مُطّلعين على شتى القضايا، والمحتاجين بشدة إلى معلومات وأفكار وناس يساعدونهم على تحقيقها. كذلك هي نعمة على المشاركين الآخرين الذين يرون أنه سوف يتم استخدام أفكارهم.
ومن المهم البحث عن السبل التي سوف تمنح أعضاء الورشات فرصة المشاركة في الترشيحات واتخاذ القرار. حالياً لا تملك الأحزاب تلك الإمكانيات، بل يتم السيطرة عليها من قبل محاضرات الثرثرة. وهذا يعني أن حق التصويت متاح فقط للمشاغبين والقادرين على أن يتحملوا كمية كبيرة من الضيق والملل. أظن أنها عملية فرز خاطئة.