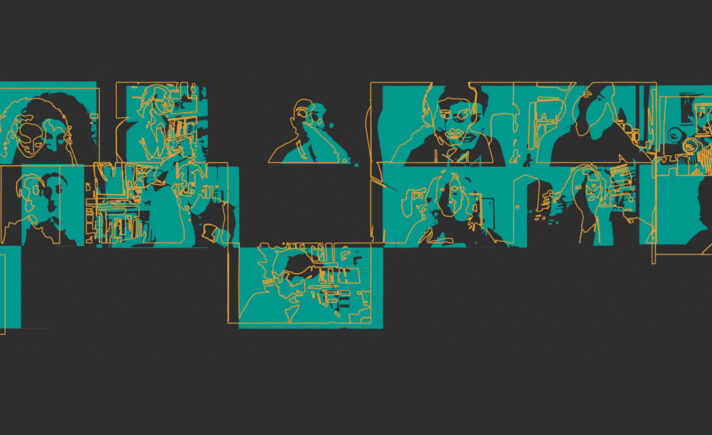ما لم نعش ونحب في الخندق، فمن الصعب أن نتذكر أن الحرب ضد التجريد من الإنسانية لا تتوقف.Audre Lorde, Sister Outsider, Penguin Classics, 1984, 112.
نكبر كنساء في مجتمعات «صِغَرُنا» فيها هو علامتنا التجارية المُطلقة. أن تصغُري هو كل ما تتمناه الخليقة منك؛ أن تصغري حجماً وسناً ومقدرةً ًوقوة وإمكانياتٍ وحِدّةً وذكاءً وشغفاً. نجاح النساء يتبعه رغبة بالانكماش والاختفاء عن وجه الكرة الأرضية. حدّة النساء تُثيرها غمامة الصوت غير المسموع الذي يحتاج أن يعلو كي لا يُغيَّب. الأنوثة نفسها محددة بمحاكاة أبدية لطفولة غير مبالية. يخيَّل لنا أنه لا كوكب يتّسع لأرقامنا المتصاعدة بأي شيء، والجيل لا يختلف عن هذه!
علاقة الإنسان المتوترة مع الجيل قديمة، وتبدو بإحدى مستوياتها منطقية. يمكن تسليمها لصيغة متداولة بخفة: علاقة طردية مريبة مع الموت. الموت بصفته معيار خاتمة الجسد، والجسد بصفته تخوم الذات وجوهرها. وما إن نبدأ بالتساؤل حول التجارب المُعاشة المختلفة للنساء والرجال فيما يتعلق بأعمارهن-م، يتجلى السنّ كعامل مُتشكّل جندرياً بشكل يحوّل الاختلاف إلى أداة ترويض وسيطرة، ويؤكد أن تجربتنا المعاشة بأجسادنا تخضع لدوالّ مختلفة. ولنعود إلى البداية: من هي الإنسان التي تكبر؟ أيشير المصطلح إلى نفس المفهوم، ونفس الرموز والخيال؟
المرأة جسد، والرجل روح. الجسد يفنى، يهرم، يتعب، يتألم، تزداد تجاعيده أو تقل، يمرّ بتقلبات عدّة، لديه كثافة عظام ومصير هرموني. أما الروح فتحافظ على جوهرها وسلاستها وأثيرية وجودها. تظهر لنا بإرادتها، إن شاءت بانت وإن لم تشأ تلاشت. الجسد يهتم بنفسه، بمحيطه الضيق، متقوقع، لا يرى بعيداً، وهو سريع الزوال بانكفاءاته وإخفاقاته. بينما تجول الروح وتصول في العالم، تهادنه، تسيطر عليه، تخاف منه، تقاومه، وترى ذاتها من خلاله او من خلال دحضه.
بالتأكيد يكبر الرجال بالسنّ، لكن يبدو وكأن التغيّر الفيزيولوجي الذي يمرون به ليس تاريخياً ولا ينعكس كتنميط مباشر وحاد على تجربتهم الاجتماعية. فالوقت بالنسبة للرجل عامل خارج عنه (لنتذكر أنه روح) ومن الممكن محاربته، وهو كغريم من الممكن أسره إلى حين غرّة، وتشكيله والتواري عنه. ولكن علاقتنا كنساء مع كِبر السن – وازدياد رصيدنا بأي شيء يترافق طرداً مع الوقت الذي نمضيه على وجه الكرة الأرضية – ليست قطبية ولا معركة مع شيء خارجي نحاول القبض عليه وقولبته. يتكوّر الوقت فينا، ونصبح منه وهو منا. الزمن بالنسبة للنساء ليس ظاهرة خارجة عن أجسادهن، ولذا أن نصارع الوقت كنساء يعني أن نصارع أنفسنا، وما تمثله أجسادنا في هذا الزمن، نحنُ المتغيّر وليس الزمن! وعلينا أن نستعجل، لا أن نحيا، بل أن نفكر بالزمن بقلق، وبتوجس وبرهبة… ليست رهبة مُحارب، بل رهبة من هُزم مسبقاً. علينا أن نستعجل قبل أن تتحول عربة ساندريلا إلى يقطينة مرة أخرى ويفوتنا القطار.أستعير هذا التشبيه من لوري بيني، Laurie Penny, Unspeakable things, 2014. الرجل يعرف الساعة، تلك التي تدله على المواعيد وتنظم حياته، ونحن نعرف ساعة بيولوجية، «بناء اجتماعي» نرزح تحت طائلته ولا يسير على خطانا أبداً.
ليس صدفة أن تشعر الكثير من النساء بأنهن «غير مرئيات» عندما يكبرن بالجيل، فعلى مدار عصور من الحياة البشرية على هذا الكوكب، ترتبت قوة النساء الوحيدة المعترف بها كقوة شرعية بحساب قدرتهن على التأثير على الرجال من خلال جنسانيتهن. القدرة على مقايضة قوة الرجل ومركزه باقتصاد المرأة الإيروسي.Laurie Penny, Unspeakable things, 2014, 209. جنسانيّة مُصمّمة مُسبقاً، محدودة بعوامل وأهداف، ومُنتهية الصلاحية. بحسب أودري لورد فإن الإيروسية منبع قوة داخلي، «بئر من القوة المتجددة والاستفزازية للمرأة التي لا تخشى استكشافها، ولا تستسلم للاعتقاد بأن الإحساس كافٍ»،أودري لورد، 44 لكن لا يُنظر إلى إيروسية النساء من منظار ما تمنحه لحاملاتها، بل يتم أيضاً حصرها بقيمتها التبادلية، بالخدمة المؤداة لطرف آخر في سبيل الحصول على شيء أثمن يملكه هو كالمقام والقوة والحب (الحب بكونه اعترافاً بالوجود وليس مشاعر فحسب). وهذا بغض النظر عن علاقة الجنسانية بـ«حاجة» النوع البشري للاستمرار، فالاستدامة ليست حصرية وليست بحاجة لأن تستبعد المتعة. الفرضية الأساس هي انعدام رغبة تخصهن ومن أجلهن لدى النساء. هن موضوع الرغبة ولسن الباحثات عنها. وعلى هذا المنوال تعاملت ثقافات المعمورة قاطبة مع الرغبة الإيروسية للنساء بورع، فكافأت اجتماعياً الامتناع، والتعفف، وحتى أحياناً تمثيل دور يتراوح بين الحياد واللامبالاة وعدم المشاركة، وصولاً إلى الرغبة المتمنعة، وهو ما يُتوقع من النساء كتصرف مقبول ولائق حول كل ما هو إيروسي. وهذا يفسّر أيضاً لماذا لا يفهم الكثيرون ضرورة الإفادة بالقبول والحاجة لها بين الطرفين، كما يفسّر إطالة أمد الثقافة الرومنسية التي ارتبطت بالمباغتة والصمت والاستراق كعلامات للإعجاب والحب.
للأسف، لا شيء من هذا جديد. لقد كتبت سيمون دو بوفوار عن هذا بدقّة جميلة منذ أربعينات القرن المنصرم فقالت: «تعرف المرأة التي تكبر بالسنّ أنها إذا توقفت عن أن تكون شيئاً جنسياً (sexual object)، فهذا ليس فقط لأن لحمها لم يعد يوفر للرجل كنوزاً جديدة، بل أيضاً لأن ماضيها وتجربتها تجعلان منها شخصاً (person) سواء أحبت ذلك أم لم تفعل. لقد قاتلت وأحبت وأرادت وعانت واستمتعت بنفسها: وهذا الاستقلال الذاتي مخيف».سيمون دي بوفوار، 621
وكأن دو بوفوار تهمس لنا أنه، وبعد أن شقِينا على هذا الكوكب كي نتحلى باستقلالية وذاتية وشخصية، تباغتنا الساعة البيولوجية – ساعة الرجل من حديد – فتصبح شخصياتنا زينة جميلة على الأرضية الأساس: الجسد وجماله وتأنيب الصبا الأبدي. فتُلحّ الحرب على «علامات الكِبَر». وكباقي الحروب الخاسرة التي تُزَجّ النساء بها، علينا أن نتحلى بالصبر ونثبت من ثَمّ جدارتنا بخوضها، وفناءنا في سبيلها. فحروبنا هي مقايضات متواصلة. قيل لنا يوماً على سبيل المثال أن العمل هو واسطتنا للتحرر، فأعيد توظيفه كليةً ليلعب هذا الدور في حياة النساء.بيني، 17 يعمل الرجل كي يقتات، أو يُقيت، أو يكتشف العالم أو يستمتع بوقته، أو يُضيف معنى للحياة. ونحن نعمل كي نتحرر!! وبينما يعيش الرجل، يستمتع أو يحزن، يُجرّب أو يتعلم، علينا نحن أن نجتاز العيش دون خدْش أو تجعيد، ونحارب علامات التجربة بعناد، كيف لا والأنوثة نفسها عبارة عن «علامة تجارية، وإن كانت واحدة منقوشة في أجسادنا عند الولادة». وبعد هذا النقش المؤلم، يبدو أحياناً التفاوض على سكاكين أخرى، اجتماعية وذاتية ومتوارثة وطبية، ليس خارج عن هذا السياق بل ضمن متطلباته، لتصبح سكينة «الخيار» أجملهم على الإطلاق وأكثرهم حنّيّة.
«لم يسبق في التاريخ أن كانت إمكانية تغيير أجسادنا قريبة جداً من الإدراك وموضوعاً لمثل هذه الرغبة الشديدة». في عالم تزداد فيه المنافسة، وابتداع الكمال وكأنه مُنال، وتسويق الأوهام بأن بإمكان الإنسان أن يكون فوق التاريخ والبيولوجيا معاً، وأننا كلنا سنصبح «سوبر هيومانز»، تتم إعادة «إنتاج الأجساد كطريق للتمكين الاجتماعي وتقرير المصير».سيلفيا فيديريتشي، خارج محيط الجلد، كايروس، 2020، 53. يبدو في هذه اللحظة بالذات أن حلم تجاوز الحاضر نحو المستقبل الذي نادت به المدرسة الوجودية – وبوفوار إحدى مفكراتها المركزيات – كابوساً. فلن تحمل هذه الفكرة المزيد من الإمكانيات والمساواة، بل هي في راهنيتها تُمركز هذه الأسئلة نحو الفرد ورغباته واحتياجاته، وليس نحو حلول جماعية هي الوحيدة القادرة على تفكيك هذه المنظومات. وهنا يبدو لي أن للنسوية الحظوظ الأفضل لإعادة التفكير وإعادة طرح الأسئلة وتشبيكها، ليس تلك المتعلقة بالجندر والمساواة والتحرر فحسب، بل أسئلة هي في صلب الإنسانية ككل، كالحياة والموت، وعلاقتنا مع الطبيعة (لماذا أصلاً نقول نحن والطبيعة؟ ألسنا نحن من الطبيعة؟) ومع ما هو أرضي ومتغير في أجسادنا، ومع تجاربنا المعاشة الكثيرة التي عليها أن تترك أثرها في أرواحنا وأجسادنا أيضاً. للنسوية تاريخ طويل من التشكيك بمنظومات اجتماعية وطبية تقترح حلولاً دراماتيكية للنساء بدل أن تعيد ترتيب القيم ومدركاتها، ولها أيضاً تاريخ من التأكيد على الأسس الاجتماعية التي تشكّل قاعدة ممارساتنا المتعلقة بأجسادنا وبتنظيمها وبتجميلها وبإعادة تصنيعها وتصغيرها.
على مرأى السكاكين المتوهجة التي تعدنا بالخلاص وباجتثاث كل ما هو «سلبي» في أرواحنا وأجسادنا (ما لا يفقأ العين شباباً وملاسة، القلِق، المترهل، المعطوب، الحزين، المجعد) واستبدال هذه بأشياء جديدة (وليدة اللحظة، واعدة، سعيدة، لها حياة أطول…) يبدو خطاب المقاومة مكموراً، ويبدو أن الحدّ الأقصى لما تستطيع نسوية ملتزمة لحياة طيبة وكريمة في الوقت الحاضر أن تفعله هو أن تحمل كراسي إضافية لغرفة العرض، كي نُحدّق أطول ونطلب وقتاً إضافياً لطرح الأسئلة: ما الذي نعرفه عن الجمال إن لم تكن الشوائب؟ ما الذي يسعدنا أكثر، الكمال أم الاعتراف؟ أيحتاج الأخير إلى الأول؟ ولماذا بكل الأحوال نُغمض أعيننا عندما نحب؟