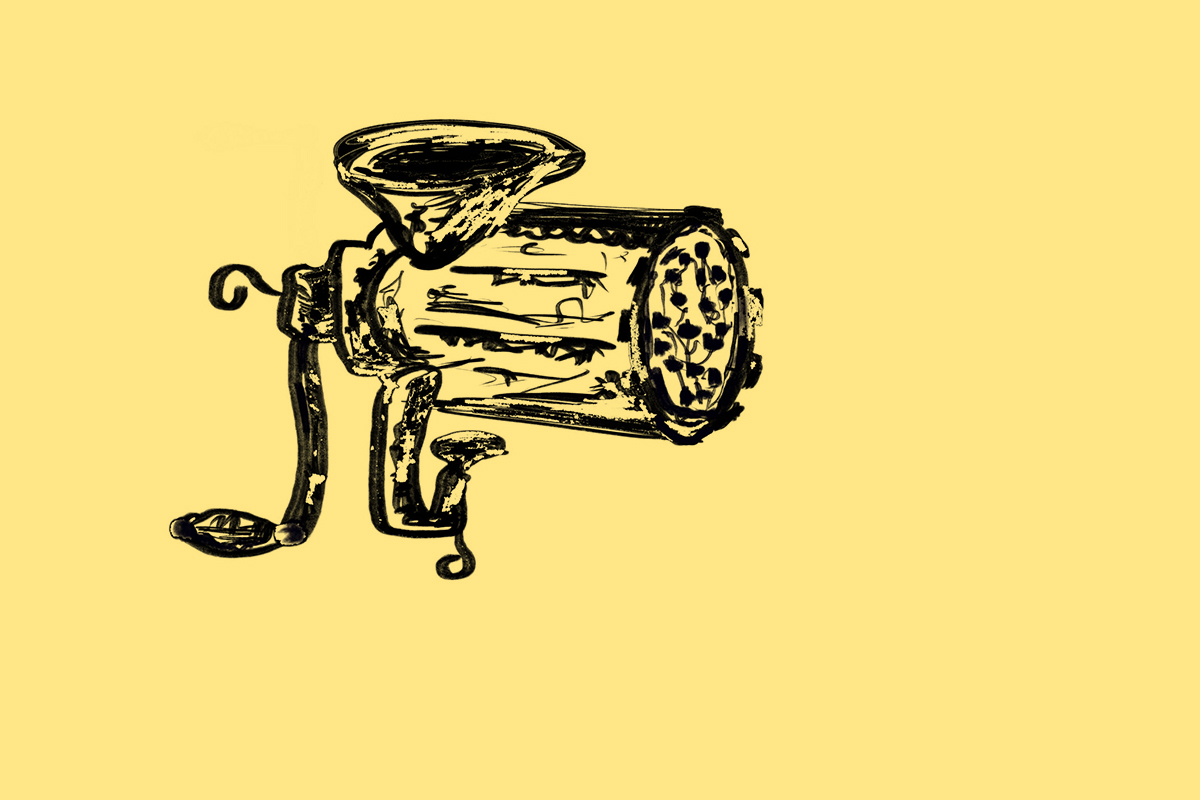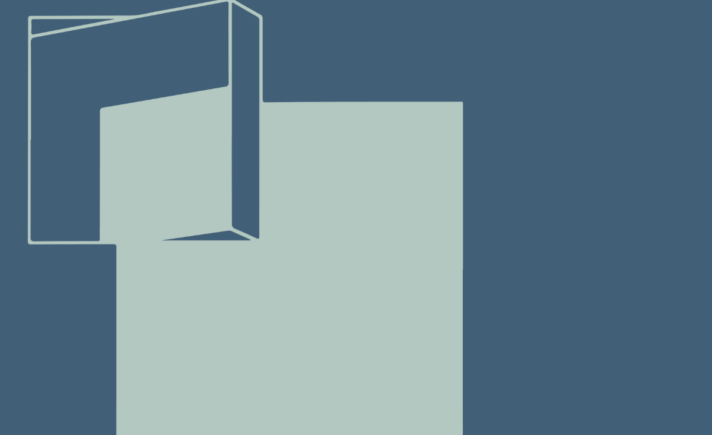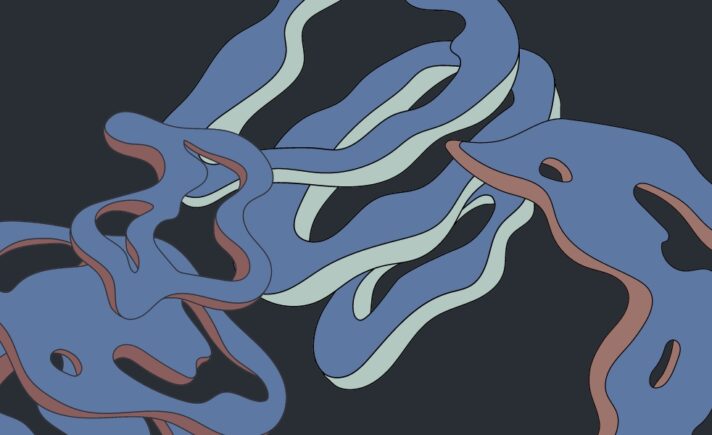لنفرض أن التئامك قد اكتمل، من سيدفن جثة الماضي إذاً؟
لم أر في الخوف دنساً أو ضعفاً، على عكس الشجاعة التي رأيتها غالباً مرادفاً للحماقة والذكورية. في المقابل يجعلك الخوف يقظاً، منتبهاً، في حالة تأمل باطنى تمكنك تدريجياً من بناء دفاعاتك النفسية. أتحدث عن الخوف المحدود، لا الرعب، لا الهلع، والفزع من تهديد واضح أو مباشر، بل ذلك الخوف الأليف الذي تطعمه أمهاتنا لنا مع حليبهن وحين تنمو أسنان المرء ويُفطم، ويصبح التحايل، والكذب، والتخفي مكونات النظام الغذائي الذي نحيا عليه. خوف يأتي متبوعاً بنصائح من قبيل «اسمع الكلام، امش جنب الحيط، ابعد عن المشاكل، لو بلطجى وقفك أعطه ما معك ولا تتعارك، اشرب كوبك كاملاً، الطعام الذي تتركه في طبقك سيجري وراءك يوم القيامة، إذا استمررت في ضرب العشاري ستفقد نظرك وتضعف ركبك، قول شكراً، قول الحمد لله، متحكيش في السياسة، البس فانلة تحت الهدوم» إلخ.. إلخ.. إلخ، ثم بخ! تصل لمراهقتك وتتعلم ضرورة البعد عن مسار ضابط المرور إذا صادفته في الشارع، وإخفاء هويتك عمن يحادثك، وألا تخوض في الدين مع أحد، وحين تصل إلى شبابك تجد تمرسك مع الخوف قد أكسبك القدرة على ممارسة الحياة كاملة بصحبته؛ الحب تمارسه مع حبيبتك وأنتم محاطون بمخاوف متعددة تبدأ من اقتحام الجيران عليكم البيت، أن يوقفكم ضابط شرطة في الشارع، أن ينقطع الكندوم، أن يأتى صاحبك إلى المنزل قبل أن تنتهوا، أن تعرف بنت خالتها بأمر علاقتكم، أن يراكم ابن عم أمها معاً، ومع ذلك تستمر قصص الحب العربية وتنمو. نتزوج وننجب وننفصل. حياة كاملة بصحبة الخوف، من نكون نحن لنرفض الخوف أو نتمرد عليه! نحن قوم نأكل الخوف بدل الكرواسون مع القهوة، ثم أن لدينا هذه الألسنة الطويلة الحادة الجارحة التي لا تتوقف عن الغلغلة عن شجاعتنا، وقوتنا وصلابتنا وفرادتنا، وكل هذه القيم العربية الجميلة عن التمرد والشجاعة والجرأة التي تلهج بها أغاني المهرجانات المصرية ومغنون يتحدثون عن قدرتهم على حمل السلاح وإنهاء أى معركة بينما يطاردهم نقيب مثل هاني شاكر مجبراً إياهم على بلع ألسنتهم في مواجهته والفلقسة بشجاعة منقطعة النظير، لأنهم مثلنا جميعاً تربوا على الخوف وأكلوه صغاراً.
الفقرة السابقة طويلة، ومليئة بالأفكار والصور المتناثرة، وأنا أعرف أن قواعد التحرير البليغ تقتضي تقسيمها وتكسيرها لجمل وفقرات أصغر، وحذف ما قد يشتت ذهن القارئ عن الفكرة الرئيسية. أقرأها وأشعر بخوف وصوت اصطكاك «اكتبي زي الناس، بلاش قلة أدب، حددي الفكرة، عبر بكلمات قليلة وجمل بليغة، اجعلي النص يسيراً لا عسيراً». في الغالب سأخضع لخوفي، لأنه هذه المرة خوف جديد، خوف فريد الطابع لم أختبره في حياتى السابقة، ليس خوفاً عربياً، ليس الخوف الذي سقته لى أمى ومجتمعى ودولتي، بل خوف كما النمل زحف دون أن أشعر به خلال السنوات الأخيرة منذ هجرتي إلى أمريكا، حتى أكل النمل كل ثقتي في ذاتي، وانقطع تواصلي بأناي «هل هذه كلمة صحيحة لغوياً؟ إذا لم تكن، فهل تفهمها؟ نعم أسألك أنت».
لنبدأ من البداية مرة أخرى.
ما من بداية لأعود لنقطتها، أنا في المنتصف عالق مع الخوف في حفرة جدرانها شاشات تعرض مناظر مدنية وصور خلابة من طبيعة قارة أمريكا الشمالية.
* * * * *
الترميز لدرجة التشفير، التوريات المفرطة، إخفاء اضطراب الذات وتناقضها بحجة الكتابة عن المشترك الإنساني، نتائج تربية مؤسسات السمع والطاعة هذه التي تحوّلت إلى عناصر أساسية في التركيب الجيني للأدب العربي الحديث. قد لا تختلف كثيراً عن ممارسات التحايل والكذب والتخفي التي نحيا بها، لكن الكاتب يحول خوفه ومحاولات الانفلات إلى فن أو أدب أو حتى إلى نص مشوش مثل هذا.
احترفت التخفي مبكراً، والفضل للإنترنت. الإنترنت الذي كان ثغرة في الجدار، وباباً يفضي إلى خارج زنازين العزلة التي يبنيها الخوف بين الأفراد. أول العلاقات الاجتماعية التي أسستها في حياتي بعيداً عن الأسرة والمدرسة، كانت مع أناس التقيت بهم عبر الإنترنت. وفي زمن ما قبل السوشل ميديا والهويات الافتراضية كان الجميع يتخفون تحت أسماء مستعارة، وفي إنترنت لا يطلب منك تأكيد شخصيتك بكود يرسله على رقم هاتفك.
كتبت ونشرت في مراهقتي تحت عشرات الأسماء المستعارة، متخفياً. نمى صوتى دون معرفة أهلي أو حتى أصدقاء مقربين منى، تكون أسلوبي ووقعت في هوى الكتابة في الخفاء، لكن لأن حياتى العلنية سارت إلي الصحافة الأدبية، فقد تآكلت المسافة بين الخفي والعلني، حتى انهار الجدار تدريجياً بين «إبليس» الاسم المستعار وقتها على الانترنت، وبين «أحمد ناجي».
في تلك السنوات كل لقاء لأحمد ناجى بشخص يعرف إبليس، احتوى على جملة من نوعية «شكلك هادى وصغير جداً»، «ازاى بتكتب كدا على النت». مع توالى السنوات اختفي إبليس تماماً، أصبح أحمد ناجي فقط هو الموجود داخل الشبكة وخارجها، بصورته واسمه على شبكات السوشل ميديا التي أنهت الإنترنت الخفي القديم.
* * * * *
خرجت من مصر فرداً، كاتباً، غير عضو في أى تنظيم سياسي، وشارداً عن جماعتى الدينية والوطنية. لكن لم يعد لهذا أى قيمة أو معنى فور وصولك إلى هنا، فمن بوابة المطار تأخذ لا ختماً واحداً بل مجموعة أختام بنت قحبة لا تعرف حتى معناها، ولم تخترها.
تجبرك ممارسة الحياة اليومية في المنفى، خصوصاً في مجال الكتابة والعمل الثقافي، على التأقلم تدريجياً مع الأختام الموجودة على قفاك. أتذكر في الشهور الأولى حين وجه أحدهم لى سؤال باعتباري كاتباً «بنياً». كانت أول مرة أسمع هذا المصطلح، وحين طلبت مزيداً من الشرح تلجلج حتى فهمت أنه يقصد أي كتاب آخرين لا ينتمون للعرق الأسود أو الأبيض. اتبضنت كثيراً وقتها، لكن بعد فترة رأيت أن الأمر عادي وهكذا تجري الأمور في الولايات المتحدة.
السمع والطاعة هنا ليست أوامر صارمة يحرسها عسكري مدجج بالسلاح والسجون. السمع والطاعة هنا همس، ذبذبة صوتية ترتطم بوعيك متحولةً إلى نمل يأكلك ويسيطر عليك ببطء، يمسخك حتى تصير كما يريد النظام لك أن تكون. وجدتني في النهاية أقدم نفسي ككاتب بني، وأتحدث عن جماعة اسمها الكتاب البنيون. بل واستخدم في كلامى كل الأختام التي وضعوها على قفايا أو رفعوها في صرمي لدى العبور من المطار. فأنا والحمد لله هنا أصبحت كاتب بنياً، مسلماً، عربياً، عربياً أمريكياً، شمال أفريقياً وأفريقياً أحياناً، ولا زلت بفضل المولى أجمع الألقاب والهويات لأنها مفاتيح أبواب المنح وفرص العمل والتعليم والحياة.
آه، التحايل مرة آخري، لكن هذه المرة في مواجهة خوف جديد.
* * * * *
ثم من أنت؟ هل تنكر أنك كاتب بني؟ هل تتنكر لأصولك العرقية؟ لماذا تنتقد العرب الأمريكان، هل تحتقر جماعتك؟ كم أنت ناكر للجميل. لكن إذا لم تكن تعرف نفسك عربياً لماذا تتحدث عن العرب؟ إذا لم تعرف نفسك بصفتك كويري، فلماذا تتحدث عن نيك الطيز؟ لا ليس ذلك من حقك. بالطبع بإمكانك الحديث عما تريد، حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، لكن إذا تحدثت عن آكلي الفسيخ وأنت لا تحب الفسيخ ولا تأكله فأنت تخطف صوتهم وتأخذ مكانهم. ورق الإقامة، تصريح العمل؟ لا ليس الآن، عليك أن تثبت لنا قدرتك على الاندماج وذلك عبر أن تعترف أنك كاتب بنى، عربي، إسلامي، she/them/he/her. ثم على هذا الأساس تندمج. أنا رضعت التحايل مع لبن ماما يا ولاد الكلب، لا يوجد أسهل عليا من الكذب.
* * * * *
تعاملت مع الإنترنت لأول مرة وعمري اثنا عشر عاماً، في سبتمبر الماضي أتممت السادسة والثلاثين. في العام الماضي ولأول مرة أصبحت أخاف من الإنترنت.
ضبطت نفسي أكثر من مرة، أكتب بوست على الفيسبوك، أو عبارة على تويتر، ثم بعد أيام وأحياناً ساعات، أمسحها، أو أخفيها في الأرشيف. يحدث هذا بدافع الخوف، لكنه خوف لم أعرفه سابقاً، ما أكتبه لا يحتوى على سياسة أو دين أو أي من المحظورات، ومع هذا يداهمنى الخوف ويقودني لمسحه.
لم أفعل هذا أثناء وجودى في مصر، وهذه الحقيقة تخيفني. يخيفني أكثر أنني لا أعرف منبع خوفي ولا سببه، ولا من أين يأتي.
في مصر مصادر الخوف معلومة ويدرك المرء حدود قدرتها، ويتحايل عليها. لكن في المنفى يأتي الخوف من الداخل، من أوراق هويتك المؤقتة التي يمنحونها لك، من الأرض غير الموجودة تحت قدمك، من اغترابك لا فقط عن المكان والبيئة الاجتماعية والثقافية التي نشأت بها، بل اغترابك عن صورتك كما عرفتها وصنعتها.
أنظر خلفي فأرى آثاري لكن لا أرى نفسي.
* * * * *
الهجرة الجبرية بالنسبة للكاتب هي فأس يشج صفحة كتابته وأسلوبه الأدبي إلى لأبد. في أيامي الأولى كان منسوب التفاؤل لدى يكاد يبلغ سقف السماء. اعتقدت أن الهجرة فرصة لبداية الجديدة. ومن منا لا يحب البدايات الجديدة؟ لكنها لم تكن سوى بداية «التيه العظيم».
كلما زادت معرفتك بالطرق، والمؤسسات الثقافية في بلد المنفى تدرك استحالة إعادة إنتاج ذاتك من بداية جديدة، واستحالة العودة لذاتك القديمة، ويتعمق انحدارك في عمق المتاهة. كأن أحدهم نزع ملكيتى للغتى، ومسح البعد التاريخي والسياق الجغرافي الذي تستمد منه معرفتى قوتها. ثم تأتى ضرورات الحياة، وتتعمق الهوة بين الكاتب الذي يبحث عن صوت جديد، والكاتب كعامل ضمن ماكينة ثقافية لا تتيح سوى حيز ضيق لأمثاله من المهاجرين. بل تدفعك إلى المنافسة على لقيمات صغيرة مع الكتاب الغرباء أمثالك.
يصبح التمرد، الخروج عن قواعد الكتابة والأفكار أو تمزيق رداء الكاتب المنفي القادم من معاناة العالم الثالث مخاطرة غير مضمونة العواقب، قد تفقد فيها مصدر دخلك وتنحدر إلى جموع المهاجرين في ماكينة العمل البدني. كثيراً ما أقول لنفسي «وأنا علي بأيه من وجع القلب دا كله». لو عملت على أوبر أو وقفت في سوبر ماركت ربما أجنى شهرياً ما أجنيه من حياة الكاتب، لكن حينها ماذا يتبقى من ذاتك؟ عمل ثماني ساعات يومياً وزيارة منتظمة لمختص نفسي لتخدير الآلام الداخلية ودفع خطر الانتحار.
* * * * *
هل هذه نوبات فزع؟ ما رأيك في التأمل؟ الحالة متعثرة، إذن زيارة لطبيب أو معالج نفسي قد تخلصك من كل آلامك وأسئلتك الوجودية.
لا، لن أذهب إلا إذا ظهرت أعراض عضوية على جسدي. غير هذا فيجب علينا كمغتربين أن نتعامل بحذر مع الطب النفسي، لا أدعوكم لمشاركتى احتقاري، بل إلى توخى الحرص وحسب.
الطب النفسي كأحد من منتجات الحداثة، يسعى لمساعدة الإنسان على تجاوز تناقضاته واضطراباته الذهنية في سبيل الانسجام مع محيطه الاجتماعي. هذا هو الهدف الأسمى للطب النفسي، إنسان لا يسبب الضرر لنفسه أو من حوله وينسجم داخل ماكينة بيئته.
التراكم المعرفي للطب النفسي أساسه عقود من الدراسة والتحليل لأفراد ولدوا ونمو داخل الدول القومية ومؤسسات الحداثة الليبرالية. بهدف مساعدة الأفراد على أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، لم يتطور الطب النفسي في جوهره ليتعامل مع المهاجرين والمغتربين، وليس باستطاعة الطب النفسي ردم الهوة بين المهاجر والمجتمع الجديد، ولم يكن من صلب اهتماماته الرئيسية فهم المجتمع الهامشي للمهاجرين، حيث تعيش مجموعات من البشر التي تتحدث الصينية أو العربية أو الإسبانية داخل دولة تتحدث الألمانية والإنجليزية.
أحد النتائج هي ارتفاع حاد في حالة انتحار المهاجرين مقارنة بالسكان، خراب نفسي ووجداني يعيشه المهاجرون، وإذا كان المهاجر قد تمكن من تحصيل معارف ثقافية معقولة ومكنه وضعه القانوني والمهني من الحصول على تأمين صحى، فسيبدأ رحلة أحقر لتعميق الشرخ الوجدانى داخله، زيارات لمحلل نفسي وأطباء نفسيين أجانب، لا يتقنون لغة المهاجر، وليس لديهم الوقت حتى لفهم خلفيته الثقافية، قوانين الصحة تحدد لهم بروتكول التعامل مع المريض بدقة.
تحت ضغط الأمل في النجاة يعيد المهاجر باستخدام لغة أجنبية بناء ذاته على كرسي المحلل النفسي، أوامر السمع والطاعة ليست مصحوبة بالتهديد والإجبار، بل تدمر دفاعات إرادتك أولاً، أنت مريض، أنت جاهل، أنت قادم من عالم متخلف، نحن هنا نحاول مساعدتك، نعلمك/ نرتقي بك.
على مدى دقائق كل أسبوع، يستمع لك الأخصائي النفسي وأنت تتلعثم بحثاً عن كلمات لتوصيف مشاعرك ثم يفتح الكتاب ويتلو عليك توصيفات لحالتك، وطريق النجاة كما يظنه المهاجر أن يتقمص التوصيف لكي يبدأ المعالج معه بروتوكول العلاج.
ماذا قد يمنحك المعالج أو المحلل النفسي أنت القادم من الحروب والثورات والسجون؟ هل سيساعدك حقاً على التعامل مع مشكلاتك؟ أم أن هذا تأثير كلامك عن نفسك بلغة غير لغتك الأم، والطبيب الخواجه يساعدك بالكلام على ابتكار هذه الذات الأجنبية؟
ذات مرة مع أحدهم، بدأ حديثه قائلاً أن الحالة بالتأكيد پي دي إس دي PDST، أي اضطراب ما بعد الصدمة، ثم بدأ التحليل واقتراح مجموعة من الاستراتيجيات يعرفها أي قارئ للطب النفسي أو التنمية الذاتية أو روايات باولو كويلهو. استمعت له كاتماً بضانى بابتسامة المهاجر المهذب، ثم حين انتهى شكرته وقلت أن كل ما قال كلام جميل، لكن أول كلمة في PTSD هي post أي «بعد» الصدمة، وأنا أتمنى فعلاً أن تنتهى الصدمة لكي ابدأ هذه الكورس العلاجى الحبوب والشيق. المهاجر في صدمة أبدية يا بهايم الطب النفسي، كل يوم في بلد المنفى والهجرة هو صدمة جديدة، السكرتيرة التي تحجز موعد الجلسة وهى تتحدث ببطء مع المهاجر حتى يفهم ما تقول هو صدمة، الجلوس أمامك وشرح نفسي بلغة أجنبية هو تراوما بحد ذاته. استمرار منظومة الطب النفسي الغربي في تطبيق بروتكول الـPTSD هو أكبر دليل على مدى تعفن منظومة الطب النفسي الغربية ومركزيتها التي تجعلها تتصور بلدانها كجنة والمهاجر كضحية يجب أن نعالجه لكي يستمتع بتلك الجنة، عبر ترويضه وتدريبه لكن بصوت منخفض هذه المرة. ثم ما الغرض من هذه العملية كلها، أن تلتئم داخلياً، أن توهم نفسك أنك مثل الآخرين حولك في هذا المجتمع الجديد عليك؟ لنفرض أن هذا الالتئام المستحيل حدث يوماً.
من سيدفن إذاً جثة الماضي الذي يتعفن داخل قفصك الصدري؟