دُمرت أجزاء كبيرة من مدينة حمص، العالم بأسره يعرف ذلك. وقد يعتقد البعض أن حمص كانت ضحية عشرة أعوام من العنف الشامل والكبير منذ عام 2011 فقط، لكن التمعّن في تاريخها المعاصر يوضح لنا حرباً من نوع مختلف شهدتها المدينة في أوقات «السلم»، وأن التدمير لم يبدأ عند اندلاع الثورة السورية. وقد عمل هذا العنف الذي واجهته المدينة وسكانها على تدمير ذاكرتها بشكل بطيء وصامت، فلم تكن أدوات الحرب في أوقات «السلم» هي المتفجرات والقنابل العنقودية والدبابات والطائرات، كما كان الحال في السنوات العشرِ الماضية؛ لكن الحرب كانت عبر المخططات المعمارية وقوانين التخطيط العمراني والجرافات، وعبر التسويق لمشاريع تدعو للتحديث العمراني والمعماري، أبرزها مشروع «حلم حمص»، مشاريع استُخدمت ضمن استراتيجية التدمير العنفي البطيء ضد المدينة.
العنف ضد المدينة قبل 2011
منذ أربعينيات القرن الماضي، ازداد التوسع العمراني خارج أحياء حمص القديمة، خصوصاً من جهة الغرب والشمال. اخترق العمران البساتين المحاذية لها ونشأت أحياء جديدة مكان هذه البساتين، ما أدى إلى انحسار الحزام الأخضر المحيط بالمدينة. ومن هذه الأحياء حي الغوطة، الذي كان عبارة عن بساتين تخترقها ساقية ري، لم يبق منها الآن إلا هذه الساقية. وقد مهّد التمدد العمراني، الذي جاء نتيجة لازدياد عدد السكان، الطريق أمام انحسار النمط العمراني الذي كانت تتميز به حمص القديمة، ذلك من خلال ظهور أبنية طابقية ضمن هذه الأحياء مكان البيوت العربية القديمة التي تتميز بطابع العمارة الأبلقية؛ الحجارة السوداء البازلتية المتناوبة مع حجارة بيضاء كلسية.
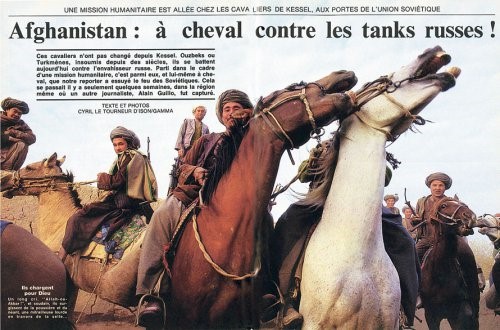
استمر هذا الانحسار العمراني داخل حمص القديمة مترافقاً مع هدير الجرافات التي عملت على مدى سنوات طويلة على تدمير تاريخ المدينة بدل الحفاظ عليه. فمنذ بداية الثمانينات، تم تهديم جزء كبير من القسم الشمالي الغربي للمدينة المسورة لبناء مجموعة من الأبنية الضخمة، والتي تعرف اليوم بمجمع الأربعين، نسبة لجامع الأربعين الذي ما يزال صامداً لليوم عند الزاوية الشمالية الغربية لحمص القديمة، والذي كانت مئذنته برجاً دفاعياً ضمن كتلة جدار السور، وأمام الجامع اليوم بعد أمتار قليلة، خمس قناطر من الحجر الأسود، هي ما تبقى مع المئذنة من سور حمص الأثري في هذا الجزء من المدينة القديمة.

كانت حمص تعاني من الإهمال وبحاجة ماسة لمشاريع ترميم لتراثها القائم. لكن بدل حماية هذا الإرث العمراني، تم العمل على تشويه المدينة وتغيير هويتها ونسيجها الثقافي والعمراني والاجتماعي، سنة بعد سنة، فتم استبدال عدد كبير من بيوتها القديمة بأبنية تجارية جديدة ودوائر إدارية ومرآب للسيارات.
تدمير ذاكرة حمص كان يتم عبر مواقع مختلفة فيها. نحن من كنا نعيش في حمص لحظنا موجات هذا العنف «السلمي» البطيء تسير عبر الأحياء والشوارع. لقد خسرنا الكثير من حمص خلال سنوات عديدة قبل اندلاع الثورة. وكنا، نحن سكان حمص ومن نمشي في شوارعها وأحيائها، نلاحظ أنه ليست العمارة وحدها من تتعرض لهذا العنف لكن أيضا بيئتها.
فمثلاً، في حي الغوطة وفي شارعها الرئيس، أحد الشوارع الحيوية والمهمة في المدينة، تم اقتلاع أشجار الكينا والآكاسيا والصفصاف، وفي شارع الملعب تم اقتلاع شجر النخيل ونقله لمدخل حمص الغربي خارج المدينة، قرب مصفاة حمص. لم يكتفوا بذلك، ولم يتوقف الأمر على أشجار موجودة على منصفات الطرقات والدوارات، بل استمر زحف المخططات العمرانية على أحلام الفقراء والمهمشين في هذا المجتمع. في بساتين حمص الغربية، بين حي الغوطة وحي القرابيص، تم استملاك هذه البساتين التي تبلغ مساحتها 462 دونماً من سكانها في عام 1994 بهدف إقامة ما سُمّي بـ «حديقة الشعب»، هذه البساتين التي كان يقطنها 1500 شخصاً يعتاشون على ما تنتجه من خضار وفاكهة. عُوّض سكان البساتين بشقق متوسط مساحتها 50 متراً مع دفعة أولى تدفعها هذه العائلات. حاول الأهالي كثيرون رفع مظلمتهم والتحدث عنها، إلى أن جاء محافظ حمص الجديد، محمد إياد غزال، سنة 2006، ليرمي أحلام هؤلاء في الحفاظ على أراضيهم بعيداً مقابل تحقيق أحلامه الخاصة في حمص، عبر توسيع شارعين مقتطعين من هذه الأراضِي، وهما شارعا نزار قباني وبدر الدين الحامد، أضيفت لهما إنارة بيضاء جديدة لها لم تعرفها حمص من قبل. وفرغت حديقة الشعب المزمع إقامتها من سكانها منذ تلك الفترة، وحتى هذا اليوم؛ ومازالت تنتظر أن تصير حديقة.
خلال عملية التوسيع تلك تم اقتلاع مئات الاشجار يبلغ عمر بعضها 200 سنة.
أثناء بحثنا عن موادٍ صحفيّة من تلك الفترة، لفتتنا إحدى المقالات التي كتبتها الصحفية السورية سعاد جروس عام 2006 منتقدةً مشاريع إزالة أشجار حمص، استخدمت جروس كلمات من قبيل «اغتيال» و«مجزرة» لتعكس الألم والمعاناة لخسارة هذه الأشجار. وفي مقالتها، تكتب جروس عن حوار تم مع المهندسة فرح جوخدار في مقابلة لها ضمن برنامج «مدن الفن والإنسان» على الفضائية السورية. عبر البرنامج، انتقدت جوخدار السياسات العمرانية الجديدة التي تدعو لتدمير تراث حمص وتاريخها، مثل مركز صبحي شعيب المهدد بالهدم آنذاك، والذي يستقطب المجموعات الفنية والأدبية في حمص -لا يزال المبنى صامداً لليوم-. كان صوت جوخدار، ومن بعدها جروس، غاية في الأهمية كأداة لمقاومة العنف الذي يطال حمص وأهلها، وكم نحن بحاجه لمثل هذه الأصوات اليوم. كتبت جروس يومها عن جوخدار حين طالبت بأهمية المشاركة الشعبية في تحديد مصير مدينتهم:
لم تسأل المهندسة المسؤولين رد القضاء عن مجزرة الكينا والأكاسيا والصفصاف، وإنما اللطف فيه، وطالبت كأضعف الإيمان عرض أي مشروع يخص المواطنين على الرأي العام للمناقشة والحوار، كي لا تتكرر المأساة تلو المأساة؛ حسبهم اقتلاع أشجار النخيل المعمرة من إحدى الساحات، والاستعاضة عنها ببحرة من السيراميك.
وبالكاد بدأت أرشفة ذكرى مجازر الأشجار والاستملاكات التي شغلت الكثير من الأهالي لسنوات طويلة، منذ صدور القرار سنة 1994 وطرد الأهالي منها في سنوات لاحقة، حتى أُعلن عن إطلاق مشروع آخر، مشروع رآه البعض الجنة القادمة لحمص، وآخرون كثيرون يرونه عقدة من عُقد سلسلة العنف البطيء الطويلة ضد المدينة.
حلم حمص
عام 2010، اجتمع محمد إياد غزال، محافظ حمص السابق، مع مبعوث الرئيس الفرنسي السيناتور فيليب ماريني في دار المحافظة، ليعرض عليه مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها الرئيس، ومنها «إعداد دراسات التخطيط الإقليمي الشامل وإنجازها بهدف توظيف الإمكانيات والموارد الذاتية لإطلاق مشروع حلم المحافظة، لافتاً إلى مشروع حمص الكبرى»، في مقاربة لافتة بأن مشروع الحلم سيكون على غرار باريس الكبرى، هذا الحلم الطموح الذي أجهضته مؤقتاً هتافات متظاهرات ومتظاهري بداية الثورة السورية ضد محافظ حمص بالذات، المظاهرة التي جاءت فزعة لحصار درعا وثأراً من المحافظ من الذي كان سيفرض حلماً لا يراه الناس إلا كابوساً، على نساء المدينة ورجالها، وعلى أرزاقهم، وعلى وسط المدينة الذي توالت فيه أجيال الأهالي.
أعلن عن فكرة مشروع حلم حمص في 2007 بشكل غير رسمي بعد تولي إياد غزال المحافظة بسنة واحدة، من خلال مقالات وتقارير عبر صحيفة العروبة المحلية وبقية الصحف السورية المعدودة، إضافة إلى موقع زمان الوصل. وقد شهد هذا المشروع صدى سيئا لدى الشارع الحمصي، بسبب ما تطرحه مشاريعه، ما جعل إياد غزال يقول: «المشكلة الأساسية أن المواطنين لم يفهموا المشروع بكل جوانبه»، إلى أن جاء الإعلان الرسمي عن المشروع في 2010 ليُفهم الحماصنة مرامي هذا المشروع، وإن ضمن جناح مخصص في معرض دمشق الدولي.
كان حلم حمص مؤرقاً حقيقياً للكثير من أهالي المدينة، بسبب البعض من مشاريعه، ومنها استملاك ما بقي من البساتين التي كان قد تم استملاكها سنة 1994 لإقامة «حديقة الشعب»، إضافة إلى طرح مشروع يتعلق بالبساتين الفاصلة بين حيي الغوطة والملعب مع حي الوعر لإقامة مشروع «جنة حمص»، وبناء مشروع برجي الغاردينيا ضمن هذه البساتين، وهو فعلياً المشروع الوحيد الذي بُدء به من ضمن سلسلة المشاريع المُعلن عنها. تم بناء البرجين على مساحة كبيرة من البساتين الخضراء تصل إلى 90 ألف متر مربع، رغم كل الوعود بأن الحلم يهدف للحفاظ على البساتين والحد من البناء ضمنها. يتضمن المشروع برجين، أحدهما من 28 طابق ليكون فندقا تحت اسم غاردينيا روتانا والثاني من 21 طابق لإقامة 45 شقة سكنية فاخرة ومول تجاري. والملفت أيضاً، خلال طرح مشروع بناء البرجين باعتبارهما أحد أكبر المشاريع العقارية والاستثمارية في سوريا، أنه موجه بشكل خاص للاستثمار وللمغتربين وليس لأهالي المدينة القاطنين فيها. بعد اندلاع الثورة السورية، تحول موقع هذين البرجين الذين لم يكتمل بناؤهما لأحد أهم معاقل القناصة، كونهما الأعلى في حمص وقريبين من مركز المدينة، ما يجعلهما يكشفان مساحات واسعة من أحياء حمص، ليحملا عند الأهالي اسم «أبراج الموت».

سلسلة من العنف البطيء التي شاهدها أهل حمص على مدار سنوات طويلة خلقت لديهم رد فعلٍ ضد المشروع الجديد، تحديداً من المتضررين بشكل مباشر منه، فخرج عدد كبير من أهالي البساتين التي تم استملاكها إلى دمشق لإقامة اعتصام سلمي أمام مبنى القصر الجمهوري للاعتراض على هدم وسط المدينة واستملاك بقية البساتين الواقعة على طرفي العاصي، كما هو مخطط في المشروع. كما خرجت مظاهرة شعبية ضد المشروع سنة 2008 في سوق الناعورة الواقع وسط المدينة والمشمول بالحلم، رافعين لافتات ضد الحلم، أبرزها لافتة تصف المشروع «بالسوليدير القطري» نسبة لشركة الديار القطرية المقترح تنفيذها للمشروع، والسوليدير الذي غير وسط بيروت بعد الحرب الأهلية في لبنان (مشروع تم انتقاده لأسباب عديدة منها تدمير مركز مدينة بيروت بعد الحرب باسم إعادة الإعمار).وها هو الحلم قادم ليغير وسط حمص.
نشرت العائلات المتضررة من المشروع حينها بياناً عرضوا فيه أهم اعتراضاتهم عليه، من حيث البطالة التي سيتسبب بها، وحول مشروع التغيير القادم لمركز المدينة، وحول الاستملاك الجديد للبساتين، مذكرين بالتجربة المريرة للاستملاك الذي جرى في الثمانينات في حي الأربعين:
إن حلماً مثيراً كحلم سيادته، يُوضع عادة من قبل الإدارات على اختلافها في شكل خطط خمسية قد تتجاوز الثلاث. ولا يُطرح مطلقاً بمنطق رجال الأعمال منفردين بحساباتهم التي لا تتعدى الأرباح والخسائر. من هنا كانت الكابوسية، كابوسية حلم سيادته لحمص.
المدن ما بين العنف البطيء والسريع
لقد استخدمنا في هذا المقال مصطلح «العنف البطيء» الذي تم اصطلاحه من قبل روب نيكسون، الباحث الأدبي والمناصر للبيئة من جامعة برينستون في كتابه حول الموضوع،Nixon, Rob. 2011. Slow violence and the environmentalism of the poor. Cambridge, Mass: Harvard University Press. حيث يقول:
هذا العنف الذي يُمارس تدريجيا وبعيدا عن الأنظار، له قوة تدميرية مؤجلة، ومشتتة على نطاق زماني ومكاني واسع. وهذا العنف المُنهِك للضحايا قد لا يدرك أحد عادة أنه نوع من العنف.
تراكمت جرعات العنف هذه في حمص. كانت متوالية، لكن في الوقت نفسه، أخذت وتيرة بطيئة على مدى سنوات عديدة. لم يكن العديد من أهالي حمص ممن لم يتضرروا من هذه المشاريع على دراية كافية بخطر هذه المشاريع. من كان يعلم بمجزرة الشجر إلا عندما استيقظنا يوما لنجد هذه الأشجار مرمية في الشوارع؟ من يعلم حتى يومنا هذا بالمعاناة التي عاش بها أهالي البساتين؟ ومن كان يتخيل ربط هذه الحوادث العنيفة بعضها ببعض لفهم المدى البعيد لهذا العنف البطيء على حمص؟ لقد تركت دراسات نيكسون الأثر الكبير على عدد من الباحثات والباحثين، مثل راتشيل بين، التي كتبت عن الصدمات العمرانية المزمنة (chronic urban trauma). وما يهمنا في فهمنا لحمص من منظور هذه الدراسات هو عامل «الزمن»: كيف خسرنا حمص؟ كيف تغيرت المدينة؟ وما هو تأثير العنف البطيء على خلق تروما جماعية عبر الزمن؟
تبدو لنا اليوم مخططات أحلام حمص وتجميلها قبل عام 2011 وكأنها مخططات لتجهيز المدينة لحرب مقبلة. تم تقسيم الأحياء بين طبقات المجتمع المختلفة، بين أحياء للفقراء وأخرى للأغنياء؛ وأحياء أخرى مقسمة على أساس طائفي. بدت حمص في كثير من الأحيان كمدن معزولة داخل المدينة الواحدة. وكان تسليح العمارة والتخطيط العمراني عامل قوة تدميرية مشتتة تعمل على الأمر بدأب، وفق نطاق زماني عبر العقود الماضية، وممتدة على جغرافيات عديدة فيها، كما كان الحال في البساتين الغربية، وفي المدينة القديمة وفي شوارع الغوطة والملعب.
عشنا في حمص قبل 2011، ونعرفها جيداً ونعرف أننا كنا نخسرها ببطء. لكن هذا البطء يبدو وكأنه تحضير للعنف السريع والشامل الذي شهدته حمص بعد 2011، العنف السريع الذي دمر كل شيء تقريباً، وأوقف زحف التدمير البطيء لينجزه بأسرع ما يمكن، تحضيراً لجولة عنف أخرى: يُعاد مشروع حلم حمص إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من التغاضي عنه وسط الكارثة التي تعيشها سوريا، وتعلن المحافظة أن مشروع حلم حمص لم يلغى، «إنما ستتم الاستفادة منه ببعض الدراسات والتعديل عليه من حيث الارتفاعات الطابقية بما ينسجم مع الواقع الموجود». ويبقى الخوف الأكبر اليوم هو أن يكون إحياء هذا المشروع ضمن سلسلة جديدة للعنف البطيء الذي يدمر ذاكرتنا، ويهجر مرة أخرى فقراء المدينة وأهلها الذين عانوا ويلات الحرب السريعة عليهم.
بالتأكيد ليست حمص المدينة الوحيدة التي تعرضت لموجات من التدمير. يتم تدمير العمارة والعمران في أنحاء العالم في أوقات «السلم»، كما هو الحال في تدمير معالم المسلمين في الصين، وبيوت الفقراء في مصر، ومدن كثيرة في العالم تتحطم باسم التطوير وتجميل المدن، لكنها تحمل في مضمونها أبعاداً سياسية واقتصادية لتهجير وتهميش مجموعات من الناس ينظر لهم بنظرة دونية وكأن لا مكان لهم في مدينتهم.
قد تكون المدينة القديمة مثالاً على تدمير ذاكرة حمص، وعلى رفض الماضي، وعلى مسح التراث وإعادة كتابة التاريخ. بيوت كثيرة في حمص القديمة كانت تتآكل كما في حي باب هود وباب التركمان وغيرها، وكان إرث حمص المادي المتمثل بالبيوت والقصور والشوارع والبساتين يتعرض للتهميش والإهمال المستمر. كانت النظرة للمدينة القديمة من قبل الكثيرين في المجال المعماري والمجتمعي نظرة ازدراء. يسألون ويسألن؛ لماذا الحفاظ على بيوت قديمة بدل بناء مدن حديثة في مكانها؟ هكذا كان الحال في عدد من المدن، كما كان الحال في بيروت عندما تم تدمير قسم كبير من مركزها باسم إعادة الاعمار، ما أدى لخلق نوستالجيا جماعية لمدينة تم مسح الكثير من تاريخها. ومن جانب آخر، هناك مدن كثيرة عبر العالم يتم الاحتفاظ بتاريخها العمراني والمعماري لسرد قصتها وحماية ذاكرتها.
لكن يمكننا أيضا التفكير في المدينة القديمة في حمص كمعيار لتغيير الآراء والمواقف من الماضي. كثير ممن يملكون ويملكن «النوايا الحسنة» لخلق مدينة حمص أفضل وأجمل قد ينادون بالهروب من ماضيها وتدمير مدينتها القديمة. كانت هذه الآراء، ومازالت، شائعة بين طلاب وطالبات الهندسة المعمارية، وهي بالطبع متأثرة بما يتم تلقينه لهم من الكادر التدريسي. من الاعتيادي في الكثير من مشاريع الطلاب اقتراح هدم مساحات كاملة من المباني، واقتراح مشاريع متخيلة تضم ناطحات سحاب ومشاريع منحنية تخلق يوتوبيا بعيدة عن هموم الناس ومآسيهم ونمط حياتهم في حمص. ولم يتغير هذا الحال حتى الآن للأسف. فكنا نرى في مراسم كلية العمارة تشجيع العديد من الكادر التدريسي على استيراد أفكار معمارية من كتب ومجلات عالمية كتقليد أعمى لهذه المشاريع بشكل سطحي، دون فهم وإمعان في السياقات والسرديات التي تحيط هذه المشاريع. أما عمارتنا، ومدننا وقرانا في سوريا، فلم تكن مطروحة في هذه المراسم و لم يكن هناك حثٌ على فهم واقعنا المعماري و العمراني. الماضي كان للنسيان فحسب، ولم يكن هناك تشجيع كافٍ للحفاظ عليه وحمايته، كما في حال المدينة القديمة في حمص.
الذاكرة بعد 2011
قبل 2011، شهدت حمص مقاومة شعبية محدودة للقرارات التي اتخذت بحق المدينة، مقتصرة بشكل كبير على من وقع عليه هذا العنف، وسط صمت الجمعيات التي تعنى بتاريخ المدينة وتراثها المادي والبيئي.
تغيرت الكثير من هذه الأمور اليوم. في أوقات الحروب والنزاعات، يصبح الماضي مكانا آمنا للهروب من ألم الواقع والخسارات المتتالية. وفي أوقات النزوح والتهجير، يتفجر الحنين ليس فقط للأماكن التي نزح منها الناس، أو أماكن تم تدميرها ومسحها بالكامل، بل أيضاً لأوقات لم يعد من الممكن العودة لها، للزمن الخالي. لذلك، نرى اليوم عدداً كبيراً من الفعاليات والمحاضرات وصفحات الأرشيف والتوثيق عن تاريخ سوريا وماضيها، وعن شوارع المدينة القديمة وعن بيوتها، وعن قصة وتاريخ حمص، وكأن هذا التاريخ والماضي أصبحا أكثر أهمية بعد خسارتهما. والآن، في وجه تدمير ذاكرة حمص، نقف أمام الخسارة التي عشناها بشكل شخصي وجماعي ومجتمعي، لنسأل عمّن يحمي الذاكرة، وهل هناك من يهتم بحمايتها، وما هي الأدوات والوسائل التي نستطيع اليوم العودة إليها لحماية ما تبقى من ذاكرة حمص، من ذاكرتنا؟
نلحظ اليوم ونحن في منافينا، من خلال متابعتنا لما يحدث في حمص، مقاومة شعبية كبيرة تتفاعل عبر وسائط التواصل الاجتماعي لأي حدث يتعلق بهذا الإرث المتداعي، وهنا نتحدث عن من بقي في حمص، الذين يقفون عند أي حدث ذي صلة ليطرحن ويطرحوا الآراء التي تعكس وعياً واضحاً تجاه هذا الإرث المتبقي رغم كل المعاناة، هذه الآراء التي لم تكن فاعلة قبلاً، وإن كانت فهمساً فقط. وهنا نتذكر ما حدث عند إعادة ترميم مسجد خالد بن الوليد، الذي شهد عاصفة انتقادات للطريقة التي أعيد بها ترميمه بها إذ اعتُبرت ماسحة لذاكرة المكان. وآخر هذه الاحتجاجات وأبرزها كان منذ أشهر قليلة فقط عند إزالة الساعة القديمة، إذ ظهرت عندها منشورات تتحدث عن هذا الرمز الملتصق بذاكرة الناس الجمعية، وبأن إزالة هذا الرمز الذي عمره مائة سنة يعني تداعياً إضافياً لهذه الذاكرة المتداعية أصلاً. هذه الاحتجاجات الإلكترونية شهدت لأول مرة رداً دفاعياً من قبل مجلس المدينة، للتبرير بأن الإزالة هي لإعادة ترميم الساعة والدوار الذي تنتصب وسطه، لكن حتى اللحظة لم يرمم أي شيء من ذلك.
قد يُبنى على هذه المقاومة التي نشهدها الآن من أهالي حمص في الداخل، والتي تتعلق بذاكرة المدينة لاحقاً، كون صوتهم -على الأقل فيما يتعلق بإرث وهوية المدينة- أصبح عالياً وليس خجولاً أو هامساً كما كان قبل 2011. أهالي حمص هم وحدهم حراس الذاكرة القادرون على حفظ إرثنا وتاريخنا. ونحن من نعيش في المنافي والمهاجر، نكتب وإن من بعيد، لنحمي ذاكرة مدينتنا حمص.







