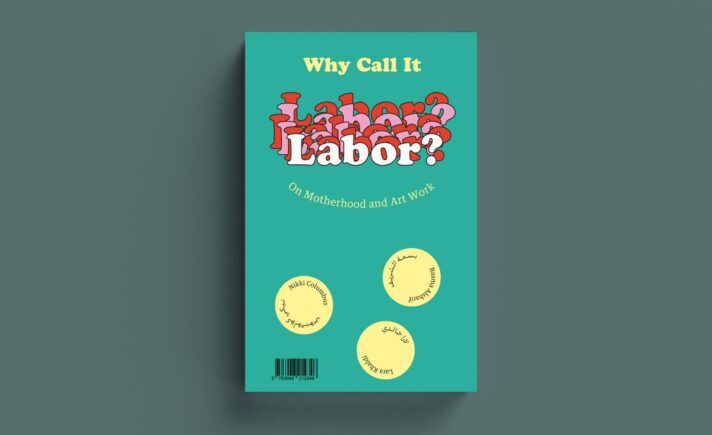خلال العقد الماضي أُنتج الكثير من الأعمال السينمائية الوثائقية التي حاولت أن توثق أجزاءاً وجوانب من الحرب السورية وتجلياتها سواء في مناطق المعارك أو جوانب من الحياة في المخيمات ورحلات اللجوء. في حين أن عدداً قليلاً من الأفلام السينمائية الوثائقية السورية تمكن من توجيه العدسة نحو مواضيع أكثر حميمية وفردية، أقرب إلى حروب صغيرة تحدث على هامش الحدث الأكبر والحرب العمياء. انشغلت هذه الأفلام بسؤال كيف نعيش في ظل الكارثة؟ كيف هي أحوال الأفراد والعائلات والعلاقات الإنسانية والعاطفية عندما تكون الحرب مشتعلة في الخارج؟
الفيلم الوثائقي قفص السكر (2019) لمخرجته زينة القهوجي، هو واحد من هذه الأفلام الوثائقية التي عادت إلى العائلة والبيت، لا لتوثق الحرب بل حياة الأفراد والعلاقات العاطفية والعائلية في ظلها. جذب فيلم قفص السكر انتباه الجمهور السوري والعربي عندما عُرض في مهرجان الإسماعلية في مصر وحصد جائزة أفضل فيلم تسجيلي، وعرض مؤخراً في الخرطوم ضمن إطار ملتقى مينا وعلى منصات افتراضية عديدة مثل منصة أفلامنا التي استضافت الفيلم في شهر حزيران الماضي.
نتعرف في الفيلم على كوبل سوري، إلهام ووليد القهوجي، في آواخر الستينات من العمر، متزوجان منذ سنوات طويلة، يعيشان في ضاحية قدسيا القريبة من دمشق، لا يقدم الفيلم معلومات كثيرة عن ماضي الشخصيات عدا عن أداء الزوج للخدمة العسكرية في السبعينات، بينما يرصد الفيلم في معظمه الحياة اليومية للزوجين خلال 8 سنوات من الحرب، وذلك من خلال عيون ابنتهما زينة وعدسة كاميراتها.
المخرجة والمصورّة زينة قهوجي، التي أتمت في عام 2017 درجة الماجستير في الإخراج الوثائقي ضمن إطار برنامج دوك نومادس (DocNomads) الأوروبي المشترك. قررت في فيلمها الأول أن تعود إلى مواد تسجيلية مصورة منذ عام 2012، في البيت ومع والديها، صورتها أولاً لغرض شخصي، وهو الاحتفاظ بفيديوهات منزلية بيتية عن هذه المرحلة، في ملف شخصي عائلي قبل أن تصبح مادة فيلمية معروضة على الشاشات العامّة.
لن نرى المخرجة/الابنة أمام عدسة الكاميرا طوال مدة الفيلم، على الرغم من أن العلاقة بينها وبين والديها، هي مصدر الحكاية ونهايتها في الفيلم. حيث أن الابنة زينة هي التي قررت أن تبدأ بتسجيل هذه المشاهد والاحتفاظ بهذه الذاكرة العائلية. لكنها أصبحت مخرجة العمل وصانعة الفيلم، وذلك عندما قررت أن تأخذ خطوة للوراء، كمتفرجة على علاقة الحب بين والدتها ووالدها، على شجاراتهما الصغيرة، موثقةً حياتهما، وفي الوقت ذاته هي متفرجّة أيضاً على حياتها معهم في هذا البيت. هذا التبدل في المواقع، بين المنغمس في الحياة اليومية والمتفرج عليها بعد انقضاء مدة من الزمن، يجعل من هذا الفيلم وثيقة شخصية لعائلة ولابنة، لكنه أيضاً يحاكي عاطفة ومشاعر شريحة واسعة من السوريين والسوريات، ممن يمكن أن يجدوا في الفيلم انعكاساً لعلاقة مضطربة مع البيت والزمن بسبب الحرب والشتات.
ليسوا أهلنا لكنهم…
يولد الفيلم دوامة من المشاعر المختلطة قد تصعب مقاومتها، مزيج من الحنين والغضب والحزن والبهجة أحياناً. وذلك، ربما لأنه من المحتمل جداً أن يكون المتفرجون-ات، قد عاشوا تجربة مشابهة لتجربة قهوجي، أو تجمعهم العديد من التقاطعات بين حياتهم خلال سنوات الحرب العنيفة وبين حياة الشخصيات في الفيلم، مما يمّكن المتفرجين-ات من وضع أنفسهم مكان الابنة، أو مكان الزوجة أو الزوج. بالإضافة لأن العودة إلى العائلة، إلى البذرة الأولى لتشكل الفرد، وإلى العلاقة مع الآباء والأمهات، هي من أكثر الأوتار حساسية وربما نقطة الضعف الأكثر هشاشة، التي استهدفتها الحرب وظروف الشتات.
هي هذا السياق، نجد أن الفيلم هو تكثيف خاص وحميمي لذاكرة عائلة قهوجي، لكنه أيضاً يلامس شريحتين واسعتين من العائلات السورية، سواء من جهة العائلات التي توزّعت بناتها وأبنائها في الشتات، في حين بقي الأهل المسنون وحيدين في سوريا. أو العائلات التي قرر الأولاد فيها البقاء بجانب الأهل في سوريا، وصارت علاقتهم العائلية تحت المجهر بسبب ثقل أيام الحرب وإيقاعها شديد البطء. وفي كلا الشريحتين، يقع على عاتق الأبناء والبنات المسؤولية الأكبر في تحديد مصير العائلات ومصير الآباء، وذلك لأن مصير الآباء متعلق بشكل أساسي بقرار أبنائهم وبناتهم بالبقاء أو الهجرة. أما السؤالان الذين يبدو لنا أن الفيلم يحوم حولهما منذ بدايته حتى نهايته، هما: ماذا نفعل بكل هذا الحب المنبعث من آبائنا؟ وكيف سيكون شكل حياتنا وحياتهم عندما ننفصل عن هذا الحب؟
توثيق الملل
الفيلم داخلي معتم، داخلي لأن الطائرات العسكرية تحوم في الخارج والقصف والقذائف محتملة في أي لحظة، ومعتم لأن التيار الكهربائي مقطوع أغلب الوقت والإضاءة الوحيدة المستخدمة هي إضاءة اللد الأزرق أو إضاءة النهار في مشاهد معينة. أما الخارج، فهو لقطات حدودية بين العالم الخاص الحميمي والخارج الخطر و البارد والجاف من خلال نافذة البيت أو شرفته.
أما الأصوات التي نسمعها، هي أصوات القصف والطيران أو الصوت المنبعث من الراديو، الراديو الذي يعمل على البطارية غالباً، ومؤنس ليالي الحرب الطويلة. لن نسمع في الفيلم حوارات طويلة بين الشخصيات أو نقاشات محتدمة سوى تلك التي يتشاجران فيها على موقع البيت الذي اختاره الزوج وعلى الغسالة التي أجلت الزوجة تصليحها.
لا يتضمن الفيلم أي مشاهد يتوجه فيها أبطال الفيلم إلى الكاميرا ليصرحوا عن موقف أو رأي ما، وعندما ينظرون إلى الكاميرا فهم ينظرون إلى ابنتهم زينة، أحياناً يتوجهون إليها بالأسئلة، أسئلة عن الفيديوهات التي تصورها وأحاديث عابرة. لا شيء كثير يحدث في الفيلم، الحياة تمر أمام عدسة الكاميرا والزمن شبه متوقف. وقد يعتقد المشاهد/ة أنه لا يوجد فعلاً حدث درامي منتظر سيغير مسار الأحداث. كذلك هي الحياة هناك، أشياء كثيرة وعنيفة تحدث في سوريا، وأعنفها تلك الأحداث غير المرئية، فمنها ما يكون مؤلماً أكثر من القدرة على وصفه، أومرعباً لدرجة لا يمكن التعقيب عليه. وهكذا يبتلع الصمت تدريجياً القدرة على الكلام عما يدور في النفس، وينقضي العمر انتظاراً لاحتمالات قد لا تحدث.
أهلية بمحلية
يتمثل أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا الفيلم في الارتهان للإيقاع البطيء للحياة اليومية لشخصياته، فلم يصطنع الفيلم إيقاعاً سينمائياً، لم يستعجل حدوث مواقف معينة، وخصص الوقت الكافي والمريح لشخصيات الفيلم، لأن تنشغل بحياتها الخاصة، وتستغرق بظروف حياتها مثل تدبير الماء والمازوت والكهرباء.
يسير إيقاع الفيلم كأنه ليس لدى شخصياته ما تستعرضه أمام الكاميرا، لا قصة درامية تجذب الجمهور إليها، ولا معاناة استثنائية تختلف كثيراً عما يعيشه بقية السوريون والسوريات. وكأن الكاميرا ومن ورائها الابنة ومن ورائها الجمهور، صاروا يعرفون الكثير عن واقع الحرب السورية، لا يوجد هم أكبر من هم الحرب، وكأنه لم يعد يوجد ضرورة تستدعي شرح هذا الحدث. تمكن الفيلم ببراعة من التقاط حالة الهدوء في استيعاب الألم الناجم عن تدهور الظروف المعيشية القاسية، ومقاومة الحرب من خلال احتضان أفراد العائلة قبل رحيلهم أو هجرتهم، هذه هي أكثر المشاعر قسوةً والتي يمكن أن تختبرها شخصيات الفيلم أو تخفيها، لكن أولئك الأفراد لا يترددون أبداً في إظهار مشاعر وسلوكيات الحب بينهم.
على الرغم من التقنيات المتواضعة المستخدمة في تصوير الفيلم الوثائقي، ولكنّه يقترح جماليات جديدة قد لا تكون مرتبطة بالمشهدية وحرفية التصوير. فنحن أمام كاميرا ترتجف من حين لآخر، والعتمة تطغى على أغلب مشاهد الفيلم وتبتلع تفاصيل منها، لكن هذه الجماليات المقترحة نابعة من اختيار العودة إلى حضن العائلة في زمن الشتات، استعادة الصورة المحلية وتفاصيل حياة كوبل سوري مسن في سوريا، وصدق وطزاجة عواطف الحب والاهتمام بينهما، وعفويتهما ودهشتهما أمام كاميرا الابنة ورغبتهما الجارفة باحتضانها حتى ولو ساعة أخرى.