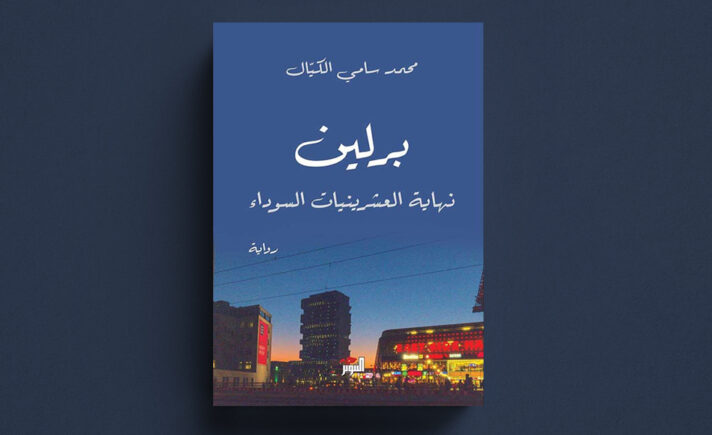عاش الإنسان العاقل ملايين السنين ككائن بيولوجي محكوم بغريزته، مثل بقية الحيوانات، إلى أن قامت الثورة الذهنية، منذ 70,000 سنة ق.م فاتحة باب الصراع بين البيولوجيا والتاريخ. ولو عدنا إلى البدايات الأولى لوجدنا أن الثقافة هي دماغ الإنسان لا عضلاته، أصابعُه لا مخالبه أو أنيابه. كان، قبل أكثر من ثلاثة ملايينالعاقل، تاريخ مختصر للنوع البشري، بوفال نوح هراري، ت: حسين العبري وصالح بن علي الفلاحي، دار متجول للنشر، ص: 13، نسخة الكترونية. سنة، وحشاً يصطاد الطرائد ويلتقط الثمار والجذور، ثم يأوي إلى مغارته خوفاً من الوحوش الأخرى، تقوده غريزة البقاء، وكان جهده العضلي، على الرغم من ضعفه، يلبي حاجاته الأساسية، المأكل والمشرب والتكاثر. وقد تمكن من العيش بين وحوش أقوى منه، لكنه انتصر عليها وروّض بعضها، بسبب تكوينه الخاص وقشرة مخه المتطورة جداً؛ ما سمح باستقامة جسده واستخدام يديه، وساعده، بالتالي، على التجريب باستخدام أصابعه وتطوير مهاراته واستمراره في العيش والبقاء.راجع كتاب أصل العائلة لفردريك إنجلز.
ومنذ 12,000 سنة ق.م،العاقل، مصدر سابق. شكّل خروج الإنسان العاقل من الكهف إلى سطح الأرض -إبان الثورة الزراعية- نقلة نوعية جديدة في تحديد مساره ومصيره، فكان بناء البيت، أول شهقة للحرية، فتحت الآفاق أمامه وجعلته في اشتباك مباشر مع الطبيعة وأسئلتها وتحدياتها..
أردت القول إن الجهد العضلي «الفيزيولوجي» رافق الإنسان البدائي مدة تزيد عن مليوني سنة، إلى أن بدأ التاريخ، مع الثورة الذهنية التي أخرجت البشر من نفق الغريزة إلى نور العقل.
ثمة من يقول اليوم إن المثقفين لا قيمة فعلية لهم في مجتمعاتنا المتخلفة التابعة، وإن دورهم تابع أيضاً، وثانوي. لكن الثقافة نشاط أساسي في حياتنا، موجودة ومتجذرة في التجمعات البشرية كلها. إنها قيمة بحد ذاتها، مثلها مثل العلم (وإن كانت تختلف عنه بالوظيفة أو الدور أو الوسائل). فهي تستأثر بمجال آخر من حياتنا، هو العاطفة والخيال والحلم والواقع البديل المُتصوَّر، أو المُؤلَّف. تضرب قوانين العلم عرض الحائطِ، فتستبدل العقل بالوجدان، وتستعيض عن التجربة العلمية بالتجريب الإبداعي، وتزيّن الصورة بالمحاكاة، وتعمل على خلق، أو إعادة إنتاج الواقع الراهن، بواقع جديد أو بديل، يكون أكثر جمالاً وكمالاً وعدلاً وإنسانية.
لقد اعتبر الفلاسفةُ الثقافةَ الذروة الروحية للفكر، لأنها شوق البشرية الأبدي للحرية والجمال والتغيير. وهي، قبل ذلك، جهد بشري لا يمارسه إلا العقلاء. ولولا الثقافة لانقرض الإنسان أو بقي في كهفه إلى يومنا هذا. فالإنسان لا يكتفي بتلبية حاجاته المادية (الأيض والتناسل)، بل يعمل -جاهداً- على تلبية حاجاته الروحية أيضاً، لأنه، كما ذكر أرنست فيشر في كتابه ضرورة الفن «يريد أن يكون أكثر اكتمالاً من بقية الحيوانات»،أرنست فيشر. ضرورة الفن.. ترجمة: أسعد حليم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص:27 أي أكثر انسجاماً مع ذاته وقدراته، وأكثر فهماً لمحيطه. إنه الوحيد المدعو والقادر على فهم الطبيعة والسيطرة عليها. لذلك، فالعلاقة الإشكالية، أو الجدلية بين السلطة والمثقف، عملية أزلية عرفتها الجماعة البشرية عندما بدأت تستبدل انتماءها الغريزي للأب والجماعة بانتمائها للعقل والتفكير. هذه العملية المعرفية العظيمة استغرقت من عمر البشرية آلاف السنين، وقد أنجزت ورسخت القيم العليا، العلمية والمعرفية والفلسفية والأخلاقية التي يعرفها الجنس البشري، والتي تُعتبر الآن جوهر الثقافة وموضوعها ومادتها الأساسية. ولولا تمرد الإنسان على الكهف وعلى الانتماء الغريزي للقطيع، واستبداله بالانتماء إلى العقل والتفكير والخيال، لما قامت حضارة أو ثقافة أو معرفة.
ثم إن الحديث عن علاقة الثقافة بالسلطة، لم ينته مع سقراط أو سبينوزا أو أنطونيو غرامشي أو ميخائيل باختين أو عبد الرحمن الكواكبي أو إدوارد سعيد، أو غيرهم من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين، فقد شغلت هذه العلاقة العقول جيلاً بعد جيل، وفي كل زمان ومكان. وما زال الجدل قائماً ومقيماً، بين الجهد العضلي والجهد الذهني (الكلمة والسيف)، لما تحمله هذه العلاقة من وشائج وارتباطات بنيوية مع حياة الناس وأفكارهم وفلسفتهم للحياة والوجود والمستقبل. ولا بد من التأكيد على أن الصراع بين الثقافة والسلطة ليس محض سوءِ فهم أو سوء إدارة وتنظيم، ولا صراع بشري/ اقتصادي على الزعامة أو فتات الثروة والجاه فحسب؛ بل هو، أولاً وقبل أي شيء، توق أزلي إلى حياة أفضل وصراع أساسي موضوعي، هدفه تحرير البشرية من ربقة الظلم والعبودية، بأشكالها المختلفة، والدفاع عن قيم وحقوق الإنسان الفردية والجماعية، الأصيلة والمكتسبة، التي أنجزتها البشرية عبر تاريخها (حق الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة…الخ. إنه شوق البشرية إلى الحرية والسعادة.
وقد مارست الجماعات البشرية هذا الجهد الذهني كي تجاوب على الأسئلة الوجودية التي واجهتها ووقفت عاجزة عن تفسيرها، وكان التفكير فيها والجواب عليها يُبتكر بواسطة الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة (الفلاسفة الأوائل)، الذين كانوا يمارسون مهنة المعرفة أو الثقافة. وقد حاولوا تفسير تلك الظواهر والتعبير عنها بشكل بدائي خيالي. ومع تطور المجتمعات ونضجها، بدأت هذه المهن الذهنية تمارَس بواسطة الدين ثم الفنون التي اخترعها الإنسان ليعبّر بواسطتها عن هواجسه وتطلعاته. هنا تجسدت فكرة الحرية وضرورتها (حرية الرأي والتفكير والخيال والتعبير..). وبدأ الأمر يصبح أكثر تعقيداً عندما نشأت حاجة السلطة إلى ترويض أصحاب تلك المهارات والمهن، وتسخير طاقاتهم لخدمة السلطة السياسية. فسلطة الدين، حتى في العصر الوثني، كانت سلطة روحية، أي ثقافية، وتحولت إلى سلطة مادية، عندما بدأت تمارس السياسة، فاستخدمت الملوكَ، كما استخدموها، وامتلكت الجيوش والسجون وشنت الحروب الدينية وأقامت محاكم التفتيش والتكفير..
إن مغامرة العقل الأولى، في مجال الثقافة، كانت عن طريق التأمل والتخيّل والتفكّر. فالإنسان العاقل، وهو يحاول أن يفسر معنى الأشياء الغامضة، العصية على فهمه، كالحياة والموت والولادة والمرض والسماء والبحر والبركان والريح…الخ، حاول فهم هذا الواقع الغريب بواسطة الخيال، والإجابة على أسئلته، مَرةً بالسحر والشعوذة والخرافات، ومرة باختراع الأديان والأساطير الكونية، ومرة أخرى بواسطة الفن والفكر والفلسفة. ومن تلك المحاولات الأولى تمخضّت الثقافة وتطورت عبر الزمن، فهي بطبعها تميل إلى التجاوز والتراكم والحركة، بينما تعمل السلطة جاهدة على تأبيد الواقع وتثبيته. وما أسطورة برومثيوس (النار) وسيزيف (الإرادة) وإيكاروس (الحرية)، إلا أمثلة لهذا الصراع الأزلي بين (كبير الآلهة) والإنسان. وإذا كان هذا التأبيد والاستقرار، الذي يحافظ على الاستمرار، صفة أصيلة من صفات السلطة (أي سلطة)، وإذا كانت تميل بطبيعتها، إلى وقف عجلة التاريخ، فالاستبداد يشكل خطراً داهماً، وتهديداً حقيقياً للثقافة، واعتداء معنوياً ومادياً صارخاً على الحرية وحقوق الناس وقيمهم الروحية والأخلاقية المتجذرة. إنها محاولة بائسة لعودة الناس والمجتمعات إلى العصر الرعوي.
وإذا كانت السلطة، بحاجة ماسة للثقافة كي تتأبد بواسطها؛ فالثقافة بحاجة للسلطة كي تقوّض السائد وتتجاوزه. وإذا كانت العلاقة بينهما جدلية تشاركية، حيث يتحالفان ويتصارعان في آن واحد، فالاستبداد يُعتبر عدواً تاريخياً للثقافة الحقيقية، الوطنية والإنسانية، يعمل جاهداً على إقصائها وتدجينها، أو طمسها واستبدالها بثقافة مزيفة تافهة خاصة به، تابعة له وحده، تقوم بترويج سياسته وحماية سلطته. وهو، بذلك، يشن حرباً مستمرة على المثقفين الحقيقيين، ويحاول بطرق خبيثة تحييد وتحريف دورهم ووظيفتهم التاريخية في «البحث عن الحكمة»، وحرمانهم من المساهمة بتحرير وتطوير الطاقات الإبداعية للأجيال القادمة، وصياغة وعي وروح المجتمعات التي ينتمي إليها المثقف، وعرقلة حياتها الطبيعية.
وإذا كان الاستبداد نهجاً سياسياً ذا صفات محددة، فماذا نقول عن نظام حكم جاهل لا أخلاقي، قاتل، يحشر الثقافة والفكر والفن داخل حذاء عسكري، وأي وصف سياسي عقلاني رصين، يمكن أن ينطبق عليه؟
إن ما كتبه إدوارد سعيد، وغيره من المفكرين والباحثين عن علاقة المثقف بالسلطة، لم يعد مناسباً للسوريين ولا اللبنانيين ولا العراقيين.. فهو يتحدث عن السلطة بمعنى الدولة ومؤسساتها، وليس سلطة قطاع الطرق والميليشيات الطائفية والعصابات الحاكمة. إن غياب الدولة يعني غياب السلطة وكسر الجسر الواصل بينهما، علماً أن الثقافة قد تضمر وتمرض وتنحطّ، لكنها لا يمكن أن تموت، كما تموت السلطة.
تعمل سلطة الاستبداد والقهر جاهدة على إعادة الولاء الغريزي لها، كما أن المجتمعات المتخلفة والمقموعة تتحدث كثيراً عن الثقافة لكنها لا تنتجها. وهي، بعد محو أمّيتِها، تكتشف فجأة أهمية الثقافة ودورها، وتدرك متأخرة أن الشعوب والأوطان تتمايز بثقافاتها: آدابها وفنونها وتراثها وفكرها ولباسها وعمارتها وكتبها ومتاحفها.. أي أن ثقافتها تصبح هويتَها، روحها. وسرعان ما تكتشف أيضاً، أن المثقفين قد يتحولون (حتى بعد موتهم) إلى رايات لشعوبهم، وسفراءَ لبلدانهم وحضارتهم التي شاركوا في صنعها ونشرها.. فألمانيا هي هيغل وماركس وغوته، وبريطانيا هي شكسبير وديكنز وشابلن، وفرنسا هي موليير وفولتير وبلزاك وسارتر، وروسيا هي بوشكين وتشايكوفسكي وتولستوي وبافلوف.. وحتى الفراعنة والإغريق عرفناهم، عن طريق ما تركوه لنا من أساطير وملاحم وفلسفة وعلوم وآثار لفن العمارة والنحت. مئات الآلاف من المثقفين في العالم تحولوا، عبر الأجيال، إلى رايات ومشاعل لشعوبهم وللثقافة الإنسانية. ومن بينهم طبعاً، كتاب وفلاسفة الحضارة العربية والإسلامية الذين قتل جلّهم بتهمة العقل أو الكفر أو الزندقة.
من المؤسف أن كلمة «مثقف» لم تكن موجودة عند العرب. كانت تعني: الأديب. والمثقف: هو المتأدّب، ولذلك قالوا: «إنّ المتأدّبَ هو من يعرف شيئاً عن كلِ شيء، ويعرفُ كلَّ شيءٍ عن شيء». والمتأدب مأخوذة عن مصدرها (الأدب): أي «الأخذُ من كل علمٍ بطرفٍ». أما بالنسبة للمعنى اللغوي لكلمة ثقافة فهي مشتقة من فعل: ثَقُفَ، ومعناها، كما ورد في القواميس: «حَذَق وفَطِن وسوّى وحسّن». والثِّقَاف: ما تسوّى به الرماح. وتثقيفها: تسويتها وتشذيبها. وثَقِفه: صادفه، وتأتي بمعنى طعنه بالرمح، والثَّقاف: العمل بالسيف. ثم تطور معنى كلمة مثقف وصارت تعني، أغلب الناس المتعلمين الحاصلين على شهادات بالعلوم الإنسانية، المهتمين بالفكر والفن والبحث والكتابة..
أما في الغرب، فكان القدماء يحصرون كلمة مثقف (intellectual) بالجهد الذهني أو العقلي أو الفكري، بمعزل عن العواطف والمشاعر والأحاسيس. لكن تلك الكلمة تطورت لديهم أيضاً، وصار معناها يشمل ليس العقل وحده، إنما العاطفة والخيال وحتى الذوق والجمال. ومن كلمة intellectual أتت كلمة إنتلجنسيا (intelligentsia) التي ترجمها العرب للدلالة على جماعة المثقفين بعامة. وهم: كل الأشخاص المتعلمين الذين يؤهلهم علمهم ليقوموا بأعمال ذهنية مفيدة للناس، وتصبح الثقافة مهنتهم واختصاصهم.
بعض الباحثين والنقاد الغربيين قدّر دور المثقفين واعتبره جوهرياً في حياة المجتمعات، ومنهم الباحث والكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، الذي بيّن في كتابه المثقف والسلطة دور المثقف ووظيفته. وركز على ضرورة أن يمتلك المثقف وعياً نقدياً لتفسير الواقع. وحصر صفة المفكر بالكتّاب والفلاسفة الكبار وحدهم. وبعضهم هاجم المثقّفين هجوماً عنيفاً، مثل جوليان بندا في كتابه خيانة المثقفين والذي استأنس عنوانه -على ما يبدو- بوصف لينين الشهير للمثقفين: «أقرب الناس الى الخيانة هم المثقفون، لأنهم الأقدر على تبريرها».. وإذا كان لينين قال ذلك انطلاقاً من احترامه للطبقة العاملة، والجهد العضلي بعامة؛ فغرامشي سعى لتحقيق الهيمنة الثقافية للطبقة العاملة، وللكتلة التاريخية الجديدة (البروليتاريا) التي ستهزم الكتلة التاريخية القديمة (البرجوازية). والمقصود بالكتلة التاريخية الجديدة هنا: العمال والفلاحين، بالإضافة إلى المثقفين العضويين، القادرين على إقامة مشروع إصلاح ثقافي وأخلاقي، ولديهم إرادة الانتصار على البرجوازية والإقطاع والمثقفين التقليديين، أصحاب المشروع الفكري المحافظ، والإيديولوجيا السياسية اليمينية المرتبطة بالكنيسة والإقطاع. وثمة نقاد رأوا أيضاً أن كل إنسان يستطيع أن يكون مثقفاً، إذا كان لديه القليل من الإدراك والوعي الشعبي أو السياسي. حتى أن بعض المتحمسين، ومنهم غرامشي (صاحب نظرية المثقف العضوي) الذي عوّم مفهوم المثقف ليشمل كل من يفكر، سواء كان متعلماً أم لا. وهكذا يتساوى لديه الجميع، ويصبح من حق كل إنسان أن نطلق عليه اسم: مثقف.
هذا المفكر الشيوعي المعروف عاش في زمن الفاشية الإيطالية 46 سنة فقط، قضى أكثر من 20 سنة منها في سجون الفاشية. وهناك كتب دفاتر السجن التي ضمّت أهم بحوثه ودراساته. يقول في حديثه عن المثقف العضوي إنه المرتبط بالجماهير، أو «المثقف الملتحم بشكل حقيقي بالشارع والطبقة العاملة»، وإنه يجب عليه أن يكون عقل الطبقة العاملة المفكر، وقلبها النابض. هذه الطريقة الجريئة في التفكير سببت له مشاكل كبيرة مع رفاقه في الحزب الشيوعي الإيطالي، الذين حاربوه ومنعوا نصوصه لمدة ثلاثين سنة تقريباً.
قسّم غرامشي المثقفين إلى قسمين: مثقفون تقليديون. وهم أولئك الذين لا تتغير لديهم وظيفة التّفكير، وهم يكررون أنفسهم كل يوم وكل سنة وكل جيل. أي أن وظيفة التّفكير لديهم غير قابلة للتجديد؛ ومثقفون عضويّون تقع عليهم المسؤولية الكاملة لتحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته. وهؤلاء من يمكن أن نطلق عليهم اسم النخبة أو الصفوة.
قد يكون صحيحاً ما كتبه غرامشي في دفاتر السجن: «جميع الناس مفكرون»، من منطلق إمكانية أن يكونوا كذلك، أو لأنه يعتبر الثقافة عملاً جماهيرياً نضالياً. لكنه أضاف أيضاً: «ولكن وظيفة المثقف أو المفكّر في المجتمع لا يقوم بها كلّ النّاس». وهذا أيضاً صحيح. فمن غير المعقول أن يمارس الناس جميعاً وظيفة المثقف.
يمكننا طبعاً أن نعتبر الثقافة مجالاً عاماً، يستطيع كل إنسان أن يكون منخرطاً فيه، ويمكننا أن نعتبره مجالاً خاصاً فردياً مستقلاً عن المجتمع، ومتفاعلاً معه في آن واحد. وتكون الثقافة في هذه الحالة مهنة وليس حرفة. وبالتالي يكون المثقف قادراً على إنتاج الفن والفكر والمعرفة، ويستطيع عامة الناس أن يتفاعلوا مع هذا الإنتاج، ويستمتعوا به ويستفيدوا منه، لكن البعض، ومنهم ميشيل فوكو، يرى أن المثقف هو من يجسد ضمير البشرية، ويحرك وعيها، ويهدي المجتمع إلى الحقيقة، ويدافع عنها ويحميها ويبشر بها. وهو كذلك من يترفع عن صغائر الدنيا ولا يبيع نفسه وثقافته بالمال أو بالجاه.. أي أنه مثقف شمولي مُكافح من أجل التغيير. كما يرى ذلك أيضاً جان بول سارتر، الذي كان نموذجاً للمثقف الشمولي، والذي دعا إلى الالتزام. وصار مفهوم «المثقف الملتزم» مع بداية خمسينات القرن الماضي، موضة العصر، وقد سبقهم لينين بعقود عندما طرح مفهوم «الأدب الحزبي والفن الحزبي» الذي تم تكريسه عبر منهج الواقعية الاشتراكية. أما كارل ماركس، أستاذ الكل، فاعتبر المثقف «ناقداً اجتماعياً» مهمته التعبير عن ضمير المجتمع، بالبحث عن الحقيقة وتحمّل مسؤوليتها والدفاع عنها مهما كان الثمن. لكن النتائج كلها كانت كارثية، فالثقافة الحزبية تحولت إلى شعارات حزبية طنّانة براقة، وأصبح الأدب الملتزم مليئاً بالالتزام وخالياً من الأدب. وصارت الثقافة في الدول الشمولية، وبخاصة الاشتراكية، هي الالتزام بالسلطة السياسية والأمين العام للحزب. وصار تقييم الثقافة والمثقفين لا يقاس بمقياس الإبداع والنقد المهني، إنما بمقياس بُعد المثقف أو قربه من السلطة ورضاها عنه، فكلما كنتَ أكثر طاعة صرتَ أكثر إبداعاً. واللافت أن نموذج الواقعية الاشتراكية تم تبنيه من قبل أحزاب وأنظمة حركة التحرر الوطني، تلك التي استولت على السلطة بانقلابات عسكرية، أو بيعَة عرش. ففي سورية، وهذا ما يهمنا، استولى البعث على السلطة بانقلاب عسكري، سمّوه ثورة، لكن سرعان ما تحولت فيه سلطة الحزب القائد إلى سلطة الأب القائد وأجهزته الأمنية والعسكرية، وسرعان ما أطلق على البلاد اسم: مملكة الصمت والخوف. والثقافة، كما تعلمون، كانت وستبقى مملكة الكلام والشجاعة والنقد الرصين.
كثيرة هي التصنيفات والآراء المختلفة حول المثقفين وأدوارهم وأنواعهم، لكننا سنتحدث عن نوعين من المثقفين السوريين، هما: الموالون للسلطة، الخاضعون لها، المستفيدون منها؛ والمعارضون للسلطة، الرافضون لها، والمنتجون للثقافة الحقيقة، بما تحمله من قيم وطنية وإنسانية. هذا التقسيم، المدرسي ربما، سيكون أكثر ملاءمة ومحاكاة للواقع الراهن السوري الذي فُرض علينا، ليس في مجال الحياة الثقافية وحدها، بل في مجالات الحياة كلها، الوطنية والإنسانية والأخلاقية. وهذا يقودنا إلى مسألة جوهرية، هي أن الاستبداد ليس سلطة سياسية وحسب، بل هو سلطات متشابكة مهيمنة متخلّفة، لا عقلانية، تحتاج إلى مقاربة مختلفة لعلاقة الثقافة، ليس بسلطة المستبد وحده، بل بالسلطة الاجتماعية والدينية والعشائرية، وسلطة رأس المال وسلطة الأحزاب والعقائد والأخلاق والقيم، التي يمكن توظيفها لتلعب دوراً خطيراً، في ظل الاستبداد. فالسلطة، كما ورد عند ميشيل فوكو «لا تكمن في تنظيم سياسي أو منظومة أعراف وتقاليد اجتماعية محددة، أو في أجهزة الدولة فحسب، بل تتشعب وتتغلغل في جسد المجتمع كله»: علاقة الأب بأبنائه سلطة. وكذلك علاقة الرجل بالمرأة والشيخ بمريديه والأستاذ بتلاميذه والمدير بموظفيه والضابط بجنوده والقوي بالضعيف والكبير بالصغير والغني بالفقير وهكذا. لذلك، دعونا نحاول معرفة من هو المثقف الحقيقي في بلدنا وعصرنا: صاحب المهنة الذهنية؟ أم الذي يعمل على إزعاج السلطة ونقدها؟ منتج الثقافة أم مستهلكها؟ الموسوعي المحترف أم الهاوي؟ المستقل، المتحزّب، التقدمي الرجعي، الثوري، الطليعي، التقليدي، بوق السلطة، بوق الجماهير، الانتهازي الأنانيّ، أم الغيور الذي يهتم بالبشرية كلها، المثقف الوطني (المحلي) أم المثقف العالمي؟ وما هو دور الثقافة ووظيفتها أخيراً؟ وهل لها وظيفة أصلاً؟
المثقفون في بلادنا ينقسمون، كما أرى، إلى ثلاثة أقسام أساسية، تحددها علاقة المثقف بالسلطة والثقافة: بعض المثقفين يمكن أن نعتبره نخبوياً مثالياً، يمارس الثقافة من أجل الثقافة وحدها. وقد يكون هذا البعض ممتلئاً بالثقافة والمعرفة، دقيقاً بعمله، عميقاً ومحترفاً مهنياً. وقد يكون ميالاً للاستقلال عن السلطة أيا كانت، سياسية أو أيديولوجية أو حزبية أو دينية، وقد يكون محباً للبحث العلمي والمعرفة والكشف والدفاع عن القضايا الثقافية والإنسانية. لكنه في الواقع، عاشق لشخصه، مفتون بالثقافة كمهنة محترمة اجتماعياً. وهو عموماً رمادي بطبعه، غير مبالٍ بالناس أو بالهدف الأساس للثقافة، ولا بالغاية النبيلة المرجوّة منها. فالثقافة بالنسبة له ترَف أو تسلية أو تلبية لرغبة دفينة، في حب الظهور والشهرة. لكن الذي يملك الحق بالحكم على هؤلاء ليس أنا أو أنتم، ولا بحث أو مقال كتب هنا أو هناك، بل الإنتاج الثقافي لأولئك المثقفين، وعلاقتهم بالمجتمع وتفاعلهم معه. «فالإنسان لا يستطيع العيش في مجتمع، ويكون بمعزل عنه بنفس الوقت»، وعلى المثقف أن يعيش هموم الناس ويساهم في حل مشاكلهم الجوهرية وتحقيق أحلامهم المشروعة، ويعبر عن ضمائرهم وطموحاتهم. فالثقافة نشاط اجتماعي ومحصلة لجهد جماعي، وعلى المثقف، طبعاً، إن يكون مثقفاً أولاً، وتكون ثقافته حقيقة عميقة مهنية. كما يجب أن تكون ثقافته منتجة للقيم المعرفية والأخلاقية السامية للبشر، مثل قيم العدل والحرية والخير والمعرفة والجمال والكشف. وأن تكون أيضاً مكافحة من أجل تلك القيم ومستعدة بشكل دائم، للدفاع عنها وإعادة إنتاجها وحمايتها جيلاً بعد جيل. ثم إن الثقافة لا تستطيع أن تكون رمادية أو محايدة اتجاه هذه القيم. بل «منحازة انحيازاً بطولياً للحقيقة والعدالة»، تقف بشجاعة ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتعصب الديني أو الإثني، واعتداء الأقوياء على الضعفاء، سواء كانوا أفراداً أو جماعات.. وهذا كله لا يمارسه المثقف إلا من خلال الكلمة والحوار، والتفاعل النشط مع الناس، والدفاع عنهم وعن حقوقهم الأساسية بالحياة.. وهكذا يجد المثقف بدوره، من يدافع عنه ويحميه. فلا أحد يستطيع أن يحمي الثقافة والمثقفين مثل الناس..
أما النوع الثاني من المثقفين فهو الانتهازي بطبعه، الذي لا يعنيه من الثقافة شيء سوى مصلحته، والذي يستطيع أن يجد تبريراً لأي فعل مشين يقوم به. ولديه قدرة عجيبة على تحويل الثقافة والفكر إلى سلعة قابلة للبيع والشراء. وهو مستعد دائماً لأن يتحول، هو نفسه، إلى بوق وخادم للسلطة. ولذلك أُطلق عليه لقب (مثقف السلطة).
أغلب هؤلاء المثقفين إما جبناء، لا يملكون الشجاعة ولا الاستعداد لمواجهة البطش، أو أنهم غير قادرين على حماية وإنتاج القيم الجميلة التي يحملونها فيقومون بخيانتها، أو أن ثقافتهم في الأصل خلّبية طارئة. إنهم أشباه مثقفين، أو مثقفون عجزة، بحاجة دائمة لعكازات سلطة ما تمكنهم من الوقوف على أرجلهم، وتجعلهم رموزاً للثقافة؛ أي أن السلطة هي التي تصنعهم وتستثمر فيهم، والسؤال الذي يتبادر للذهن: هل تستطيع أي سلطة في العالم أن تصنع مثقفاً حقيقياً؟ إن قوى البشرية مجتمعة لو أرادت صنع شاعر مثل المتنبي أو بوشكين أو لوركا أو محمود درويش لعجزت عن ذلك. لكن سلطة الاستبداد لا تجد صعوبة في تصنيع الكثير الكثير من الشعراء والفلاسفة والمفكرين.
لكن هذا لا يعني أن الثقافة كائن هش ضعيف، لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وتستطيع السلطات المختلفة أن تستخدمه متى وكيفما شاءت.!
وهناك مثقفون حقيقيون، وثمة ما يُسمى بسلطة الثقافة الحقيقية وهيبتها، التي تسمح لها بالدفاع عن نفسها وحماية صانعيها ومريديها معنوياً، على الأقل. لكن سلطة الثقافة مختلفة تماماً عن سلطة العسكر، بأدواتها وأساليبها ووظيفتها والغاية منها. فللثقافة سلطة معنوية وجدانية ناعمة، ليست عنيفة أو فظّة مثل السلطة السياسية. لا أظافر ولا أنياب للثقافة! ليس لديها شرطة ورجال أمن، ولا زنازين ومحاكم وهراوات وقيود وأسلحة. وهي ليست «أداة قهر» (كما وصف فوكو الدولة) ولا تمتلك القوة لإجبار الآخرين على طاعتها بالإكراه أو الإغراء أو حتى القانون. إنها تستند بطبيعتها إلى المعرفة والتجربة الإنسانية العميقة والجمال. أداتها الوحيدة هي الكلمة (الرأي والفكرة والحوار والمشاركة) وسلطتها هي سلطة الفكر والمنطق والإقناع.. والفكرة، كما يقول ماركس، «تتحول إلى قوة مادية إذا ما آمنا بها». وهذا يعني أن واجب المثقف أن يكون له دور فاعل في تطور المجتمع وخلق هويته الثقافية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع الثقافة يا ترى أن تحقق كل هذه الأهداف بسهولة!؟ والجواب: طبعاً لا، وبخاصة في بلد تحكمه طغمة عسكرية. رغم أن الثقافة واحدة من أهم أدوات المعرفة والتواصل الاجتماعي والتغيير. وهل هي بحاجة لمساعدة السلطة.؟ والجواب: حسب السلطة وعلاقتها بالثقافة. فالسلطات الشرعية المنتخبة من الشعب، التي تخضع للمراقبة والمحاسبة، والتي تدافع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، تختلف جذرياً عن سلطة الاستبداد، التي تصادر الثقافة وتجبر المثقفين على القيام بدور الدعاة، كما حدث أيام ستالين وربيبه جدانوف في الاتحاد السوفيتي، وكما حدث أيام هتلر وربيبه غوبلز، وكذلك في ثورة ماو تسي تونغ الثقافية في الصين، وثورة الملالي في إيران، وغيرها الكثير من «الثورات العربية» التي كانت، في جوهرها، فعلاً سياسياً أدى إلى مجازر ثقافية…
الثقافة بطبيعتها لا تستطيع التأقلم مع السياسة ولا العيش بمعزل عن الحرية. لكنها لا تستطيع أيضاً إنجاز الديموقراطية، ولا تؤدي حتماً إلى الفوز بالحرية. فالحرية تصنع من خلال آليات سياسية (أحزاب وتنظيمات وتحالفات) والثقافة ليست حزباً، وهي لا تقود الجماهير ولا تعقد تحالفات سياسية، ولا ترفع شعارات أيديولوجية. إنها غير قادرة على القيام بدورها تحت وصاية أو رعاية أية سلطة، لكنها تخلق الوعي المناسب والداعم للتغيير، فهي لا تمثل إلا نفسها وقيمها، وهي غير قادرة على أن تكون صدى للآخرين (سلطة، حزب، عقيدة، إعلام) إنها تثبّت أقدامها بحذر وتتطور ببطء شديد، لكنها تحفر بعمق وتترسخ بتفاعل كيميائي عجيب، مع مكونات المجتمع وسلطاته السياسية والدينية والشعبية والحزبية والعقائدية. ولذلك، لا يقدر المثقف أن يكون بمعزل عن هذا الدور الكيميائي والفيزيائي، الذي يفرض عليه الانصهار داخل بوتقة الهوية الوطنية والاجتماعية والإنسانية، ويساعد على خلق الهوية الثقافية لبلده وشعبه. فالهوية الثقافية والموروث الثقافي، والثقافة الشعبية والبيئة السياسية والحرية والوعي والتربية والسلطة والإعلام… كلها محاور أساسية مرتبطة ببعضها عضوياً، وكل منها يؤثر في الآخر سلباً وإيجاباً. السلطة بحاجة للمثقف، والثقافة مرتبطة بالسلطتين السياسية والإعلامية، وهي لا تستطيع العيش بلا حرية. والحرية مرتبطة بالوعي والتطور الاجتماعي والانفتاح.. والحديث عن الحرية وعلاقتها في رأب الصدع أو تعميقه بين الثقافة والسلطة، ودورها في حياة الثقافة والمثقفين والأفراد والجماعات؛ حديث طويل جداً، ويحتاج لبحث مستقل..
خلخلت الثورة الذهنية، وما زالت تخلخل، مقولة السلطة الثابتة الأزلية المطلقة، وتحولها إلى حقيقة نسبية، تفتح الباب للتناقض بين السلطة والثقافة. فالسلطة بحاجة للمثقفين، ليس لأنها تخاف منهم وحسب، إنما لأنها تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبوه ضدها أو لمصلحتها في تدعيم سلطتها وتسويق سياستها، وتحويل الثقافة لأداة من أدوات التدجين، أو جسر لا بد منه بينها وبين الشعب، لكن الثقافة لا تستطيع أن تلعب هذه الأدوار، لأن ولاءها عقلي متحول مرتبط بالمستقبل، بينما الولاء للسلطة وخدمتها ولاء غرائزي ثابت متخلف، وهذا جوهر الصراع بينهما، وأهم عامل من عوامل التقدم وتغيير المجتمعات في شتى العصور. ونستطيع، عملياً، تحديد علاقة المثقف بالسلطة من هذه الزاوية؛ أي من خلال الجواب على هذا السؤال: ولاءُ المثقفِ للسلطةِ، هل هو ولاءٌ غريزيٌّ قطيعيٌّ، أم ولاءٌ عقليٌّ وجداني؟ وإذا كان الحال كذلك مع السلطة/ الدولة، فكيف هو الحال مع الاستبداد (الاستيلاء على الدولة والمجتمع) وإذا كان هذا هو حال الاستبداد، فكيف نصنف النظام الذي يحكمنا بالخوف منذ أكثر من أكثر من نصف قرن!؟
يحتار العقل في تعريف سلطة، أمّعة، بلا ماهية، يتحكم فيها ويقودها قطاع الطرق و«الشبيحة» والمرتزقة ورجال الدين الطائفيون، والسفلة والمجرمون. هل هي سلطة طغيان.! أو ماذا نسميها؟ فاشية، همجية، مافيوية، قاتلة، أم أسوأ من هذا كله؟ يحتار العقل حقاً، ويعجز اللسان، ويصبح الجواب مستحيلاً عندما تفكر بصلة ما بين مثقفين مزيفين، وسلطة بلا هوية. فما هي الثقافة، ومن هو المثقف الحقيقي الذي يمكنه العيش في هذا الخراب؟
الطريف في الأمر، أن كلمة استبداد لم يكن لها مثل هذا المعنى السيء الذي نعرفه اليوم، علماً أن العرب كانوا محكومين به منذ 14 عشر قرناً. فكلمة استبداد تعني: التفرد بالأمر وعدم التشاور، وتعني أيضًا: الحزم وعدم التردد باتخاذ القرارات، وهذا ما قصده عمر بن أبي ربيعة حيث قال: «إنما العاجز من لا يستبدْ»…(ليت هنداً أنجزتنا ما تَعدْ/ وشَفَتْ أنفسنا مما تَجِدْ/ واستبـدتْ مرة واحدة/ إنما العاجز من لا يستبدْ) ويقال إن هارون الرشيد، ما أن سمعها، حتى راح يرددها طوال الليل. وعند انبلاج الفجر اتخذ قرارًا بشأن البرامكة، واستطاع القضاء عليهم، في مجزرة شهيرة اسمها: مجزرة البرامكة.
لن أتحدث عن تاريخ الاستبداد السوري الحديث الذي بدأ مع الانقلاب العسكري الأول لحسني الزعيم، ولا عن دكتاتورية العقيد أديب الشيشكلي، الذي آثر الانسحاب من الحياة السياسية والهرب حقنا لدماء السوريين. فهذا التاريخ بات معروفاً للجميع. دعونا نتحدث اليوم عن سورية الأسد، أو الأسدين إن شئتم..
بعد ما سمي بثورة آذار (مارس) 1963، وبعد هزيمة 1967 واحتلال هضبة الجولان بلا مقاومة، تحول نظام البعث بسرعة كبيرة إلى حكم عسكري أمني استبدادي بقيادة حافظ الأسد، الذي استولى على جميع السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، من خلال دستور جديد أصدره سنة 1973، أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة خولته تعيين السلطة التنفيذية ورئيسها، وخوّلته تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب. كما خوّلته أيضاً، وضع السياسة العامة للدولة.. فالدستور السوري الجديد ينص على «أن الوزارة لا تمتلك صلاحية رسم السياسات وليس لها من مرجعية سوى رئيس الجمهورية».دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973م. المادة 117 وحسب هذه المادة، ومواد أخرى، يتحول الوزراء ورئيسهم إلى موظفين تنفيذيين ليس لهم أي دور سياسي. أي أنهم ينفذون السياسات ولا يرسمونها، ولا يمتلكون صلاحية الاعتراض أو التعديل أو التغيير. فالوزير هو «الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته».المصدر السابق. المادة 119 ورئيس الجمهورية هو أيضاً القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وهو رئيس الجبهة الوطنية التقدمية والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان بدوره، قائداً للدولة والمجتمع. فحسب المادة الثامنة من الدستور «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». لكن دور الحزب وجبهته الوطنية سرعان ما تم تهميشه طبعاً، لتحل محله خطب ومقابلات وأقوال «الأب القائد»، حيث انتقلت البلاد من مرحلة «الحزب القائد في الدولة والمجتمع» إلى مرحلة الأب القائد لكل شيء. وقد تمكن خلال 30 سنة من إحكام قبضته الأمنية على المجتمع وابتلاع الدولة والمؤسسات، والحياة السياسية والثقافية. فعسكرَ المجتمع بحجة المقاومة وألغى الحياة السياسية، بقوة القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية وقانون الطوارئ. وسيَّس القضاء، وأسس للفساد والبيروقراطية، وكممَّ الأفواه بشتى الطرق، وأقفل الصحف المستقلة والنوادي الثقافية والرياضية والفنية ومنع العمل المدني. وأنشأ، على الطريقة الكورية منظمات بديلة تابعة له (طلائع البعث، شبيبة الثورة، اتحاد الطلبة…الخ) كما فتح المعتقلات للمثقفين والمفكرين ورجال الدين والقضاة والمحامين الشرفاء بسبب وشاية من جار أو تقرير من مخبر. فحبس مفكراً بسبب مقالة أو رأي. وشرد كاتباً بسبب كتاب أو جملة في كتاب. واعتقل بائعاً بتهمة كتم المعلومات… وأذل بذلك الناس كلهم، وحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية في التعبير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وباتت «الموافقة الأمنية» وثيقة أهم من الوثيقة الرسمية، ولا بد منها لكل مواطن، سواء كان يريد أن يتوظف أو يسافر، أو يحصل على شهادة سواقة أو حسن سلوك أو حتى فتح بقالية، أو أي عمل آخر يحتاج إليه الناس في حياتهم.. والأخطر من ذلك كله أنه قسّم المجتمع إلى فئتين فقط، فئة موالية له يمكنها أن تتجاوز القانون وتفعل ما تشاء، وفئة من الصامتين والخائفين والحياديين. أما الذين امتلكوا النزاهة والشجاعة على معارضته فقد صُنفوا معادين للبلاد وعملاء للإمبريالية والصهيونية، ومكانهم الطبيعي هو السجن والحرمان من الحقوق، بما في ذلك الحقوق المدنية. كما حمى المثقفين الفاسدين وسهّل أمورهم ورفَعهم إلى مكانة لا يستحقونها، وحطم الشرفاء منهم. فهدد واعتقل وهجّر المئات، وبات أمام المثقفين خياران، لا ثالث لهما: الصمت أو الموت.
وإذا كان مفهوم الاستبداد قد ارتبط بالنظام الإمبراطوري البيزنطي في القرن الأول قبل الميلاد، فإن الاستبداد السياسي ناتج في الأساس عن استبداد القوة (العسكرية): أي إحلال القوة محلّ الفكر. وهو نظام حكم قديم قِدم التاريخ. أما في العصر الحديث فقد عرّفه جيمس ماديسون على أنه «جمعُ كل السلطات والصلاحيات، من تنفيذية واستشارية وقضائية، بيد واحدة». دون أن ينفي عنه صفة الظلم والطغيان والتعسف. لكن الاستبداد عملياً بدأ، كما ذكرنا سابقاً، بشكل غريزي، من سلطة الأب وزعيم القبيلة، ليصل إلى نظام الحكم الشامل. وهو نظام متكامل يشمل المجتمع والثقافة والدين والسياسة.
يقول الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد: «الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، إلى كنّاس الشوارع..». فالمستبد يأخذ السلطة بقوة السلاح، ثم يتدرّج باحتكارها ومركزتها داخل أسرته الحاكمة، التي تكون عادة من الأقليات الدينية أو العرقية أو القبلية أو الفلاحية الفقيرة. ويعمل أولاً على ضبط وربط العلاقات الاقتصادية بسياسته، ويساعده في هذه العملية ظهور طبقة أو جماعات متنفذة، وجاهات عائلية وزعامات اجتماعية ودينية وحزبية وفكرية، وضباط جيش وأمن وموظفين.. ترافقه حتماً ثقافة الفساد، وإضعاف دور القضاء في العدالة والمحاسبة، وتخريب دور مؤسسات الدولة بتأسيس نظام إداري بيروقراطي يقضي على ما تبقى من أمل في تحديث تلك الدولة أو تطويرها.
كما أن الاستبداد السياسي/الديني في تاريخنا العربي والإسلامي ليس جديداً. فالشورى، التي تُعد ضمانة للعدل، تم الاعتداء عليها وإلغاؤها عملياً على يد خامس خليفة إسلامي، هو معاوية بن أبي سفيان، عندما ورّث الحكم لابنه يزيد، ضارباً عرض الحائط بكل نصائح وفتاوى العلماء، مثل الحسين بن علي، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، الذين استنكروا ذلك، فكان جوابه لهم: «من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه».صحيح البخاري – كتاب المغازي – باب غزوة الخندق. رقم: 3799 (5 /137). وقد فتح معاوية بذلك بوابة الاستبداد على غاربها لمن جاء بعده من خلفاء، عباسيين وعثمانيين وملوك وأمراء وسلاطين ورؤساء وزعماء وجنرالات.
يشخّص عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ما يسميه داء الاستبداد السياسي، ويرى أن أقبح أنواع الاستبداد هو «استبداد الجهل على العلم». وكذلك يرى الشيخ محمد الغزالي في كتابه الإسلام والاستبداد السياسي: «الاستبداد بأشكاله المختلفة الديني والسياسي والاقتصادي، أساس جميع الفساد، وأن عاقبتَه لا تكون إلا الأسوأ».
ففي ظل الاستبداد يتبدل سلّم القيم، لتصبح القوةُ فوق الفكر، مما يجعل المستبد وجماعتَه هم أصحاب الفكر والرأي. وتصبح وظيفة الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في خدمتها، بدل أن تكون في خدمة الشعب. وتصبح المؤسسات الأمنية أكبر من الدولة، فتبتلعها، ويصبح شغلها الشاغل مراقبة وملاحقة المعارضين، والتنكيل بهم، فتمتلئ المعتقلات بالمفكرين والمثقفين والكوادر العلمية والأكاديمية وكل المناضلين من أجل التغيير والحرية وحقوق الإنسان.
وفي ظل الاستبداد تصبح الثقافة، من جديد، في مواجهة الوحش؛ حيث تعم الفوضى المنظمة، ويضعف الحس الاجتماعي والأخلاقي والانتماء الوطني، ويرتدّ المجتمع إلى الولاء الغرائزي (العشيرة والعائلة والطائفة والقومية والمذهب والمنطقة)، وتُمتهن الكرامة الإنسانية، وتنحط القيم الأخلاقية..
يقول الكواكبي: «فكلما كان المستبد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجّدين العاملين له المحافظين عليه، واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة، وهي أن يكون أسفلهم طباعاً وخصالاً أعلاهم وظيفةً وقرباً، ولهذا لا بد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة».
وقد بيّن ابن خلدون ذلك عندما ركّز في مقدمته، على أن «الاستبداد والظلم يحوِّل الناسَ إلى شخصيات ضعيفة، فيها كذب ومكر وتملُّق. وعندئذ، فلا خير فيهم، فلا هم يستطيعون المطالبة بشيء قوي، ولا المدافعة إذا طالبهم أحد».
وفي ظل الاستبداد تبرز تيارات جديدة من مثقفي السلطة وزبائنها الضعفاء؛ أولئك الذين ينتقون كلماتهم وأفكارهم، ويدبجون نصوصهم ومقالاتهم، ويأتون بأدلة تبيّض الأسود، وتسوّد الأبيض. ويزيفون الحقائق والوقائع ليبرروا سياسات أسيادهم المستبدين. فلا يكتفون بالصمت المذل، بل يبررون الظلم والقسوة، ويفلسفون الفساد والرشوة، متهمين المجتمع حيناً، والظروف العصيبة التي تمر بها الأمة، والمصلحة العليا للوطن حيناً آخر، ويبررون التفريط والتخاذل بالحكمة، ويصبح صوتهم أعلى من صوت السياسة، مدّعين الوطنية، داعين الناس إلى السمع والطاعة والتحمّل، خوفاً من المؤامرة الخارجية والفتنة الداخلية. وكذلك، يدخل المتدينون على الخط، فيستخرجون من بطون الكتب القديمة النصوصَ والأحاديث الدينية التي تُكرّس طاعة الحاكم وتدعو للخنوع والخضوع. يخترعون للمستبد صفاتٍ ليست فيه، ويسبغون عليه ألقاب الرّفعة والسمو والقداسة، وينبشون العقائد البائدة، التي كانت سائدة أيام الحروب الدينية، كعقيدة الإرجاء والجبر والصوفية والقدرية والماتريدية، التي تطمئن النفوس، وتثبط العزائم، وتزهّد الناس بالحياة الدنيا، وتدفعهم دفعاً، إلى الاستسلام، وقبول الظلم والذل، والاتكال على الله..
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا تقدِر الثقافة أن تفعل في هكذا ظروف، وهل تملك الثقافة، يا ترى، أن تقول كلمتها، أو أن تصمت؟ وماذا يستطيع المثقف أن يفعل إذا قبلت أغلبية الناس هذا الواقع السريالي، فصفقت ورقصت وانتخبت قاتلها؟
هي أسئلة طرحها المثقف السوري على نفسه، قبل أن نطرحها نحن، وكان الجواب عليها دائماً، مثل جواب سقراط شارب السم. لأن المثقف إذا قال «نعم»، فقد يربح العالم، لكنه سيخسر نفسه وثقافته. وإذا قال أو فكر أن يقول «لا»، فهو يحتاج إلى طاقة تفوق طاقة البشر كي يصمد، ليس أمام هكذا نوع من الاستبداد وحسب، إنما أمام مجتمع تعود على الصمت والخوف، وصار يفضلهما على الحرية والفكر.
ثمة من يقول إن المثقف الحقيقي والثقافة الوطنية الديموقراطية، التي تحدثنا عنها، قادرة على مواجهة القمع. وقد يكون هذا ممكناً ولازماً وضرورياً، لو أن المستبد ترك هامشاً، ولو صغيراً، يستطيع المثقف من خلاله إن يعيش أولاً، كي نطالبه بعد ذلك بإنتاج الثقافة والتفاعل مع مجتمعه. فهل يملك المثقف حيلة إذا أمَّم الاستبداد الثقافة، بكل أشكالها، وأغلق الدائرة عليها من كل الجهات، وترك لها، بدهاء وخبث، هامشاً مسمِّماً، يفقدها القدرة على الحياة والتأثير، ويحولها إلى أيقونة أو وسام على صدر الطاغية، كي يثبت للعالم الحر، مرة بعد مرة، أنه ديموقراطي وصدره واسع ونظامه منفتح؟ وقد يصل به الخبث أحياناً، لدرجة أنه يسمح لك بالحصول على رخصة لتصوير فيلم وثائقي، ولا يسمح بالحصول على موافقة لعرضه جماهيرياً. وقد يسمح بالحصول على موافقة لنشر ما تشاء من الشعر. حتى وزارة الثقافة مستعدة لأن تساعدك وتنشر لك، لكنهم لا يسمحون لك بإقامة أمسية شعرية أو إلقاء قصيدة واحدة في مقهى.. وقد يسمحون بنشر كتاب فكري لكنهم لا يسمحون أبداً بمحاضرة حوله. وقد يسمحون بطبع نصوص مسرحية وقصص وروايات، ثم يضعونها في المستودعات، أي أنهم يصادرونها عملياً ولا يقومون بنشرها، ولا يسمحون -طبعاً- بتنفيذها على خشبة المسرح، أو تحويلها إلى فيلم سينمائي أو مسلسل درامي أو برنامج فكري.. ومن حظ الاستبداد إن نسبة الذين يجيدون القراءة أصلاً قليلة، لا تخيفه ولا تؤثّر عليه، وهو يعرف ذلك ويستفيد منه بخبث. ويعرف أيضاً أن نسبة من يشاهدون التلفاز ويتفاعلون مع الأنشطة الثقافية كبيرة جداً، وهذا التفاعل هو الممنوع في جمهورية الصمت. وإذا كانت الأمية متفشية، وكان عدد الذين يقرأون أصلاً لا يتجاوز الآلاف، مهما كان كبيراً، وإذا كانت أفضل الكتب رواجاً لا يُطبع منها أكثر من ألف نسخة؛ فإن عدد المشاهدين للفيلم أو المسلسل قد يصل إلى مئات الألوف وربما الملايين.. وحتى لو كانت الثقافة للتسلية وقتل الفراغ، فهو يخاف منها ويمنعها، لأنه هو من يقرر نوع التسلية. إنهم يغرقون البلاد بالكتب التافهة لأزلام السلطة، والمسلسلات والأفلام الساذجة، المستوردة والمحلية. ويحوّلون المراكز الثقافية التي بنوها في المحافظات والمدن كلها، إلى منابر حصرية لخطبهم ومناسباتهم التي لا تنتهي. أي أن النظام عملياً، يقوم بمصادرة المنابر الثقافية، ومنع اللقاء بين المثقف والجمهور، وهو الركن الأساس في العملية الإبداعية والثقافية. هذا الجمهور يجب أن يكون ويبقى ملكاً للأب القائد، لا أحد ينافسه عليه. وبذلك تمنع وجود منبر غير منبره، وصوتاً غير صوته، وأنشطة غير الأنشطة التي يراها مناسبة. فالتواصل بين المثقف والناس محرم لديها، ونمو التفكير والتحليل والحوار والتفاعل الذي تطرحه الثقافة، كمتنفس للمجتمع، أو كبديل ديموقراطي، ممنوع من قبل سلطات الأمر الواقع، لا تسمح به، وتعاقب بشدة من يخالف أوامرها، وهي بذلك، تصادر مادة الثقافة وموضوعها وأدواتها، كما تصادر وظيفتها.
ومن أدوات الثقافة الأساسية، بعد الكتب والفنون والنقابات ودور النشر والدوريات والمراكز الثقافية وغيرها، يأتي الإعلام كواحدة من أهم الأدوات المعاصرة لإنتاج الثقافة ونشرها. وقد لعب الاستبداد بهذا السلاح دوراً خطيراً طبعاً، كونه يحتكر وسائل الإعلام كلها، المقروءة والمسموعة والمرئية، وكون المرئي منها، وبخاصة التلفاز، يشكل عنصر جذب مغرٍ لبعض المثقفين الذين يعجزون بمفردهم على أن يجدوا مكاناً لهم في المشهد الثقافي، ولأن الإعلام أيضاً قادر على إشهار من يريد من المثقفين، وتحويله إلى نجم ساطع، أو حجبه، بشخطة قلم. وعلى الرغم من أن مهمة الإعلام ليست هذه، فإن سلطة الاستبداد تستخدمه لتعميم التفاهة، ولإلقاء الضوء على مثقفيها العجزة، وتلميع صورهم وفكرهم، فيصبحون أَعلاماً، وتصبح كلمتهم مسموعة، كما يحققون طموحاتهم الشخصية كي يسدوا الدَّين لأسيادهم، في الوقت المناسب. بينما تحجب الضوء عن المثقفين الحقيقيين، وتعمل بشكل منهجي على التشكيك بأفكارهم وموهبتهم وانتمائهم الوطني وسمعتهم الشخصية. وكذلك، يسيطر النظام بشكل كامل على النقابات المهنية، وبخاصة اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين والتشكيليين والفنانين. ويحوّلها إلى ما يشبه الفروع الأمنية، حيث يتجسس فيها الزميل على زملائه. وتتحول مهمة النقابات الأساسية إلى كتابة التقارير السياسية والأمنية، وحتى الشخصية، والحميمة منها، كما تتحول السمة الغالبة في عملها المهني، إلى فبركة الدسائس والمكائد بين الزملاء، الذين يتسابقون للحصول على ولاء أو مركز أو عطاء. ومع السنوات الطويلة التي يعيشها نظام الاستبداد، ومع الشعور المرير بالإحباط الذي يولده، يقزّم دور المثقفين الحقيقيين ويحل محله صوت السلطة وأبواقها. وينهزم الفكر والجمال، لتحل محلها السخافة وخراب الذوق والمعرفة والقيم الأخلاقية الراقية..
كما فطن النظام السوري إلى موضوع لم يسبقه إليه أحد، غير تجار هوليود الذين كانت لهم الريادة في اختراع فكرة «النجم السينمائي». وإذا كان هدف هوليوود الأساس من صناعة النجم، هو استثماره مالياً، للحصول بواسطته على أكبر قدر ممكن من الربح؛ فهدف النظام كان استثماره سياسياً، وتحويله لبوق، يصدح في المناسبات والاحتفالات والأعراس الوطنية والقومية..
والسؤال الآن: هل هذا يعني أن قدر الثقافة أن تستسلم وتصمت.؟ وهل يستطيع المثقفون أن يلعبوا دوراً ما، في ظل هذا الخراب؟ والجواب هو نعم بالتأكيد، لأن هذا هو دور الثقافة وطبيعتها، ولولا ذلك لانقرضت البشرية منذ وقت بعيد. فقد مرّ على الشعوب والأمم الكثير من الفترات المظلمة حيث ينحطّ فيها كل شيء، وبخاصة الثقافة/ العنقاء التي هي أول من تحترق وأول من تنهض من رمادها. «وكي لا يقولوا صمت الشعراء» كما أكد برتولد بريخت، يستمر المفكر بالتفكير، ويستمر الشاعر بكتابة الشعر. فهل ماتت الفلسفة بعد ما أُجبر سقراطَ على شرب السم؟ وهل مات الشعر ببضع رصاصات اخترقت صدر لوركا؟ صار سقراط رمزاً للدفاع عن الحقيقة وشرف الكلمة، جيلاً بعد جيل، وصار لوركا رمزاً للحرية والنوافذ المفتوحة، ووصمة عار على جبين فرانكو ونظامه الفاشي، وصار المثقف يفكر بوسائل أخرى كي يوصل كلمته ورأيه. ولذلك قيل: «إن الثقافة العظيمة تخدم أهدافاً عظيمة»، وإن للثقافة ضمير حي، وذاكرة لا تموت.. إنها الفراشة التي تقتل الوحش.