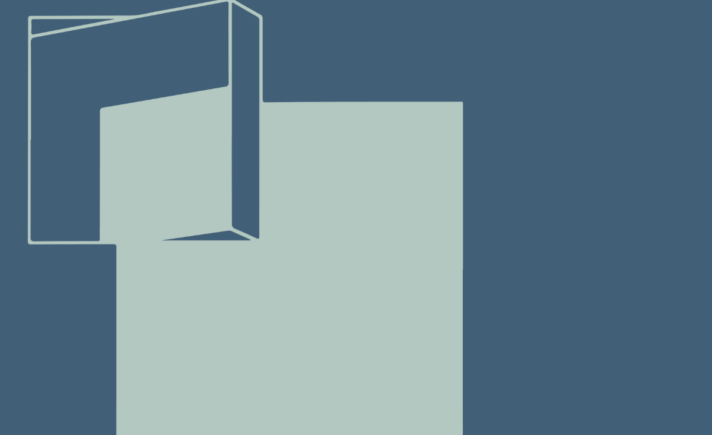قلّما نهتم، نحن متكلمو العربية، بتعلم منظم للتفكير، أو تحسين قدراتنا على ممارسة ما يفترض أنه يميزنا كبشر عن غيرنا من الأحياء من نظر في العالم حولنا وفي أنفسنا، على نحو ربما يعود علينا بوجود أفضل. ولعل هذا بسبب أننا نفكر في كل حال، فلا نفكر في الحاجة إلى تدرّب خاص على التفكير. الإنسان حيوان ناطق، أو عاقل، والعاقل يعقل الأمور بعقله، يفكر. لكن هذا يرد التفكير إلى ما يشبه غريزة، كالطعام والجنس، لا تحتاج إلى تعهد خاص. ولعله يمكن التمييز في هذا المقام بين «عقل»، تفكير أساسي يشترك فيه جميع الناس الأصحاء، ويستطيعون تسيير شؤونهم، بخاصة في بيئات أبسط، أهّلنا تطورنا البيولوجي للتعامل مع ما تطرح من تحديات، وبين تفكير بعد-أساسي أو معقد، لا يُستغنى عنه في بيئات أقل طبيعية، أو أشد صنعية و«ثقافية»، ولم يؤهلنا تطورنا البيولوجي بصورة خاصة للتعامل معها. نحتاج إلى تطوير مهاراتنا الفكرية كي نحسن التعامل مع هذه البيئات المعقدة المختلطة. هذا التطوير مسألة تعلم. وهو غائب بقدر كبير من مداولاتنا، ومن شغلنا الفكري الثقافي، بما فيه ذي التوجه «التنويري». لقد ولدت أشكال التفكير الواعية والأكثر تعقيداً في صلة وثيقة بانفصالنا عن الطبيعة، وظهور أشكال من الاجتماع البشري أقل طبيعية بعد الثورة الزراعية (نحو عشرة آلاف سنة قبل اليوم)، ثم ظهور المدن. والاعتناء بها اليوم ضرورة تكيفية، أو جهد للتغلب على إعاقة تكيفية، تقودنا على نحو نَسَقي إلى بقاء متدهور في عالم اليوم.
هذه المناقشة، التي تبني على تناول سابق، تحاول إظهار تاريخية التفكير، والعلاقة بينه وبين الشروط الاجتماعية والسياسية، وتحاول تزكية خلاصات عملية حول تعلّم التفكير. وهي تنطلق من معطيين، لغوي وفلسفي. المعطى اللغوي يبدو موجوداً في كل اللغات، أعني الضمائر الثلاث: المتكلم والمخاطب والغائب، أنا، وأنتَ أو أنتِ، وهو أو هي (وصيغ مثنى المخاطب والغائب منها بالعربية: أنتما وهما)، ثم صيغ الجمع التي تحيل إلى متكلمين: نحن، ومُخاطبين: أنتم وأنتن، وغائبين: هم وهن. أما المعطى الفلسفي فهو ما قاله أفلاطون من أن التفكير هو حوار للمرء مع نفسه، وهو ما يعني ازدواجه إلى متكلم ومخاطب يتحاوران، يقلبان أمراً ما على وجوهه. ويربط بين المعطيين بقوة حقيقة أن اللغة ركيزة التفكير، وأساس العقل، لا وجود له من دونها، وأن التفكير تحقيق اللغة، جعلها واقعاً معاشاً. ليس هذه اللغة أو تلك، بل اللغة كاسم لفاعلية الإنسان العاقلة والمتوجِّهة في العالم. نحن عاقلون لأننا ناطقون.
وبالتركيب بين هذين المعطيين، يمكن تمييز ثلاثة أنماط من التفكير، نمط أول متمركز حول المتكلم، ونمط ثان يتشاطره متكلمان يتخاطبان، ونمط ثالث يتكلم فيه الثالث، الغائب، فضلاً عن المتكلميْن المتخاطبيْن. أسمّي الأول اعتقاداً، والثاني حواراً، والثالث اشتراكاً.
المتكلم الواحد
في النمط الأول يستبعد المتكلمُ المخاطبَ، أو يمنعه من أن يكون متكلماً بدوره، سواء أخذ ذلك شكل فرض مباشر بقوة السلطة الإكراهية، أو شكل تقييد اجتماعي شديد يحول دون تولد كلام مغاير، ويعرض أصحابه للخطر إن هم ثابروا عليه. نحن هنا حيال مُتكلم وحيد، إن في صورة شخص يُصغى إليه ولا يخالفه من يسمع كلامه، أو في صورة تقليد سائد.
لا يقتصر الأمر على الديانة التوحيدية التي لا تستطيع احتكار الكلام إن لم تصر سلطة إكراه، بل أن حياتنا السياسية يسودها النمط الواحدي، وجود كلام لا يُرَدُّ عليه ولا يُساءل، ولا يُعتبر كلاماً مثل كل كلام آخر. يعامل بالأحرى ككلام إلهي أو مقدس، يجري تكريسه في المدارس ونظم التعليم وفي وسائل الإعلام «العامة».
لا نتدرب في المدارس على أن هناك قول آخر في الشؤون الاجتماعية والسياسية. نتدرب، بالعكس، على أن هناك قول واحد صحيح، وحزب واحد صحيح، ودين واحد صحيح، وقائد واحد عظيم… إلخ، وأن أي قول آخر هو باطل أو ضال، غير شرعي الوجود بالتالي. في المدارس السورية مثلما عرفناها خلال نصف القرن الأخير، هناك مقرران «دينيان»، واحد إسلامي أو مسيحي، وواحد أسدي (كان يسمى «التربية القومية الاشتراكية»)، حيث يشغل حافظ الأسد موقعا إلهياً، لا يُرد على كلامه ولا يناقش.
وفي الحالين، بنية التعليم قائمة على أن المعرفة موجودة في الكتاب، والأستاذ يملك المعرفة التي في الكتاب، وينقلها للتلاميذ، والطالب «المجتهد» أو «المتفوق» هو الذي يتماثل مع ما يقوله الأستاذ، و«الكسلان» هو الذي يقصّر في التماثل. وعلى هذا النحو يُنتَج التماثل حيث تتطابق المعرفة بالسلطة، أو الحقائق المعترف بها والسلطة التي تفرضها وتعمّمها. ويكافأ الممتثل، من يجيد التماثل مع معرفة مسبقة لا تُناقَش.
وتظهر البنية الواحدية الاعتقادية في مختلف مؤسسات التأهيل والممارسة الدينية الإسلامية، من التعليم و«نقل العلم»، وصولاً إلى النموذج المتخيل للدولة الإسلامية، مروراً بالإفتاء وإمامة الصلاة وخطبة الجمعة. خطبة الجمعة ليست فعل تخاطب، بل فعل تكلم من قبل سلطة لا تُساءل، مثلما لا يُساءل الطاغية من رئيس أو ملك. الفرق أن السلطة في الشأن الديني ليست شخصية، ليست سلطة خطيب الجمعة أو «العالم» بشخصه؛ إنها سلطة التقليد الديني الذي يمثلانه. أرجحية النقل على العقل في تكوّن التقليد الإسلامي تتصل بغياب المخاطب الذي يجعل التفكير حوارياً، وباختزال الناقلين إلى ما يقارب حملة أو أوعية لعلم معصوم، ناجز قبلهم، مكتمل بهم وبدونهم.
وعبر ذلك، تكويننا الفكري والاجتماعي والسياسي على نحو ما تتعهده أجهزة التأهيل السياسية والدينية واحدي، تكراري، لا يسمح بتفكير يتجدد، ولا بحياة اجتماعية وسياسية قائمة على التعدد. وبما أن مجتمعنا مثل كل مجتمعات الأرض متعدد فعلاً، فإن هذا التعدد غير المعترف به ينزع إلى أن يشقِّق من باطن الوحدة المفروضة التي ما إن تتداعى قوى فرضها حتى يغيب مستوى الوحدة تماماً، وتظهر مكان التجانس الظاهر أصناف بشرية لا تجتمع، تجنح كل منها إلى فرض تجانسها الخاص وواحديتها الخاصة، وتستبعد بدورها المتكلمين الآخرين. هذه بصورة ما تجربتنا بعد الثورة السورية: زالت الواحدية الأسدية لتحل محلها واحديّات أهلية، يسود في كل منها قول متكلم معصوم.
تجري حماية كلام المتكلم الوحيد بقمع الأقوال المغايرة. وإذ لا يجري الأخذ والعطاء مع قول أو أقوال أخرى، يُفرض على الجميع ضرب من الـ«نحنـ»ـية المتجانسة، التي لا يبدو أنها يمكن أن توجد إلا كأثر لسلطة عليا، أو للتماثل المفروض مع «علم» موجود سلفاً، مماثل لذاته قبل التعلم وبعده. الاعتقاد بحد ذاته لا يضمن التجانس دون سلطة تحتكر الكلام الصحيح، الكلام الذي لا يُساءل، وتفرضه وتقمع الاعتراض عليه. ما يمكن تسميته مجتمع النَّعم هو نتاج سياسي اعتقادي: فرض قول معصوم بالقوة.
تحمي الواحديات نفسها كذلك بعزل نفسها عن العالم، أو بالأصح بعزل العالم عن نفسها، فلا تدخل في حوار، ولا تقبل أن تكون في تعدد مع غيرها. ولكنها بذلك تحكم على نفسها بذلك بالتكرار والتحجر، تحرسهما أنا متصلبة لا تدخل في علاقة ولا تقبل أنها مساوية لغيرها. بالانفتاح على فكرة أخرى والسماع لمتكلم آخر والإقرار بوجود آخر، ندخل النسبية على أنفسنا، ونطور تكويناً حوارياً بحيث يكون الواحد منا في آن معاً نفسه وغيره. المشكلة في أنماط التفكير الواحدية، الدينية وغير الدينية منها، أنها اليوم مصدر إعاقة تكيفية في عالم معقد لا ينفع كلام الواحد المنتهي، المسموع المطاع، في التوجه فيه. الواحديون من أبناء جلدتنا هم قوى موت، أنتجوا منه أكثر مما أنتجوا من أي شيء آخر. وأشباههم من غير أبناء جلدتنا هم قوى موت كذلك. الواحديات تقتل، والواحديات المطلقة تقتل قتلاً مطلقاً.
سادت الواحدية في المسيحية الأوروبية حتى عصر النهضة الذي أخذ يُستعاد فيه التراث اليوناني والروماني. هنا أخذ يظهر التفكير كحوار، وتكرس في الديالكتيك الذي لم يعد مجرد حوار من أجل الوصول إلى الحقيقة، أي كتعلم للتفكير على الطريقة السقراطية الأفلاطونية المأثورة، بل منطقاً للفكر وبنية للعقل والتاريخ بحسب هيغل.
الحوار
نمط التفكير الذي لا يستبعد المحاور المخاطب اقترن تاريخياً بالديمقراطية، سواء في أثينا التي عاش فيها أفلاطون، وإن كان خصماً لديمقراطيتها التي أعدمت معلمه سقراط، أو في الديمقراطية الحديثة في بلدان الغرب وغير الغرب اليوم.
تقوم الديمقراطية على متكلميْن متساويين، أي على الحوار. ليس هناك كلام لا يُرد عليه هنا أو لا يُنفى. وهو ما يحرر الأذهان من سلطة الكلام الواحد المرفوع فوق غيره والقامع لغيره، وما يتوافق مع التفكير بالمعنى الذي صرنا على إلفة به في الزمن المعاصر. نفكر، أي نحاور أنفسنا، لأننا نحاور غيرنا. في التفكير بهذه الدلالة نتمثل وضعية الحوار بين متكلم/ مخاطب ومخاطب/ متكلم. حين يكون هناك قولان متاحان للجميع، فإن المرء يُدفع إلى تقليبهما على أوجههما، والتفكير في غيرهما، فلا ينفرد أي من الأقوال المتاحة بالتحكم بذهنه، وعن ذلك تتولد أقوال جديدة. وبينما ليس للقول الواحد حدود، فهو يحتل العقل تماماً ولا يترك مكاناً لغيره، فإن تعدد الأقوال يعني محدودية كل منها، فتكون فاعلية التفكير وحدها هي غير المحدودة. وهذا يحرر طاقة تفكير إيجابية هي عبارة عن جولان الذهن عبر الحدود، حدود أقوال نسبية وغير معصومة. الاقتران التاريخي بين الديمقراطية وبين الغنى الفكري والثقافي لا جدال فيه، على نحو يرجح علاقة سببية بينهما. بالمقابل، اقترنت الواحديات، دينية أم سياسية، بالفقر الفكري والتكرار. وبينما تعمل نظم الاعتقاد الواحدية على إنكار محدوديتها بنسبة نفسها إلى الله أو العلم أو الأمة، فإنها إن لم تستخدم القوة لفرض ذاتها، فإن هذا الإنكار الدفاعي سيتراجع شيئاً فشيئاً، وستدخل دوائر أوسع من الناس في الحوار، تتكلم أو تخاطب.
بل إن كلاماً لا يُردّ عليه لا يمكن أن يكون شرعياً من وجهة نظر التفكير كحوار؛ كما لا يمكن للسلطة التي تفرضه، دينية أم سياسية، أن تكون شرعية. وهذا بقدر ما إن عنفاً رسمياً لا ينضبط بحق المحكومين في الدفاع عن أنفسهم لا يمكن أن يكون شرعياً من وجهة نظر السياسة كديمقراطية، ولا يمكن لسلطة تحتكره أن تكون شرعية. الثورة، ثورة مكتومي الصوت ومنزوعي السلاح، حق للمحكومين في الحالين.
ونتاج التفكير كحوار ليس أفكاراً جديدة فحسب، بل هو أنفسنا كذوات تفكر، نستدخل تعدد المجتمع حولنا وندخل التعدد إلى أنفسنا. العلاقات الاجتماعية هنا حوارية.
وتقوم المواطنة على الحق في الكلام، أن نتكلم بالأصالة عن أنفسنا كلاماً غير كلام السلطة، وضد كلام السلطة. ليس هناك مواطنة دون متكلمين أصلاء ينقون قول السلطة، أي يقولون لا.
وتظهر البنية الحوارية للاجتماع السياسي الغربي الحديث في مؤسسات التعليم وفي الصحافة ووسائل الإعلام عموماً وفي الانتخابات العامة وفي التأليف في مجال الإنسانيات، ويترسخ في المحصلة كثقافة. المسيحية (المسيحيات) ظلت على بنية واحدية عقدياً (ومؤسسياً في حالة الكاثوليكية)، وإن دون سيادة، وبانفتاح متفاوت الاتساع على الفلسفة والإنسانيات الحديثة. لكنها إذ تعيش في بنية حوارية تعرض هي نفسها منزعاً حوارياً، فلا تحتكر الكلام الصحيح، وإن ظل أساس الدين واحدياً (الخلاص بالمسيح). ومرة أحرى، المعتقد التوحيدي لا يستطيع احتكار الكلام إن لم يتسلح بسلطة. الدين في كل حال يتلون ببيئته، ويعرض منزعاً حوارياً في بيئة حوارية ومنزعاً واحدياً استبعادياً في بيئة استبعادية مثلما هو الحال عندنا.
التحول نحو الحوارية ونحو الديمقراطية في إطارنا تعثر بقدر كبير بفعل سحق المنظمات الاجتماعية والسياسية المستقلة، في إطار بناء مجتمع النعم. وهو ما انتفعت منها المنظمات الدينية دون غيرها، مع واحديتها القديمة المتجددة، القائم على نَعمها الخاصة، «السمع والطاعة»، والتي ترفع بطاقة لا في وجه العالم.
ما يميز الديمقراطية في أي مكان هو وجود لا أساسية داخلية غير قابلة للحذف. هذا مرسخ في الفكر والثقافة، وقد يمكن التفكير في الديالكتيك الهيغلي والماركسي كتأسيس للنفي وحسم لمسألة شرعيته.
الاشتراك
على أن في بنية التفكير الحواري غائباً هو الأجنبي أو الغريب، وهو العبد (أو من في حكمه في عصرنا)، وهو المرأة. الثلاثة كانوا بلا حقوق في الكلام والسياسة في ديمقراطية أثينا القديمة. ثم أن الغائب هو المهاجر وغير المواطن في الديمقراطيات المعاصرة، وبقدر ما حتى المواطن من غير الإثنية الأصلية إلا بقدر ما يكون «مندمجاً»، ثم هو المجتمعات والثقافات الأخرى التي تتأثر كثيراً بقرارات وسياسات القوى الديمقراطية النافذة دولياً دون أن تكون لها كلمة في شأن هذه القرارات والسياسات. هذا الغائب العاقل عملت على استحضاره نظريات الامبريالية والأممية. هناك بعد ذلك الغائب غير العاقل، أي الحي الذي لا يفكر، من حيوان ونبات وبيئة حياة في كوكب الأرض. هذا الغائب لا يدخل في الحوار بدوره، وآل تغييبه إلى مشكلات البيئة التي تهدد مستقبل البشر، وربما الحياة على الكوكب. ثم هناك الغائب الكوني، ما نحن منه وما هو منا، من كون متمادي الأبعاد، من شؤون تتصل بالمنشأ، من سؤال «الروح»، ومن تعدد محتمل في الوجود، مما تحيل إليه بصورة ما كلمة الغيب العربية.
هذا أفق للتفكير يتجاوز الديمقراطية نحو شراكة حياة كوكبية، تبدو منذ الآن شرط نجاة البشر والحياة على الأرض. والواقع أن الانفتاحات التحررية الكبرى في التاريخ الحديث اقترنت بحضور الغائب وكلامه، في صور هادئة أو صاخبة. دخلت الطبقة العاملة بفضل الحركة الاشتراكية، وتدخل النساء بفضل النسوية، ويدخل الأجانب والغرباء بفعل نزع الاستعمار والنضال ضد العنصرية، وتدخل الأحياء بفضل النضال البيئي. يمكن التفكير في النضال التحرري في هذا الإطار بأنه العمل من أجل حضور الغائبين وعمل الغائبين من أجل الحضور. ويبدو أنه يكون أشد عنفاً كلما كانت آليات التغييب أشد إحكاماً. في بدايات الثورة الروسية، ظهرت تجارب طليعية في التنظيم والتعبير والفن والعلاقات بين الجنسين والسياسة، لم تلبث أن أودت بها الواحدية الشيوعية حيث هناك كلام واحد شرعي ولا يُردُّ عليه. وبعد أيار 1968 تحققت في فرنسا وبلدان أوروبية ثورات في الحياة الجنسية وفي التعبير والفن، وتوسع مجال الحرية وتعمق اجتماعياً. وظهر تعدد وغنى سورية المغيب في البدايات الواعدة للثورة السورية. ولزمت أشكال عنيفة من التغييب، السياسي والديني، من أجل إعادة إقامة مجتمع النعم.
مسألة التحرر أشد قسوة وإعضالاً في إطارنا. حياتنا التعليمية والفكرية، وحياتنا الأخلاقية والسياسية والروحية، تعاني أشد المعاناة من تغييب المخاطَبين الذين يقاسموننا الكلام، وبطبيعة الحال تغييب الغائبين من البشر (النساء، الشرائح الأفقر، أصحاب الرأي المغاير، «الأجانب» و«المكتومين» و«البدون»…) ومن الأحياء، بل وحتى الغيب أو مجال الغائب الكوني، رغم مركزية المفهوم في الإسلام. التيار الصاعد إسلامياً في السنوات الأربعين الأخيرة هو السلفية التي هي مزيج من واحدية مطلقة ومن تضييق مجال الغيب إلى أقصى حد أو رده إلى مقولة فارغة من الدلالة.
لذلك فإن النضال التحرري في مثل مجالنا السياسي الثقافي هو نضال امتلاك المخاطبين للكلام ودخولهم في الحوار، أي من أجل المواطنة، ثم نضال الغائبين ومن أجل الغائبين، الشعب أو العامة، ومنه بصورة خاصة النساء، ومنه كذلك البيئة الحية. إنه نضال من أجل الثاني والثالث، في وجه من يصرون على احتكار الأول للكلام، سواء كان كلاماً دينياً أو سياسياً.
تعلم التفكير بالتالي هو تَعلمان: تعلم الحوار بأن نخرج من أنفسنا إلى مخاطب- متكلم يقول غير قولنا وينفي قولنا، وأن ندخل هذا المخاطب في أنفسنا أو نستضيفه رغم قوله المختلف أو النافي؛ ثم تعلم الاشتراك بأن نستحضر الغائب في كل وضع. فإذا كان نمط الحوار ديمقراطياً، فربما يناسب أن نسمي نمط الاشتراك اشتراكياً. في مقصدها الأصلي، كانت الاشتراكية تجاوزاً للديمقراطية وليس نكوصاً عنها، كما كانت تجاوزاً للسياسة نحو المجتمع. وكان يفترض ألا تحل مشكلة غياب البروليتاريا المادي والسياسي فقط، وإنما كذلك تكفل المساواة الجذرية بين النساء والرجال، وتنفي العنصرية جذرياً، وكذلك القومية وكل أشكال التعصب المحلي. واليوم التجاوز مفتوح على البيئة الحية وعلى الكون.
تعدد العالم
وتحيل أنماط التفكير الثلاثة، الواحدي والحواري والاشتراكي، إلى ثلاثة أنماط من الاجتماع. اجتماع يقوم على السلطة والطاعة، واجتماع يقوم على الحوار والحرية، واجتماع يمكن أن يقوم على التشارك والانحياز للغائب. وقد نتكلم كذلك على ثلاثة أنماط من الوجود: وجود واحدي يقوم على موجود حقيقي واحد (مركزية لاهوتية)، ويقرر صواب قول واحد؛ ووجود ثنوي يقوم على وجود كل من وعينا والعالم (مركزية إنسانية)، ويضمن شرعية تعدد الأقوال؛ وتعددية وجودية، تقوم ربما على نزع المركزية، إلهية أم إنسانية، وتضمن شرعية تعدد الوجودات في ما يمكن أن يكون ضرباً من الأحيائية الجديدة. الغيب هو افتراض من أجل التأسيس الجذري للتعددية الوجودية، مثلما الصفر هو التأسيس الجذري للكثرة، ومثلما العدم هو التأسيس الجذري للوجود كوجود، بل هو الوجود من حيث هو محض وجود، على ما يُظهِر هيغل في فينومينولوجيا الروح.
وبالتوازي قد نميز بين ثلاثة أنماط من السلطة. الطغيان أو سيادة الواحد، الديمقراطية أو سيادة الأمة أو الشعب، والاشتراكية التي يمكن أن تأخذ في هذا السياق معنى سيادة الحياة. فإذا فكرنا في أن سيادة الشعب اقترنت بزوال التعذيب، فقد نتصور أن سيادة الحياة تتوافق مع أنماط العيش والسلوك التي لا تعذب الحيوان أو تقتله، أي النباتية. يُضحّى في الطغيان بعموم المحكومين، فلا قيمة لحياتهم مقابل حياة السيد الواحد. ويضحى في الديمقراطية بالغائب، ويفترض أن تعتني الاشتراكية بالدلالة المعطاة لها هنا بألا يُضحى بأحد، ولا حتى بالحيوان.
تظهر التضحية بالغائب في قصة جميلة يرويها شنوا أتشيبي، الروائي النيجيري الذي رحل قبل شهور، في كتابه الوطن والمنفى،Achebe, Chinua. 2000. Home and exile. Oxford: Oxford University Press. وينقلها عن شعب الإغبو الذي ينحدر هو منه. تقول الحكاية إنه ذات صباح كانت الحيوانات ذاهبة إلى اجتماع دعاهم إليه منادي البلدة في الليلة السابقة. وكان مفاجئا أن الديك لم يكن متجهاً إلى الساحة العامة مثل جميع الآخرين، بل بعيداً عنها. وحين سأله الجيران عما إذا لم يكن قد سمع بدعوة المنادي للاجتماع، أجاب أنه في الواقع سمع الدعوة، إلا أن عليه لسوء الحظ أن يتابع شأنا شخصياً طرأ للتو. وقد رجاهم أن ينقلوا تمنياته الطيبة للاجتماع، بل وأعلن أنه يدعم قراراته المحتملة ويلتزم بها. كانت المشكلة التي تعين على الاجتماع معالجتها هي ما أخذ يسببه الإنسان من أذى للحيوانات منذ أن صار يقدم قرابين دموية لآلهته. وبعد جدال حامٍ أقرت الحيوانات بالإجماع بأن يُقدّم الدجاج للإنسان كقربان أساسي. وقد بقي الأمر كذلك إلى اليوم (يبدو أن الخروف هو من غاب عن الاجتماع في «بلدتنا»). دلالة القصة أن من لا يمثل نفسه لن يمثله أحد، وأن من يغب يُضحى به، وبالتالي أن الصراع ضد الغياب هو صراع من أجل الحياة. في موضع آخر من الكتاب يقول أتشيبي أنه إلى حين تنتج الأسود مؤرخيها، ستمجد قصة الصيد صياديها فقط.
ونعلم من مثالنا الأقرب في سورية أن التغييب السياسي الواسع للسوريين كان نتاج نمط حضور سياسي كاسح للمستولي الأسدي، وأنه آل إلى «الأسد أو لا أحد» وإلى الإبادة بعد الثورة السورية. يمكن التفكير في الثورة بالمقابل كنضال من أجل الحضور، أو كجهد جمعي هو الأكبر في تاريخ سورية لتغيير نظام الحضور بحيث يظهر متكلمون آخرون.
ويظهر مما تقدم ترابط وثيق بين المعرفي والأخلاقي والسياسي. فالواحديات لا توحد الإنسانية، بل هي تؤسس لالتزامات أخلاقية حيال جماعة المعتقدين بالواحد دون غيرها. ويبيح غرور التوحيد التمييز ضد الغير، وربما إيذاءهم، فيخلق على هذا النحو أعمق الانقسام بين البشر. هذا لأن الواحدية تستبعد المتكلم الآخر، وشرط وجود هذا المتكلم هو أن يقول كلاماً مغايراً لا يستظهر كلام المتكلم الأول، مع بقائه شرعياً ونداً للمتكلم. ومن باب أولى يستبعد الاعتقاد الواحدي الاشتراك، الذي هو دخول الغائب في الحوار، ومنه هنا بطبيعة الحال المعتقد بدين آخر أو من لا يعتقد بأي دين، و«المشرك». ثم لأن الاعتقاد، بفعل واحديته الاستبعادية ينزع إلى فرض نفسه بالقوة، أو يقوم على تحالف بين العقيدة والسلطة. والحال أن ما نتعلمه من فرض الواحدية كسياسة و«شريعة»، أو كدين ودولة، هو الأمّية الأخلاقية، حيث الغير غير موجود كمساوٍ وند، بل لعله غير موجود إلا كخطر وشر. وقد لا يقتصر الأمر على الامتناع عن فعل الخير للغير، بل يتخطاه إلى وجوب فعل الشر على ما تقرر بعض صيغ عقيدة الولاء والبراء السلفية. الأمّية الأخلاقية في كل حال هي نتاج تعلم خاص، وليس بحال قرينة عدم معرفة بالغير. وباختصار، لا نحصل على بشرية موحدة عبر درب التوحيد، أياً يكن هذا التوحيد. ما نحصل عليه عبر الواحديات هو انقسامات دائمة وعداوات متجددة.
والجماعة التي تقوم على الواحد هي العصبة أو الأمة الدينية، أو الطائفة. وهذه منظومة للأمية السياسية فضلاً عن الأمية الأخلاقية. فقر الفكر السياسي في تاريخنا وفي حاضرنا متصل بالواحدية التي قد تتكسر إلى واحديات، لأنها لا تكف عن طرد التعدد من داخلها، أي عدم الاعتراف بمتكلم آخر، فضلاً عن التغييب النشط لكل من المرأة، وغير المؤمن، و«عوام المسلمين» بالذات. التعلم السياسي يبدأ بإقرار التعدد كواقع أساسي ومنطلق للسياسة.
ويؤسس الحوار لأخلاقية تشمل المتكلم الآخر، المساوي والند. لكن أطر الحوار كما نعرفها في العالم المعاصر هي دول-أمم، تنحصر فيها الالتزامات الأخلاقية، السلبية منها والإيجابية، أي عدم الإيذاء وفعل الخير للغير. الدول- الأمم هنا وحدات أخلاقية من حيث المبدأ، وما قد يؤخذ عليها هو التباين بين صفتها هذه وبين واقعها الفعلي، وبخاصة فيما يتعلق بالثالوث القديم: الأجانب والعبيد (أو الشرائح الدنيا من المجتمع) والنساء، وأكثر الحيزات «التقاطعية» هي من هذه المجموعات. معظم دول الكوكب ليست وحدات أخلاقية بحال. والعالم ككل ليس وحدة أخلاقية اليوم. ولعل العالمية لا تقوم إلا على الاشتراكية، على ألا يفهم ذلك على غرار الاشتراكية الشيوعية في القرن العشرين. فقد ألغت المتكلم الآخر، ولم ترحب بالأجنبي والغريب، وتسببت بكوارث بيئية (تشيرنوبيل، تلويث بحيرة بايكال، وهي أكبر مورد للماء العذب في العالم)، وأنتجت ضروباً من التمييز تفوق ما أنتجت الديمقراطية. الاشتراكية في هذه المناقشة هي حركة حضور الغائب، وبالطبع حضور المتكلم الآخر، وضمان الحوار. فرصة الاشتراكية كحركة أكبر في أطر ديمقراطية، تقبل وجود كلامين، وتقر النفي.
التعلم كعمل
فإذا فكرنا في توصيات لنظام تعليمي نتدرب فيه على تفكير متجدد لزم أن يكون حوارياً هو ذاته من الصنف الذي زكاه باولو فريري في بيداغوجيا المقهورين:Freire, Paulo. 1972. Pedagogy of the oppressed. [New York]: Herder and Herder. تعلم ينفي تمركز الحقيقة حول المعلم الذي يحتكر الكلام الصحيح والسلطة التعليمية. لزم كذلك أن يشجع هذا النظام المتعلمين على المجادلة والاعتراض. ألا يكون نظام تغييب بعد ذلك، سواءً كان التغييب قومياً أو دينياً أو جندرياً، وبالعكس، أن ننشغل في كل وضع معطى في التساؤل عما يُغيِّب. فيريري فكر في تعليم يصاغ مع المقهورين، أي مع غائبي الصوت، ولا يُعَد لهم من فوق من قبل محتكرين للكلام الصحيح.
يبقى أن الغرض المجمل من التمييز بين أنماط التفكير الثلاث هذه هو أن ندرج تفكيرنا في إطار أوسع لندرك حدوده ولنعمل على التجاوز. والنمط الواحدي يتسبب في إعاقة تكيفية كما تقدم، وهو لا يديم نفسه بغير العنف في شروط اليوم. النمط الحواري هو إطار أغنى للثقافة والسياسة، وإن يكن استبعادياً لمن هم من غير الأمة. أما النمط الاشتراكي فهو حركة باتجاه الغائب، حركة تحررية لأنها تعمل من أجل حضور الغائبين وكلامهم.
ويظهر من مجمل هذه المناقشة ترابط وثيق بين التفكير والسياسة، وأن تعلم التفكير بصورة أخرى هو فعل نضالي، انخراط في الصراع من أجل امتلاك الكلام ومن أجل الحضور. ليست المسألة أن تغيير العالم أولى من تفسيره على ما بدا لماركس، بل أننا نكون في وضع أفضل لتفسير العالم بالانخراط في العمل من أجل التغيّر فيه وتغييره.