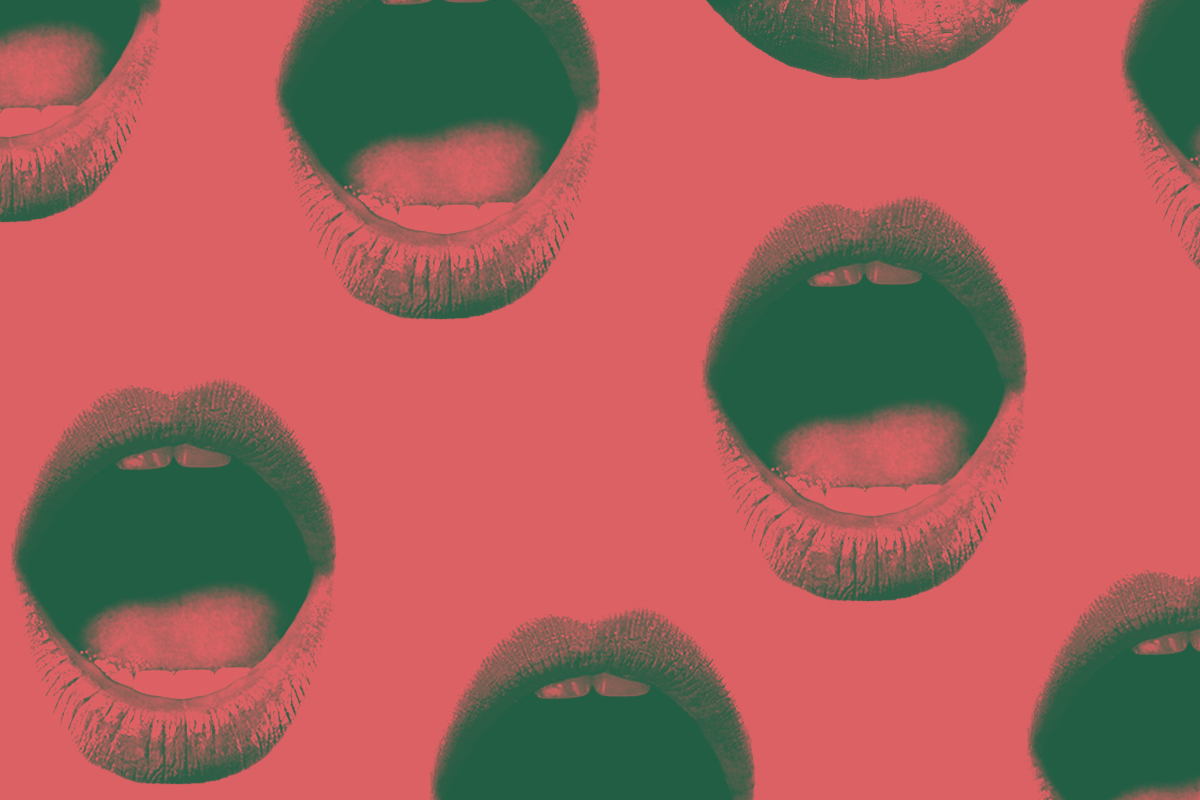لأتمكن من تحريك بدال الدراجة، يلزمني أولاً دفع الأرض بقدمي دفعة هينة، خارجة عن صميم عمل الدراجة وعن آلية التبديل كلها، ولكن من دونها لن تتتحرّك المركبة وتستقر على عجلتيها، وبالتالي فلن أطمئن أنا لرفع قدميّ عالياً وإسنادهما على البدال.
يذكّرني هذا بكل مرة عرضت فيها فكرة أمام أصدقائي، وكيف كان لزاماً عليّ التفوه أولاً بكلمات مرتبكة ولا معنى لها، من عينة «طيب» و«يعني» و«آه» و«لأ»، كلمات زائدة ويمكن حذفها بسهولة، ولا تكمن قيمتها سوى في قدرتها على شحذ ذهني باتجاه الهدف الذي أرمي إليه، كلمات أكسب بها بعض الوقت للانتقال من وضع الصمت لوضع الكلام.
ولكنه يذكّرني أيضاً بأمر ما متعلّق بالسكون، الذي هو – نظرياً – الصوت الصافي للحرف، وأقول «نظرياً» لأنني عندما أضرب أمثلة لابنتي على الحروف الساكنة، أجد نفسي متعثراً؛ الكاف الساكنة أنطقها «كِ» والزاي أنطقها «اِز»، عاجزاً، في كل الأحوال، عن نطق الصوت الساكن نفسه منفرداً.
* * * * *
يعرف علماء اللغة والتلاوة أن ثمة نوعين من الأصوات؛ صوت شديد ينفجر من الفم دفعة واحدة، وآخر رخو يمكنك مواصلة نطقه على قدر ما يسمح نَفَسك، وقد ملت في حالة الصوت الشديد، ولتقريب لفظه من السكون، لكسره كسراً خفيفاً، أما الرخو فقد اضطررت لأن أسبقه بصوت مكسور ما، صوت لم أعرف كنهه وقتها.
أنتبه الآن أن تكنيكيّ هذين قد يسريان على اللغات الأوروبية أيضاً، والتي يُظن فيها القدرة على البدء بالسكون. فلو أبطأنا من نطقنا لكلمة سْتوپ (stop) الإنجليزية مثلاً، للاحظنا أن حرف الـ«إس» الرخو مسبوق بصوت مكسور وغير مبين، كأنه «اِسْتوپ»، صوت يسميه ابن جني «صُوَيْتاً»، ويرسمه كألف وصل مكسورة، وكثيراً ما سمعت مصريين يبالغون هازلين في لفظ الكلمة قائلين: إيستووب.
وعلى الناحية الأخرى، فلو أبطأنا من نطق حرف الـ«تي» الشديد الذي تبدأ به كلمة تْرَسْتْ (trust) مثلاً، للاحظنا كونه هو نفسه مكسوراً: تِراست.
في فيلم «عسل أسود»، يلتقي أحمد حلمي، العائد لمصر من أمريكا، بمعلّمة اللغة الإنكليزية ذات اللكنة المريعة، والتي تنطق كْلاس (class) كأنها «كيلاس». ولكي تبدو الكوميديا في المشهد معقولة، فهي لا تنطقها «كالاس»، ولا «كولاس»، فقط «كِيلاس»، تروح بشكل بديهي لكسر الحرف المُفترض به السكون والحياد.
تجنباً للاستحالة الفيزيائية الكامنة في التقاء الساكنين دون وقف، كثيراً ما مالت العرب لكسر الساكن الأول، في مثل «ومن لم يجعلِ الله له مخرجاً»، وهو ما تفعله كثير من المحكيات العربية الآن بلا حرج، حين يُكسر الحرف الأخير الساكن في الكلمة، في حال استمرار الكلام، في مثل «كلبِ الْشارع» أو «بحرِ الْشمال».
تلافياً لالتقاء الساكنين أيضاً، يقال في الشام يقال «أنا أكَلِتْ»، وصحيح أننا في مصر نقول «أنا أكَلْتْ»، غير أن هذا لا يحدث إلا لدى الوقف حصراً، إذ لو استمرت الجملة فستُكسر تاء الضمير بلا هوادة: أنا أكلْتِ مكرونة أو أكلْتِ فْراخ.
قد يكون هذا الكسر الخفيف للصوت الساكن قريباً مما يُقصد بـ«القلقلة» القرآنية، والتي تسري على حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال، حروف كلها – باستثناء الجيم الإشكالي – شديدة، أي انفجارية، بوضوح، وتتحتّم قلقلتها، أي لوكها في الفم لوكاً خفيفاً، إذا جاءت ساكنة.
يؤكّد علماء التلاوة على الفرق بين قلقلة الحرف وبين تحريكه باتجاه أي من الحركات المعروفة، الفتح والكسر والضم، إذ القلقلة – كما يقولون – محض هزٍّ خفيف للحرف الساكن.
ولكن أليس الهزُّ شكلاً، ولو صغيراً، من التحريك، وهل يمكن لصوت أن يهتز في غير اتجاه؟ ما أسمعه غالباً، في الحروف المقلقلة، وصوّبوا لي لو أن أذنتي خانتني ، هو الكسر شديد الخفوت.
* * * * *
لو أن أعجمياً أراد، قبل وضع علامات التشكيل، أن يتعلّم العربية عن طريق القراءة، لخمّن أن لغتنا لا تحوي سوى صوامت ساكنة، بلا حركات، باستثناء أحيان نادرة يظهر فيها الألف أو الواو أو الياء في متن الكلمة.
أعتقد أن شيئاً على غرار هذا الخلط بين اللغة المنطوقة وقواعد الإملاء هو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بقدرة الأوروبيين على البدء بالسكون، فيما قد لا يرجع هذا سوى لقرار من نخبة معينة بالتقريب بين حرفي التي والآر في كلمة تْرَسْتْ، بعد أن سُمعت المسافة الفاصلة بينهما أقصر من المسافة بين الآر والإس، على نحو ما فعله النحاة اليهود مثلاً في العصور الوسطى، تأثراً بالسريان، حين قرّروا أن ثمة سكوناً ثابتاً، نعرفه جميعاً، وسكوناً متحركاً يميل للكسر.
هل كان حرياً بكلمة «وَلَد» العربية، كما أخبرنا أستاذ علم لغة ما، أن تُجمع على هيئة «وْلاد»، ولم تُضَف إليها الهمزة الأولية سوى لأن العرب لا يبدأون بالسكون؟
ثمة مؤشرات في كل الأحوال على أن العرب لاحظوا صوتاً ما، لا يرقى لدرجة الهمز، يسبق الحرف الساكن في بداية الكلام.
رأيت هذا في كلام ابن جني عن الصوَيْت الذي يسبق السكون «نحو قولك اِحْ واِصْ»، كما رأيته في رسم ألف التعريف، ذلك الصوت المتحرك الواقع في منزلة بين الهمز وحرف المد، والذي يساعد على النطق باللام الساكنة من بعده.
لشد ما دهشت، بهذه المناسبة، حين رأيت «الله» تُكتب مهموزة في علم العراق البعثي: ألله أكبر.
لفعل الأمر الثلاثي الصحيح هو الآخر علاقة وثيقة بالسكون، ليس فقط لكونه مجزوم الآخر، كما يليق بالحسم والجزم في معناه، ولكن لأن شيئاً في أوله أيضاً يتراوح حول السكون؛ تدوّنه العبرية على هيئة «فْعَل»، والفاء مكسورة بخفة، ويكتبه السوريين كأنه «طْلاع» و«سْماع»، ثم أن أوله يأتي ساكناً في العربية الفصحى، فيُسبق بالتالي بالصويت المعجز، ألف الوصل المكسورة: «اِطْلع»، «اِسْمع» أو «اِذْهبا إلى فرغون إنه طغى».
مثل الكلمات التي ننطقها بلا غرض سوى تأهيلنا للخروج من الصمت للكلام، يأتي هذا الصوَيْت، بلا قيمة صوتية في ذاته، سوى في حمله للحركة التي ترافقه، الحركة التي، بدورها، لا تفيد سوى في تمهيد الأرض للسكون كي يأتي أخيراً، مستقراً ومتحقّقاً ومشبَعاً وشبعاناً.