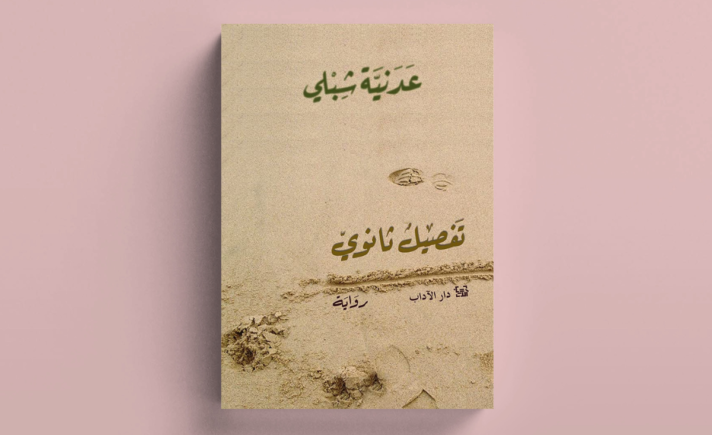في حوار: رسالة إلى لورين
سارة أحمد
العزيزة لورين،
عرفتُ أننا سنفقدك. أخبرتِنا ذلك بكلمات أو بأخرى. كم أنت بارعة في الكلمات، حتى أنه من الصعب ألا يلهيني جمالها عن قسوة ما كنتِ تقولينه لنا. عندما سمعت أنكِ متِّ، لم أشعر إلّا بالضياع.
ماذا لو كانت مَن فقدتِها هي أفضلَ مَن تشرح لكِ ذاك الفقدان؟
عندما نفقد شخصاً ما، نفقد الكلمات التي كان يمكن أن نتشاركها في ذلك المستقبل الذي لن يراه. لا كلمات كي أصف شعوري وأنا ألفظ هذه الكلمات: ماتت لورين برلنت. أنّكِ متِّ. لا كلمات، لكن بلى، فالكلمات الغائبة هي كلماتٌ تتطلّع لشيء ما، تصلنا بأحدٍ ما. ما زلتُ غير قادرةٍ على التصديق. لو أن التصديق يتمهّل قليلاً، خُذْ وقتَك لتصل، خُذْ وقتَك. كان حضوركِ مرشداً لي، كمَعلمٍ، كتلك الشجرة المميّزة في قوامها، أو ذاك البرج الذي ترينه وأنت قريبة منه أو بعيدة عنه، فيتيح لك أن تعرفي وجهتك، يدلّك على الطريق. أشعر بأنّي بلا وجهة، بلا بوصلة، من دون وجودك هنا. لستُ أعرف طريقي.
نتخبّط. علّمتِني أن أنتبه لما نفعله عندما نتخبّط. لا تزال كلماتك ترشدني. أنا ممتنّة لها كلّها. يكفي أن أقرأ عدداً قليلاً منها حتى أعرف أنها كانت كلماتكِ. لديك أسلوب لا يشبه أسلوب أحد آخر، جمل حادّة ذات خليط عجيب، حادّة ومبهمة، تأتيكِ وتفلت منك في آنٍ معاً. بارعة أنت في التقاط التفاصيل، تدوزنين الجمل وسط الضوضاء والتشويش والفوضى كي تسمعي فرادة نوتة، حادّةٍ، واضحة حتى الموت. وجدتِ في مادة الحياة اليومية أدوات عدّة للتفكير، تقلبين الأشياء على رأسها، تنظرين إليها من نواحٍ مختلفة، كي تُضيء أو تلمع، أو تنظرين إلينا من نواحٍ مختلفة، كي نُضيء أو نلمع. لا أعرف أحداً ولم أقرأ لأحد بهذه القدرة على شرح صعوبة تَخلّينا عن الروابط العاطفية،تشير سارة أحمد هنا إلى العلاقة بين «التفاؤل القاسي» كما عرّفت عنه برلنت في كتابها التفاؤل القاسي، أي التعلّق العاطفي بما يعيق السعادة، ومفهوم سارة أحمد عن الطقّة النسوية التي تأتي كرد فعل على شرط التعلق العاطفي وممارسة للقطيعة معه. حتى لو كنّا نحن من يمتلك الأدلّة على خلل تلك الروابط ونحن واعيات في الآن نفسه لإمكانية إعادة ترتيب الأشياء، لجعل الزلة بدايةً لقصة أخرى، في الوقت الذي نتخبّط فيه، ونواجه ما لا يرقى، بل لن يرقى إلى أن يصبح حدثاً.في فكر برلنت، الحدث هو الاعتيادي الذي يصبح له معنى. تقول في التفاؤل القاسي: «الوضع هو عندما يتكشّف في الممارسات الاعتيادية للحياة شيء قد يصبح له معنى. هي حالة من الإرجاء الحي والمُحيي الذي يفرض نفسه على الوعي، والذي يؤدي إلى شعور بأن ما يظهر اليوم قد يصير حدثاً في ما بعد».
كذلك لم أقرأ لأحد على هذا القدر من الاهتمام بالآخرين، من الفضول لمعرفة تاريخهم، عمّا أتى بهم إلى أبحاثهم، عمّا أتوا به إلى أبحاثهم، أو لأحد بهذا القدر من الولاء لمهمة التفكير، لمواصلة التفكير بالعوالم والمشاعر والأفكار والروابط التي تجمعنا، حتّى أن ما قد يبدو للوهلة الأولى جامداً، كالأعراف مثلاً، بات أكثر ليونةً، أكثر اتّساعاً، أكثر خفّة. أحياناً، كَوْني خجولة – إلا حين أكون في سياق رسمي أعرف قوانينه – وكوني إنسانة تضع حدوداً صارمة للآخرين، أكثر ممّا يجب – لكننا نحاول، نحاول أن نعيش بأفضل طريقة ممكنة – كانت تربكني حدّة انتباهك، فيُقلقني ما قد ترينه أو لا ترينه فيّ. كنتُ في الوقت ذاته ممنونةً لهذا الانتباه وللوقت الذي أعطيتِني. الامتنان يحاكي الحِداد، الشعور بأن ما تقدّمه إحداهنّ لنا، ينذر بما قد نفقده؛ احتمال الفقدان، حتمية الفقدان. سألتِ: «أنا منظّرة الحب. كيف حصل لي ذلك؟».في نص نشرته على مدوّنتها تقول برلنت: «أنا منظرة الحبّ. أحياناً أشعر بأني معزولة عن كل من أحبّ. أحياناً أطلب منهم أن يتمسّكوا بصورة عني، حتى أنا لا أقوى على مسكها. أعني بـ “أحياناً”، دائماً. الصورة هي الشكل الناكص، وليس الضجيج السردي الذي يأتي لاحقاً ليضمّد الفانتازيا وتمثّلاتها في الأشياء، كي أعرف أنّي حدثٌ يعيش في هذا العالم .(…) أنا منظّرة الحب، ولكن كيف حصل ذلك؟ كنت أمارس نقد الأيديولوجيا فوقعت في البئر، في كأس ماء». انظروا أيضاً إلى كتاب برلنت الحب/الرغبة (2012). أظنّني أعرف كيف حصل ذلك: منظّرة الحب، منظّرة مُحبّة، منظّرة للحب والفقدان والعلاقات التي تنتهي، كما ننتهي نحن، حيث لا ندري.
حيث لا ندري. في المرة الأولى التي التقيتُ بكِ، رأيتُ اسمكِ، قرأتُ كلماتٍ كتبتِها – نعم، قد يكون ذلك كافياً للقاء أحد ما – كان على قصاصة ورقة وَضَعَتها في بريدي زميلةٌ ستصبح لاحقاً رفيقة دربي (كنتِ شاهدة على القصة!)، سارة فرانكلين. كم أحبّ ذلك: أني قرأت اسمكِ للمرة الأولى، قرأتُ كلماتكِ، بفضل قصاصة وضعتْها في بريدي صديقة لكِ. يمكن أن تكون للعلاقات أولوية؛ يمكنها أن تكون الطريقة التي نعثر فيها على كلمات بعضنا بعضاً. كانت سارة قد نسخت دعوةً لتقديم أبحاث للعدد الخاص عن الحميمية ووزّعَتها على جميع الأساتذة. كتبتُ لك إيميلاً. اقترحتُ أن أكتب بحثاً عن الحميمية والسيرة الذاتية. حينها، كنت أكتب فصلاً من كتابي لقاءات غريبة الذي قرّبني من مفهوم الحميمية، وإن لم يكن عنه. كنتُ محاضِرة مبتدئة آنذاك، حاصلة على الدكتوراه للتو، ولم يكن كتابي الأول القائم على الأطروحة قد صدر بعد،نشرت سارة أحمد أطروحتها عن النسوية ونظريات ما بعد الحداثة في كتاب الاختلافات التي تعني شيئاً: النظرية النسوية وما بعد الحداثة (2009). مما يعني أنني كنت لا أزال أحاول أن أطوّع نفسي لأي منصب، لأي فرصة. كنت آمل أن يكون القرب كافياً. شرحتِ لي كيف أنّ اقتراحي لم يكن ما أردتِه للمشروع. لم أعد أذكر الكلمات التي استخدمتِها، ولكنها أوحت بما معناه أنّ مقاربة الحميمية من السيرة الذاتية أمر بديهي. كان في محادثاتنا الأولى قليلٌ من التوتر- وهنا السخرية – لأني شرحت لك كيف يمكن للسيرة الذاتية أن تقدّم لنا وجهة نظر غير متوقّعة عن الحميمية، تحديداً لأننا نتوقّع أن نعثر فيها على الحميمية. لم أكن أعرف حينها كيف أن الالتفات إلى البديهي (أو الالتفات إلى ما نفترضه عن مكمن الأشياء والناس) سيصبحُ لاحقاً محور عملي وطريقتي في تعقّب الأفكار.
أظنّ أنّ السنوات اللاحقة شابها توتّر بيننا. هناك أثر له في بعض كتاباتنا. صوّرَتني مقدّمة التفاؤل القاسي، مثلاً، بأني مهتمة بالشعور لا الانفعال. رغم أني كنت قد انتقدتُ فعل التفريق بين الشعور والانفعال، إلا أن غالبيّة أعمالي كانت عن الوعود، والأهواء، والمواضيع اللزجة، واقتصاديات الانفعال، وعن كيف تتغلغل السرديات التاريخية فينا، ممّا جعل أعمالي تتحرّك في مجالِ ما يُسمّى أحياناً «نظريات الانفعال». أشرتُ إلى حجّتكِ في مقدّمتي للطبعة الثانية من السياسات الثقافية للشعور كمثال على كيف أُعطي الانفعال والشعور مسارات (وحتى مواضيع) منفصلة. لم نتناقش في تلك النقطة قط، وكم أتمنّى لو قمنا بذلك. بعد فترة طويلة، عندما كنت تكتبين مقالة «الجنس وحدث السعادة» التي أظنّها ستصدر في كتابك الجديد (كم يسعدني أن أقول، «كتاب لورين برلنت الجديد»!)، سألتِني إن كنا نستطيع أن نفكّر معاً، لأن «كتاباتك بتخضّني (بالمعنى المنيح)»، في إشارة، على ما أفترض، إلى وعد السعادة. لم أكن على السمع عندما أرسلتِ لي هذه الرسالة القصيرة، ولم نتمكّن من التفكير معاً. لن نتمكّن من التفكير معاً.
بالرغم من تلك التخبّطات والتوترات، تَشاركنا الكثير في أعمالنا. لعلّ «بالرغم» هذه، ليست في مكانها. قد تكون التخبّطات والتوترات الطريقة التي نسكن فيها العلاقة. أن نسكن علاقة، كما كنت تكرّرين، هو الفرح (والعناء أيضاً)، أن تكوني مع شخص لستِ هي.
ولكن التفكير في التوتر دفعني إلى حرق المراحل. دعيني أعُد إلى الوراء.
تواصلُنا الأوّل، إن لم تخُنّي الذاكرة، كان سنة 1996. دعوناك بعد ذلك لتفتتحي مؤتمر «تحولات: التفكير عن طريق النسوية» في تمّوز 1997. كان ذلك أول المؤتمرات العالمية لمركز دراسات المرأة في جامعة لانكستر؛ كان حدثاً مهماً جداً في حياة المركز. تحدّثتِ في جلسة الانعقاد الأولى، وفي المرة الأولى التي رأيتك فيها، كنتِ قد اعتليتِ منصّةً. كنتِ ترتدين تنورة جلد قصيرة، على ما أذكر، ولا أذكر إلا أنّي قلت، واو، كم أنتِ أنيقة وجذّابة. بالحقيقة، شعرت بالهيبة كثيراً عندما تحدّثنا وجهاً لوجه للمرة الأولى، وذكرتِ شيئاً عن ذلك -لا أذكر الكلمات- عن أن التوتّر الذي شاب تواصلنا الأول، جعلكِ تظنّين أنني أكثر شراسة من الانطباع الذي كنت أعطيه (شخصيتي النكدة النسوية غاضبةٌ فعلاً، وشرسة أيضاً، لكنّها لا تظهر إلا في بعض المناسبات). علمتُ لاحقاً، أنك فهمتِ ذلك، فهمتِه، فهمتِني، فهمتِ كيف يمكنني أن أزاول مهمّة النكدة النسوية لا بالرغم من خجلي، من قلقي، من حساسيتي، بل بسبب ذلك كله؛ العتاد الذي نحمله، له قصة أيضاً، هي قصتنا. يصبح للقساوة معنىً عند اللواتي يدركن هشاشتهن.
سأعرف لاحقاً كم كنتِ قارئة جيدة، ليس فقط للنصوص، بل للناس أيضاً.
وحبستِ أنفاس الحضور في محاضرة عن: ذوات الشعور الحق: الوجع، والخصوصية، والسياسة، التي ما زلتُ أتعلّم منها الكثير. كانت المرّة الأولى التي أسمعَك تحاضرين فيها. بعدها، سمعتك مراراً. أحببت كيف وقفتِ («وضعية الشجرة»، كما يدعوها البعض)، كيف ضحكتِ، كيف ملأتِ المكان، وفي الوقت ذاته، جعلتِه مكاناً للآخرين. لا تزال الأسئلة التي طرحتِها في تلك المحاضرة، والتي نشرناها فصلاً في كتابنا، في غاية الأهمية: «ما مصير الأسئلة المتعلّقة بإدارة الاختلاف والغيرية والموارد في الحياة الجماعية، حين يصبح الشعور بعدم الارتياح دليلاً على الشروط البنيوية للظلم؟ ماذا يحصل لنظرية التغيير الاجتماعي وتطبيقها، حين يصبح الشعور بالرضا دليلاً على انتصار الحق؟» بعدها، عدتِ إلى لانكستر لمؤتمر عن «ثقافات الشهادة والأجندات النسوية» سنة 1999 نظّمتُه أنا وجاكي ستايسي، حيث قدّمتِ محاضرة رائعة أخرى: «التروما والركاكة»، نشرناها في مجلّة كلتشورال فاليوز. هناك جملة تحضرني: «الشهادات التي تختزن التاريخ تشبه الاستعارات الميتة، تتحدّى قرّاءها كي يُحيوها». ساعدتِني في مساءلة كيف تتحوّل التروما فرصةً لتلبية آمال أولئك الممحوّين، المُخضَعين، لكن أيضاً كيف نتخيّل من خلال هذا السؤال طريقةً أخرى لاستيعاب تروما الآخر، من أجل نفخ الحياة في استعارة ميتة.
جاءت الألفية الجديدة ومعها مشاريع أخرى لدعوتك مجدداً إلى لانكستر. أخذتْ سارة فرانكلين المبادرة لاقتراح منصب أستاذة زائرة برعاية ليفيرهوم. وبعدها في صيف 2001 و2002، عدتِ فترات طويلة، شاركتِ فيها في عدد من الفعاليات الرسميّة وغير الرسميّة والتي يجمعها عنوان عريض: «المشاعر في العام». بين 1997 و2002، إذن، كنتِ حاضرة جداً، في مرحلة كنت أعمل فيها على السياسات الثقافية للشعور، وقرّرتُ الكتابة عن السعادة — قرار أعرف أني استلهمتُه من نقاشاتنا كما من تجربتي في أبحاثي الميدانية حول التعددية والعنصرية. الكتابة عن السعادة أوصلتني إلى مفهوم النكدة النسوية، إلى العمل على تغيير عملي كي يصبح أقلّ ارتباطاً بالجامعة، أكثر تحرّراً من الآليات التي تحكم عملنا في الجامعة. وهكذا صرت أكتب عنها، عن الجامعة، وعن المؤسسات وتاريخها المتشعّب.
بالعودة إلى تلك اللحظة، إلى صدفة وجودك آنذاك، يمكنني أن أرى كم أصبحت أعمالي عن الشعور والانفعال ممكنة بفضل حواري معك والأثر الذي تركتِه علينا جميعاً، نحن الباحثات في الدراسات الجندرية والدراسات الثقافية في بريطانيا. في الكلمة الختامية في السياسات الثقافية للشعور، كتبتُ، «أنا مدينة للورين برلنت وأسئلتها حول متى تصبح الأعراف أشكالاً، تلك الأسئلة التي كانت مصدر إلهام في أعمالي».
الإلهام. قد لا ينحصر الإلهام في الدعم المعنوي أو التشجيع، ولكن أيضاً في جعل الآخر يتنفّس، في إعطاء نَفَس. الحياة التي نفختِها في أعمالي تدفّقت في كل أعمالي. في فينومينولوجيا الكوير، اقتبستُ مقالتك «الجنس في الحيز العام»، التي شاركتِ في كتابتها، والتي تتضمّن وصفاً رائعاً للعوالم الكويرية: «العالم الكويري هو مساحة للمداخل، للمخارج، خطوط غير منسّقة للإدراك، خطوط تتخيّل آفاقاً ممكنة، تجسّد الأمثلة، طرقاً بديلة، انسدادات، جغرافيا غير متساوية» (2005: 198). في وعد السعادة، استعرتُ عبارتكِ التي أبهجتني حدّتها، «فانتازيا السعادة المشوشة» وأيضاً قولك إن المواضيع «خصل من الوعود». في ذوات معاندة، استعدت مقالتك موت بطيء، للتعمّق في مفهوم الطقّة، فقلت إن الطقّة تبدو لنا مباغتة لأنه «لا يمكننا رؤية الأيام البطيئة التي أُجبرنا فيها على التحمّل والتأقلم»، وارتكزت أيضاً إلى وصفك لمعضلة كيف تصبح الإرادة هي المشكلة. كما كتبتِ في ملكة أميركا تذهب إلى مدينة واشنطن الذي ما زال كتابك المفضّل عندي: «في الحياة الرغيدة التي تتخيّلها الدولة المتقلِّصة، لا يُعَدّ اشتراط الرأسمالية وجود مجموعات من العمّال تحت الطلب من ذوي الأجر المنخفض أو آخرين يعملون بالمؤقت، مشكلةً بنيويّة، بل مشكلة إرادة وابتكار» (2004: 4). عدتُ مراراً إلى أعمالك في عيش حياة نسوية، وفكّرتُ مع مفهومك عن «التفاؤل القاسي»، متسائلةً عمّن يقدر على الجزم إن كانت خياراتنا في الحياة صالحةً أم لا، وفكّرتُ أيضاً مع شرحك لمفهوم «الوضع»: «عندما يتكشّف في الممارسات الاعتيادية للحياة شيء قد يصبح له معنى».انظروا إلى الملاحظة 4.
نعم، تعلّمينني كيف أصف ما يجري، ممارسات الحياة الاعتيادية، كيف ألاحظ ما يمكنه أن يكون مهمّاً وهو يتكشّف أمامي، أن ألاحظ ما يتكشّف أمامي كوسيلة للإمساك بشيء ما، بخفّة.
ما نصنعه هشٌٌ لأننا بحاجة إليه كي ننجو.

لقد التقينا عبر السنين. جئتِ إلى لندن. أذكر أني طبخت لك ولشريكتينا أنواعاً من كاري الخضار. بعدها جئتُ إلى شيكاغو مرات عدة، مرة لأعطي محاضرة في برنامجك، وأخرى لأحاضر في جامعة أخرى. أظنّ المرّة الأولى كانت سنة 2013. كم كنتِ مضيفة كريمة. المرة الثانية كانت عام 2015 — المرة الأخيرة التي التقينا فيها وجهاً لوجه. التقينا عند كوافيرك وقضينا بعض الوقت معاً. كنتُ مشغولة وقتها في دعم طالبات تقدّمن بشكوى جماعية ضدّ التحرّش الجنسي، ممّا أدّى إلى تركي ليس فقط لمنصبي، ولكن لمهنتنا أيضاً — أخبرتك عن ذلك. حاولتْ كلٌّ منا في أعمالها وأسلوبها التفكير في أذى المؤسسات وعنفها، وفي كيفية التعامل معها في الممارسة. يمكن للممارسة أن تحوّل الأفكار إلى عناية بالآخرين. عندما تركتُ منصبي، تركتُ فيسبوك أيضاً، حيث اعتدنا على التواصل. كانت هناك مرحلة، سنتان تقريباً، لم نتواصل فيها. أندم على ذلك. عندما عدنا، قلتِ إنّكِ تأملين أن أكون قد بدأت أشعر بالحرية أكثر. قلتُ إنني في طريقي إليها. فمن الصعب أن تضعي المؤسسة وراءك؛ لا بدّ أن تعثر عليك. ولكن أجبتك أنّ البحث في مفهوم الشكوى ساعدني كثيراً.
على سيرة الشكوى. لطالما توقّعت من عملي حول مفهوم الشكوى أن يحاور بشكل مباشر الشكوى النسائية، الكتاب الثاني في ثلاثيّتك المدهشة. تعلّمت الكثير من ذلك الكتاب عن الشكوى كمفهوم مطّاط. ولكنني لم أحاورك. ذلك أنّ كتابي شكوى! أخذ صوت اللواتي قابلتهنّ، صوت تحالف أولئك الشاكيات. أصبحنَ هنّ مُنظّراتي. فلم أفعل ما أفعله عادة، أي ملاحقة الشكوى، ملاحقة الكلمة، وهي ملاحقات كانت ستقودني إلى كتابك، إلى التفاعل معه بشكل جدّي.سارة أحمد نشرت مقدمة شكوى! على مدونتها ريثما يصدر الكتاب في الأسابيع القليلة المقبلة.
أرسلتُ لك إيميلاً بهذا الخصوص. أردتُ أن تعرفي أنني أضعتُ فرصة أن نلتقي؛ الحوار الذي كنا نحن الاثنتين، على ما أظنّ، ننتظره. فهمتِ ما كنتُ أقوله لك. كتبتِ، «كأنك عم تقوليلي إنك ما كتير بتفكري مع الشكوى النسائية. هيدي خسارة إلي، لأن طول عمرنا كنا نتحاور. وقت يطلع الكتاب، لازم ننظم ندوة نتحاور فيها، متل ما تعوّدنا نعمل. عبالك؟ فيني نظّم القصّة بكل سهولة». حزنتُ لعبارة «خسارة إلي» ولكني فهمتُها. قلتُ، نعم، نعم لذلك الحوار. بعدها مرضتِ أكثر، فأكثر. بقيتِ ترسلين «رسائل لورينية» (الرسائل اللورينية لم تكن مجرّد رسائل أرسلتها لورين، بل رسائل شديدة التعبير عن لورين). كانت رسالتك الأخيرة في 11 حزيران، الشهر الذي رحلتِ فيه. قلتِ إنك تكتبين لي من «جحيم الوجع». قلتِ إنك قد رأيتِ كتابي، شكوى! في كتالوج منشورات جامعة ديوك، وقمتِ بقفشة لورينية عن كيف وضعتْ دار النشر صورتي على الغلاف (وكيف لم تفعل ذلك معكِ). بعدها قلتِ: «متحمّسة على نسختي. من هلّق لوقتها، شكراً لأنك فكرتِ معي مثل ما بفكّر معك. كتير بقدّر هيدا الشي».
كتير بقدّر هيدا الشي. أظنّك كنت تقولين لي إنّ هناك طرقاً عديدة كي نكون في حوار، وإنّ الحوار لم يفُتنا بعد. قد يكون الحوار هو بالذات ما نحن فيه: مساحةً، دائرةً، حميميةً ما.

«لم أكن أعرف أنّ الأمور ستنتهي إلى ذلك» (ما كتب على القبر السرّي للحميمية، بكلمات لورين).
قد نكون في حوار من دون أن نقيم حواراً.
نحن في حوار. هذا ما انتهت إليه الأمور.
أجبتك بإيميل وقلتُ إنني سأرسل لك أولى نسخي، نسخ المؤلّفة، وعليها إهداء. ما زلت أنوي أن أرسلها لك، بطبيعة الحال.
تقول إحدى ملاحظاتي الختامية للكتاب: «تشديدي على الطبيعة الانفعالية للشكوى يحاكي مفهوم لورين برلنت عن الشكوى النسائية. تصف برلنت الشكوى “كطريقة لأرشفة التجربة، تحويل التجربة لبرهان، والبرهان لحجّة، والحجة لعرف، والعرف لكليشيه، كليشيهات على قدر من القوة يمكّنها من الإمساك بإحداهنّ طوال حياتها” (227). تركيزي هو على الشكوى النسوية أكثر مما هو على الشكوى النسائية. يمكن للشكوى النسوية أيضاَ “أن تمسك بإحداهنّ طوال حياتها”، ولو بطريقة يقلّ فيها العرف والكليشيه. مع جزيل الشكر للورين برلنت على أعمالها الملهمة». عندما كتبتُ ذلك لم أكن أعرف أنك كنتِ قد بدأتِ تستخدمين ضميراً آخر. في حال صدور الطبعة الثانية، سأطلب تحويل «هي» إلى «هم»، احتراماً لخياراتك ولأعمالك.
أعرف أننا في حوار. أعرف أنك كنتِ تكتبين بشراسة من «جحيم الوجع»، ومن خلاله، بإخلاص لورينيّ، وأعرف أنّ مزيداً من الكتب سيصدر بفضل ذلك. ولكن ليتني أستطيع أن أحاورك أكثر، وجهاً لوجه، كي أسمع ضحكتك، وقع صوتك، كي أشعر بوجودك معي.
أكتب هذه الرسالة لكِ. أدرك أهمية أن نقول لبعضنا بعضاً ماذا تعني واحدتنا للأخرى. لا يمكننا أن نفعل ذلك دائماً. ندرك أحياناً أهمية الشيء عندما لا يعود ممكناً. أشارك هذه الرسالة على مدونتي، يا لورين، لأنك علّمتني بأنك إذا ما كتبتِ عن طريق الشعور، معه، فعليكِ أن تشاركيه. نخلق جماعة، مفجوعة، نعم، ولكنها أفضل مما كانت عليه، أكثر حدّةً، أكثر بهاءً حتى، لأننا عرفنا بعضنا بعضاً، عثرنا على بعضنا بعضاً، في الكلمات، في الأشخاص، في الخسارات والانكسارات الكويرية، الحيوات الكويرية، فخلقنا هيئات جديدة؛ تضيء، تلمع.
كتبتُ لك مرّة أخيرة بعد موتك.
«ما عم صدّق إنك بطلّتِ هون. رجعت على فيسبوك لأنه المحل يلي بذكر كنا نحكي فيه، بس لأسمعك. فيني دايماً إسمعك بكتاباتك، ما حدا عنده صوتك. رح إشتقلك كتير، بس رح ضلّ إتعلّم منك، لورين. بوعدك xxx.»
أعدِك يا لورين. أعدكِ أن أظلّ أتعلّم منك. أن أفكّر معكِ، أن أبقى على تواصل، أن أكون في حوار.
محبتي الدائمة،
سارة xxx