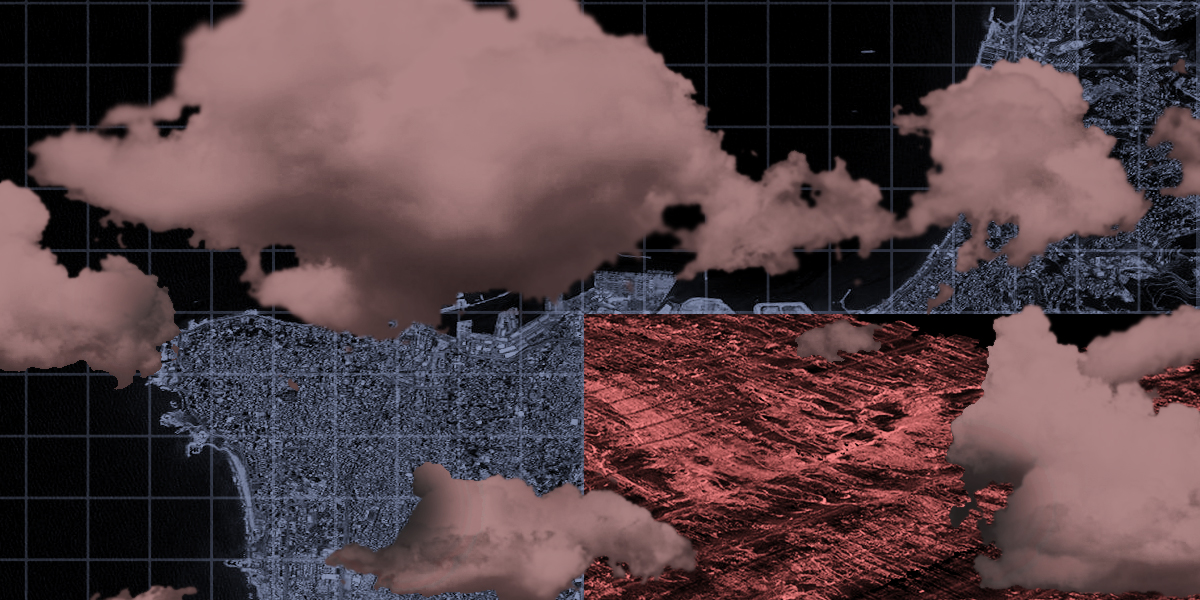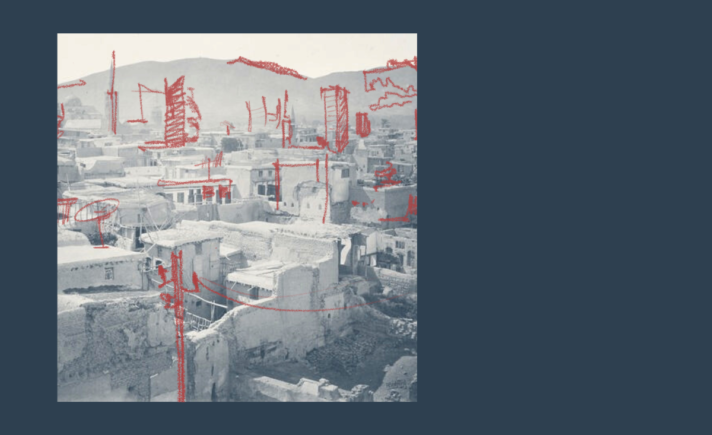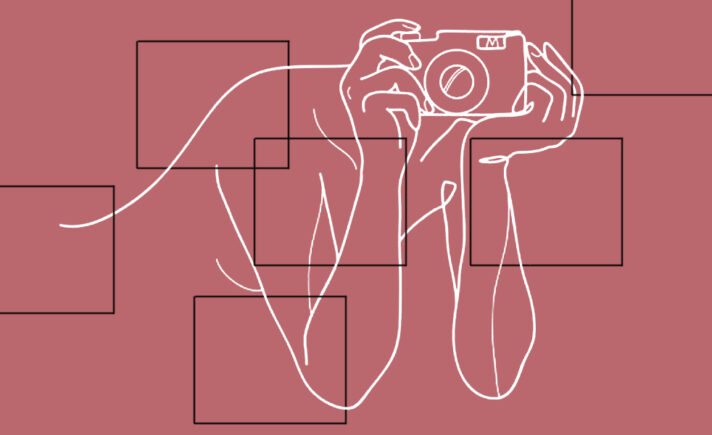خلال سبع سنوات فحسب، دُمّرت أجزاء مُعتَبَرة من مدن ثلاث في المشرق العربيّ، هي من أهمّ مدنه وأعظمها: الموصل في 2014 وحلب في 2016 وبيروت في 2020. المتسبّبون المباشرون بالمآسي كانوا: داعش في الموصل، ونظام الأسد وحلفاؤه في حلب، ونظام المحاصّة الطائفيّة المحميّ بـ«حزب الله» في بيروت.
لكنّنا إن عدنا قليلاً إلى الوراء داهمتنا غابة أسباب وعوامل متراكمة أوهنت هذه المدن وأضعفت مناعاتها حيال المآسي المذكورة ومرتكبيها. وإذا كان صعباً افتراض علاقة سببيّة بسيطة ودائمة بين أيّ من تلك الأسباب والسبب الآخر، فالمؤكّدَ وجودُ هَرَمٍ من ثنائيّات الظالم والمظلوم جثمَ على صدر المسار التاريخيّ المديد للمنطقة، واستقرّ بعضه الكثير في هذه المدن التي لعبت، هي نفسها، دور الظالم مرّات والمظلوم مرّات أخرى. وبهذا المعنى فإنّ الانتقائيّة في اختيار بعض الأحداث التي عاشتها المدن الثلاث، وإغفال أحداث أخرى ليست بالضرورة أقلّ أهميّة منها، محكومان بما تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليه، أي مصادر الإضعاف لمدينيّة المدن المذكورة.
الموصل
تُعَدّ الموصل مدينة العراق الثانية، والمركز التجاريّ الرئيس لشمال البلاد الغربيّ. لكنّ القلق لازمها في العصر الحديث إذ ظلّت لسنوات، بعد احتلال 1918 البريطانيّ للعراق، مُحيّرة الهويّة: أهي تركيّة أم جزء من العراق الناشىء للتوّ؟ وكان ما يعزّز الحيرةَ فصلُها عن باقي المدى العثمانيّ، والآثار التجاريّة السلبيّة الناجمة عن ذلك، والتي فاقت مثيلتها في بغداد والبصرة البعيدتين نسبيّاً.
والحال أنّ الموصل حُسبت ضمن رقعة الانتداب الفرنسيّ، واستمرّ التفاوض البريطانيّ-الفرنسيّ طويلاً بشأنها حتّى وافقت فرنسا على التخلّي عنها (وعن فلسطين) للبريطانيّين، مقابل حصّة من نفط المدينة وجوارها. لكنْ مقابل مكسب النفط الذي طُوِّرَت حقوله في شمال الموصل وشرقها، حضر الإحساس بفقد العلاقة التاريخيّة، التجاريّة والسياسيّة والقرابيّة، مع حلب. وهذا، على الأرجح، ما شكّل أحد الأسباب وراء قوّة القوميّين العرب لاحقاً في المدينة.
ومسلّحاً بانتصاره على اليونان في 1922، طالب مصطفى كمال بضمّ الموصل إلى تركيّا، ما كاد يتحوّل أزمةً دوليّة لم تُحلّ إلاّ في 1926 بتوقيع معاهدة بريطانيّة تركيّة عراقيّة ثبّتت حدود البلد الوليد. لكنْ ما إن هدأت العواصف التي أطلقتها السياسات الإقليميّة والمطامح الدوليّة وما يترجمها من خرائط، حتّى تململَ الداخل. ففي 1929 طالب نوّاب كرد بإنشاء إقليم كرديّ يشمل أجزاء من ولاية الموصل العثمانيّة.Charles Tripp, A History of Iraq (3rd ed.), Cambridge, 2007, p. 63.

والكرد موجودون بقوّة في أرياف الموصل، كما أنّ للمسيحيّين والإيزيديّين والتركمان وجوداً وازناً. أمّا في المدينة، فلم يكن العرب، إبّان الحرب العالميّة الأولى، يتجاوزون ثلث السكّان، وكانوا (170 ألفاً) يقلّون عن الكرد (179 ألفاً)، فيما كان مجموع «غير العرب» 241 ألفاً، و«غيرُ المسلمين»، المسيحيّين واليهود، 90 ألفاً.Isam Al-Khafaji, Tormented Births: Passages to Modernity in Europe and the Middle East, I.B.Tauris, 2004, p. 99. على أنّ الأمور راحت تتبدّل بعد الاستقلال، فباتت الأغلبيّة العربيّة كاسحة في المدينة، والكرديّة كاسحة في الريف، فيما شارك الطرفين نقاطَ إقامتهما مسيحيّون شكّلوا، في الخمسينات والستينات، خُمس المدينة وأكثر من عُشر الريفيّين، ومعهم نسبة مرموقة من الإيزيديّين.
ويتناول عصام الخفاجي البُعد الطبقيّ النافر، حيث «منذ مطالع القرن التاسع عشر، ومعظمُ قرويّي الموصل مُسجَّلون على أسماء الشيوخ والأغوات والمختارين والملّات أو أعيان آخرين، وفي بعض الحالات استمرّت القبائل في توفير الحماية للفلاّحين المسجّلين في الطابو (…) وكان نظام تأجير الأرض في الموصل أشرس كثيراً من أيّ مكان آخر في العراق. ففي 1880-1882 عطّلَ العثمانيّون تسجيل الأراضي لكنّ القرار لم يَسْرِ على الموصل والجزء الشماليّ من العراق. ومع الزمن باتت نسبة المسجّلين في الطابو، في الموصل، أعلى منها في أيّ مكان آخر في العراق. أمّا عمليّة تسجيل الأرض بأسماء المشايخ والأعيان فهي ما تنقله مصادر عدّة». وهو يستمدّ من بعض تلك المصادر صوراً عن المظالم النازلة بالفلاّحين، كأنْ يُعطى الفلاّح «25 بالمئة من قيمة أرضه من أجل أن يبيعـ[ـها]، فإذا رفض زُجّ به في السجن بِتُهَم زائفة كالقتل، إلى أن يغيّر رأيه».المرجع السابق، ص. 27.
على أنّ الآشوريّين كانوا، من بين تلك الجماعات، أوّل ضحايا المذبحة، وهو ما حصل عام 1933 في بلدة سميل، قرب المدينة.حاولت أطروحة جامعيّة لراسل هوبكنز (Russell A. Hopkins) في جامعة أكرون (أوهايو) أن تربط تلك المذبحة بالمجاري العريضة السابقة واللاحقة للحركة القوميّة في العراق. الأطروحة حملت عنوان The Simele Massacre as a Cause Of Iraqi Nationalism: How an Assyrian Genocide Created Iraqi Martial Nationalism. فما إن توقّف سفك الدم حتّى كُرّم مُنفّذوها الجنود والضبّاط بـ«عراضة انتصاريّة في الموصل».وفق السرديّة الآشوريّة جرت خمس مذابح للآشوريّين في العصر الحديث: 1843 (هاكاري)، 1914-23، 1933 (سميل)، 1969، 2014-5 (داعش).
ومن أجل وجهة نظر آشوريّة حول ما حلّ بهم على يد العثمانيّين في الحرب العالميّة الأولى، وهو ما يعتبرونه جريمة تطهير عرقيّ، انظر:
Travis, Hannibal (2006) “Native Christians Massacred: The Ottoman Genocide of the Assyrians during World War I”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 1: Iss. 3: Article 8.
واقع الأمر أنّ التركيب التعدّديّ (المدينيّ) دون ثقافته (المدينيّة)، معطوفاً على إحباطات مزمنة وعميقة، يفسّر التطرّف الذي شاب الموصل في تاريخ الحركة القوميّة العربيّة في العراق، والذي لازمه ضعف القبول بالمختلف والتعايش معه. ففي قاعدتها الجويّة، اغتيل عام 1937 بكر صدقي، الكرديّ الأصل الذي كرهه العروبيّون، والذي نفّذ الانقلاب العسكريّ الأوّل في العالم العربيّ. وقد رفض آمر حامية المدينة، الموصلّيّ (الموصلاويّ) أمين العمري، تسليم قاتليه إلى بغداد. ومن الموصل كان يونس السبعاوي، أحد الآباء المدنيّين الروحيّين لانقلاب 1941 الذي راهن على الدعم الألمانيّ والنازيّ لطرد البريطانيّين من العراق، وصلاح الدين الصبّاغ، أبرز ضبّاط تلك الحركة الأربعة (وهو من أصول صيداويّة لبنانيّة)، وكذلك يونس البحري المذيع الشهير من محطّة «حيّ العرب» في برلين، وسعيد الحاج ثابت، الموصوف بـ«أبرز المدافعين عن عروبة الموصل» ورئيس ومؤسّس «لجنة إنقاذ فلسطين». وربّما لم يكن عديم الدلالة، في وقت لاحق، أن يختار نجلا صدّام حسين، عديّ وقصيّ، مدينة الموصل كي يختبئا فيها بعد سقوط سلطة أبيهما، وأن يُقتلا هناك.
وأغلب الظنّ أنّ تهميش الموصل لصالح بغداد أضاف عنصراً ملتهباً في تعزيز التوجّهات الراديكاليّة لدى أوساط النُخب العربيّة الموصلّيّة. فمن أصل 22 رئيس حكومة في العهد الملكيّ (1921-1958)، كان هناك أربعة فقط من الموصل، وهو تهميش شاركتها إيّاه باقي مدن العراق، فكان هناك رئيس حكومة واحد من كلّ من البصرة والناصريّة وسامرّاء وأربيل والكاظميّة والحلّة، فيما الاثنا عشر الآخرون من بغداد.Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba’thists, and Free Officers, Princeton, 1978, Pp. 180-3.
لكنّ عرس الدم الأكبر كان ما سطع في آذار 1959، حين استفزّ الشيوعيّون، بتنظيمهم مؤتمراً حاشداً لـ«أنصار السلم» في الموصل، القوميّين العرب ممّن أحسّوا أنّ رئيس الحكومة عبد الكريم قاسم شرع يبتعد عنهم متحالفاً، حتّى ذاك الحين، مع الشيوعيّين. وبالفعل تمرّد القوميّون بزعامة آمر حامية الموصل الضابط عبد الوهاب الشوّاف، المدعوم من «الجمهوريّة العربيّة المتّحدة»، ضدّ حكومة قاسم. يومذاك تولّى الشيوعيّون سحق القوميّين، فيما هاجم الكردُ التركمانَ المعارضين لقاسم، وكان الشيوعيّون والكرد لا يزالون على ولائهم له. وكان «لأعمال النهب والإعدامات الميدانيّة في الموصل أن عكست التصدّعات العميقة في علاقات الكرد والعرب، والفلاّحين وملاّكي الأراضي، والشيوعيّين والقوميّين».المرجع السابق، ص. 866-889.
ويذهب حنّا بطاطو في رصده الخلفيّات إلى أنّ «الصراعات القَبَليّة والإثنيّة والطبقيّة كانت تنضج لسنوات. فالمشاعر السيّئة بين قبيلة البو متَيْوِت، المتوطّنة التي تعمل في الزراعة، وقبيلة شمّر، التي هي أصلاً قبيلة محاربين متنقّلين، تعود إلى 1946 على الأقلّ، حين قاد خلافٌ حول الأرض إلى مواجهة دمويّة قُتل فيها 144 رجلاً من الطرفين. أمّا الآشوريّون (…) فتعهّدوا كراهيّة مُرّة لعرب الموصل ترقى إلى 1933، حين لعب ضبّاط من تلك المدينة دوراً بارزاً في سحق تمرّد آشوريّ بائس. وبدورهم لطالما اعتبر الكردُ الموصلَ شوكةً في لحمهم؛ متراساً عربيّاً يُراد تحويله قطعة أرض يرون أنّها مُلكهم. فوق هذا، كانوا لا يزالون يتذكّرون قتل الحشود الموصلّيّة الغاضبة في 1909 الشيخَ سعيد البرزنجي وثمانية عشر شخصاً من معاونيه، وهو والد الثائر الشهير الشيخ محمود وقائد الطريقة الصوفيّة القادريّة في السليمانيّة. أمّا العداء الذي يكنّه فلاّحو ريف الموصل لملاّكيهم الزراعيّين [السنّة العرب] فهو أيضاً عميق التجذّر، تقيم مصادرُه في تَظلّمات أصيلة ومديدة العهد».المرجع نفسه، ص. 869-870.
وكان من عناصر المواجهة أنّ أحد الذين شاركوا فيها أحمد عجيل الياور، زعيم شُمّر، مقاتلاً إلى جانب القوميّين ضدّ الشيوعيّين والكرد وقاسم، ومستفيداً من توزّع عشيرته على بلدين هما العراق وسوريّا ومن ضعف تقيّدها بإملاءات الحدود الوطنيّة. فالياور، وكان المَلاّك الزراعيّ الأكبر في العراق، تنتشر أملاكه بين الموصل وبغداد، لم يتقبّل الإصلاح الزراعيّ بعد انقلاب 14 تموز الجمهوريّ، مندفعاً إلى الرفض الذي اندفع إليه.
وعموماً بدا «كما لو أنّ كلّ اللحمة الاجتماعيّة انحلّت وكلّ السلطة السياسيّة تبخّرت (…) فأطلق الصراع بين القوميّين والشيوعيّين أحقاداً شديدة القِدَم، موظّفاً إيّاها بقوّة تدميريّة ودافعاً بها إلى حدّ الحرب الأهليّة».المرجع نفسه، ص. 864. وفي تناوله حرب الجميع على الجميع هذه، والتي كلّفت مقتل وإعدام المئات، كما دلّلت مبكراً على معوقات التأسيس الجمهوريّ للعراق، لم تَفُت بطاطو الإشاراتُ المطوّلة إلى بعض الخلفيّات السوسيولوجيّة والثقافيّة. ففي تلك البيئة العريضة صمدت ثقافة دمويّة وسلاليّة متينة عملَ بعضها، منذ 1871، غطاءً ومبرّراً لانتهاكات مارسها الشمريّون على الفلاّحين والجماعات الأضعف، ولتعدّيات عليهم وعلى أملاكهم، كما عمل بعض تلك الثقافة، في حالة «سادة الموصل» و«أشرافها»، على تبرير قمع السكّان المحلّيّين لصالح السلطنة العثمانيّة. وهي ممارسة تعود إلى استقدام هؤلاء «الأشراف» من المدينة (يثرب) أواسط القرن السادس عشر.المرجع السابق، صفحات 229-32 و114 و21 و156-7.
فقد آمنَ هؤلاء، في الموصل كما في بغداد والبصرة، بأنّه «ما من دم يتمتّع بجودة دمهم»، لكنّ «الموصل امتلكت جماعة أريستوقراطيّة أشدّ انغلاقاً حتّى من البصرة. وكان ممّا يميّزها أنّ «عائلتها الأولى» في العشرينات لم تتفرّع عن السادة، إذ احتلّت المكان هذا عائلة الجليلي، من قبيلة تغلب العربيّة، أو بدقّة أكبر، من «فرع الباشوات» في آل الجليلي، أي المتفرّعين عن إسماعيل باشا والذي صدر عن بيته حكّام الموصل في القرن الثامن عشر. أمّا أجدادهم، وبما يكفي من غرابة، فكانوا مسيحيّين (ربّما بسبب مسيحيّتهم، وتأخُّر تحوّلهم إلى الإسلام، احتلّ الدم لديهم موقعاً تجاوز ما احتلّه لدى المسلمين الذين وجدوا في الدين شريكاً أكبر من الدم). وبحسب ما لاحظه مراقب مطّلع في 1909، بلغ نقاء نَسَب الرأس الحاليّ للفرع المذكور من العائلة حدّاً جعل شقيقاته لا يتزوّجن لأنّه لا يتوفّر في الموصل زوج «يكافئهنّ في [مرتبة] الولادة». وفي آخر المطاف عُقدت زيجات بين هؤلاء الجليليّين والسادة في الموصل، «إلاّ أنّ أيّاً من الطرفين لم يدخل في مصاهرات مع طبقة أخرى».المرجع نفسه، ص. 159-160.
وشهدت السبعينات حملات لتعريب «حزام المناطق المختلطة» عبر رفع نسبة عربه قياساً بغير العرب. هكذا وفّر النظام البعثيّ لتلك المراتبيّة القديمة الجامدة، والحاجزة للروابط المدينيّة، ما يعادلها من أفعال «قانونيّة» استهدفت الموصل وكركوك، لتجد تتويجها في حملة الأنفال الشهيرة. وخلال حملات التعريب لإحداث تغيير دائم للديموغرافيّات الإثنيّة في تلك الأراضي الغنيّة بالنفط، «هُجّرَ 250 ألفاً من الكرد والأقلّيّات الأخرى غير العربيّة واستُبدلوا بعرب من وسط العراق وجنوبه».Elizabeth Ferris & Kimberly Stoltz, Minorities, Displacement and Iraq’s Future, Brookings, 2008. P. 10. ونعلم أنّ إطاحة صدّام والبعث في 2003 أطلقت انفجاراً في النزاعات الإثنيّة، خصوصاً مع محاولات الكرد استعادة أملاك صادرتها الحكومة منهم.
وهي عمليّةٌ رفَدَها تمجيدٌ للعرب والعروبة والأصالات الدمويّة المزعومة، وكالعادة، كان المثقّفون «الحديثون» و«الحداثيّون» صنّاعها. ذاك أنّ دورهم (وبالطبع في ظلّ حضّ الدولة ورعايتها) في انبعاث القَبَليّة في العراق يشهد عليه نشر الكتب عن القبائل والعشائر في الثمانينات، ممّا سبق أن درج في أواسط الخمسينات قبل أن يمنعه حزب البعث «التقدّميّ» ثمَّ يعاود تشجيعه في ظروف لاحقة.Keiko Sakai, “Tribalization as a State Control in Iraq: Observations on the Army, the Cabinets and the National Assembly,’’ in: Faleh A. Jabar & Hosham Dawod (ed.), Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in the Middle East, Saqi, 2003, pp. 136-8.
وهكذا خابت توقّعات حداثيّة متفائلة، ساذجة وكثيرة، في صدد العراق البعثيّ، كأنْ يرى دارس العراق في السبعينات والثمانينات، الإسرائيليّ أماتزيا بارام، أنّه «في داخل الدولة الأمّة العراقيّة، رُفِّعت اللغة العربيّة إلى مستوى غير مسبوق من الأهميّة. فقد أدّت عمليّة التمديُن إلى اجتثاث البُنى الاجتماعيّة التقليديّة والولاءات القديمة للعائلة الممتدّة والقبيلة والدين، وأصبحت المدن الكبرى غير شخصيّة وغير مألوفة. إلى ذلك، فإنّ “الثقافة العليا” تُفرض عموماً عبر التعليم الشامل. وفي ظروف كهذه تغدو اللغة الوسطَ الرئيس في تعريف المرء هويّتَه».Amatzia Baram, Culture, History & Ideology in the Formation of Ba’thist Iraq, 1968-89, St. Martin’s Press, 1991, p. 138-9.
بيد أنّ الموصل دفعت أيضاً بعض أكلاف العُظام الصدّاميّ وميله إلى إنشاء المشاريع النُصُبيّة، حالُه في ذلك حال سائر زعماء التشكيلات السياسيّة الديكتاتوريّة والتوتاليتاريّة. ففي 1981، وبعد عامين على تسلّم صدّام حسين رئاسة الجمهوريّة إثر إبعاده «الأب القائد» أحمد حسن البكر، وفيما كانت تستعر الحرب العراقيّة-الإيرانيّة، بدأ العمل ببناء «سدّ صدّام» على بُعد 60 كيلومتراً شمال المدينة، هو الذي غدا يُعرَف، منذ 2003، بـ«سدّ الموصل». وفي 1984، دُشّن السدّ، الموصوف بكونه الثاني من نوعه في الشرق الأوسط، والبالغ الطول 13 كيلومتراً. لكنّ «كونسورتيوم المستشارين السويسريّين» (Swiss Consultants Consortium)، الذي استشير فيه، حذّر منذ البدايات الأولى حاكمَ العراق من أنّ موقع السدّ مُقلق، وأنّ أساساته تتطلّب الحشو المتواصل للنتوءات والفجوات الكثيرة، فلم يكن من صدّام سوى تجاهل التنبيهات. وبالفعل استمرّ التجاهل حتّى 1988، حين بدأ بناء سدّ بادوش على بُعد 16 كيلومتراً إلى شمال الموصل بوصفه سدّاً بديلاً. وفي الحالات جميعاً، وفي ظلّ العقوبات التي فُرضت على العراق بعد غزو الكويت، توقّف العمل ببادوش الذي لم يكن قد أُكمل من بنائه غير 40 بالمئة. لكنْ بعد إطاحة صدّام، أُعلن أنّ سلاح الهندسة في الجيش الأميركيّ سينفّذ برنامجاً يُقدّم بموجبه 27 مليون دولار لوزارة المياه العراقيّة تُنفقه في سدّ الفجوات. مع هذا، ففي الأسابيع التي أحكم داعش فيها سيطرته على منطقة السدّ (2014)، قبل أن تطرده قوّات البيشمركه الكرديّة، حذّر الخبراء من أنّ انهياره قد يطلق موجات مائيّة تهدّد بقتل ملايين السكّان على رقعة جغرافيّة تصل إلى بغداد جنوباً. وبدورها توالت التحذيرات الدوليّة، ولا تزال، من دون أن تبدي الحكومات العراقيّة كبيرَ اكتراث.Barbara Bibbo, Mosul Dam collapse ‘will be worse than a nuclear bomb’, Aljazeera, 11/12/2016.
لكنّ تركيبة الموصل وجوارها وجدت فرصة أخرى للاستعراض مع الفوضى التي ضربت العراق إبّان اندلاع الحرب الأهليّة السنّيّة-الشيعيّة في 2006–2008. ووفق تقرير أعدّه معهد بروكنغز «يبدو أنّ المسيحيّين خصوصاً يواجهون مخاطر محدّدة بسبب علاقتهم بالغرب، وبالتالي صلتهم بالقوّات متعدّدة الجنسيّة في العراق. وحقيقة أنّ المسيحيّين، إلى جانب الإيزيديّين، يسيطرون تقليديّاً على صناعة الكحول جعلتهم أيضاً استهدافاً لبيئة إسلاميّة متزايدة الأصوليّة. ففي الشهرين الماضيين [من 2007]، استُهدف المسيحيّون على نحو متعاظم، ما قاد آلافاً كثيرة منهم للفرار من المدينة».E. Ferris & K. Stoltz, Minorities…, p. 12. وإذ يسجّل التقرير كيف أنّ التدهور الأمنيّ أجبر الأقلّيّات جميعاً، لا المسيحيّين وحدهم، بمن فيهم الشِبَك والإيزيديّون وسواهم، على مغادرة منازلهم، يضيف: «تواجه بعض الأقلّيّات خطر الاستيعاب لأنّ المناطق التي تقيم فيها، كالموصل وكركوك، تضعهم وسط صراعات على السلطة بين الكرد والسنّة والشيعة ممّن يتقاتلون على مزاعم تاريخيّة، وخصوصاً على موارد النفط. وهم أيضاً يفتقرون إلى حماية القبائل، ممّا يحظى به السنّة والشيعة. وإذ يزوّدهم الكرد بالكثير ممّا يحتاجونه من أمن وإسكان طارئ للاّجئين، فثمّة أيضاً تقارير تفيد بأنّهم يسعون إلى استخدام المسيحيّين لمكاسب سياسيّة عبر نظام زبونيّ معقّد. مثلاً، هناك تقارير بأنّ المسيحيّين لا يستطيعون الحصول على عمل ما لم ينضمّوا إلى الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ».المرجع السابق، ص. 13.
على أنّ داعش باحتلاله الموصل في حزيران 2014 وبقائه فيها حتّى 2017، جعل تجارب الاضطهاد والتمييز السابقة مجرّد تمارين أوّليّة. وكان ما يفاقم المأساة ويكرّس مضامينها الأهليّة درجةُ التداخل بين سلطة داعش وضبّاط السلطة البعثيّة، العربيّة السنّيّة، التي سقطت قبل عقد ونيّف، مقابل اللونين الكرديّ والشيعيّ في مقاومة تلك السلطة. ولم يكن بلا دلالة هويّاتيّة أنّ زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي سريعاً ما اختار «مسجد النوري الكبير» في الموصل (أو «الحدباء» نسبةً إلى مأذنته)، كي يلقي الخطبة التي شكّلت إطلالته الأولى على العالم وإعلانه نفسَه خليفة المسلمين.
ولم تَحُل السنّيّة العربيّة لداعش دون فرضه نظام عقوبات بالغ الجور والقتامة على الأكثريّة السنّيّة العربيّة، وإنزال عدد من المذابح بهاربّما كانت المجزرة الأكبر التي نزلت بمواطنين سنّة عرب تلك التي تعرّضت لها دير الزور السوريّة، وكان ضحاياها من قبيلة الشعيطات، الذين قدّر شيخهم رافع العقلة أنّ «3170 شخصاً قُتلوا في مذابح ارتكبها داعش، منهم 700 شخص في يوم واحد». وتدمير بعض معالمها التاريخيّة بما فيها «مسجد النوري الكبير» نفسه. إلاّ أنّ غير العرب وغير المسلمين دفعوا الثمن الإضافيّ الناجم عن هويّتهم الدينيّة و/أو الإثنيّة بذاتها. وقد أطنب الإعلام العالميّ، خصوصاً مع زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وإلى الموصل تحديداً، في آذار 2021، في وصف مآسي الإيزيديّين الفظيعة ابتداءً من العمليّة الإباديّة في سنجار وسبي نسائهم، ما أدّى إلى فرار ثلثيهم خارج العراق، وفي قتل المسيحيّين واسترقاقهم ونزوحهم وما آل بمعالمهم التاريخيّة وكنائسهم.راجع حول ما آل بكنائس الموصل على يد داعش:
Charlotte Bruneau, In Iraq, pope to visit Mosul churches desecrated by Islamic State, Reuters, 28/2/20121.
على أنّ تحرير الموصل من داعش، والذي كان محلّيّاً ودوليّاً هذه المرّة، أتى هو أيضاً بالغ الكلفة بشراً وحجراً، وشديد التدمير لمدينيّة المدينة وتزكيةً لعلاقاتها الثأريّة. وكمثل غير حصريّ، ينقله صحافيّ من رويترز غطّى الحربَ على داعش، باتت «الجدران تحمل شعارات دينيّة شيعيّة يرشّها الجنود الحكوميّون، ويقول السكّان السنّة إنّها تُشعرهم بأنّهم يعيشون تحت الاحتلال».Ulf Laessing, Resentment festers in Mosul: just ask Saddam Hussein, Reuters, 20/4/2017. ولئن عَكَسَ التعاطفُ والتكاملُ اللذان تتبادلهما الصدّاميّة والداعشيّة السنّيّتان بعض أسباب المحنة، كَمُنت أسباب أخرى في شيعيّة السلطة في بغداد وارتباطها العضويّ بدولة إيران التي لا تراها الغالبيّة الكاسحة لسُنّة العراق غير مصدر للكَيد والخطر. فحتّى أواخر 2020، بعد انقضاء ثلاث سنوات على تحرير المدينة، كان لا يزال في وسع صحافيّ الغارديان مارتن شولوف أن يكتب: «لا يزال 400 ألف عراقيّ على الأقلّ ممّن هربوا من سلطة “الدولة الإسلاميّة”، أو ممّن عاشوا في مناطق سيطر عليها المتطرّفون، في مخيّمات اعتقال على امتداد شمال البلاد، ممنوعين من العودة إلى بيوتهم أو غير راغبين في محاولة ذلك. والأكثريّة سنّة عراقيّون، مثل البغدادي وأتباعه، ممّن يخشون ألاّ يُعتَبَروا، بعد الانتصار على “الدولة الإسلاميّة”، شركاء في عراق ما بعد الحرب». وإذ يتناول شولوف نقص الاهتمام الرسميّ بإجراء مصالحات فعليّة بين السكّان، والاهتمامَ البالغ بالنشاط الانتقاميّ، يتوقّف خصوصاً عند مآسي الأمّهات اللواتي قُتل أزواجهنّ ولا يُمنَح أبناؤهنّ شهادات ميلاد تتيح لهم دخول المدارس أو المشافي أو المباني الحكوميّة والإدارات.Martin Chulov, ‘The militias are not allowing us back’: Sunnis languish in camps, years after recapture of Mosul, The Guardian, 24/10/2020. وهذا، في أغلب الظنّ، ما سوف يثمر جيلاً جديداً يصعب أن لا يستأنف، إذا ما قُيّض له ذلك، ماضي مدينته ومحيطها.
حلب
تشبه حلب جارتها الموصل بكونها هي أيضاً المدينة الثانية، لكنّها تشبهها كذلك بكونها عاصمة تجاريّة وتعدّديّة التكوين، فضلاً عن تأثّرها بالقوى والمناطق الشماليّة نفسها وبالانشداد إليها. فإلى علاقتها الحميمة والعريقة، الاقتصاديّة والثقافيّة والدينيّة، بتركيّا، والتي ترقى إلى بدايات عهدها العثمانيّ، أفادت حلب من الطلب الأوروبيّ المبكر على الحرير، العائد إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي منافسة الفرنسيّين والإنكليز لتجّار البندقيّة، أقام الأوّلون، منذ 1557، تمثيلاً قنصليّاً في حلب، أمّا الإنكليز، فمنذ عهد إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر، بدأت علاقة مربحة ومثمرة بين حلب وشركتهم، «شركة المشرق الإنكليزيّة» (Levant Company). وقد استمرّت حلب مقرّاً للشركة في سوريّا حتى عام 1825 حين حُلَّت الأخيرةما لم يُذكَر العكس فإنّ الإشارات التاريخيّة إلى حلب تستند إلى:
Bruce Masters, ’aleppo: the Ottoman Empire’s caravan city’’, in: Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Masters (ed.), The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul, Cambridge, 1999. وباتت الحاضرةُ الشماليّة وجهة مرغوبة للغرباء عنها، كاليهود السفرديّين (الشرقيّين) الذين طُردوا من إسبانيا، وانتقلوا بدايةً إلى إيطاليا، ثمّ عاش منهم في حلب، وعمل في تجارتها، «450 ذكر راشد» عام 1672، ليرتفع العدد إلى 875 في 1695. وكان لتزايد أعداد اليهود أن دفعهم إلى منافسة أرمن حلب على المنصب الرسميّ الوحيد والامتيازيّ المتاح لغير المسلمين، وهو أمانة الجمارك. ومعروفٌ أنّ حلب ضمّت تجمّعاً كبيراً وقديماً للأرمن، خصوصاً منهم الكاثوليك، ضخّمتْه لاحقاً، بعد إبادة 1915، إقامة عشرات آلافهم فيها.
لكنّ حلب، قبل الثورة، لا تشذّ عن قانون السكن في المدينة الشرقيّة. فاليهود يقيمون في حيّ بحسيتا، والمسيحيّون في العزيزيّة، والمسيحيّون الأرمن في السليمانيّة، وللكرد وباقي الجماعات الإثنيّة غير العربيّة حاراتهم. أمّا الكرد الأفقر فيقيمون في الشيخ مقصود، بينما الأغنى يسكنون الأشرفيّة، مثلما يسكن الكرد الإيزيديّون «الهراطقة» في حيّ بني زيد، بينما يختلط تركمان وكرد في بستان الباشا.Isam Al-Khafaji, Tormented Births…, p. 102.
صحيح أنّ دور المدينة التجاريّ استفاد من ضخامة السوق العثمانيّ، ومن الحماية الأمنيّة المضمونة غالباً، بيد أنّ خوف التجّار من غارات البدو حدّ من تجارة القوافل عبر الصحراء. وفي معظم القرنين السادس عشر والسابع عشر، قلّد العثمانيّون المماليكَ في دفع مقابلٍ ماليّ لزعماء قبليّين «يَحمون» القوافل التي تتحرّك على خطّ غير مأهول بين جنوب تركيّا وعانة في العراق الحاليّ. لكنّ الحماية لم تكن مأمونة دائماً، كما لم يكن إخضاع البدو ممكناً، وأحياناً لم يكن مرغوباً لاحتمالات ارتداده العكسيّ على المصالح التجاريّة للمدن. وعلى نحو أو آخر أسهمت تلك العوامل في انهيار تجارة القوافل في القرن التاسع عشر، خصوصاً وأنّ قناة السويس كانت تستبدلها بتجارة الشحن البحريّ. وكان ما زاد الخوف على القوافل وتجارتها أنّ حلب «مطوّقة» بجماعات ريفيّة كرديّة وتركمانيّة ربّما هدّدتها، فيما بدا مألوفاً تَعرُّض التجّار والمترجمين المسيحيّين لعقوبات وإهانات اعتباطيّة، فضلاً عن انعكاس أيّ توتّر بين السلطنة والبلدان الأوروبيّة سلباً عليهم.
وعلى صعيد سَوس المدينة، اعتمدت اسطنبول، منذ مطالع القرن السابع عشر، وبعد نزاعات ومطامح داخليّة، سياسة المداوَرة بين حكّام المدينة المعيّنين، كي تمنع أيّاً منهم من بناء قاعدة سلطةٍ مستقرّة وفاعلة. ووفق بروس ماسترز، تأدّى عن هذا النهج «ارتفاع الفوضى السياسيّة في شوارع المدينة في القرن الثامن عشر»، كما حيلَ دون «صعود أيّة قوّة سياسيّة ذات قاعدة محلّيّة تستطيع أن تتحدّى مباشرة سلطة السلطان على المدينة وساكنيها. فعند السلاطين، كانت الفوضى المُمَأسسة خيراً من النظام، خصوصاً متى كان في وسع النظام السياسيّ أن يفضي إلى انفصال».Bruce Masters, Aleppo…, p. 32.
وعلى امتداد الحقبة العثمانيّة، وعلى جاري ذاك التقليد، ظلّ قضاة المذهب الحنفيّ، الذين يلعبون دور الوساطة بين السكّان المحلّيّين والسلطان، يُعيَّنون من الخارج، وإن تحدّث كثيرون منهم العربيّة بطلاقة. وبالطبع كانت المحاكم الإسلاميّة تبتّ في النزاعات التجاريّة، وغير التجاريّة، للمسلمين وغير المسلمين، مع استثناء قضايا الأحوال الشخصيّة للمسيحيّين واليهود التي بتّتْها المحاكم المِلليّة.
ومنذ القرن السابع عشر، عرفت حلب عدّة انتفاضات ضدّ السلطنة، ثمّ في القرن التاسع عشر، وتحديداً 1819، كانت انتفاضة فقراء المدينة ضدّ خورشيد باشا والتي قُمعت بقسوة. وفي مجال الاصطفاف العصبيّ، تشكّلت الحزبيّتان المتنافستان من الإنكشاريّة والأشراف، فشهدت حلب بين 1760 و1850 صراعاً ضارياً بينهما، كما شهدت صعود «الأعيان» وبعض العائلات المسيحيّة المستفيدة من توسيع هوامش العلاقة بأوروبا. أمّا الإنكشاريّة فجاء معظمهم من مهاجرين ريفيّين وقَبَليّين وفدوا إلى المدينة وظلّوا فيها أقرب إلى طارئين غرباء عن نسيجها، فعاشوا في ضواحيها الشرقيّة وعملوا في مهن وخدمات تتّصل بالتبادل مع العشائر، كسَوْق البغال والجزارة والصباغة. وأمّا الأشراف فأقاموا ضمن أسوار المدينة وعملوا خصوصاً في النسيج. وبدورها تشكّلت القوّة الثالثة للأعيان من عائلات محلّيّة ناشطة في الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة، وفيها احتلّت أُسَر رجال الدين ومدراء الوقف (الجابري، الكواكبي، مدرّس، قدسي، طه…) موقعاً متصدّراً. غير أنّ هذه العائلات التي برزت اقتصاديّاً، «فشلت في ترجمة هذا النجاح إلى سلطة سياسيّة مقابلة».المرجع السابق، ص. 53.
وإذ يسجّل ماسترز «تدهور العلاقات الطائفيّة بين المسلمين وغير المسلمين»، والذي سمّم السلطنة حتّى انحلالها في 1918، فإنّه يعتبر أنّ «أوّل انفجار كبير للعنف ما بين الطوائف في الأقاليم العثمانيّة الآسيويّة حصل في حلب» عام 1850. فمن عهد إبراهيم باشا إلى سياسات عهد التنظيمات العثمانيّ، فضلاً عن انهيار الاقتصاد المحلّيّ التقليديّ في ظلّ التنافس مع السلع الغربيّة، تراكمت أسباب الجفاء التي أجّجها الدور الوسيط، الاقتصاديّ والتعليميّ، لمسيحيّين ويهود. ولم يكن الثراء الذي حقّقه بعضهم عبر الترجمة للقناصل والمتاجَرة مع أوروبا مُستساغاً، لكنْ لم يكن في وسع السلطنة الضعيفة والمستَضعَفة أن تفعل شيئاً. وعلى العموم، وُصِفت أحداث 1850 بانتفاضة مسلمة (في شرق المدينة) ضدّ المسيحيّين (في شمالها)، وبكونها مذبحة نزلت بالمسيحيّين وأثارت مسائل تمتدّ من التحوّلات الاقتصاديّة والأزمة الاقتصاديّة العامّة إلى بناء الكنائس ورفض التجنيد…
في أيّة حال، انخرط الجميع في تلك الأحداث المأسويّة التي سبقت بعشر سنوات مذابح دمشق وجبل لبنان الطائفيّة: الإنكشاريّون والأشراف والبدو والكرد والتركمان، وفرّ مئات المسيحيّين إلى بيروت وإزمير، كما نُقلت بطريركيّة الكاثوليك من حلب إلى ماردين إثر إصابة البطريرك الذي قضى بعد عام.
مع هذا لم يكن استقبال الاحتلال الفرنسيّ للمدينة عام 1920 متكافئاً. ففي الريف انفجر الكفاح المسلّح بقيادة الملَاّك الزراعيّ والموظّف العثمانيّ ذي الأصول الكرديّة إبراهيم هنانو، فيما حافظت المدينة على سكينتها وهدوئها دون أن يفارقها، ويفارق تجّارَها خصوصاً، القلق من جرّاء خسارة السوق العثمانيّة. وبالطبع تنوّعت المواقف على قاعدة الاختلافين الدينيّ/الطائفيّ والإثنيّ كما على قاعدتي التباين الطبقيّ والانشطار الريفيّ-المدينيّ.
وكان لقيام الدولة السوريّة، وعاصمتها دمشق، سيّما مع إلغاء «الاتّحاد السوريّ» وتوحيد «دولتي» دمشق وحلب في 1924، أن أشعل المنافسة بين المدينتين والتي تعهّدها الفرنسيّون وزادوها احتقاناً. فحلب، منذ 1534 حين أنشأ سليمان القانونيّ «إيالة حلب»، ومن ضمنها أضنة وشطر كبير من الجنوب الشرقيّ التركيّ، مفصولة عن «إيالة دمشق»، ما جعل الإقرار بـ«العودة» إلى حاكميّتها تنازلاً كبيراً وصعباً. لهذا شهدت مرحلة 1918-1920 انشغالاً سياسيّاً وثقافيّاً واسعاً برسم صورة حلب في المستقبل، مع غلبة واضحة لدعاة استقلالها وانفصالها عمّا عداها ممّا غدا سوريّا. وفي 1925، كتب القانونيّ الحلبيّ إدمون ربّاط، المتحمّس للوحدة السوريّة، داعياً إلى «ولايات متّحدة سوريّة»، ومعدّداً العقبات الحائلة دون ذلك، ككثرة الانتماءات الطائفيّة. أمّا المَثل الذي اختاره فكان حلب التي يريد لها أثرياؤها أن تستقلّ عن دمشق، «فهم يرفعون شعار ’ثروة حلب لشعبها‘، كما لو كانت دمشق وباقي سوريّا بلداً غريباً، وكما لو كان وطنهم الحصريّ حلب».Isam Al-Khafaji, Tormented Births…, P. 96. بيد أنّ ضمّ لواء إسكندرون، عام 1939، إلى تركيّا، زاد في إضعاف قدرة المدينة على المنافسة إذ حرمها ميناءَها على المتوسّط.
وكما بات معروفاً، ظلّت منافَسةُ دمشق وحلب واحداً من العوامل التي أضعفت الاستقرار السياسيّ لسوريّا الأربعينات والخمسينات، وفتحت الباب للانقلابات العسكريّة، خصوصاً أنّ «الكتلة الوطنيّة» (1928) التي جمعت الطاقتين السياسيّتين للمدينتين في مواجهة الانتداب، ما لبثت أن انشقّت، في 47-1948، إلى «الحزب الوطنيّ» الدمشقيّ و«حزب الشعب» الحلبيّ.
وبفعل اصطفاف سوريّا في الخمسينات إلى جانب مصر، ضدّ تركيّا والعراق عضوَي «حلف بغداد» والشريكين الاقتصاديّين الكبيرين لحلب، شكّلت الأخيرة طليعةَ المتضرّرين من اصطفاف كهذا، ما عكسته مواقف زعمائها (رشدي الكيخيا وناظم القدسي…) وتيّاراتها السياسيّة المتحفّظة على التوجّهات الراديكاليّة في السياسة العربيّة، تَحفُّظَها على التوسيع العسكري اللاحق لدور الدولة في الاقتصاد. وإذ جاء عهد الوحدة (58-1961) يفصل إدلب عنها، بدا التاريخ الحلبيّ تاريخ قضم وتصغير: من خسارة الأراضي التركيّة في إيالة حلب، إلى خسارة لواء الإسكندرون، وأخيراً خسارة إدلب، ناهيك عن تقلّبات العلاقة بتركيّا والعراق.

لكنْ في هذه الغضون، وفي موازاة تصاعد الصراع العربيّ-اليهوديّ على فلسطين، راحت المدينة تنزف يهودها، وهو ما بلغ محطّته النوعيّة أواخر 1947، بُعيد قرار التقسيم، حيث قضى عشرات اليهود الحلبيّين في بوغروم يقلّد «الفرهود» البغداديّ قبل ستّ سنوات. أمّا الوحدة المصريّة-السوريّة، ثمّ خصوصاً سنوات حكم البعث بدءاً بـ1963، فتأدّت عنها هجرة طالت رأسماليّي المدينة الذين أضرّت بهم سياسات التأميم، وكانت نسبة المسيحيّين والأرمن فيهم مرتفعة، هم الذين أحسّوا بوطأة تأميم المدارس والتعليم خصوصاً.يُلاحَظ أنّ كافّة محطّات ما يُعرف بـ«التحرّر الوطنيّ» و«الصراع ضدّ الاستعمار»، لا في سوريّا وحدها بل في العالم العربيّ، كانت تترافق مع اعتداءات على الأقلّيّات الدينيّة. أنظر: روجيه أصفر، مسيحيّو حلب: المسار والمآل، مبادرة الإصلاح العربيّ، 6 /12/2017.
على أنّ خريطة الريف والمدينة كانت تُفاقم التفسّخ الاجتماعي والسياسي، وتنفخ في ناره. فريف حلب، الواقع شرقها، قليلة المردود الزراعيّ تبعاً لنقص المياه، فيما إدلب التي كانت تاريخيّاً ريف حلب الغربيّ بعيدة جغرافيّاً، لا تتّصل أو تتفاعل مع عموم الحلبيّين، باستثناء أفراد بعينهم من الملاّك الزراعيّين. وينقل بطاطو عيّنات عن علاقة المالك والمستأجر الزراعيّين في المناطق الأفقر من محافظة حلب، في النصف الأوّل من القرن العشرين. فالفلاّح كان «مُرابعاً» لا يتلقّى، مقابل عمله، سوى ربع الحاصل عن ذاك العمل، أمّا في السنوات التي تسوء فيها المواسم والمحاصيل فيُرمى للضيق والعوز. وهو يتوقّف بالأخصّ عند الفوارق بين الرجال والنساء التي استمرّت حتّى الثمانينات.Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics, Princeton, 1999, p. 39 & 44.
ويميّز بطاطو عموماً بين الفلاّحين البساتنة القريبين من المدن، كما في الغوطة المحيطة بدمشق مثلاً، معتبراً إيّاهم استثناء على غالبيّة الفلاّحين. فهم أبكر وأكثر تأثّراً بالاختراق الاقتصاديّ الأوروبيّ، لكنّهم أيضاً أوفر تملّكاً للأرض من باقي الفلاّحين، وأشدّ تأهيلاً للتنظيم والمهن. وقد تزايد التشابه في طرق الحياة بين هؤلاء البساتنة وجيرانهم من سكّان المدن مع تزايد التمديُن الذي تعرّضت له قراهم. إلا أنّ هؤلاء يمثّلون «تبايناً» مع باقي الفلاّحين، لا سيّما منهم أولئك الذين اختلطت قيمهم بقيم البدو.
وبقياس الأرياف، بدت حلب ودمشق محظوظتين، وإن ظلّت الثانية أكثر محظوظيّة من الأولى. ففي 1939، أقام 69.8 بالمئة من مجموع أطبّاء البلد فيهما، لكنْ في 1963، سنة الانقلاب البعثيّ، ومع تزايد عدد الأطباء السوريّين بنسبة تفوق الضعف، وتزايد أسرّة المشافي أربعة أضعاف، وتحسّن قدرة الفلاّحين على الوصول إلى أوليّات الرعاية الصحّيّة، بقي اختلال التوزيع ضخماً. وحتّى السبعينات، ظلّ في وسع شيخ صوفيّ هو محمّد النبهاني أن «يحقّق ربحاً مادّيّاً» بالاستفادة من سذاجة الفلاّحين في سبع قرى من محافظة حلب.المرجع السابق، ص. 67-8 و107.
هكذا ففي حلب، وبقيادة الزعيم الفلاّحيّ الحمويّ أكرم الحوراني، انعقد عام 1950 المؤتمر الفلاّحيّ الأوّل في تاريخ سوريّا، واستقطبت الحركةُ الفلاّحيّة في أرياف المدينة أعداداً ضخمة من الأنصار والمؤيّدين.المرجع السابق، ص. 128، بحيث يعتبر بطاطو أنّ الحوراني هو المؤسّس الأوّل للبعث كقوّة شعبيّة، قبل أن يعاود حافظ الأسد تأسيسه الثاني.
غير أنّ النظام البعثيّ كان، منذ قيامه في 1963، كثيراً ما يلجأ إلى استقدام «فلاّحين من الريف كي يواجهوا المظاهرات والإضرابات التي تنفجر في حماة وحلب ودمشق».المرجع تفسه، ص. 162. وقد تغذّت سياسة تطويع المدن (السنّيّة) عبر الريفيّين، وفي عدادهم العلويّون الأكثر تعرّضاً تاريخيّاً لظلم المدن واضطهادها، على تهميش سنّة المدن في وسائط السلطة وأدواتها. فمثلاً من أصل حوالي 600 عضو في «الحرس القوميّ» الذي أنشأه البعثيّون عام 1964 لضبط مدينة دمشق، لم يوجد سوى 12 دمشقيّاً.المرجع نفسه.
وعزّز سياسةَ استخدام الديموغرافيا لتطويع المدن واقعُ الهجرات الريفيّة الكثيفة التي شهدتها الستينات إلى مدن «العالم الثالث»، مع تأزّم القطاع الزراعيّ وتوسّع العواصم التي صارت مراكز لبيروقراطيّات متضخّمة، فضلاً عن الإغراءات في العمل والاستهلاك ممّا توفّره المدن أو تُوهِم بتوفيره. فدمشق مثلاً، والتي لم تكن تضمّ في 1945 أكثر من 300 ألف، ارتفع عدد سكانها عام 1970 إلى 800 ألف، ليتجاوزوا، أواخر الثمانينات، الثلاثة ملايين.Patrick Seale, Asad: the Struggle for the Middle East, I.B.Tauris, 1988, pp. 442-3.
لكنْ في سوريّا، وكما يلاحظ ياسين الحاج صالح، اختلف التمديُن العلويّ خلال الجيلين الماضيين، عن مثيله لدى الكرد وعموم الريفيّين، «بأنّ قوّة الجذب الأساسيّة هنا نحو المدينة هي سلطة الدولة، أجهزة القوّة بخاصّة من مخابرات وجيش، ثمّ أجهزة أخرى (…) مع ما هو معلوم من أرجحيّة علويّة كبيرة سلفاً في الأجهزة».ياسين الحاج صالح، «من الثورة إلى الحرب: الأرياف السوريّة تحمل السلاح» الجمهوريّة نت، 10 تمّوز 2015. فانطوى الانتقال المكانيّ، والحال هذه، على إحراز وظائف سلطويّة، تعدّل التراتُبيّات المجتمعيّة قسراً، وهذا إن لم تكن تلك الوظائف أمنيّة مباشرة تفاقم الاختلال في مدينيّة المدن. وبالفعل ازدادت الحاجة إلى تطويع المدن إلحاحاً، إذ إنّ 2 بالمئة فقط من قيادة الحزب الحاكم، إبّان 63-1966، كانوا سُنّة دمشقيّين، و8 بالمئة سنّة حلبيّين. ومع انقلاب البعث «اليساريّ» عام 1966 زادت تلك النسب المنخفضة انخفاضاً. ومع السنوات اتّخذت الوجهة هذه منحى تصاعديّاً، فاستنتج نيكولاس فان دام من قراءته «التقرير التنظيميّ» للحزب الحاكم في 1985، أنّ الحزب حافظ في الثمانينات على قوّة تمثيله «في منطقة اللاذقيّة (العلويّة أساساً) كما في المحافظات الريفيّة الجنوبيّة»، على عكس الحال في دمشق وحلب.Nikolaos van Dam, The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba’th Party, I.B.Tauris, 2011. P. 125-6. وفي 1992 كما في السنوات السابقة، ظلّت عضويّة البعث في حلب ودمشق أدنى ما تكون. وهي نسبة تزداد تدنّياً حين نعلم أنّ كثيرين من المنتسبين والأنصار ريفيّون يقيمون في المدينتين لأغراض العمل أو الدراسة. وكان حافظ الأسد نفسه قد اعترف في 1970 بأنّ عضويّة المنظّمة الحزبيّة في حلب لا تتجاوز السبعين عضواً. مع ذلك، وكما يضيف بطاطو، حقّق الحزب اختراقات أكبر بين فلاّحي المحافظة، بحيث شكّل المكوّن الفلاّحيّ الحلبيّ، عام 1989، 15.8 بالمئة من مجموع العضويّة الفلاّحيّة في الحزب.Hanna Batatu, Syria’s Peasantry…, p. 181-5.
على أنّ الأسد، منذ أواخر السبعينات، وبموازاة المَيْلَشَة المتعاظمة للنظام، استعاد بقوّةٍ ذاك «التقليد» الستينيّ في استحضار الريفيّين لكسر احتجاجات المدن. وهو، في 1980، في ذروة صدامه بالإخوان المسلمين، سمح بتشكيل تنظيمات فلاّحيّة مسلّحة وموالية، فضمّت 546 رجلاً ليصبحوا 34,496 في 1985 ثم 46,239 في 1990.المرجع السابق، ص. 255. ومعلوم أنّ عامي 1979 و1980 سجّلا أحداثاً في ضخامة مجزرة مدرسة المدفعيّة في حلب، وهي العمليّة الإرهابيّة والطائفيّة التي نفّذها في 16 تموز 1979، النقيب ابراهيم اليوسف، من ريف تادف، شمال شرق حلب، وضربات «الطليعة المقاتلة» التي استطاعت في آذار ونيسان 1980 أن تُخرج ثلاثة أرباع المدينة، ولعدّة أسابيع، من سيطرة النظام، ثمّ محاولة اغتيال الأسد نفسه في 26 حزيران 1980 والردّ الثأريّ والفوريّ عليها في مجزرة سجن تدمر الفظيعة. وكان لمجموع هذه الأحداث أن ضاعف تسميم العلاقات الأهليّة، الطائفيّة والريفيّة-المدينيّة، ومهّد لانفجار 1982 في حماة، ثمّ المجزرة التي ارتكبها نظامٌ بات متزايد التعويل على الطائفيّة.
وفي هذه الغضون، وفي حلب تحديداً، سجّل العام 1980 انتهاكات ومذابح نزلت بأهل المدينة وكان أبرزها في حيّ المشارقة، حيث تروي أوساط المعارضة أنّ العشرات قُتلوا ودُفنوا في مقبرة جماعيّة. وجاء ما حصل في ذاك الحيّ تتويجاً لأفعال مماثلة أصغر في سوق الأحد وبستان القصر والكلاسة وأقيول بذريعة إيوائها قيادات من الإخوان.
ولئن درج نظام الأسد، من جهة أخرى، على مدّ الجسور مع البورجوازيّة السنّيّة الدمشقيّة، وتقديم تنازلات لها، فهذا ما لم تحظ بمثله البورجوازيّة الحلبيّة. فمن أصل 20 فرداً و/أو عائلة يسمّيهم الخفاجي «فاعلين اقتصاديّين أساسيّين» في سوريّا، هناك اثنان فحسب من حلب مقابل 11 من دمشق.Isam Al-Khafaji, Tormented Births…, p. 282-6. هكذا يغدو مفهوماً، وفي وجهة معاكسة تماماً لوجهة البعث، أنّ عضويّة الإخوان في حلب، التي لم تتجاوز الـ800 فرد عام 1975، شهدت في 1978 تضخّماً ارتفع معه الرقم إلى ما بين 5,000 و7,000، بحسب ما ينقله بطاطو عن قياديّين إخوان.Hanna Batatu, Syria’s Peasantry…, p. 273.
لقد جاء امتحان الثورة لحلب معقّداً وشرساً ومتعدّد المستويات. فقد تحوّلت المدينة،كمثل غير حصريّ على بعض الدمار الذي ألحقه نظام الأسد وحلفاؤه بالمدن السوريّة، راجع إصدار «معهد الأمم المتّحدة للتدريب والبحوث» (يونيتار) في 2019. على مدى ثلاث سنوات من القتال، إلى ما سمّاه مراسل نيوزويك «ستالينغراد سوريّةً»، كما انقسمت إلى «نصفين مميّزين».James Harkin, Inside Aleppo, Syria’s Most War-Torn City, Newsweek, 19/8/2015.
في وقت يرقى إلى مطالع 2013، عُثر على ما يقرب المئة جثّة، بثياب مدنيّة، مرميّة في نهر قويق. وفي 2015 ظهر خوفٌ فعليّ من سقوطها – وقد تحرّرت من جيش الأس -، في يد داعش،أنظر: لينا سنجاب، «هل تسقط حلب في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية؟»، بي بي سي نيوز، 10/6/2015. ما نمّ عن بؤس المصائر المتاحة لسوريّا عموماً، ولحلب بالأخصّ.
أمّا مواجهات 2016 لكسر الحصار (المعزّز بالطيران الروسيّ والميليشيات الشيعيّة) عن شرق المدينة، فبقدر ما دلّت على توحّش النظام وحلفائه، فإنّها أشّرت إلى تفتّت المعارضة. وهذا ما يصف بعضه صادق عبد الرحمن إذ يكتب عن «هشاشة تحالف الفصائل هناك وتضارب توجّهاتها، وهي الهشاشة التي ظهرت بشكلٍ واضحٍ مع إصرار جبهة فتح الشام وفصائل أخرى على إطلاق تسمية غزوة الشهيد إبراهيم اليوسف على معركة تحرير مدرسة المدفعية»، فيما رفضت تلك التسميةَ ذات الدلالة الطائفيّة الحادّة فصائلُ الجيش الحرّ، المنضوية في غرفة عمليّات جيش الفتح، «رفضاً غير معلن». ويشير الكاتب إلى «خلافات» بين فصائل مدينة حلب وفصائل جيش الفتح «القادمة من إدلب»، وأنّ جبهة فتح الشام أصرّت «على إطلاق تسمية غزوة أبو عمر سراقب على المعركة»، ما أثار «جدلاً وتوتّراً شبيهاً بذاك الذي رافق إطلاق تسمية غزوة ابراهيم اليوسف على معركة مدرسة المدفعيّة».صادق عبد الرحمن، «حلب: الحصار ومقاومته والخروج الكبير»، الجمهوريّة.نت، 9/1/2017. ويبدو أنّ أبو عمر المذكور، القياديّ في «جبهة فتح الشام» وفي «تحالف جيش الفتح»، والذي اغتالته طائرة تابعة للتحالف الدوليّ، كان مقاتلاً مع أبو مصعب الزرقاوي والقاعدة في العراق.هذا على الأقلّ ما يرد في تعريف ويكيبيديا به.
وكان من تكسّرات النسيج الحلبيّ موقف المسيحيّين الحلبيّين المؤيّد للنظام، وخصوصاً الأرمن المشبعين بعداء تاريخيّ لتركيّا التي كانت حليفة لبعض فصائل الثورة. والحال أنّ القهر التركيّ الذي طال الأرمن، ثمّ الكرد، أسّس لدى الطرفين مزاجاً صلباً مناهضاً لتركيّا، يخالف الحساسيّة العربيّة السنّيّة الودودة تقليديّاً حيالها، وهذا من غير أن يترافق ذلك مع صيغة سياسيّة تجمع بين الكرد والأرمن.
وفي تحليله، يسلّط روجيه أصفر الضوء على دور السلطة البعثيّة في تصليب التكسّر المجتمعيّ عبر «امتيازات» تقدّمها للمسيحيّين، هي بالأحرى «حقوق» لهم ولسواهم. فالسلطة في سوريّا، كما في العراق البعثيّ، أرفقت تلك «الامتيازات» (حقّ العبادة والصلاة في الكنائس وتشكيل جماعات مجتمع مدنيّ موصولة بالكنيسة، والحصول على نسبة مضمونة من التمثيل في البرلمان والوزارات…) بمعاملتهم كـ«جماعة» لا كـ«أفراد».يقدّم أصفر وجهة نظر مؤيّدة للثورة تحاول أن تفسّر تعاطف المسيحيّين مع نظام الأسد بمسلسلات الاضطهاد التي تعرّضوا لها تاريخيّاً، انظر:
Roger Asfar, “Aleppo Christians: A Turbulent History and the Path Ahead”, Arab Reform Initiative, 6/12/2017.
وقد حاول عمر قدّور، في وقت مبكر نسبيّاً من عمر الثورة (2012) الإجابة عن السؤال الكبير حول موقف المدينتين الكُبريين دمشق وحلب من الثورة والنظام، فترك لنا إحاطةً بمعظم تناقضات المدينة والثورة معاً، مظهّراً صعوبة التقاط أيّ انتظام اجتماعيّ يمكن البناء عليه. فهو لاحظ استنهاض ناشطي الثورة لـ«حميّة المدينتين»، وتعريض حلب لسخرية الثوّار وعنفهم اللفظيّ، لكنّه، من جهة أخرى، ردّنا إلى ما هو أكثر أَشْكلَةً لمدينيّة المدينتين، إذ «يدلّل الواقع على أنّ حكم البعث من بدايته عمل على تحطيم البرجوازيّة التقليديّة، وظلّت أطروحاته النظريّة إلى وقت قريب تركّز على انتصار ثورته على الإقطاع والبرجوازيّة. هذا السياق البعثيّ لا ينفي وجود بقايا برجوازيّة تقليديّة استسلمت للنظام وعقدت تحالفاً فاسداً معه، على أن تؤخذ هذه الحالات بفرديّتها لأنّها لم تؤلّف سياقاً ممنهجاً، ولم تعنِ أبداً أنّ البرجوازيّة التقليديّة ككتلة تحالفت مع النظام، بقدر ما أنّ فساد النظام قد طال جزءاً منها».
فحلفاء النظام، وفق تحليل قدّور، هم «طبقة بديلة من صُنعه [أي النظام] نفسه، هي طبقة أثرياء الفساد الذين تزول أسباب ثرائهم بزوال النظام (…) وهي طبقة لامدينيّة، بمعنى الانتماء المباشر لنسبة كبيرة من أفرادها، وأيضاً بمعنى أنها لم تتأسّس على السيرورة الطبيعية للاقتصاد المدينيّ. هي طبقة تشكّلت من فوق». وإلى الهشاشة الاقتصاديّة، يسجّل الكاتب جهد السلطة في السيطرة على الساحات الرئيسة، وإجبار الناشطين على «الانكفاء إلى الأحياء التي لا تشهد قبضة أمنيّة شديدة»، مُقرّاً بـ«أنّ بعض هذه الأحياء لم يكن مهيّأً للثورة، فكان النشطاء يأتون من مناطق أخرى للتظاهر السريع». هكذا دُفع المتظاهرون إلى «الأحياء ذات النسيج العمرانيّ العشوائيّ»، وقد استطاعوا «استثارة أبناء تلك الأحياء فشهدت الثورة انتشاراً أفقيّاً، وإن بقيت مقطّعة الأوصال». فلم يبق للثوّار بالتالي سوى المحيط التقليديّ ذي النسيج الاجتماعيّ «المتجانس»، الذي يصعب على الأجهزة الأمنيّة اختراقه، وهو الذي تحوّل إلى ملاذ ذي بُنى «لم تخذلهم… وإن اضطرّ بعضهم إلى مراعاة الحساسيّات التقليديّة المحافظة لها». وفي الخلاصة المرسومة بحبر أسود، فإنّ «السمة غير المدينيّة هي التي توفّر حاضناً اجتماعيّاً أقوى»، لكنْ «بينما تنطلق شعارات الثورة إلى الفضاء الوطنيّ العامّ، وهي شعارات تنتمي بالضرورة إلى المفاهيم المدينيّة المعاصرة، فإنها تبقى مُكرهةً أسيرةَ بؤر لا تقع في صلب الانفتاح المدينيّ».عمر قدّور، «عن لا مدينيّة الثورة السوريّة»، مجلّة كلمن، عدد 6، ربيع 2012.
ولم تبد الأمور للكاتب أفضل حالاً في المدن الأخرى، إذ في حمص مثلاً كشفت تجربة الثورة «عن هشاشة الفضاء المدينيّ، حيث التجأ كلٌّ من مكوّنات المدينة إلى الأحياء التي كانت مقسّمة أصلاً وفق روابط ما قبل مدينيّة، وكان لعجز الثورة عن السيطرة على ساحة الساعة الرئيسيّة مفاعيل عميقة لا يخفّف من وطأتها التمسّكُ برمزيّة الساحة، وصنعُ مجسّم على شاكلة الساعة الأصليّة ووضعه في ساحة صغيرة لأحد الأحياء».
وبعد ثلاث سنوات، وأيضاً بحبر أسود، عاد ياسين الحاج صالح إلى السؤال نفسه، فردّ تدنّي مساهمة المدن في الثورة إلى أسباب أربعة، هي أنّ «سلطة النظام الاحتلاليّة أقوى في المدن ممّا هي في الريف»، وأنّ «موجة المعتقلين والمنفيّين الأولى (…) هي من الشبّان المدينيّين أو الناشطين في المدن»، و«أنّ المدن، والأكبر منها أكثر من الأصغر، استفادت من لبرلة الاقتصاد بقدرٍ ما، وفيها شبكات محسوبيّة محلّيّة متفاوتة الكثافة انتفعت من الأجواء الاقتصاديّة الجديدة»، و«أنّ الوجه الآخر لما سمّي منذ سبعينات القرن العشرين “ترييف المدن” هو انكفاء الطبقة الوسطى المدينيّة على نفسها وتدهور أيّ تطلّع تحرّريّ في أوساطها». وفي شرحه هذا العامل الأخير رأى أنّ المدن «ركنت إلى السلبيّة. تحجّبت. وبصورة عامّة ليس فقط تأثير المدينة الإيجابيّ على الريف، وعلى القادمين من الريف، هو ما انحسر، بل لم تعد المدينة تُمدّن أهلها أنفسهم. كانت تستسلم للمحلّيّة والتريّف عبر هذا الانزواء على النفس والأصل».ياسين الحاج صالح، من الثورة إلى الحرب…، سبق الاستشهاد.
بيروت
تختلف بيروت عن سواها من مدن المشرق، بما فيها المدن اللبنانيّة الأخرى (طرابلس، صيدا)، في أنّها أقلّها تضرّراً من الحداثة والتحديث، بل أكثرها استفادة منهما. فهي، في آخر المطاف، ابنة المرحلتين التحديثيّتين لإبراهيم باشا (1831-1840) وللإصلاحات العثمانيّة (1840-1918)، وهي إنّما جُعلت مركز ولاية في هذه الحقبة الأخيرة، وكان ذلك عام 1888.
لكنّ السمة الأخرى الخاصّة ببيروت أنّ ريفها، ولم يكن قد صار ريفَـ«ـها» بعد، كان متقدّماً وبَعيد التمديُن نسبيّاً، بفعل العلاقة بالغرب تجارةً وتعليماً وإرساليّاتٍ، وتالياً بفعل نجاح حركاته الفلاّحيّة والعامّيّة، بالتحالف مع الكنيسة المارونيّة، في كسر هيمنة ملاّكي الأراضي الكبار. هكذا، وبحسب سمير قصير، لعب الحكم الذاتيّ لجبل لبنان ودور القناصل المستمرّ والقانونيّ وموقع الكنيسة المارونيّة «انقلاباً لا يُقاوَم (…) في موازين القوى». وعلى عكس العاديّ والمألوف في ثنائيّتي الريف والمدينة، ارتفعت أصوات «في إطار المتصرفيّة تطالب بإلحاق بيروت بالجبل، فيما أضحت بيروت آنذاك عاصمة لولاية مترامية الأطراف». ويضيف قصير في إضاءة البُعد الأهليّ لتلك المطالبة (المسيحيّة الجبليّة)، أنّها «كانت تضحّي، أو لا تقيم وزناً، بالتركيبة الطائفيّة للمدينة (…) تحدّياً للسكّان المسلمين ولسلطة الباب العالي في آن، حتّى لو كان صحيحاً أنّ الفكرة نشأت غداة إعلان نظام المتصرفيّة وبتأثير من الحاكم العثمانيّ نفسه داوود باشا»، لا بل، ومرّة أخرى على عكس ما هو مألوف من علاقة المدينة بأطرافها، «ظهر ميل آخر يطمح إلى الالتفاف على بيروت وإلى جعل جونية البوّابة المرفئيّة لجبل لبنان»، كما نشأت منافسات تجاريّة زاد منها «الاقتطاع من مداخيل ولاية بيروت لتمويل المتصرفيّة».سمير قصير، تاريخ بيروت، دار النهار، 2006، ص. 259.
إلاّ أنّ لجوء الجبليّين إلى بيروت في 1860، هرباً من النزاع الطائفيّ في الجبل، رسم لنشأة المدينة صورة تتجاوز النجاة من التنازع الطائفيّ إلى الإيحاء ببديل يتخطّاه، مصدره التجارة والمصالح. لكنّ المسألة لم تكن بهذه البساطة، فلم يَخلُ الأمر من محاولات تحويل إيديولوجيّ، مبطّن طائفيّاً ولبنانويّاً، مارسها الريف على المدينة، حيث عملت هجرة الجبليّين إلى بيروت «على تقوية الإيديولوجيا ’الكيانيّة‘ فيها».المرجع السابق، ص. 260 و261. وتكفي إلفةُ حدٍّ أدنى مع تاريخ العاصمة اللبنانيّة كي نعلم أنّ هذا التحويل لاقى، على امتداد القرن العشرين، مقاومة البيارتة، أو أقلّه أكثريّتهم المسلمة السنّيّة.
فمنذ الثلاثينات، برزت الثنائيّة المناطقيّة المعروفة للبيروتيّين («البسطة» المسلمة مقابل «الجمّيزة» المسيحيّة)، وفي سياق احتدامها تأسّس حزب الكتائب اللبنانيّة عام 1936، وتنظيمات مسلمة صغرى أهمّها «النجّادة» نشأت ردّاً عليه، وتأكّد أنّ الانقسام الجهويّ-الطائفيّ (الغربيّة المسلمة والشرقيّة المسيحيّة، قبل أن تتماهى الضاحية الجنوبيّة مع هويّة مسلمة شيعيّة) انقسامٌ ذو استطالة سياسيّة وإيديولوجيّة أيضاً. وهذا ما وجد تعبيره العنفيّ الأوّل عام 1958 حين وقف المسيحيّون وراء رئيس الجمهوريّة الموالي للغرب كميل شمعون، فيما عارضه المسلمون متحالفين مع «الجمهوريّة العربيّة المتّحدة» الناصريّة التي أشعرَ قيامُها المسيحيّين بالخوف والتهديد، ثمّ وعلى نحو أكبر، في الانشقاق حول العمل الفلسطينيّ المسلّح في لبنان الذي انفجر عام 1969 ليبلغ ذروتَي تصعيده في اشتباكات أيّار 1973 ثمّ في حرب 1975 الأهليّة.
في هذه الغضون كانت القوانين الانتخابيّة، ولا تزال، تردّ المواطنين إلى قراهم حيث يصوّتون. وفي هذا التغليب لمسقط الرأس على دورة الحياة، عملاً ومعاشاً ودفعاً للضرائب، كان النظام السياسيّ يكرّس أولويّة الريف، إن كعلاقات زبائنيّة أو كثقافة وتصوّرات. ودائماً ما وجدت الأولويّة هذه ما يعزّزها، أكان ذلك في طائفيّة مناطق السكن بأحيائها وحاراتها، أو في القرب الجغرافيّ من مدينة تعيش على اقتصاد خدَميّ ضئيل القدرة على ردم الانقسامات الأهليّة الموروثة وتجاوزها.
وعلى العموم، عاشت بيروت توازنات قلقة لعبت دورَ كفّة الترجيح فيها الهجراتُ الريفيّة الكثيفة والمتواصلة. فعشيّة حرب السنتين (5-1976) باتت الكثافة السكّانيّة في أحياء بيروت الشعبيّة «من أعلى كثافات العالم»، وبين 1959 و1973 ارتفع تعداد سكّان بيروت الكبرى من 450 ألف نسمة إلى مليون وستين ألف نسمة، كما ارتفعت نسبة اللبنانيّين الذين يعيشون في بيروت الكبرى من 27.7 بالمئة إلى حوالي 50 بالمئة. ويكفي لتبيّن الاستطالة الكوزموبوليتيّة المكمّلة لهذا التكاثر التذكيرُ بأنّ بيروت حينذاك حضنت 175 ألف فلسطينيّ و250 ألف سوريّ و130 ألف أرمنيّ و60 ألف كرديّ،الأرقام والنُسب من سليم نصر، سوسيولوجيا الحرب في لبنان: أطراف الصراع الاجتماعيّ والاقتصاديّ 1970-1990، دار النهار، 2013، ص ص. 50-55. فضلاً عن سواهم من يهود لبنانيّين ومن عرب وأوروبيّين آخرين.
غير أنّ البُعد الكوزموبوليتييّ هذا، ودون أن يكتم تراتُبه الطبقيّ المؤكّد، لم يكتف بالامتناع عن تعزيز مدينيّة المدينة، بل تحوّل إلى فولكلور تعايشيّ وسياحيّ ينفجر بنفسه وبالمدينة سواء بسواء عند كلّ منعطف كبير. وقد سبق لوضّاح شرارة أن درس بيروت من خلال معادلات القرابة والإقامة، والبداوة والمدينة، ملاحظاً عناصر الضعف القويّة التي لم تنجح بيروت «الموقوفة» في تطويعها. فعبر قراءته رواية حسن داوود بناية ماتيلد والتي أرّخت بطريقتها لانفجار المدينة، رأى في حياة الريفيّين المنتقلين حديثاً إلى عاصمتهم، «غلبة الضيافة على التجارة، والهِبَة على التبادل» والقرابة على الإقامة. ويسجّل شرارة اضطراب الحياة «بين قرية لم يغادرها القادمون الجدد [إلى المدينة] تماماً، وبين مدينة لم يحلّوا فيها حلولاً راسخاً وثابتاً، أي حلولاً لا عودة منه». أمّا المدينة من ناحيتها، فـ«لم تسعَ إلى تطويع هؤلاء النازحين أو إلى قَسْرهم على اصطناع مُثُل أخرى من اللباس والطعام والاجتماع والسكن»، علماً أنّ المدينة تعريفاً «تُدخل الشقاق على ما كان مجتمِعاً وملتئماً بالقرابة».وضّاح شرارة، المدينة الموقوفة: بيروت بين القرابة والإقامة، دار المطبوعات الشرقيّة، 1985. خصوصاً الصفحات 191-206.
وفي تناوله العلويّين الذين انتقلوا إلى المدن وصاروا أكثريّة في بعضها، كاللاذقيّة وطرطوس وجبلة، يلاحظ الحاج صالح أنّهم «ظلّوا مشدودين بقوّة إلى منابتهم القرويّة. للأمر صلة بالضعف الاقتصاديّ للمدن السوريّة عموماً وتواضع الصناعة فيها من جهة، وبإجراءات إداريّة وبيروقراطيّة في سوريّة لا تسهّل انتقال قيود الأحوال الشخصيّة للأفراد». وفي المقابل، أصاب التمديُن السنّةَ الريفيّين أيضاً، حيث «تسكن نسبة منهم المدن منذ جيل أو جيلين وأكثر. ومثل غيرهم ظلّوا مرتبطين بقُراهم وبلداتهم بقدر لا بأس به، وللأسباب ذاتها». «من الثورة إلى الحرب…»، سبق الاستشهاد.
على أنّ الدعم الأكبر الذي حظيت به تلك السمات الحاجزة لمدينيّة المدينة كان مصدره الحرب. فقد لاحظ مثلاً سليم نصر، بعد تسجيله حالات السكن المشترك لمنحدرين من طوائف ومناطق مشتركة، «أنّ معظم الدراسات تميل إلى تبيان أنّ ظاهرة تجمّع الآتين من مكان واحد كانت ظاهرة عابرة تتفكّك بسرعة كبيرة عند الجيل الثاني».سليم نصر، سوسيولوجيا الحرب…، ص. 60. وهو ما يسمح بافتراض أنّ السلم الأهليّ والاستقرار كانا قادرين، من حيث المبدأ، أن يشقّا طريقاً تطوّريّاً يؤسّس لخروج البيروتيّين ممّا قد يبدو قدراً أو تعطيلاً حتميّاً لمدينتهم. وإذا صحّ أنّ نشأة الجامعة الأميركيّة في منطقة رأس بيروت، بالاستفادة من مراحل السلم والاستقرار النسبيّين، هي ما سمح لتلك المنطقة بكسر التماثل الشرق أوسطيّ بين القرابة والإقامة، فهذا ليس بالضرورة قراراً حصريّاً مقفلاً وغير قابل للتكرار، إذ يمكن نظريّاً لمؤسّسات حديثة مشابهة أن تفضي إلى نتاج مشابه في ظلّ سِلم واستقرار مستتبّبين.
لكنّ ما حصل أنّ الحرب (1975-1990)، وفق أرقام الاقتصاديّ اللبنانيّ بطرس لبكي، هي التي نجحت في تغيير التموضع الجغرافيّ الطائفيّ للسكّان، خصوصاً في بيروت الكبرى، تغييراً كبيراً، وكان ذلك في اتّجاه معاكس تماماً. فبعد توسّع الاختلاط الذي عزّزته الهجرات الريفيّة منذ أواسط القرن التاسع عشر، انتكست هذه الوجهة كلّيّاً. ذاك أنّه عشيّة الحرب كان 62 بالمئة فقط من سكّان مدينة بيروت نفسها مولودين فيها، وتنخفض النسبة في بيروت الكبرى إلى 54 بالمئة (مقابل 28 بالمئة من خارجها، و10 بالمئة من العرب، وهم غالباً فلسطينيّون وسوريّون، و8 بالمئة من الأجانب). وتأدّى عن أولى عمليّات التهجير في ما عُرف بـ«حرب السنتين» (5-1976) أن هُجّر من المناطق الشرقيّة المسيحيّة 110 آلاف مسلم شيعيّ وسنّيّ و5 آلاف درزيّ و20 ألف مسيحيّ يعارضون أحزاب «الجبهة اللبنانيّة»، في مقابل تهجير 40 ألف مسيحيّ من الضاحية الجنوبيّة و35 ألفاً من بيروت الغربيّة. ثمّ جاءت موجة أعنف بين 1984 و1987، ترافقت مع الاحتلال الإسرائيليّ ومع حرب الجبل، وهُجّر بنتيجتها 300 ألف مسيحيّ من بيروت الكبرى، في عدادهم 165 ألفاً من الغربيّة، كما هُجّر 135 ألف من بيروت المسيحيّة شملوا سنّة وشيعة ودروزاً ومسيحيّين منشقّين عن الأحزاب المسيحيّة. لكنْ في هذه الغضون زاد عدد سكّان بيروت الكبرى 330 ألف من مسلمين ومسيحيّين هُجّروا من الجبل (مسيحيّين) والجنوب (شيعة) والمناطق الطرفيّة فانتقلوا إلى المناطق التي تشبههم طائفيّاً في بيروت، ما زاد في رفع نسبة الصفاء المذهبيّ.انظر مداخلة لبكي في هذا الفيديو.
وفي سوريّا، لاحظ الحاج صالح، في قراءته «الصراع خلال 52 شهراً»، «مسار تريُّف وتطيُّف لجبهة النظام المحاربة، بقدر ما كان مسار تريّف وتطيّف عامّ…». لكنّه ذهب أبعد رابطاً ولادة «الشبّيحة» بهذا المسار، إذ تدلّ الظاهرة على «بروز “النفس الغضبيّة”، الأقرب إلى المنبت والأصل، والمتمرّسة أكثر من غيرها بالسلاح من قبل، على حساب “النفس العاقلة” التي تتواصل مع غير، وتتوسّل الكلام في تواصلها. وهي من وجه آخر تشير إلى المزيد من بروز الأهليّ الصافي على حساب الدولتيّ المختلط، [و]الريفيّ أيضاً على حساب المدينيّ». ياسين الحاج صالح، «من الثورة إلى الحرب…»، سبق الاستشهاد. وبالفعل، فعلى دفعتين سجّلهما عاما 1967 (الحرب العربيّة-الإسرائيليّة) و1982 (الاجتياح الإسرائيليّ)، غادر يهود بيروت ولبنان الذين لم يبق منهم إلاّ عشرات قليلة.
وفي هذه الفسحة الزمنيّة المديدة نسبيّاً، تعرّضت بيروت لقسوة الاجتياح والحصار الإسرائيليّين، فكانت موجة نزوح هائلة من المدينة أعقبها إخراج منظّمة التحرير الفلسطينيّة منها، قبل أن تتلاحق سلسلة حروب صغرى تأدّى عنها طرد السلطة المركزيّة وتسليم المدينة إلى ميليشيات الطوائف التي سلّمتها، بدورها، إلى القوّات السوريّة.
هكذا، ومع نهاية حرب تداخل فيها الأهليّ والإقليميّ، تقدّم المشروع الحريريّ لإعادة بناء المدينة بجرّافات شركة عقاريّة خاصّة استلّت الروح من العاصمة بعدما طردت فقراءها وشتّتتهم. فالمشروع المذكور إنّما عبّر، بلغة قصير، عن «رغبة دفينة بالانطلاق من الصفر، يحاول أن يضفي على المدينة وجهاً آخر يخالف المورفولوجيا المعروفة للمدينة، لأهداف اقتصاديّة بحتة ناتجة عن الاستثمار الخارجيّ».سمير قصير، تاريخ بيروت…، ص. 571.
فمُدن كبيروت الحريري، أو دبيّ، بوصفها النموذج الأقوى والأصفى، إنّما تبدو ترجمةً لفكرة لا مصادر لها في التاريخ والاجتماع المحلّيّين، وبالتالي فهي مدن تهرب من ذاتها وتتفادى مدينيّتها. ففي دبيّ مثلاً، «يلوح تحويل الطبيعة أقرب إلى تطهّر من المكان وإلى تعقيم للزمن».حازم صاغيّة، «أبراج الله وبرج دبيّ (تحقيق في الفيزيك والميتافيزيك)»، مجلّة كلمن، عدد 0، ربيع 2010. وهي وجهة إن صحّ ربطها بالصعود الكونيّ للنيوليبراليّة، صحّتْ أيضاً مَوضعَتها في خانة الاعتذار الفاشل عن مدن قديمة دمّرتها الحروب والاستبدادات والتعصّبات على أنواعها، ولم يُطرح بديلاً عنها إلاّ المسخ.
في هذا المعنى، ومع انفجار المرفأ في 4 آب 2020، الذي دمّر خُمس المدينة، ظهرت أصوات تنعى حقباً بأكملها، وتنطوي على جردات حساب غالباً ما تُرافق النهايات. فبيروت، كما كتب حسام عيتاني، «تتحمّل ربّما أكثر من باقي أنحاء لبنان (باستثناء طرابلس على الأرجح) عبء الأزمات التي دمّرت الاقتصاد والعمران»،حسام عيتاني، «الخروج من بيروت»، الشرق الأوسط، 29/7/2021. أمّا نديم شحادة فذهب إلى أنّ انهيارها ذروة الهزيمة التي نزلت بالكوزموبوليتيّة في عموم المنطقة وكتبت موتها.Nadim Shehadi, “Tragedy of Beirut, last bastion of the true Levant”, Arab News, 4/8/2021.
وكان وضّاح شرارة قد توقّف مطوّلاً، من خلال مراجعته بناية ماتيلد لحسن داوود، عند هذه الحرب التي شُنّت على الكوزموبوليتيّة في بيروت. فحديثو الهجرة من الريف لا يملكون إلاّ العداء لعائلة روسيّة تقيم في البناية التي يقيمون فيها، فيهاجمها أولاد الهجرة الريفيّة ويهتفون كأنّه هتاف حربٍ «روسيّة»، كما ينظرون إلى حياتها المختلفة كأنّها دلالة على غرابتها، بل شيطانيّتها. وبدورها تبدو لهم ماتيلد، التي كانت رمز المرأة الفرديّة والحرّة والمختلفة، منتمية «إلى دنيا الجنّ والسحرة»، «فيها طرف من رجولة غير خفيّة»، و«مثلها لا يصلح جاراً»، أو بلغة داوود «كانت كأنّها تسكن في بناية أخرى». فوق هذا، هي بعاداتها «الغريبة» «تبالغ في خلخلة المكان وفي انخلاعه خارج محوره ومداره (…) إنّها تُحلّ الليل محلّ النهار وتخلط الأنوثة بالرجولة، وتلعب عوض العمل [المنزليّ] والحمل. وهي بإتيانها ذلك، تعدو على الحدود المستقرّة بين القريب والبعيد، وبين الأنوثة والرجولة، وبين الجدّ واللعب، وبين الليل والنهار». وضّاح شرارة، «المدينة الموقوفة…»، سبق الاستشهاد، ص. 219-21 و243 و244.
الاستحالة المدينيّة
بيد أنّ هذه المدن المظلومة كثيراً ما كانت، بموجب تبادل المظلوميّة الذي يكاد يكون مَلمحاً راسخاً من ملامح اجتماعنا، مدناً ظالمة. فقد نمت نموّاً أعرج، خصوصاً بعد الاستقلالات وتضخّم البيروقراطيّة فيها، فضلاً عن تجميع الأنشطة الصناعيّة والماليّة داخلها و/أو في ضواحيها، ممّا صحبه تجفيف الجاذبيّة الاقتصاديّة وفرص العمل في الأرياف. وهي، على العموم، توجّهات تعاظمت في العقدين الماضيين، بفعل النفوذ المتنامي للسياسات النيوليبراليّة في بلدان درج بعضها (سوريّا، العراق…) على خصّ الدولة بموقع وازن في الاقتصاد. وسياسات كهذه إذ تفكّك الضمانات الاجتماعيّة وتُعلي الاستهلاكيّ على الإنتاجيّ، تركّز اهتمامها على المدن، وعلى أحيائها الأغنى، مُشيحة بوجهها عن الريف وفقرائه.
وفي التاريخ ما بعد العثمانيّ، كان لتحوّل المدن حواضرَ للعمل السياسيّ والاستقلاليّ ضدّ الكولونياليّة، أن أبقى الفلاّحين في الظلّ والإهمال على ما تبدّى خصوصاً، وعلى نحو تراجيديّ، في تجربة فلسطين التي باتت معروفة جيّداً. فهناك تعالى عليهم قادةُ العمل الوطنيّ من ملّاك الأراضي المتغيّبين، تاركينهم كتلةً من العطالة ولقمةً سائغة للمشروع الصهيونيّ، تستهلكهم نزاعاتهم العصبيّة القديمة، وبالأخصّ منها الصراع الحسينيّ-النشاشيبيّ.
وإذ تركّزت الحياة السياسيّة والإداريّة والثقافيّة في المدن، خضع الريفيّون لأشكال من استغلالها سبق الإلماح إلى بعضها، سيّما حيث كانت الهويّة الطبقيّة تتعزّز باختلاف في الديانة والطائفة والإثنيّة (علويّون، كرد، أشوريّون، إيزيديّون…). وفي هذين التجاهل والتعالي، اكتفت أكثريّة مدننا بممارسة لون من الطفيليّة حيال ريفها الذي يزوّدها بكافّة الحاجات التي لا تستوردها من الخارج، فتكافئه بتسويق منتجاته و/أو إعادة تدويرها بما يتيح بيعها للريفيّين بـ«أسعار المدينة» المرتفعة.
وقد يصحّ القول إنّ البورجوازيّات المدينيّة في المشرق ليست ودودة حيال الريف، ولا تكتم، بين حين وآخر، بعض العنصريّة حيال الريفيّين بوصفهم أغراباً. فبعد أن يتوقّف الباحث الهولنديّ-الإيرانيّ آصف بيّات عند تذمّر النخبة القاهريّة من الفلاّحين، ومخاوف النخبة الإسطنبوليّة من تدفّق «الأتراك السود» الأناضوليّين، ينتقل إلى الظواهر المشابهة في أوروبا، فيجد في النظرة إلى المهاجرين الأجانب ما يعادل النظرة إلى الريفيّين في بلدان الشرق الأوسط. فـ«بنبرة لافتة في شبهها، تعبّر النُخَب الأوروبيّة البيضاء عن «غزو الأجانب» – الأفارقة والآسيويّين، وخصوصاً المسلمين – ممّن ترى أنّهم غمروا السكن الاجتماعيّ الأوروبيّ وشوّهوا طريقة الحياة الأوروبيّة…».Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Amsterdam University Press, 2010, p. 15-16.
لكنّ الريفيّين، من جهة أخرى، هم الذين يقاتلون ويبادرون، حين يسنح الظرف، إلى حمل السلاح الذي يدمّر المدن. من هنا نشأت في لبنان مثلاً صورة البيروتيّ (السنّيّ) الذي يتاجر ولا يقاتل، تاركاً هذه المهمّة للريفيّين والمهاجرين المتجمّعين في الضواحي (الموارنة والشيعة والدروز). ويجوز القول إنّ المتحاربين في سوريّا، بعد تغلّب الحرب الأهليّة على الثورة، ريفيّون أو حديثو الأصول الريفيّة، أكانوا من سنّة الأرياف أو علويّين أو كرداً. وقد يبلغ التناحر في حدّه الأقصى ما يصف به شرارة علاقة «حزب الله» ببيروت في الثمانينات: فهم، وقد أقاموا «مدينتهم» في الضاحية الجنوبيّة، يرون في بيروت «القرية الظالمة» التي «يحلّ تدميرها والقضاء عليها»، بحيث يُعاث فيها «فساداً وتفجيراً وتهجيراً وتخويفاً وإذلالاً وإنكاراً» لأنّها ميدان حرب وسدوم وعمورة وبابل معاً.وضّاح شرارة، «المدينة الموقوفة…»، ص. 341. وثمّة بين دارسي الإرهابيّين الإسلاميّين من رأى أنّ الحجم الكبير الذي تحتلّه المسائل الجنسيّة في الأدبيّات الإسلاميّة، السنّيّة كما الشيعيّة، ردٌّ «على قلق أعرض ناجم عن الاقتلاع الريفيّ والتغيّر الاقتصاديّ. فعوارض الانحسار [في الدور] الأبويّ تستعرض نفسها في مجالات العائلة والأخلاقيّة الجنسيّة».
Malise Ruthven, A Fury for God: The Islamist Attack on America, Granta, 2002, P. 123.
وهو ما قد يذكّر، ولو تذكيراً بعيداً ومُداوراً، بربط وليم رايخ، تبعاً لتجربته العياديّة، بين حالات التقشّف و/أو التصوّف، وعدم إشباع الحياة الجنسيّة.
من ناحيته يسجّل عبد الصمد الديالمي عن المغرب في السبعينات أنّ 78 بالمئة من شباب القرى يحلم بالهجرة إلى المدينة لأسباب جنسيّة. وهذه تصريحات بعض أولئك الشبّان بهذا الصدد: «في المدينة، يمكن أن تجد النساء بسهولة»، «لا توجد المواخير إلاّ في المدينة»، «في المدينة تخرج النساء عاريات، مرتديات أشياء قصيرة، وإذا أردت أن تجرّب حظّك فذلك ممكن». عبد الصمد الديالمي، المدينة الإسلاميّة والأصوليّة والإرهاب: مقاربة جنسيّة، رابطة العقلانيّين العرب، دار الساقي، 2008. ص. 73.
مع هذا، وكما في الحروب الأهليّة التي تتغذّى على عنفها الذاتيّ، ولا تكون العناصر الإيديولوجيّة والبرنامجيّة أساسيّةً فيها،راجع، للتمييز بين نمطي الحروب الأهليّة: حازم صاغيّة، رومنطيقيّو المشرق العربيّ، دار رياض الريّس للنشر، 2021، الفصل الثامن. يُستَبعَد أن يتحوّل السلاح إلى انتصار وطيد أو مكسب نهائيّ ومكرّس لحامله. ذاك أنّ نحر المدينة وانتحار الريفيّ المقاتل غالباً ما يترادفان، أو يمهّد واحدهما للثاني، في عيش من القلق الدائم والاحتراب المفتوح ذي النتائج المتقلّبة. ومثلما استحال تحوّل الموقع الاقتصاديّ لأعيان حلب إلى موقع سياسيّ، ولم يتأدّ عن كوزموبوليتيّة بيروت أيّ موقع صلب ومستدام، تمتنع أدوات القوّة عن التحوّل قوّةً واثقة تحظى بدرجة من الإقرار والتسليم. هكذا مثلاً سجّل الحاج صالح ما عبّرت عنه حالة العلويّين المهاجرين إلى المدن، إذ انتابهم «قلق خرج إلى السطح علناً مرّتين: وقت مات حافظ الأسد حيث عادت أُسَر وطلاب جامعيّون إلى قراهم في حركة بدت غريزيّة دون مُسبّب ظاهر، ووقت الثورة السوريّة حيث حصل شيء مشابه على مستوى العوائل (وليس المقاتلين والحاكمين، عموم “أهل الدولة”)».ياسين الحاج صالح، «من الثورة إلى الحرب…»، سبق الاستشهاد.
وعلى عكس ما علّمنا ابن خلدون عن ضمور العصبيّة في المدن، تغدو مدننا حاضناً للعصبيّات القلقة والكارهة التي تجمع بين الخوف والإخافة. أمّا عند رصد النتائج السياسيّة، أي ترجمة الوقائع والأحداث إلى سياسة، فتبقى نتائج هدم المدن صفراً يماثل الصفر الذي تنتهي إليه محاولات بناء المدن وإدامتها على الطريقة الحريريّة.
وبدورها تقدّم الأشكال والتنظيمات والأفكار الحداثيّة، كما بلغتنا وتفاعلنا معها في المشرق العربيّ، مساهمة ضخمة لصالح الاستحالة المدينيّة. ففي النصّ المشار إليه أعلاه، ردّ عمر قدّور الموقف من المدن إلى حزب البعث الذي وصف «ثورته» بأنّها «ثورة العمّال والفلاّحين (…) وانحدر أعضاؤه بغالبيّتهم الساحقة من أصول فلاحيّة». هكذا وبفعل راديكاليّة البعث اللفظيّة، «أثار ريبة أهل المدن»، سيّما وقد خلخل البنية السكّانيّة للمدينة وأغرقها «بفائض بشريّ تعجز عن استيعابه». لكنْ بدلاً من أن تؤدّي هجرة أبناء الريف إلى تمديُنهم فقد ساعدت سلطة البعث على «ارتحالهم بالمعنى المكانيّ فقط، وأقاموا في المدن بكلّ حمولاتهم الاجتماعيّة السابقة، ما يدفع إلى اليقين بأنّ البنية المدينيّة هي المُستَهدفة حصراً من قبل السلطة الجديدة التي أبقت وشجّعت على الروابط التقليديّة الأخرى، كالروابط العائليّة الواسعة والعشائريّة وأخيراً الطائفيّة». وكما عبّر هذا التوجّه عن إقصاء المجتمع عن السياسة، فإنّه ناقضَ الشعارات القوميّة التي تبشّر بتجاوز العصبيّات والروابط القديمة.عمر قدّور، «عن لا مدينيّة الثورة…»، سبق الاستشهاد.
لكنّ حزب البعث، الذي حكم سوريّا والعراق عشرات السنين، لم يكن غير فصيل من الفصائل الموصوفة بالقوميّة والتقدّميّة والاشتراكيّة التي سادت الفكر والعمل السياسيّين في الكثير من البلدان العربيّة بعد الحرب العالميّة الثانية. وهذا المجمّع الفكريّ-السياسيّ لم يكن مرّةً ودوداً مع المدن أو رؤوفاً بها، سيّما وقد جمع، مدفوعاً بحكم «الحزب الواحد»، بين تصفية الروابط القديمة (حِرَف، عائلات، أهالٍ…) وتلك الحديثة (أحزاب، نقابات، جمعيّات…).
فالقوميّ اعتبر المدن صناعة غريبة مرشّحة دائماً للتآمر على «أصالتنا»، فيما الشيوعيّ العالمثالثيّ طابقَها مع الواجهة الاستهلاكيّة التي تستنزف الكادحين بيد وتستلبهم باليد الأخرى. وهذا كي لا نذكر الإسلاميّ الذي رآها، حتّى حين يكون هو نفسه مدينيّاً، بيتاً للشيطان هجرتْه الفضيلة، أو عاملها معاملة «حزب الله» لبيروت كما وصفها شرارة.
ولم يكن ألمع أصوات التحرّر الوطنيّ وأشدّها حساسيّة بعيداً من خلاصة تلك التصوّرات. ففرانس فانون، أحد أبرز أيقونات مكافحة الكولونياليّة، لم يُخف احتقاره وعداءه للمدينة «التي أنشأتها السيطرة الاستعماريّة»، والتي حين ينتقل الكفاح المسلّح إليها فإنّه ينقل «الحرب إلى معسكر العدوّ، أي مدنه الضخمة المسالمة». وحين يقسو فانون على الأحزاب السياسيّة، يسجّل عليها إهمالها الريف و«جماهير الشعب» والهبوط عليهم هبوط المظلاّت من المدينة العاصمة.Frantz Fanon, The Wretched Of The Earth, Grove Press, 1963. P. 111, 128 & 113.

وكان حصار الريف للمدن موضوعة أثيرة لدى الشيوعيّات الفلاّحيّة غير الأوروبيّة، لا تبزّها في ذلك إلاّ الراديكاليّة الإسلاميّة في أفغانستان، بمجاهديها ثمّ بطالبانها، والتي لم تكفّ، مرّة بعد مرّة، عن تطبيق الاستراتيجيّة هذه. فالماويّة الصينيّة، بصورة خاصّة، بدأت انعطافها عن الماركسيّة العمّاليّة منذ مذبحة شانغهاي التي أنزلها بها شانغ كاي تشيك وحزبه «الكومينتانغ» عام 1927. ومن أريافهم، عبّأ الشيوعيّون الفلاّحين الذين هبطوا بهم على المدن فحاصروها واستولوا على السلطة. أمّا لاحقاً، مع «الثورة الثقافيّة» في الستينات، فنُفي 17 مليون شابّ مدينيّ إلى الأرياف كي «يتعلّموا من الفلاّحين». وكانت كمبوديا إبّان عهد بول بوت مسرح الوحشيّة القصوى، المَسوقَة بالهذيان، فأخلت المدن من سكّانها، وحوّلت، بأكلاف عادلت المليون ضحيّة، أولئك السكّان إلى فلاّحين.والحال أنّ الحركات الراديكاليّة في عدائها كثير الذرائع للمدينة، لا تحجب سعيها إلى صفاء ما، دينيّ أو قوميّ أو طبقيّ، يكون أشدّ تأهيلاً ومواءمة للنشاط النضاليّ والتعبويّ. ولما كان البحر مصدر تهديد لذاك الصفاء، لما يحمله من وافد وغريب، بشراً وسلعاً وألسنةً، واستعماراً أيضاً، حظي البحر بجزء من هذا العداء النضاليّ للمدينة. ففي ملاحظة نبيهة عن فلسطين ومراحل احتدامها الصراعيّ، كتب سليم تماري: «وصلت العداوة نحو البحر ذروتها خلال سنوات الانتفاضة (وبخاصّة الأعوام 1989-1992) حين تضافرت القوى الوطنيّة والإسلاميّة على إبعاد المتنزّهين – رجالاً ونساء – عن شواطىء غزّة ورفح وخان يونس. وفي منشور تكرّرت فحواه لاحقاً، دعت القيادة الموحّدة للانتفاضة -في 25 أيلول 1990 – إلى «التمسّك بالأخلاق والحشمة، وأدانت بكلمات صارمة أولئك الذين يرومون شواطىء البحر… ويتعرّضون لقيمنا وتقاليدنا وأخلاقنا… غير آبهين بدماء الشهداء». بهذا الحظر أصبحت غزّة أوّل مدينة في تاريخ البحر المتوسّط – حسب علمي – تُمنع فيها السباحة بمرسوم سياسيّ، وقد عمّمت بيانات عدّة – شبيهة بالبيان الذي أشرنا إليه أعلاه – تحذّر الجمهور من المحاذير الأخلاقيّة للانغماس في ملذّات البحر. وفي نهاية العام الثالث للانتفاضة، أصبح مجرّد التنزّه البريء على الشاطىء – وهو الحيّز الوحيد المتبقّي متنفّساً للناس من ضغط منع التجوّل المستمرّ الذي فرضته سلطات الحكم العسكريّ – في حكم تحدّي أحكام الدين والأخلاق العامّة». سليم تماري، «الجبل ضدّ البحر»، مواطن-المؤسّسة الفلسطينيّة لدراسة الديمقراطيّة، رام الله، 2005، ص 17.
وليست الفاشيّة بعيدة عن هذا التغليب، أقلّه لفظيّاً وخطابيّاً، للريف والفلاّحين. فرغم اهتمام النازيّة بقطاع الإنتاج الحربيّ، ظلّ الفلاّح «الشخص المفتاحيّ» لإيديولوجيّتها، وكان النازيّون مولعين «بتوكيد أنّ الأرض، بالنسبة إلى الفلاّح، أكثر من وسيلة لكسب العيش. إنّها تحظى بكلّ التردّدات العاطفيّة للوطن». ومع البدايات الفاشيّة الإيطاليّة في 19-1920، لم يكن موسوليني مكترثاً بالفلاّح والأرض، بل رأى الفاشيّة حركةً مدينيّة، لكنّه في وقت لاحق بدأ يعوّل على الريف ويعلن أنّ الفاشيّة «تريّف» إيطاليا وتتزعّم طرح قضيّة الفلاّحين، بل أنّها أساساً «ظاهرة ريفيّة».Barrington Moore, Jr, Social Origins Of Dictatorship And Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Penguin, 1974, p. 450 & 451.
والريف اليوم هو حصن الزعامات الشعبويّة من ترامب في الولايات المتّحدة إلى بريكزيت في بريطانيا، ناهيك عن أردوغان في تركيّا (الأناضول خصوصاً) ولوبن في فرنسا…
ولم يكن الإنتاج الأدبيّ العربي أرحمَ بالمدن من التيّارات السياسيّة التي أثّرت في الوعي السياسيّ العربيّ. فحتّى السبعينات، ظلّ الريف مهيمناً على الكتابة الروائيّة العربيّة.انظر: محمّد حسن عبد الله، الريف في الرواية العربيّة، عالم المعرفة، الكويت، 1989، خصوصاً الفصل الأول. وجاءت الضربات الأقصى والأشدّ إيلاماً من جهة الشعر الذي لم يكفّ عن هجاء المدينة بألسنة كثيرة.أنظر: حازم صاغيّة، رومنطيقيّو المشرق العربيّ، دار رياض الريّس، 2021، خصوصاً الفصل الثامن.
ومن دون إغفال دور الدين، لا يسعفنا كثيراً ردّ تلك العلاقات إلى الدين بذاته. فقد بقي التديّن الريفيّ طويلاً أقرب إلى تديّن شفويّ مخلوط بممارسات تصوّفيّة بدائيّة ومرتجلة. وفقط في العقود الأخيرة، مع التمدّد المتفاوت للرأسماليّة ولأجهزة الدولة، وما استلزمه من مدارس وخدمات، شرع الإسلام يدخل عميقاً في الأرياف فيما تزامن دخوله هذا مع صعود الإسلام العقائديّ والحزبيّ. هكذا سيكون من المبالَغ فيه تحميل الدين وحده، وتحديداً هنا الإسلام، مسؤوليّة أوضاع الريف التاريخيّة وعلاقته بالمدينة أو علاقة المدينة به ممّا ينبغي البحث عنه في تاريخ العلاقات الاجتماعيّة نفسها.
ويذهب عبد الصمد الديالمي أبعد، فيرى أنّ الهويّة السلاليّة والقرابيّة للمدينة تحاول أن تقاوم الهويّة الدينيّة الجامعة للمؤمنين، وهي تفعل ذلك «عبر آليّات مختلفة مثل الوقف والزواج الداخليّ». وهكذا «فالمعمار الانطوائيّ (غياب الشرفة، غياب النوافذ، الدرب اللامخرج، المدخل المكوّع) معمار دفاعيّ يعبّر عن إرادة الاحتفاظ بكلّ فتيات العائلة لفتيان العائلة».عبد الصمد الديالمي، المدينة الإسلاميّة…، سبق الاستشهاد، ص. 15.
مدينتنا وجروحها القديمة
لقد أدارت المدينةُ الريفَ لقرون بموجب الأنظمة العثمانيّة في «التيمار» و«الالتزام» ممّا كرّس القطائع والانقطاعات أكثر ممّا ضيّقَها. فالتيمارات، والزعامات في حالة الأراضي الأكبر، والتي ترقى بدايات العمل بها إلى القرن الرابع عشر، كانت حقولاً وقرى غالباً ما تُعطى مكافأةً «مؤقّتة» و«بالمداورة» للمقاتلين المحلّيّين غير النظاميّين، أو السباهيّين، أي الفرسان «الإقطاعيّين»، ممّن يكون عليهم أن يقدّموا، على رأس جنودهم، خدمات للسلطنة تعادل ما عهدت به إليهم. ولئن أمّن هذا النظام بعض العوائد للدولة وأعفاها من دفع مرتّبات مستحقّة للجنود، فقد أدّى احتفاظ الدولة بمُلكيّتها ومنع المستفيدين منها من بيعها أو توريثها، إلى الحؤول دون تشكّل إقطاعيّة مالكة تعريفاً للأرض، تضارع قوّة السلطة مرهوبة الجانب.
على أنّه منذ أواخر القرن السادس عشر، باشر هذا النظام تفسّخه المديد، تحت تأثير عوامل عدّة منها الأهميّة المتعاظمة للجيش النظاميّ والمعاشات الثابتة لجنوده. أمّا في الأرياف، فما لبثت التيمارات أن حُوّلت عقودَ التزامٍ لمصلحة مستثمري اسطنبول، ما أضعف المهمّة العسكريّة المفترضة للسباهيّين ومعها البُعد العسكريّ في إدارة الأراضي. لكنْ مع ذلك لم يكن السباهيّون أو التيمارات قد اختفوا حتّى بدايات القرن التاسع عشر، وكانت لا تزال أراض واسعة، خصوصاً في الأناضول، تُصنّف وتُدار كتيمارات، كما بقي من المعهود أن يحظى بها إنكشاريّون ونظاميّون آخرون.
وبفعل سلطتي التصرّف بالأرض وإنزال العقوبات بالفلاّحين (بعد الحصول على حكم قاضٍ محلّيّ)، قضى هذا النظام على الفلاّح والريف بالتهميش والحرمان المديدين، وهو ما فاقمه، منذ القرن الثامن عشر، نظام التزام الضرائب الذي يُناط بأغنياء ذوي حظوة، مع ما يتأدّى عنه من ابتزاز وإفراغ لبعض الريف من سكّانه المُعدمين والمَدِينين الذين يهجرون قراهم تاركين وراءهم قطاعاً زراعيّاً جديباً وهزيل العوائد.
وكان لهؤلاء الأعيان وملتزمي الجباية، الذين لم تحدّ «التنظيمات» من تولّيهم شؤون الأرض والسكّان، دور بارز في إضعاف السلطة المركزيّة والحدّ من قدرتها على صوغ سياسات اقتصاديّة وإنتاجيّة، فيما كانت الحروب مع روسيا تعزّز حاجة تلك السلطة إليهم تبعاً لافتقارها إلى الموارد المطلوبة. وفي بعض الحالات باتت حماية الحدود من وظائف كبارهم، كآل الجليلي في الموصل أو أحمد باشا الجزّار في عكّا الذي تولّى التصدّي لنابوليون. وفي موازاة تعاظم الحاجة إليهم كان يتعاظم اضطهادهم وإفقارهم الفلاّحين بما يضمن لالتزامهم اعتصار أرباح أكبر، مستعينين على ذلك بـ«جيوش» قطّاع الطرق.انظر كل من: Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire, Cambridge, 2017. P. 257, 100 & 189. و Bernard Lewis, The Emergence Of Modern Turkey, Oxford, 1967, Pp. 90-91. وكذلك دراسة ألبِر داغر، «نخبة السلطنة العثمانيّة واقتصادها»، الأخبار، 30/4/2015.
إلى ذلك، قد يصعب الإغفال عن الطابع النهريّ للموصل التي تقع على نهر دجلة، وبنسبة أقلّ كثيراً لحلب، حيث نهر قويق (بطول 129 كلم). أمّا بيروت فبقي طابعها البحريّ طاغياً على أدوارها وعلى صِلتها بسواها، فلم يترك أثراً يُذكر وجود نهر بيروت الصغير (29 كلم). ولربّما عادت بعض الأصول التاريخيّة لهذه العلاقة، على ما سوف يشار لاحقاً، إلى تحكّم المدينة تاريخيّاً بالماء والأنهار، في ظلّ شحّ المطر، ما يصحّ عموماً في مصر والعراق، وبدرجة أقلّ في سوريّا. فالعلاقة المذكورة، التي اتّصفت بها المجتمعات النهريّة، ولّدتْ معادلة مفادها الربط بين حصول الريفيّين على الماء وحرمانهم من الأرض أو اكتفائهم بحصّة هزيلة منها معطوفة على شروط إنتاج واستثمار بالغة القسوة.

ويصف جمال حمدان، بقدر من البلاغة والتكثيف، علاقات التسلّط من خلال السيطرة على مصادر المياه النهريّة، والتي أوجبت إقامة سلطة مركزيّة متشدّدة في مجتمعات الأنهار: «ذلك أنّ كلّ من يقيم على أعلى الماء يستطيع أن يسيء استعماله إمّا بالإشراف أو بحبسه تماماً عمّن يقع أسفله. أي أنّ كلّ حوض علويّ يستطيع أن يتحكّم في حياة، أو موت، كلّ حوض سفليّ، وكلّ من يقع على أفواه التُرَع يستطيع أن يهدّد حقوق المياه لمن يقع على نهايات التُرع».جمال حمدان، شخصيّة مصر: دراسة في عبقريّة المكان، المجلّد 2، عالم الكتب، القاهرة، 1981. ص 538.
وكان كارل فيتفوغل، المؤرّخ الألمانيّ-الأميركيّ، الماركسيّ ثمّ المرتدّ على الماركسيّة، قد درس «الاستبداد الشرقيّ» بوصفه مراكمة للسلطة عبر التحكّم بمياه الأنهار وتوزيعها، مع ما يصاحب ذلك من بناء للسدود ومواجهة للفيضانات إلخ… فلقد لاحظ، بين ما لاحظه، متفاعلاً مع أفكار ماكس فيبر و«نمط الإنتاج الآسيويّ» لكارل ماركس، كيف أنّ الدولة وبيروقراطيّتها في الحضارات المائيّة (الهيدروليكيّة) أحد الأسباب التي حالت دون تشكّل إقطاع مقيم في الريف، يبني فيه قصوره وقلاعه على غرار الإقطاع الأوروبيّ، وكيف أنّ الملكيّات الفلاّحيّة تبقى محكومة بالبعثرة الاقتصاديّة والعجز السياسيّ.
وكان لهذه العطالة الريفيّة أن أفضت، ومنذ قرون، إلى عدد من السمات والممارسات التي تؤكّد الدونيّة وتُمأسسها بقدر ما تعزّزها. فالتمايز في الملابس وفي اقتناء الزينة الثمينة غالباً ما يُفرض حين تكون الأكثريّة الكبرى من السكّان العاميّين فلاّحين يعيشون في مناطق خاضعة لسلطة الحكومة. وحتّى لو تمكّن أولئك السكّان من إقامة مشاريع ترتكز على المُلكيّة وتكون قابلة لاستدرار الربح بمعزل عن بيروقراطيّة الدولة، فإنّ ذلك قد لا يحدّ من فقرهم ولا يرفع عنهم سيف الضرائب أو المصادرة الاعتباطيّة. ويذهب فيتفوغل، كما آخرين سواه، إلى أنّ التعذيب، في الصين والدولة الإسلاميّة العبّاسيّة، كان عملاً ملازماً لانتزاع الضرائب والرسوم من الفلاّحين وعموم الريفيّين، فيما أغلب جامعي الضرائب ممّن تعيّنهم الحكومة من أبناء المدن الأغنياء الذين يكمّلون عمل البيروقراطيّة الماليّة هذه. وهو إذ يراجع علاقة روما القديمة بالمناطق الواقعة إلى شرق إمبراطوريّتها، وهي مناطق «هيدروليكيّة»، يسجّل أنّ سياستها كانت ترمي إلى جمع أكبر عائد ريفيّ ممكن بأصغر بيروقراطيّة ممكنة، بحيث لا يعود من الصعب تصوّر درجة القمع والامتهان التي ترافق هذه العمليّات الجائرة.Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, Yale, 1963. P. 130, 144 & 168-70.
ورغم تعرّض هذه الأطروحات لكثير من النقد اللاحق، قد لا يكون مفيداً، في حالتي حلب والموصل، نبذ «الاستبداد الشرقيّ» كلّيّاً ونبذ توكيده على دور أعمال الريّ وما تتطلّبه من بُنى بيروقراطيّة صارمة وأوامريّة، وعلى انعكاس «الإمبراطوريّة المائيّة» تلك على سيرورة الاجتماع، خصوصاً مع ما تستدعيه من تنظيم قوّة عمل من السكّان تكون جبّارة العدد كما تعمل قسريّاً، فضلاً عن سَوسها استبداديّاً.
ومثلما خضعت نظريّة «الاستبداد الشرقيّ» لكثير من النقد، بل الإدانة، خضعت نظريّة ماكس فيبر في المدينة، والمنشورة في 1921، أي بعد وفاته بعامٍ، لنقد وإدانة أكبر، كما ظهر كثيرون ممّن وصموا فيبر بـ«الاستشراقيّة» و«المركزيّة الأوروبيّة»، بل «العنصريّة» التي تُنكر على العالم الإسلاميّ كلَّ حياة مدينيّة.
ومع أنّ المدينة التي تحدّث عنها فيبر (مدن إيطاليا عصر النهضة، في القرنين السادس عشر والسابع عشر) لم تعد كياناً مستقلاً كما كانت حينذاك، بل اندمجت، اقتصاداً ودفاعاً وتمثيلاً سياسيّاً في كيان الدولة الأمّة الأكبر، بقي أنّ عمله، وفق مُحبّذيه، رسمَ الركائز الأصليّة والأساسيّة للمدينة انطلاقاً من أوروبا العصور الوسطى. فهي «اقتصاديّاً، موقع للتجارة والتبادل، وسياسيّاً واقتصاديّاً، قلعة وحامية جُند، وإداريّاً، محكمة للمقاطعة، واجتماعيّاً، كونفدراليّة مُلزَمَة بقَسَم».Max Weber, The City, The Free Press, 1958, p. 104.
ونظريّة فيبر في «المدينة» متعدّدة الجوانب والمسائل، تتّصل بباقي نظريّاته في البروتستانتيّة والرأسماليّة وفي العقلانيّة والكاريزما. لكنّ ما يعنينا، هنا، طبيعة المدينة، وهي وفقاً له أوروبيّة حصراً، ومن ثمّ دورها في التطوّر السياسيّ والديمقراطيّ تبعاً لاحتضانها مقدّمات هذا التطوّر وبذوره. فالمدينة، عنده، رابطة ذاتيّة ذات سلطة منتخبة تنبثق منها، وفيها يحضر السكّان ويفعلون بوصفهم أفراداً يخضعون لما يشبه قانون حكم ذاتيّ، مستفيدين في بلوغ تلك السويّة من الدور الذي لعبته المسيحيّة في ضرب النظام القرابيّ.
ولئن كان الإسهام الفعليّ لطبقة «البرغرز» (burghers – نُوى ما بات يُعرف بالبورجوازيّة) أساسيّاً في الإدارة المدينيّة، فهذا ما كان وثيق الارتباط بصعود «الغيلدز» (guilds) التي لم تكن مجرّد نقابات حِرَفيّين بل وحدات سياسيّة تتنافس على السلطة مع أصحاب الحكم و/أو أصحاب المكانة (أو ربّما، عليّة القوم – the Patriciate). وقد أدّى نجاح «الغيلدز» إلى إنجاز الاستقلال السياسيّ الكامل والسلطة القويّة للمدينة حيال خارجها. وبفعل الأهمية القصوى لـ«الغيلدز»، تحوّلت من مؤسّسة اقتصاديّة إلى رابطة انتخابيّة ومجلس بلديّ يمكن عبرهما التأثير في صنع قرار الجماعة.يذكّرنا خالد زيادة بارتباط نشأة المجالس البلديّة في بلداننا بسيرورة التحديث الوافدة من الخارج، إذ «الجديد المستحدث الذي شهدته المدن هو النظام البلديّ. وكان الإصلاح الإداريّ الأوّل، ذلك الذي جرى في 1827، حين أنشأ السلطان محمود الثاني مكتباً للتفتيش أو «الاحتساب» في اسطنبول، وتبعه في عام 1829 نظام «المختارين». وخلال احتلال القوّات المصريّة بلاد الشام (1832-1840) أنشأ ابراهيم باشا مجالس بلديّة في المدن، ومنها دمشق وبيروت». خالد زيادة، المدينة العربيّة والحداثة، دار رياض الريّس، 2019، ص. 203.
وبحسب فيبر، كان هناك عامل حاسم في تطوّر المدينة الغربيّة هو رابطة العناصر الاقتصاديّة المختلفة التي تمتدّ من الحِرَفيين إلى أصحاب المشاريع، أو البوبولو (popolo) ذات الطبيعة والدور «الثوريّين».Max Weber, The City…, chap. 4. فهي ما لبثت أن حلّت محلّ أخويّات (conjuratio) «البرغرز»، لتنخرط في مواجهات القرن الثالث عشر ضدّ عائلات من النبلاء. وكانت «البوبولو» قد أمّنت شروط المواجهات، إمّا من خلال التمويل الذي قدّمه أصحاب المشاريع التابعين لها أو عبر خوضها من قبل أعضائها الحِرَفيّين. وكجماعة سياسيّة فرعيّة باتت لـ«البوبولو» تنظيماتها الرسميّة، الماليّة والعسكريّة، التي تعمل كدولة ضمن الدولة. ثمّ ما إن تشكّلت مؤسّساتها القانونيّة حتّى انتشرت على نطاق السكّان جميعاً، والأهمّ أنّها أنشأت، قانونيّاً وتشريعيّاً، حكماً ذاتيّاً كان غالباً ما يمارس السيادة على الكوميون المدينيّ.
بمعنى آخر فإنّ المدينة، ضدّاً على الريف الإقطاعيّ، هي، وفي وقت واحد، حيث تصان المُلكيّة وتصان الحرّيّة ويتاح للعقل أن يشتغل متحرّراً من كوابح الولاءات الصغرى، وحيث تكون هناك قبضة عسكريّة ذاتيّة تدافع عن تلك المكتسبات والإنجازات.
ويُستشفّ من نظريّة فيبر أنّ شَرطي وجود الجماعة المدينيّة هما، في آخر المطاف، حكم ذاتيّ سياسيّ وعسكريّ يوفّر فرصة الإدارة الذاتيّة من قبل سلطات ينتخبها المواطنون، والقدرة على الدفاع عن هذه الديمقراطيّة الجديدة والوليدة. بهذا المعنى، يتشابه الكوميونُ القروسطيّ المدينيّ والبولِس (polis) اليونانيّة القديمة بوصفهما رابطتي مواطنين خاضعين لقانون خاصّ. أمّا السلطة المدينيّة التي تنتجها هذه العلاقات فتنهض على أساس عقلانيّ، لا كاريزميّ ولا تقليديّ، وفيها يُفرض القانون بشمول وتجريد، لا على قاعدة شخصيّة. وإذ ينشأ التجمّع المدينيّ على أساس المصالح، تتّسم علاقات الأفراد بالغُفليّة (anonymity)، بعيداً من روابط العائلة أو العشيرة أو الدين.
أمّا المدينة غير الأوروبيّة، في المقابل، فتفتقر إلى روحيّة مدينيّة وجماعيّة، وهي الروحيّة التي لا تقتصر على توليد الهويّة الجامعة بل تنجب كلّ شيء آخر تقريباً، من الرأسماليّة إلى السياسة فالثقافة والفنون والتشريع، وهي تُحكَم بيروقراطيّاً من خارجها، وغالباً ممّن يغايرون سكّان المدينة دينيّاً أو إثنيّاً ولغويّاً. وهذا ما يجرّ سكّان المدينة الإسلاميّة، المأهولة بجماعات عِرقيّة أو دينيّة مختلفة، إلى التنازع على السيادة والسلطة أكثر ممّا يتضافرون لصالح هدف مدينيّ جامع وهويّة مدينيّة مميّزة.
ولا يعفي فيبر الإسلام من المسؤوليّة، فيردّ إليه كثرة الطرق الملتوية والأزقّة المسدودة والبيوت المسوّرة ممّا يكثر في المدن الإسلاميّة المحافظة وفي عمارتها. ذاك أنّ مكّة في عهد محمّد، لم تحظ فيها إلاّ «العائلات القُرَشيّة» بالأهميّة العسكريّة والسياسيّة، وبالتالي «لم تنهض بتاتاً حكومة يقودها الغيلدز»المرجع السابق، ص. 88. أو ما يعادلهم. وهو يستشهد بالخلاف حول أرض «فَدَك» الذي يراه نقيضاً لمسائل المدينة الغربيّة، و«الذي وفّر المناسبة الأولى للانفصال الاقتصاديّ للشيعة». فهناك دار النزاع حول ملكيّة عائليّة، فيما «الجماعة التي زعم الخليفةُ باسمها الحقَّ في الأرض، جماعة الإسلام الدينيّة، لا جماعة مكّة السياسيّة، إذ الأخيرة لم توجد».المرجع نفسه، ص. 96-7.
وكان وصف عالم الاجتماع الألمانيّ للوقائع المدينيّة في مكّة ولتبايُنها مع النموذج المثال للمدينة القروسطيّة الأوروبيّة على النحو التالي: «إنّ فكرة الرابط الذي يستطيع أن يوحّد المدينة في وحدة مشتركة مفقودٌ في مكّة. وهذا ما أظهر خلافها المميّز عن البولِس القديم وعن الكوميون الإيطاليّ القروسطيّ المبكر». وقد اعترف فيبر بأنّه إنّما استشهد بمكّة لكي يصف الشروط المدنيّة النمطيّة قبل ظهور الكوميون الغربيّ القروسطيّ الأمثل.المرجع نفسه، ص. 88.
ولئن أكّد فيبر، في تحليله القانونيّ والتشريعيّ، على أهميّة الملكيّة المدينيّة للأرض والمكانة القانونيّة للأشخاص في المدينة الغربيّة، فقد اعتبر أنّ غياب الملكيّة الخاصّة في الشرق ربّما كان أحد العناصر الأساسيّة في عدم ظهور المدينة المثلى. ذاك أنّ المدينة الشرقيّة تتألّف من سلسلة «غيابات» أو نواقص تتصدّرها وظيفة المدينة كجماعة مدينيّة مستقلّة. ذاك أنّ مفهوم الرابطة المشتركة لم يوجد، ولا شعر الشرقيّون بارتباط قويّ بالمدينة، فيما امتلكت روابط كالعشيرة والقبيلة أو الكاسْت حضوراً يفوق حضور الاشتراك في جماعة مدينيّة. وفي ظروف كهذه لم يكن ممكناً أن يظهر، في الشرق، قانون حكم ذاتيّ للمدينة، ولا مفهوم للقانون بوصفه معطى عقلانيّاً يصنعه البشر. ففي آسيا، لم تُعرَف فكرة الوضعيّة القانونيّة للمواطَنة أو فكرة أنّ المدينة وحدة تقوم على الاشتراك، وكان من غير الوارد بالتالي اشتراك سكّانها في إدارة محلّيّة، سيّما وأنّ المدينة الشرقيّة كانت مقرّاً للحاكم الأعلى المُعيّن ولِعَينه الرقيبة. ومقابل دِفاع السكّان الأوروبيّين عن مدينتهم، وبناء مواطنيهم جيشاً من المشاة المدجّجين (hoplite army) على طريقة إسبارطة، دمج الحاكم الشرقيّ الجيش في جهازه البيروقراطيّ، وفُصل الجنود عن ملكيّة أدوات الحرب ممّا جعلهم رعايا عاجزين عسكريّاً بذاتهم، كما ترك الهويّات القويّة، العائليّة والقبليّة والطائفيّة، وجدّد قدرتها على منع سكّان تلك المدن من تأسيس مواطنيّة مدينيّة متّحدة وقويّة تتيح المقاومة لسيطرة الدولة.المرجع نفسه، ص. 211 و220. فالتنظيم العسكريّ في الشرق لا يرتكز على مبدأ التجهيز الذاتيّ (self-equipment) كما في الغرب، حيث يسود تنظيم القادرين على حمل السلاح وعلى تجهيز وتدريب أنفسهم والتمويل الذاتيّ للمهمّة هذه. فللدولة، في الصين وما بين النهرين، احتكارها العسكريّ الناشىء عن ثقافة الريّ، حيث المياه شارطة لوجود البيروقراطيّة وللخدمة العسكريّة الإجباريّة للطبقات الأفقر، كما لاعتماد تلك الطبقات على البيروقراطيّة المَلكيّة.المرجع نفسه، ص. 101 و119. من ناحيتهم، أكّد نقّاد فيبر على أنّ سكّان المدينة الإسلاميّة لم يُعدَموا الوساطة بينهم وبين السلطة المركزيّة، وهو الدور الذي شغله الأعيان، وفي عدادهم علماء دين وتجّار، كما أكّدوا على دور القضاة الذين ترك بعضهم تأثيراً ملحوظاً في القوانين والأحكام، وتالياً في إدارة المدن الإسلاميّة، وقد تزايد اهتمام الباحثين بهم مع تزايد دراسة سجلاّت المحاكم ووثائقها. كذلك أشاروا إلى الموقع الذي احتلّته النقابات المهنيّة (الغيلدز) والملل الدينيّة، آخذين على فيبر أنّه يغلّب التفسير بالغائيّة (التِلِيولوجيا)، ويقيس العالم على أوروبا بوصفها صاحبة التاريخ الأوحد، ولهذا فهو يضفي الماهويّة على الإسلام (والصين والهند…) قياساً بـ«النمط الأمثل» الأوروبيّ، حيث لم تكتمل الرأسماليّة إلاّ هناك. وثمّة من رأى أنّ نموذج فيبر الغالب لا يجوز تعميمه على سائر أوروبا، وأنّ قوّة المدينة الغربيّة انحسرت مع تطوّر بيروقراطيّة الدولة كما اندثر حكمها الذاتيّ. وهذا بينما رأى آخرون أنّ مدن الغرب التي عرفت التحوّلات الفيبريّة ليست القاعدة بل هي الاستثناء العالميّ الذي يعوزه التفسير. أمّا في ما خصّ أحاديّة النموذج الأوروبيّ عند فيبر، فقد أُخذ عليها تعميم يتجاهل الفوارق بين مدينة إسلاميّة وأخرى، وما قد ينتج عن الموقع الجغرافيّ للمدينة و/أو عن تراثها ومواريثها والجيران الذين أثّروا فيها.في استعراض مسهب ووافٍ للنظريّات التي تناولت نظريّة فيبر، تأثّراً واعتراضاً وبين بين، يمكن مراجعة: خالد زيادة، المدينة العربيّة…، سبق الاستشهاد.
على أنّ أعمالاً فيلولوجيّة واكبت الاستنتاجات الفيبريّة، فلاحظ برنارد لويس مثلاً أنّ الأدبيّات الفلسفيّة العربيّة اعتمدت كلمة «مدينة» تعبيراً وحيداً يعادل تعبير «بولِس» اليونانيّ. لكنّ «المدينة»، وقد استُمدّت الكلمة إمّا من الآراميّة أو العبريّة وضيّقت معنى «بولِس» ولخّصته، تبقى أرفع حظّاً من ابن المدينة، أي المواطن (citizen). ذاك أنّه لا توجد أيّة كلمة بالعربيّة تدلّ عليه، إذ بقي مصطلح «مواطن»، بمضامينه التي تتعلّق بالمشاركة في تشكيل الحكومة وتسييرها، وبأصوله الممتدّة من الثورتين الفرنسيّة والأميركيّة رجوعاً إلى الدول-المدن في اليونان القديمة، غريباً كلّيّاً عن التجربة السياسيّة المسلمة، وبالتالي مجهولاً للّغة السياسيّة الإسلاميّة. فـ«حينما تُرجمت الكتابات السياسيّة اليونانيّة إلى العربيّة في العصور الوسطى العليا، واستُخدمت كأساس لأدبيّات سياسيّة جديدة وأصليّة في العربيّة، كان هناك مُعادلٌ للمدينة، ولم يكن هناك أيّ معادل للمواطن (…) واستمرّ الأمر، في العالم الإسلاميّ، حتّى الاعتماد العامّ للأفكار الغربيّة في القوميّة والمواطنة، حيث ظهرت الحاجة إلى المصطلح فتمّ عند ذاك العثور عليه».Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Chicago, 1988, p. 32-33, 50 & 63.
لكنّ تجنّب التحليل الفيبريّ كلّيّاً بذرائع سياسيّة، أو لأسباب سياسيّة، ليس مهمّة سهلة دائماً. فالباحث والكاتب الفرنسيّ والشيوعيّ أندريه ريمون، الذي يرفض ماكس فيبر و«القراءة الاستعماريّة» للحقبة العثمانيّة، نراه، مدفوعاً بأمانته العلميّة والتاريخيّة، يسجّل ملاحظات عن الزمن العثمانيّ لا تبعد كثيراً عن التأويل الفيبريّ، من نوع أنّ «الانحطاط الذي يُشار إليه دائماً كان واضحاً بصفة خاصّة في المدن حيث ازدادت إقامة الفواصل في الحياة الحضريّة في ظلّ نظام ’الملّة‘، والذي كان من نتيجته حصول تصدّع حقيقيّ في البنيان الحضريّ أدّى إلى تفسّخ المدينة بصورة يتعذّر إصلاحها».أندريه ريمون، المدن العربيّة الكبرى في العصر العثمانيّ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة-باريس، 1991، ص. 34. وهو يؤكّد أنّ موقع الأوقاف الدينيّة المُعطِّل والمُصادِر للخيارات البلدية الديمقراطيّة، حابسٌ لجزء من العملية الاقتصادية بوصفه «حبس مال يمكن الانتفاع به»، وفي شمال أفريقيا تُسمّى الأوقاف بـ«الحبوس». أمّا «أهل السيف»، في المقابل، فهم أجانب فيما «الرعايا» محلّيّون، رغم وحدة الولاء للسلطنة. وبالنسبة لـ«الطبقة الحاكمة»، فإنّ «جوهر السلطة (…) كان بين أيدي طبقة يتمّ تجنيد أعضائها إلى حدّ كبير من أصل أجنبيّ، كما كان يتمّ اختيار الجزء الأكبر من العاملين في المجالين السياسيّ والعسكريّ من أفراد هذه الطبقة».المرجع السابق، ص. 55. وعن الأوقاف ودورها، أنظر ص. 165-167. وأمّا العسكريّون ممّن أُسندت إليهم مهمّة توطيد الأمن، فكانوا «عدداً من الميليشيات» أهمّها الإنكشاريّون. وهو يضرب المثل بالجزائر، إذ منذ التخلّي عن نظام الدنشيرمه (devsirme – حيث تجنّد الدولة العثمانيّة أولاداً من عائلات مسيحيّة يُحوّلون إلى الإسلام ويُدرّبون كإنكشاريّين، على أن يتحوّلوا طبقةً من المحاربين يتبعون السلطان مباشرة)، «بات يتمّ تجنيد عساكر أوجاق [=وحدات] الجزائر من الأناضول أساساً ومن الطبقات الأكثر فقراً هناك»، وإن أقام بعض هؤلاء علاقات مصاهرة مع سكّان المدن و/أو أقاموا فيها. وقد حلّ شراء المماليك وتجنيدهم «لتعيينهم في الوظائف الحكوميّة والعسكريّة لمنافسة الإنكشاريّة». وفي الجزائر أيضاً، حافظت الميليشيا على طابعها التركيّ حتّى النهاية إذ كانت «تتجدّد دائماً مع وصول تعزيزات قادمة من الأناضول. وقد بذل الأتراك الجهود للحفاظ على القولوغلي («أبناء العبيد» وهم أطفال أتراك لرجال من الميليشيات ونساء محلّيّات) في مرتبة أدنى».المرجع نفسه، ص. 55 و56 و60 و62. ويذكّرنا أندريه ريمون بما هو معروف جيّداً عن محدوديّة سلطة القضاة الذين «كانت ترسلهم حكومة السلطان ليرأسوا مجموع النظام القضائيّ في الولايات»، وإذ يعرّج على علماء الدين ومسايرتهم الحكّام، يلاحظ ما يدرّه موقع «الأشراف» (أقارب النبيّ)، رغم هامشيّتهم، من «مكانة وامتيازات مادّيّة». ومستشهداً بالمؤرّخ الفرنسيّ جان سوفاجيه، يرجّح أنّ عدد هؤلاء في حلب القرن الثامن عشر تراوح بين ثلاثة آلاف أسرة وأربعة آلاف.المرجع نفسه، ص. 66 و67. وحين يتناول الانفصال بين الجماعات الدينيّة والمذهبيّة والإثنيّة يسمّيها «الفصل بين الجاليات» ويعتبرها سمة مميّزة للمدينة، كما يرى الشيء نفسه في النسبة المرتفعة للدروب المسدودة dead ends أو cul de sac.المرجع نفسه، ص. 131 وما يلي، وص. 139-140. أمّا سكّان الضواحي فكانوا «في الأغلب غير مندمجين مع «المدينة» ويعيشون في ظلّ ظروف غير ملائمة اجتماعيّاً، ويبدون بصفة عامّة كمتمرّدين وناقمين، ويوجد تعارضٌ بينهم وبين سكّان «المدينة» الأكثر بورجوازيّة».المرجع نفسه، ص. 153.
وقصارى القول إنّ خراب مُدننا سببٌ آخر، أشدّ إلحاحاً من باقي الأسباب، في الدعوة، وفي الحاجة، إلى اتّباع نهج أكثر جذريّة وأقلّ ورديّة في قراءة أحوالنا، وأحوال مدننا نفسها، فكيف وأنّ استحالة المدن تعني استحالة الأرياف أيضاً، واستحالة كلّ شيء آخر بالتالي؟ أمّا داعش وبشّار الأسد و«حزب الله» وحكّام لبنان فلم يؤسّسوا دمار المدن الثلاث وسواها ممّا دمّروه، بل استأنفوه وصعّدوه وكانوا اليد القذرة التي نفّذت حكم تاريخ ظالم متعثّر.