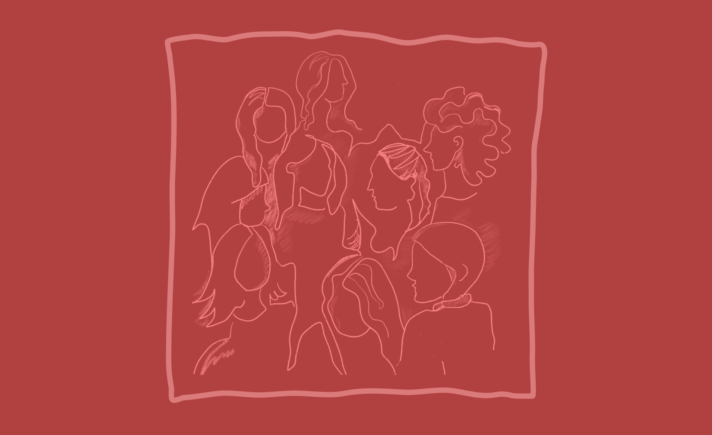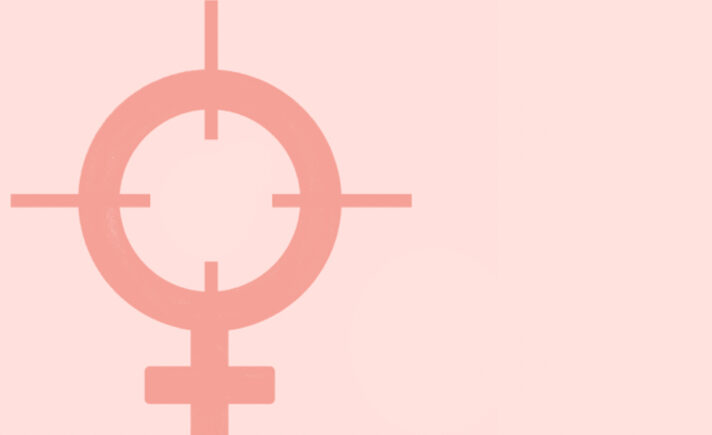تصل رند إلى المقطورة حيث أَنتظرُها في القطار، تضع حقيبتها على الطاولة وتجلس، تسلم عليّ وتفتر شفتيها عن ابتسامة متعبة. يجلس ابنها قربها، وتتدفق الطاقة منه ويبدو نابضاً بالحياة وشديد الثقة بنفسه. «حطيت بابني كل الشجاعة وقوة الشخصية اللي أنا ما ربيت عليها». تزيح رند حقيبتها التي يختبئ خلفها وشم طبعته على يدها ما يزال يبدو حديث عهدٍ على جلدها. فكرة الوشم في بالها منذ زمن، ولكن قرارها بالوشم كان قبل أسبوع.
تسألني رند إن كنت قد فهمت الكلمة المكتوبة. هذه الخطوة التي أجلتها كثيراً وجدت نفسها قبل أسبوع مدفوعة باتجاهها. ليس الوشم صباغاً أسود ملتصق بالجلد، ولكنه خيار روحي ويجب أن يكون جزءاً من ذاتها إلى الأبد.
مرت ثلاثة أعوام على حصول رند على الطلاق من زوجها.
تزوجت رند في ريف دمشق قبل 15 عاماً من أخ صديقتها. تقدم الشاب إلى رند ثلاث مرات ورفضت. لكن إصرار الشاب وثقتها بصدق صديقتها التي كانت تتوسط له في كل مرة طوّعا عقلها وقلبها. رند كانت أكبر صبايا العائلة اللواتي لم تجدن الشريك بعد. خوفها من أن تقل فرصها في الزواج جعلتها توافق على الشاب المتقدم. على الأقل ليس متزوجاً قبلها، ويبدو وسيماً.
لم تكن رند سعيدة يوماً في زواجها، ولكن طبعها اللطيف وشخصيتها المرحة كانت تجد السعادة في أبسط التفاصيل وتخلق الفرح لتنشره حولها. فمع كل تعاستها لم يكن تُظهر إلا أنها أسعد الفتيات «يمكن ماكنت أرضاها على حالي ويمكن ما كان بدي شفقة ويمكن ما كان بدي وجع قلب اللي حوالي عليي».
«والله لطلقك»
بعد حصار مدينتها، هربت رند مع زوجها وطفليها إلى تركيا. «ما عشت بحياتي قلة وتعاسة متل ما عشت بهالمكان». لم يكن زوجها قادراً على إطعام عائلته وإيجاد عمل، الأمر الذي بدأ يضغط عليه وعليها، وبدا أن مخلفات الحرب بدأت تلقي بثقلها على العائلة.
«والله لطلقك» أصبح الشبح الذي يلوح به زوجها كلما شعر أنه مُدان أو مُلام. كان الخوف في تركيا رفيقها كل يوم. الخوف من الجوع، من القلة، ومن أن يطلقها زوجها. لم تطل إقامتها في تركيا قبل أن تركب مع طفليها وزوجها البحر متجهة إلى ألمانيا.
في مدينتها الصغيرة في الجنوب الألماني، عاشت رند في بيت صغير، بناؤه قديم في مكان بعيد عن المدينة، وبدأت تجرّب الحياة من جديد. زوجها نفسه، لكن في بلد جديد. بلا عمل وبلا عائلتها.
في وقت قصير وجدت رند لنفسها عملاً بسيطاً كانت تساعد فيه زوجها في رد ديون رحلة البحر. أما زوجها فلم يكن سريعاً بنفس الدرجة في تعلم اللغة ولم يجد عملاً. مع الوقت بدأت رند تحصد الثناء على عملها وعلى ذكائها.
زوجها، الذي لم يكن قبلاً يهتم للفرق بين صلاة الظهر والعصر، أصبح شيخاً، وصار طول لباسها وتوقيت عودتها إلى المنزل شغله الشاغل. «كنت حس إنو أنا لعبته وشغلته».
«والله لطلقك وآخد منك الولاد»، صار زوجها يكرر العبارة كوِرد أو مسبحة وفي كل مرة كانت تشعر هي بالخوف. خوف أن تبقى وحيدة، وخوف أن «تتبهدل» وتحرم من أطفالها أو أن يربوا في عائلة مفككة. في كل مرة يهدد هو فيها بالطلاق تقول له «طيب الله يخليك خلينا نسكر هالسيرة، كل شي بينحل وكل شي فينا نحكي فيه».
كانت الحياة تصعب والعلاقة بينهما تصبح غير ممكنة. تساءلت عن السنوات الماضية، كيف مرت؟ وكيف صبرت معه كل هذا الوقت؟ أخيراً، أدركت رند أن استمرار زواجها في سوريا كان في جزء كبير منه بسبب عائلتها، وبالأخص أمها التي سندت الزواج وساندت الزوج. كانت المشاكل تتفاقم، وتصل إلى طرق مسدودة وهي تحاول أن تحلها. زوجها كان يتهرب من المشاكل ويؤجلها دون أن يقوم بأي محاولة تذكر لحل المشاكل.
«بحياتي ما كنت سعيدة بزواجي، بس ولا مرة كانت العلاقة مؤذية هالقد». تقطع رند روايتها لتلتقط أنفاسها. تصل الحروف إلى حلقها فتبتلعها ككتلة أشواك تجرح حلقها «مافيني احكي، صارت المشاكل تزيد، في مشاكل ما فيكي تشاركيها مع الناس لأنو الناس ما بتعرف وما بتفهم!». أطلب منها تفاصيل أكثر. تصمت قليلاً وتتعرق ثم تبدو وكأنها اتخذت قراراً مريحاً بالصمت، ويبدو الألم وكأنه زال من صوتها مثل عربة تنزل المنحدر بعد صعود إلى القمة. «ليكي في تفاصيل كتير، كتير في شغلات، ما فيني إحكي شو، بس ورا كل قصة الله بيعلم قديش في صبر».
كانت رند تحاول أن تستمر في العلاقة رغم كل التحديات. وكانت تتألم نفسياً ويؤلمها تلويح زوجها بالطلاق عند كل مشكلة. بدأت رند تنهار وبدأ ثقل الغربة يسحبها للأسفل وزوجها يشدّ وفكرة أن تترك وحيدة بلا أطفال تمزقها. أخبرت صديقتها المقربة في سوريا عن ما يحصل، فنصحتها: «لما يقلك بدو يطلقك جربي قوليلو إي»
في إحدى المرات بعد شجار قال لها: «أنا ماعاد اتحمل الحياة معك، بدي طلقك» وذهب إلى بيت صديقه يومين ليعطيها فرصة لتفكر وتعتذر. وعندما عاد لم تعتذر كعادتها، بل قالت له «طلقني». في هذه اللحظة شعرت أن شيئاً فيه قد اهتزّ. «كنا بجنينة بالمدينة، وقلي وقتها: إذا تطلقنا أنا رح غيّر المقاطعة». شعرت رند بالخوف لكنها هزت رأسها بالموافقة. تركها زوجها وحيدة ومعها أولادها ودراجاتهم الهوائية والأغراض، في محاولة منه لجعلها تتذوق شعور الترك والحياة دون رجل. «دبرت حالي وركبت مع الأولاد بالقطار ورجعت على البيت ولقيته ناطرني». ناقشها في ما تقوله وأخبرته عن عمق الأذى النفسي الذي تعيشه. وعدها بالتغيير، وسألها ماذا تريد لكي تشعر بشكل أفضل، فأخبرته أنها تريد مساحة صغيرة تتنفس فيها، وبعض الثقة.
في اليوم الثاني عادت إلى المنزل فوجدت شوكولا وورود على تختها. أمل صغير تفتح في داخلها.
«يا رب بس بدي ولادي»
«أنا ما عم إحكيلك التفاصيل كاملة لأنو وقتها ما بخلص، وأنا إذا ما قلت التفاصيل فالإحساس ناقص والقصة رح تصير ضعيفة». كانت الورود تحرك فيها شيئاً، لكن الجرح كان أعمق من أن يداوى ببضع زهرات ملونة.
في اليوم الثالث، وقبل امتحان اللغة الألمانية، طلب منها زوجها العلاقة الجسدية وكأن شيئاً لم يكن. فطلبت منه أن يتكلما قبل ذلك «معلش بس نحكي؟ بس نحكي كلمتين؟». اقترب منها بجسده وهي تبتعد حتى التصق ظهرها بالخزانة. خلع عنها ملابسها، فخارت قواها. ضربها فهوت على الأرض، فركلها بقدمه. توسلت له أن يتكلما ثم ليفعل ما يشاء. لم يستمع لكلامها وبدأ يهوي على جسدها بالضرب في كل مكان يصل إليه الألم. توسلت أن يتوقف عن الضرب ويفعل بجسدها ما يشاء. عاشرها مرغمة، ثم سكب عليها الماء البارد وذهب ليُقل ابنه من حضانة الأطفال.
في اليوم التالي كان تقديم فحص اللغة في المدينة. ذهب معها إلى مقر الامتحان وانتظرها خارجاً حتى خرجت. ثم سألها: «شو حابة تتغدي اليوم؟». لم تعرف ماذا تجيب، كان عقلها أشبه بشاشة سوداء: «فاصوليا، أي شي». في اليوم التالي خرجت من المنزل ولجأت إلى معارف لها في ألمانيا وحاولت الحصول على الطلاق. بهدوء.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يضربها فيها، ولا الأخيرة. «بسوريا كان يضربني، بس ولا مرة بهالوحشية، كان يخاف من أهلي». تبرر لي رند بأسىً طلاقها وحرمانها لأولادها من أبيهم، وتبدو وكأنها لم تغفر لنفسها ذلك بعد. «عطيته فرصة وفرصتين وتلاتة.. عطيته فرص لحتى خلصت الفرص». تنقبض حنجرة رند، ثم تنفتح عن تفاصيل رهيبة تطلب مني ألا أنشرها. تكرر الضرب وازدادت حدته حتى لفها الحزن وكاد يقودها إلى حالة اكتئاب حادة.
باحت رند لأمها ببعض التفاصيل، فطلبت منها أمها أن تتركه. توسلت لها أن تنجو وتترك زوجها حتى لو اضطرت للتخلي عن الأطفال.
«أنا بتعب من الحكي، الحكي عن حياتي بيوجعني، بيرجعني لمكان بحس حالي فيه ضعيفة وأنا مابحب كون ضعيفة».
وسّطت رند أقاربها في ألمانيا وأقاربه، لكن شيئاً لم يكن يردعه. حتى كبار العائلة الذين كانت كلمتهم «لا تصبح اثنتين» لم يتمكنوا من الإصلاح أو تغيير شيء. حاولت أن تشد مرة وترخي أخرى ولكن الأذى كان يزداد. أمها في سوريا صارت تتوسل لها أن تترك زوجها وتمشي لأنها لا تريد أن تجن ابنتها أو أن تخسرها.
يرتبط الطلاق في مجتمعنا بالفشل والعار، ويعتبر «أبغض الحلال» وخطوة على طريق تفكك العائلة وتشرذمها. يتوقع المجتمع من المرأة الصبر والتحمل، وإلا سيكون عليها تحمل الإهانة والشعور بالذنب طيلة حياتها.
«مع هيك وبعد كل شي الناس، رح تفكرك المرة اللي طلعت على ألمانيا لتطّلق! المرة اللي حرمت أولادها يربوا ببيتهم مع أبوهم! المرة اللي بس بدها تفلت». بالنسبة لكثير من المشايخ و«المصلحين الاجتماعيين» ورجال الدين والعوائل فإن الطلاق هو أبغض الحلال وحرية المرأة شيطان يتعوذون بالله منه لأنهم «يريدون حمايتها». لكن كل الأذى الذي ينال المرأة والتعنيف الذي تعيشه لا يقلقهم ولا يكلفون أنفسهم عناء الكلام عنه. في مجتمعها السابق في سوريا، كانت رند تتحمل كل أنواع الإيذاء كرامة لمجتمعها وخوفاً منه، وكان المجتمع يساعدها. أما اليوم في ألمانيا فلا أحد يمكنه مد لها يد المساعدة ولا أحد يرفع عنها السوط.
بعد تكرر الإيذاء الجسدي هربت رند مع طفليها إلى نُزُل النساء (frauenhaus)، وهي أماكن في ألمانيا مخفية العنوان تلجأ إليها النساء اللواتي يتعرضن لعنف منزلي مع أطفالهن، تحت حماية الدولة وإلى أجل غير مسمى. لم يكن من السهل عليها أن تحصل على الطلاق، وكان زوجها يمسكها من يدها التي تؤلمها: أطفالها. في أكثر من مرة اختفى ومعه الأطفال، وفي غيرها عاد والأطفال ليسوا معه. وكانت رند في كل مرة تسقط في هاوية من الخوف لا قرار لها. «مرة التقينا وإجا بدون الولاد فأنا كتير خفت، رجعت على النُزُل، كنت قاعدة مكسورة ومقهورة وعاجزة، قعدت على الشباك تكورت على حالي وتطلعت للسما، وقلت يا رب.. يا رب بس بدي ولادي».
في نُزُل النساء، تعرفت رند على نساء يعانين مثل معاناتها وسمعت قصصهن، وعرفت أن القانون سيحميها إن كانت قوية، وأن حصولها على حضانة الأطفال مرهون بأن تكون قادرة على رعايتهم. بدأت رند رحلتها في البحث عن بيت وعن عمل لكي تحصل على أطفالها وتمكنت في النهاية من ذلك.
لا سبيل آخر
لم تحب رند زوجها يوماً، لكنها لم تكن تفكر بالطلاق قبل أن يكبر أطفالها. «بتذكر كنت عطول قول لأمي أنا ما بدي إكبر مع هاد الإنسان»، لكنها لم تفكر يوماً بأن تطلب الطلاق، بل كانت تخاف أن يطلقها وكانت تنتظر أن يكبر أطفالها لتترك زوجها.
لكن في ألمانيا وجدت نفسها بدون مجتمع يحمل عنها ومعها، وزوجها نفسه أصبح أكثر عدائية وتوحشاً، وأدركت أنها في هذا البلد يمكنها أن تربي طفلين وحدها. لم تختر رند الطلاق، بل كانت مجبرة عليه. لم يبق طريق آخر لم تجربه حتى نهايته. لكن المجتمع والناس لا يفهمون ذلك ولا يكلفون أنفسهم عناء الفهم. «قبل يومين كنت قاعدة ببيتي، عم اتطلع بحالي وبكل شي وصلت له، أنا كتير منيحة! أنا ناجية، عندي بيت حلو وشغل منيح وعندي ولادي، بس حسيت حالي موجوعة ومضطرة إتخبى كل الوقت».
تخفي رند تفاصيل حياتها عن كثيرين: «ما بدي إحكي ومافيني إحكي». خوف رند من الآخرين الجاهزين للحكم عليها يكبّلها.
* * * * *
تتقاطع قصة رند مع قصة ليلى في تفاصيل كثيرة: رند وليلى تزوجتا بمباركة وضغط من المجتمع، لم يستطع زوجاهما الاندماج والانطلاق في المجتمع الجديد، كلتاهما خسرتا الدعم الاجتماعي الذي كان مقدماً لهما في سوريا. ورغم اختلاف شخصيتهما وظروفهما إلا أن الألم في الحكايتين يتشابه لدرجة أن القصتين تبدوان قصة واحدة في شخصين. وفي عمق العمق، تعيش كلتاهما معركة خاضتاها وحيدتين ودفعتا ثمنها وحيدتين، ثم وجدتا نفسيهما مدانتين من المجتمع. قصة نجاح ونجاة ملهمة لكن في قلبها قصة طلاق مؤلمة.
«لهلأ بيوجعني كتير أني تركت ولادي»
تدرس ليلى الهندسة الطبية في جامعة في شمال ألمانيا. قدمت ليلى كل موادها ولم يتبقّ لها لإتمام دراستها سوى مشروع التخرج. تعرف ليلى جميع طلاب الجامعة العرب تقريباً، ويعرفها جميعهم. لكن من يعرفها حقاً قليلون جداً.
من يعرف ليلى قبل سنوات لا يمكنه إلا أن يندهش من تغيّرها وسرعة خطواتها. تشعر ليلى بالفخر مما حققته وتشعّ طاقة وقوة. لم تنتهِ معاركها بعد ولكنها أصبحت أكثر توازناً وقوة. أثني عليها وعلى انطلاقها مقارنة بذاتها قبل سنوات حينما رأيتها لأول مرة. تفتر شفتيها عن نصف ابتسامة ونصف جرح ثم تقول: «كنت بعرف أنو أنا مو منيحة بسبب العلاقة مع طليقي، وكنت بعرف الطريق لإطلع، بس مع هيك كنت خايفة كتير»
تلتمع عيون ليلى لوهلة ثم تسفر ابتسامتها عن ألم عميق. تنظر إليّ ثم تحدق في الأفق وتقول: «بدي قلك شي لسا ما قلتو لحد،ا بس شي بحسو كل يوم وبيعصرلي قلبي، أنا كل يوم بحس بوجع أني تركت أولادي».
كانت ليلى طفلة عندما تقدم لخطبتها صديق والدها الذي يكبرها باثني عشر عاماً. تعرفت عليه عاماً ونصف واستمرت الخطبة عاماً ونصف أيضاً. شرط والدها للزواج كان أن تنجح في البكالوريا.
كانت ليلى في الصف الأول الثانوي ولم تكن تحب خطيبها «بس نحنا بسوريا كنا نفكر حالنا أحرار، الحقيقة إنو المجتمع بيفرض عليكي أشيا وبيوهمك إنو فيكي تختاري». حتى أهل خطيبها لم يكونوا مسرورين للخطبة بسبب تاريخ عائلتها السياسي وسمعتهم في الابتعاد عن الدين. رغم ذلك، لم يكن التراجع عن الأمر ممكناً، فأهل البلدة يعرفون بالخطوبة والشاب زارهم في منزلهم وستقل فرصها في الارتباط إن فسخت خطوبتها: «الواحدة بس تنخطب بتصير مستعملة وبتقل قيمتها».
نجحت ليلى في البكالوريا لكنها لم تحقق المعدل الذي تريده. علاماتها كلها كاملة أو شبه كاملة. ما عدا في مادة واحدة: «ليلة هالمادة إجا لعندي خطيبي وسهر عندي للساعة تلاتة، وأنا رح ابكي لأنو الساعة ستة تاني يوم لازم فيق ع الامتحان».
أثناء تقديمها على مفاضلة البكالوريا، كان خطيبها وصديقه حاضرَين. أمسك الورقة بكلتا يديه وبدأ يرسم عنها مستقبلها ويقيم خياراتها. «كل واحد عم يعطيني رأيو بشو بدي إدرس، هاي لا لأن فيها اختلاط، وهاي لا لأن بتأخر فيها برات البيت، وهاي لا لأنو الشغل فيها ممكن يكون بالليل».
سجلت ليلى في معهد للكمبيوتر، لكن زوجها لم يكن يسمح لها بالذهاب لحضور المحاضرات وشعرت ليلى كأنها في قفص يخنقها. بعد شهور أخبرت أمها أنها تريد الطلاق فلم تعارضها أمها لكنها طلبت منها أن تتريث حتى مرور عام على الزواج على الأقل «لكي يتبين خيره من شره». بعدها، عرفت ليلى أنها حامل، وشعرت أنها عالقة. حمْلها بطفلتها ضرب بكل خططها للهروب والنجاة عرض الحائط. شعرت ليلى بأنها سجنت نفسها بيدها وابتلعت المفتاح في بطنها. حتى عندما ولدت طفلتها لم تشعر بذلك الحب الأمومي الجارف الذي يتكلم الجميع عنه. بل كانت خائفة من هذا المخلوق الصغير الذي لن تستطيع الهرب بسببه.
أثناء حملها، قررت ليلى أن تقدم البكالوريا مجدداً وتدخل فرعاً آخر. كانت وقتها حاملاً في شهرها الخامس. بدأت ليلى الدراسة قبل الامتحان بشهر واجتازته وسجلت في كلية الرياضيات.
«بتذكر وقتها كيف أقنعت الكل إنو الفرع منيح وما بدو حضور ولا فيه مخابر». دخلت ليلى الجامعة ووجدت أنها ليست الوحيدة التي اختارت الفرع لهذه الأسباب، ففرع الرياضيات كان ملاذاً لكثير من الأمهات اللواتي دخلن الفرع لأن الحضور غير إلزامي فيه. «على طول كنت بحلم بالجامعة، بس ولا مرة فكرت أنو رح فوتها وبطني لحلقي». كانت ليلى تسافر كل يوم ساعة من منزلها في ريف دمشق إلى جامعة دمشق، وحتى في شهرها التاسع كانت تحضر جميع المحاضرات.
بعد ولادتها عادت للجامعة وتولت أمها جزءاً من تربية ابنتها وحملت عنها بعض عبء الأمومة وجزءاً من ضغط الجامعة. «إمي كانت تروح على كشك الجامعة وتجبلي المحاضرات والملخصات وتخليني إدرس». ولم يكن التوفيق بين الدراسة والأمومة وعمل المنزل سهلاً. لكن المجتمع كان يساعد ليلى. حتى أهل زوجها الذين رفضوا الزواج كانوا يدعمونها ويدفعونها إلى الأمام، فقد كانت تعجبهم فكرة أن «كنّتهم متعلمة». أما زوجها غير المتعلم فكان مجبراً لكنه لم يكن يتوانى عن كسر معنوياتها وإحباطها.
مع دراستها بدأت ليلى في تقديم الدروس الخصوصية وبدأت تصنع لها اسماً وشهرة ودخلاً مادياً مستقلاً. وهنا شعرت أن زوجها بدأ يصبح قلقاً وخائفاً. «كذا مرة يدق الباب بنص الدرس ويقلي يلا صار وقت الطبخ. أو يخلي بنتي تبكي ورا الباب وما يرضى يخليها عند إمي».
بعد السنة الثانية من دراستها تأزمت الأوضاع في ريف دمشق وعرفت أن اسمها على قائمة الأسماء المطلوبة للنظام بسبب نشاطها الثوري، وكان القرار الحاسم في حياة ليلى أن تخرج مع زوجها إلى لبنان. كان عليها أن تختار بين دراستها أو حياتها. بعد مدة من العيش في لبنان، قررت ليلى أن تعود إلى سوريا لتقدم موادها. «كان لازم إختار بين إني موت على البطيء بلبنان، أو خطر الحواجز على الطريق».
«يخرب بيتك على هالقلب»
طلبت ليلى من أمها أن تسافر إلى لبنان وتتولى العناية بابنتها ريثما تقدم موادها في الجامعة، وهكذا استطاعت أن ترفع جميع موادها. وكانت أمها قبل ذلك تشتري لها المحاضرات وترسلها مع المسافرين إلى لبنان أو في الباصات أو سيارات الأجرة. في الفصل التالي، لم يكن من السهل أن تنوب أمها عنها في رعاية طفلتها فطلبت من زوجها ذلك. «مرة قبل الامتحان قلي هيك من نص الدنيا: مافي روحة». فقدت ليلى صوابها، فزوجها لا يعرف الثمن الذي دفعته والعذاب الذي تكلفته لتحصل على المحاضرات ولتدرس المادة. أصرت ليلى على الذهاب وخرجت من الباب لتلحق سيارة الأجرة. لحقها زوجها ومعه ابنته تبكي بدون توقف وهي ترى أمها تخرج من المنزل. توسلت ليلى لزوجها ألا يدع الصغيرة ترى أمها وهي ذاهبة.
كانت ليلى تخطو إلى السيارة وصوت بكاء ابنتها يتهادى إلى مسمعها. قدمها في السيارة وقلبها عند صغيرتها. تراجعت ونظرت إلى ابنتها وهي لا تدري ماذا تفعل. من أمامها وخلفها صارت أصوات الناس تصل إلى أذنها وهم يقولون: «يا الله يا أختي خلصينا بدنا نمشي، يا روحي لعند بنتك يا اركبي».
«هاد هو المجتمع اللي على أساس مهتم لأمرنا وعم يحمينا! هاد هو المجتمع اللي مستقبلي متل رجلو»، تقول ليلى وهي تتذكر تلك اللحظة.
شعرت ليلى يومها أن الأرض رخوة تحت قدمها، استجمعت قوتها ودخلت إلى السيارة وهي تتشبث بالمقعد كمن يشعر بالهاوية تحته وهي تقول باللامبالاة الفظة لامرأة يائسة: «معلش لو سمحت أخي تمشي فوراً؟». بينما تتفادى النظرات المندهشة المعلقة عليها، جلست على المقعد وأغلقت باب السيارة ليتناهى إلى سمعها: «يخرب بيتك على هالقلب، بتتركي بنتك مشان هالمادة». أما زوجها ومعه الطفلة في يده فلم يلُمه أحد.
عاشت ليلى أقسى أيامها في لبنان. كانت فقيرة جداً وعليها أن تبدأ كل شيء من الصفر. رغم ذلك، استطاعت أن تقف على قدميها وتُحسّن حياتها. في لبنان شاركت زوجها الحياة وحده، بدون مجتمع وأهل. وتأكدت أنها لا يمكن أن تستمر معه. في الفترة الأولى، كانت تلوّح بالطلاق عندما تتفاقم المشاكل. عندما غادر كل أهلها سوريا وهاجروا، شعرت بأنها باتت بلا ظهر، وشعرت أن زوجها أصبح لا يبالي بتهديداتها بالطلاق. «كتير رجال بعد الهجرة صاروا يضغطوا على نسوانن، إنو يلا تطلقي وارجعي على سوريا إذا فيكي». كانت ليلى تعتمد دوماً على قوتها وعقلها للنجاة. لكن في لبنان شعرت بقلة الحيلة والعجز وانعدام فرص النجاة.
حالف الحظ ليلى، واتصلت الأمم المتحدة بهم وأخبرتهم أن الاختيار وقع عليهم للسفر إلى ألمانيا. «أول شي سألته أنا : فيني إدرس!؟ يقلولي ما منعرف». عندما رأى زوجها تعلقها بفكرة السفر وحماسها هددها أن يلغي السفر. قالت له «بسافر لحالي».
«فجأة رجعت إنسانة طبيعية»
بعد وصولها إلى ألمانيا، حصلت ليلى على دعم لتمويل دروس اللغة الألمانية من مؤسسة أوتو بينيكيه، وكان عليها أن تنتقل إلى هامبورغ وحيدة. في الغرفة الجديدة بدأت تستيقظ وحيدة كل يوم لمدة شهرين، وبدأت تشعر بسلام نفسي غريب. «حسيت فجأة أني صرت إنسانة طبيعية!».
بدأت ليلى تتعافى بالوحدة، وبدأت تدرك أن مشكلتها ليست مع ذاتها، وأنها ليست مريضة نفسية أو مضطربة أو ميؤوس من حالها. حتى آلامها الجسدية بدأت تنحسر، وزنها الزائد بدأ ينزل، ألم الركب والشد العضلي انحسر، صوتها الذي كان يختفي عاد. صارت تنام بعمق أكثر. «كنت عرفانة بعقلي إنو نجاتي بدراستي».
نجحت ليلى في الامتحان بترتيب الثانية على المعهد. كان الأستاذ سعيداً جداً بها لأنه كان قلقاً عليها إذ إنها لم تُنهِ كورس اللغة السابق. أخبرها الأستاذ: «Du bist ein Wunder des Jahres» (أنت معجزة هذه السنة)، فسرعة تعلمها للغة كانت غير متوقعة.
بعد انتهاء المنحة، عادت ليلى إلى منزلها ومعها شهادة اللغة C1 التي تؤهلها لدخول الجامعة. كانت سعيدة وفخورة، ولكن معارفها في المدينة كانوا يلومونها على أنانيتها لأنها تركت طفليها من أجل نفسها. لم تمر أيام على إقامتها مع زوجها حتى عادت لها آلامها وعادت لتشعر باضطرابها وبالألم النفسي الذي يسببه لها وجودها في هذه العلاقة. لمدة ثلاثة شهور، حبست نفسها في غرفة الأطفال. لم تكن تطيق رؤية الشمس، فكانت تسدل الستائر أربعاً وعشرين ساعة في اليوم. أما زوجها فلم يكن يدري أو يبالي. طلب منها زوجها «حقه الشرعي» لكنها لم تستطع، فعاشرها مرغمة.
«بلش جوزي يتعرف بألمانيا على ناس اسقالله رفقاتو بسوريا، أمور بديهية بسوريا كانت تصير صارت هون محل سؤال، صار المجتمع يضغط عليه: مرتك ما لازم تسمحلها تجيب غراض، ليش إنت اللي عم تدير بالك على بنتك، هي لازم تكون عم تعتني فيها»… كان زوجها مرتاحاً لأنه يحصل على المساعدات الاجتماعية دون بذل جهد، ولذلك لم يكن يمنعها من حضور كورسات اللغة. لأنها لو لم تكن تذهب للدروس، لكان عليه هو أن يفعل. لكنه كان يقودها بتصرفاته إلى الجنون.
«أنا كتير عولت على العلاقة معو، على المجتمع، على الأهل، على المشايخ، على القرايب… كنت هدد بالطلاق بس ما كنت عن جد بدي اتطلق، كنت بدي كبر ولادي أول، ذبلت عاطفياً واجتماعياً ومتت جنسياً، انهرت نفسياً». أصبحت ليلى عصبية وحزينة، وصارت تشعر أنها غير متزنة، زوجها كان يقودها إلى الجنون ثم يعيّرها بأنها مجنونة.
عندما يغفو أطفالها، كانت تتأملهم وتصبّر قلبها وتربط عليه من أجلهم. أكثر ما كان يجعلها تصبر وترضى هو أن زوجها، رغم أنه زوج سيء، إلا أنه أب جيد وحنون ولم تكن تريد أن تحرم أطفالها من حنانه.
في إحدى الليالي كانت ليلى تغفو قرب طفلتها وهي تتأملها وغفت: «حسيت المخدة عم تبلعني، حسيت حالي عم إغرق وإختنق، فقت وأنا ما عم إقدر إتنفس». عندما استيقظت وأدركت يأسها الذي يبتلعها إلى قاع لا تعرف له نهاية، «تأكدت وقتها إنو ولادي اللي عم ضل مشانن، رح يخسروني إذا بقيت».
الحرمان من الأطفال
عندما تأكدت ليلى من قرارها، طلبت الطلاق. «كنت أظن أن ألمانيا ستتكفل بأن يبقى أطفالي قربي»، هذه الصورة التي كانت مرسومة في عقل ليلى. لكن بعد المحكمة، عندما عرفت أن الوصاية على الأولاد ستكون من حق الزوج، لأنه عاطل عن العمل، وبالتالي متفرغ للتربية أما هي مشغولة مع جامعتها، شعرت بلحظة بالانهيار لكنها قررت أن تتماسك، فهي تحتاج كل ذرة طاقة. «فكرت أنو بكل الأحوال ولادي كانوا رح يخسروني لو بقيت بالعلاقة».
انتقلت ليلى إلى المدينة التي فيها جامعتها وركزت على دراستها، فهي تعرف أن نجاتها في دراستها. استطاعت ليلى أن تقدم كل موادها في الجامعة وتنجح فيها، وكانت تدرّس الطلاب مادة الرياضيات في الجامعة وتقدم دروساً خصوصية في مواد أخرى. الفصل القادم سيكون فصل مشروع التخرج. وقد حصلت ليلى على الجنسية الألمانية مؤخراً، أما أطفالها فتتأمل أن يعودوا ليعيشوا معها عندما تجد عملاً.
* * * * *
تتزايد أعداد اللاجئات السوريات اللواتي يطلبن الطلاق في أوروبا وألمانيا. في مقابلة مع جريدة فرانكفورتر، تقول المحامية نجاة أبوكال أن معظم الطلاقات التي تقدمت إلى مكتبها في برلين بعد عام 2015 كانت من نساء قادمات من سوريا قررن ترك أزواجهن. وقد شهد مكتبها عام 2016 بالذات زيادة كبيرة في هذه الطلبات. ترى نجاة أن الطلاق في ألمانيا كان بالنسبة للكثيرات طوق نجاة من العنف الزوجي والأذى الجسدي والطريق الوحيد لتحقيق ذواتهن.
تستغرب ليلى ممن يعتبرون أن النساء يطلبن الطلاق في أوروبا لأن الطلاق طريقه معبّد أو لأن الدول الأوروبية تشجع عليه. «بالنسبة إلي خطة إني اتطلق قديمة كتير، قبل ألمانيا بكتير، أنا بس كان بدي إتخرج وإطلع إستقل وإهرب مع أولادي». لكن بسبب الحرب والخروج، اضطرت ليلى لتأجيل خطتها: «ألمانيا ساعدتني كون مستقلة مادياً ومحمية بالقانون، بس أنا انحرمت من أولادي، وكوني أمّ وامرأة بيقلل احتمالات توظيفي بس إتخرج، ما بعرف شو اللي عم يحكوا عنو إنو ألمانيا بتشجع النساء يتطلقوا».
رند لم تكن تفكر بالطلاق أبداً، وكانت تعود إلى زوجها في كل مرة يضربها ويهينها فيها لأن الحياة وحدها مع طفلين في بلد أجنبي تخيفها كثيراً، ولأنها لا تعرف كيف يمكنها أن تتدبر أمر طفلين وحدها. حتى عندما أرادت الطلاق لم تستطع أن تحصل على حق الوصاية على طفليها إلا بعد معارك كثيرة.
تثير زيادة معدلات الطلاق حفيظة كثير من السوريين، الذين يرون في الانفصال عاراً وفضيحة. ولكن إن كانت معدلات الطلاق تتزايد عندما تصل النساء إلى أوروبا، فهل هذا دليل إدانة للنساء؟ أم للبلاد الأوربية التي تحمي المرأة وتسمح لها بأن تحقق ذاتها؟ أم إدانة للأعراف الذكورية الفجة التي كانت تضغط على النساء في مجتمعاتهن، وللقوانين المجحفة التي كانت تقهرهن وتحكم عليهن الخناق وتجبرهن على الصبر والتحمل؟ وهل الطلاق هو المشكلة، أم الزواج نفسه الذي كان مبنياً على إخضاع المرأة؟
تجاوزت ليلى عقبات كثيرة وشارفت على التخرج من الجامعة. «مافيني أحكيلك قديش تعبت لوصلت لهون». تضغط على أصابعها وتلقي نظرة خاطفة على صورة طفليها على الحائط خلفها «ما بعرف إذا ولادي رح يسامحوني أني تركتن، بس رح إحكيلن كل شي بس يكبروا، وأكيد رح يسامحوني، صح؟». أومئ برأسي، وأرى التماع دمعة تغافل ليلى وتتدحرج على خدها: «يمكن إنتي مستغربة إني واقفة قدامك هلأ وقوية بعد كل اللي مريت فيه، بس مارح تستغربي إذا بقلك إني عم روح عند طبيب نفسي بس لعالج أثر الصدمات».
وجدت رند منزلاً وحدها وفرشته، وقبل أشهر بدأت عملاً كموظفة في شركة ألمانية وتربي طفليها وتصرف عليهما، لكن حنجرتها ما زالت تنقبض لمجرد الحاجة للكلام عما مرّت به. وبعد كل ذلك، ما زالت رند تشعر بأنها مُلامة من المجتمع وأن «ذنبها» غير مغفور، ولذلك تبتعد قدر الإمكان عنه وتحمي نفسها وأهلها في سوريا من كلام الناس.
أحاول أن أقرأ الكلمة الموشومة على ذراع رند. ترتسم السعادة على وجهها بليونة وتحكي لي: «أنا انتبهت إني بخاف من لسان العالم، يمكن هيك أنا تربيت، الوشم خلاني حس بالقوة أو يمكن خلاني إكسر حاجز كنت خايفة إكسرو».
الوشم كان بالنسبة لها راحة وتحرراً من المخاوف الباطنية ومحاولة للخلاص من «شو بدن يحكوا الناس». لم يقدم المجتمع لرند شيئاً ولم يستطع أن يقف أحد من الناس الذين كانت تحسب لهم حساباً معها. كلمة «حرّة» وشمتها على يدها في مكان ظاهر لها وللناس لكي تذكر نفسها، كلما نسيت، أنها حرة وقوية.
تروي رند وليلى قصتين من قصص كثيرة لنساء كان طلاقهن بداية لحياة جديدة. كلتاهما طلبتا مني إخفاء هويتهما والتفاصيل التي تدل عليهما خشية أن يُعرفا. يسيل الألم والقهر من تفاصيل الحكايا، لكن في كلا القصتين كان الرعب الناتج عن العجز وانسداد الأفق طريقاً للانعتاق.
لأن لجوءاً واحداً لم يكفِ لحياة بكرامة وحرية.. كان الطلاق. ليس فقط من العلاقة الزوجية، بل من الإرث الذكوري والقهر المجتمعي والأعراف البالية، لجوء ثان لابد منه.