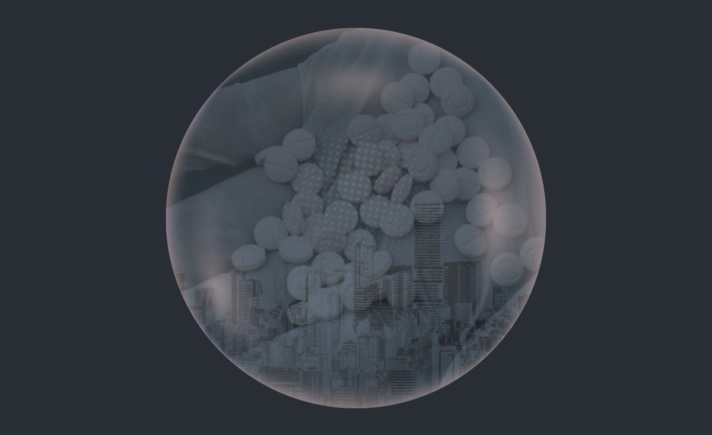في الرابع عشر من آب 2011 بدأ جيش النظام السوري، مدعوماً بالأجهزة الأمنية وميليشيات «اللجان الشعبيّة»، عملية عسكرية في حيّ الرمل الجنوبي ومحيطه في مدينة اللاذقية، وذلك بعد حصار دام نحواً من شهرين، قامعاً بذلك مركز الانتفاضة الشعبيّة في المدينة بعد أن نجح في حصر الحراك الثوريّ فيه. كانت تلك لحظة حاسمة في تاريخ المدينة الحديث، ومثّلت أحد النماذج الأولى (بروتوتايب) لسياسة النظام في التعامل مع معارضيه والمناطق الثائرة عليه؛ سيتكرر سيناريو العزل والحصار هذا، على نطاق أوسع وأكثر وحشيّة، في حمص القديمة والغوطتين وغيرهما على امتداد الجغرافيا السوريّة.
تحاول هذه المقالة بعد عشر سنوات أن تستعيد المسار الذي سلكته الأحداث في مدينة اللاذقيّة، بناءً على مزيج من ذكرياتٍ شخصيّة ومقربين كانوا شهوداً على الأحداث وما توفره المصادر المفتوحة على الانترنت من معلومات، وذلك خلال الفترة الممتدة من انطلاق المظاهرات السلمية في آذار (مارس) إلى السحق العسكري في آب (أغسطس)، وهي الفترة التي شهدت انطلاقة الثورة السوريّة وتبلور مطالبها، وشهدت أيضاً الفصول الأولى للمأساة التي مثلّتها الأسدية وحلّها «العسكريّ».
المدينة تنتفض
شهدت اللاذقيّة أولى مظاهراتها في جمعة «العزّة» يوم 25 آذار، حين انطلقت مظاهرة حاشدة في منطقة الصليبة، استُبدلت فيها شعارات الفداء التقليديّة لبشّار ومن قبله أبيه، بالفداء لدرعا، وسارت عبر الشوارع الرئيسيّة حتى ساحة الشيخضاهر، الوسط التجاري الشعبي للمدينة، ونجحت في أن تملأ الساحة تدريجياً قبل أن يتم إطلاق النار من مبنى الشرطة العسكريّة القريب لدى محاولة بعض المتظاهرين الاقتراب من نُصب حافظ الأسد الواقع في وسطها، وهو ما أدى لاستشهاد متظاهريْن اثنين. تشير الروايات المتداولة إلى أنّ المظاهرة لم يكن مخططاً لها؛ عند الدعاء التقليدي لبشار الأسد في صلاة الجمعة في جامع خالد بن الوليد، قاطع أحد المصلّين الإمام هاتفاً للحريّة ودرعا فتجاوب معه الحضور، ثم خرجوا لينطلقوا في مظاهرتهم من أمام باب الجامع.
,
تكررت المظاهرات في اليوم التالي على نطاق أوسع تشييعاً لمن سقطوا في اليوم السابق، واتجهت مثل سابقتها إلى ساحة الشيخضاهر. وإذ لم تتمكن أيضاً من الإحاطة بنُصب حافظ الأسد في وسط الساحة، فإنها تمكنّت من إحراق مركز سيرياتيل على طرفها الغربي، وتعرّضت، كسابقتها أيضاً، لإطلاق نارٍ مباشر من ثلاث مراكز على الأقل؛ مخفر الشرطة وقصر المحافظة الجديد ومبنى الشرطة العسكرية، ما أدى لاستشهاد 12 مواطناً، حسب هيومن رايتس ووتش، في واحدة من أولى مجازر المدينة.
,
مثّلت أحداث الأيام الأخيرة من شهر آذار دليلاً جلياً على أنّ تنوّع المدينة الأهليّ، وكونها المركز الإداريّ الذي تتبع له القرداحة، منبت آل الأسد، لن يستثنيها من تمدد الثورة. وعلى ذلك، حمل يوم الأحد 27 آذار ما يشبه حالة إضراب وعصيانٍ مدنيّ غير مُعلن: لم تفتح الأسواق والمحال التجاريّة، وبقيت أغلب المؤسسات الخاصّة والحكومية مغلقة طوال الأسبوع. وبدا أنّ ثمّة ما يشبه «خزّاناً» من الأخبار الكاذبة والإشاعات قد فُتح على مصارعيه، من حديث عن الاستعداد لنهب سوق الصاغة في وسط المدينة، أو عن تنكّب «شباب آل الأسد» (يذكر تحديداً سليمان الأسد في هذا السياق) اقتحام الأحياء التي شاركت في التظاهر، لا سيّما وأن بعض «الاحتكاكات» قد وقعت فعلاً ليل 25 آذار في حيّ القلعة، وهو ما يستوجب، تبعاً للمنطق الذي ساد آنذاك، انتشار وحدات من الجيش لدرء أي انفلات أمنيّ في المدينة (لم يكن حينها قد تحوّل لآلة إباديّة بالشكل الذي ستشهده البلاد لاحقاً، حتى أنّ المتظاهرين حيّوه في هتافاتهم باعتباره والشعب يداً واحدة)، خاصة مع وقوع أعمال إحراق لسياراتٍ وتحطيم لواجهات محلّات نُسبت لمجهولين. دفعت هذه «الأخبار الكاذبة» أيضاً إلى فعّاليات أهلية لحماية المناطق، عبر قطع الطرقات ليلاً بـ«ما تيّسر» من حاويات قمامة أو غيرها، بالإضافة إلى التدقيق عن «غربتلية» في الأحياء.
وفي محاكاة للربيع العربيّ القائم على نموذج «احتلال الساحات»، أُعلن في 28 آذار عن اعتصام مفتوح في الصليبة، يُمكن تلخيص موضوعه في اليافطتين الكبيرتين اللتين عُلقتا في ساحته: «الحريّة غالية، ونحن مستعدّون لدفع ثمنها» و«نعم للاعتصام السلمي. نعم للحريّة. لا للطائفيّة». حاول محافظ المدينة آنذاك، رياض حجاب، تهدئة الأوضاع بالنزول شخصياً والوقوف مع المعتصمين، كما قام عدد من فناني المدينة بمحاولة «الوساطة» لفكّ الاعتصام، لكن دون جدوى. وترافق الاعتصام مجدداً مع تحفيز للعصبيّات الأهلية وتهديد بانفلات أمني، فاعتلى قناصّة «مجهولو الهويّة» بناء الأوقاف في وسط المدينة، وسقطت امرأة من المارّة على الأقل ضحيّة ذلك اليوم، وهو ما سيتحول إلى طقسٍ متكرر الظهور عند الحاجة خلال الأشهر التالية.
,
في 30 آذار (مارس)، ألقى بشار الأسد خطاب «رئيس العالم» أمام مجلس الشعب، وتحدّث فيه عن تشكيل لجان تحقيق لتحديد المتورطين بقتل المحتجين في درعا وحمص واللاذقية؛ وتزامن الخطاب مع خروج مظاهرات قُدرت بالمئات في المدينة جابت مختلف الأحياء، وحاولت التوجه إلى ساحة الاعتصام لرفدها قبل أنّ يتم إطلاق النار عشوائياً على إحداها في ساحة اليمن، في ما سُيعرف بـمجزرة محطّة القطار الأولى، أو مجزرة الخطاب، التي سقط بنتيجتها ستة شهداء، والعشرات بين جرحى ومعتقلين، وأدت في المحصلة إلى انفضاض الاعتصام في الصليبة.
المجزرة
مع بداية نيسان (أبريل) 2011، كان ثمّة مشهديتان مختلفتان في المدينة، الأولى في ساحة أوغاريت، التي تحوّلت إلى مقرّ لوحدات الجيش التي كانت قد «انتشرت» ليل 26 آذار، وحوّلت مبنى «سينما أوغاريت» المهجور إلى مقرّ مؤقت ومركز توقيف للمعتقلين – وهو ما سيستمرّ لسنوات لاحقة؛ والثانية، كانت في ساحة الصليبة، حيث قادت «أمهات وأخوات الشهداء» مظاهرة ضخمة في جمعة «الشهداء»، نادت بإسقاط النظام، بعد أن كانت في الأسبوع السابق تتمحور حول نصرة درعا ومطالب إصلاحيّة متنوّعة. كانت المدينة تحاول استعادة روتين الحياة اليوميّة إلى جانب المظاهر الثوريّة، التي أخذت بالازدياد من «مظاهرات طيّارة» ومظاهرات مسائية داخل الأحياء، إلى شعارات «الرجل البخاخ» على الجدران والمناشير. ثم شهدت «جمعة الصمود» في الثامن من نيسان تصعيداً تمثّلَ في محاولة الاعتصام مجدداً في الصليبة، ورغم أنّ من افترشوا الطريق في محاولة الاعتصام الثاني لم يتجاوز عددهم بضع مئات، فإنهم تعرضوا للتفريق من قبل أجهزة الأمن في الليلة ذاتها ما أدى لاستشهاد شابيّن. وتكرر السيناريو ذاته في جمعة الإصرار في 15 نيسان مع توّسع كثافة التظاهرات وحجمها، حتى بلغت عدة آلاف تعرضت جميعها للتفريق بالرصاص الحيّ، تبعها أكبر مظاهرة عشيّة عيد الجلاء في 17 نيسان، قُدّر عدد المتظاهرين فيها بنحوٍ من 30 ألف متظاهر، وتمخّضت عن محاولة الاعتصام الثالثة؛ يُمكن اعتبارها، في سياق المدينة، أقربَ إلى مظاهرة «مركزيّة» بدلاً عن مظاهرات الأحياء المتفرّقة.
,
أدّت مظاهرة 17 نيسان، ومحاولة الاعتصام الثالثة إلى اقتحام حيّ الصليبة والأحياء المجاورة من قبل الأمن السوريّ ووحدات الجيش بشكل عنيف: فتحت وابلاً من الرصاص العشوائي على المتظاهرين كما في الواقعة الشهيرة بمجزرة بن العلبي، واتجهت سيارات الأمن نحو تقاطعات الطرق الرئيسيّة داخل المدينة ونصبت حواجز ونقاط تفتيش، كما اقتحمت المساجد واعتلى قناصة المباني المرتفعة. ثمّة من اعتقلوا لا لشيء سوى لتواجدهم في الطريق. في ساحة الصليبة، حيث كان الاعتصام الثالث، فُتحت النار على المتظاهرين بشكل مباشر، فسقطت أعداد قدّرتها بعض المصادر الأهلية بأكثر من 80 شهيداً. وفيما يتم تداوله من مرويات بين الأهالي أنّه تمّ التخليص على جرحى أسعفوا للمشفى الوطني القريب، وأنه في ليل المجزرة استقدم مجلس المدينة جرّافات لرفع الجثث وسيارات إطفاء لغسيل الساحة من دماء أبنائها.
وخلافاً للأسابيع الماضية، حينما كان حضور أجهزة الأمن يتراجع في أعقاب الاقتحامات الدوريّة، فإنه في أعقاب مظاهرة عيد الجلاء وما تلاها من مجزرة، بقيت وحدات الجيش والأمن السوري منتشرة في الطرقات والأزقة، وقامت بدءاً من جمعة 22 نيسان، بتطويق المساجد التي كانت قد تحوّلت إلى بؤرٍ للتظاهر، منعاً لأي مظاهر احتجاج – ولم تتردد في اقتحام المساجد عند اللزوم؛ وكان الخطاب المعتمد على استثارة الحساسيات الطائفيّة قد غدا في المدينة، كما في مجمل التجمعات السكّانية المختلطة في غرب سوريا ووسطها، مثل حمص وبانياس، أساساً في سياسات النظام، وهو ما أشارت إليه بثينة شعبان مبكراً في مؤتمر صحفيّ يوم 24 آذار، وتلتها مبادرة مديرية الأوقاف في المدينة ليؤمّ شيخٌ سنيّ مصلين علويين، ويؤمّ شيخ علويّ مصلين سُنّة في 30 آذار (في يوم مجزرة الخطاب ذاته!). ورغم انتشار مبادرات تحاول أن تعكس صبغة متجاوزة للسؤال الطائفيّ، ورغم حضور أشخاص من مختلف الجماعات الأهليّة ضمن المظاهرات، فإنّ تحفيز العصبيات الأهلية والاستثارة الطائفيّة شكّلا الأساس الذي تحوّلت بنتيجته المناطق الفاصلة بين الأحياء التي يغلب عليها لون طائفيّ واحد إلى خطوط تماس تعبّر عن الموقف من الانتفاضة الشعبيّة ضد بشار الأسد، سيّما بعد أن قام موالون للنظام (ومعهم مجندو الجيش في الخدمة الإلزامية، وموظفو القطاع العام وطلاب الجامعات والثانويات، فرضاً لا خياراً)، بمسيرات مؤيّدة في ساحة المحافظة ودوّار الزراعة مباشرة في أعقاب المجزرة. وبذلك، فإن الفالق الطائفي، الذي ورثته الثورة، كان قد بدأ يلقي بظلالٍ مباشرة على الأرض.

على الرغم من استغلال هذه المخاوف والعصبيات، كان يمكن للمرء أن يرى في نيسان 2011 مناشيرَ تدعو للوحدة الوطنيّة في جامعة تشرين، أو يسمع تمسكاً بخطابٍ مدنيّ حتى من أئمة المساجد التي مثّلت نقاط التظاهر. وكان يُمكن له أيضاً أن يرى أوساطاً مختلطة طائفياً لم تدخل في مرحلة القطيعة التامّة، وأن يلمس خطاباً أقرب لمحاولة الاحتواء منه إلى خطاب «المندّسين» – المصطلح الذي بدأ استخدامه لوصف من يفترض أنه يقتل المتظاهرين، قبل أن تحوّله الرواية الرسميّة إلى اتهام المتظاهرين أنفسهم بقتل المتظاهرين.
عزل، حصار، اجتياح
مع مجزرة عيد الجلاء، وسياسة تقطيع الأوصال التي انتهجها النظام، تراجع زخم التظاهر في أحياء المدينة الرئيسيّة، واقتصرت الأنشطة الشعبيّة على مظاهرات طلابيّة صغيرة أو مظاهرات طيّارة في الأسواق، وحملات مقاطعة سيرياتيل أو التكبير الليلي أو غيرها؛ لكنّ حيّ الرمل الجنوبي، نتيجة موقعه أولاً، ولكونه من الضواحي الفقيرة ذات الأزقة الضيقة في المدينة، قد تُرك دون اقتحام، وغدا بالتالي موئلاً للشبّان الهاربين أو المتهيبين من ملاحقة أجهزة الأمن لهم بعد انتشار المداهمات في الأيام التالية للمجزرة. مثّلَ الحيّ بالتالي جزءاً من سياسات النظام لحصر رقعة التظاهر بحيث يسهل السيطرة عليها، وهكذا انتقلَ ثقل الحراك الشعبيّ تدريجياً من الشوارع والساحات الرئيسيّة، مثل شارعيّ القوتّلي وبورسعيد وساحة الشيخضاهر، إلى ساحات حيّ الرمل وأزقته، وذلك بدءاً من الجمعة العظيمة في 22 نيسان، لتتسع مظاهراته باضطراد مع مشاركين من مختلف أحياء المدينة، وتصبح مع «جمعة آزادي» في 22 آيار (مايو) مظاهرات ضخمة من عدة آلاف، تُحرَق فيها صور بشار الأسد ورموز نظامه، ويقتصر القمع المباشر فيها على مواجهة محاولات الخروج من الحدود المفروضة نحو قلب المدينة وشوارعها الرئيسية، وهو ما سيتسبب بمجزرة محطّة القطار الثانية في جمعة العشائر في العاشر من حزيران (يونيو)؛ يوم سقط برصاص أجهزة الأمن ستة شهداء وعشرات الجرحى لدى محاولة الخروج نحو ساحة اليمن.
,
وعلى هذا المنوال، ستنحصر تظاهرات أيام الجمعة، في أيار وحزيران في حيّ الرمل، مع بعض الاستثناءات لمظاهرات من عشرات أو مئات في حيّ القلعة، والعوْينة – سوق الذهب والطابيات، وجميعها قُمعت بالرصاص الحيّ. وأما التظاهرات في حيّ الرمل، فستتحول إلى طقس يوميّ في حزيران 2011، مع مظاهرات صباحيّة وأخرى ليليّة، وإطلاق بالونات بشعارات سياسيّة، ونسج أعلام ضخمة ورفع علم الاستقلال، وسواها من مظاهر الحراك المدنيّ التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها آنذاك.
في أواخر حزيران، أشيع عن نيّة الجيش السوريّ اقتحام حيّ الرمل وجواره، واستحضرت دبابات ومدرعات عسكرية لإغلاق كامل مفترقات الطرق المؤدية إليه. ستكون تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها كاتب هذه السطور الدبابة عياناً كرمزٍ لفرض السطوة والإرهاب. كما تم استدعاء البحرية السوريّة للتواجد قبالة الحيّ من جهة البحر. وفي مواجهة ذلك، أصدر أهالي الحيّ بياناً في 19 حزيران يرفضون فيه دخول الجيش. وتزامن حصار الحي مع تحول في الخطاب الرسمي، إذ تراجع حضور مصطلح «المندسين» لمصلحة «الإمارات السلفيّة»، بما فيها ما أشيع عن إمارة يُزمَع إعلانها في الحيّ. وبذلك، فمع نهاية حزيران، أصبحت منطقة الرمل خاضعة لحصار فعليّ كامل، وغدا الدخول والخروج من الحيّ ومحيطه بحاجة إلى تصريحٍ أمنيّ مع تفتيش للسيارات والمارة، فيما أعلن الأهالي «العصيان المدني الجزئي حتى فكّ الحصار»، واستُحدثت مقبرة للشهداء في أحد حدائق الحي. أما خارج الرمل؛ كثّفت أجهزة الأمن من انتشارها تبعاً لتطورات التظاهر، فكان ثمّة مظاهرات متكررة في حيّ الطابيات ما استدعى انتشاراً أمنياً فيه، وأزال مجلس المدينة حاويات القمامة منعاً لاستخدامها في قطع الطرقات.

ستثمل أيام تموز 2011 الطويلة، مع تمدد الثورة وبلوغ التظاهر الشعبيّ ذروته في طول البلاد وعرضها، عودةً للتظاهرات في الصليبة والطابيات، وسيستدعي ذلك اقتحاماتٍ لمساجد وبؤر التظاهر، واعتقالات لطلابٍ في الجامعة سيّما مع امتداد المظاهرات إلى السكن الجامعيّ فيها. استمرت تظاهرات حيّ الرمل الذي أصبح مركز الحركة الانتفاضيّة في المدينة، وغدا الحصار كذلك أكثر قسوة، حتى شهدت الأيام الأخيرة من تموز خروجاً جماعياً للنساء والأطفال من المنطقة المحاصرة بعد انتشار أخبار تفيد بقرب الدخول العسكري إلى المنطقة. نظّمت المحافظة أيضاً برنامج احتفالات فنيّة «وطنيّة» في الساحات العامّة، تزعّمها علي الديك وفنانون محليون آخرون للتأكيد على «الولاء» للنظام. مقابل مشهد الحيّ المحاصر، نصب النظام مشهديّة الاحتفالات و«حلقات الدبكة» التي اعتادها السوريون منذ السبعينيات، مرسخاً بذلك الانقسام والاستفزاز الطائفيّ. وضمن هذه الأجواء، ستبدأ عملية اجتياح حيّ الرمل بدءاً من صباح 14 آب 2011 بقصف بريّ وبحريّ على من بقي من سكّان المنطقة – ولم يكن ثمّة أي وجود مسلّح معارض في المدينة حينها.
تم قطع طرقات في مناطق عدّة في المدينة، ولم تؤجل الجامعة الامتحانات، وكانت حينها الدورة الامتحانية الثالثة. أصررتُ يومها على الذهاب للامتحان رغم الظروف، وأصرّ أبي على مرافقتي – في قاعة الامتحان لم يكن هناك سوى أشخاص معدودون؛ قدّمنا الامتحان على إيقاع الرصاص والمقذوفات من كلّ حدب وصوب. في «مشروع البعث» القريب من الجامعة كان ثمّة شبّان وعائلات من الموالين يتوجهون إلى أقرب نقطة تطلّ على الحيّ لمراقبة عمليات القصف عن بُعد، ومشاهدة الملالات العسكريّة والدبابات على طريق شركة التبغ «الريجي»؛ كان مشهد «فرجة» أشخاص على قصف مناطق سكنيّة يقطنها من يُفترض أنهم مواطنوهم بالغ القسوة والتأثير.
خارج المنطقة المحاصرة، كان هناك انتشار أمنيّ كثيف كرّسه «شبيحة» النظام وعناصر مخابراته باللباس المدنيّ في الساحات والتقاطعات الرئيسيّة والأحياء التي شهدت تظاهرات سابقاً. استمرّ القصف لأربع أيام متتالية دون توقّف أو مقاومة. كانت نداءات الاستغاثة عبر مآذن المساجد تطلق منذ ليل اليوم الأول لإخلاء الجرحى دون تجاوب. في 18 آب، دخلت قوّات الجيش الحيّ وقامت باحتلاله. لا يوجد تقديرات دقيقة لأعداد القتلى أو المعتقلين من جراء عملية الاجتياح. تذهب بعض التقديرات إلى أن أعداد الشهداء في اليومين الأولين بلغت نحو خمسين، وثمة من لم يُعرف مصيره حتى اليوم.
ما بعد القيامة
بالنسبة لكثيرين، كان يوم الرابع عشر من آب يوماً قِيامياً بامتياز؛ «انهارَ العالم» أمام ذروة جديدة من ذرى العنف الذي انتهجته السلطة منذ اندلاع المظاهرات في آذار 2011. ولعلّ السؤال الأصعب حقاً هو تحديد كيف «عادت» الحياة إلى طبيعتها بعد ذلك اليوم. أما في التفاصيل، فقد استمرّت البحرية السورية بحصار شاطئ الحيّ عدّة أشهر بعد ذلك، واستمرت المداهمات والاعتقالات في مختلف المناطق. خفتت مظاهر الثورة لكنها لم تختفِ، بل تجددت في مفاصل بعينها: تجددت المظاهرات مع مقتل أولاد الدكتور معد طايع، وهو معتقل لدى النظام لم يشمله «العفو»، بحريقٍ شبَّ في منزلهم قيل إنه مُفتعَل (كانون الثاني 2012). وكذلك إثر استشهاد حسن أزهري تحت التعذيب (حزيران 2012) وإرسال جثمانه بـ«تابوت مقفل» مع ما سبّبه ذلك من سخط عارم وغضب. والشاب خريج الصيدلة لُفقت له تهمة تطوير مواد كيميائيّة لاستخدامها كمتفجرات، على أنّ اعتقاله كان لدوره التأسيسي في إنشاء تنسيقية اللاذقيّة وإدارة مكتبها الإعلامي. وكذلك الأمر، شهدت المدينة مظاهراتٍ وفعّاليات متفرقة تفاعلاً مع الأحداث على المستوى الوطني مثل إضراب الكرامة (كانون الأول 2011)، ومجزرة الحولة (2012). وكذا كان اقتراب فصائل المعارضة من المدينة أو تصاعد المواجهة بينها وبين جيش النظام، وقد غدا حينها ميليشيا بين ميلشيات متنوّعة على الأرض، يوّلد مظاهراتٍ وقطع طرقاتٍ ومظاهر احتجاجية مختلفة؛ في معركة الحفّة (2012) وقسطل معاف (2013) وكسب (2014)، قبل أن تتوقف هذه المظاهر كلياً إثر ذلك.
سُمح لمن خرجوا من أهالي الرمل بالعودة إلى حيّهم تباعاً في أعقاب الاجتياح، ولم ينس النظام طبعاً قمع ومسح أي مظاهر تشير إلى خروج المنطقة يوماً عن سطوته، فنبش على سبيل المثال، مقبرة الشهداء التي أنشأها الأهالي تحت الحصار. ستزدهر ظاهرة سليمان الأسد في المدينة، باقتحاماته الدوريّة للصليبة والأحياء التي شهدت يوماً مظاهرات ضد نظامه، وذلك حتى إبعاده عن المدينة إلى دمشق (2015) بعد قتله لضابطٍ في الجيش؛ وكان سليمان المذكور قد ورث والده هلال في فرض سطوته إثر مقتل الأخير في قصفٍ لفصائل المعارضة على المدينة (2014). وهو قصفٌ أزهقَ أيضاً أرواحاً بريئة عند سقوط قذائفه في أمكنة مكتظة أو أسواقٍ شعبيّة، ولم يقتصر على فصائل المعارضة، إذ أسقط النظام بدوره أربعة صواريخ على وسط المدينة في 2016، مخلفاً أضراراً كبيرة وضحايا. كذلك ستختفي «المظاهرات الطيّارة» من المدينة وستظهر «الحواجز الطيارة» مكانها، ووظيفة هذه الأخيرة التفتيش عن المطلوبين للأجهزة الأمنية، وعن شبّان لسوقهم إلى الخدمة العسكريّة في ظلّ شح الموارد البشريّة للنظام.
أما نشطاء المدينة وناشطاتها الذين أطلقوا المظاهرات واستطاعوا ملأ الساحات يوماً، فقد انتقل الناجون منهم من الموت والاعتقال إلى أرياف يصعب على النظام إحكام قبضته عليها، ثم تابع بعضهم عيشه ونشاطه في مناطق ستصبح خارجة عن سيطرة النظام في الأشهر القليلة التالية، فيما لجأ آخرون إلى بلدان الجوار أو عبرها إلى مهاجر السوريين العديدة ومنافيهم. لكن بعضهم بقي في اللاذقية ملتزماً الصمت و«الحياة العاديّة»، شاهداً على صعود أثرياء الحرب وأمرائها وميليشياتهم وصراعاتهم في المدينة، التي قدّمَ مسار الأحداث فيها مبكراً شهادة بليغة على نوعية ونتائج «انتصار» نظامٍ أحرق بلداً بأكمله وجلس على تلّة الخراب منتشياً.