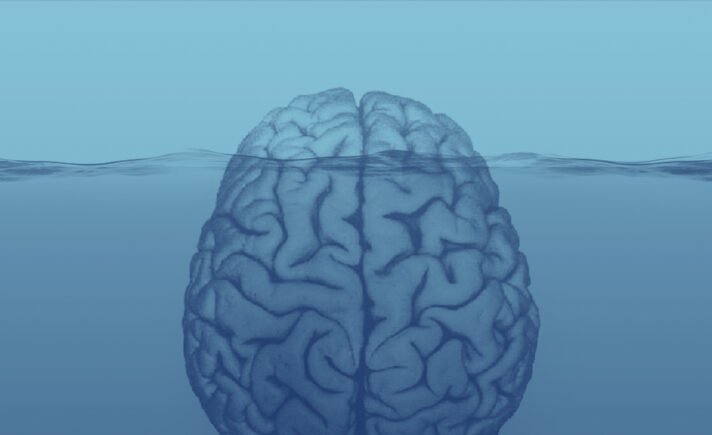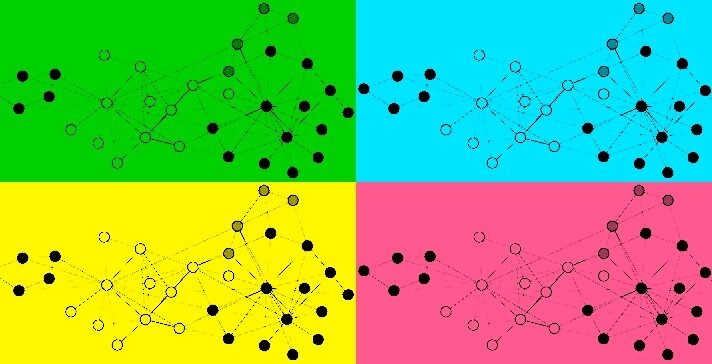عند التفكير بإمكانية التغيير والفعل وجدواها، يحار المتأمل فيما آلت إليه أوضاع الأطفال السوريين الذين شردتهم منظومة الإبادة الأسدية. وتزداد الحيرة في موضوع خسارة الأطفال لكافة الأطر التعليمية والمدرسية التقليدية.
ترتكز بعض الحلول المطروحة على تفعيل دور التقنية الرقمية، من قبيل توفير أجهزة لوحية للأطفال يتلقون من خلالها دروساً ضمن «المساقات الهائلة المفتوحة على الإنترنت» أو ما يعرف بـMOOC. لعل من أشهر التجارب في هذا المجال كانت مبادرة رومي للأجهزة اللوحية، وجهاز آكاش في الهند (الذي تبلغ كلفته 35 دولار) وجهاز OLPC XO الذي طورته جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتبلغ قيمته حوالي 100 دولار. ربما ساعدت الجائحة في إجبار العملية التعليمية التقليدية على تبني أساليب الدراسة عن بعد، ولم يعد الأمر ترفاً للمرفّهين أو اضطراراً للفقراء، وهو ما يعزز فرص نجاح هذه الحلول.
تدور حلول أخرى حول تعليم الأطفال تقنيات تحفز إبداعاتهم وتمنحهم مهارات تُعينهم في المستقبل، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد (والتي استُخدمت لبناء أطراف صناعية لعدد من السوريين الذين بُترت أطرافهم)، أو البرمجة للأطفال بلغة سْكْراتش (تجدر الإشارة لتجربة عبد الرحمن إدلبي الرائدة والمستمرة في مخيمات اللجوء في الشمال السوري وتركيا)، أو بناء وبرمجة الروبوتات (مثل حقائب LEGO MindStorms التعليمية التي استخدمها أطفال مؤخراً في مخيم الزعتري لبناء روبوت لتعقيم الأيدي).
يعيب معظم هذه الحلول أنها حلول جزئية، وشرط نجاحها مرهون بعوامل أخرى تقنية وغير تقنية، فما جدوى الأجهزة اللوحية دون وجود محتوى تعليمي كافٍ، وهل الكهرباء متوفرة في المخيمات بشكل يمكن الاعتماد عليه؟ وهل تعلُّم تقنية الروبوتات بشكل منعزل عن السياق والظروف التي يعيشها المتعلم يولّد إبداعاً يعوَّل عليه؟ وبشكل أعم، ماذا يمكن للتقنية الرقمية والتقنية عموماً بوصفها «كل ما قام الإنسان بعمله، وكل التغييرات التي أدخلها على الأشياء الموجودة في الطبيعة، والأدوات التي صنعها لمساعدته في أعماله»، أقول ماذا يمكنها أن تقدم لتأهيل الأطفال بما يتناسب مع مستقبلهم وواقعهم القاسي؟
الحلول التقنية الصرفة لمشاكل مجتمعية وسياسية تلقى عادةً رواجاً كبيراً لدى القائمين عليها ومموِّليها لعدة أسباب، أهمها أنها غالباً ما تكون محايدة سياسياً، ولا تشتبك مع سؤال السلطة والمنظومة التي أفرزت هذه المشاكل. حتى أن غض الطرف عن المكوِّن السياسي لهذه المشاكل وصل لدى البعض لتبني ما يسمى بعقيدة الطوباوية التكنولوجية. تقول هذه العقيدة إن التقدم العلمي والتقني، حصراً، سيؤدي بنا لا محالة إلى اليوتوبيا المنشودة، وبأن البشر هم من يؤثرون ويشكلون التقنية وليس العكس (ناقشنا هذه الجزئية في مقال سابق في الجمهورية.نت، وتطرقنا لتشكيل الخوارزميات التي تنهل من تحليلات البيانات الضخمة لوعينا وتصرفاتنا وقراراتنا وخياراتنا في أبسط الأمور وأهمها).
من الأسباب الأخرى لرواج الحلول التقنية الصرفة أنها تقدم نتائج مرحلية سريعة، وترسل رسائل إيجابية بأننا من راكبي الحداثة وسالكي دروب التطوير، وهذا يظهر جلياً في أسماء من قبيل «المدرسة الذكية». أما من وجهة نظر الحكومات وصناع القرار، فإن الحلول التقنية تمنح القدرة على تحقيق رقابة أكبر على المستخدمين، وبالتالي تصبح أداة من أدوات التحكم وهندسة الوعي. وكمثال على ذلك، وإن في سياق مختلف، فقد رأينا ما قامت به خوارزميات فيسبوك ويوتيوب وفِرَق إدارة المحتوى الخاصة بها في محاولات التشويش على الهبّة الفلسطينية الباسلة في الأسابيع الماضية منذ مطلع أيار (مايو) 2021. وفي سياق المدارس، فهي تمنح صناع القرار القدرة على تنميط الطلاب بحسب عدد من الشخوص (personas) التي تشترك كل منها في خصال معينة، يسهل فهمها و«إدارتها» بل وحتى التأثير على مستقبلها التعليمي، وذلك بغرض تهيئة هذه الأنماط البشرية لتصبح أكثر «تأمثلاً» (optimized) لدورة العرض والطلب بين الأكاديميا وسوق العمل، فبدل إيلاء الاعتبار الكافي لرحلة التعلم لدى الطفل يتم تسليعه ليصبح مورداً من «الموارد البشرية» في المستقبل.
أما في حال فشل هذه الحلول، فإن لدى المسؤولين شماعة كبيرة للتمترس خلفها، وهي أن العيب إما في الحل التقني نفسه، أو في الناس وانخفاض ثقافة تقبّلهم للحل التقني. وعليه، تكون التقنية أداة من أدوات تثبيت الوضع الراهن ومجرد إضافة مسحوق تجميل يُخفي قبحه.
على الضفة المقابلة، لا يجوز بحال إغفال الجوانب الإيجابية الكثيرة للتقنية، ومنها مثلاً أنها آلية لخفض النفقات، كإحلال الأجهزة اللوحية مكان الكتب المدرسية المطبوعة (إذا افترضنا أن عملية التحول تمت بشكل مدروس وتدريجي) والحد من الممارسات الضارة كالفساد الإداري والمالي (إذا افترضنا وجود الرغبة الجادة للحد من ذلك، وكم عَهِدنا في دولنا أن تكون الشركة المنفذة للحل التقني مملوكة أصلاً لأحد الفاسدين). ولكن لا يمكن النظر إلى دور التقنية عموماً في شكل المدرسة المفترض الذي نتخيله لأهلنا في المخيمات دون الإجابة عن أسئلة متعلقة بالسلطة التي ستستخدم التقنية، من قبيل: من نحن؟ وكيف يمكننا تطويع التقنية لخدمتنا؟
ربما لن يتسع المجال للإجابة على هذه الأسئلة بالتفصيل، ولكن سيستعرض هذا المقال ثلاث تجارب ملهمة وقريبة منا، لعلها ترسم لنا معالم الطريق لتطوير مفهوم المدرسة للأولاد المتسربين، أو الذين لم تعد تستوعبهم أي بُنى مدرسية ضمن الظروف المعيشية الاقتصادية المتداعية لأهلنا في المخيمات.
من نحن: «المجاورة» مقابل «المؤسسة»
طوّر هذا المفهوم المعلم المقدسي منير فاشِه، والذي يعتبر رحلة التعليم قدرة بيولوجية لا مكتسبة أو ملقَّنة، وهي تعمل وفق مبادئ وقناعات يحددها الأهالي المتجاورون، وليست أهدافاً تفرضها سلطة ما. يَعتبر مفهوم المجاورة أن الحكمة هي «المرجع الرئيسي، والطبيعة هي المعيار»، بعكس المؤسسات التي تشكل الأكاديميا مرجعها الرئيسي، والمعرفة التقنية معيارها. وللدكتور منير فاشه قصة يرويها عن بداية تنبُّهه لأثر المؤسسات والسلطات على الوعي والواقع، وهي ملاحظته أن الرياضيات التي درسها ويحضّر الدكتوراه في علومها في جامعة هارفارد دقيقة ومتصلّبة، بينما رياضيات أمّه الأميّة التي تمارسها عبر الخياطة وحسابات المقاس دقيقة ومرنة؛ رياضيات نسجت جذورها في المجتمع. رفضت اللجنة الأكاديمية تضمين حكمة والدته المعرفية والحياتية ضمن قائمة المراجع (بالإضافة إلى الدجاجة الفلسطينيّة ودودة الأرض)، وبعد عام من تمسُّكه بذلك، تمت الموافقة على تضمين والدته فقط في القائمة.
يتحدث منير فاشه عن قضايا الاحتلال المعرفي الذي يشمل الألفاظ (كلمات مثل التنمية، الجودة، التعليم العالي…) ولا ينتهي بسرديات تُعامل الإنسان ككائن مستقل عن الآخرين، على اعتبار حياته ووظائفه الرئيسية ترتبط بالمؤسسات، لا ككائن مركَّب تتفاعل علاقاته مع مجتمعه المحيط ومكنوناته الدائمة التحول على اعتبار أنه مصدر معرفة للآخرين. ينظم منير فاشه ومجموعته أنشطة عملية في فلسطين والأردن، وندوات عبر الانترنت مثل جُمعات راديكالية (عن التربية الراديكالية) وينشر في موقع المجاورة مقالات بديعة اسمها «خواطر الطبيعة الشافية».

أعتقد أن رحلة التعلم المثالية التي يمكن تخيلها في ظل الأوضاع التي نعرفها – سواء ضمن مفهوم المدرسة أو أي مستوى تعليمي موازٍ لها أو بديل عنها – هي أقرب لرحلة تعلُّم يمرّ فيها الطالب ضمن شبكة من المجتمعات المحلية المتجاورة، والتي تتبنى مفاهيم منير فاشه (وتجارب أخرى سلّطنا عليها الضوء في الجمهورية.نت سابقاً). يكتسب الطالب عبر هذه الشبكة مفاهيم نابعة من الحياة والمجتمع، فيتعلم ويعلِّم ويبني ما من شأنه النهوض بمجتمعه المحيط.
التقنية بأيدينا: كلّيّة الحفاة
تجسد كلية الحفاة (Barefoot College)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الهند، أفضل المقاربات في معرض الإجابة عن أسئلة التقنيات التمكينية التي تعين المجتمعات والمدارس التي يناقشها هذا المقال. تقدم الكلية دروساً تعليمية للكبار والأطفال في المناطق النائية، بغرض رفع قدرتها على الاعتماد الذاتي في شتى المجالات، كتنصيب أجهزة الطاقة الشمسية ومضخات المياه. لا تمنح الكلية لا شهادات ولا درجات علمية، فهي تسعى لتبسيط التقنيات العلمية المعقدة وجعلها في متناول الشخص العادي الفاعل في مجتمعه، مع تفادي خلق النخب. بحسب الإحصائيات المنشورة في الموقع، تم تدريب 2,200 امرأة في المناطق النائية ليصبحن مهندسات في الطاقة الشمسية (يبدأ البرنامج بتدريب لمدة ستة أشهر، ومن ثم تعود النساء لقراهن لتركيب وصيانة الأجهزة والبطاريات)، كما تمت تغذية 18,000 منزل بالطاقة الشمسية عبرهن. تنشط المنظمة أيضاً في تدريب الأمهات ليصبحن معلمات ويعملن في شبكة تعليمية منزلية (نهارية وليلية). تَخرَّج من هذه المدارس 75,000 طفل، وتم تدريب 14,000 معلمة. واللافت أن هذا البرنامج التعليمي أسهم في استبقاء 85 بالمئة من الطلاب في قراهم وخفض الهجرات نحو المدن. يضاف إلى ذلك برامج التدريب العملية في تنصيب وإصلاح مضخات المياه، وإقامة السدود، وتحلية المياه، والصحة والطبابة، والزراعة، والمهارات الرقمية.
نلاحظ أن التقنية هنا هي خادم حقيقي وفعال لحاجات المجتمع، يشكلها ويستخدمها لتلبية مصالحه وضمن ما هو متاح من موارد. بالإمكان تخيل أن المدرسة المثالية التي ننشدها مدرسة شبيهة بكلّيّة الحفاة، حيث التعليم والتقنية متداخلة مع المجتمع والحياة. هذا النوع من التعلم، حتى وإن وصلت الأمور في سوريا لتسوية معينة وعاد بعدها الأهالي لبيوتهم، سيُكسب مجتمعنا مرونة واستقلالية لا بد أن يعم نفعها على شتى مناحي الحياة.
نحن والمدرسة: مدرسة يديرها التلاميذ والمدرّسون والأهالي!
عند مشاركتي في ترجمة كتاب إعادة اختراع المنظمات إلى اللغة العربية – والذي يتحدث عن أنماط ومفاهيم تقدمية في إدارة المنظمات تتناسب مع منظومات الوعي المتقدمة التي تسير نحوها البشرية – أسرتني تجربة مُلهمة لمَدْرَسة ألمانية اسمها المدرسة الإنجيلية-مركز برلين (ESBZ)، قد نستلهم منها شكل المدرسة الذي نتخيله، ليس فقط في مخيمات اللجوء وإنما في مدننا وقُرانا. تأسست المدرسة في برلين عام 2007 لتدريس الصفوف من السابع إلى البكالوريا، وهي مسجلة كمنظمة غير ربحية ومموَّلة حكومياً. بدأت المدرسة بمبنى بالٍ مسبق الصنع من الحقبة الشيوعية، تحصَّل عليه عدد من الآباء والأمهات من مجلس المدينة، وسجل فيها 16 تلميذاً فقط، قبل أن يرتفع العدد إلى 46 تلميذاً في العام الأول، معظمهم من المرفوضين من مدارس أخرى ومثيري المشاكل. أما اليوم فقد بلغ عدد الطلاب حوالي 1,500 طالب. الروح المحرِّكة للمدرسة هي السيدة مارغريت راسفلد، وهي مدرِّسة علوم سابقة ومبتكِرة راديكالية. في هذه المدرسة، يُعطى الأطفال كامل المسؤولية عن تعلمهم، حيث يُعلِّم الأطفال أنفسهم ويُعلِّمون بعضهم. معظم البالغين مرشدون وموجِّهون فقط، ولا يقومون بدور المعلم التقليدي إلا إذا طُلب ذلك منهم صراحةً. فدورهم هنا يقوم على التشجيع، وتقديم المشورة، والثناء، والتعقيب البنّاء، والتحدي. أما مسؤولية التعليم فوُضعت صراحةً في أيدي الطلاب. يبدأ ذلك من الأساليب التي تُدرَّس فيها المواد الأساسية: اللغة، الرياضيات، والعلوم. لقد تخلّت المدرسة عن التدريس بالمواجهة المباشرة لهذه المواد، بحيث يضبط التلاميذ وتيرة تعلمهم ذاتياً، فُرادى أو ضمن مجموعات. وبالتالي، يمكن للطالب الذي يعاني في الرياضيات تخصيص وقت أكبر لهذه المادة ليتمكن منها أكثر، على حساب وقت أقل في مادة أخرى يجدها سهلة. يسرد الكتاب تفاصيل دقيقة عن عمل هذه المدرسة، مثل تنقُّل الطلاب باستمرار بين كونهم طلاباً ومدرِّسين لغيرهم؛ والتوقعات الصريحة من الطلاب في نهاية العام؛ وعلاقة الطفل الخاصة مع مدرِّسه-مُرشده؛ وتعزيز العمل على المشاريع الفردية والجماعية؛ ومشاركة الأطفال في تصميم وترميم مبنى المدرسة وتنسيق ذلك فيما بينهم؛ وتشجيع الطلاب على إيجاد الأمور التي تُعنيهم: التطلع عالياً، الفشل، إعادة المحاولة، الاحتفال بالإنجازات. يتعلم الطلاب أن أصواتهم لها شأن وأهمية، وأن بإمكانهم تحقيق التغيير، وأن الآخرين بحاجة لهم وأنهم بحاجة للآخرين.
يُدير المدرّسون في المدرسة الإنجيلية أنفسهم ذاتياً، متجاوزين فكرة أن التدريس التقليدي مهنة فردية، بينما في هذه المدرسة هو رياضة جماعية. كذلك يدير الأهالي أنفسهم ذاتياً، حيث أُنشئت المدرسة ضمن حالة خاصة: تدفع المدينة 93 بالمئة فقط من رواتب المدرسين، أما المباني وباقي النفقات فلا تموِّل المدينة أي شيء منها على الاطلاق. يتعين على الأهالي ردم الفجوة التمويلية بإسهام يتم احتسابه بناء على دخل كل منهم. ولخفض النفقات، قرر الأهالي أن يقوموا بالمساهمة بثلاثة ساعات من وقتهم بشكل شهري لصالح المدرسة. يتحدد ما سيقومون بعمله وكيفيته تبعاً لمبادئ الإدارة الذاتية. فمثلاً، يعقد فريق ترميم المبنى بشكل منتظم احتفالية في نهاية الأسبوع، يقوم عليها خمسون من الأهالي حيث يعملون بأيديهم مباشرة في ترميم بعض الصفوف. والجدير بالملاحظة أن المدرسة الإنجيلية لا تتمتع بأي استثناءات، فهي ملزمة بتوفير عدد ساعات التدريس ذاتها التي تقدمها باقي المدارس في برلين.
لعل هذه التجارب التي أوردناها توضّح أهمية وضع دور المدرسة التي نتخيلها ضمن مجتمعات تريد استعادة ثقتها بنفسها، وتعمل على الانتفاض على واقعها، وتعتمد على نفسها في إدارة مصالحها وتسخير مواردها وتقنياتها. إن عرض التجارب هنا لا يطمح لنقلها واستيرادها كما هي، بل لتحريك الخيال للاستلهام من هذه التجارب وإعادة ترتيب أولوية الأسئلة الملحة.