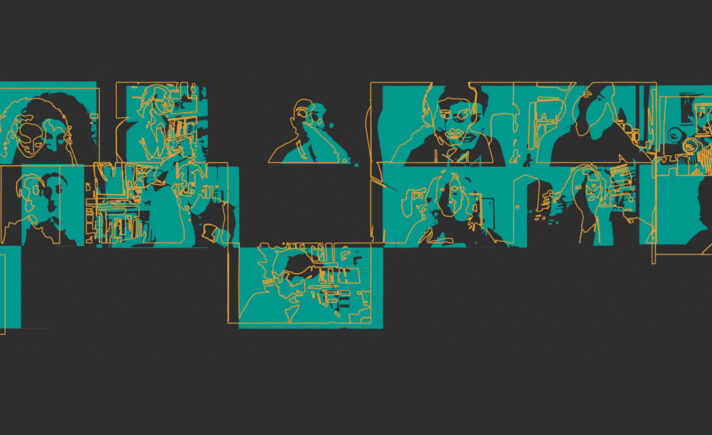بعد أسبوع على محاولة الاحتلال اقتلاع أهل الشيخ جراح من بيوتهم، أصبح واضحاً أننا أمام مرحلة جديدة في سيرورة التحرير، والتي حملت العديد من الجولات وكل لكل منها دلالاتها ودروسها. تميّزت الانتفاضة الحالية بتغيير الوعي وتحرير الخيال. سريعاً جداً، ابتعدت هذه الهبة عن الارتباط بمكان او حدث دون غيره، وساهم حلول أسبوع النكبة في خضمّها بأن تتحول أي محاولة لتأطير الحدث بحصره بجغرافيا محددة إلى غباش في الرؤية وتعتيم للحقائق. عادت الإنسانة الفلسطينية والإنسان الفلسطيني ليكونا ضحيتين لكن فاعلتين، تصوّبان رؤاهما وبوصلة قضيتهما، وتؤكدان أنها قضية تحرر وطني، لتتركا خلفهما وصاية القيادات والخطابات القديمة والتقليدية وينتجا خطاباً يتماشى مع خطواتهما وممارساتهما في الشارع.
ليس التغيير لحظياً طبعاً، بل تراكمي. ومن بين الكثير مما راكمته فلسطين وتفاعلت معه على الأرض من تجارب نضالية وأحداث، كانت الثورات العربية في العقد الأخير ذاكرة كفاحيّة هامة ترافقنا وتحمي وعينا، بالذات في ضوء حملات التطبيع التي تقودها بعض الحكومات دون وازع أو ضمير. فقبل أي شيء، وبعد كل ما مرّ عليها، أعادت هذه الثورات في كل مكان في العالم العربي معنى الفعل السياسي، وربطته مع التحرك الفعلي في الشارع، وحرّرت الناس من خوفها الذاتي والجمعي، وجعلت المواجهة مع القمع علانيّة. ولا ننسى أنها استلهمت من انتفاضات فلسطين الشعبية، وبقيت هذه بوصلتها، وهي اليوم تمدّ فلسطين بالمزيد من الإلهام والقدرات الإبداعية.
مرّت القضية بأزمات عدّة في العشر سنوات الأخيرة، قد يكون الخيط الرفيع الذي يربط التعامل معها وردود الأفعال عليها هو نقص القدرة على تعميم خيال تحرري جامع لكل فلسطينية وفلسطيني، بما ينشّط الخطاب والمشروع السياسيين ويعكسهما في تنظيم الناس على الأرض. فالصدمات المتتالية، وما ترتّب عليها من خوف وحنين غير مسيَّس إلى الماضي، كبّلت ولادة خيال صرف وفعلي؛ خيال جامح لممارسة العيش بحرية وكرامة ومساواة في أي مكان على أرض فلسطين. فانحسر الوعي ما بين تأبيد البؤس وأدلجته على يد قيادات متعددة، أو مباعدة المشروع السياسي عن الهوية الوطنية ووضعهما ضمن مسميات الخصوصية، بالذات داخل أراضي 48، وما بين الدولة «النص الكم» التي أصبحت كابوساً ملعوناً يلاحقنا، ومحجّاً لأحزاب مستعدة للتخلي عن غالبية أبناء شعبها وغالبية أرضه بمسميّات الواقعية السياسية. تعود هذه الانتفاضة لتطلق العنان للخيال، وليعزز هذا الخيال غربة وقطيعة متزايدة بين جغرافيات البلاد، وليفرض منطق المساواة كإطار جامع.
وإذا ما اعتبرنا تحرير الخيال والوعي منجز هذه الانتفاضة الأهم، فإن منجزها الثاني هو التحرر من عبء القيادات التقليدية والتقدم دونهم، بل وأحياناً في صدام مباشر معهم. المنجز الثاني مرتبط بالأول، فقياداتنا والمتحدثون باسمنا على مدى عقود عانوا، وإن بدرجات متفاوتة، من محدودية في الإبداع وجرأة في رفع سقف الخطاب، وبعضهم كان يستحدث لغة العجز بذرائع ودودة. لقد شُلّ خيالهم وحاولوا سجننا معهم هناك. وقد جاء نجاح الإضراب، بالذات في أراضي 48، ليتوّج الخروج عن وصايتهم. فقد أظهر الإضراب بوضوح أن إضراباتنا السابقة التزمت السقف الأدنى، سقف الهوية وليس المشروع، وأن قياداتنا أرادت أن يتوّج هذا اليوم حلقة النهاية. هذه المرة، لم تكتفِ مناطق الداخل الفلسطيني بإقفال محالّها على الشوارع الرئيسية، كما جرت العادة، بل اتسم الإقفال بروح التصعيد والرفض، فشاركت به شرائح مختلفة لم تخرج لعملها بل جاهرت وأرسلت رسائل لمشغّليها بأنها «تنضم لأبناء وبنات شعبها». هذا جيل يأخذ مسؤولية شخصية، ولا ينتظر تحريكاً من أعلى الهرم؛ جيل يعرف التكتيك والاستراتيجية، ويعرف أيضاً ألا يأبه بانزعاج البعض من تسمية الأمور بمسمياتها. هذا لا يعني أن حراكات كهذه ليست بحاجة لتخطيط وتنظيم، ولكن هذا ما يفرزه الشارع بشكل طبيعي وعضوي، كي تخدمه أولاً وأخيراً.
كلما احتدّت المواجهات في الشارع اشتدّت الرؤيا وعظُمت، واحتاجت لأن تسكن مساحات فعل وحلم جديدة فينا كأشخاص وكجماعات. وليس صدفة أن نجد اليوم المزيد من الأفراد والتنظيمات ووسائل الإعلام تستعمل مصطلحات ما كانت لتجرؤ على استعمالها لوصف إسرائيل، كالأبارتهايد، والتطهير العرقي، والاستعمار الاستيطاني. هذه مراكمة عمل وسنوات من جهود أفراد ومؤسسات، وفلسطينيين ومناصرين في كل مكان، لم يعبأوا بصراخ الوحدة الذي تُروّج له القيادة الفلسطينية بغرض إفراغ الخارطة وتعبئة الخطاب، بل أشعلوا وحدة في الفهم والتحليل والمثابرة المنهجية وفهم الانتفاضة كحالة تؤسس لما بعدها في صراع طويل.
إنها بداية النهاية. لم تُسَق قبلاً – بهذه الحدّة وبهذه الوتيرة وهذا الوضوح – علاقة المروية بطرفي القصة، وقدرتها على الالتحام حدّ الانحجاب أحياناً بما هو آني ومباشر، وتجاوزها كل التفاصيل الآتية من الميدان لتشكل مشروعاً جامعاً محدداً.