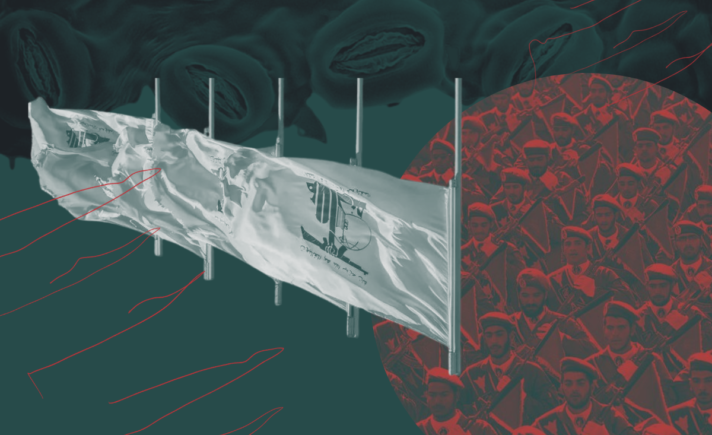لمياء، كيف تُعرِّفين عن نفسك؟
أنا في الأساس خريجة معهد دار معلّمين، ثم درست في كليتي التربية والأدب العربي، ومارست التعليم لعدة سنوات. كنت أحب التعليم رغم طبيعة النظام التعليمي القائم في البلاد، والذي كان بحاجة إلى مسح وإعادة هيكلة. في 2010 عملت في الصحافة في موقع مدوّنة وطن، وفي 2011 تركت التدريس والصحافة بسبب اضطراري للخروج من دير الزور نحو الحسكة، حيث كانت القبضة الأمنية أقل قسوة. وهناك في العام 2012 بدأتُ مرحلة جديدة متّصلة بالعمل المدني والنضال السلمي إذا صح التعبير.
قبل 2011 كنت أكتب الشعر، ولدي ديوان شعر مطبوع. بالإضافة إلى دراستي في كليتي التربية والآداب، كان الشعر أهم شيء في حياتي. ولكن منذ 2011 لم أعد أكتب الشعر، لأنّ الواقع كان أصعب من أواصل الكتابة. في 2012 كنت على قطيعة مع الكتابة، وتمنّيت وقتها ألا تكون نهائية، ولكن يبدو أنها بالنسبة للشعر كانت نهائية.
في 2013 كنت مُقيمة في الحسكة، وعملت في حملة كلنا للشام، واضطُررت حينها – على مدار سنة ونصف – للنزول إلى دير الزور مرات عديدة من أجل توزيع الإغاثة. أقنعْنا المتبرِّع حينها بشراء ألعاب وقصص للأطفال، فوافق على ذلك، وبدأنا بعمل مُجمَّعات صغيرة داخل المدارس ليلعب الأطفال، إذ لم يكن حينها مفهوم الدعم النفسي متداولاً. وبدأنا من خلال خبرتنا في التعليم بإنشاء مسرح دمى بسيط للأطفال، حيث يرسمون ونغنّي نحن وإياهم.
في 2014 تحرّرتْ مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، التي أنحدر أساساً من ريفها. وكان أهلي حينها نازحين إلى الميادين. هناك أنشأنا منظمة خطوات، وعملنا فيها بشكل تطوعي، فلم نكن قد تعرفنا بعدُ على أمور التمويل، والذي كان، بالمناسبة، أمراً غير مستحب. اشتغلنا لأشهر عديدة، كانت من أجمل أوقات عملي. في مرحلة لاحقة، وجدنا أنه في سبيل توسيع العمل لا بد من الحصول على تمويل، وجرى التواصل مع كومينكس (المنحة الأوروبية-البريطانية للتعليم في الشمال المحرر)، كما عملنا أيضاً مع مؤسسة طفل الحرب الهولندية، ومن ثم دخلت داعش إلى المنطقة منتصف 2014، وكان ما يزال لدينا ثلاثة مراكز تعليمية. كانت الفرصة متاحة لمحو أمية الأطفال الذين انقطعوا لسنة ونصف أو أكثر عن التعليم، غير أن دخول داعش غيّر المعادلة، فكان من الضروري أن نغيّر مخططاتنا. الجهة المموِّلة، كومينكس، كان لديها مشروع معنا اضطُرّت لإلغائه، أما المشروع الثاني مع طفل الحرب الهولندية، فقد جرت الموافقة بشكل غير متوقع على مواصلة العمل فيه داخل مناطق داعش، وبالرغم مما كان يترتب على ذلك من مخاطر بالنسبة للمموِّل، من بينها محاذير تتعلق بكون المنظمة نفسها قد تتعرض للمساءلة نتيجة عملها في تلك المناطق. لكنهم لحسن حظنا وافقوا على مواصلة العمل. بناءً على ذلك، غيّرنا أسلوبنا المُتّبَع، ولم يعد لدينا مراكز فوق الأرض، فقد تحولت جميعها إلى تحت الأرض، فعملنا في الأقبية والمساجد، ونسّقنا مع معلمين ليعلّموا داخل المنازل.
مع بدايات دخول تنظيم داعش إلى المنطقة، كانت الأمور أيسر من الفترات اللاحقة لسيطرته، فقد كانت مدرسة الشام للبنات في الجزء المحرَّر من مدينة دير الزور لا تزال تستقبل الطلبة. هذه المدرسة كانت تحمل اسم جمعية الشام، وهي جمعية دينية تخلّت عن المدرسة نتيجة عدم قدرتها على تمويلها، فانتهزْنا الفرصة للعمل فيها. كانت المدرسة محسوبة في السابق على جمعية لا تعارضها داعش، فقلنا لهم إن بوسعنا أخذ المدرسة منهم، وكان يديرها السيد ز.ج. بعدها، أسّسنا مركزاً في مدينة الميادين قريباً من المحكمة، كان عبارة عن قبو. ولتأمين حماية المركز وخوفاً من بطش داعش، تواصلت مع أقاربي طالبةً منهم أن يدّعوا أنهم هم من يموّل المركز في حال خضعنا لمساءلة من تنظيم داعش، بحيث نتجنب إغلاق المركز. وبالفعل، قال لي أخوال وأعمام أن أشخاصاً بعينهم سيدّعون أنهم المموِّلون للمركز في حال حدوث مساءلة من هذا القبيل. استمر الحال على هذا الترتيب مدة ستة أو سبعة شهور، كانت مُرعِبة لجميع الشباب والشابات الذين يعملون في المركز. كما كان من الصعب جداً علي وعلى زوجي البقاء في مدينة الميادين، ذلك أنه سبق لي العمل بشكل مُعلَن مع الأطفال على الفنون والموسيقى والنحت، وكنتُ من بين أوائل الذين قد يتعرضون للتصفية من داعش نتيجة هذه الأعمال. حينها، قررنا أنه لم يعد البقاء ممكناً نتيجة الخطر على حياتنا وحياة بناتنا. الأمر ذاته انطبق على الشباب الذي كانوا ظاهرين في الصف الأول من العاملين معنا، ولذا رفضنا مواصلتهم للعمل بشكل قاطع كونهم معروفين لخلايا داعش الأمنية، وفي ذلك خطر عليهم وعلى بقية العاملين من الشباب غير المعروفين بيننا.
بالتزامن مع ذلك، افتتحنا فروعاً في قريتَي المجاودة وبقرص تحتاني، وتابعنا العمل في مركز مدينة دير الزور. لقد كانت تلك الفترة شديدة الصعوبة، لا سيما أني قررت خلالها الانتقال إلى تركيا، في حين ظلّ أحد إخوتي يُدير واحداً من المراكز، وكانت صديقاتي موجودات أيضاً. لذا، كنت في حالة رعب دائمة من فكرة اعتقال أيٍّ منهم. كانت داعش في تلك الفترة تُعدِم الناس ويُعلّقهم على دوّار في الميادين، وكنت أتواصل مع أحد العاملين معنا فأخبرني أنه كان كلما مرّ من أمام الدوّار وشاهد أحدهم معلقاً يُخيَّل إليه أنه الشخص التالي. كان ذلك يُشعرني بغصة ظلّت مرافقة لي، ولكنّ الشباب والصبايا بقوا صامدين حتى نهاية 2016. حينها حدث أمران: الأول هو أنّ منظمة طفل الحرب كانت تخشى من ارتفاع مستوى الخطر، وهي منظمة هولندية وستقع في كارثة لو أُصيب كادرها العامل في المنطقة بأذى، وتزامن ذلك مع معرفة داعش أن العاملين معنا في الميادين وفي قرية المجاودة قد استلموا تمويلات خارجية. هنا اتخذنا القرار بأنّ الحياة أولى من التعليم، وأخرجنا الشباب من مناطق سيطرة داعش، والحمد لله من دون أن يصاب أحدهم بضرر.
على خلفية ذلك، افتتحنا مراكز شبيهة في إدلب بتمويل من نفس الجهات (طفل الحرب وكومينيكس)، فضلاً عن جهات أخرى، فاستقبلَنا الشباب الذي خرجوا من دير الزور في إدلب، وواصلوا العمل هناك حتى 2018. استطعنا حينها الحصول على تمويل مباشر من الخارجية الأميركية لطباعة مجلة أطفال، كما اشتغلنا مع مؤسسة دو فرانس على مجلة أطفال أخرى.
قلتِ شيئاً يصلح مقدمة لسؤال آخر: «الحياة أهم من التعليم». هل كان لديكم إزاء هذه الظروف القصوى تخطيط لسياسات تعليمية، بمعنى أنه هل كنتم تخططون ما هو أهم شيء تعلمونه للأطفال، أم أن الأمر كان يتم وفق استنارة برأي المموِّل؟ ماذا كانت الأولويات التعليمية بخصوص المضامين؟
على الصعيد التعليمي، كنا ندرّس في 2014 فقط بهدف محو أمية الأطفال الذين هم خارج عملية التعليم، فقد كان عددهم كبيراً جداً، وكان لدينا منهاج مُحدَّد لمحو الأمية الحسابية والقرائية. وبالتوازي مع ذلك، قدمنا أنشطة دعم نفسي. عندما دخلت داعش إلى المنطقة، صار لزاماً علينا تغيير هذه السياسات، فجميع الأطفال تقريباً، ومع مرور الوقت، صاروا أميّين، ذلك أنّ جميع المدارس صارت تابعة لداعش. هنا بقينا على نفس المنهج، ولكن صار لدينا شريحة من الأطفال غير الأميّين من الذين تركوا المدرسة، فعدنا إلى مناهج النظام نفسها، حيث كان الأستاذ يحتفظ بنسخة واحدة من المنهاج، ولا يحقّ له الاحتفاظ بأكثر منها وأن تكون منزوعة الغلاف، كما كان يتعين عليه أن يحاول قدر الإمكان الخروج بملخصات من الكتاب، وأن يحرق الكتاب الأساسي. هذه كلها كانت أشياء مكتوبة ومخططاً لها، بحيث أن لكل درجة خطورة تدبيراً معيناً. أخيراً، عندما اشتدّ التضييق، وبعد رفض داعش تدريس كثير من المناهج، كالعلوم والرياضيات، قررنا الاقتصار على تدريس اللغة العربية.
أما على صعيد الاستراتيجية، فقد كنّا نتوقع السيناريوهات من خلال مراقبة ما يحصل في منبج والرقة، متوقِّعين من داعش اتباع نفس السياسة في مناطق عملنا. صرنا، مثلاً، نمنع اختلاط الأولاد مع البنات قبل أن تقرر داعش ذلك فعلياً، وذلك حتى لا يكون ذلك ذريعة لهم لإغلاق مراكزنا. كان ممنوعاً أن تأتي طفلة غير محجبة، لأننا كنا نعرف أن قدوم بنت غير محجبة يعني إغلاق المركز. كنا نقول للفتاة: عندما تأتين، ومن أجل أن تحمي نفسكِ والأولاد الآخرين، عليكِ ارتداء الحجاب، فهذه مرحلة يجب أن تمرّ بأقل الأضرار.
إذن سياساتكم كانت قائمة على أن تستمروا عبر معرفة الخطوط الحمر وتجنب تجاوزها؟
نعم، وبالأحرى كيف نتحايل عليها. مثلاً، بمجرد أن عرفنا أنّ داعش ستصل إلى دير الزور، درسنا وضع التعليم في منبج والرقة، وعرفنا الممنوعات: كمناهج النظام، والاختلاط بين الذكور والإناث، ودخول المجسَّمات والرسوم في العملية التعليمية. الأمور التي تتناسب معنا عملنا على اتباعها، أما ما لم يناسبنا فقد صرنا نعمل عليه في الخفاء. على سبيل المثال: في أول مرحلة لدخول داعش، كان ما يزال الأساتذة يستخدمون مجسَّمات من الصلصال مع الأطفال، وعندما ينتهي الدرس يُعيدون عجنها. كنا هكذا نتحايل على سياساتهم، ولكن التفاصيل التي تشكل خطراً على العاملين معنا كنا نستغني عنها، فالأولوية مواصلة العملية التعليمية.
كان هناك قلق وخوف دائمان لدى المعلمين والمعلمات، فكيف كان حال الأهالي، ألم يكن لديهم خوف من إرسال أطفالهم إلى مدارسكم ومراكزكم؟
في تلك المرحلة لم يكن هناك خطر على الأولاد حين يذهبون إلى بيت المعلم/ة، لكن كان المعلم يعاقَب. لم تعتقل داعش أولاداً أو يسئ لأهاليهم أو يجلد أباً لأنه أرسل أطفاله للتعليم. من جهتنا، لم نكن نواجههم بالقول إنّ لدينا مركزاً نستقبل فيه الأطفال. في بداية عملنا كان مركزنا «شرعياً»، ولم يكن لدى عناصر داعش مشكلة فيه، لأنهم ظنّوا أن أهالي الحي هم الذين يموّلونه. حينها لم يكونوا على علم بطبيعة عملنا والجهة التي تموّلنا، وحين قررت داعش إغلاق المدارس وجميع المراكز التعليمية بعد افتتاحها لمراكز شرعية، تذرّعنا بوجود أطفال بحاجة إلى محو أمية، وتحدّث بعض الأهالي إلى داعش، لا سيما إلى العناصر من أبناء المنطقة، والذين كان من الممكن التفاهم معهم إلى حد ما. وضع المدينة كان مختلفاً عن وضع الريف، حيث كان التشديد في هذه المسائل أقل نتيجة إمكانية التذرع بأن وجيهاً فلانياً منحنا مبلغاً معيناً من المال طالباً منّا تدريس هؤلاء الأطفال. إذن استفدنا من الحالة العائلية في المنطقة.
ولكن بدأنا بإخفاء الأولاد والذهاب إلى البيوت عندما صارت داعش تمنع اجتماع الأولاد، فصرنا نشكل مجموعات صغيرة من خمسة أطفال مثلاً، ويذهب أستاذ لتدريسهم. في فترة من الفترات، وصلنا إلى مرحلة أن يتولى كل أستاذ تعليم أولاد حارته، وإن لم يستطع فعلى الأقل أطفال عائلته. المهم في النهاية ألا نشعر بأننا سلّمنا وانسحبنا جميعاً. لم يكن كل العمل على سوية واحدة وبنفس الاستراتيجية، فسياستنا في دير الزور كانت مختلفة عن سياستنا في الريف. كان هناك أمر مهم نركّز عليه كثيراً، وهو عدم تعريف العاملين معنا ببعضهم البعض، فالعاملون في ديرالزور لا يعرفون العاملين في الميادين، ولا يعرفون أصلاً بوجود مراكز أخرى في مناطق أخرى. كنا ندرس بحذر كل هذه التفاصيل من أجلنا ومن أجلهم.
هل هناك أساتذة لا يعرفونكم وليسوا ضمن كادركم أخذوا مبادرات مشابهة، كتدريس أبناء حارتهم مثلاً؟
للأمانة، وأنا أتألم لقول لذلك، عندما بدأنا بالعمل لم يخطر في بالنا أن الجميع توقف. كنا نظن أن هناك مجموعات أخرى تعمل مثلما نحن نعمل بطريقة أو بأخرى. وكنا نقول لأنفسنا: عندما تتحرر دير الزور سنجتمع للحديث مع الآخرين عن تجاربهم في هذه المرحلة القاسية. ولكن بعد خروج داعش، كان هناك أول تحقيق صحفي عن عملنا من قبل صحفية مصرية سألتني نفس هذا السؤال، وكانت هذه المرة الأولى التي سألتُ فيها إن كان ثمة أحد غيرنا يقوم بما قمنا به، وتواصلت مع كثير من المنظمات التي كانت موجودةً في المنطقة، فاكتشفت أن الجميع قد توقفوا في 2014، ولم يواصل غيرُنا تقديم التعليم.
في اجتماعاتكم قررتم أن الأساسي في هذه الحالة الطارئة والحديّة هي القراءة والحساب كمهارات أساسية للحياة. هل فكرتم كيف يمكن في هذه الظروف العمل على الجانب القيمي والمعنوي؟ قلتِ أنكم عملتم على الموسيقى والفن والصلصال، ولكن كيف كان يمكن حماية الأطفال من الأجواء التي يعيشون فيها؟
كلامي السابق كان عن مرحلة داعش، ولكن قبل دخول داعش، كنا عملنا على برنامج صادر عن منظمة طفل الحرب، وكان يعالج مشاكل الأطفال النفسية الناتجة عن الحرب. كذلك عملنا على برنامج اسمه التربية على حقوق الإنسان عن طريق اللعب. تحدثنا عن مجموعة من القيم البسيطة التي لم يألفها أطفالنا عن طريق ألعاب ورسوم، بالإضافة للعمل بشكل موجّه على المسرح، وكان ذلك أثناء سيطرة جبهة النصرة على مدينة الميادين، وكنا نتخوف من أن يخرّبوا لنا العرض، ولكنهم خيّبوا ظننا عندما حضروا وأثنَوا علينا، ليس من باب أننا رائعون أو أنهم أُعجبوا بتقديمنا للمسرح أو القيم التي يحملها العمل، ولكن من باب أننا عملنا على محو أمية الأطفال. تولى مسرح الأطفال شخص مختصّ بالمسرح المدرسي، بالإضافة إلى عازف عود كان يعلّم الموسيقا للأولاد وقام بإنشاء فرقة كورال. كان هناك أيضاً فنان تشكيلي عمل على تعليم الرسم للأولاد. كل هذا كان في 2014، وحينها كانت الميادين، وهي نسبياً محافِظة اجتماعياً، تحت سيطرة أحرار الشام وجبهة النصرة، ولكنّا قدمنا مسرح هواء طلق، وعملنا على معارض فنية وحفل للأولاد. كل هذه الأشياء عملنا عليها بالتوازي مع مواصلة التعليم.
هذه المدارس ما زالت مستمرة، أليس كذلك؟
حتى 2018 كان عملنا في إدلب ما يزال على ما يرام، وحينها بدأنا نتلمّس إمكانية العودة إلى دير الزور والتوقّف في إدلب. كان الخيار صعباً، لا سيما بعد أن ألِفنا المكان بعد عامَين من العمل، ولكن كان هناك إحساس بالواجب، وبأن دير الزور خالية من المنظمات، ومن الضروري العودة إلى أهلنا. هنا قرّرنا العودة، في 2018، وحينها لم يكن ممكناً الاستمرار تحت اسمنا القديم خطوات، فأنشأنا كياناً جديداً باسم بداية، آملين أن تكون بداية جديدة للمنطقة.
كم مدرسة لديكم؟
هنا ذهبنا إلى واحدة من المناطق الأكثر ضعفاً، مخيم أبو خشب، حيث عملنا على محو الأمية ومن ثم التعليم الذاتي، وبدأنا مع الأطفال بتنفيذ أشكال متنوعة من الفنون الجميلة التي رغبنا بالعمل عليها خلال فترة داعش دون أن نستطيع. هذه المدرسة في المخيم ما زالت قائمة حتى اليوم.
قلتِ تعلّم ذاتي، بأيّ معنى؟
منهج اليونيسيف للتعلم الذاتي بحد نفسه، والذي يشبه منهاج النظام، يسمى منهجاً ترميمياً. اهتمامنا الأساسي كان بالأولاد المشرَّدين في أبو خشب، المنطقة التي كانت منفى في البادية، وكان من حق هؤلاء الأولاد أن يتعلموا. كان التحدي الأساسي والأهم هو إنشاء مركز في قلب البادية، وكان مشروعاً ناجحاً وظل هذا المشروع قائماً ويتوسع. عملنا أيضاً على العمل على برامج التربية على حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكان لدينا برنامج اسمه قصص للسلام، يحتوي قيماً تحض على التعايش السلمي ونبذ العنف، فكنا نعيد إخراجها من جديد. عملنا على شق آخر هو ترميم المدارس، لأن عدداً كبيراً من المدارس تدمّرت. هناك مدارس كانت بدون أسوار، فحصلنا على عقد لتهيئتها وترميمها، فتحت أسوارها كانت هناك أنواع مختلفة من القذائف والجثث والأفاعي. أخرجنا كميات كبيرة من المواد المتفجرة منها كانت موجودة مع الأولاد في المدارس التي يداومون فيها.
لنربط ذلك مع سؤال أولوية التعليم، بغض النظر عن لغة المنظمات أو كيف تقترح المنظمات المشاريع. الحالة القصوى بين الحياة والموت ما زالت موجودة، ولكن بمعنى آخر، اقتصادي، أي أن الحياة صارت صعبة جداً في سوريا. كيف لكم أن تقنعوا أطفالاً يعملون أو يُشغَّلون من قبل أهاليهم بأولوية التعليم رغم هذا الظرف؟ وهل يمكن أن يكون هناك بديل آخر هو التعلم والعمل معاً؟ كيف يمكن ربط الطفل ببيئته، وما الذي يجب العمل عليه لتصبح الحياة ممكنة في هذه الأماكن أو في كل سوريا بالأحرى؟ دعينا نتخيل مكاناً معيناً هو الريف الشرقي لدير الزور: ما الممكن للحياة في هذه المنطقة؟ وبالتالي ما الذي يمكن أن أعلّمه للطفل كي يعيش؟ الحساب والقراءة مهمان لأنهما يساعدانه على العيش ولكن ماذا أيضاً؟ هل فكرتم بذلك؟
ما ركزنا عليه بشكل أساسي هو أن عملية التعليم شكل من أشكال الصمود، والعلوم بالنسبة لنا – التي ندرسها أو التي يتلقاها الطفل – هي أداة من أدوات الصمود. هو شكل من أشكال المقاومة ضد القهر، كما يقول أحد المعلمين البرازيليين هو «تعليم المقهورين».
نقصد العلاقة مع البيئة. الولد خارج المدرسة، هل يمكن ربط ذلك مع المدرسة؟
أنا أركز على هذه الفكرة لأن لها نفس المنحى الذي نعمل عليه. جميع العلوم ضرورية بمستوياتها المختلفة وهي متاحة للجميع. ما ينبغي أن نعمل عليه نحن هو إصلاح منظومات التعليم بشكل يواكب التطورات العلمية في العالم.
نتفق أنه لا يجب انتقاء علوم بحسب بيئة كل شخص. العلوم جميعها حاجة نفسية وروحية، كونية، لجميع الناس. ما نقصده هو أن هناك حياة صعبة، وهناك تعليم. كيف يمكن إيصال ذلك للطفل. سأطرح السؤال بطريقة ثانية، أنا عندما أعلم طفلاً، إلى أين أريد إيصاله؟ وماذا أُريد له أن يعمل في هذه الظروف التي يعيشها البلد،؟ وكيف يمكن أن يكون الطفل مفيداً لبيئته أيضاً؟
الطفل الذي يصل إلينا في المدارس هو طفل عاش أبشع تفاصيل الحياة، قد يكون رأى أمه تحت الركام، أو شاهد طيارة دمرت بيت أهله، وقد يكون جاع على طريق العبور من منطقة لأخرى. ما أقصده أن هؤلاء الأطفال مروا بتجارب قاسية جداً، فوعيُهم ليس كوعينا عندما كنا أطفالاً في مثل عمرهم. هم أكثر نضجاً ووعياً منا نتيجة الظرف الذي يعيشونه. ما نراه نحن من هؤلاء الأطفال أنه بقدر ما لديهم حالة ألم قصوى، لديهم إرادة قصوى. بالأخص الأطفال بين 12 و14 سنة. هؤلاء أصحاب إرادة استثنائية قياساً بأعمارهم وقياساً بأطفال يعيشون في دول أخرى.

تقصدين لديهم رغبة شديدة بالتعلم؟
طبعاً طبعاً. أما بالنسبة لحالات عمالة الأطفال، فهؤلاء يجب جذبهم من جديد للمدرسة بشكل أو بآخر، وهذا عمل المجتمع المدني بشكل عام، والجهات المسيطِرة على المنطقة، والمنظمات الأممية.
لنغض النظر عن كيف تفكر المنظمات. نتحدث عن أطفال نضجوا قبل أوانهم نتيجة الظروف، فبالتالي الطفل الذي يعمل في سن 15 سنة كأنه شاب عمره 20 أو 25 سنة في بلد ثانٍ، قد لا يكون من الضروري أن يترك العمل، ولكن ماذا أقدم له من مهارات بحيث يتعلم ويستمر في عمله في نفس الوقت؟
سأعطي نموذجاً عملياً. في 2018، افتتحنا مركزاً في أبو خشب اسمه ألوان، وعملنا على إزالة أنقاض مدارس ومنازل، وبعدها عندما اتجهنا للتعليم كانت المنظمات لا تدعم العمل في الريف الشرقي لدير الزور، وهذه واحدة من أكثر المناطق تهميشاً في ديرالزور، حيث الكثافة السكانية عالية والبنى التحتية منهارة منذ ما قبل الثورة. راسلنا المموِّلين وقلنا لهم إن الريف الشرقي مهيأ، ولكنهم قالوا إنه غير مهيّأ. ذهبنا إلى أصعب نقطة في الريف الشرقي لدير الزور، وهي بلدة الشحيل شبه المنهارة أمنياً منذ 2018 وحتى الآن. في 2018، أردنا العمل على إزالة الأنقاض، وواجهنا تحدي إثبات أن المنطقة أمنة ويمكن العمل فيها. كنا بالون الاختبار ونفذنا مشروعنا، لكن المموِّلين لم يريدوا العمل على التعليم، فبدأنا مبادرة باسم «تعلّمتُ لأُعلِّم»، وطلبنا من الناس الذي ليسوا معلِّمين ولكنهم مهندسون أو محامون أو فلاحون ولديهم مهارة في التدريس أن يجمّعوا بعضهم ويطلقوا مبادرة. أردنا أن نوصل رسالة للناس بأننا لم نتعلم فقط للعمل بشهاداتنا، ولكن كذلك من أجل تعليم غيرنا. مركز تعلّمتُ لأُعلِّم ما يزال موجوداً اليوم، وليس مموَّلاً من أي جهة، وفيه 570 طالباً في مرحلتي التاسع والبكالوريا، وهو يشتغل في ثلاث مناطق – هي أبو حمام وهجين وغرانيج – بمبادرة تطوعية من الناس. الآن نحن في طور إنهاء المنهج لهؤلاء الطلاب، بجهود مهندسين وصيادلة ومعلِّمين متطوعين – هناك 45 متطوعاً. كان المبدأ هو أن يعطي المتطوعون ساعات قليلة حتى لا نُرهقهم وحتى نضمن الديمومة، وبالفعل ضَمِن ذلك لنا الاستمرار بالرغم من غياب التمويل.
نتيجة عملنا وعمل جهات أخرى غيرنا، صار هناك منظمات تتجه إلى المنطقة وتشتغل على التعليم، لأننا استطعنا بعملنا الإيحاء بأن المنطقة آمنة وهادئة ويمكن العمل فيها.
المشروع الثاني يستهدف الأطفال الذين ليس لديهم قدرة على الذهاب إلى المدرسة. هؤلاء حتى لو توفرت لديهم الإرادة ليست لديهم الإمكانية. وجدنا الشريحة الأكبر من خلال مشروع لإنشاء مكبات نفايات في الريف الشرقي ولدعم النظافة اليومية. النباشون في المكبات يصل عددهم إلى 60 طفلاً تحت سن 12 سنة. منظرهم وهم يركضون على النفايات يندى له الجبين، ويستدعي في أي إنسان الخجل والمسؤولية. راسلنا المنظمات بخصوصهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. اليوم نعمل على مشروع اسمه «لست وحدك» يتضمن جمع تبرعات بسيطة من الأهالي، مع إبقاء الأطفال يعملون، ولكن إذا لم نضمن لهم دخلاً يمكّنهم من الجلوس في البيت فلا أقل من تأمين مبالغ لتأمين معلم يدرسهم. هذا الأمر لم نبدأه إلا بعد استفتاء هؤلاء الأولاد في مناطق كثيرة من الريف الشرقي، وقال أكثر من 80 بالمئة منهم إنهم مستعدون للتعلم مساءً. بمبلغ بسيط لا يتجاوز دولار من كل شخص، نحن قادرون على إحداث فارق بالنسبة لمعلم وبالنسبة لطفل، وبإمكان أي معلم تعليم 10 أطفال على الأقل. نحن بحاجة 150 دولار شهرياً لتعليم 60 طفلاً. بإمكاننا فعل شيء حتى لو رفع العالم يده عن معاناة هؤلاء الأطفال.
مشكلتنا الأساسية، وخاصة في مجال التعليم، هي أن عيوننا تتجه دائماً إلى البعيد، ولكن هناك إمكانيات كبيرة في واقعنا. سآخذ مثالك: في حالة هؤلاء النباشين، من المستحيل أن نقول إن القمامة قد تصنع ثروة لبلدان أخرى، فليس من الضروري أن نتكبر عليهم، ولكن يمكن التفكير معهم لفرز مواد عضوية وصناعة غاز ميتان كما حدث في تجارب أخرى في سوريا أثناء حصارات بعض المدن . إذن أقول للطفل إن عملك مهم ولكني سأعطيك ظروفاً أفضل لتتعلم. هناك صورة متشنجة – هي غربية في الحقيقة – بأن شكلاً معيناً هو النمط الأفضل لعيش الأطفال. ولكن نحن لدينا واقع مختلف يجب أن نربطه بالتعليم، من دون أن نُشعر الأطفال أنهم في حالة مزرية.
استكمالاً لحديثكم، نحن الآن لدينا مشروع، كما سبق أن ذكرت، لدعم النظافة في الريف الشرقي، وسيكون لدينا مشروع سيبدأ في نيسان لصناعة السماد من النفايات العضوية، وأيضاً تدوير البلاستيك وصناعة طوب منه. هذا موجود أيضاً بكثرة في شرق آسيا. يمكن من خلال ذلك تأمين فرص عمل أفضل لوالد أو إخوة هذا النباش الصغير، على أن يكون شرط العمل هو إدخال الطفل إلى المدرسة. بذلك نكون بصدد العمل في قطاعي التعليم والخدمات، وبصدد الاستفادة من وظائف خارج التعليم لدعم التعليم نفسه.
مشروع النباشين بدأتم به؟
نعم، نحن في طور أخذ الموافقات من المجلس المحلي ولدينا حجم تبرعات جيد من خلال جمعية في ألمانيا. وأنا حصلت على جائزة أدب الدولة لأدب الطفل في قطر والتي تتضمن مبلغاً جيداً نسبياً سيساعدنا في وضع اللبنات الأولى للمشروع. وفي خطتنا أن نقدم دعماً نفسياً لخمسمئة طفل وإدارة حالة لمئة طفل من بينهم هؤلاء النباشون.
أتيتِ على ذكر الموافقات، وأنتم تعملون اليوم في مناطق تسيطر عليها قسد، هل تواجهون أية مشكلة متعلقة بالتراخيص؟
عملنا على أكثر من مشروع ولم نتعرض لمضايقات أمنية. في إحدى المرات، حدث شيء من هذا ولكن ليس مع المؤسسة؛ مجرد خلاف مع أحد العاملين معنا. أسمع عن مضايقات تتعرض لها باقي المنظمات، ولكننا لم نواجه ذلك، قد يكون الأمر متعلقاً بخبرة اكتسبناها في التعامل مع السلطات الحاكمة بما يجنّبنا الخطر. منذ 2018 وحتى اليوم، سواء في منظمة بداية أو خطوات، لم نتعرض لأي أزمة مع السلطات المحلية. في بعض الأحيان هناك تأخير في منحنا الرخص، لأن رخصنا تتجدد في كل عام وليست رخصاً دائمة.
عند التعامل مع أطفال يعيشون في مناطق جغرافية خضعت لسيطرة فصائل وقوات مختلفة، منذ الجيش الحر مروراً بالنصرة وداعش وصولاً إلى قسد حالياً، هذا الطفل القادم إليكم والذي عاش في شوارع وظروف مختلفة، كيف يمكن التعامل معه في مركز يعمل فيه على الصلصال، وعندما يخرج منه قد يرى أجساد مصلوبة ورؤوس معلقة في الطرقات؟
من حقك أن تسأل هذا السؤال. كادرنا ليس فقط معلمين ومعلمات يدخلون المركز لتعليم الأطفال، بل هم أشخاص خضعوا للتدريب في تركيا مع منظمات مثل طفل الحرب الهولندية، وهذه المنظمة لديها برامج دعم نفسي مخصصة لأبناء المنطقة، وتراعي الخصائص الاجتماعية للمنطقة، وهي مخصصة لأطفال يعايشون الحرب. من جهة أخرى، لدينا في المؤسسة اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي يأخذون البرامج قبل إعطائها للأطفال، ويعالجونها ليقرروا الأشياء الصالحة لتقديمها للأطفال، ولا سيما الأمور التي تجعل الطفل يعيش حالة غربة أو صراع، ويقومون بفلترتها بالتعاون مع الميسِّرين، فنوصل للطفل مادة تجعله يعيش حالة من التوازن مع البيئة المحيطة مهما كانت صعبة. كما نقدم في المركز أنشطة تخفيف ضغط. بالنهاية هو ليس دعماً نفسياً فقط، بل دعم نفسي موجه يجنّب الطفل بشكل أو بآخر حالة الصراع التي تفرضها ثنائية الشارع والمركز.
هل نجحتم من خلال هذه الاستراتيجيات؟
لو لم ننجح لما واصلنا. كنا نغامر بكوادرنا، وهم أناس أعزاء ومقربون مني شخصياً. هناك فيديوهات تدل على نجاحنا مع هؤلاء الأطفال من خلال المعارض والأنشطة التي قمنا بها وأنجزها الأطفال. كل هذا حصيلة الجهد الموجَّه الذي بذله الكوادر في الداخل. صار هؤلاء الأطفال يحكون بثقة وبحب، يحكون عن الحب والسلام والتفاؤل، وهذا أمر للأسف صرنا نفتقده في أولادنا نتيجة وضع البلد الرهيب. استطعنا خلق ذلك في سلقين ودير الزور، ونحاول خلق الأمر نفسه في هجين وأبو حمام ومختلف المناطق التي نعمل فيها اليوم. ليست مشاريعنا دائماً وفق توجيهات الجهة الممولة، وإنما بحسب الأولويات في المناطق التي نعمل فيها ولدينا دراية بطبيعة احتياجات الأطفال فيها، فقد عملنا على الترفيه والفنون والمسرح والموسيقا لتنمية مواهب الأطفال، وهو ما أعطى لعملنا روحاً وقيمة، ودفَعَنا للصبر والمواصلة.
استراتيجياً، هل تفكرون بالاستغناء عن التمويل المنظماتي وتوسيع التمويل الأهلي لتصبح المدارس مدارس أهلية؟
نتمنى أن يحدث ذلك، ولكنه صعب في المدى المنظور. نحن نلجأ للتمويل الأهلي عندما نيأس من الممولين. ولدينا المبادرات التي تحدثت عنها وتمت بجهود أهلية وتطوعية. في كل الأحوال، عندما يتوفر التمويل تصبح الأمور أسهل ونستطيع الوصول إلى شريحة أكبر من الأطفال.
عند دراسة السياسات، ما هي آليات العصف الذهني المتّبَعة، وكم شخصاً أنتم؟
بشكل أساسي، نعمل مع نفس الكادر الذي بدأ في دير الزور في 2013، ولكن في كل مرة معنا أشخاص أساسيون من المناطق التي نعمل فيها، فالسياسات لم تُبنَ في يوم وليلة وإنما منذ 2013 وحتى اليوم، ولدينا شيء جديد يومياً نحاول إضافته لعملنا.
إذا قررنا إدخال مضامين متعلقة بقيم جديدة خلال الظرف الحالي، غير السلام، بماذا تفكرين؟ وما الشيء الذي علّمتكِ إياه هذه التجربة وتودّين تعليمه للأطفال على المستوى القيمي والروحي والأخلاقي. ما أهم شيء يجب أن يتعلمه الأولاد في ضوء تجربتك؟
بشكل أساسي، لا بد من تكريس القيم الاجتماعية التعاونية مثل الغيرية والإيثار، فنحن نحاول تجنيب الأطفال الأنانية وإنكار الآخر وإنكار حقوق الآخر. لا بد من السيطرة على هذه الأمور، فضلاً عن الحقوق والحريات الفردية.
ما هو الشيء الذي يجب المحافظة عليه وهو موجود في مجتمعنا كقيمة، وما الذي يجب تفكيكه ونزع تعلمه كقيمة؟
إذا أردت الحديث عن شيء أصيل، بإمكاني الحديث عن سوريا كلها أو عن دير الزور. في دير الزور هناك درجة تسامح عالية، مثلاً المسيحي هناك لا يُعرَف بأنه مسيحي، رغم وجود نعرات عشائرية. لا توجد طائفية بالمطلق في دير الزور. نحن مثلاً من المدن التي احتضنت الأرمن. هناك كنيات أرمنية في دير الزور، ولكن مظهر هؤلاء الأشخاص المنحدرين من هذه العائلات ديري ولا يختلف عن باقي سكان المدينة. إذن يمكنني الحديث عن أمر يجب استعادته، هو حالة التسامح التي كانت موجودة لدينا كسوريين بشكل أو بأخر، أكثر من بناء قيم جديدة. والتسامح الديني على وجه الخصوص. وهناك الكرم قبل وأثناء وبعد الثورة، ولكن التسامح أمره مختلف. كذلك نبذ العنف وتقبل الآخر قيم لم تعد موجودة كما كانت، وهي ليست بحاجة للبناء كما قلت، وإنما للاستعادة. عند الحديث عن فترة انتقالية بين الحرب والسلام، فلا بد من تجاوز التاريخ الراهن والمآسي والجراح الحالية. إذا أردنا جيلاً غير مُثقَل بأحقاد الماضي فلا بد من تجاوز هذه المرحلة.
هناك مجموعة من الأطفال خضعوا للأسف لتنشئة أيديولوجية، كالذين دخلوا مدارس داعش أو الذي يدرسون في مدارس ترعاها إيران، خصوصاً في المناطق التي سبق أن عملتم فيها في الريف الشرقي لدير الزور. هؤلاء الأطفال، كيف يمكن العمل معهم لتخليصهم من قيم سلبية يحملونها من هذه المدارس؟
نحاول قدر الإمكان التركيز على الهوية الإنسانية الكونية للفرد، والتركيز على الوعي بعدم أسبقية الهوية الطائفية والدينية والعرقية والجنسانية والمناطقية والثقافية، وأن الهوية الإنسانية لها الأولوية.
كيف؟ ما طبيعة المشاريع التي يمكنها بناء هذه القيم؟
نحن لدينا برامج دعم اجتماعي ونفسي موجَّه تحاول مساعدة الطفل على استعادة توازنه والتفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي. وثانياً برنامج التربية على حقوق الإنسان، والإنسان الذي نربّيه على معرفة حقوقه هو الدرزي والسنّي والعلوي والكردي والعربي. البرنامج الآخر هو قصص للسلام، وهو ينفَّذ من خلال مسرحيات يشتغل علهيا الأطفال وتحض على السلام ونبذ العنف، وثمة برنامج آخر عملنا عليه هو برنامج المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي، وهو يُقدَّم للشباب بين 20 و25 سنة. هذا البرنامج بشكل أو بآخر يمكن قولبته ليصبح مناسباً للأطفال، لا سيما أنه أعطى نتائج مذهلة عند تقديمه لشريحة الشباب ببلدة هجين.
ما قلتِه عن التعلم التشاركي والتعاوني قد يصنع مواطنة أكثر من التلقين. ففي حال توفر مشروع يشكل مكتسباً للجماعة التي تعيش في قرية أو منطقة ما، والكل ساهم ببنائه، سيكون الجميع معنياً بالحفاظ عليه. هذا قد يساعد على تربية مواطنية أكثر من منهج معطى. أقصد هناك منهج عملي يرتبط بالواقع ويكون مفيداً.
ما فاتني إخباركم به هو أن المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي هو في ضوء الوضع السوري ومن عمل عليه هو شخص فلسطيني-سوري يدرس دكتوراه في الفلسفة السياسية بجامعة فرانكفورت، وهو الذي صمم وقولب البرنامج كي يتلاءم مع الوضع السوري، وهذا الشخص هو ابن البيئة وبالتالي كان البرنامج ابن البيئة ويصلح تقديمه لأطفال سوريا بإشرافه. هو ليس برنامجاً مستورداً وهو مرتبط بالحالة السورية وبالحساسية الموجودة في المنطقة.
هل تعملون على الزراعة، كون ريف دير الزور منطقة زراعية؟ أي هل تعملون مع مراعاة للنشاط الاقتصادي المنتشر في المنطقة؟
لا، فرغم أن دير الزور زراعية بحكم وجود النهر والبيئة الصالحة للزراعة، لدينا أولويات أخرى، والمدارس ما تزال في طور استعادة العافية. في هذه المرحلة لا، ولكن في مراحل سابقة عملنا على البستنة في الميادين، وقد نعود للتوسع في هذا السياق إذا استقرت الأمور أكثر.
هل لديكم نسب عن معدلات الأمية في المناطق التي تعملون فيها اليوم، قبل وبعد 2011؟
المقارنة بالماضي صعبة لعدم وجود إحصائيات، ورغم وجود التعليم الإلزامي كان هنالك أمية. ولكن كوني درّست قبل الثورة في الريف الشرقي لدير الزور، أبو حمام وغرانيج وهجين، كنت أدرك أن هذه المنطقة تنتشر فيها الأمية وينبغي العمل عليها. بالنسبة لمحو الأمية، لدينا اليوم تحديات على مستويَين: خارج المدرسة وهو ما يتعلق بالأطفال الذين خرجوا من المدرسة بسن مبكرة وهم منقطعون عن الدراسة منذ عشر سنوات، وهؤلاء أميون؛ والمستوى الثاني، وهو غير منظور، متعلق بالأمية داخل المدارس. عندما يأتي الطفل بسن 10 سنوات، ويدخل في الصف الثالث وهو لا يُجيد فك الحرف. هنا المعلمات يتجهن لإنهاء المنهج، في حين أن أطفالاً موجودين في نفس الصف لا يُجيدون أساسيات القراءة والكتابة، والمدارس لا تخصِّص معلمين ومعلمات لمحو أمية الأطفال بسبب الإمكانيات المادية المتواضعة. هنا يتم نقل الأطفال من صف إلى صف أعلى دون أن يتعلموا شيئاً. لدينا مشروع سيبدأ قريباً يتعلق بمسح لحالة الأمية داخل المدارس في أبو حمام والباغوز وهجين.
هل يمكن توسيع حملات التبرع وترسيخها لضمان استمرار المشاريع التعليمية، كون تمويل المنظمات ليس مستداماً؟
مع توفر الإرادة كل شيء ممكن. كما قلت سابقاً، 150 دولار شهرياً كفيلة بمحو أمية 60 طفل خلال عدة أشهر. المبالغ الصغيرة قد تُحدث أثراً.
تحدثتِ عن كيفية تأمين فرص للأهالي لقاء إرسال أولادهم وبناتهم للمدارس، إلى أي حد يعتبر التعليم أولوية اليوم بالنسبة لفئات اجتماعية نازحة وفقيرة ومتضررة؟
لا يمكن اعتباره أولوية وحالة عامة أو لا، ولكن الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الأهالي مخيف، وبالتالي هناك بالفعل نسبة لا تعتبر تعليم أولادها أولوية، ولكن ما أراه من معاينتي أن النسبة الأعظم ما زالت تعتبر التعليم أولوية، حتى الآن على الأقل، وهذا أمر جيد.