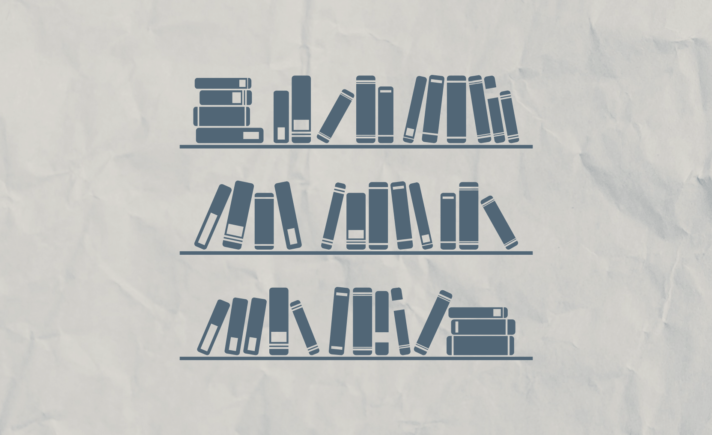من الأزمة المرورية في دمشق وحلب إلى اعتقال المتظاهرين، مروراً بإغلاق طرقات بلدات بأكملها من أجل حصارها ومداهمتها، وصولاً إلى تهجير عشرات آلاف السوريين من مناطقهم، يحكي هذا النص سيرة الباصات الخضراء الشهيرة في سوريا، التي أصبحت رمزاً للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي في البلد.
تعود القصة إلى العام 2006، حين وقّعت وزارة النقل في سوريا عقداً مع شركة «زيجيان تيميس» الصينية بقيمة 39 مليون دولار، لتوريد 600 باص كبير ومتوسط من نوع «كينغ لونغ»، لتخديم كل من محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية. كان يُفترَض، بموجب العقد، أن يتم تسليم كامل الحافلات خلال فترة تمتد إلى عام ونصف من تاريخ التوقيع، لكن فشل وزارة النقل في تأمين القطع الأجنبي اللازم لتسديد المبلغ المستحق تسبّب في تعليق تنفيذ العقد، وبعد مساعٍ عديدة استطاعت الوزارة تأمين الاعتماد اللازم من مجلس الوزراء.
ومع تسديد النظام لجزء من المبلغ المستحق للشركة الصينية، وصلت في شهر نيسان (أبريل) 2008 أول دفعة من الحافلات، وعددها 118 حافلة، لتدخل نطاق الخدمة في مدينة دمشق في أيار (مايو) من العام نفسه، أما باقي الحافلات فوصلت على دفعات على مدار ثلاث سنوات نتيجة تأخر النظام في سداد باقي المبلغ.
عقب اندلاع الثورة السورية، وجد النظام نفسه بحاجة إلى حافلات لنقل مجموعات الشبيحة من أجل قمع المظاهرات التي اندلعت في عدة مناطق سورية، فأوعزت أجهزة المخابرات إلى وزارة النقل بضرورة تخصيص جزء من الحافلات الموجودة ضمن ملاكها لخدمة الأجهزة الأمنية. وبالفعل، استجابت الوزارة لذلك كما أفادنا موظف في وزارة النقل.
بعد شهر واحد على اندلاع الاحتجاجات، وصلت إلى ميناء طرطوس، في نيسان (أبريل) 2011، آخر دفعة من الباصات الخضراء المتفق عليها مع الشركة الصينية، وعددها 150 باصاً، فأمرت الأجهزة الأمنية وزارة النقل بتسريع إجراءات إدخالها في نطاق الخدمة، بحيث تكون جاهزة عند الحاجة إليها، خاصةً مع اتساع رقعة المظاهرات في المناطق السورية. فضّلت أفرع المخابرات استخدام الحافلات الصينية الخضراء، كونها جديدة وتساعد العناصر في الوصول بسرعة إلى المناطق الثائرة، بينما تُركت الحافلات القديمة التي تعود لأكثر من ثلاثين عاماً لخدمة النقل العام الذي لم يستفِد من الباصات الجديدة.
«سلاح فتّاك» متعدد الاستعمالات
منذ الأيام الأولى للحراك الثوري في البلد، راحت خلفيات مقاعد وسائل النقل العام تمتلئ بملصقات أو كتابات تتضمن شعارات عن الحرية وإسقاط النظام، بما فيها الباصات الخضراء القليلة التي نجت من التوظيف الكامل لصالح الأجهزة الأمنية، وبقيت تستخدم في بعض خطوط النقل العام. كان الأمر يشبه الصدمة في البداية بالنسبة للركاب الذين يشاهدون تلك العبارات، لكن المشهد أصبح معتاداً لهم فيما بعد. ومع زيادة النقاط الثائرة، لم يعد لدى الشبيحة وعناصر الأمن وقت حتى لإزالة تلك الملصقات والكتابات.
حافلات النقل العام، التي أصبحت أحد منابر إطلاق شعارات الثورة، استخدمها النظام سلاحاً متعدد الاستعمالات ضد الثورة. يقول عضو رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية منتصر أبو زيد في حديثه مع الجمهورية.نت: «في المقام الأول، كانت تلك الحافلات تتولى نقل الشبيحة وعناصر الأمن من المقرات الأمنية الموجودة داخل الغوطة كفرع الأمن السياسي في دوما، أو من الأفرع الموجودة في العاصمة، بهدف قمع المظاهرات ضمن مدن وبلدات الغوطة. وهو الحال نفسه طبعاً في باقي المدن الثائرة».
يضيف أبو زيد، وهو أيضاً أحد المهجَّرين من بلدة العبَّادة في منطقة المرج في غوطة دمشق: «استخدمت الباصات الخضراء كذلك لتنفيذ المداهمات والاعتقالات. أتذكّر أنه، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2011، استهدف عناصر معارضون للنظام من بلدتي حاجزاً لجهاز أمن الدولة، فقام الأخير بمحاصرة البلدة بآليات من بينها عشرات الباصات الخضراء، وذلك في الثامن عشر من الشهر ذاته، ثم بدأ العناصر بمداهمة المنازل، واعتقلوا حينها حوالي 500 من أهالي البلدة، تم اقتيادهم بتلك الباصات إلى الأفرع الأمنية».
لا يقف الأمر عند حدود نقل العناصر والمعتقلين، بل يروي لنا ضياء الدين العربيني، مدير مركز الغوطة الإعلامي، أنه «في إحدى المظاهرات الكبيرة التي خرجت في بلدة عربين، توجه عناصر الأمن بالحافلات إلى نقطة التظاهر وحاصروا المتظاهرين من كل الجهات، إلى درجة لم يعد لديهم مجال للفرار. وقتها قام أحد سائقي الحافلات، قيلَ وقتها إنه عنصر من المخابرات الجوية، بدهس المتظاهرين، ما تسبّب بمقتل شاب من آل الشقيران وإصابة آخرين بجروح بليغة».
بعد مداهمة المظاهرات أو الأحياء، كان عناصر الأمن والشبيحة يقومون بتكديس المعتقلين داخل الحافلات، ليبدو مثل مشهد رعب بالنسبة لمن يسيرون في الطريق: شباب وشابات، أيديهم مقيّدة الى الخلف، ورؤوسهم منخفضة، وهراوات تنهال على الرؤوس والأجساد بالضرب المبرح، لتتحول الباصات الخضراء إلى غرفة تعذيب مؤقتة إلى حين الوصول إلى مراكز الاعتقال.
كذلك استخدم النظام الباصات الخضراء في جلب المؤيدين إلى الساحات للقيام بمسيرات ورفع لافتات وصور تدعم الأسد، وفي نقل أشخاص إلى مناطق شهدت مظاهرات، بهدف الترويج عبر مقابلات إعلامية مفتعلة معهم إلى أنّ الحياة طبيعية وليس هناك مظاهرات. وفي سنوات لاحقة، مع استعادة النظام السيطرة على مناطق عقب تهجير أهلها، كان يستخدم الحافلات الخضراء لجلب أشخاص مؤيِّدين إلى المناطق التي استعادها، بحيث يدّعون عبر وسائل إعلامه أنهم من أهل المنطقة وعادوا اليها، ويشكرون «الجيش» على إعادة الأمان الى مناطقهم، كما حصل في كل من داريا وحلب والغوطة الشرقية وغيرها.
يقول معتز الحو، وهو من مهجَّري داريا: «زعم النظام في آب (أغسطس) 2018 أن خمسة آلاف من أهالي داريا عادوا إلى ديارهم، وقام بتصوير مجموعة من المدنيين الذين تجمعوا في ساحة الزيتونة وسط المدينة على أساس أنهم يحتفلون بالرجوع إلى منطقتهم، لكنّه في الحقيقة كان قد استقدم بالباصات الخضراء مجموعة من مؤيِّديه، بعضهم فقط من أهالي المدينة فعلاً». وأضاف الحو للجمهورية.نت: «سمحت الأجهزة الأمنية في ذلك اليوم لبعض الأهالي بتفقد بيوتهم فقط، ومن ثم أمرتهم بالخروج من المدينة مع حلول الساعة الخامسة عصراً. وقد تكرر هذا المشهد أكثر من مرة في داريا، إلى أن سمح النظام في عام 2020 لجزء من السكان بالعودة لبيوتهم».
الركوب بحافلة خضراء أو احتمال الموت
شهد يوم الثالث والعشرين من أيار (مايو) 2014 تحولاً جديداً في عمل الحافلات الخضراء، عندما استخدمها النظام للمرة الأولى في تهجير السكان والمقاتلين المحاصرين من أحياء حمص القديمة إلى ريف حمص الشمالي، بعدما فرض عليهم اتفاق تهجير برعاية الأمم المتحدة. منذ ذلك الوقت، تمّ اعتماد تلك الحافلات كراعٍ رسمي لجميع عمليات التهجير التي حدثت لاحقاً، وبقيت رمزاً لهذا التهجير حتى عندما استخدمت أنواع أخرى من الحافلات فيه.
يقول محمد الخطيب من مهجري حمص القديمة: «الحافلات الخضراء باتت دلالة على تغيير هوية سوريا وحاضرها ومستقبلها، ودلالة على وضع جزء من السوريين بين خيارين، إما أن تترك أرضك ووطنك وتصعد على متن حافلة خضراء، أو أن تكون جثة هامدة». يوضّح الخطيب أن «الصعود في الباصات الخضراء كان مشهداً مؤلماً للغاية، خاصةً أن حمص القديمة كانت أول منطقة سورية تتعرّض للتهجير. كان شعوراً قاسياً أن تصبح الباصات التي كنا نفرح بالصعود فيها لحداثتها ورخص أجرتها مصدراً للألم والغربة، وتكون تكلفة الركوب بها باهظة للغاية، التخلي عن أرضنا وبيوتنا وذكرياتنا».
عادت الباصات الخضراء للظهور للمرة الثانية في كانون الأول 2015، حيث استُخدمت لتهجير السكان والمقاتلين من حي الوعر في حمص إلى ريف إدلب، ومن ثم جاء العام 2016 الذي سُميّ «عام التهجير»، والذي بدأ بإخلاء داريا في آب 2016، ومن ثم جاء الدور على المعضمية والتل وقدسيا والهامة وخان الشيح في ريف دمشق.
في نهاية العام 2016، قام النظام بإخراج الأهالي والمقاتلين من أحياء حلب الشرقية إلى ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب بالباصات الخضراء، التي باتت جزءاً من الحرب النفسية التي يستخدمها الأسد عبر وسائل الإعلام الموالية له، إذ ظهر مراسل قناة العالم الإيرانية، حسين مرتضى، قُبَيل سيطرة النظام على أحياء حلب الشرقية، وهو يقود إحدى الحافلات الخضراء في حيّ الشيخ سعيد جنوبي شرق حلب، كمحاولة لبث الرعب والهلع في نفوس الأهالي والمقاتلين.
عقب تهجير أهالي حلب في نهاية 2016، تراجع استخدام الباصات الخضر في عمليات التهجير بشكل كبير، واعتمد الأسد على حافلات السفر التابعة لشركات نقل خاصة (البولمان). يعود ذلك إلى عدة أسباب، تحدّث عنها الصحفي غياث الذهبي، من مهجري كفربطنا في غوطة دمشق: «فضّل النظام استخدام البولمانات بشكل أكبر، خاصةً في الغوطة الشرقية، لأن أعداد الباصات الخضراء التي كانت متوفرة لا تكفي لنقل كامل المهجّرين، حيث كانت نسبتها 20 بالمئة فقط، بينما 80 بالمئة من الحافلات التي شاركت في تهجير الغوطة كانت تتبع لشركات خاصة».
وأشار الذهبي، الذي كان ناشطاً ميدانياً خلال حصار الغوطة، إلى أنّ «الحافلات الخضراء ذات جودة رديئة وتتعرّض للأعطال في المسافات الطويلة، خاصةً بالنسبة لرحلات التهجير بين دمشق وإدلب التي تصل إلى 400 كيلومتر، على عكس رحلة التهجير التي حصلت من حلب إلى إدلب، والتي لا تتجاوز 100 كيلومتر. إضافةً إلى أن الباصات الخضراء لا تتسع لعدد كبير من الركاب، وغير مجهّزة للسفر الطويل».
كذلك لم يكن النظام يرغب في تحمّل خسائر اقتصادية جديدة نتيجة تضرّر حافلاته خلال عمليات التهجير، سواء بسبب الأعطال الفنية أو الاعتداء عليها، حيث يعمد بعض الموالين لقذف الحجارة على زجاج الحافلات كنوع من الانتقام من المهجّرين، أو قد تتعرّض لاعتداءات من قبل بعض الفصائل، كما حصل حين قام عناصر فصيل جند الأقصى بإحراق 20 حافلة خضراء نهاية 2016، قبيل دخولها لنقل سكان ومقاتلين من كفريا والفوعة في ريف إدلب.

من يقود باصات التهجير؟
في تموز 2018، بثّ ناشطون مقطع فيديو يُظهر قيام حافلة مخصصة لنقل المهجَّرين من القنيطرة بدهس مدنيين كانوا يستعدون للصعود إليها، ما تسبّب بمقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.
وما إن انتشر الفيديو حتى بدأت الاتهامات والشتائم تطال السائق، حيث اتهمه البعض أنه قام بعملية الدهس عمداً بأمر من النظام، بينما اعتبر آخرون أن ما حصل خطأ غير مقصود، وهو ما يدفع إلى التساؤل: من يقود الباصات الخضراء التي كانت تقوم بعمليات التهجير أو نقل الشبيحة واعتقال المتظاهرين؟
في بدايات الحراك الثوري جنّد النظام كثيراً من حافلات النقل الداخلي العامة لخدمة الأجهزة الأمنية، وكان يقودها سائقون يعملون في المرآب التابع لفرع المخابرات، كون الحافلة الخضراء كبيرة ولا يستطيع أي عنصر أمن قيادتها. وفي بعض الأحيان، كان يتم الاعتماد على سائقين يعملون لدى مديرية النقل الداخلي، بعد التحرّي الأمني عنهم بشكل جيد، تحسُّباً من قيام السائق بأي عمل يضرّ الأجهزة الأمنية. ثم لاحقاً مع بدء تنفيذ اتفاقيات التهجير، اعتمد الأسد كلّياً على سائقين يعملون لدى الدوائر الحكومية، وذلك خشية تعرُّض عناصره للاحتجاز أو الهجوم في حال دخلوا مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وذلك حسب ما نقل لنا الموظف في وزارة النقل الذي تحدثنا معه.
في بعض اتفاقيات التهجير الكبيرة، كما في الغوطة الشرقية، لم تكن الباصات الخضراء تكفي لنقل المهجّرين كما قلنا، لذا كانت تقوم دوريات المرور التابعة للنظام بإيقاف الحافلات الخاصة على الأوتوستراد الدولي، وتقوم بإنزال الركاب منها، أو تسحب أوراق الحافلة من السائق وتمنحه وثيقة للمراجعة الفورية بعد إيصال المسافرين الذين معه، لإجباره على نقل المهجَّرين لاحقاً.
يحكي لنا منتصر أبو زيد، من مهجَّري المرج: «كان سائقو حافلات التهجير أشخاصاً مدنيين، ولا علاقة لهم بالأجهزة الأمنية، فالنظام لم يكن بحاجة لإرسال سائقين أو مخبرين ضمن الباصات الخضراء، طالما أن اتفاق التهجير تم توقيعه وكل شيء قد انتهى. لكن من باب الحرص، كان يتم أخذ أوراق السائق الثبوتية قبل دخوله إلى المناطق التي سيتم التهجير إليها. عند وصول إحدى حافلات التهجير، ترجّل منها السائق الذي بدت عليه علامات الخوف والدهشة، خاصةً بعدما شاهد حجم الدمار. اقتربتُ مسرعاً للحديث معه، فالحصار الذي عشناه على مدار ست سنوات جعلنا متلهِّفين للحديث مع أي شخص غريب، وكأنه قادم من المريخ. كان لطيفاً للغاية وأبدى تعاطفه معنا، واستغرب كيف كنا نعيش طوال تلك السنوات في هذا المكان».
يضيف أبو زيد: «ريثما ننتهي من وضع أمتعتنا في الحافلة، جلس السائق أبو حسين (اسم مستعار) بعد أن أخرج نرجيلته، وطلب منا بعضاً من الماء لتشغيل النرجيلة. أخبرناه أن بإمكانه الحصول على الماء عبر الكبّاس اليدوي. اندهش من ذلك في البداية، لكن سرعان ما أعجبته تجربة إخراج الماء من البئر بتلك الطريقة، بعدما وجد فيها شيئاً جديداً لم يعتد عليه من قبل. حين بدأ أبو حسين بشرب النرجيلة وكوب الشاي الذي قدمناه له، تفاجأ من مذاق الماء، وكيف كنا طوال فترة الحصار نشرب من هذا الماء الكلسي الممزوج بالوحل. حين انتهينا من وضع الأمتعة، صعد الجميع إلى الحافلة. جلست إلى جانب أبو حسين لأتبادل معه أطراف الحديث. أخبرني أنه من المنطقة الشرقية ويعمل سائقاً لدى إحدى شركات النقل الخاصة، وأن دورية للنظام أوقفته على الطريق وأنزلت جميع ركاب حافلته كما حصل مع باقي السائقين، وأجبرته على التوجه معها، دون أن تخبره عن الوجهة التي تقتاده اليها، ليتفاجأ أخيراً أنه أصبح داخل الغوطة».
يتابع أبو زيد حديثه عن تلك الرحلة قائلاً: «قبل الانطلاق أعطانا أبو حسين بعض النصائح، فأخبرنا بضرورة أن تجلس النساء والأطفال في الخلف كي لا يتعرضوا للمضايقات من الأجهزة الأمنية، وأن نخفي كل الأشياء الثمينة، وألا نعطي أسماءنا الحقيقية ولا حتى هوياتنا الشخصية عند الحواجز. شعرنا جميعاً بالرعب ونحن داخل الحافلة، فكنا نخشى أن تقوم حواجز النظام على الطريق بقتلنا أو اعتقالنا، وعندما يوقفنا حاجز كنا نرتجف من شدة الخوف، ولا سيما أن حافلتنا تعطّلت على الطريق وابتعدنا عن موكب حافلات التهجير قرب طرطوس. كان أبو حسين يحاول طمأنتنا ورفع معنوياتنا، ويتجاوب مع كل شيء نطلبه منه منذ البداية إلى النهاية، إذ وافق عند قدومه على الدخول إلى الأزقة الضيقة والمدمرة في الغوطة كي لا نضطر لحمل أمتعتنا لمسافات طويلة، وخلال كان يحرص على أن يوفّر لنا أسباب الراحة من تشغيل المكيِّف والموسيقى وغيرها من الأمور».
يختم أبو زيد حديثه قائلاً: «كان أبو حسين شديد الصراحة معي، حيث أخبرني أنّ ابنه الأكبر توفي تحت التعذيب في سجون الأسد، لكنه مضطر للإقامة في مناطق سيطرة النظام للحفاظ على عمله ومصدر رزقه. استمرت الرحلة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، تعرّض أبو حسين خلالها كباقي سائقي حافلات التهجير للمضايقات والشتائم من الحواجز الأمنية، التي كانت تتعمّد إيقاف الحافلات لفترات طويلة. عند وصولنا إلى الشمال السوري، طلبنا منه المبيت لدينا، لكنه أخبرنا أنه يريد العودة بسرعة كي لا يتأخر على عائلته، وتمنى لنا التوفيق في حياتنا والعودة إلى ديارنا».
وجه آخر للباص الأخضر في الغوطة
قُبَيل انسحاب قوات النظام من الغوطة الشرقية، تمكن مقاتلون معارضون من الاستيلاء على حافلات خضراء كان يستخدمها النظام في نقل جنوده إلى جبهات الغوطة، بلغ عددها حوالي عشرين حافلة تم الاستيلاء عليها خلال المعارك في دوما وعدرا عام 2013.
يقول الصحفي غياث الذهبي: «دخلت الحافلات الخضراء نطاق الخدمة في العام 2014، واستمر عملها إلى العام 2017، حين اشتد حينها القصف وأصبح استخدامها خطراً على حياة المدنيين. كانت الحافلات تعمل على عدة خطوط لنقل المدنيين والطلاب والموظفين بين مدن وبلدات الغوطة، وعملت مديرية النقل التابعة لمحافظة ريف دمشق الحرة على تقديم الدعم لتشغيل الباصات لفترة من الزمن».
ومن أبرز خطوط نقل الحافلات الخضراء التي عملت في الغوطة خلال فترة الحصار كان خط حمورية-النشابية، الذي كان يصل بين بلدات حمورية وسقبا وكفربطنا وجسرين والمحمدية وبيت نايم وأوتايا وحوش الصالحية والزريقية والنشابية. كما كان هناك خط لنقل الطلاب من قطاع الغوطة الأوسط إلى المعاهد المتوسطة في دوما. كذلك عملت الحافلات الخضراء على نقل المدنيين، ضمن خطوط: دوما-سقبا-المليحة، ودوما-عربين، ودوما-عين ترما، ودوما-المرج. كانت تلك الحافلات تعمل بشكل متقطّع، حسب الظروف الأمنية وتوفّر المحروقات، وتوقَّف بعضها نهائياً وبعضها استمر بالعمل لفترة، لكنها كانت حلاً جيداً لسكان الغوطة في ظل صعوبة التنقّل إلى بعض المناطق بالدراجات الهوائية أو سيراً على الأقدام مع ندرة المحروقات، خاصةً أن بعض الخطوط تعمل لمسافة 10 إلى 20 كيلومتراً.
استنزاف قطاع النقل لخدمة القمع
استخدم النظام حافلات النقل العام لخدمة أهدافه الأمنية والعسكرية، ما تسبّب في استنزاف قطاع النقل الداخلي بشكلٍ كبير، فخلال العامين الأوّلين للثورة السورية، خرجت 90% من الباصات الخضراء عن الخدمة، بحسب تصريح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي التابعة لحكومة النظام، الذي وعد بتأهيل 150 من الباصات المتضررة نهاية عام 2013.
ووفق إحصائيات وزارة الادارة المحلية في حكومة النظام، فإن أعداد باصات النقل الداخلي انخفضت من 928 عام 2011، إلى نحو 500 خلال عام 2014، بينما وصل إلى حوالي 350 حافلة عام 2015. وفي ظل هذا الواقع، عقدت حكومة النظام صفقة جديدة مع شركة صينية عام 2015، استوردت من خلالها 200 باص جديد للتشغيل.
الأعطال المتكررة التي تعرّضت لها الحافلات الخضراء دفعت الحكومة إلى تقديم شكوى للشركة المصنّعة لها، إلّا أن الشركة ردّت أن سبب ازدياد تضرّر الباصات في سوريا يعود إلى تعطّل علبة السرعة العادية أو ناقل الحركة («صحن الدبرياج») نتيجة قلة خبرة السائقين. كما أرجعت الشركة السبب إلى الازدحام الشديد والحمولة الزائدة في الباص. بحسب الاتفاق، فإن حمولة الباص هي 80 راكباً كحد أقصى، إلا أنه يتم تحميل الباص بأكثر من 120 راكباً، أي فوق قدرته بحوالي 50 بالمئة، إضافةً إلى أن الوقوف المتكرر في شوارع دمشق نتيجة الازدحام يؤدي إلى استهلاك صحن الدبرياج وبالتالي تعرُّض الحافلة للأعطال.
تعاني العاصمة دمشق من أزمة مواصلات مستمرة على مدار عقود من الزمن، ورغم تراجعها قليلاً مع دخول الحافلات الخضراء إلى العمل في العام 2008، إلا أن أزمة المواصلات عادت مجدداً وبشدة عقب اندلاع الثورة وتسخير معظم حافلات النقل الداخلي لخدمة الأجهزة الأمنية. يقول من تحدثنا معهم من سكّان دمشق إن أزمة المواصلات تضاعفت بين عامي 2016 و2018 مع تزايد اتفاقيات التهجير، وقد اعتقدوا عقب انتهاء هذه الاتفاقيات أن أزمة وسائل النقل ستنتهي، لكن لسوء الحظ بدأت أزمة المحروقات التي انعكست بشدة على قطاع النقل.
وهكذا فإن عودة الباصات الخضراء إلى مهمتها الأساسية لم تحلّ مشكلة الازدحام في المدن السورية الكبيرة، ويبدو أن كل مشاكل البلد تنتظر حلّها بعد زوال المسبِّب الرئيسي لها: النظام الذي استخدم كل مقدرات الدولة السورية في سبيل قمع الحراك الثوري، ومن أجل فرض سطوته بالسلاح والدم على جميع السوريين.