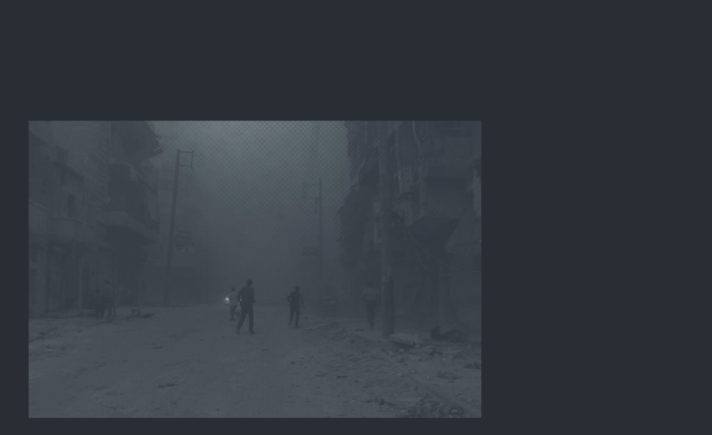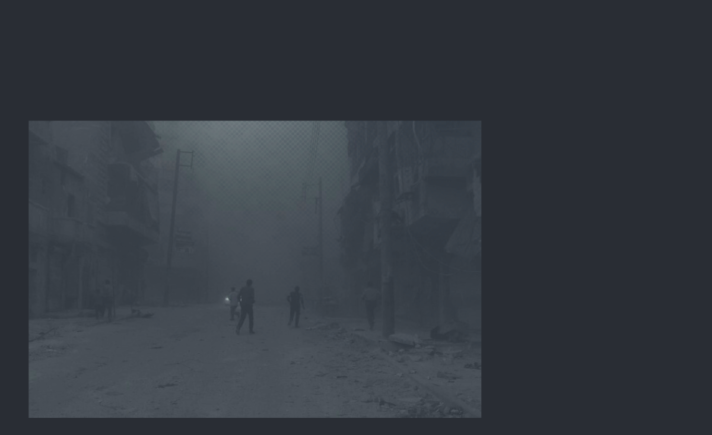في شهر نيسان (أبريل) الجاري، الشهر المحمّل بذكريات السارين والكلور بين ضربة خان شيخون في 2017 وضربة دوما في 2018، سيجتمع مؤتمر الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بهدف اتخاذ قرار حول عدم امتثال الحكومة السورية لقرارات المنظمة. قد ينتهي هذا الاجتماع بعودة سوريا في هذا الملفّ إلى ما قبل خطوط أوباما الحمراء.
بعد الضربة الكيميائية على غوطة دمشق، في 21 آب (أغسطس) 2013، كان العالم كله متيقظاً، وطبول الحرب ضد النظام السوري كانت تُقرع. عام كامل كان قد مرّ وأوباما يلوح فيه باستخدام القوة العسكرية، ويرسم الخطوط الحمراء ويهدد ويؤكد على سقوط شرعية الأسد كلما سُئل عن سوريا. كنتُ في الغوطة وقتها، وكنّا ككوادر طبية مُرهَقين بشكل كبير جداً، خاصة ونحن في عين الحدث: إعلام وصحافة ولجان دولية وتواصلات مع دبلوماسيين ووزارات خارجية. كُنّا بالكاد نتنفس. أذكر جيداً أني تواصلت مع عائلتي في دمشق وبدأت بإعطاءهم نصائح لتحضير المنزل لضربات عسكرية محتملة: «ضعوا لاصقاً على زجاج النوافذ… أبقوا الكثير من الشموع وبعض بيدونات مياه الشرب دائماً جاهزة… قد تنقطع الكهرباء والمياه لساعات طويل…. يجب أن تجهّزوا حقيبة إسعاف أوّلي ومعلبات ومواد غذائية جافّة».
كنا نشعر أن أمراً محتوماً ينتظر دمشق، أمراً لا نريده، وهو شرّ لا بد منه. كنا نريد أن يُقتلع هذا النظام بأي طريقة، لكن خلال أيام اتضحت معالم صفقة سياسية بين الأسد وأوباما بوساطة روسيّة. سكتت طبول الحرب، وبالتأكيد لا أحد يريد حرباً أخرى، لكن المقابل في الصفقة كان يقتصر على التخلص من سلاح الجريمة، وضمّ سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية دون أي عقاب. كان ذلك ضوءاً أخضر للمزيد من الضربات، وكنّا ضحية مرتين، مرة لكيماوي الأسد ومرة لخطوط أوباما الحمراء.
الكيماوي وقصف المشافي
في الرابع من نيسان من عام 2017، اختتمت قوات النظام سلسلة من الهجمات الكيميائية على منطقة ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بضربة سارين على بلدة خان شيخون، راح ضحيتها ما يفوق 90 شخصاً مع أكثر من 500 مصاب. كانت هذه الهجمات قد بدأت قبل بضعة أيام، في الخامس والعشرين من آذار (مارس)، بضربة على مشفى اللطامنة راح ضحيتها الدكتور علي درويش أثناء عمله في غرفة العمليات.
في الثاني من نيسان، قبل مجزرة خان شيخون بيومين، قصفت قوات النظام مشفى المعرة الوطني بشراسة حتى أخرجتها عن الخدمة، رغم ضخامتها وقوة بنائها. معرة النعمان كانت نقطة الإخلاء الأولى للمجزرة القادمة بعد يومين في خان شيخون، فقام النظام على ما يبدو بتحييدهما عن الخدمة لكي يحقق أكبر حجم من الخسائر.
يحمل السوريون في ذاكرتهم عن الكيماوي صوراً لأكفان بيضاء، ولأطفال يختنقون، وأمهات تبكي، وتصريحات فارغة لسياسيين… وفي الخلفية دائماً مشفى، هذه المشفى دائماً ما تكون ضحية أيضاً؛ تُقصف، تُستنزَف، وتشعر بالعجز أمام هول الجريمة.
الضربات والسياق العسكري والعلاقة مع قصف المشافي
بعد عام تماماً، وفي السابع من نيسان 2018، قامت قوات النظام السوري بإلقاء عدة ذخائر محملة بإحدى مشتقات الكلور في محيط مشفى دوما، أو ما كانت تسميّه الكوادر الطبية «مشفى ريف دمشق التخصصي». كانت الكوادر الطبية قد عملت على تحصينات متطورة ومعقدة في منطقة المساكن في مدينة دوما، لبناء يبعد بضع كيلومترات عن موقع مشفى ريف دمشق التخصصي العام المعروف في وسط المدينة. ولمن يفوته السياق، في ذلك الوقت كانت منطقة الغوطة الشرقية وكبرى مدنها دوما ترزح تحت وطأة عملية عسكرية همجية، سُجِّل فيها ما يزيد عن 25 ضربة على المرافق الطبية، وما يقارب 9 ضربات بالسلاح الكيميائي خلال ثلاثة أشهر، كانت أكبرها تلك الضربة في السابع من نيسان، والتي نتج عنها 43 وفاة وما يزيد عن 500 إصابة.
إذا راقبنا نمط استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ضد التجمعات السكنية، فسنلاحظ غالباً أنه يترافق مع حملة عسكرية على المنطقة، وأن الضربات الكبيرة تسبقها سلسلة ضربات خفيفة قبلها، وأنه بكل تأكيد ومع كل تصعيد عسكري هناك استهداف للبنى التحتية والمرافق الخدمية، وأولها المشافي. يصح هذا بخاصة بعد التدخل العسكري الروسي في 2015، حين أصبح الهجوم على المرافق الصحية يتجاوز معاقبة المجتمعات الثائرة ليصبح تكتيكاً عسكرياً يهدف إلى شلّ المنظومة الطبية خلال أي هجوم عسكري.
الجهود الدولية
ثلاثة قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وأولها كان القرار 2118، القرار-الصفقة الذي صدر في نهاية أيلول (سبتمبر) 2013 بعد بضعة أسابيع من مجزرة الغوطة في 21 آب 2013، والذي يشرعن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول إنهاء التصعيد السياسي والإعلامي مقابل انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير الترسانة الكيميائية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وضمّ القرار، في البند رقم 21 منه، صياغة توحي باستخدام إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال حصلت تجاوزات في سوريا.
لم تتأخر التجاوزات كثيراً، فبعد بضعة أسابيع، وفي شهر تشرين الثاين (نوفمبر) من العام نفسه، شهد حي جوبر الدمشقي ضربة كيميائية. تتالت بعدها الضربات، وحملت بعضُها أعراضاً جديدة على المصابين، مثل الضربة على حرستا في آذار 2014، وكأنّ النظام كان يجرب وسائل أو تقنيات أخرى. لكن وبشكل واضح، أصبح الكلورين هو الغاز الأكثر استخداماً في هذه الهجمات، وشهد العام 2015 العدد الأكبر من هذه الضربات – حتى وصلت إلى 69 ضربة كيميائية خلاله لوحده. عملياً، لم يقدم القرار 2118 إلا تشجيعاً على المزيد من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، حتى أن ما يزيد عن 77% من الضربات حصلت بعد هذا القرار.
كان هناك حوار عبثي يجري في كل الأوساط حول ماهية الغاز المستخدم في هذه الضربات، وكنت أظن هذا الحوار محلي فقط، إذ كان يلي كل ضربة سؤال فيما إذا كانت الضربة بالسارين أو أحد أشقائه من مركبات الفوسفور العضوية، أو بالكلور. بشكل شخصي، فوجئت أن مجلس الأمن اتخذ دور مدرّس الكيمياء ليشرح للعالم أن الكلور هو غاز محرم دولياً، وأنه مشمول بالقرار 2118، وذلك من خلال إصدار القرار 2209 لعام 2015. حرفياً، لم يَحوِ القرار الجديد أي إضافة، أو أي تلويح بمسؤوليات أو محاسبة، بل اقتصر على تفسير الماء بالماء عندما قال إن الكلور يعتبر غازاً مُحرَّماً.
بعد خمسة أشهر، في آب 2015، أصدر مجلس الأمن القرار 2235، وأصبح لدينا أخيراً نتيجة هذا القرار آلية تحقيق مشتركة متخصصة بالتحقيقات حول استخدام السلاح الكيميائي ولديها صلاحية توجيه الاتهام. عامان من عمل هذه الآلية، أصدرت خلالهما سبعة تقارير حول عدة حوادث، وأشارت بشكل واضح إلى مسؤولية القوات الحكومية السورية، وبمنتهى التفصيل، مع تحديد القواعد العسكرية المسؤولة في أربع حوادث، وإلى مسؤولية داعش عن حادثة أخرى. كان هذا كفيلاً بأن تتدخّل روسيا، وتُنهي تفويض هذه الآلية باستخدام الفيتو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
مع بداية العام 2018، قرّرت فرنسا أن تفكر خارج الصندوق المسمى مجلس الأمن، وأعلنت مبادرة لشراكة دولية ضد الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية، انضمّت أكثر من ثلاثين دولة إلى مؤتمرها التأسيسي في باريس. وتدعو هذه الشراكة إلى تعزيز دور جهات التحقيق الموجودة، وإلى استخدام العقوبات ضد الجهات المتورطة باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
توازى ذلك مع جهود ضمن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاتخاذ قرارات وإجراءات ضد استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. استطاعت هذه الجهود إخراج المنظمة من دورها التقني البحت في الملف السوري، في تقصّي الحقائق حول استخدام السلاح الكيميائي وتحديد نوع الغاز، إلى دور أكبر يشمل توجيه أصابع الاتهام وتحديد الفاعلين، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المنظمة. وهكذا تم إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) ضمن المنظمة، والذي أصدر تقريره الأول في نيسان 2020 ومحمّلاً القوات الحكومية السورية مسؤولية ثلاث ضربات كيميائية وقعت في ريف حماه الشمالي في آذار 2017.
إضافة إلى ذلك، في تموز (يوليو) 2020، وبناء على نتائج التقرير الذي أعده فريق التحقيق وتحديد الهوية، تبنى المجلس التنفيذي للمنظمة قراراً يعطي سوريا مدة 100 يوم للتعاون في مشاركة كافة المعلومات حول أي نشاط يتعلق بالأسلحة الكيميائية، بما فيه معلومات عن المخزون والاستخدام والنقل وأي أنشطة أخرى. بعد انقضاء مهلة المائة يوم، قام رئيس المنظمة بتقديم تقريره حول عدم تعاون الجانب السوري، وننتظر اليوم قرار مؤتمر الدول الأعضاء حول هذه الخروقات.
عدا ذلك، تم تقديم جهود لدعم الفرق الطبية وفرق الإنقاذ بمعدات وأدوات للتشخيص والعلاج، عدا عن دعم تقني وتدريبات على جمع العينات. كان قد سبق ذلك استجابة واسعة من قبل المنظمات الإنسانية عام 2013 بعد ضربة الغوطة، وتدريبات لفِرَقِها وتجهيز للمرافق بمُعدّات لإزالة التلوث والاستجابة ونقل العيّنات الحيوية.
لجان التحقيق
حققت في الحوادث الكيميائية، منذ بداية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في العام 2012 حتى اليوم، خمس جهات:
1- لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا (COI) التي شكّلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد أصدرت هذه اللجنة، في مطلع العام 2018، خريطة إنفوغرافية حددت فيها مسؤولية الحكومة السورية عن 22 من الهجمات.
2- لجنة التحقيق الأممية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص في العام 2013 للتحقيق في الحوادث الكيميائية، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً مفصلاً حول هجمة 21 آب 2013 دون توجيه أصابع الاتهام لأي جهة.
3- بعثة تقصي الحقائق (FFM) التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2014، وقد قامت بالتحقيق في العديد من الحوادث، وأصدرت حتى الآن 24 تقريراً. ولا تملك هذه اللجنة صلاحية توجيه الاتهام لأي جهة، بل يقتصر دورها على التحقّق من وقوع الهجمات وتحديد نوع الغاز المستخدم.
4- آلية التحقيق المشتركة التي شكلها مجلس الأمن الدولي في آب 2015 من خلال القرار 2235، والتي أصدرت خلال عامين سبعة تقارير، شملت توجيه الاتهام بشكل واضح للقوات الحكومية السورية في عدة حوادث، إحداها مذبحة خان شيخون، وفي حادثة واحدة ضد داعش. في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد التجديد لهذه الآلية.
5- فريق التحقيق و تحديد الهوية الذي شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليعمل بالتوازي مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لها، ومنحته تفويضاً بتوجيه الاتهام. وقد أصدر الفريق حتى الآن تقريراً واحداً فقط في نيسان 2020، يحدد مسؤولية النظام السوري عن ثلاث ضربات كيميائية في ريف حماة الشمالي في 2017.
الجهود غير الحكومية
في تشرين الأول 2020، وبعد سبع سنوات من ضربة الغوطة في آب 2013 وثلاث سنوات من ضربة خان شيخون في نيسان 2017، تمكنّت ثلاث منظمات غير حكومية، هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، وبالنيابة عن مجموعة من الضحايا، من تقديم شكوى للمدعي العام الفدرالي في ألمانيا حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. ثم أعادت المنظمات الكرّة في فرنسا بعد خمسة أشهر عبر شكوى أخرى للمدعي العام الفرنسي، شملت تحقيقات كاملة: شهادات الشهود، وأدلة بصرية من صور وفيديوهات، وسلسلة قيادة ورُتَب مع أسماء المتهمين، والأجهزة الأمنية والعسكرية المنخرطة في تطوير الترسانة الكيميائية وتنفيذ الضربات، مع مطابقة مع تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد اضطُرت هذه المنظمات لبناء هذه القضايا نتيجة عدم وجود أي آلية فعالة في إدانة مرتكبي الجرائم تُكمل ما تبدأه التحقيقات كل مرة من توجيه اتهام. ورغم أن ما نتحدث عنه ما يزال عبارة عن شكوى تطالب المدعي العام بفتح تحقيق، وهو ما تمّ بالفعل في ألمانيا، إلا أن هذه خطوة مهمة وغير مسبوقة.
أُتيح لي عندما كنت أعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن أطّلع على بعض الجهود في إعداد القضية، وأن أطّلع أكثر على النقاش الدائر بين المؤسسات الحقوقية حول ما يمكن للدول أن تفعله. وتنوعت المقترحات على هذا الصعيد، من تشكيل محكمة أو آلية تقاض مشتركة بين عدة دول، أو إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية، أو إلى محكمة الجنايات الدولية. كان على المنظمات السورية وعلى مدار أعوام أن تقوم بدور كبير جداً، بِدءاً من توثيق الانتهاكات وتقديم المعلومات لأجهزة التحقيق الدولية بعد عدة خطوات تَحقُّق. كان عليها أن تكون عين حقوق الإنسان على الأرض، طالما أن الوكالات الأممية وأجهزة التحقيق قلّما تستطيع الوصول إلى مواقع الجرائم. كان عليها أن تطوّر أساليبها وأدواتها وتقنياتها وآلياتها للتكيُّف مع الواقع الأمني الصعب جداً، وفي النهاية كان عليها أن تحلّل القوانين والمعاهدات الدولية والإجراءات التنفيذية لتبحث عن مسار قد يؤدي إلى إدانة الجناة. عدا ذلك، فقد وجد مقدمو الخدمات الإنسانية، وخاصة كوادر الإنقاذ والمؤسسات الطبية، أن دورهم يتجاوز دور الشاهد، فاضطروا لأخذ دور واسع في عمليات التوثيق وجمع العينات.
في عام 2018، وفي إحدى التدريبات على عملية جمع العينات، كنا ننقسم إلى فِرَق لنقوم بتدريب عملي تجري فيه مُماثَلة لظروف القصف بالغاز، وبأنواع غاز مختلفة تنبه مُشْعِرات معينة بحيث نتدرب على أجهزة الكشف. وجزء مهم من التدريب كان ارتداء معدات الحماية، ومن ثم إزالة التلوث من اللباس وخلعه دون تلويث المنطقة النظيفة نهائياً. كان في فريقي طبيب جراح، وصيدليان، وأنا طبيب أسنان، وذلك في نهاية العام 2018، أي بعد أكثر من خمس سنوات على ضربة الغوطة الكبرى. القناع يحدّ من حركتك وقدرتك على التنفس براحة، وحتى من قدرتك على الرؤية بشكل جيد، وقد كنت أراقب عيون الزملاء أثناء ذلك: أين نحن؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا نفعل ذلك؟ لماذا علينا نحن مجموعة الكوادر الطبية أن نتدرب على جمع العينات؟ هل حقاً هذا مكاننا؟ هل حقاً كان علينا أن نفقد الطبيب علي درويش في ضربة كيميائية؟ أليس من الأفضل أن نكون اليوم ضمن فرق تبني النظام الصحي في سوريا؟ هل حقاً نفذت الحلول ليقوم مجموعة من الأطباء بالتدرب على جمع العينات، و يقوم مجموعة من الحقوقيين بالبحث عن سبل قانونية لمعاقبة الجناة على جريمة ثبتت مسؤوليتهم عنها مراراً وتكراراً من قبل عدة جهات؟ هل كان علينا أن نفعل ذلك لولا خطوط أوباما الحمراء؟
بروباغندا النظام وحلفائه
منذ العام 2012، عَمِد النظام في رد فعله المباشر على تحمليه مسؤولية جرائمه الكيماوية إلى طريقتين: الأولى هي تكذيب الحادثة بشكل مطلق واتهام المعارضة أو منظمات إنسانية بالفبركة والتلفيق – ومن ينسى في هذا السياق تصريحات مستشارة الأسد الإعلامية بثينة شعبان حول اختطاف أطفال من منطقة أخرى لتمثيل مجزرة الغوطة؟ – والطريقة الثانية هي اتهام أطراف أخرى بتنفيذ الجريمة، إما مجموعات عسكرية أو منظمات تعمل لحساب دول أخرى. وكان يتم تحشيد جهود كبيرة من قبل النظام وآلته الإعلامية لذلك، ثم لاحقاً تولت الحكومة الروسية موقعاً قيادياً وكبيراً في هذه المهمة.
كانت ضربة دوما 2018 لحظة فارقة في عمل آلة البروباغندا الروسية على هذا الصعيد، إذ دفعتها إلى تكوين مجموعة تستغل بضعة كوادر طبية وإنسانية بهدف ترهيب الشهود، يرأسها الجنرال الروسي زورين بِنفس، وهو أحد الشخصيات القيادية في عمليات التفاوض على الاتفاقات المحلية في سوريا. وعملت آلة البروباغندا الروسية على عدة محاور، أهمها:
1- ترهيب الشهود: تتم عملية الترهيب بشكل أساسي من خلال اتصالات هاتفية، تُجريها كوادر تم تجنيدها لتقوم بهذه الاتصالات دون أي صفة رسمية، يتم فيها تهديد الشهود بسلامة أقاربهم الموجودين في مناطق سيطرة النظام السوري.
2- ضرب مصداقية لجان التحقيق: وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما اضطر المنظمة إلى فتح تحقيق حول هذه المسألة، وإصدار تقرير مفصّل حول الاتهامات الموجهة لها.
3- الضغط سياسياً على لجان التحقيق: هناك حادثة واضحة بهذا الشأن، وهي عُدول لجنة التحقيق الخاصة بسوريا عن تضمين استنتاجاتها حول ضربة دوما في تقريرها الدوري الصادر في تموز 2018. في اللحظة الأخيرة، قامت اللجنة بسحب عدة صفحات من الملف.
4- الزجّ بشهود زور أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: حيث استضافتهم البعثة الروسية في لاهاي، ونوّهت المنظمة وقتها إلى أنه على المحققين مقابلة الشهود قبل أن يتم زجّهم بهذه الطريقة، لكن الجانب الروسي أصرّ على طريقته، وبالتالي كان واضحاً أن الغرض من جلب شهود الزور هو التجييش الإعلامي.
العودة إلى ما قبل 2013؟
ترسم الهجمات الكيميائية في سوريا بوضوح العقلية الإجرامية التي يملكها النظام السوري، والتي وجدت في خطوط أوباما الحمراء الوهمية، وفي قرارات مجلس الأمن المعطِّلة، ضوءاً أخضر لمزيد من الضربات والمذابح: ضربة الغوطة 2013 بحجم ضحاياها المروّع؛ ثم مجموع الضربات في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بين 25 آذار و4 نيسان 2017، والتي بدأت بضربة مشفى اللطامنة وانتهت بضربة خان شيخون، وما تخلّلها من تدمير للمرافق الصحية التي استقبلت الإصابات وأصدرت التقارير الطبية وقدّمت الشهادات للجان التحقيق؛ ومن ثم مجموعة الضربات التي تخللت الحملة العسكرية على حلب، التي كان يُستخدم فيها السلاح الكيميائي في ضربات محدودة وضد أماكن معينة تستعصي على آلة التدمير، منها المشافي مثل ضربة مشفى M10 في بداية تشرين الأول 2016؛ وصولاً إلى ضربة دوما في نيسان 2018، التي تختصر المشهد بضرب مُحيط المشفى ومَداخله رغم أن الانتصار العسكري للنظام كان وشيكاً. لقد دفعت الشراهة للعنف نظام الأسد إلى ضربة كيميائية أخرى، لتنطلق بعدها آلة البروباغندا وترهيب الشهود والتشكيك في نتائج التحقيقات وضرب مصداقية جهات التحقيق، وصولاً إلى ممارسة الضغوط السياسية عليها لتكون أقل جرأة وأكثر تردّداً في توجيه الاتهام وتحديد المسؤولية.
بعد عدة أيام، سيجتمع مؤتمر الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليقرّر ما هي نتائج إصرار النظام على استخدام السلاح الكيماوي، ثم التملّص من المسؤولية بكل السبل والوسائل. قد يُفاجأ السوريون بقرار يجمّد عضوية سوريا في المنظمة، وهو ما سيُعيد ملف الكيماوي السوري إلى ما قبل خطوط أوباما الحمراء وقبل القرار 2118، حين لم تكن سوريا راغبة أصلاً بالانضمام إلى المنظمة لولا الصفقة الروسية-الأميركية، التي خلّصت أوباما من الإحراج بشأن تنفيذ خطوطه الحمراء. الحل الثاني قد يكون أن يقرر أعضاء المؤتمر إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ليفرضوا على روسيا لعبة تحبها جداً، هي استخدام الفيتو ضد أي قرار أو تحرك جدي في هذا الملف، بعد أن استخدمته سابقاً لمنع التحقيقات في السلاح الكيماوي، ويبدو واضحاً أنها لن تتوانى عن استخدامه مجدداً في مواجهة أي تحرك حقيقي ضد النظام السوري. وقد بادرت روسيا، ومن خلال ممثلها في مجلس الأمن، إلى استباق هذا الاجتماع، إذ رفضت مسبقاً مقترح القرار الفرنسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجميد عضوية سوريا، وهدّدت بوقف تعاون الحكومة السورية مع المنظمة بشكل كامل.
خلال ثمانية سنوات من مراقبة هذا المشهد، ومن الانخراط فيه والوصول إلى طريق مسدود كل مرة، وكشاهد على الضربات بشكل مباشر عندما كنت في سوريا قبل 2014، أو من خلال التواصل بعدها مع الشهود ولجان التحقيق، وانخراطي في عمليات التوثيق والاستجابة للسلاح الكيماوي، كان دائماً لدي أمل بأن تحركاً حقيقياً ما سيحصل في هذا الملف؛ تحركاً باتجاه مساءلة الأسد قانونياً، بما يتجاوز استعراض ترامب لقوته ببضعة صواريخ بعد ضربتي خان شيخون في 2017 ودوما في 2018. لكن يبدو أننا ما زلنا نحمل إرث خطوط أوباما الحمراء، كما يبدو أن الدول الغربية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – تتساوى في المسؤولية، على الأقل أخلاقياً، مع روسيا التي دعمت النظام بشكل مباشر، وذلك نتيجة موافقتها على الصفقة التي أُبرمت في منتصف أيلول 2013 في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا.
في إحدى جولات المناصرة، وبعد لقاء مع عدة مكاتب لأعضاء في الكونغرس الأميركي، توجه إلي متدرب وخرّيج علوم سياسية من إحدى الجامعات الأميركية لنتبادل الحديث أثناء مشينا خارجاً. كنّا وقتها نحاول دفع مجموعة الدول أصحاب النفوذ في الشأن السوري لاتخاذ تحرك جدي تجاه قصف المشافي في سوريا، وقال لي يومها: «لو كنت مكانَكم، سأجرب الضغط ضد استخدام السلاح الكيميائي. قليلة هي الدول التي لديها تورّط في استخدام السلاح الكيميائي، وهي عصا سيحب الجميع استخدامها، بينما كل الدول التي تحاولون دفعها لتحرك جدي ضد قصف المشافي متورطة في قصف المشافي في مكان ما، إن لم يكن في سوريا ففي أفغانستان أو اليمن أو العراق، أو غيرها».
اليوم، أستذكر كلامه وأشعر أن هذه الدول لا تريد أكثر من التلويح بالعصا، وأن أقصى ما تستطيع أو ترغب في فعله هو تجميد عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة بعد أن كانت قد أجبرت النظام على الانضمام سابقاً في 2013، فيما ستُترك الكوادر الطبية والمنظمات غير الحكومية الحقوقية والإنسانية لتستمر في محاولة تفتيت الصخر بأظافرها، ويواصل الشهود الشعور بأنهم يخاطرون بسلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم دون جدوى، طالما أن هذه الدول لا تستطيع شيئاً أبعد من تجميد عضوية النظام في منظمة دولية.