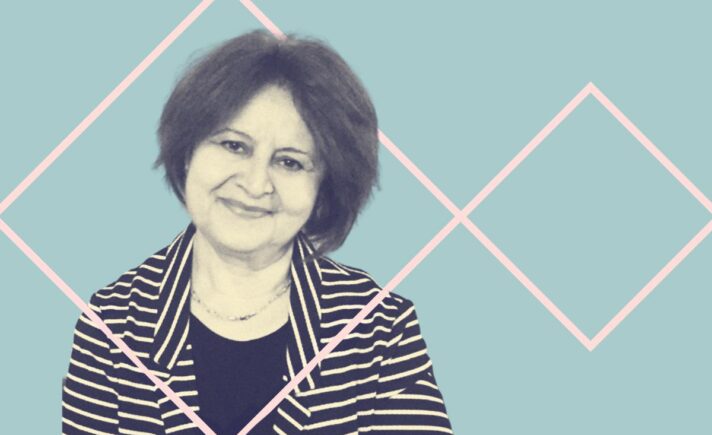أين كنت قبل 2011 يا غسان، وأين أودت بك دروب الثورة والحرب؟
كنت في دمشق منهمكاً بالمسرح والكتابة للتلفزيون. آخر مسرحية أخرجتُها للمسرح القومي كانت السهروردي، وهي عن شيخ الإشراق الصوفي شهاب الدين السهروردي، أستاذ ابن عربي، الذي حاول أن يفكر فقُتل صبراً، بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي وتحريض من مشايخ حلب، وقد ألقي في الجب الأحمر داخل قلعة حلب حتى مات من الجوع والعطش. وكان من المقرر أن تُعرض المسرحية في مهرجان حلب عاصمة الثقافة العربية سنة 2006، لكنها مُنعت من العرض في المهرجان، وتم توقيف عرضها في دمشق، لأنها تسيء للسلطان صلاح الدين الذي كان حافظ الأسد يعتبره رمزاً وقدوة. كما كنت أتوق للعودة إلى التدريس في المعهد، لكني مُنعتُ لأسباب أمنية، فتفرّغتُ لكتابة المسلسلات. وقد أنجزت ثلاثة مسلسلات ضخمة هي الحشاشون، وعمر المختار، وشجرة الدر، وكان آخرها البحث عن وليد مسعود للكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، وذلك بتكليف من المركز العربي في عمّان، لكن أياً من هذه المسلسلات لم ير النور حتى الآن.
عندما انفجرت المظاهرات في تونس ثم مصر، كنت واثقاً أن السوريين سوف يتحركون. وحينما عمّت المظاهرات السلمية جميع المحافظات السورية، قلت لزوجتي: لقد انتصرنا! ومع كل ما حدث بعدها من جرائم وخيبات، ما زلت مصراً على أن السوريين اخترقوا جدار الصمت ودمروه إلى الأبد. شاركتُ بالمظاهرات، وتوقفت عن كتابة المسلسلات وإخراج المسرحيات، وتمت دعوتي للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد المنع الوقح، فرفضت أنا هذه المرة، ودُعيت للمشاركة بأكثر من برنامج في التلفزيون السوري فامتنعت، وأصبح النظام بالنسبة لي ساقطاً وغير معترَف به. وهو كذلك حتى الآن.
حافظت بعد خروجك من المعتقل على وتيرة عالية من النشاط في مجال المسرح والكتابة والشعر. ما الذي يغلي في داخلك حتى خرجتْ كل هذه المواهب والفنون؟ هل لهذا علاقة بمقاومة الظلم، أم أنها موهبة ارتبطت بالتاريخ الذي حصل معك؟
في الحقيقة أنا بالأساس لست كاتباً. طفولتي كانت مسرحاً، وشبابي كان مسرحاً، ودرستُ المسرح. ولكن الله يكثّر خير المعتقل، فهو الذي جعلني كاتباً، هو الذي شكّل في داخلي ذاكرة تختلف عن ذاكرة الحياة. وطبعاً، نحن كنا آلاف المعتقلين، ولكل معتقل قصة وروايته الخاصة به. هذا ربما ما جعلني أشعر بمسؤولية أن أتكلم باسم الجميع؛ أن يتحقق الهدف الذي انحبس من أجله الناس: الحرية! لم أكن قادراً أن أقعد، أو أكتفي بالقراءة، أو أكتئب مثلما حصل مع البعض، أو أنكسر. ما قدرت أنكسر. الأمر أشبه بتلميذ يجب أن يكتب وظيفته قبل أن ينام، أردت أن أقول قبل أن أنام إني إنسان، أقول ذلك باسم جميع الذين كافحوا الظلم والعبودية من أجل الحرية، أن أكون صوتهم، وبخاصة أني أمتلك الأدوات. وبما أني مخرج مسرحي، فيمكنني أن أعبّر عن طريق المسرح. كتبتُ داخل السجن مجموعة هائلة من الأشعار والقصص والمسرحيات التي كان من واجبي أن أنشرها بعد خروجي. كنت قد كتبتها على أوراق السجائر، واخترعنا مليون طريقة حتى تمكّنّا من تهريب الأشياء التي كتبناها. ينبغي ألا تبقى هذه الكتابات ضمن الأدراج، وبخاصة أنه كان هناك محيط يدفعني باتجاه النشر. يمكنكِ أن تقولي إنه واجبنا الذي قمنا به.
هل أخرج من السجن وأصمت؟ ماذا يعني ذلك؟ هل أخرج من المعتقل وأصير مع النظام مثلاً؟ ماذا يعني ذلك؟ هل أُجَنّ؟ أجملنا فقدوا توازنهم النفسي وأصيبوا بأمراض وانتحروا، نعرفهم بالأسماء. كم كانوا راقين! كم كانوا إنساناً بالحرف الكبير! أرقُّنا على الإطلاق وأكثرنا حساسية حصل ذلك معه. لذلك أشعر أني ما زلت مقصراً. ثمة أشياء كثيرة لم أقلها بعد. هناك دائماً دافع الكتابة.
ولكن للأسف، لا توجد رواية أو كتاب طُبع لي في سوريا. طبعت لي وزارة الثقافة أصابع الموز والوحل ومجموعة اسمها ثلاث مسرحيات. ولكنهم طلبوا مني أن أحذف المكان: أنت لم تكتب في تدمر، أنت كتبتها في الشانزليزيه، وهذه لم تكتبها في فرع التحقيق الفلاني، وإنما لا أدري في أي مطعم أو مقهى. طلبوا مني أن أحذف الأماكن ليبدو الأمر كما لو أني أتكلم عن كوكب آخر. اعتباراً من قهوة الجنرال لم يُطبع لي أي عمل في سوريا، والذي طُبع لي بقي في المستودعات. حتى إنهم لم يوزعوها على المراكز الثقافية، كما لو أنها مُصادَرة. وهذا حصل مع غيري، ومع كل الشباب الذين كتبوا ولديهم تجربة ضد الاستبداد.
أما بالنسبة للعروض المسرحية، فلم يُصوَّر أي منها للتلفزيون، ولا لمجرّد أرشفتها. يا أخي صوّرها وضعْها في الأرشيف كي نقول أن ثمة مخرجاً مسرحياً عاش في عام ألف وتسعمائة وخشبة وأخرج هذه المسرحية! صوّرها فقط للأرشيف، أنا لا أُطالب بعرضها. هذا ناهيكِ عن المعاناة قبل أن نصل إلى مرحلة العرض: هذا مسموح، وهذا ممنوع، وتآمُر، وسرقة ديكورات. ينبغي أن تكون نظيفاً في مكان وسخ، لا يمكن إلا أن تتلطخ بالأوساخ. مسيرتنا كانت صعبة جداً رغم الإنتاج الغزير، الذي كان سببه ذلك الدافع الكبير الذي اسمه الدفاع عن الحرية. ينبغي أن ندافع كل يوم عن الحرية.
طرحتَ في رواية قمل العانة موقفاً سلبياً من الكتّاب العرب على لسان البطلة، مشيراً أنهم غير قادرين أن يكتبوا شيئاً مفيداً. وبالتالي فهي لا تقرأ للكتاب العرب، وإنما فقط الأدب المترجم. هذه الفكرة خطيرة بتعميمها. هل هذا هو رأي الكاتب أيضاً؟
الحق ليس على الكتّاب العرب، وواضح في الرواية أنهم مقموعون وغير قادرين أن يكونوا شهوداً على عصرهم. بالتأكيد هناك كتّاب حاولوا، ولكني أقول بصراحة أن من بين كل الرموز الموجودة عندنا، كان الجميع مهادناً للنظام. لم يدخل منهم السجون إلا القليل، ولم ينتحر منهم أحد كما حصل في بلدان أخرى.
هذا الموضوع طويل وعريض، ولكن اسمحي لي أن أتطرق لرمز مثل سعد الله ونوس. درس ونّوس في مصر، ورجع بعدها ليستلم بعد سنة أو سنتين مواقع مهمة من قبيل رئاسة مهرجان المسرح الأول في سوريا. وتم إرساله بعدها إلى فرنسا، وبعد عودته بدأ يكتب وينشر. كل شيء كتبه ونوس تم نشره في البعث والثورة والمعرفة والصحف الرسمية، وهو في الوقت نفسه معارض. نحن نعلم أنه معارض. أنا لا أتناوله كشخص على الإطلاق، فهو رمز من رموز الثقافة وأضعه على رأسي من فوق. ولكن لدينا دائماً هذان القطبان: أنت جزء من النظام وضد النظام. ممدوح عدوان مع النظام وضد النظام. الحق في ذلك يقع على الاستبداد.
أنا أيضاً من الناس الذين زوّروا أنفسهم في فترة من الفترات حتى أقدم مسرحية الشقيقة. كُتبتْ مسرحية الشقيقة عن سجن تدمر، عن رفاقي، عن العذابات التي تعذبناها داخل السجن. كنت مضطراً حين طلب المسرح الوطني الفلسطيني تقديم تلك المسرحية. قالوا لي اعملها عن فلسطيني، وليس عن سوري، وحينها سوف تقبلها الرقابة. أنا وافقت، وهذه خيانة من قِبَلي؛ خيانة لقضيتي، خيانة لمشروع الحرية الذي ننادي به. لذلك لا أقدر أن أعمِّم. لا أعرف إن كنت قد عمّمت في روايتي. ولكني أحترم الكتّاب العرب الذين دخلوا السجون، والذين تهمّشوا وبقيت مخطوطاتهم في الأدراج، أو الذين سُمِح بطبع أعمالهم عن طريق وزارة الثقافة، ولكنها وُضِعت في المستودعات ولم توزَّع.
لقد قدّم النظام مثقّفيه. نحن لا نَقدِر بعد الذي حصل في سوريا أن نقول «معليش»، ونشير إلى الظروف. برأيي ادخل السجن من أجل رأيك! معليش، ضحّي من أجل الهدف الكبير! أنت في جميع الأحوال تضحّي بنفسك وعائلتك. يا أخي ضحّي على الأقل بأن ترفع صوتك ضد الاستبداد والظلم والتخلف والمصادرة للثقافة الوطنية. ربما أكون متطرفاً في هذا الرأي، ولكني أعرف أني دفعت الثمن. لا أقول أن الآخرين يجب أن يفعلوا مثلي، لكل إنسان ظروفه طبعاً. عدد كبير من الكتاب اختاروا أن يهربوا من البلد، وعدد كبير من الكتاب هادنوا النظام ونشروا واشتغلوا سينما ومسرحاً تحت رقابته. ولكنها كانت في واقع الأمر فنوناً مزورة: احذف هذا، أضف هذا، هذا مسموح وهذا ممنوع، ناهيكِ عن الفساد والسرقات. وفي النهاية تكون النتيجة فيلماً مسحوباً خيرُه، أو «من دون ذخر» كما يقول أهلنا في السويداء. لو كان لدينا مثقفون وقفوا ضد النظام كما يجب أن يكون، لربما ما وصلنا إلى هنا. أو على الأقل ليس بهذه الطريقة. على الأقل كان لدينا ضمير عام في سوريا لا يسمح لهذا الشيء أن يمرّ بتلك البساطة، ويتدمر البلد والزرع والضرع والبشر. بكل بساطة: كيف تجرأ النظام على ذلك؟ «يا فرعون من فرعنك؟». نحن الذين فرعنّاه للأسف!
من الصعب أن تكتب عن حدث تظهر نتائجه شيئاً فشيئاً، حتى ولو كان مستمراً على مدى عشر سنوات كما هي الثورة والحرب في سوريا. لقد لعبتَ لعبة ذكية على البناء التقني لرواية قمل العانة؛ أنقذت الرواية من راهنية الحدث. كانت الرواية مليئة بالمفاجآت، والأحداث كثيفة، وفيها تحولات. كيف استطعت أن تصنع هذه الخلطة بين الظاهر والباطن، والرواية داخل الرواية، والشخصية التي تنافس الكاتب بالكتابة إلى درجة لم نعد نعرف من يكتب من؟
أنا منذ البداية مع الحداثة والتجديد. أنا غير قادر أن أكتب عملين متشابهين. وأرى أنه يجب أن نكتب بشكل مختلف كلياً منذ ذلك الحدث الذي أصاب سوريا. نحن سنختلف، ولم نعد قادرين أن نكتب مثل حنا مينا أو زكريا تامر على سبيل المثال. الحدث سبّب انقلاباً كاملاً لي: بالذائقة، بقراءاتي، وبالمفاهيم التي كنا نعرفها، وكل شيء من الناحية الفكرية والجمالية.
بدأت الحداثة في أوروبا بعد الحربين العالميتين، حيث كفرت الناس بالذي كان سابقاً وبدأت تطرح الأسئلة. أنا مستبشر وأنظّر بأن هذا سوف يحصل في سوريا. ولقد بدأنا شيئاً فشيئاً نرى شعراً جديداً وقصة جديدة ومسرحاً جديداً، وبشكل خاص سينما مختلفة عن كل ما تعلمناه في السابق وانفرض علينا في سوريا. أن تكتب تحت راية الاستبداد يختلف برأيي عن أن تكتب وأنت حر. وهذا ما جرّبه الكتاب الذين خرجوا من سوريا. نرى أن كتاباتهم مختلفة تماماً.
ما الفرق؟ أنا لم أفهم أين وجدت الفرق في كتاباتهم، لأني لا أعتقد أنهم يصبحون أحراراً بمجرد خروجهم من حدود سوريا. غالباً يحملون قيودهم معهم. أخبرني أين وجدت الفرق؟
قرأتُ منذ فترة مسرحيتين لا تشبهان إطلاقاً المسرح السوري بالتقنية والزاوية والنظرة إلى الشخصيات والبنية. في المهجر يتغير أهم شرط من شروط الإبداع، وهو مناخ الحرية، أي حرية التعبير والنشر والنقد الموضوعي والحوار مع الجمهور والبنية التحية المناسبة للثقافة. وهذا ما يفتقده المبدع الحر في سوريا. كما أن للهجرة والتهجير شجوناً وأشواقاً وعواطف إنسانية تنشّط الذاكرة وتُعيد صياغتها، واكتشاف جمالياتها ومعانيها، ناهيك عن اكتساب لغات جديدة والاطلاع على ثقافات جديدة، والعيش في بيئة صديقة للفن والإبداع. ثم إن هذه الظروف تمنح المبدع الموهوب فرصة ذهبية للانفتاح على الآخر والتطور والتغيّر، سواء شاء أم أبى. لذلك، قالت العرب: ارحلوا تتجددوا!
هل لديك أمثلة عن ذلك؟
هناك أمثلة كثيرة. في الشعر مثلاً: محمد زادة، سوزان علي؛ وفي المسرح: محمد آل رشي، رأفت الزاقوت، نوار بلبل، رمزي شقير، عمر الجباعي؛ أما في القصة وكتابة المسرح: روعة سنبل، كاتبة القصة الحديثة المدهشة، التي قرأتُ لها نصين مسرحيين هامين جداً هما نقيق وحارسة الحكايات، وهما مختلفان كلياً عما عرفناه في المسرح السوري، ويمكن أن نضيف مسرحية كحل عربي لسوزان علي، التي تعيش في دمشق، وقد حصلتْ على الجائزة الأولى في مهرجان قرطاج المسرحي سنة 2019، بينما رفض النظام السماح لها بعرض مسرحيتها في مسارح دمشق، فعرضتْها في أحد بيوت باب توما. وكذلك عمر الجباعي في عديد من نصوصه وعروضه المسرحية الفقيرة الساخرة، والتي تقوم على التجريب والمغامرة. أما مصطفى تاج الدين الموسى، فهو مثال واضح يبشّر بولادة جديدة للقصة السورية بعد الثورة. ويمكننا أن نتحدث طويلاً عن السينما السورية الجديدة، وبخاصة الفيلم الوثائقي الذي كاد يكون معدوماً فيما سبق، وبدأ – عملياً – مع الثورة من خلال التصوير بالهواتف الذكية. وثمة أسماء شابة كثيرة لم تكن معروفة من قبل حصلت على جوائز هامة في الإخراج والتصوير والتمثيل، مثل إياس مقداد، غطفان غنوم، عروة مقداد، فراس فياض، الفوز طنجور، غيفارا نمر، ووعد الخطيب، المصورة والمخرجة التي حصدت أكثر من خمسين جائزة على فيلمها الوثائقي من أجل سما الذي رُشح لجائزة الأوسكار. وغيرهم الكثير من المبدعين/ات السوريين/ات الشباب.
ولكن كيف نمتلك أدوات الحداثة؟
واحدة من أهم أدوات امتلاك الحداثة هي نفض الرأس من كل شيء قرأتُه. أريد أن أكتب شيئاً مختلفاً عن كل شيء قرأته. لذلك قلت منذ البداية أن لدي استعداداً للحداثة منذ طفولتي. والآن بعد الذي حصل في سوريا، صار هناك إعادة نظر في كل شيء سابق. لا يعني إلغاءه أو تقزيمه، ولا يعني شكراً على رواياتكم التي كتبتموها. كتبتَ يا سعد الله ونوس مسرحاً وقدّمتَ شخصيات ليس لها علاقة لا باللحم ولا بالدم. يبدو أنه لم يكن ممكناً أكثر مما كان. نحن نريد أن نُعيد النظر بهذا الميراث، نريد أن نفكر بطريقة جديدة. من الناحية التقنية، أنا غير قادر أن أكتب عملاً يشبه الآخر. روايتي قهوة الجنرال التي تدور حول العوالم ذاتها تقريباً، إلا أنها مختلفة تماماً عن قمل العانة. بالنسبة للأخيرة كان هناك صدفة حسنة: زوجة جنرال ممنوع عليها أن تتكلم، وإلا قُصّ رأسها، لأنها مرتبطة بجهاز أمني. لذلك كانت تحتاج إلى وسيط كالخيال والتكاذب. مرة تقول إنها وحيدة، ومرة تقول إن لها أخاً، ومرة تقول إن لها أختاً. هي تقدم روايتها بواسطة رجل، غير أنها تجاوزته، وراحت تملي عليه كيف يكتب. أعتز بتلك الرواية، وأعتبرها إنجازاً حداثوياً يختلف عن كل شيء قرأته سابقاً أو هكذا أدعي. برأيي يجب أن نكتب شيئاً آخر مختلف.
إلى أي درجة أثّر تكوينك المسرحي على كتابة الرواية؟
كثيراً، ولكني لا أفصل كثيراً بين الفنون. ذلك أن المسرح تأثر بالفنون التشكيلية والسينما والرقص والغناء. كما أن الرواية تأثرت بالمسرح والسينما. أنا تكويني مسرحي. العظمة في المسرح هي أنه يعلّمك معنى الدراما، وبناء الشخصيات، والاختصار، والاختزال إلى أبعد الحدود. لا يوجد أي شيء زائد في المسرح. هذا لعب دوراً في روايتي، التي كان من الممكن أن تصل إلى خمسمائة صفحة في حال توسّعتُ في سرد تواريخ الشخصيات. أعتقد أن الاختصار في روايتي جاء من المسرح، ناهيكِ عن أن القارئ يشاركني، لا بل يجلس أمامي. هذه الظاهرة في الرواية، أي أن يكون القارئ معك، يكمّل عنك ويضيف ويحذف، هذه الظاهرة تكسر الجدار الرابع في المسرح، ولكنها انتقلت إلى الرواية. والأهم من ذلك المشاهد التي تتحول إلى مسرح. بشكل عام يتأثر الكاتب بكل شيء من حوله، فما بالكِ بالفنون.
تمرّ سوريا بمرحلة فاض فيها الواقع على الخيال أو الكذب الخيالي والفني، حتى صار يكفي أن ترصد الواقع لتصل إلى مستوى وصف يفوق الخيال. أما في كتاباتك، فالخيال يتجاوز نفسه. روايتك قهوة الجنرال كان حاملها الأساسي هو المسرح، ورواية المطخ كان حاملها الأساسي هو السينما. بينما الفن التشكيلي كان الحامل الأساسي لرواية قمل العانة. هل المزج بين الفنون هو الذي يفتح أفق الخيال في أعمالك، مزجك بين الكتابة والمسرح والسينما والفنون التشكيلية، ليصبح الخيال أوسع وأرحب من الخيال العادي؟
الخيال هو أساس أي إبداع على الإطلاق. لا يمكنك إعادة إنتاج هذا الواقع إلا عبر تخيُّله. حتى مسألة أن تبتدع شيئاً من الصعب أن يتواجد في الواقع، هذا يحتاج إلى الخيال. كتابة عمل خيالي شيء، أما أن يكون الخيال هو أساس العمل الإبداعي أو القصصي أو الروائي فهذا شيء آخر. الخيال هو الذي يعطيك مفاتيح الأحداث القادمة أو انحرافها أو تضخيمها، وهو ليس غاية بحد ذاتها، ولكنه يساعدك على تصور أو تخيل الأحداث وإضافة عناصر إليها. من هذا المنطلق، أنا غذائي هو الخيال. حتى حين تكتب القصة الواقعية، تحتاج لتخيل عناصر تدعم الواقع. لا يمكننا رسم الواقع كما بالكاميرا، فأنا أحتاج إلى ترتيبه وأن أختار منه. وهذا ينطبق بالدرجة نفسها على المسرح، لأنك تبني عملاً. يمكنك أن تأتي بشحاذ وتضعه على المسرح، ولكن حين تُلبسه قبعة الجنرال، وتُحمّله عصا الجنرال، وتجعله يقدم قبّعته للناس ليضعوا النقود فيها، عندئذ سوف يزداد المشهد جمالية. الخيال يضفي معنى وجمالية.
بعض القراء لم يتمكنوا من قراءة رواية قمل العانة لأنهم وجدوها قاسية، ما رأيك؟
هذا الكلام مهم جداً ومفاجئ. نعم، صحيح، ولكن هذه هي الحياة في بلدنا. لعل الذي حصل في سوريا أكبر بكثير وأكثر إيلاماً وقذارة من الذي ذكرتُه في الرواية. نعم هي رواية قاسية، ولكن إذا أخذنا فكرة التراجيديا أو التطهير أو أن نُطلّ على هذه العذابات كي نعبر عنها. حين قرأ بوشكين الأرواح الميتة لغوغول، قال: يا إلهي كم هي بائسة روسيا! هو كان يتكلم عن الفلاحين والإقطاعيين الذين كانوا يشترون الأصوات حتى ينجحوا في مجلس «الدوما». كان يتكلم عن الذل الذي يعيشه الفلاحون، مع أنه لم يكن هناك شيء يدعو إلى الأسى. وعذراً من بوشكين: يا إلهي كم هي بائسة سوريا! لا يوجد بلد في العالم، أو في تاريخ البشرية، حصل فيه الذي حصل في سوريا. ياريت لدينا استبداد، لأن الاستبداد عنده على الأقل شرف، وقليل من الأخلاق. أما أن تكون منفلتاً إلى هذه الدرجة؟! الرواية لا تنكتب إلا بهذه الطريقة. لا يمكنني تجميل الواقع، ولكن بالوقت نفسه لا يمكنني تيئيس الناس، أو بالأحرى هذا ليس من طبعي. أنا متفائل بطبعي. لذلك اختلطت المأساة مع الإرادة. فبعد أن اكتشفت المرأة مدى حجم مأساتها، واكتشفت قمل العانة، قررت أن تلبس بنطال جينز وخفّافة وترحل إلى الغوطة، وفي النهاية خاطبتْنا من فرنسا. أعتقد أن السجون التي عانينا منها في الثمانينات كانت سبع نجوم مقارنة مع السجون التي يعاني منها الناس حالياً.
إلى أي مدى كان مسرح القسوة عند أرتو له تأثير من الناحية التقنية على كتابتك لرواية قمل العانة؟ طبعاً القسوة والعنف والدمار الشامل واللامعقول الذي حصل في بلدنا فرضوا أنفسهم على الرواية. ولكن إلى أي درجة استفدت من تقنية مسرح القسوة في مقاربة هكذا موضوعات، سواء بالوعي أو اللاوعي؟
لا بالوعي ولا باللاوعي. القسوة الموجودة في مسرح أرتو مبنية على شيء مختلف كلياً. مبنية على الأساس النفسي الذي له علاقة بالمازوخية أحياناً. هو يرى أن عرض القسوة عبارة عن تفريغ طاقة. في رأيه الحياة بمنتهى القسوة، والقسوة التي يتكلم عنها تأتي بالمعنى النفسي والفلسفي. وهذا مختلف كلياً عما عانيناه نحن من قسوة. القسوة التي يقصدها أرتو نابعة من الذات، أما ما نعاني منه فهو نابع من نظام قاسٍ إلى أبعد الحدود. مارس القسوة حتى يصدم الناس ويجعلهم يمارسون القسوة بأنفسهم. مسرح أرتو يشكل اتجاهاً في نبش الرغبات الدفينة عند الإنسان. الإنسان بطبعه وحش مثلاً، ويحاول أرتو أن يُخرج العنف الكامن في داخله. أرى أننا هنا أمام ضرب من المثاقفة. أنا لست ضدها في المسرح، ويحق لها أن تعيش مثل الاتجاهات الأخرى في المسرح، ولكني لا أتبناها إطلاقاً، حتى أني لا أعتبرها ترتقي لمستوى الفن الحقيقي. الشيء نفسه ينسحب على القول إن الإيروس هو أساس المسرح، وأن المسرح يجب أن يكون فيه رغبات جنسية يعبر عنها بشكل واضح، وأحياناً فاضح.
أنا أتكلم عن صراع القسوة مع الآخر، أما عند أرتو فتنبع الصراعات عن دوافع دفينة. هكذا أفهم مسرح أرتو الذي كان رداً على كل ما كان سائداً ما قبل عصره، ما قبل الحربين العالميتين. حتى أن أرتو ردّ على الكلاسيكيين من أمثال ستانسلافسكي وحتى بريخت. في رأيه الحياة لا يوجد فيها سوى القسوة والألم، هذا هو جوهر وجود الإنسان. الإنسان يتألم، والحياة هي أن تدافع عن نفسك. هذه فلسفة تُشوّه قسوة الاستبداد. العنف الذي مورس في سوريا، لا أرتو ولا الذي أكبر من أرتو فكّر فيه. يتكلم أرتو عن الإنسان الضعيف والمضطهد. من حق النقد أن يلتفت إلى هذه النقطة، ولكن حتى في المسرح ليس لدي استعداد أن أدخل بتلك المتاهة التي اسمها مسرح القسوة.
أذكر أن الكاتبة أليف شافاق قالت مؤخراً ما معناه أن هذا العصر هو عصر الرواية، وأن أي شيء آخر لن يستطيع أن يعبّر عن المعاناة التي نمر بها حالياً كما الرواية والأدب. هل توافقها الرأي؟
بالتأكيد. جميعنا ندرك مدى أهمية الثقافة، سواء كانت أدباً أم مسرحاً أم سينما. كثيرون يقولون الرواية الرواية الرواية، ولكني أعتقد ليست فقط الرواية. جميع مناحي الحياة تلعب دوراً ببناء الوعي، سواء كانت قصة أو مسرح أو سينما أو أي شكل من أشكال الفنون. نحن كسوريين بأمس الحاجة إلى الفن، وبشكل خاص إلى الفن غير المتحزب. راح زمن الفن الأيديولوجي. الجمال والفن بكل أنواعه هو المنقذ، لأنه لا يمكن أن يكون إرهابياً أو غير وطني، لا يمكن إلا أن يكون إنسانياً. وظيفته هي الدفاع عن القيم العليا للبشرية، والتي تجسدت بحقوق الإنسان في القرن العشرين. الفن يدافع عن الحرية والعدالة والجمال، والإنسان السويّ يلتفّ حول هذه المطالب التي ضحّت البشرية لأجلها حتى صارت حقوقاً مكتسبة لها. لا أتصور أن هناك رواية تدعو إلى الاعتقال أو القتل أو الظلم. بطبيعته الفن يحمل هذه القيم العظيمة التي يمكن لجميع السوريين الأسوياء الالتفاف حولها. من هذا المنطلق لا الحزب يُنقذ، ولا الدستور يُنقذ، ولا سقوط النظام يُنقذ. كل هذه التعابير نافلة ومُعيقة. ولكن بناء الشخصية أو بناء الشعب السوري لا يتم إلا إذا تمّ جانبه المعنوي أيضاً. حين تكون مع العدالة، ومع الحرية، وضد قتل البشر والتعصب، هذا هو الذي يبنينا. كذلك ألا تكون منعزلاً أو طائفياً أو أيديولوجياً بالمعنى الذي عرفناه سابقاً. من هذا المنطلق، نعم، الرواية تصنع هذه المعجزة. الرواية توقف الحرب، ولكننا نعلم جميعاً أن الثقافة والفن ديمقراطيان جداً، ولا يفرضان نفسَيهما على أحد. يقدّمان نفسيهما قائلين: هذا الذي عندنا! ليس لديهما سلاح، ولا مخابرات، ولا وسائل ضغط على الإطلاق. هذه هي القوة الناعمة للثقافة التي تتغلغل إلى النفس البشرية. لذلك يذكر الشباب المعتقل في الثمانينات كيف كنا نغني، يعني فن: «طلعت يا محلا نورها شمس الشموسة!» وهكذا تتذكر أنك إنسان، إنسان جميل!
لم تغنّوا فقط، بل صنعتم مسرحاً كذلك، وقد كتبت عن ذلك في كتابك المسرح في حضرة العتمة الذي جاءت أهميته من ارتكاز النظري على التجربة العملية. لحسن حظ رفاقك في السجن أن كان بينهم مخرج مسرحي. ماذا تروي لنا عن تلك التجربة؟ ما الذي يميزها؟ وهل أضافت لك على الصعيد الشخصي والمهني؟
عندما كنا في معتقل تدمر، لم يكن حتى التفكير بالمسرح معقولاً. لم يكن ثمة مكان، ولا جمهور، ولا ممثل واحد، والمسرح مكان وجمهور وممثلون. كان الخوف والموت والتعذيب هو المسيطر (ولا مسرح مع الخوف والموت والألم). بعد نقلنا إلى معتقل صيدنايا، ولقائنا بمجموعة من شباب حزب العمل واللجان الشعبية وغيرها، دبّت فينا روح جديدة.
مسرحية العنبر رقم 6 جاءت بعد مُضيّ تسع سنوات تقريباً من الاعتقال. كان لنا شرف تدشين سجن صيدنايا العسكري سنة 1987، على ما أذكر. وكان ذلك – بالقياس إلى سجن تدمر – بمثابة إخلاء سبيل. فهو سجن حديث نظيف، مكوَّن من ثلاث طبقات، على شكل مروحة أو إشارة مرسيدس، لكنه من الداخل أشبه بالمتاهة، أو غابة مليئة بالأقفاص والسلالم والأبواب الحديدية، له ساحة كبيرة جداً في وسطها درج لولبي يقود إلى الطبقات العليا، مُسيَّج بشبك حديد دائري، وباب رئيسي يُقفَل بالسلاسل فوق المزلاج. هناك تحول السجن إلى مركز ثقافي، حيث جمعنا من خلال الزيارات عدداً كبيراً من أهم المؤلفات، وحوّلْنا أحد المهاجع إلى مكتبة عامة. وهناك ترجمنا الكتب، وكتبنا الأشعار والقصص والروايات، وأقمنا الأمسيات والمحاضرات. وهناك قمت بأول تجربة مسرحية بعد تخرُّجي. فما إن جمعونا مع حزب العمل الشيوعي في جناح واحد، وكان جلّهم من الشباب المتّقدين حماسةً وحيويةً، حتى دبّت فينا الروح من جديد، فقرّرتُ أن أحقق حلماً مسرحياً قديماً، كنت قد قمتُ بإعداده عن قصة للكاتب الروسي أنطون تشيخوف هي العنبر رقم 6.
اخترنا كل من كان يملك ولو موهبة قليلة في التمثيل، وبدأنا التدريبات سراً، في أحد المهاجع التي تبرع نزلاؤها بالتخلي عنها، لمدة ثلاث ساعات يومياً، وكانت تلك تضحية كبيرة. لكن التحدي الأكبر أمامنا كان تصميم العرض والديكور المناسب للظروف التي نعيشها، وكيف يمكن أن نقدم عرضاً مسرحياً في مهجع لا تتجاوز مساحته 30 متراً مربعاً. أين سيمثل الممثلون؟ أين يجلس المشاهدون!؟ واخترعنا تصاميم وحلولاً غريبة عجيبة، كأن يتحول الممثل، عند الحاجة، إلى طاولة أو كرسي، وأن تُثبَّت المخدات على الجدار وينام سكان العنبر 6 وقوفاً لكسب المساحة المتبقية، وأن نجدل الحبال ونثبّتها بين السطح والأرض لتتحول إلى قضبان حديدية، نفكّها ونركبها حسب المشهد. كما قررنا أن نعتمد في الإضاءة الشاحبة على الشموع خلف الأقنعة، وأن يحضر العرض كل مرة عشرة أشخاص فقط، ويكون الحضور وقوفاً وأداء الممثلين همساً تقريباً، كي لا يسمعنا الحراس. كنت متردداً في البداية، وكان المحرض الأكبر لهذه التجربة صديقي الكاتب والصحفي علي الكردي، الذي كانت له تجارب سابقة مع بدر زكريا ورفاقه، قبل لقائنا. قمت بإعداد النص وقام أحدنا بنسخ عدد من النسخ بخطه الجميل، وبدأ آخر بتأليف الموسيقى على عود صنعناه من «بيدون» ماء بلاستيكي وأوتار من النايلون، وقام الفنان التشكيلي طلال أبو دان برسم تصوُّراته للشخصيات بقلم الرصاص. وما زلت حتى الآن، لحسن الحظ، أحتفظ بنسخة من النص، ومن تلك التصاميم والتصورات التي رسمتها للعرض.
أصبحتْ مسرحيتنا حديث الجميع، وكانت التجربة ماتعة لدرجة أننا تمنَّينا ألا يصدر قرار بإخلاء سبيلنا قبل عرض المسرحية. وبدأنا نبحث عن مهجع مناسب للعرض، فوقع خيارنا على المهجع المخصص للمكتبة الذي لم يكن فيه غير شخص واحد هو أبو رباب المسؤول عنها. كان أبو رباب من أولئك الشيوعيين المخلصين في عملهم، أبيض الشعر وأشقر الوجه، وقد حاولنا إقناعة بشتى الطرق لكنه رفض بعناد مغادرة المهجع، معتبراً المكتبة أهم من المسرح. ولم يبقَ أمامنا إلا أن نضمه إلى فريق العمل ليصبح واحداً من سكان العنبر. لكن العرض مع ذلك لم يتم، لأن إدارة السجن قررت فجأة فصلنا عن بعضنا بجدار إسمنتي، لسبب ما.. مثلما اعتُقلنا لسبب ما أيضاً.
تتحدث في كتابك الثقافة والاستبداد عن ثلاثة أنواع من المثقفين، حسب موقفهم من الاستبداد والمجتمع. لدينا المثقف النخبوي المثالي، والمثقف الانتهازي، والمثقف الحقيقي القادر أن يكون فاعلاً في التغيير ومساهماً في خلق الهوية الثقافية للمجتمع وتطويرها. كيف ترى المشهد الثقافي السوري العام المناهض للنظام؟ هل تعتقد أن الثورة أنتجت ذلك النوع من المثقف/ة الحقيقي/ة القادر/ة على إعلاء صوت الضمير الحي والقيم الإنسانية، السامية على المصالح الآنية والصراعات البينية والعنصرية والذكورية؟ وإذا كان جوابك سلبياً، أين يكمن التقصير برأيك؟
انتشرت في العقد الأخير كثير من مراكز البحوث والمجلات المحكمة ودور النشر والصحف الرصينة والمجتمعات المدنية، وبدأ السؤال النقدي يفرض وجوده على عقولنا، ويطالبنا بإعادة النظر ومراجعة مواقفنا ومفاهيمنا السابقة. وقد لعب المهجَّرون دوراً لافتاً في ذلك. وهذا كله جيد، لكن الفجوة بين الثقافة وأهلنا، ما زالت كبيرة للأسف. لقد تركت قرون طويلة من الاستبداد والاستعمار والتخلف والأمية ندوباً عميقة في نفوسنا وعقولنا، وهو ما تجذَّر أكثر في ظل حكم العسكر والنظام الشمولي الذي استعمر بلدنا – عملياً – منذ الإنقلاب العسكري الأول، فكرّس أجيالاً من الخائفين والخانعين والمراوغين والثقافة الزائفة.
نحن بحاجة ماسة اليوم لثورة ثقافية ديمقراطية شاملة، تواكب ثورتنا السياسية، وتمشي أمامها، وليس خلفها أو إلى جوارها. بحاجة لمثقفين حقيقيين منتجين للفكر والمعرفة، ليس في مجال الإبداع الفني والأدبي وصناعة الكتب فحسب، بل في مجالات الحياة كلها، وبخاصة الفكرية والنقدية والبحثية. فالنخبة السورية – للأسف – ما زالت تشبه النظام القديم وتحمل جيناتِه، وقد تمكن نظام البعث إلى حد كبير من خلط الأنواع الثلاثة التي ذكرتُها في كتابي، ولم يُبقِ إلا على نوع واحد هو المثقف الانتهازي، أو في أفضل الحالات المثقف الدبلوماسي الذي يعرف كيف ومن أين تؤكل الكتف! ولم يَسلم من هذا الاختلاط غير عدد قليل يحاول جاهداً إعادة الروح للثقافة السورية العميقة وهويتها الوطنية. وعلينا بدورنا ألا نخلط الثقافة بالسياسة، أو الأيديولوجيا بالإبداع، على الرغم من الوشائج التي تربط بينها.
كذلك نحن بحاجة ماسّة لبناء مؤسسات تُنظّم وتُوجّه العمل الثقافي، وتُدرّبنا على بناء المؤسسات المنشودة. ويجب أن يبدأ ذلك في أي مكان يتواجد فيه السوريون، وبخاصة في المهجر. عدم قيام هذه المؤسسات سوف يلعب دوراً سلبياً جداً في إثبات الذات، وبَعثرة الجهود، ويحرم السوريين من الإعلان عن أنفسهم وتنظيم عملهم، والدفاع عن إنجازاتهم وإشهارها، كما يحرمهم من الفعالية والتخطيط والتطور.
نحن بانتظار ثقافة حقيقية أصيلة، ومثقفين عضويين يولدون من رحم المأساة السورية، وعندما نقول ثقافة حقيقية، فهذا يعني أنها تأسيسية، ومنفتحة على ثقافات العالم، غير حزبية أو فئوية أو طائفية أو قومية أو دينية أو ذاتية، إنما ثقافة وطنية ديمقراطية شاملة، تتناول هموم حياتنا كلها، وتدافع عن القيم العليا للسوريين أولاً، والبشرية جمعاء.
إذا حاولنا أن نبحث في مشروعك الفكري، سنجد أنه يهتم بشكل أساسي بدراسة علاقة الثقافة والفن بالرقابة والسلطة والاستبداد. وقد كتبت عن ذلك في كتبك المسرح في حضرة العتمة والثقافة والاستبداد والفن والثورة السورية. تعتبر أن جوهر الفن هو النقاش، أما المسرح فهو أول حلقة ديمقراطية أوجدتها البشرية كي تناقش شؤونها البشرية. الحرية هي الكلمة المفتاحية لديك. هل تعتقد أن سلاحنا الأول صار هو الثقافة والفن، بعد أن خسرنا الثورة عسكرياً وحتى سياسياً؟ وماذا يتطلب ذلك منا كي ننتصر وتتحقق نبوءتك في آذار 2011 أخيراً؟
ليست كتبي ومسرحياتي هي وحدها التي تدعو إلى ثقافة وطنية ديمقراطية وفن جميل وأصيل، بل حياتي كلها كانت وما زالت مكرسة لهذا الهدف. نحن نعلم أن الفن، والثقافة بعامة، لا تستطيع وحدها اجتراح المعجزات! آمنّا بذلك عندما كنا صغاراً، وكنا نظن أن قصيدة الشعر يمكن أن تغيّر الكون، وأن المثقفين يستطيعون أن يقودوا العالم، لكن التجربة أثبتت أن ذلك محض هراء، وبخاصة في حضرة الاستبداد والشمولية التي ابتُلينا بها، والمعادية والمزوِّرة للثقافة الوطنية، والعاملة على مسح الذاكرة، وتخريب الذائقة الجمالية، والحس الإنساني، واستبدال ثقافة الحرية بالعبودية، والأصالة بالسخافة والتفاهة والابتذال، والجمال بالبشاعة، والوطن بالمزرعة، والشعب بالقطيع، وسيادة القانون بسيادة الخارجين عن القانون.
لكن المثقفين الحقيقيين لا يستسلمون. والثقافة تحفر ببطء، وتترسّخ عميقاً في الوجدان، وتتحول إلى إيمان بالقيم العليا للبشرية. ثم إن قضية الثقافة محقة وعادلة، لأنها تدافع عن حقوق الناس في الحرية والعدل والخير والجمال، وهي لا تتسلح بالبنادق والحواجز، بل بالعلم والمعرفة والحب والجمال والديمقراطية. لقد علّمنا التاريخ أن الثورة المسلحة تتبادل الأدوار مع الاستبداد المدجَّج بالسلاح، وهي تستخدم العنف والكراهية والثأر، ولا تُنتج غير استبداد جديد، واستبدال طاغية بأخرى. من هنا تأتي أهمية الثقافة للثورة السورية. سيكون الهدف بعيد المنال طبعاً، وقد يحتاج إلى أكثر من جيل لتحقيقه، كما حدث في ثورات الشعوب التي سبقتنا، والتي انتصرت بعد عشرات السنين.