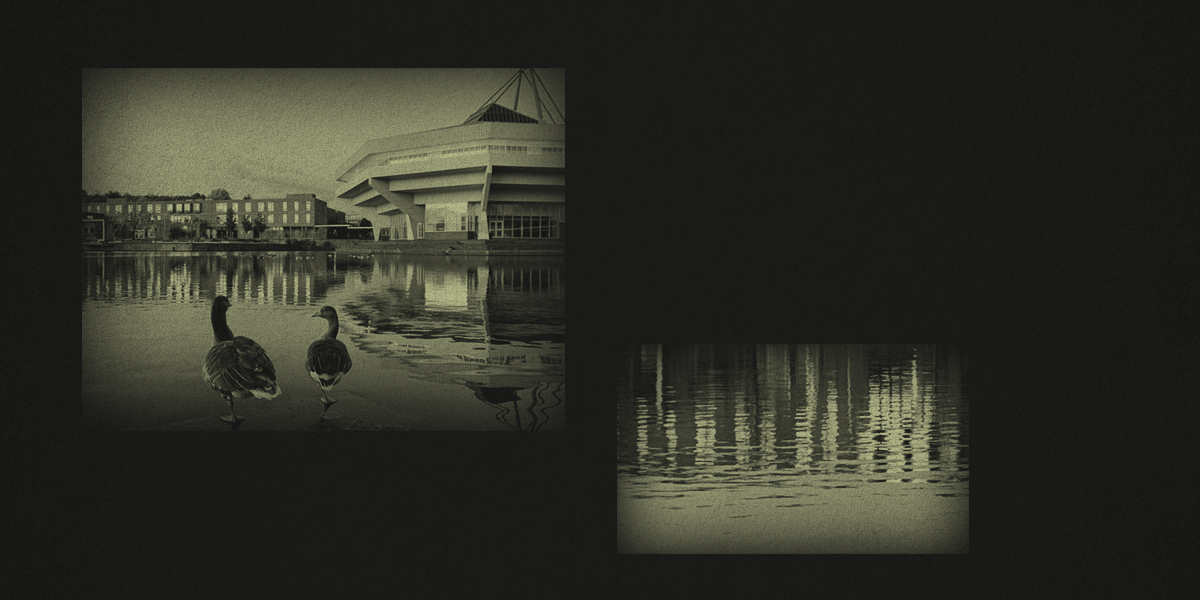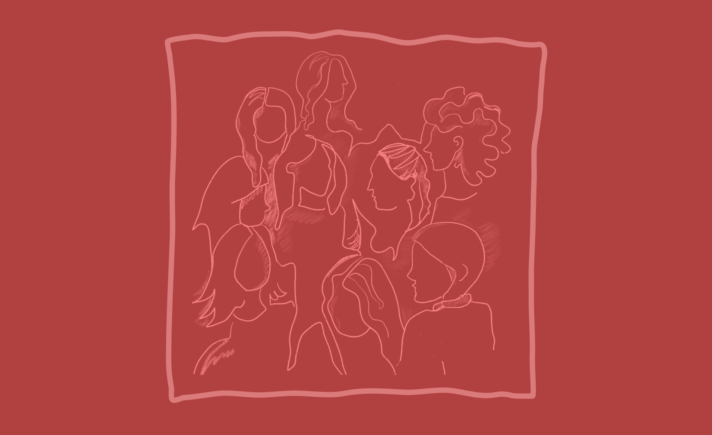إنها السنة الثالثة والأخيرة لي في اختصاص علم النفس في جامعة يورك، وصلتُها أخيراً بعد أن تخيلتُ وفكرتُ بألف سيناريو محتمل يحول دون وصولي هذه السنة، وخاصةً لحظة التخرج. سيناريوهات مكرّرة محمّلة بأعباء ثقيلة تختلط بين الماضي والحاضر. لم تبدأ السنة بخلاصنا من الكورونا ومحاضرات الزووم كما توقعت. بالعكس، فرضت بريطانيا – حيث أعيش – قوانين صارمة أكثر من سابقتها، وامتدّ الحجر الصحي لأشهر إضافية. وبِتُّ لا أرى إلا وجهي في المرايا، أو الوجوه القادمة من الشاشات أو بعض اللقاءات القصيرة المسروقة بعيداً عن قرارات الحظر والعزلة.
في اللقاء الأول مع مشرفتي في الجامعة على تطبيق زووم، لم يكن لدي رؤية واضحة عن الموضوع الذي سأختاره للبحث كجزء من واجبات سنة التخرج. كنتُ مصرّة من بداية دخولي الجامعة أنّني أريد أن أتعلم وأبحث عنا، نحن، والـ«نحن» هنا تعني السوريين، بكل ما فينا من جروح وندوب وهزائم. وفي السنتين الأولى والثانية، لم أستطع أن أختار أي موضوع للبحث؛ الجامعة تختار دوماً، لكن الآن أنا صاحبة القرار. كنا في الاجتماع الأول أربع طالبات ومشرفة، حبيسات غرفنا وشاشاتنا، نحاول أن يكون لقاؤنا أخفّ من الثقل الذي نعيشه في شتاء كوروني نهاراتُه مُظلمة كليله. تحكي كل طالبة منا عن مشروعها الذي اختارته، ولا أذكر إلا موضوعاً واحداً عن الذُهان اختارته الفتاة التي تحدثت أولاً لاضطرارها لترك الاجتماع باكراً. يأتي دوري لأخبرهم بأنني أنوي أن يكون بحثي عن الصدمات النفسية للسوريين، وبالذات اضطراب ما بعد الصدمة. وفي سياق ذكر الأسباب لاختياري، أذكر الجواب البسيط والمعقد: لأنني سورية، لديَّ صدمات كثر، وتشخيصٌ باضطراب ما بعد الصدمة، ولأننا السوريين نعيش تروما جمْعية وقاسية ومَهولة، وغيابُها عن الوسط العلمي يشكل لي شخصياً صدمة إضافية.
تسألني عن مدى توازني واستقراري النفسي للتعامل مع اختياري، وهل أنا قوية كفاية للتعرض لتفاصيل مؤلمة، أم ستكون هذه المراجعة الأدبية عبئاً على صحتي النفسية؟ أحاول الآن تذكر ماذا أجبتها، لكن ربما كليشيه معتادة أنني «بخير». للحقيقة، البحث بهذه المواضيع يضعني ضمن وضع نفسي معقد، بين الهشاشة والقوة، ولا مفر من هذه المواجهات الآن أو بعد سنوات. المواجهة قادمة لا محالة، بدأتُ بمواجهتها بشكل فردي باكراً، والدراسة الأكاديمية وتجارب الشعوب دفعتني بشكل أعمق للمواجهة كجزء من التروما السورية والمعاناة الإنسانية الجمعية.
بعد أيام من الاجتماع، نبدأ بنقاش التفاصيل الأخيرة للموضوع الذي اخترته، ونظراً لقلة الأبحاث التي ركزت على السوريين بشكل خاص، والذي أكد لي ضرورة اختياري، أبدأ بالتفكير باضطراب ما بعد الصدمة لدى العرب بعد الربيع العربي، ثم اللاجئين العرب، ليستقرّ البحث أخيراً عن العلاجات النفسية لاضطراب ما بعد الصدمة لدى اللاجئين.
فلاش باك 2013
درست في سوريا فرع الصيدلة لأربع سنوات، اعتُقلتُ في نهاية السنة الرابعة في أيار، أي في الامتحانات الأخيرة قبل نجاحي للسنة الخامسة والأخيرة. أكملت السنة الأخيرة في فرع فلسطين، الذي توعّدني محقِّقوه وسجّانوه ألف مرة بأنهم سوف يحرمونني من جامعتي التي تكرّم عليّ بها بشار الأسد، وأنني أستحق الموت لا الجامعات، وغيرها من التهديدات التي تسحب مني كل استحقاقاتي كإنسان، وتجعلني فقط تلك الفتاة التي لا تستحق.
اخترت الصيدلة لأن درجاتي في الثانوية كانت عالية وكنت أستطيع أن أدرس طب الأسنان أو الصيدلة بجامعة دمشق، أو الطب البشري في محافظات ثانية. فكان الخيار الأمثل هو البقاء قريبة من أهلي في القنيطرة، واقتنعت أنني أحب دراسة الصيدلة، وربما أحببتها فعلاً، وتدربت في صيدلية في بلدتنا الصغيرة منذ السنة الدراسية الأولى. لأربع سنوات تراكم لدي الكثير من الخبرة النظرية والعملية، ولم يبقَ إلا سنة التخرج التي نجح محققو فرع فلسطين في حرماني منها، ومن جامعتي، وحتى من كشف العلامات الذي احتجته كل مرة أنوي التقديم على جامعة بعد خروجي من سوريا.
لسنوات، أحاول استيعاب خسارة أهلي واصدقائي وجامعتي وبيتي في يوم واحد، وأحاول وضع هذه الخسارة ضمن إطار زمني منطقي؛ أحاول فهم كيف تكون الأوامر الوحشية سهلة وطيّعة لهذه الدرجة بأيدي الطغاة، وكيف تكون مدمّرة وكارثية على شعوبهم. ربما ضمن الظرف السوري العام، وتاريخ السوريين مع سلطة الأسد لعقود، أستطيع فهم تغلغل القمع والسلطة والديكتاتورية والوحشية في هذه البلاد، وأفهم أيضاً أن القتل والتعذيب سمة أساسية للدولة الأسدية، وأن طغيانهم لا يتوقف عند حدود المكان والزمان، ولا يقتل البشر فقط، إنما يسلبهم ذواكرهم وماضيهم، وربما أحلامهم للذين بقوا عالقين تحت سيطرته الجغرافية. لكن على المستوى الفردي عندما أُحبَس داخل رأسي. أجد ما حصل كابوساً مفككاً وضبابياً، أحاول ترتيبه ولملمته كقطع «الپازل» ضمن صورة واحدة مفهومة. لكنها دوماً ناقصة، ولن تكتمل، لأنني لن أجد يوماً سبباً واحداً في العالم يجعلني أرضى بأن يحصل هذا في الحياة الطبيعية. أفهم تماماً أن المحقق صفعني على وجهي وأنا مغمضة العين، وشتمني واستنكر عليّ أن أهلي لم يُرَبّوني بما يكفي، ووعدني بأنني سأحلم بالجامعة ولن أصلها، وأنّه قادر على قتلي دون أن يُحاسبه أحد. أعرف أن كل هذا حصل في الساعة الأولى فقط، أذكره تماماً وبتفاصيله وروائحه، لكني أعرف أيضاً أنني سأبقى دوماً خارج هذه الصورة كجمانة التي في الثالثة والعشرين من العمر، تتساءل وكأنها لا تعرف الأسد وحكم الأسد. كيف ضربني؟ كيف حصل هذا وما زال يحصل؟ ثم تتجنب جمانة السؤال والأجوبة والتفاصيل هاربةً إلى أي حياة لا تحمل هذه المواجهات.
فلاش باك 2016
انتقلتُ في 2016 إلى بريطانيا، ويلز تحديداً، وعشت في مدينة على البحر الأيرلندي، تشبه المدن الساحرة في الحكايات، يحكي أهلها لغة ويلزية يحملونها في كل مكان كمعركة وجودية تُعزِّز انتماءهم الذي حاولت بريطانيا سلبه منهم. اسم المدينة آبريستويث، وهو اسم ويلزي معناه مصب نهر «ستويث»، وهي كثيرة الأنهار والجسور، وكل جسر يحمل ذكرى وتواريخ احتجاجاتهم ضد الحكومة البريطانية، حكى لي عنها الويلزيين بكل مرة أحدثهم فيها عن الثورة السورية.
في ويلز كان لدي عائلة ويلزية مقرَّبة مؤلَّفة من الزوجين شون – وهو أيضاً اسم ويلزي يُكتب Siôn ويقابله في الإنكليزية «جون» – وزوجته جانيت، يعيشان في الريف مع ابنهما ذي الرابعة عشر. كنت أحدثهم كثيراً عن سوريا، عن الثورة، عن أهلي، وشاركنا ونظّمنا سويةً الاحتجاجات والأنشطة كجزء من الحراك الشعبي السوري في بلاد اللجوء، تزامناً مع هجمات النظام السوري المتلاحقة على المدن السورية. أسررْتُ لهم يوماً أنني خائفة من أن يغلبنا جميعاً اليأس والاستسلام وأنا أرى البراميل تسقط على حلب، وكل ما أستطيع فعله احتجاجات في مدينة لم تسمع يوماً بحلب. فأخبَروني أنهم سيقفون دوماً إلى جانبي في أي شكل نضالي أستطيعه، لأنهم كويلزيين يعرفون معنى النضال في مواجهة القمع. وأخبرني شون أنه كان أحد الذين اعتقلتهم الحكومة البريطانية في احتجاجات ونشاطات لجعل اللغة الويلزية رسمية في كل ويلز، ثم أفرجت عنه، بينما نقلت بعض الأفراد الويلزيين المشاركين معه إلى المحكمة، وصلوا بعدها بسنوات إلى هدفهم في استعادة لغتهم وانتمائهم من كل محاولات تهميشها وسلبهم إياها.
في هذه المدينة أيضاً، أخرجت اضطراب ما بعد الصدمة الوحش الكامن تحت السرير، والذي تفاديتُه أثناء لجوئي إلى لبنان لسنتين لأنني كنت مشغولة بمعارك النجاة اليومية وعملي المتواصل. بدأت أعرفه أكثر، هو وقلقي وخوفي من الأصوات المفاجئة والظلام، وقرّرتُ خوض معاركي بدءاً من العودة للنوم الطبيعي في الليل والعتمة كما أحب. وفي الوقت ذاته كنت أحاول التواصل مع الجامعات لأعود لدراسة الصيدلة، وكل جامعة تطلب مني كشف العلامات الذي قررت جامعة دمشق بأنني لا أستحقه. كنت ببساطة أحاول بناء حياة جديدة.
بعد عدد كبير من المحاولات، قررتْ جامعة واحدة قبولي في الصيدلة وأن أبدأ من السنة الأولى بعد تقديم امتحان اللغة، كان عرْضاً بائساً ووحيداً وأوجب عليّ انتظار سنة، لكنني سورية ولاجئة وبدون ثبوتات رسمية من الجامعة السابقة وعليّ الامتنان. في هذه السنة التي بدأتُ التحضير فيها لدراسة الصيدلة، تعمّقتْ علاقتي باضطراب ما بعد الصدمة وبالدماغ وبعلم النفس وبالناجين من الحروب، قرأتُ فيكتور فرانكل وإيدث إيجر اللذين نَجَوا من الهولوكوست، وديفيد إيجلمان الشاب الجميل المهووس بعلم الدماغ، وجوديث لويس هيرمان عن التروما – وخاصة السياسية – وعلاجها. كنت أتقلب بين الفرح والخوف، أفرح واتفاءل كلما عرفتُ أكثر عن النجاة النفسية والعلاج، ثم أنسحب إلى السرير كلما فهمت عن أثر الصدمة المخيف على الدماغ والذاكرة والكوابيس والحياة كلها حتى أصبع قدمك الصغير.
قرّرتُ حينها أن أترك الصيدلة للأبد، وأتحول لدراسة علم النفس. وبدأت التقديم على الجامعات بفرع جديد ومختلف، قُبلت في 3 جامعات قبولاً مشروطاً، وفي جامعة واحدة قبولاً غير مشروط وهي جامعة يورك. سألوني في المقابلة: لماذا علم النفس؟ أجبت: لأنني سورية لاجئة، قادمة من بلاد مليئة بالصراعات والصدمات والجراح والمعاناة، وربما علم النفس يساعدني وأساعده أيضاً في فهم التروما السورية والتروما السياسية، وأنا شخصياً أحتاج فهم أعمق لنفسي مع ما أحمله من تروما – طبعاً مع بعض الإضافات التي بحثتُ عنها على غوغل عن مهارات المقابلة الناجحة للقبول الجامعي. أتمنى ألا أكون قد ذكرت له أنني أعمل جيداً تحت الضغط.
فلاش باك 2018
بدأ معي كابوس خسارة الجامعة منذ اليوم الأولى في السنة الأولى.، عندما دخلت قاعة المحاضرات في المدينة الجديدة. في الحقيقة كانت القاعة في جامعة يورك، لكنني رأيتها في جامعة دمشق. كنت أنظر لكل تفصيل والطلاب وللمُحاضِر وشاشة العرض، وكأني على ضفة أُخرى من الزمان والمكان، وكأنهم خيالات لا وجود لها ولا أستطيع وصولها. غبتُ أكثر من أسبوعين بعد انتهاء المحاضرة، لا أردّ على الإيميلات ولا أخرج من غرفتي ولا أرى أحداً. أقضي كل وقتي مع مخاوفي وقلقي، ولا يصمت هذا القلق والخوف إلا بهجمة قلق ثانية أقوى منه تُزيحه وتُثقلني بطبقات وجدران إضافية من الذعر والتعب.
أُجبِر نفسي بما تبقّى من طاقة على العودة للجامعة، وهناك أعود فأرى الحياة التي أخافها، كنت أقاوم فكرة وجود حياة طبيعية وعادية جداً، يعيش فيها الناس لا يتابعون نشرات الأخبار كل دقيقة، ولا يسكنون مواقع التواصل الاجتماعي المملوءة بأخبار الحروب والقصف والتهجير، ولا يفرحون بالتهجير القسري والنفي لأصدقائهم لأنه الحل الوحيد لبقائهم أحياء، ولا يُدركون كمْ مرّ الوقت طويلاً وقاسياً، وكم أنهم الآن بعيدون جداً – إلا حين تأتيهم صور آبائهم وأمهاتهم مع الكثير من الشيب والتجاعيد – ولا تحتفظ أحلامهم وذواكرهم بصورة واحدة لإخوتهم أطفالاً – بينما قد كبروا وكبِرن سنيناً – ولا تقضمهم الهزيمة وقلّة الأمان في كل لحظة، ولا يبعثرهم الذعر من الزمن فيبدو لهم اليوم والبارحة والغد كأنهم لحظة ممتدة من الخيبات المتراكمة.

تكرّر ذلك الأمر بين عودتي للجامعة ثم اختفائي أياماً وأسابيع، حتى نهاية أكثر من منتصف السنة الأولى تقريباً. يتجهز الجميع للعطلة، بينما أنا واقفة امنع نفسي من الحركة كي لا أقع. وبينما تُخبرنا الجامعة عن خطوات التحضير للامتحان النهائي، أرسلتُ لهم بريداً إلكترونياً أُخبرهم فيه أنني لا استطيع الدراسة، وأعتذر لأنني أخذت مقعداً جامعياً كان من حقّ طالب أو طالبة غيري. يطلب مني دكتور ودكتورة في الجامعة برؤيتهم في المكان الذي أرغب، أُقابلهم في الجامعة، وأبكي مع كل كلمة، مع كل شعور بالظلم لأنني أملك ذاكرة مُتعبة، وبالذنب من عدم تقديري للفرص، وبالخجل من أنني لست «طبيعية» مثلهم.
بعد بكاء ونقاش طويل، أصل إلى خيار التمديد وإعادة الامتحانات النصفية التي لم أذهب إليها أصلاً. أبدأ سنتي الدراسية من شهر نيسان حتى آب، أنام في مكتبة الجامعة لأيام متواصلة لا أتحرك منها إلا لمحاضرة، أو لتبديل الملابس في بيتي القريب. أُنهي السنة كلها بأربعة شهور دون عطلة يوم واحد، وينتهي كابوس السنة الأولى. لكن فوبيا الخسارة وقلق الفقدان يجدان دوماً طرقاً جديدة للوصول إليّ، يظهران غير آبهين بالظرف والزمان والمكان. لكني بدأت أتعلم مع الوقت تمييزهما وإدراك الخطوط الفاصلة بين صوت القلق القادم من تراكم السنوات والخسارات، وبين صوت الحقيقة وموضع قدمي الآن. دخلت في سباق غير مرئي مع هجمات القلق والخوف، ومع العلاج والتدريب ومضي الوقت وإعادة المحاولات والوعود اليومية أن أكون أكثر رحمةً مع نفسي.
وبدأت أُسامح نفسي على تقصيري بالدراسة في السنة الأولى، مبرِّرةً بأنه تزامن مع خطواتي الأولى للتعافي من تبعات الماضي والحاضر، ومحاولاتي للنجاة نفسياً لا زمانياً وجسدياً ومكانياً فقط، وأيضاً بسبب الانتقال لحياة جديدة بشكل مختلف وبمدينة صغيرة وهادئة وأنني فيها وحيدة وبعيدة عن الأصدقاء. وتمضي باقي الأيام بين تلك الأصوات الكثيرة والكثيفة التي تزورني كل بضعة أيام لتخبرني أنْ لا فائدة، لن تصلين للتخرج، إنه أمر محتوم؛ وبين محاولات التعايش مع هذه الأصوات، وتجاهلها بالمقاومة اليومية والرغبة في العبور إلى ضفة أخرى، أقل قلقاً وارتباكاً وأكثر طمأنينة وثباتاً.
فلاش باك 2020
يتفاقم خطر الخسارة في السنة الأخيرة، سنة التخرج. يتحرك قلقي بسرعة ويُغيّر خطته بتخويفي بأنني لا أخسر الدراسة في السنوات الأولى بل السنة الأخيرة؛ في السنة التي أعمل بها على مراجعة بحثية لاضطراب ما بعد الصدمة لدى اللاجئين.
أقرأ في هذه الفترة عشرات ومئات الأوراق والمصادر والأبحاث، أرى فيها قصصَ وسردياتِ الناجين من التعذيب والحروب والاضطهاد في كل زمان ومكان، من العراق والبوسنة والسودان وسوريا وإيران. يوحّدهم الخوف والألم والجروح في الأجساد والأرواح، وتجمعهم سنين من المحاولات لدفن العذابات التي حمّلتهم بها بلادهم. يشارك بعضهم في هذه الأبحاث لأنه يريد أن يتعافى من حمّولة أوطانهم الثقيلة، ويهرب البعض لأنه لا يستطيع إخراج الجثث من قبورها المفتوحة.
قرأت في ورقة أن اللاجئين السودانيين، بعد أن شاركوا في أحد الأبحاث لاختبار شكل علاجي يسمى «العلاج بالتعرض السردي» – ويشمل سرد الأحداث ووضعها في سياق زمني ومكاني ومحاولة استذكار ما أمكن من التفاصيل والمشاعر التي رافقت الحدث – أخبروا الباحثين أن ينشروا شهاداتهم ويوثّقوها ويُخرجوها للعالم الذي نسيهم، وأن يوصلوها أيضاً لأولادهم ليعرفوا قدر معاناتهم وكفاحهم. إنهم باختصار يرفضون النسيان.
يُقتَل الإنسان مرة ثانية حين تُطوى معاناته، وينتصر المجرم ألف مرة حين تموت سير إجرامه وظلمه.
بينما لاجئون من دول ثانية رفضوا إكمال جلسات العلاج لأغراض بحثية لأنهم لا يريدون إثارة جراحهم، يريدون فقط أن ينسوا ويعيشوا بقية حياتهم دون هذه الذكرى، أي أنهم يرفضون الذكرى.
ولي صديقة تركية كنت أستشيرها خلال عملي على البحث لكونها تعمل على بحث دكتوراه عن اضطراب ما بعد الصدمة في جامعة مانشستر. أخبرتها أنني قرأت في أحد الأوراق العلمية عن علاج اللاجئين السوريين في مخيمات كلس في تركيا، أن السوريون في العلاجات لأغراض بحثية رفضوا تسجيل جلساتهم صوتياً لخوفهم من الحكومة السورية. تسألني: هل هذه حقيقة أم بارانويا بسبب الصدمات المتراكمة؟ لماذا يخافون وهم بعيدون وفي دول ثانية؟ يبدو الشرح سهلاً ومختصراً بأن خوفهم طبيعي وعادي لأنهم عاشوا في «سوريا الأسد» وتحت قانون «الحيطان إلها آذان»، ولكن فضّلتُ أن أحكي لها الأسباب بالتفصيل. والشرح الطويل لها جعلني أفكر أكثر: كيف يكون شكل التعامل مع التروما الجمعية بمعزل عن سياقها مسببها؟ كيف يكون شكل التروما الجمعية السورية بعيداً عن الأسد وأشباهه الكُثر؟ هل يمكن أن نتحدث ونبحث، ونعالج ونَصِف التروما الجمعية، دون معرفة الطرف الذي خلق كل هذا الخراب؟
يظهر حينها أنني أعيش أيضاً «فوبيا» خسارة الحقيقة والسردية. لا أرغب شخصياً بأن أروي حكايتي ضد مجهول، ولا أن تُوثَّق قصتي مجردة وخالية مني أنا وممن انتهكوا إنسانيتي. أرغب لروايتي الشخصية أن تمتلئ بالحقيقة والإنسانية. تُفزعني التسميات والقوالب الجاهزة والمختصرة والنتائج الحتمية التي تدور حول كل الناجين من الحروب. هذه الصدمات والخسارات التي كنت أقرأ عنها كل يوم في الأبحاث، كان عليّ أن أعيشها بوجهين، وجه حقيقي وإنساني وأرتبط به كلياً، ووجه أكاديمي مجرّد له شكل واضح ومتطلبات واضحة، مما جعلني أقصر كثيراً وأُطيل مدة عملي على الموضوع وأنا أحاول التوازن قليلاً. تأخُّري في تسليم البحث للجامعة أعادني إلى نقاط القلق الأولى والبكر عن الخسارة والاستحقاق والخوف. والحالات التي كنت أقرأها أعادتني للحظة الخسارة ذاتها، لليوم الذي بدأ فيه كل هذا، للوقت الذي تغير فيه شكل حياتي.
أسلّم البحث أخيراً، وأكتب ملاحظة في آخره بالتوصيات، وهي أنسنة اللاجئين وأنسنة الناجين من الحروب، وعدم التعامل معهم ضمن أدوات واحدة وصور نمطية تُفرَض عليهم باختلاف شخصياتهم وتجاربهم وحياتهم وأحلامهم وقدراتهم. ثم أعود بعد ذلك لقلق خسارة الجامعة، وكلما مرّ يوم باتجاه التخرج احترتُ بين الخوف والطمأنينة، بين الاقتراب من كسر هذا الخوف وبين تأصيله أكثر. ينتصر القلق مرات، والمحاولات ألف مرة، وأنقل نفسي خارج سوريا نفسياً كما مكانياً. أُقنع نفسي أحياناً بأنني أخاف من مرارة التجربة الماضية في فمي، من مرارة الخسارة القديمة الممتدة، من احتمالات الحياة التي جاءت بعدها، لا من خسارة قد تبقى حبيسة الوهم للأبد. أُقنع نفسي بأن الخسارة في حياة يُسمَح فيها بالمحاولات تختلف كلياً عن سلب هذه المحاولات ومعها الحياة في سجون الأسد.
شباط 2021
أكتب هذا النص وأنا اقترب من إكمال سبع سنوات على خروجي من فرع فلسطين. قبل مغادرته، كنت أعتقد أن كل شيء سيعود طبيعياً بمجرد أن أرى الشمس خارج جدرانه، لكنني بمجرد أن خرجت عرفت أن الخلاص الجسدي من سجونهم هو بداية لخلاص مختلف، لخلاص من امتداد وحشيتهم ومن مساحات وجودهم نفسياً في كل تفاصيل حياتي. لم يعد كل شيء طبيعياً دفعةً واحدة. يعود كل يوم القليلُ منه. أقاوم كثيراً، وأحاول كثيراً، وأحلم كثيراً، وبين كل محاولة وحلم ومقاومة يظهر بعض من شطحات الذاكرة وذعر الخيبة. لا أنكر جراحي وصراعاتي وهزائمي، ولكن لا أتمسك بآلامها. أحرص على ذاكرتي ولكني لا أعطيها الحق بأن تُدخلني في سراديب مظلمة. معركتي الأزلية واليومية أن أحاول ألا أُسجَن مُجدداً وأنا بعيدة آلافَ الأميال؛ ألا أسمح بسلطة السجانين على حياتي؛ أن أبصقهم هناك في عتمتهم، وأن أُحرِّر ذاكرتي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. على جدران السجن استعرت هذه العبارة من محمود درويش: «ونحنُ نُحبُّ الحياةَ إذا ما استطعنا إليها سبيلا». كتبتها بورقة القصدير التي كانت داخل علبة دخان قديمة موجودة في الغرفة. كتبتها من جملة ما نكتب في السجن كي نخفف وحشة الأيام، ورتابتها، وتكرارها، ومجهولية المصير، ولانهائية الزمن. عندما خرجت، وبدأت أعيش مع كوابيسي الفردية، وكوابيس السوريين اليومية من قصف وقتل وتعذيب ونفي، رفضت هذه العبارة واعتبرتها هُراء.
لا أرفضها الآن، ولا أعرف إن كنت أريدها كما قالها درويش. لكنني أحاول وأحب النجاة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأعرف أن الحياة ممكنة بعيداً عما رسمه الأسد للسوريين. أحاول ترويض وكبح جماح وهم الخسارة من اقتحام أيامي. أحاول أيضاً تطوير آليات نفسية واجتماعية تسند ظهري وتطهّر بعض الجراح، وربما تتركها مكانها كندوب قد لا تزول، لكنها لا تُعيق الحياة ولا الحركة. وجودها فقط للتذكار والحقيقة، ولأن وجودها أصلاً قائم على عدم زوالها نهائياً؛ على الأقل حتى تتحقق العدالة.