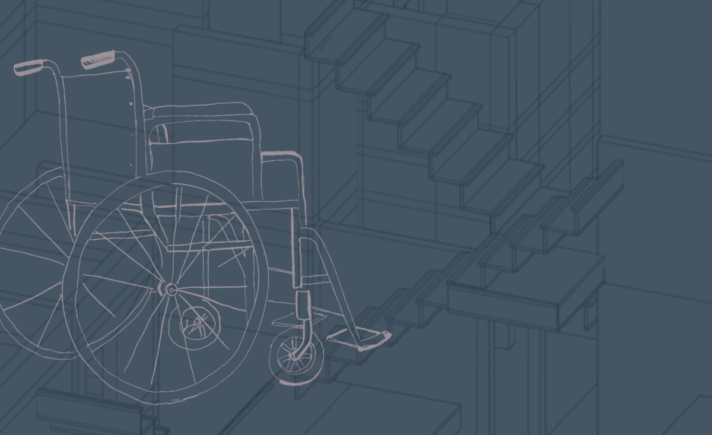حسان العزيز،
اقترحَ صديقٌ أن نجتمع في جنازة رمزية في باريس لنودعك، في الهواء الطلق بسبب استحالة الصالات المغلقة في ظرف الحجر الصحي الحالي. فكرت أنه قد يكون من الممكن أن نودعك على ألحان أحببتها، وما أكثر المراجع التي كنت تذكرها موسيقياً في صفوف دروس الترجمة. لم أتذكر أي اسم أو أي مقطوعة، ولكن يبدو لي والله أعلم أنك كنت تحب الجاز. أقرأ من ينعيك ويقفز قلبي، فكيف لي أن أنسى ما يذكره عدي الزعبي في أنك من محبّي البوم، جامع لمئات القطع من البوم، رمز الحكمة اليونانية كما كنت تقول. أحاول أن أتذكر شيئاً من النصوص التي كنت تسحرنا بعرضها علينا للترجمة، لم أعد أذكر النصوص، أذكر احساس الامتنان واحساس التعرف على الأشياء في غرفة من غرف القبو في المركز الفرنسي في البحصة، منذ اللحظة الأولى التي قدمك فيها جمال شحيّد كأستاذنا الجديد بعد عودتك من فرنسا. أليس هذا أفضل ما يتركه معلّم لطالب؟ لذة التعرف؟ وذلك السحر الذي ظل يرتبط بسحر رواية مولن الكبير لآلان فورنييه. لم أعد أتذكر شيئاً من تفاصيل الرواية والأحداث، ولكني أتذكر مشاعر الخطف والسحر. النصوص التي كنا نقرؤها معك ومع ديمتري وجمال كانت تعطيني نفس الشعور، سحر وانخطاف.
كنت تتعجب من سذاجتي الممزوجة بعماء وعند. «ألم تنتبهي حتى الآن أن فلان شديد الإعجاب بك؟» بالله؟ ما انتبهت؟ «ما هذا الخيار الجامد ؟ دبلوم دراسات عليا باللسانيات؟» لازم تكتبي أدب وتترجمي. صحيح ماذا حلّ بفلان المعجب بي؟ الشاب الشاعر البكّاء الذي رعيته كما كنت ترعى الجميع وتنتبه لأدق تفاصيلهم؟ ما أتذكره، يا حسان، أنك كنت ترى بدون نظاراتك. المثقفون في بلادنا يكونون عادة محاطين بطبقة مغناطيسية لصيقة بأجسادهم، منشغلون بسرّاتهم ولا يرون الآخرين إلا بقدر ما يعكس لهم هؤلاء الآخرون ما يرضيهم عن أنفسهم. كنت ترى الآخر، حين تنظر في عينيه تنظر فعلاً ولا تكون شارداً. ترى دون انشراط بطقوس و إشارات بلدنا الرهيب. في بلدنا الرهيب الذي ليس لنا بلد غيره، كما يقول ياسين، الناس متخصصون في علم القبّان، قبل أن تراك وتنظر في عينيك ترى ما تمثله وما تزنه فعلاً من سلطة ومن سطوة ومن قدرة على الوصول وإيصال الآخرين. لم تمتهن القبّان، كنت ترى جمال الجميع دون وزنهم بموازين بلدنا.
لم أعد أذكر ما المسرحيات التي دعوتنا، نحن طلابك، لنحضرها. لكني أتذكر ما بقي من انطباع عند رؤيتك على درجات مسرح الحمراء مع الدكتورة زهرة، إذ كنا نثق بأن المسرحية جديرة بالمشاهدة. أول مرة دخلت مكتبة معهد دراسات الشرق الأدنى في أبو رمانة، لأستعين بمراجعهم اللغوية عند تحضيري لحلقات بحث في اللسانيات، كنت أرتجف من الخجل، كنت أشعر أنه ليس مكاني وأني غريبة. مشكلتي الأبدية أني لست مشروعة في أي مكان. أخذتني من يدي وعَرَّفتني على كل العاملين، من أمين المكتبة إلى مسؤول الاستقبال، وعرفتني على سهيل شباط وعلى أستاذ لغة عربية وعلى دارس يهيئ لقاموس لهجة شامية، لم أعد أذكر كل الأسماء، أذكر مشاعر الأمان والعرفان.
أعرف أن موضوع الذاكرة يقلقك، الذاكرة التي أصبحت هاجسك في السنين الأخيرة، ولكني فعلاً نسيت اسم اللحم المقدد الذي كنت تحبه وتشتريه من البرتغال في سفراتك العديدة للشبونة للتنسيق مع هيئات متوسطية نشاطات وفعاليات وتأهيلات شبابية حول المواطنة، ولكني أذكر ما بقي في إحدى زوايا دماغي حين دعوتناإلى بيتك وطبخت، كل ذلك الحب الغامر والدفء.
مرة، كنت أنتظرك أمام باب المعهد الفرنسي، ولم أرَ طفليك يزن وآرام يخرجان من السيارة لتودعهما في بيت أهلك المقابل للمعهد، وكانا أقصر من زجاج السيارة في النصف الأول من التسعينات. لم أعد أذكر أي شيء من تلك الحادثة إلا انطباعي عن أناقة وأثيرية بالتعامل مع طفليك، ومع والديك اللذين كانا ينتظران على الشرفة وأنا المنتظرة على الرصيف المقابل. أعتقد أنك كنت تحاول اقناعي بترجمة كتاب ما حول ماركس؟ تلك الأناقة الغريبة التي لا أعرف ما هي، أحسستها أيضاً بعد سبعة عشر عاماً، نيسان 2013، في عيونك المنهمرة بكاءً على رحيل أكرم أنطاكي. حين انتهى القداس وخرجنا من كنيسة الصليب، تفاجأت بدموعك، قلت حينها للحاضرين أنها نهاية إقامتك في سوريا وستغادر إلى لبنان، لم أعد أذكر بقايا الكلام حينها، ولكني أذكر أناقة البكاء وتلك الأثيرية المنسجمة مع ذاتها دون تغيّر، وحزننا جميعاً .
لم نلتقِ كثيراً بعد الثورة، قليلاً في بيروت ومن ثم باريس التي أحببتها. في لقاءاتنا المقتضبة كان هناك عمل، تعمل الكثير، بصمت ودون جعجعة. منذ اللحظة الأولى كنتَ تدركُ معركة محو الذاكرة، الذاكرة الجمعية، وكل ما فعلته في حياتك كان متسقاً مع ذلك الهم. لا تتضح الصورة إلا في لحظة النهاية، وكأن صنيعة الحياة عليها ألا تتبدى كاملة إلا بأناقة ثوب اللحظات النهائية، فراشة ملونة من شرنقة. أتابع أرشيف مركز دراسات الشرق الأدنى في دمشق، لقاءاتك المسجلة في الأمسيات الثقافية مع الكتاب، النادي السينمائي، سلسلة شهادات سورية، كتاب التراث الموسيقي السوري، نفس الانسجام.
في لحظات خاطفة وقليلة، كنتُ أستشعر عندك بعض المرارة بأن عملك العميق والدؤوب لا يُقدَّر تماماً حق تقديره. هذا ثمن الأناقة يا حسّان، الأناقة التحت-جلدية كما يصفها ياسين السويحة، الذي كنتَ تكرر لي كم تحبه. أن تدخل كجزء مضمون في كادر حياة الجميع دون أن تخبط قدميك على الأرض، مثل خلفية موسيقية كاملة الانسجام لا يوجع إلا انقطاعها، إزميل يحفر دون ضجيج، موجود فقط.
في المشهد النهائي لفيلم مازلت أليس لجوليانا موور، بعد أن تنسى أليس المصابة بالألزهايمر كل شيء وكل تفاعل، تتكلم معها ابنتها وتسألها «هل تفهمين ما يعنيه كلامي؟» لتجيب الأم: «الحب». قد ننسى التفاصيل لشدة أثيريتها وسلاستها ومرافقتها الطبيعية للحياة وكأنها مضمونة لن تنقطع. ولكن أثر الموسيقى يبقى حتى لو نسينا العلامات. المحبة والأناقة والكرم تبقى، حتى لو أصابنا ألزهايمر، مثل الموسيقى التي كنت تسمعها في أيامك الأخيرة يا حسان.