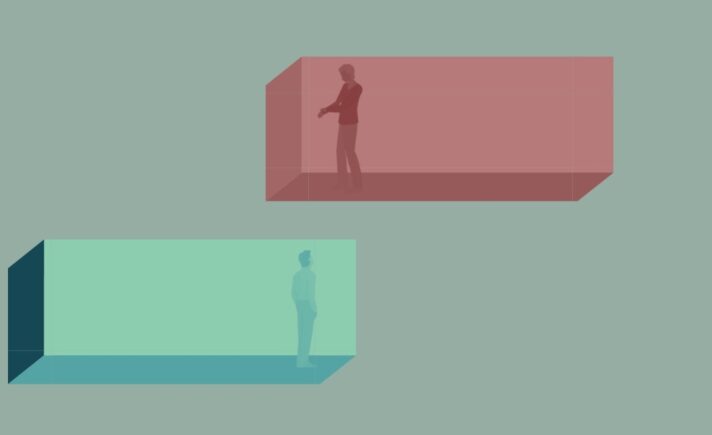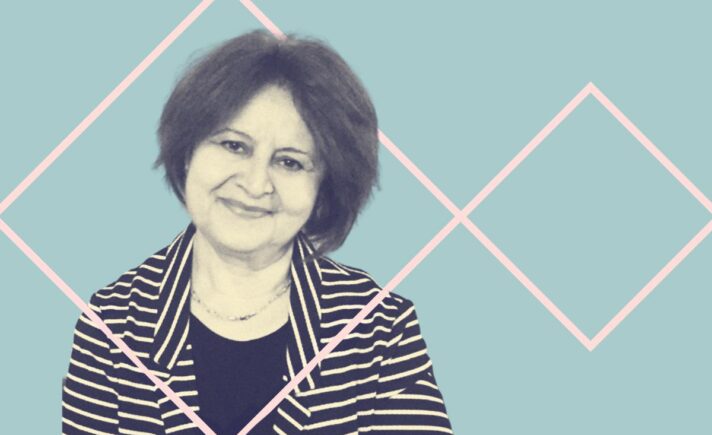ما عدا القلقلة التي يتسبب بها طرحُ المواضيع النسوية الجدية في الحياة الواقعية والافتراضية، إلا أن المزاج العام بين الناس هو تَغزُّلُ الرجل بالمرأة على الملأ، وتأفُّفُ المرأة من الحب بين السرّ والعلن. يتغنى الرجل بالمرأة الوطن التي التفت حول خصرها النجومُ، وحارت بنهديها الغيومُ، غير أنها بدورها تزدري الشِعر ولم تعد كلماته تنطلي عليهاِ بسهولة، فلا تتورع عن إطلاق النار على ملاك الحب كوبيدو إن لزم الأمر.
ما زلتُ أذكر جيدًا تلك الأمسية حين اجتمعتُ مع عدد من الصبايا السوريات ممن لجأنَ إلى هولندا مؤخرًا، وكان لا بد للكلام أن ينتقل في آخر المطاف إلى موضوعنا الأثير: الحب! تساءلنا كيف نُعرِّفُ الحب؟ قالت إحدانا: «الحب هو شعوركِ باهتمام الآخر بكِ، وليس فقط عطاؤكِ له!». عادة ما تنبع التعريفات عن تجارب معينة، ولا حاجة برأيي أن أُفصِّلَ أي تجربة أدت إلى تعريف الحب بهذه الطريقة. وما زلتُ أذكر كيف انتقلنا من الحب مباشرة، ودونما تردد، إلى العلاقات العاطفية المعقدة، والتي نعجز عن الخروج منها أحيانًا. ولاحظنا صدفة أن أكثر من واحدة منا أنهت علاقة ميؤوس منها، ولم يعد ينفع الترقيع معها، بعد أن جلست جلسة صدق مع نفسها، واكتشفت أنها لا تريد أن تبلغ سن السبعين إلى جانب إنسان لا يهتم سوى بنفسه. هل محض صدفة أن كثيرات مررنَ بهذه التجربة الخاصة جدًا؟ ولا أخفيكم كم مرة قالت الصبايا بصراحة: «لا أريد رجلًا عربيًا!». يبدو أن خيبة أمل النساء كبيرة، ومن الأفضل أن يستيقظ الرجال من أحلامهم الوردية، فالأمور ليست على ما يرام. لا ضير من أن يَحكُّوا رؤوسهم قليلًا، ويفكروا ما الحل مع هؤلاء الجميلات اللواتي اكتشفنَ أنهنَّ غير قادرات بعد الآن على الألم، ويستمعوا إلى آرائهنّ في الحب، ويخرجوا من صومعة الغَزَل الصوري غير الموجه إلى حبيبة بعينها، والذي يدل على انفصال عن الواقع وتوحد.
من الطبيعي أن يولد الإنسان بدرجة لا بأس بها من الشعور بالأمان والثقة، والتي سوف تتكرس أو تتراجع وفق التجربة الحياتية التي يمر بها. يسلّم الوليد نفسه لمن يعلّمه من خلال الحدب أو القسوة في أي اتجاه يسير، وهل سوف يبقى واثقًا أم يرتاب. وحين أربط بين هذه الثقة الطفولية والفرق الذي لمسته في موقف الرجال و(بعض) النساء من الحب، أستنتج أن الرجال بشكل عام ما زالوا يشعرون بالأمان في علاقاتهم العاطفية، وما زالت فطرتهم حيال الارتباط معافاة، وما زالت العلاقة مع المرأة تمثل سندًا عاطفيًا لهم. صحيح أنهم يكافحون ويشقون ويعانون من أوضاع العالم المتردية، غير أن ذلك يحصل في معظم الأحيان ضمن بيئة لا تصب عداءها على كيانهم كذكور. وهذا هو الوضع الطبيعي.
أما الوضع «غير الطبيعي»، فهو موقف (بعض) النساء المستجد من الحب، والذي يوحي بشعورهنّ بفقدان الثقة. ما الذي حصل حتى باتت هؤلاء النساء لا يترددن عن إطلاق النكات اللاذعة حول الحب، والتي تدل على ألمٍ عميق: «الحب هبل!» أو «هذا ليس حبًا يا عبيطة، إنها الهرمونات!» أو «قضيتُ نصف حياتي عاشقة، إلا أن النصف الآخر كان أجمل!» أو «لست مُطلّقة، أنا طليقة!». في الحقيقة أستغربُ أن يستغربَ أحدٌ الارتفاع المفاجئ في حالات الطلاق بين السوريين والسوريات في السنوات الأخيرة. أو أن يتساءل البعض من أين جاء الغضب العام والتشاؤم العاطفي لدى النساء؟ هل من المعقول أن اختلال الموازين لم يكن واضحًا كعين الشمس للجميع؟ يبدو الأمر كذلك، فقد أثبت الواقع مرارًا وتكرارًا أن النساء بالعموم سبّاقات في التقاط الحس العنصري ورموز الاضطهاد في القضايا الجندرية مقارنة مع الرجال. موقعهنّ في الهامش يؤهلهنّ لاستيعاب منظور المهمشات ومنظور المركز في آن، أما أصحاب الامتيازات فيحتاجون وقتًا طويلًا وحسن النية كي يكتشفوا نقاطهم العمياء.
في رأيي، لم ينبع موقف هؤلاء النساء «غير الطبيعي» من الحب عن فراغ. يبدو أن تجاربهنَّ العاطفية مثقلة بالهمّ والغمّ. ولا أعمم هنا تجاهلًا مني للعلاقات العاطفية الصحية وحالات الذكورة الإيجابية غير القليلة، وإنما بغرض استخلاص النتائج التي لا تتجاهل التركيبة الأساسية للمجتمع. لا شك أن موقف المرأة «غير الطبيعي» من الحب نابع عن تراكمات وإدراك جديد لمعادلة الهدر التي هي ضحيتها الأولى، هدر لِطاقاتها وكيانها الإنساني ومصالحها وصحتها الجسدية والنفسية. لطالما استثمرت كل ما لديها من جهد وعمرٍ في العناية بأفراد أسرتها، وطوت أحلامها وذاتها في سبيل الدفع بهم نحو الأمام، لتجد نفسها بعد كل ذلك الكرم صفر اليدين، أو وحيدة أمام اللامبالاة والأنانية تارة، والتجبر والعنف والغرور تارة أخرى. لذلك لا عجب أبدًا أن «تنطلق» بعض النساء، حالما تتوفر لديهنّ فرصة الاستقلال في بلد يرعى حقوقهنّ كنساء.
طبعًا لا بد أن يعتبر بعض مرهفي الحس كلامي كُفرًا، إذ أن كل شيء مباح إلا المساس بالحب. ولكن لماذا لم يحنق هؤلاء قبلًا حين رأوا بأم العين أن العلاقة العاطفية داخل الأسرة وخارجها غالبًا ما تكون مبنية على تمييز أحد الطرفين على الآخر؟ لماذا لم يغاروا على الحب حين لمسوا أنه قلّما ساعد على خلق توازن في المصالح بين الجنسين، وما زال الارتباط العاطفي يُفضي في كثير من الأحيان إلى علاقة غير متوازنة اقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا وثقافيًا ونفسيًا؟ دعونا لا نكذب على أنفسنا، ونتذكر ما أشار إليه جون ستيوارت ميل في كتابه استعباد النساء (1869) حول أن العاطفة التي تُكنّها المرأة للرجل هي للأسف ذاتها السلسلة التي تبقيها أسيرة مكانتها المتدنية. ذلك أن الرجل، في رأيه، لا يريد طاعة المرأة فقط، بل يريد مشاعرها أيضًا. ينبغي أن تخضع له بكامل إرادتها، لذلك تنوعت وسائل استعباد العقل التي تعرضت لها عبر التاريخ، كي تتعلم فن الجذب وأن تطير فرحًا حين تنال إعجابه ورضاه. لا توجد فئة مستعبدة أخرى تلعب المشاعر في استعبادها هذا الدور الكبير. لذلك يعتبر وضع النساء الأصعب على الإطلاق.
رغم نبل الحب، إلا أنه ليس أكثر نبلًا من العدل. ولا ينبغي أن يكون حجة لظلم أي إنسان. قد يظن البعض أن الظلم في الحب لا يؤلم، أو أنه أقل إيلامًا من أشكال الظلم الأخرى. كم مرة سمعنا مقولات مقيتة على شاكلة «ضرب الحبيب زبيب». فأقول إن الظلم في الحب أكثر إيلامًا من أي شيء آخر، ففي الحب يكون الإنسان هشًا ومكشوفًا. وحين تزول الحدود بين البشر تنفتح الإنسانية على مصراعيها أو اللاإنسانية، يكتمل الإنسان أو يمعن ضعفًا، يمتلئ بالآخر أو يتعرى أنانيًا. ليست كل سبل الحب عطاءً متبادلًا بالضرورة. والواقع أثبت أن لا شيء مُقدَّس في المحبين.
لن أتوقف طويلًا عند حالات الارتباط العاطفي خارج نطاق الزواج في مجتمعاتنا أو بين الجاليات العربية في المهجر، فهذه تحتاج إلى دراسة خاصة تسبر وضع المرأة فيها. إذ يحصل أن يرتبط الرجل والمرأة في علاقة غير مُشهَرَة لأسباب تخصّهما، أو لأنهما ما زالا في طور التعارف. اللافت أن بعض هذه العلاقات تصاحبها انتهاكات تبقى غالبًا مجهولة، ولا تعرفها سوى المرأة نفسها، ولكنها لا تجهر بها، نظرًا لبشاعتها، أو لوقوعها خارج حيز القانون واعتراف المجتمع. تبقى تلك التجارب طي الكتمان، ولا تسترد المرأة حقها طيلة حياتها. فضلًا عن أن معظم حالات التحرش الصريحة، التي يقدّر أنها تشمل نسبة كبيرة من النساء، تُسوَّقُ على أنها إعجاب وهيام. ليس بالضرورة إذن أن يجلب الالتفاف على مؤسسة الزواج تحررًا للمرأة كما يظن البعض، بل أميلُ إلى التفكير أن الانتهاكات التي تحدث خارج نطاق الزواج أكبر من التي تحصل داخله، وإن كانت أقصر أمدًا بالعموم. ذلك أن المرأة تتخلى عن الضمانات (مهما كانت واهية) التي يقدمها الزواج التقليدي دون أن تحصل على أي بديل عنها، بينما يستمر الرجل بإملاء قواعد اللعبة. من دون الرقابة الإيجابية التي يمارسها الأقارب والأصدقاء عادة على الزوجين في مجتمعاتنا، تصبح المرأة من حيث المبدأ في مهب النوايا الطيبة وغير الطيبة، وقد تُعرِّض أحاسيسها إلى سوء المعاملة أو تذهب ضحية ما يعرف بقضايا الشرف. فضلًا عن أن هذا النوع من التحرر لا يعفيها أوتوماتيكيًا من مسؤوليات المرأة التقليدية، وقد يشارك الشريكُ المجتمعَ بمعاقبتها على خروجها عن المألوف. أجل، يحصل أن يسحب الشريك كمجتمع صغير البساط من تحتها، لأنها لم تكن كما حسبها في البداية. كان عليها أن تصمد أمام غزله ومحاولاته اللحوحة. كيف سيتزوجها الآن؟ قولوا له!
أما في العلاقات الزوجية، فالوضع يختلف بالعموم. يدخل الرجل والمرأة مركب الزوجية على أمل أن يكون أحدهما سندًا للآخر، وقد يستمر العسل دهرًا في حال لم يَخُنهما الحظ، وتَحمَّلَ كلاهما المسؤولية العملية والعاطفية حيال الأسرة. ولكن يحصل كثيرًا أن تتحول العلاقة إلى عملية استلاب المرأة لخدمة الأسرة والبيت، وتوجه الرجل إلى العالم الخارجي بشكل أساسي. يتقلص عالمها ولا يجد عقلها مجالًا للنماء، بينما يتابع هو التعلم من الآخرين عبر التجربة والوقوف بعد السقوط. وهذا الوضع ليس خيارًا من بين عدة خيارات تتخذه المرأة طوعًا، وإنما منظومة مفروضة عليها في أغلب الأحيان، ولا مناص منها حتى ولو تزوجت رجلًا متعلمًا يقارع التقاليد بالكلمات دون الأفعال. لا يعارض عملها خارج المنزل شريطة ألا تهمل بيتها وزوجها وأطفالها، ولا مانع أن تقرأ وتدرس شريطة ألا تتوهم أنها تفهم أكثر منه، أو تقدّم انشغالاتها على انشغالاته الأهم من حيث المبدأ، أو تبرز فَيتجاوز عالمها حدود عالمه. كم محبط أن نكتشف أن معظم الرجال المتعلمين لا يختلفون فعليًا عن غير المتعلمين بما يخص أمور المرأة. يعتبرون أنهم حفظوا الدرس، وصاروا متحررين في حال تركوا لزوجاتهم حرية الملبس (السفور مثلًا) أو لم يقفوا عائقًا أمام خروجهنّ إلى العمل. يخلطون بين مظاهر العصرية السطحية والعدالة الأصيلة. والمحصلة هي أن يحرّر الزواجُ العصري الرجلَ من مهامه التقليدية (المهر والمسؤولية المادية الحصرية حيال الأسرة) دون أن يضطره إلى تعويض ذلك بمشاركة حقيقية في الرعاية والمسؤولية العاطفية، بينما يحمِّل المرأةَ أعباءً عصرية فوق أعبائها التقليدية. نأتي هنا إلى نقطة هامة: نظرتنا إلى العطاء كفضيلة أنثوية!! حين تعطي المرأة بلا حدود وتتحمل مرارة الحياة بصمت، سوف ترتفع مكانتها الاجتماعية. طبعًا هذا النوع من العطاء مشروط بإنكار الذات والرغبات، ولا يستجدي عطاءً بالمقابل. كم مرة تعرّفتُ على أسر تضع احتياجات الزوجة/الأم في نهاية قائمة الأولويات. ولكن حين لا يحضّ العطاء على عطاء مماثل من الطرف الآخر، هل بإمكاننا أن نسميه عطاءً، أم أنه شيء آخر؟ لا شك أن في هذه المعادلة هدرٌ لكيان المرأة وطاقاتها وحقوقها.
يحصل هذا الهدر في أحسن العائلات، والأمور سوف تسير طالما القاضي راضٍ. ولكن يحصل أحيانًا أن يتدهور الوضع جزئيًا أو كليًا حين تتذمر المرأة أو تتمرد أو تحاول تعزيز مكانتها دون التضحية بذاتها. وهنا ستفقد هالة القدسية لا محالة، لأنها لم تحمل الأسى إلى نهايته. قد تنجح في شد اللحاف إلى طرفها قليلًا، ولكن فشلها سيجعل الحياة الزوجية جحيمًا لكلا الطرفين. ففي محاولة منه لإعادة الأمور إلى عهدها السابق، ينقلب الزوج عنيفًا من باب «الموانة». وقد يمارس ذكورته السامة التي لن تقبل بالهزيمة إلا بعد قلب الطاولة على الجميع. وتتنوع ردات فعل الزوجة من محاولات «عقلانية» لعدم إغراق السفينة بالذي فيها، إلى محاولات تحطيمية يرتد الجزء الأكبر منها إلى داخلها. ليس لأنها ليست عنيفة، بل لأنها سوف تكون الخاسرة الأولى، وتُعاقَب على عنفها أضعافًا مضاعفة. الغريب أن المرأة تصبح مسؤولة عن عنفها وعنفه على حد سواء. ويحصل طبعًا أن تستسلم وتعود للرضوخ، خوفًا منها أن يمسكها شريكها من اليد التي توجعها: أطفالها.
لا أعتقد أن هذا هو الحب الذي تدافعون عنه، أليس كذلك؟
دعونا نفترض رغم كل شيء أن الشريك كان «أكابر» ولم يُرِها السبع نجوم، ولم يهددها بأطفالها، ولم يتركها لا مطلقة ولا معلقة، ولم يمتنع عن دفع نفقة الأطفال، ولم يحاول أن ينتقم لأنها تجرأت على هجره. هؤلاء الرجال موجودن أيضًا، وهم ليسوا قلة لحسن الحظ. ولكن نبلهم نابع من ذواتهم، وليس لأن لدينا قوانين منصفة تحمي المرأة. العدل في بلادنا متروك للضمير البشري المعروف أنه يخطئ ويصيب، يعتدل ويستشيط. ولكن لو أراد الرجل أن يمرمط المرأة، سوف يجد مائة طريقة قانونية وغير قانونية تتراوح بين التشهير بسمعتها إلى إيذائها جسديًا و/أو نفسيًا. وقد يتصاعد العنف الجسدي و/أو النفسي بشكل مروّع حين يفقد الشريك الرادع الاجتماعي المباشر، أو حين تكون المرأة بلا ظهرِ يسندها، كما في زمن التفكك الاجتماعي الذي يرافق الحروب، أو كما هو الحال بين المهاجرين/ات واللاجئين/ات، عندئذ لن تكون حالات القتل أو التهديد بالقتل نادرة على الإطلاق.
ولكن دعونا ننطلق من السيناريو الإيجابي، ونفترض أن الأمور لم تصل إلى ذلك الحد، وأن خسارات المرأة المُطلَّقة كانت في حدود المعقول، وأن محاولاتها في توجيه السفينة إلى برّ الأمان نجحت نوعًا ما. ماذا ينتظرها الآن يا ترى؟

من الناحية النظرية ما زالت الدنيا مفتوحة أمامها، ويمكنها البدء من جديد متى أرادت، مثلها مثل الرجل. ولكن عمليًا سوف تنكفئ على نفسها جراء الخيبات المتكررة، والأرجح أن تبقى وحيدة طيلة حياتها إن لم تكن صغيرة السن، وباهرة الجمال، ومن دون أطفال وطموح على الصعيد الشخصي. كما أنها قد تحتاج إلى طاقة كبيرة لكبت عاطفتها خشية استغلالها من قبل من يريد تجريب حظه مع امرأة أربعينية دون التزامات أخلاقية، وخاصة أنها الأدرى بالعواقب النفسية و/أو الاجتماعية التي ستنال منها حصريًا. فضلًا عن أن قطار الحياة لا ينتظرها، ريثما يكبر أطفالها ويكفوا عن الاحتياج إليها. وبينما يتعامل الناس معها بمزيج من الريبة والخوف والحذر والفضول، نراهم أقرب للشفقة على الرجل المطلّق. يا حرام، من سيعتني به الآن؟! ولكنه سرعان ما يعاود محاولاته الطبيعية والصحية بالارتباط، وليس مستبعدًا أن يبدأ من جديد مع امرأة أصغر سنًا من الأولى، ولكنه سوف يكون هذه المرة أكثر حذرًا باختيار واحدة على قدر أسنانه: غِرّة وبتول. لأنه لن ينسى أن يستقصي تاريخها، قبلة قبلة، قبل أن يقع في الفخ.
تقولون الآن إن العيب في المحبين وليس في الحب، وعلى الأرجح أنكم محقون. ولكن ماذا نحتاج كي نعيد تأهيل هؤلاء المحبين، ونحفظ كرامة الحب كعاطفة نبيلة تربط بين قلوب البشر؟
من الواضح أن مشاكل الحب التي ذَكرتُها لا يمكن حلها جذريًا على المستوى الفردي فقط. قد نطالب رجالنا أن يقرؤوا أهم عشرين كتاب نِسوي عالمي، على أمل أن يخرجوا قليلًا عن التمركز حول أنفسهم وامتيازاتهم، ويلمسوا جزءًا من معاناتنا، ويعيدوا لنا حقنا بالغضب دون اللجوء الواعي أو اللاواعي إلى تقزيم آرائنا، واللف والدوران حول رغباتنا غير المحققة لتصبح مصدرًا للتهادر المتبادل، بدلًا من أن تكون بداية لتفاهم أعمق أو وئام. ولكننا ندرك منذ الآن أننا لن نلقى التجاوب الكافي من الجميع. لا شك أن هناك رجالًا يحاولون ببطء أن يشتغلوا على أنفسهم، ويعترفون أنهم يتحمّلون جزئيًا مسؤولية تجاوز المسافات بيننا، التي لم يصنعوها بأنفسهم فقط وإنما جاءت نتيجة عملية تأهيل مجتمعية طويلة الأمد. ولكن عدد المحظوظات اللواتي تعثّرن برجلٍ من هذا النوع ليس كبيرًا إلى درجة تتغير معها المعادلة العامة، وأنصحهنّ ألا يَبُحنَ بتجاربهنّ الإيجابية أمامنا، كيلا نصيبهنّ بالعين الحسود.
من أجل حفظ كرامة الحب، سوف نحتاج أولًا إلى الربط بين هموم المرأة الواحدة وهموم جميع النساء، لأنه حين تبقى همومنا حبيسة المجال الخاص، ولا نقدر على البوح بها، سوف نظن أنها مشاكل شخصية بالدرجة الأولى ويتعيّنُ على كل منا أن تحلّها وحيدة. أما حين نعترف أن مشاكل النساء أكثر تشابهًا وتقاطعًا من أن تكون مشاكل فردية، ونخرج بها سوية إلى المجال العام، ونحمّل مسؤوليتها على عاتق المعنيين بها مباشرة وغير المعنيين، أي حين يصبح الشخصيُ سياسيًا، ويتحول الألم الفردي إلى قضية عامة، سوف نكون خطونا خطوتنا الأولى نحو التغيير.
ينبغي إذن أن نشتغل على عدة مسارات تتقاطع فيما بينها. الأول سياسي/قانوني، والثاني ثقافي/اجتماعي. نحتاج أولًا أن نغير عن طريق السياسة جميع القوانين الخزعبلية التي تكرس عدم المساواة بين الجنسين. هذا يعني إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي يفضّل الرجل على المرأة في أمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث والجنسية وغيرها. ليس مجرد تعديل مادة هنا أو مادة هناك، بل نسف القانون برمته. لا شك أن هذا الطريق طويل وشاق، وبخاصة ضمن ظروف انعدام الدولة والديمقراطية والأمان التي يعيشها السوريون والسوريات حاليًا. غير أن طرحه للنقاش في غاية الأهمية، نظرًا لتأثيره السلبي في حال وقع حيز التطبيق أو حتى بقي مجرد حبر على ورق. فالأفكار التي يطرحها القانون خطيرة، ولها تأثيرها النفسي على البشر. من ناحية يجعل القانونُ النساءَ يشعرن بقلة الحيلة والقيمة، فيتقبلّنَ الضيم كالقَدَر، ولا يحاولنَ النهوض بأنفسهنّ والخروج من العلاقات والظروف السامة. ومن ناحية أخرى ينفخُ الرجال، ويجعلهم يشعرون أنهم أكثر أهمية مما هم في حقيقة الأمر. الرجل الذي يصدق أنه قادر على أربع زوجات في آن، سوف يبالغ في هواماته حول قدراته الجنسية، ويتماهى لا شعوريًا مع هارون الرشيد، فيشعر ضمنيًا بالظلم إن اكتفى بامرأة واحدة، وقد يؤثر ذلك على تعامله مع النساء بشكل عام. والرجل الذي يقبل بفكرة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، سوف يعتقد عن وعي أو غير وعي أن قيمته ضعف قيمة المرأة، ويتوهم أن كلمته أعلى بالضرورة. من غير الممكن ألّا يكون لقانونٍ يعتمد مبدأ قوامة الرجال على النساء تأثيرٌ على التكوين النفسي للنساء والرجال على حد سواء. كيف استشرَت إذن حالات العنف المادي والمعنوي في جميع أرجاء المجتمع إن لم يكن ثمة تواطؤ بين تسلط ذكوري مُشرَّع وعجز أنثوي مُتعلَّم؟ لذلك لا بد من مواصلة مناقشة قانون الأحوال الشخصية ودحضه وتفنيده إلى ما لا نهاية، حتى ولو تبدّى أن تغييره على المدى القريب أمر غير قابل للتحقق عمليًا. هذه مهمة الجميع، وتحتاج إلى تعاضد النسويات الليبراليات والإسلاميات، فيشتغلن معًا من داخل المنظومة وخارجها، على النخر في القلاع الذكورية. ينبغي أن نرفع سقف مطالبنا، وألا نرضى بقانون يتناول الحب والزواج بلغة أقرب إلى تجارة السلعة، على أمل أن نقدر على اجتثاثه جذريًا مع الأيام.
وسوف نحتاج كذلك أن نشتغل بكثافة على المسار المجتمعي والثقافي لنُخرِجَ الحب من خانة الحرام، أو بالأحرى من خانة الحرام على المرأة دون الرجل. لا يمكن أن يكون هناك حبٌ خال من الخوف ومشاعر الذنب والحسابات غير الرومانسية، طالما أن العلاقة التي تجمع اثنين لا تُخضِعهما لمعايير العفة ذاتها. ليست صدفة أن تتشبث المرأة عادة بأمثولة الحب الأحادية، وتضع كل ثقلها على أول علاقة دخلتها على حين غفلة، ولم تجد فيها ما تستحقه كإنسانة كاملة القيمة، ولكنها لا تنبذها إلا بعد أن تتأكد أنها شارفت على أن تخسر نفسها. تربّت منذ نعومة أظفارها على أن أول حب هو آخر حب، فيخيب ظنها حين تكتشف أنها أمثولة كاذبة. لا أصدق أن ثمة كثيرات ممن يخرجن بطرًا من علاقة عاطفية، أو يطالبن بالطلاق قبل أن تتقطع جميع السبل. في حين ينحو معظم الرجال إلى التعددية العفوية في استهلاك الحب واستبداله، إلى أن يجدوا من يقنعون بها جمالًا وشبابًا وتواضعًا ليعقدوا معها زواجًا تقليديًا. هذه الفروق بين المعايير المفروضة على الجنسين تؤدي إلى رضوض نفسية واجتماعية يكون للمرأة النصيب الأكبر منها. من ناحية تجد نفسها مطالبة بالحفاظ على عذريتها والابتعاد عن جميع الشبهات، ومن ناحية أخرى مطاردة من قبل ذكور يطلبون ودّها. لن يسعها حلّ هذه المعضلة إلا بالنفاق، حيال النفس أو حيال المجتمع.
ليست المرأة وحدها المضطرة إلى النفاق، بل كذلك الرجل. ذلك أن معايير العفة تنطبق عليه أيضًا، وإن بشكل غير مباشر. هو مطالب بحراسة نسائه، ولكن ماذا عن بنات الناس؟! هل هو مسؤول عنهن أيضًا؟ يعاني الرجل من انفصام سببه تلك المفارقة بين قيمة المرأة قبل أن تصبح امرأته وبعد ذلك. ومن هنا يأتي السؤال المشهور الذي يتداوله الرجال فيما بينهم: «هل ترضى ذلك على أختك؟». من ناحية نراه يفنى من أجل الحصول على خطافة القلوب، ولكن ما إن يتحقق مرامه حتى تتلبسه حالة قلق عجيبة، ويبدأ يشك بقيمة المرأة التي أدخلها لتوه حياته وصارت منه. يسألها مندهشًا: ألم تندمي؟ وكيف لا تندمين؟ وهنا تبدأ عملية عكس شعوره بالنقص إليها. وفي حال استمرت العلاقة أكثر مما قدّر لها الحب، ولم تصبح خراءً منثورًا، لن ينسى أن يفرك الملح في الجرح ويذكرها بين الحين والآخر أنها سقطت. وحتى ولو تَحمَّلَ المسؤولية وتزوج منها في آخر المطاف، ستبقى تلك السقطة سيفًا مسلطًا على رقبتها إلى يوم الدين. والمشكلة أنه كان معها منذ البداية، خطوة خطوة، ويدرك تمامًا أنها لم ترمِ نفسها عليه، ولكن هل يحق لها ما يحق له؟ قد لا ينطبق ما أقوله هنا على جميع الرجال بالطريقة أو بالدرجة نفسها، ولكن أعتقد أن فكرتي وصلت. ومن اللافت في هذا الصدد أن بعض رجالنا الشرقيين مستعدون أن يغيروا فجأة من أنفسهم في حال تسنى لهم الارتباط بامرأة أوروبية/ غربية. يا لعجبنا حين يصبحون متحررين فجأة، ويتخلصون من عقدهم الذكورية، ويحدّون تلقائيًا من ازدواجيتهم وبعض تسلطهم، ويتقبلون المرأة كما هي، بعجرها وبجرها، بماضيها وحاضرها وطموحها، حتى أنهم يبقون مهذبين في حال باءت العلاقة إلى الفشل رغم التنازلات. تصوروا؟! السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا يفعلون ذلك مع بنات جلدتهم أيضًا؟ وإلى أي غور وصلت بنا التناقضات؟
وطبعًا لم أتكلم بعد عن سلوك بعض الرجال الجنسي. لا أدري لماذا يعتقدون أن المتعة خُلقت من أجلهم فقط؟ يخطر على بالي أحيانًا أن أدخل في عقولهم، لأرى كيف ينظرون إلى المرأة ويتواصلون معها. هل سأستغرب إن اكتشفتُ أن أحدهم يفكر مثلًا أن يكتب رواية يكون قضيبه البطل الحقيقي فيها؟ لا شك أن جسد الرجل يختلف عن جسد المرأة، ولكن ليس إلى تلك الدرجة. ليس إلى درجة ألا تتذوق بعض النساء الذروة طيلة حياتهن الزوجية التي قد تمتد لعقود. يحصل هذا دون أن يشعر الشريك بالمسؤولية حيال ذلك. لا حاجة أن يتعب نفسه، المشكلة عندها. المهم أنه تَخلَّصَ من احتقانه، تصبحين على خير! ولكن ألا تنشأ العلاقة بين شريكين، وتتأثر بهما معًا، تنجح أو تفشل لأسباب تخصهما كثنائي؟ دعونا نفترض أن سلوكه نابع عن جهل بجسد المرأة لا أكثر، وهذا ممكن لأن ليس للمجتمع الذكوري مصلحة بالعناية بالجسد الأنثوي. ولكن لماذا لا يتوانى ذلك الرجل الذي يواجه مشاكل بالانتصاب عن صب غضبه على رأس شريكته، أو حتى إهانتها، لأنها غير قادرة أن تثيره برأيه؟ من قال لهؤلاء إن المرأة في خدمتهم؟! صحيح أن هذين المثالين يستعرضان حالتين قصويين، ولكنهما حقيقيتان، وتُعبّران عن الوضع بفجاجته الصريحة. يحصل أحيانًا أن تشكل الحياة الجنسية عبءًا على المرأة (المتزوجة)، أكثر مما تمنحها الرضى والامتلاء كما ينبغي لحب. هذا هو الأثر الحرفي والمباشر لتشييء المرأة في المخيلة الجمعية لثقافة الحريم.
كما أن لِعالِم النفس فرويد فضل علينا في ذلك. يا ليت كتبه لم تصل إلينا! هاهم شبابنا يتعلمون أن المرأة كائن جنسي سلبي ومُتلقٍ، ولا يمكن أن تكون مبادرة على الإطلاق، وإلا فهي تغار من الذكور. حتى إن بعضهم صار يعرف كيف تفكر وتشعر المرأة أفضل منها هي، لأن فرويد أخبرهم بذلك. وفي حين أحال الغرب أعمال فرويد إلى خانة التراث الفكري الذي بنوا عليه عبر نقده وتطويره، ما زال شبابنا المتنور يصدقون كلماته حرفيًا كما نُزِّلَت إليهم. يتقبلون تلك الأفكار بسهولة، لأنها تدعم ذكورية عريقة لديهم. من أين جاءنا فرويد؟ ألا يكفينا همّنا مع موروثنا الثقافي المحلي؟
يبدو لي أن الفجوة بين التجربة العملية لكل من الرجال والنساء تجعل كل واحد منهم يغني على ليلاه، كما لو أن الربّ نزل وبلبل لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. هي تحمّله مسؤولية معاناتها، وهو لا يفقه ماذا تريد، فيُحيلها إلى الدين أو التقاليد أو فرويد. على عينها ورأسها الدين والتقاليد وفرويد، ولكن ألا تتعامل المرأة مع إنسان من دم ولحم، إنسان واع جدًا لمصالحه وامتيازاته، لا بل يتفوق عليها في كثير من الأحيان بالمعرفة والفرص والإمكانيات؟ أين مسؤوليته كفرد إذن؟ كإنسان عاقل؟ كإنسان أخلاقي؟
رغم احترامي الشديد للتحديات الجبارة، وغير المنصفة أحيانًا، التي يواجهها جميع الرجال في مجتمعاتنا، إلا أني ألمس فرقًا في المعاناة ضمن العلاقات الحميمة. كما ظهر لي، وحسب ملاحظاتي المتواضعة، فإن الرجال الذين يفشلون عاطفيًا يميلون بشكل عام إلى مثلنة المرأة، أي إلى تكوين صورة خرافية في أذهانهم عنها، صورة غير أرضية ومتناقضة في سماتها، القديسة والعاهرة في آن. ويواصلون البحث عنها دون أن يجدوها في أي امرأة واقعية. هم لم يُعانوا فعليًا وعمليًا من أخطاء حقيقية قامت بها امرأة باسم المجتمع في حقهم. هم يعانون فقط من أن الحبيبة الحلم غير موجودة في حيواتهم لتُغرقهم بِحدبها وحنانها وجمالها الأسطوري. المرأة التي يريدونها غير موجودة أصلًا. يا لها من مأساة فعلًا! أما النساء اللواتي فشلنَ عاطفيًا، فيملنَ غالبًا إلى شيطنة الرجل، أي إلى اعتبار جميع الرجال مسؤولين عن أخطاء رجلٍ واحد مستهتر (أو أكثر من رجل) قدّمت له الكثير ولم يحترم كيانها. وتتعزز الشيطنة من خلال ربطها المعقول والمنطقي بين جروحها الطازجة وضعف حصانتها المجتمعية. في رأيي، هذه ردة فعل نفسية واقعية، وصحية في بعض وجوهها، على واقع مُزر بالعموم. تحتاج النساء مؤقتًا إلى شيطنة الرجل كي يحمينَ أنفسهنَّ من رضوض جديدة. وقد يترك ذلك أثرًا مديدًا على موقفهنّ من الحياة، ونظرتهنّ إلى الحب. هذه الهوة بين تجربة النساء والرجال في الحب، تجعل المرأة تظهر كما لو أنها لا تُقدِّر النعمة، بينما الرجل، يا عيني عليه، طالب القرب، والعكس صحيح.
كل الفروق التي ذكرتها حتى الآن بين تجربة الرجال والنساء في الحب لا تنبع عن اختلافات جوهرية بين الأنوثة والذكورة، وإنما عن فروق بنيوية في المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والتاريخية. نحتاج إذن إلى تحليل علاقة الحب ثقافيًا من منظور يأخذ جميع اعتبارات السلطة بعين الاعتبار، وألا نكتفي باجترار النظريات الرومانسية التي كتبها بعض المفكرين الرجال المدللين عاطفيًا. حيث أنهم لطالما تناسوا أن العواطف تنشأ في بيئات غير محايدة، ولا تنبثق حرة من أعماق الإنسان الفرد. والسبب برأيي أنهم لم يتذوقوا ماهية الكبت والقهر الوجودي الضاغطان على كاهل المرأة. حتى ولو كان الرجل والمرأة مخلوقين ليحبّا بالطريقة ذاتها، إلا أنهما سوف يختلفان تبعًا للتوقعات والتبعات المجتمعية المرتبطة بسلوكهما وخياراتهما. ومع ذلك ينطلق هؤلاء المنظّرون من وضع مثالي خالٍ من الضغوطات والتوترات. كما لو أن الحب بين الرجل والمرأة علاقة ندية في أساسها، ولا تؤثر الأعراف السائدة وموازين السلطة على العِشرة بينهما بعد زوال غشاوة الشهوة الأولى.
من أجل فهم الحب وتحليله بصدق، ينبغي إذن ألّا نتجاهل أصوات النساء وتعبيراتهنّ عن تجاربهن، وألّا نتغافل عن البعد الذكوري لسلوكيات الأفراد حتى ولو انطلقنا مبدئيًا من حسن نواياهم، وألّا ننسى ازدواجية المعايير والميسوجينيا المنتشرة في المجتمع، والتي تؤثر على العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة من دون أدنى شك. الميسوجينيا هي احتقار النساء والاعتقاد بدونيتهنّ مقارنة مع الرجال. ماذا تقولين؟ الميسوجينيا؟ أسمع الآن بعض الرجال يستنكرون: «الميسوجينيا؟ أتقصدينَ كره النساء؟ ماذا إذن عن افتتاننا الحقيقي بوجودكنّ يا معشر النساء؟ ومطارداتنا المريرة لكنّ؟ وتعلّقنا بأذيال أثوابكنّ؟ وماذا عن المعلّقات الشعرية الطويلة التي كتبناها حول ولهنا بأهدابكنّ وعيونكنّ الحوراء؟ ألا تسمّينَ هذا حبًا؟ وحاجتنا العميقة إليكن إذن؟ ماذا تسمينها إن لم تكن حبًا؟». أنا متأكدة أن هذه هي التساؤلات التي تجول في أذهان بعض الرجال حين يسمعون مصطلح ميسوجينيا، كره النساء، للمرة الأولى. وهذا لأن الحب يختلط لديهم بالإثارة الجنسية العابرة التي تتمحور غالبًا حول الرغبات الذاتية أكثر مما تهتم بالآخر. لا، ليس هذا حبًا يا صديقي. الحب هو أن تحترم كياني كإنسانة كاملة القيمة، وتصون حدودي وجسدي وسري ومستقبلي وطموحي، وتحترم عقلي، وتَصْدُقني، وتهتم لتعبي، وتتكلم وتُصغي، وتأخذ وتعطي، وتتعاون من أجلك وأجلي، وتعتذر حين تخطئ، وإن تعذّر كل ذلك أن تنسحب دون أن تدمر ما خلفته وراءك. هل أنت قادر على كل ذلك؟ إذن أنت تعرف الحب!!
في الحقيقة لم يمر عليّ تحليل للحب أقرب إلى قلبي مما كتبته نوال السعداوي في فصل (ما هو الحب؟) من كتابها المرأة والجنس (1972). برأيي ينبغي أن يدخل ذلك الكتاب في «المنهاج الإلزامي» لجميع اليافعين واليافعات. فهو كتاب سهل وصادق ومباشر، ويعالج قضايا أساسية، ويجيب على أسئلة تشغل من لم تعركهم الحياة بعد، وما زالوا منفتحين للتعلم خارج الأطر المتحجرة. في ذلك النص الذي عالجَت فيه مختلف النواحي التي تخص نشأة الفتاة الجنسية، تقول السعداوي: «إن شرطًا من شروط الحب هو التكافؤ، ومعنى التكافؤ هو أن يكون المحبّان متكافئين. إذا كان أحدهما إنسانًا له جسم ونفس وعقل، فلا بد أن يكون الآخر إنسانًا له جسم ونفس وعقل. ولا يمكن للحب أن يحدث بين إنسان متكامل العناصر وبين آخر ليس له إلا جسد فحسب». وتضيف: «الحب أرقى عملية يمارسها الإنسان، لأنه من خلالها تستطيع مكوناته الجسمية والنفسية والعقلية جميعًا أن تمارس أعلى وظائفها تغلغلًا في كيان الإنسان». وتُبيّنُ أن الإنسان الذي لم تنمو عنده جميع هذه المكونات غير قادر على تبادل الحب مع الآخر. هذا يعني أن النضج شرط من شروط الحب، وهذا ما لم يُتحه المجتمع للمرأة بشكل كاف، وما لم ينتفع الرجل منه لعدم قبوله بالآخر كندٍ. إذا كنت لا تعترف بندية الآخر، أو كان الآخر غير قادر أن يكون ندًا لك، فلا يوجد شيء اسمه حب! كما تؤكد السعداوي على أن: «القدرة على الحب تعتمد على قدرة الإنسان على إدراك حرية الشخص الآخر وحقيقته واحترامه». كم نحتاج إلى الأقلام النسائية التي ترسم معالم الحب من منظور الثائرة التي تطمح إلى خلق عالم أكثر حبًا واحترامًا للمرأة! أكرر: حب واحترام! حب واحترام! حيث أنه يوجد احترام من دون حب، ولكن لا يوجد حب من دون احترام. برأيكم، ما الذي يجعل النساء لا يكفنَّ عن التأكيد على مسألة الاحترام في الحب؟
ما زلت لا أدري كيف تجرأتُ أن أكتب عن الحب، عن ذلك الموضوع الشائك الذي يمسنا جميعًا. أتمنى أن تكون لكتابتي قيمة مضافة، من حيث أنها لعبت على أوتار لا نرغب عادة بإثارتها، أو رمت حجرًا في المياه الراكدة. وعلى ذكر المياه الراكدة، لا أعتقد أنها ستبقى كذلك بعد أن بدأت حالات التحرش والعنف المنزلي وانتهاك خصوصية النساء تصل إلى المجال العام وأسماع الناس. جميع هذه الحالات تخاطب آلامًا خاصة جدًا لدى النساء. أتمنى أن يأتي دور الحب قريبًا، ليخرج من قفصه الذهبي، ونتعرَّفَ على تجارب النساء العادية. سوف يحتاج الأمر بداية إلى كسر الصمت. ولا بأس أن نتعلم ممن سبقننا على درب النِسوية. أحد أهم الأدوات التي استخدمتها النسويات الغربيات، على سبيل المثال، كانت حلقات الكلام النسائية. تقول النسوية الهولندية أنيا مولينبيلت في حوار أجريته معها: «لو لم تنظّم حلقات الكلام، لما كان هناك نِسوية، ولما تكلمنا عن المواضيع التي تعنينا». ولقد تناولت حلقات الكلام مواضيع من قبيل الحب والجنس والجسد والجمال والزواج والأمومة والإجهاض والتربية والخيانة الزوجية والطلاق والتدبير المنزلي والعمل غير المأجور والتمكين المهني والتحرش الجنسي والعنف المنزلي وإلى آخره. يبدو أن تلك الحلقات الدورية دفعت النساء نحو وعي أكبر بمشاكلهنّ وبمسؤوليتهن في استمرار العلاقات الاستنزافية، وساعدتهنَّ على الاستشفاء واكتشاف مكامن قوتهنّ. كما شكلت المواضيعُ التي طَرحنَهَا المادةَ الخام للكتابات والشهادات اللاحقة، والتي حضت بدورها على خلق شبكات دعم للمعنفات، وفتحت الطريق للتفكير الإيجابي بحلول على المستوى الفردي والأُسري والمجتمعي.
وبما أن يدًا واحدة لا تُصفّق، بودي أن أقتبس في هذا السياق ما تردده النِسويات العالميات: «الرجل ليس جزءًا من المشكلة فقط، وإنما جزء من الحل أيضًا». أستغرب لماذا لم تظهر حتى الآن بوادر حراك بين الرجال السوريين رغم الطموح والكلام الكبير حول الديمقراطية والتغيير. حراك يطمح إلى تحرير الرجل، وليس المرأة فقط، من الذكورية والأبوية القاهرة. غير مستبعد أن يرغب بعض الشباب ممن لا يزالوا يؤمنون بدورهم في التغيير بتشكيل النواة. نحتاج إلى روّاد يفكرون بهذه القضايا الحساسة، ويبحثون عن حلول معنا، ويرفدوننا بكتابات صديقة للمرأة تعالج الحب من منظور إصلاحي وواقعي. نحتاجهم في حني الخطاب العام نحو جوهر القضية، كي لا نضيع في متاهات ومعارك جانبية. لعل مساهماتهم تُوسِّعُ الرؤية إلى المشكلة، ويجدون معنا سبلًا لخرق السلوك الذكوري ليصلوا إلى الرجل المعنِّف، ويساعدوا من خلال تقديم أمثولات للذكورة الإيجابية، ويصمموا البرامج التوعوية التي تهدف إلى تحسين مؤسسة الزواج ودور الأبوة، والحدّ من مشاكل ما بعد الطلاق، ومن سلوك العنف والتحرش، وتطوير سلوك العناية بالنفس والآخرين. قد لا تسمح الحرب والشتات بكل ذلك دفعة واحدة، ولكن لا بأس من البدء تدريجًا والمراكمة إلى أن يحين الظرف. هل أنا حالمة؟ لمِ لا؟
الكلام عن الحب لا ينتهي، ولا أعتقد أني أعطيت همومه كامل حقها، وبخاصة أن لكل علاقة عاطفية مطباتها التي تخصّ الشريكين كثنائي، وتختلف بالتفاصيل عن أي ثنائي آخر. ومع ذلك أتوقع أن تتعرف كثير من النساء (والرجال) على شذرات من تجاربهنّ الشخصية في كتابتي، لأني لم أخترعها، بل استقيتُ من تجربتي وتجربة جميع النساء اللواتي عرفتهنّ ذات يوم. آمل أن أكون وفقت بصياغتها. وطبعًا لن أستغرب إن استجلبت كتابتي نقدًا، كأن يرى بعض القراء أني استخففت كثيرًا بحجم العطب، ولم أتطرق بَعدُ إلى أشنع الانتهاكات التي تصيب المرأة في مجتمعاتنا. يتساءلون هل حان وقت نقد الحب، بينما تُغتصب النساء تحت قوة السلاح في هذه الأيام العصيبة؟ وما معنى كل هذه الآلام الصغيرة في زمنٍ عَرِفَ عودة استرقاق النساء؟ جوابي هو أن هذا من ذاك! لو لم نتغافل عن اختلال الموازين قبلًا، لما وصلنا إلى هنا. هل تعتقدون أن العنف الوحشي الذي تواجهه المرأة في ظل الحرب هبط فجأة من السماء؟ ألم يبدأ يومًا على شكل تجاوزات لحصانة المرأة ضمن الأسرة والمجال العام؟ ألم تكن بذوره مزروعة سلفًا في القوانين والتربية والمناهج التعليمية والإعلام؟ ولماذا ينبغي علينا أن نعترض فقط على الانتهاكات الجسيمة؟ ألا نكون قد تأخرنا كثيرًا؟ وهل يفيد الاعتراض عليها إن لم نربطها بتلك الانتهاكات «المنزلية» التي تَعوَّدنا عليها إلى درجة بدت لنا طبيعية؟ وهل من المعقول أن نعتبر إصلاح العلاقات الحميمة أمرًا ثانويًا؟ تكمن جذور العنف فعليًا في السلوكيات التي تعودناها إلى حد الملل، وليس في الانتهاكات الجسيمة التي هي ليست سوى طفرة بشعة ونادرة نسبيًا لما هو شائع ومتكرر. قد لا ينقلب العالم إن سمعت المرأة كلمة نابية في حقها، ولكن قذف المرأة بكلمة هي الخطوة الأولى في الطريق نحو رجمها بالحجر.
وقد يجد آخرون أني ظلمتُ الحب وحمّلته ما لا يحتمل، وعمّمتُ تجارب وأغفلتُ أخرى. أجيب هؤلاء أني لم أفعل سوى كشف بعض المستور. ولم أغفِل تجارب غير قادرة أن تجد سبيلها إلى النور من تلقاء نفسها. يسهل الاعتراف بالحب الناجح، ولكننا نستصعب الكلام عن إخفاقاتنا. ألا يقول المثل: صيت غنى ولا صيت فقر؟ هذا ينسحب كذلك على الحب. أدرك وجود تجارب حبٍ سامية، ولكنها ليست سوى جزء من الحقيقة. حاولت فقط أن أعبّر عن صوت الهامش، الذي أنا جزء منه، مع إدراكي أنه سيكون نشازًا. صوت الهامش مزعج بالضرورة. بيد أني لم أنسَ أثناء الكتابة ثانية واحدة أن للحب أكثر من وجه. كما أَصدقكم أني بتّ لا أعرف ما هو الطبيعي. هل الطبيعي أن تصيب قلوبنا من أول أو ثاني محاولة، فنعيش العمر بثبات ونبات وأمان؟ أم أن الطبيعي ألا نجد ذلك الحب أبدًا، لأنه وهم، ونبقى وحيدات كجذع شجرة مقطوع، أو نسكن إلى شخص نشاركه في أمور الحياة العملية فقط؟ أيهما الطبيعي يا ترى؟ فضلًا عن أن تركيزي على السلبيات نابع عن عشمٍ بالتغيير نحو الأحسن. هل تعتقدون أني كنت سأكتب كل هذه الكلمات لو نفضتُ يدي تمامًا من الحب؟
ذكرتُ منذ قليل أن مشاكل الحب لا يمكن حلها جذريًا على مستوى الفرد فقط، ولكن هذا لا يعني أن الأفراد لا يمكنهم صنع واحات حب وارفة وسط القحط والسراب. نحن بأمس الحاجة إلى تلك الواحات. ونظرًا للتغيرات الكبيرة، السلبية والإيجابية، التي تحصل في مجتمعاتنا، وتَعرُّض الكثيرين إلى ظروف وبيئات جديدة وتجارب خارقة، أرى أن موضوع الحب راهن كما لم يكن من قبل. لن نتغلب على القهر والفقدان والاغتراب إن لم نحرّر الحب من سلاسله، ليلمّ شتاتنا، ويغدو مَرهمًا لجراحنا الغائرة. يحتاج الأمر إلى الشجاعة من النساء والرجال على حد سواء. شجاعة النساء في قول كلمة الحق، وشجاعة الرجال في قبول كلمة الحق.
وفي الختام أقول إن نقد الحب لا يعني نقضه. كل ما طمحتُ إليه هو إضافة زاوية نظر إلى فهمنا للحب. ذلك أن جزءًا لا بأس به من تعاستنا يتعلق بأوهام وسوء فهم وأحكام مسبقة حوله. يحتاج الحب إلى ثورة في تفكيرنا، وسلوكنا، وانقلاب على المعايير البائدة. هل ستكون ثورة في الحب يا ترى، أم ثورة عليه؟ لكلٍ منا ثورتها!