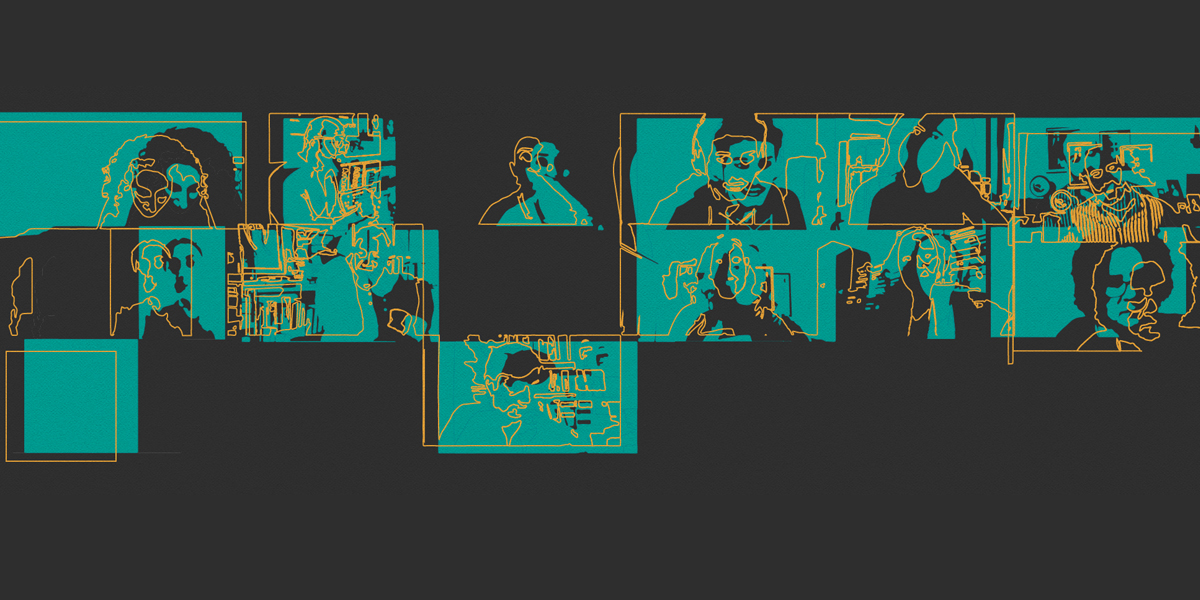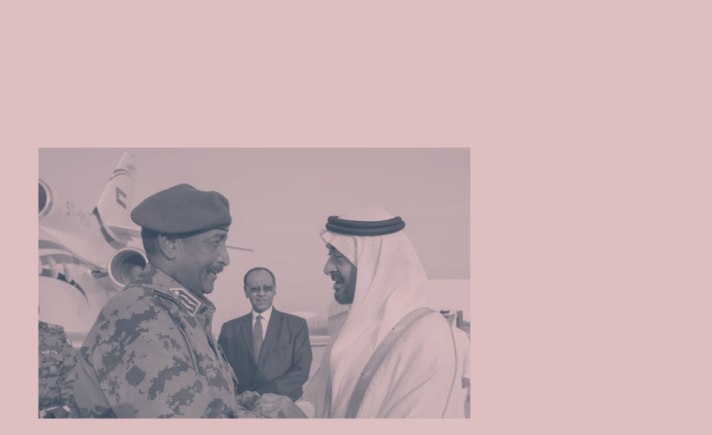هل يمكننا الحديث عن تقليد ثوري أنتجته ثورة يناير 2011 في مصر؟ تقليد يسعى للتغيير السياسي التحرري من حيث القيم/الانحيازات وأساليب العمل/الأشكال التنظيمية؟ وأين يمكن البحث عنه؟ هل في قيم وسلوكيات وشعارات الناس الذين تحركوا بالملايين في وجه الدولة المتوحشة؟ أم في المشروعات السياسية الديمقراطية التي تشكلت وسعت لتحقيق أهداف الثورة؟ أم الاثنين؟
يتحدث موريس عايق عن معضلة واجهت الثورات العربية، وهي هيمنة ثقافة سياسية محافِظة معادية للحريات (ثقافة الثورة المضادة) على غالبية الجماهير التي شاركت في الثورات، لكنني أفضل التركيز على ما قدمته المشروعات السياسية للجماهير، التي ليست كتلة صماء وبها الكثير من التنوع في المصالح والانحيازات والمواقع.
أعتقد أن الثورة أتت بفرصة تاريخية لإنتاج مجال سياسي جديد. ملايين البشر اهتموا بالشأن العام وقرروا المشاركة فيه، وتنظيمات/جماعات بالمئات – بل الآلاف – تشكلت. كانت فرصة لإحياء الحركة الديمقراطية بمعناها الشامل السياسي والنقابي والأهلي والطلابي، وبشكل خاص، فرصة لإعادة تأسيس التيارات السياسية القائمة في مشروعات جديدة على أرضية أكثر ديمقراطيةً وانفتاحاً.
يعنيني هنا التنظيمات الحزبية كشكل معين من التنظيم السياسي، وهي تشمل التيارات السياسية كافة التي كانت قائمة في مصر منذ التحرر الوطني وحتى العقد السابق على الثورة، حيث تضمن حراكاً ديمقراطياً واجتماعياً متصاعداً كانت له أشكال تنظيمية قائمة قبل ثورة يناير. ومع الثورة في فترة الانفتاح والسيولة، ظهرت (أو كانت موجودة وتطورت) أشكال جديدة أظن أنها مثلت تطوراً داخل هذه التيارات الليبرالية واليسارية والإسلامية والناصرية باتجاهات أكثر ديمقراطية وانفتاحاً.
بالنسبة للتيار الناصري، تمثل الجديد في حزب الكرامة مقابل الحزب العربي الناصري، تعبيراً عن الاختلاف بين الناصريين الذين نشأوا معارضين لنظام السادات ورجال دولة عبد الناصر الذين عاداهم السادات، وبين التيار الشعبي الذي نشأ بعد الثورة مرتبطاً بحزب الكرامة نفسه وزعيمه حمدين صباحي.
وبالنسبة للتيار الليبرالي، نشأ مشروعان ليبراليان هامان بعد الثورة هما حزب مصر الحرية بقيادة المثقف الليبرالي عمرو حمزاوي وحزب المصريين الأحرار بقيادة الملياردير نجيب ساويرس، وذلك مقابل حزب الوفد الجديد. ولكن التنظيمين انتهت صيغتهما الأصلية فعلياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وكانون الأول (ديسمبر) 2016 على الترتيب بفعل عوامل متنوعة.
وبالنسبة للتيار اليساري، ظهرت دعوة لتأسيس حزب جديد لليسار في 10 شباط (فبراير) 2011 من العناصر الأكثر انفتاحاً داخل ثلاثة تيارات يسارية كانت قائمة بالفعل قبل الثورة، وهم «تيار التغيير» في حزب التجمع، و«تيار التجديد الاشتراكي» في منظمة الاشتراكيين الثوريين، وشخصيات من تيار يمكن تسميته باليسار الديمقراطي، وإن لم يكن له شكل تنظيمي موحد قبل الثورة، بالإضافة لرافد جديد ممن لم يكونوا بالضرورة يعرفون أنفسهم كيساريين قبل الثورة، فتكون حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وفي تشرين الأول (نوفمبر) 2013، استقال عدد من مؤسسيه ليبدأوا مشروعاً يسارياً آخر هو العيش والحرية الذي ما زال في طور التأسيس القانوني والفعلي، لكن هذا المشروع يعتبر ابن مرحلة الانغلاق والمصادرة وليس مرحلة السيولة والانفتاح السابقة (في نفس التوقيت تقريباً بدأ مشروع ليبرالي آخر ويبدو أنه لم يستمر وهو الحزب العلماني المصري، وهو قيد التأسيس).
بالنسبة للتيار الإسلامي، انشق من جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة جماعة من الشباب سُميِّت التيار المصري، وسعوا لتأسيس حزب. كذلك، أسس القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبوالفتوح حزب مصر القوية في 2012. بعد 2013، ابتعد جزء كبير من أعضاء التنظيميين عن العمل السياسي تحت تأثير الخوف أو الإحباط، كما حدث لمعظم التيارات السياسية الأخرى، لكن من استمروا منهم انقسموا تقريباً إلى ثلاثة أقسام، وفقاً لملاحظاتي الشخصية: قسم أصبح علمانياً صريحاً؛ وقسم تطرف وأصبح متعاطفاً مع الجهاديين (ومنهم من انضم لداعش فعلياً)؛ وقسم استمر في تمسكه بما يسمى بـ«الإسلام الحضاري» وبالعمل السياسي الديمقراطي السلمي. من تبقوا من التيار المصري اندمجوا في حزب مصر القوية، الذي بدوره تجمد في 2018 بسبب الضربات الأمنية.
نشأت أيضاً تنظيمات عبرت عن الاتجاه الليبرالي الاجتماعي، وكان أهم المعبرين عنه هم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المكون من شخصيات يسارية وليبرالية إصلاحية ساهمت في الحراك الديمقراطي قبل الثورة، وعدد من رجال الأعمال المتوسطين من المسلمين والمسيحيين، وبعض القيادات الكنسية المستنيرة نسبياً وخاصة من الطوائف الأصغر عدداً؛ وحزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، وحزب العدل الذي أسسه مصطفى النجار.
يقول عمرو عبد الرحمن إن معظم هذه الأحزاب الجديدة نشأت على عجالة بـ«هدف إفساد تحالف الجيش والإسلاميين بالأساس، وليس بهدف بناء قاعدة اجتماعية تمتلك أسباب الحياة». قد يكون هذا صحيحاً، لكن اختيار هذه الأحزاب الجديدة لمهامها وطرق عملها تخبرنا عن تصوراتهم عن فئات المواطنين التي يريدون التوجه لها في المجتمع باعتبارها صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي. ورغم كثرة الحديث عن شباب الثورة في تلك الفترة، وكأنهم فئة بدون محتوى طبقي أو جندري أو ديني، فإن كل حزب أو جماعة سياسية عملياً حددت هذه الفئات وتوجهت لها وفقاً لانحيازاتها وتصوراتها الأيديولوجية. لكن هذا التوجه كان مرتبكاً بفعل الانشغال بالمتصارعين على السلطة، وكذلك لأن الحركة الاجتماعية المعبرة عن هذه الفئات كالنساء والمسيحيين والعاملين بأجر كانت هي الأخرى خارجة من سنوات الانغلاق إلى حالة الانفتاح والسيولة وتمر بعملية إعادة تأسيس شبيهة. لكن أعتقد أن هيمنة الرجل المسلم النمطي الأفندي ومخيلته الضيقة على هذه التنظيمات – حتى اليسارية والليبرالية منها – جعلتها مترددة وفوّتت عليها فرص هامة في لحظات كان المجال مفتوحاً؛ خطراً وقاسياً ولكن مفتوحاً.
فالثورة كانت فرصة لتطوير إجابات تحررية على أسئلة الدولة والثروة وقواعد الحياة الخاصة والعامة، خاصة في ظل المواجهة مع الإسلام السياسي سواء أثناء تحالفه مع العسكريين أو صراعه معهم، لكن قِصَر النظر وهيمنة هذه المخيلة الضيقة أضاع فرصاً لا لحسم هذه الأسئلة (فالحسم كان صعباً بالفعل) وإنما لوضع حد أدنى جديد أو لطرح بدائل أكثر جذرية على الساحة لتكون أحد البدائل المتصارعة على الأقل.
من الأسئلة/المحطات التي أعتقد أنها عبرت عن هذه الفرص الضائعة:
- أسئلة العدالة الاجتماعية: كيف أصبح التحرير موقع الأسئلة «الكبرى» المتعلقة بمسألة الحكم والديمقراطية، وأصبح ماسبيرو وجهة المهمشين الباحثين عن العدالة الاجتماعية مثل السكان المعترضين على الإخلاءات القسرية والمسيحيين الرافضين للعنف الطائفي؟
- في انتخابات برلمان 2011، كانت خيارات القوى الديمقراطية سواء في برامجها أو اختيارها لمكوناتها ومرشحيها محافِظة ومحدودة.
- صياغة الصراع حول مدنية الدولة بقيت صياغة دينية، مع التسليم بمرجعية الأزهر وتعزيز سلطة المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية على حياة المواطنين الخاصة.
- ضعف اهتمام الأحزاب الديمقراطية بالصراع حول الأحوال الشخصية مع الإخوان والسلفيين في مجلس النواب ذي الأغلبية الإسلامية.
- وبشكل عام، ضعف التواصل مع الحركات الاجتماعية المنبثقة من نضال الفئات الاجتماعية المذكورة أعلاه، وعدم تقدير أهمية ما تفعله سياسياً باعتباره «مطالب فئوية».
- الديمقراطيون الذين بدأوا النضال ضد حكم الإخوان بعد الثورة ضموا إلى صفوف جبهتهم السياسية عناصر رجعية بدعوى توسيع المعركة لإنقاذ الوطن. وبعد عزل الإخوان عن السلطة في صيف 2013، تلكأوا في العودة لموقع المعارضة، فتركوه شاغراً للإسلاميين محاولين التشبث بموقع الناصح الأمين للسلطة الجديدة.
- وهناك قضية التنظيم، فقد سعت الأحزاب الجديدة للتجديد في أشكالها التنظيمية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الروافد الجديدة، لكن معظمها بقى أسير جوهر الأشكال القديمة.
معروف أن العديدين من قيادات وأعضاء التنظيمات التي ذكرتها حالياً سجين أو منفي أو مختفٍ قسرياً أو مطارَد، ولا أنكر أبداً دور القمع الوحشي في قطع الطريق على تطور مشروعاتها فكراً وممارسة. كذلك، لا أهدف من الملاحظات السابقة إلى التطهر، فأنا واحدة ممن شاركوا في كل المحطات المذكورة سابقاً. لكن إن كان علينا كديمقراطيين في هذا البلد الاستمرار في محاولة الحفاظ على بؤر النضال الديمقراطي القليلة المستمرة، والتي لم يتمكن القمع من قتلها بعد ومحاولة خلق أخرى جديدة، علينا أن نفكر فيما فعلناه حين كان المجال مفتوحاً.