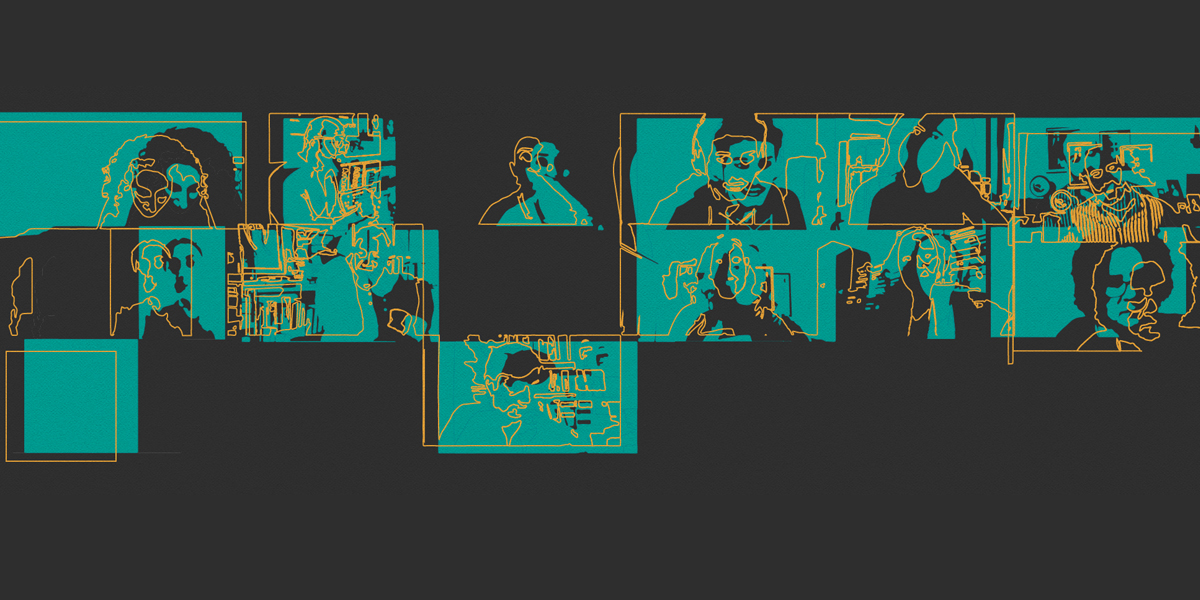يُحيل سؤال التقليد إلى ترسيخ فعل ما، تكراره والمواظبة عليه بإخلاص. وسؤال التقليد هذا مهم في محيط بشري عالمي مهووس بالتحديث وكل ما هو جديد. لا ننفي طبعا التناقض، حدَّ الاحتدام، الذي تحمله دلالات الكلمات في قول «التقليد الثوري»، فكلمة «تقليد» تعانق «ثوري» كلغز بديهي وحالة انفجار مؤجلة. الثورة هي روح التجديد والنفور من المألوف، وفي التقليد تكرار وروتين.
لربما نحن، الثوريات والثوريين بالغريزة والعزيمة، بحاجة للمأوى الذي تعرضه علينا «التقاليد»، كاستراحة محارب، من مناورة الدحض والتشكيك التي دأبت مجموعات، منذ لحظة تفجّر الغضب الجماهيري في الشوارع قبل عشرة أعوام، على مزاولته واتهامنا بالفشل – دون الخوض الآن في نواياها. فبحسب تقاليدهم، على الثورة أن تأتي بتغيير مدروس، مرئي ومحسوب. وكارثي كل ما هو عدا ذلك.
دون أن نقلل من شأن هذه الرغبة، التي من الصعب محاججتها من حيث المبدأ، نسأل من تقاليدنا نحن، تلك التي تصون الثورة بحب وتُشكك بها بمسؤولية:
أهناك ما هو في حسابات الانتقال الديمقراطي، والسلطة، والنجاح والفشل المُعَديّن مسبقاً وفق معايير ثابتة ومتعارف عليها، ما قد يُعمينا عن تغييرات اخرى، أصغر أو أكبر، في الهامش أو في العمق، ما زالت قيد التشكل؟
أهناك ما يمكن أن يُحسَب مادياً، ولكن من الصعب أن يُحسَب سياسياً؟
أهناك مكاسب بشرية خارجة عن السياسة حتى، وهي منغمسة فيها كلياً؛ مكاسب لا يمكن ترجمتها إلى لغة السياسة – على أية حال، تلك المتُعارف عليها، إلى أن نغيّر فهمنا لها – لأنها شاملة ومكتسحة؟ لأنها تمسّ الإنسان ذاته؟
أهناك ما هو بحاجة إلى أن يكون في حِلّ من تقييم لحظة زمنيّة ما زالت هي نفسها تتكشف، فتُلِحّ غواية فهمها وتنبسط على مساحتها الطبيعية من رهبة الفعل البشري؟
لرصد سؤال التقليد لا بدّ من العودة إلى النقطة التي يأخذ فيها التقليد شكل انطلاقة أصليّة ومبتكرة، بحيث تفعل «النوستالجيا» به ما لا يستطيع «الخيال» أن يقدمه. كلاهما وهم، في دقيق العبارة، ولكن الأولى جذابة أكثر، وتبدو ودودة تجاه أسئلتنا، لأنها تُحيل إلى شيء كأننا عشناه: الماضي.
«الحسم خيانة»
في نصّ مشترك كتبه كل من علاء عبد الفتاح وأحمد دومة من سجنهما، لا يُخفي علاء خوفه من الأسطورة وبحثه فيها عن تجارب بشرية حقيقية وبسيطة. النصّ نصّ تأسيسي بكل معنى الكلمة، حتى وإن ظهر أنه يُكتَب في لحظة انكسار وضعف صاحبت جموداً وانكفاءً ما، ولكنه يؤسس لأنه يواجه الأسطورة ببناء بديل، فيتحداها «لأن الأسطورة، في محاولتها لطمس الضعف والقلق والعنف والعبث وفجيعة الألم وهشاشة الحلم، تفتح لهم أبواباً لبث غموضهم». النص يؤسِّس لما هو أقل وأكثر: أقل من ثورة لأنه يبحث عن معنى قد نجده في حياتنا اليومية دون أي حاجة لأن نثور ونخسر ويُباح دمنا في الشوارع؛ وأكثر، لأن من المستحيل أن تُحيط علماً به دون أن تذوب تجاربُنا حدَّ استحالة تمييزها عن بعضها، فنتحرر من ذاتيتنا ونحن نملكها بحرية على الملأ.
يكتب علاء هذا النص عام 2014 وهو ملاحَق بهاجس مقولة «اليأس خيانة». يناقشه، يدحضه حيناً، يتفهم الخوف والضرورة فيه، ويكتب أيضاً: «هل هناك خيانة أكبر من الأمل؟». ويجزم بعدها بصفحات: «لن أخون الثورة باليأس ولا بالأمل». ولكنه يجد الخيانة في الحسم: «ميداننا الوحيد المبني على حلم وحب ولكن الناس يبغون استقراراً… والاستقرار يحتاج لحسم، والحسم يحتاج لقوة، والقوة تقتل الحب وتشوه الحلم!! الحسم خيانة، فهو يستبدل قوة الناس بما هو أدنى: السلاح أو التنظيم أو الدولة. الحسم خيانة فهو يستبدل الحلم بما هو أدنى: خارطة طريق أو ترتيبات سلطة أو بعض فتات المطالب والإصلاحات».
المثير والمهم بهذا المقطع هو فصل الكاتبَين بين عدم المقدرة على الحسم أو على الحصول على السلطة، وعدم الرغبة به. فلا نستعجل الاستهانة من توجُّسه من السلطة، ولا يمكن إهمال هذا النقد – الذي يأتي من ناشط سياسي وإنسان يدفع أثماناً باهظة – باعتباره رومانسياً أو غير عقلاني أو غير مبرَّر أو يائساً. على العكس تماماً، فقوة الناس وفعلهم وتَحَرُّكهم التي يصفها عابراً هنا بالحلم والحب هي ليست تجليات لحالات حسيّة، ولكنها مادة خام لحقيقة مغايرة وجماعة مختلفة وبناء جديد، وكل هذه قد لا تستطيع أدوات سياسية أن تحملها، وقد تحتاج إلى ثورة بمفاهيمنا حول السياسة والسلطة معاً.
من كانط إلى علاء
يكتب الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط عام 1798 باحثاً عن حدث ما من الممكن أن يشير إلى ميل الجنس البشري نحو التقدم؛ حدث يشير إلى سعينا الدؤوب نحو ما هو أفضل. يتساءل كانط إن كان بالإمكان أن نُجمع على حدث تاريخي يُشير إلى تورطنا ككائنات أخلاقية مهيأة دوماً لأن تكون جزءاً من مشروع لتحسين حياتها؟ إجابته القاطعة في النص هي الثورة (وفي مخيلته اللحظية لتلك اللحظة التاريخية تتجلى الثورة الفرنسية). يقول:
«قد تنجح الثورة أو قد تفشل. قد تكون مليئة بالبؤس والفظائع لدرجة أن إنساناً ذا تفكير سليم، ورغم تيقُّنه من نجاح الثورة، لن يختار أن يُعيد التجربة بتكلفتها هذه مرة ثانية، ورغم ذلك تجد الثورة حماساً كبيراً في قلوب المتفرجين؛ حماساً يُجاوز المشاركة المتلهفة والمحفوفة بالمخاطر. وبالتالي، لا يعود هذا التعاطف إلى سبب آخر سوى لميل أخلاقي لدى الجنس البشري».
وبناءً عليه، لا مسارُ الثورة ولا نتائجُها ولا أعمالُها تُعَدّ مؤشرات على تقدم الجنس البشري بالنسبة لكانط. بل الرغبة بحياة أفضل، في حد ذاتها، هي ما يدلِّل على الثورة كحدث بنّاء. إنها رغبة جماعية مشتركة بحياة أفضل.
تهميش كانط للنتيجة السياسية للثورة يُتيح إمكانية تداوُل المسعى الثوري كمسعى أخلاقي، وهي نقطة مفصليّة. لا يكترث وصفه للمشروع السياسي للثورة، بل يصوّر الحشود بحماسها ومشاركتها وتعاطفها مع فعل جماعي بشكل «متأصل وغير زائف». إنها قدرتنا كبشر على الإشارة إلى التقدّم والتأكيد على رغبتنا به – مشاركتنا المتّقدة في الخير، وهي رغبة منفصلة عما إذا كان بالإمكان تحقيق هذا الخير أم لا، وما إذا كان هذا هو السيناريو الأفضل أم لا. إن الثورة هي تقدُّم بقدر ما نميل إلى الرغبة بتحسين أحوالنا، بدون أي ضمان ورغم الأثمان غير المتوقعة.
العودة إلى كانط هي ليست ارتكاسة للزمن، ولا هي محاولة للتوكيد على المقولة الممجوجة «أن التاريخ يُعيد نفسه». أوجه التشابه فيما قاله كانط حينها وعلاء البارحة هو في علاقتنا نحن مع الثورة، كل ثورة، في أهميتها، وسحرها وضرورتها، وفي ارتباكنا أمامها، ولكن الأهم في الدرس الإنساني الأول: أننا نبحث بفرادتنا عمّا هو أكثر وأجمل، ومرة كل كثير وكثير من السنين، نفهم أنه عندما يتشظى وهم الفرادة هذا، يتصدّع ككيان «جاسئ» (هوية ثابتة تراكمية هي عبارة عن مجموع تجاربها وآلامها وأفكارها) وينجلي كمشيئة حاضرة (متفاعلة ومتغيِّرة). يظهر للعيان المشترك بيننا، ويبدو وكأن العالم كله هو نحن ونحن نخطو معه.
وحين نضع الحسابات الفجة الخاصة بسؤال النجاح والفشل جانباً، هناك ما يدعونا التقليد إليه. أن نُخلص للفكرة، وأن نواظب بإخلاص المؤمن – وليس العارف – بأن هناك، بعد اليأس والأمل، ما لا يُهزم.