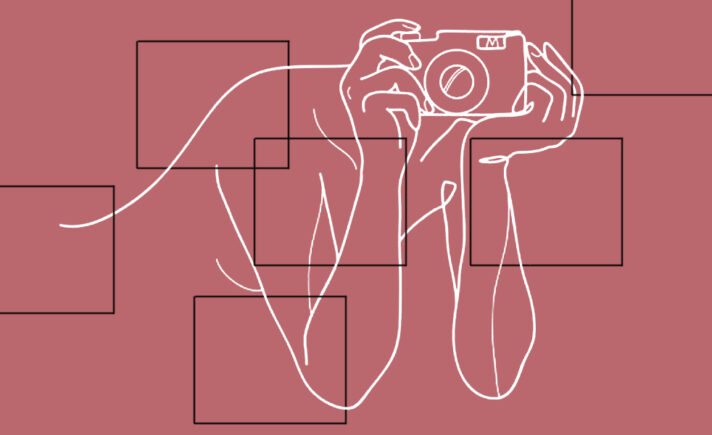لم أتجوّل خارج دمشق منذ أكثر من اثني عشر عاماً، فضّلتُ خلالها زيارة بعض سواحل لبنان أو أي مكان آخر قد تسوقني الفرصة القصيرة إليه، لكن ليس في سوريا. وكأنَّ مقاطعة نفسية من نوع ما حلّت بيني وبين سوريا، وخاصة بعد العام 2012، ولم يعد لي فيها ما يخصني سوى منزل والدَي وبعض الأحياء.
لم أُفاجأ عندما أدركتُ مؤخراً أن هناك كثيراً من السوريين والسوريات يتقاسمون معي الإحساس بالمرارة تجاه عدم معرفتهم بالمدن والأرياف الأخرى قبل دمارها، أو تجاه عدم تمكنهم من العودة للتجوال بعيداً عن مناطقهم منذ عشرة سنوات، بسبب انعدام الأمان، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي والحساسيات والحواجز النفسية بين أبناء مناطق سورية متعددة.
ثم كان أن أحكمَ وباء كوفيد-19 قبضة الحصار النفسي والجسدي الذي نشعر به كسوريين نعايش كارثة إنسانية بحجم تبعات الحرب والدمار والحصار في الداخل السوري، فأصبح حتى الخروج من المنزل للعمل أو لقاء الناس غير متاح لفترة طويلة خلال فصلي شتاء وربيع العام 2020. وهي فترة أخرجت كل الانضباط الداخلي عن طوره، وخلقت حاجة إلى الخروج أياً تكن الوجهة، ما جعلني أعقد العزم أنا وصديقتي سلمى على زيارة الساحل بعد كل هذه السنوات، التي لم تتحرك خلالها هي أيضاً خارج دمشق. قد تبدو للبعض مجرد نزهة صيفية تقوم بها صديقتان، الا أنها بالنسبة لنا لم تكن كذلك، لأن دافعنا الأول إليها كان الرغبة في دفع حدودنا، وقياس وهمنا حول المساحات التي نملك الحق في التحرك ضمنها في بلدنا، خاصة كوننا بالدرجة الأولى امرأتان خارج محيطهما التقليدي الآمن، لا يرافقنا في رحلتنا رجل أو طفل، وفي ظل الوضع الأمني غير المستقر في البلد. عَوّلنا على أن المكان المقصود سياحي، وتأمين طرقاته يصبّ في صالح الجميع.
في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) من العام 2020، خرجتُ من منزلي في مدينة دمشق في الصباح الباكر متوجهة الى ما يسمى «كراجات البولمان»، وهو المكان الذي كنت أقصده مع عائلتي عندما كنت طفلة إذا ما أردنا أن نستقل حافلة بقصد السفر إلى أحد مدن الساحل السوري، الذي كنا نقضي فيه بعض أيام إجازتنا الصيفية.
التقيتُ بسلمى على مدخل المحطة. غمرنا شعور غريب؛ مزيج من الغبطة والحزن العميق والذنب والحب والفضول. عادت محطة الحافلات إلى مكانها القديم في منطقة القابون في أيار (مايو) من العام 2019، بعدما خرجت من الخدمة لسنوات طويلة بسبب موقعها إلى شمال شرقي العاصمة دمشق، متاخمة لبعض مناطق الغوطة الشرقية التي خرجت عن سيطرة النظام لفترات طويلة، وعايشت دماراً كبيراً سوّى مساحات كبيرة منها بالأرض. عادت المحطة الى العمل رغم كل الخراب والدمار المحيط بها، تنطلق منها كل يوم حافلات الى كل الوجهات، كوسيلة نقل عامة وحيدة تصل بين دمشق والمحافظات الأخرى من سوريا.
«نحن في القاع»؛ قالت سلمى. لم أُلقِ بالاً، فقد كنتُ أراقب أفواج البشر التي ترتاد المحطة تباعاً، بعضهم يقصدون الساحل مثلنا، وآخرون يقصدون المدن المختلفة، وأكثرهم من الجنود المتجهين إلى كل الوجهات والعائدين من كل الوجهات. جلسنا على الكرسي الخشبي الوحيد الذي وجدناه فارغاً ننتظر حافلتنا حتى تصل. الكرسي قريبٌ جداً من أحد مكاتب شركات النقل، التي يقف موظفها على بابه بالقرب مني وينادي فوق رأسي بكل ما أوتي من قوة باللهجة الحلبية: «حلب حلب، يا رايحين عا حلب». نظرت إليَّ سلمى وقالت: «الرحلة القادمة لي ستكون الى حلب».
وصلت حافلتنا بعد ساعة من الانتظار، وفاجأنا اللقاء بها: حافلة حمراء ضخمة، حديثة ومكيفة، ذات مقاعد جلدية مريحة جداً، تقف وسط الدمار بانتظار المسافرين إلى الساحل. جلستُ بالقرب من النافذة، أرنو لرؤية الطرقات. الطريق عادي جداً، نباتات جرداء، ذات لون بني تكاد تموت من العطش ترامت على طرفي الطريق حتى مدينة حمص، الا أنها تكاثفت بالتدريج ثم تحولت الى بساتين خضراء على جانبي طريق طرطوس ثم اللاذقية.
وصلنا بعد أربع ساعات الى المحطة في مدينة اللاذقية. من هناك كان علينا أن نستقل سيارة أجرة إلى وادي قنديل، وهي قرية متطرفة حيث يلتقي البحر بالجبل إلى الشمال من مدينة اللاذقية، ذاعت شهرتها منذ العام 2005، حين بدأت بعض مشاريع الاستثمار المتواضعة تظهر على شواطئها بشكل غامض، استهدفت طبقة الشباب والشابات محدودي الدخل ممن يرنون إلى تجربة منفتحة، غير مقيدة بالعادات والأعراف الاجتماعية والدينية، حيث لا رقيب اجتماعي أو حكومي على سهرات الموسيقى والرقص أو اللباس أو المشروبات الروحية.
تقاطعَ مع تجربتنا حكيُ ريم، وهي فتاة في العشرينات من العمر وخريجة هندسة حاسوب، عن رحلتها لوادي قنديل صيف السنة الماضية؛ تقول: «إن الوادي يتناسب مع طريقة تفكيرنا وأجوائنا الاجتماعية كشباب، إضافة إلى قدراتنا المادية. من الممكن أن يستأجر مجموعة أصدقاء من الشباب والشابات شاليهاً متواضعاً، فالمكان غير مهم وإنما الرحلة الجماعية والأجواء الحرة». تتابع ريم متحدثة عن وفود مجموعات سياحية مختلفة إلى الوادي يومي الجمعة والسبت، حيث يطرأ تغيير ملحوظ على الجو السائد: «الموسيقى واللباس يختلفان تماماً خلال هذين اليومين، والأجواء تصبح أقرب إلى العائلية المحافظة منها إلى الشبابية. أعتقد أن المجموعات السياحية مربحة أكثر بالنسبة لأصحاب المكان وخاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي نعيشه، فالمُنشآت المتواضعة لم تعد قادرة على الاستمرار بسياسة معينة، وفئة الشباب فئة غير مربحة مثل فئة العائلات والأطفال المتطلبة. ومع قدوم أزمة كوفيد-19 هذه السنة، لم يعد باستطاعة المكاتب السياحية الاستمرار بتنظيم الرحلات العائلية الى لبنان، فكان لا بدّ من إيجاد مواقع سياحية بديلة داخلية غير المواقع المزدحمة المعروفة». لذلك، تعتقد ريم أن هذه المناطق ستتغير كلياً خلال السنوات القادمة، وربما يتم تنظيمها بشكل مختلف بما يتناسب مع الأجواء العائلية، مما سيبعد عنها فئة الشباب.
انطلقتُ أنا وسلمى مع العم أبو وائل، سائق إحدى سيارات الأجرة القليلة التي عثرنا عليها في محطة حافلات اللاذقية. اتفقنا معه على أجرة تقارب ما يعادل الخمسة دولارات، وهي أجرة مرتفعة، بحجة بعد المكان وندرة توفر مادة البنزين، وخروج الكثير من وسائل النقل عن الخدمة، فتدهور الأوضاع الاقتصادية يلتفّ رويداً رويداً حول أعناق المدن والناس. خيَّمَ الصمت علينا في الطريق. «رباه… كم هي مهملة هذه المنطقة»؛ تقول سلمى. لم يخبرنا أحدٌ سابقاً أن طريق الوادي وعر وسيئ ومليء بالقمامة، مع أن العديد من الأصدقاء يقصدونه بكثرة. لم يخبرنا أحد عن العسكر المحيط بالمكان، مع مدرعاتهم وأسلحتهم الثقيلة الموجهة إلى الشاطئ، مما يقع في القلب ويجمد بعض المشاعر. لم يخبرونا أن الأمكنة والاكواخ المخصصة لاستقبال القادمين رديئة ومهملة، بالمقارنة مع جمال الطبيعة المحيطة ومع المقابل المادي الذي يعادل تقريباً 18 دولار أميركي لليلة الواحدة.

وصلنا منهكَتَين، وأدركنا بعد وصولنا أن عدم توفر الوقود يعني عدم قدرة الإدارة على تأمين الطعام من المصادر الوحيدة الأقرب للمكان، وذلك يعني اعتمادنا على القليل الذي نحمله معنا، وعلى بعض المعجنات التي يصنعها سكان القرية. تتألّف الإدارة من بضعة شبان يعتمدون ثياب البحر كلباس دائم في جميع الأوقات، يبتسمون لنا وهم يُسلّموننا المكان المريب والوسخ، وعندما نعترض يرسلون شاباً صغيراً لا يتجاوز اثني عشر عاماً من العمر ليقوم بالتنظيف، فنقوم أنا وسلمى بمساعدته تعاطفاً.
سلمى صامتة وجهها خالٍ من التعابير، وأنا تراودني فكرة العودة من حيث أتيت، إلا أن المسافات التي قطعناها، إلى جانب دعوة على القهوة مع ابتسامات لطيفة تلقفّتنا بها مجموعة من الأصدقاء كانوا قد وصلوا قبلنا بيوم من مدينة حماة، وتلقوا الصفعة قبلنا مع بعض التسليم، ساهمت في إقناعنا بتجاهل الواقع والبحث عن بعض المَسرّة خلال اليومين القادمين. وهكذا، ارتمينا في أحضان البحر المتوسط قبل غروب الشمس بساعتين. لم أفهم كُنه غبطة سلمى بعد ملامسة مياه البحر لجسدها إلا عندما علمتُ أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها بزيارة الساحل، ورؤية البحر عن قرب. نحن امرأتان سوريتان في بداية الثلاثينات من أعمارنا، ننحدر من عائلات متوسطة، إحدانا من دمشق والأخرى من السويداء. بالنسبة لي، أردتُ هذه الرحلة كاستعادة لمكان أو مساحة كنتُ على علاقة معها في الطفولة، وأعتقد أن قدرتي على زيارتها هو استعادة لحقّ بالتواجد في أي مكان من بلدي. وبالنسبة لسلمى، هذه الرحلة هي أول محاولة لممارسة هذا الحق، والتعرف على أماكن أخرى في سوريا.
من هنا، بدأت رحلة بحثي عن علاقة بعض الشابات والشبان السوريين بالمكان والبحر في الداخل السوري. أردتُ أن أعرف كيف يشعرون تجاه فكرة التحرك من مكانهم أو منطقتهم إلى منطقة أخرى اليوم، وهل عادوا إلى الأمكنة التي عنت لهم شيئاً يوماً ما، وخاصة بعد قطيعة دامت سنوات من القهر والرعب والدمار، لصالح التشبث بالمنزل أو المنطقة فقط، كما قال لي واحدٌ ممّن تحدثت إليهم.
ربى، ثلاثة وثلاثون عاماً، موظفة من مدينة حمص، وهي ثالث أكبر المدن السورية، استطاع النظام السوري إخضاعها وإخضاع جميع أريافها الخارجة عن سيطرته بحلول العام 2018. تقول إنها منذ الطفولة لم تشهد أن خرجت عائلتها يوماً أبعد من أطراف مدينتهم، فوالدها لا يحبذ ذلك، ولم تملك العائلة رفاهية التجوال. لكن صديقة أقنعتها بالخروج مع مجموعة سيدات في صيف العام 2019 الى بلدة جميلة وقديمة تقع إلى الشمال من مدينة اللاذقية الساحلية. تلعثمت ربى، بينما تحاول تذكر اسمها، ثم قالت: «لقد طالتها حرائق كبيرة هذا الصيف، نعم تذكرت، اسمها (مشقيتا)». تتحدث ربى حول شعور بعدم استحقاقها لرحلة كهذه، فمصائب الناس كبيرة، ولا يحق لها أمام هذا البؤس والحزن العملاق أن تشعر بالفرح. لكنها حاولت منح نفسها فرصة.
تقول ربى في وصف مشهد الطريق من نافذة الحافلة: «لم أتخيل أن سوريا يمكن أن تكون خضراء، أو أن فيها أماكن بهذا الجمال. رأيتُ البحر لأول مرة منذ زمن طويل، وعندما وصلنا اقتربتُ منه بحذر وهدوء، ثم اقترحت باقي الفتيات استقلال قارب إلى عرض البحر. شعوري بدرجة عمق الماء من تحتي كان سحيقاً، كَرَّسه عدم امتلاكي مهارة السباحة. القارب يترنح في عرض الماء، هذه هي حياتي تماماً، أحيا على أرض غير ثابتة أو مستقرة. أعتقد أنها كانت رحلة تطهيرية زعزعت استقراري وأَخرجتني من مدينتي لأول مرة، إلّا أن الماء ما زال مخيفاً بالنسبة لي».
تُتابع مطلقة بعض الضحكات المكتومة وهي تروي لي كيف خرجت الحافلة عن الطريق أثناء الانطلاق في طريق العودة، وانقلبت إلى الوادي. تقول ربى: «شعرتُ أن هذا كان عقاباً لي، وكأنها كارما تحذرني من اقتراف ذنب الخروج مرة أخرى. إلا أن امرأة من أهل القرية رأت الحافلة وهي تنحرف إلى الوادي من نافذة منزلها، فركضت فوراً مع بعض الناس باتجاهنا، وبدأوا بإنقاذنا بلهفة كبيرة. تأثرتُ جداً من هذا الموقف». غصّت قليلاً وتابعت بتردد: «لا نعرف سكان القرية ولا يعرفوننا، وهم غالباً من طائفة أخرى كما تعلمين. لكن رجال القرية تجمعوا حولنا لحمايتنا، ثم استقبلنا الأهالي في بيوتهم وقدَّموا لنا الطعام والشراب رغم أن عددنا كان يرنو عن خمسين امرأة وبعض الأطفال. أردتُ تقبيل يد المرأة الكبيرة التي حضنتنا بلهفة، وجمعتنا إلى مائدة واحدة. أعتقد أنها أعمق ذكرى وعلاقة استطعت بنائها مع المكان خلال هذه الرحلة. لم أكرر التجربة هذا الصيف رغم الدعوات العديدة، ولا أعلم إن كنت سأفعل لاحقاً، لكني حالياً أعتقدُ أني أُفضِّلُ البقاء في مدينتي ضمن المساحة الآمنة الخاصة بي».
يحكي أوس، 28 عاماً، درس الطب البيطري ثم الفنون التشكيلية، ويقطن مع عائلته في أحد الأرياف الشرقية لمدينة دمشق، عن تجربته في الخروج إلى الساحل بعد انقطاع دام أكثر من خمسة عشر عاماً: «حدث الأمر بالصدفة. والدي موظف في أحد المشافي. أتاحت له النقابة في صيف عام 2019 فرصة الحصول على شاليه في منطقة رأس البسيط، وهو جرفٌ ساحليٌ واسع إلى أقصى الشمال من مدينة اللاذقية، ويعتبر أحد أشهر المقاصد السياحية بالنسبة للعائلات وخاصة المحافظة منها». لم يشأ أوس في البداية مرافقة العائلة، يقول: «انتابتني مشاعر خوف من المحيط، أي من أهالي المنطقة، فأنا أشعر بالتوتر والرعب حتى من مجرد سماع اللهجة، وإن استوقفني حاجز عسكري ما على الطريق، أعرفُ فوراً أنّ عليَ رشوة العساكر المسؤولين حتى يتركونا نمر بسلام بدون إزعاج أو استفزاز، إلا أني لا أعرف ما السلوك المثالي لفعل ذلك، فأنا شخص سريع الغضب وهذه التصرفات الانتهازية تستفزني جداً. تكمن المشكلة في الصورة اللاإرادية التي تشكلت لدي عن هذه الطائفة من الناس، والتي ينحدر منها معظم عناصر أجهزة النظام الأمنية. أعي تماماً أنني لا أستطيع تعميم الصورة، وخاصة على الناس العاديين، لكن هذا الأمر أحياناً قد يكون خارجاً عن السيطرة، فوجهة النظر هذه تشكلت نتيجة الكيفية التي ينظر بها أغلبية عناصر الأمن أو المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة إلى الأمور، والعلاقة التي عملوا على ترسيخها معنا كمواطنين، وهي علاقة قائمة على العنف والفوقية والاضطهاد وانتهاك الكرامة الشخصية عند أي تماس أو تعامل بيننا وبينهم، لذلك أحاول تجنب التعاطي مع أي فرد منهم قدر المستطاع».
إلا أن عائلة أوس الصغيرة مارست عليه ضغطاً عاطفياً لإقناعه بمرافقتها، فهو الابن الذكر الوحيد للعائلة. يتابع أوس: «كانت الرحلة سلسة، لم يعترض أحد طريقنا، وفور دخولنا مدينة طرطوس، وعند أول لقاء بين عيني والبحر، شعرتُ بتلك النشوة التي شعرت بها عند أول لقاء لي مع البحر وأنا طفل صغير؛ شعور تشنج جميل في المعدة، تماماً كالشعور الذي ينتابك إذا ما هبطت بك أفعوانية مدينة الملاهي بشكل مفاجئ من أعلى إلى أسفل. فالبحر بالنسبة لنا بعيدٌ ومُغرٍ».
وصلت العائلة بعد فترة الى رأس البسيط، تسلمت المكان المخصص لها، وهرع أوس الى الشرفة يتأمل البحر عن قرب، ثم ما لبث أن ارتدى ملابس السباحة وخرج: «هناك صورة عن البحر لطالما احتفظت بها ذاكرتي في الخلف، صورة أشبه بصور سينمائية عن شاطئ ذي رمل ناعم نظيف وتجهيزات للاسترخاء في الشمس. إلا أن الواقع كان مغايراً تماماً، الشاطئ وسخ، تراكمت القمامة في كافة اتجاهاته، بل وحملت الأمواج بعضها، وهو شاطئ صخري ليس مؤهلاً للسباحة الآمنة، تناثرت عليه العائلات المحافظة المحدقة بالآخرين، مما دفعني للشعور بالخجل من الجزء العاري من جسدي، وتسلَّلَ إلى داخلي وازع يجبرني على البقاء متيقظاً لِئلا يخترق بصري المجال الخاص لهؤلاء الناس. انكمش جسدي وتكسرت الصورة المتخيلة على تلك الصخور، وبدأت تترسخ صورة جديدة. انتبهتُ بعد برهة أنه لطالما كانت الشواطئ السورية المتاحة للطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتدني على هذه الهيئة. تكمن المشكلة فقط في أن شيئاً لم يتغير كل تلك السنين. تجاهلتُ كل تلك المشاعر وبدأتُ بالنزول إلى الماء بحذر، ولما وصل مستوى الماء إلى فمي، لثمت طعم الملح. أحب هذا الملح الذي يحمل جسدي بخفة أكثر بكثير من طعم مادة الكلور أو الأسيد التي اعتدت عليها في المسابح، إلا أنه لم يستطع التعويض عن شعور الخذلان الذي ترسَّبَ في وجداني. هل تكلفنا كل هذا العناء من أجل مَسرّة أو متعة مُتخيلة؟».
لم يحدث أي موقف غير مريح بين أوس وسكان المنطقة، فما صَوَّره له خياله من مخاوف كان محض وهم. لم يَخلُ الأمر من مصادفة بعض الشبان المُعتدّين بلهجتهم، حيث يستغلون ما تفرضه من سلطة في محاولة التحرش اللفظي ببعض الفتيات: «إلا أن معظم أهالي المنطقة هناك بسطاء مثلنا ودمثون، وهذا موسم رزق بالنسبة لهم سيعتمدون على مردوده أغلب أيام السنة»، كما يقول أوس.
في صباح اليوم الثالث قررتُ أنا وسلمى العودة الى دمشق. وَدَّعنا أصدقاءنا الجدد على أمل أن نتبادل الزيارات بين منطقة محردة في محافظة حماة ومدينة دمشق. ساعدنا أحد الشبان من فريق الإدارة في الاتفاق مع سائق ميكروباص صغير لنقلنا من الوادي إلى محطة الحافلات، عوضاً عن سيارات الأجرة التي اختفت تقريباً بسبب أزمة الوقود. انتابني وسلمى الصمت على طريق العودة إلى دمشق. وعلى الرغم من تواضع الرحلة، إلا أن شعوراً جيدا ًكان يراودنا حول النجاح في تحقيق تجربة التجوال والتواجد في أمكنة مختلفة، بعيداً عن محيط منازلنا وأحيائنا؛ شعورٌ بامتلاك الوطن والحق في لقاء الغرباء من مناطق مختلفة. لقاء الناس، ومشاركتهم بعض الوقت، وابتساماتهم المتواطئة التي يرسمونها تحت نظرات متعبة، تشي بكلام كثير عن مشاعر وأفكار كثيرة، هي تقريباً العنصر الأهم الذي يمكننا التعويل عليه كدافع لتكرار تجارب التجوال.