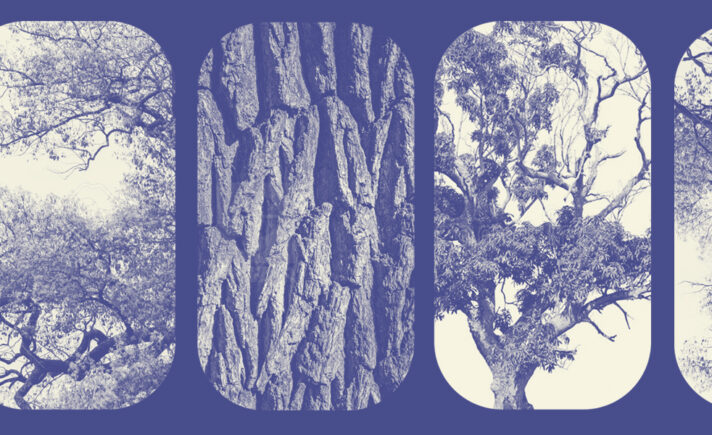وأنتِ التي لا قرية ألفية لديك. تجذّري في الريح، في المحيط الأطلسي، في ضباب الصباح. رغبة الجذور في البنيان ملِحّة. ذاكرة مياهك هي الجذور.
– سميرة نقروش تقرأها مارلين هاكر (تعريبي).
أتوجه بالشكر للأصدقاء سونيلا موباي وسامر فرنجية وزينة حلبي، وإلى أختي أمل، على القراءة والملاحظات والتشجيع.كنت أعلم أن أمي تحلم بأن تكون كاتبة حين وجدت دفترها الأخضر الصغير، حيث دوّنَت قصائد كانت تكتبها. كانت أمي فخورة بكونها أماً لثلاثة أولاد عندما قررَت الرجوع إلى الدراسة. حصّلت البكالوريوس، وبعدها الماجستير، وكانت ستقدم على الدكتوراه لولا أن مسؤولياتها الأمومية أجبرتها على إيقاف مسيرها العلمية والالتفات إلى الأسرة وتدبير الرزق. سمعتُها ذات يوم تقرأ الشعر لأبي، وهو يُجيبها أنه كلام برجوازي لا ينم عن عاطفة صادقة. أعتقد أن أمي قررت أن تهجر أبي يومذاك، ولكنها ستنتظر عشرين سنة أخريات قبل أن تنفذ قرارها.
لا أعرف تماماً من ورث الكتابة عن من؟ هل وَرِثْتُها عن أمي، أم وَرِثَتْها هي عني؟ جلُّ ما أعرفه أن وضعها النفسي كان يتحسن مع الكتابة. فلا المحلل النفسي ولا حبوب الأعصاب كانت تعطي نفس النتيجة: الكتابة تساعد أمي على أن تشلح عنها كآبتها المزمنة وتستبدلها بثقة بالنفس – دون أن تتخلى أبداً عن الحزن والألم. تعلمتْ أمي الكتابة، كما السباحة، على كِبَر: فهي نشرت أول رواية لها في الخمسين من عمرها، وتعلمَت العوم معي أنا عندما كنت في الثانية من عمري. لم تكبَر أمي في بيئة مشابهة للبيئة التي منحتنا إياها. فهي أتت من عائلة يتيمة الأب، فقيرة، تفضّل الذكور على النساء، خصوصاً في زمن كانت الممكنات الاقتصادية للرجل أوسع من ممكنات المرأة. على الأقل، هكذا كانت جدتي تعتقد، وهكذا ربت أولادها السبعة. لم تكن جدتي تعرف بأن التغيير كان قد بدأ في عالم اللجوء الذي كانت تعيشه، وأن ابنتها سامية – التي كانت تُصرّ على الدراسة – ستكون أوفر أطفالها حظاً فيما بعد.
جدتي لأمي، ازدهار، كانت أُمّيّة. لم تعرف حتى كيف تكتب اسمها: ازدهار؛ لم يعلمها أحد أن تكتبه، ولا حتى بناتها. كانت جدتي لاجئة فلسطينية من ترشيحا. وفي المحيط الذي نشأت فيه، لم يُطلب من النساء التعلم، لأن المتوقع منهن كان الزواج والإنجاب و«السُّترة». في العالم الذكوري، أن تكوني أُمّيّة يعني أن تكوني على ما جَبَلَتْك عليه أمك، تنطقين بلسانها. أن تكوني أُمّيّة يعني أنك لم تقطعي بعدُ حبل الخلاص الذي يدور عبره الدم بينك وبين رَحِمِ أمك. هكذا يكتب العرب في معاجمهم. لذلك أمر جبريل النبي محمد أولاً بأن يقرأ، لكي يُثبت أنه قطع صلة الرَّحِم تلك مع الأم ودخل إلي عالم الانتماء الاختياري. أن تقرأ هو أن تتحول عن الأم وتجد لك «أمة». هذه الأمة سيحتكرها الرجال في معظم تاريخنا البشري المدوَّن. كانوا يكتبون ويقرأون، ويُبعدون نسائهم عن تلك الأفعال.
«الأمّة» كما نعرفها نحن الذين توارثنا العربية بصلة الأرحام هي أصلاً لغة مشتركة. هكذا فهمْنا موضعنا في العالم، أي أسسه المتجذرة في الإعراب. هذه الأمة كانت دائماً ذات صوت متجهّم، ومِسطَرة خشب ذات حدًّ حديدي تصفعنا بها معلّمة اللغة العربية على أيدينا الصغيرة بُغيةَ تثقيفنا من خلال تصحيح نطقنا، خاصة في أواخر الكلمات. لم يضرب أحد يدي ازدهار لتقويم نطقها وتحويل لسانها عن لسان أمها. في قصصي التي أرويها لطفلَيَّ عن ازدهار، أجعلها دائماً ساحرة شريرة، مؤذية، ولا تحب الأطفال كثيراً. جدتي تشبه جدات روالد دال في حقدها على الحياة. يشدّ ابني الصغير اللحاف أكثر نحو رأسه وأنا أخبره كم كانت الساحرة ازدهار تحب طعم لحم الأطفال. لم تكن ازدهار طمّاعة، بل كانت أحياناً تستبدل العضّ على سواعدنا بأكل السكّر. ها هو ذا خاتمها الذي ورثتُه عنها يوم وجدته مرميّاً بين رزم الأوراق في بيت أبي. أذكر جيداً كيف كان يضيق كل سنة على إصبعها. هذا الخاتم – كما أخبرت طفلَيّ – سحريّ وقادر على أن يغلب أكبر مارد، وقد جربته شخصياً في حروبي اليومية بين بيروت وأوسلو. يكفي أن أحكّه وأتمنى ليمتلئ قلبي شجاعة وأُخرج من لساني ناراً تُحيل الأشرار رماداً. قوته تكمن في حقد جدتي على الحياة. هذا هو الحقد الذي سيلازمني إرثاً، والذي شكّل اهتماماتي الأدبية في معظم حياتي. اسمها ازدهار. ولدت أيام الثورة العربية الكبرى قبل النكبة، وتوفيت منكوبةً في مشفى فقير في مخيم برج البراجنة، حيث تتناهش الجرذان لحم المنسيّين في لبنان.
جدتي ازدهار هي الإرث المخزي الذي كان علي أن أستره عن عيون الناظرين. وسيمرّ علي زمن طويل قبل أن أقبل أن مثل هذا التعرّي ضروري لكتابة التاريخ. تنبّه الكاتبة إيمان مرسال إلى العلاقة الزمنية التي تحدّد التفكير بالأمومة. عندما نفكّر بالأمومة نتوجّه إلى الماضي والمستقبل في آن واحد: «يوم كنت ابنة لأم، ويوم أصبحت أماً لطفل». الكتابة عن الأمومة لازمة لأننا جميعاً أطفال لأم، وإن لم نكن جميعاً مهتمّين أو قادرين على أن نكتب من خلال التفكير بالرحم – رمزياً كان أم جسدياً.
الكتابة تشبه الأمومة في طبيعتها الزمنية. كملاك التاريخ البنياميني، نقف على ماضينا الأليم وننظر بقلق إلى المستقبل، كتّاباً كنا أم أمهات. في كلتا الوظيفتين نتجه إلى الماضي: إلى أمنا وجدّاتنا، وسائر الأمهات اللواتي عرفنا، أو إلى ماضٍ تَرَبّينا فيه على أيدي كتّاب قرأنا لهم لنستقي ونستلهم، أو لنختلف ونعارض، سواء قصدنا ذلك أم فعلناه دون وعي. كما نتجه إلى مستقبل قلق يتشكل فور رغبتنا في الإبقاء على الجنين، أو عندما نتصور أننا حتماً سنجد قراء لما نكتبه. لحظة الحمل بجنين ولحظة تفريغ فكرة (أو إنجابها) على الشاشة تتقاطعان في فعل الخلق، وإن كان نتاج الكتابة ليس أبداً كفصام الولادة.
تختلف بين الحالتين العلاقة بالمكان: الكتابة هي وسيلة للخروج من سجن لغوي يكبّلنا في قيود وأعراف المحيط، والحمل هو فصام يفرض على الحامل إعادة تحديد علاقة جسدها بمحيطه. ولكن الكتابة والأمومة تعودان لتلتقيا عندما ننظر إلى الإرث الأدبي من خلال المجاز الأمومي. كما تكتب ماغي نلسون في تحويرها لمقولة المفكرة الكويرية إيف سيدجويك: «الأمهات ذوات الجندرات المختلفة القريبة على قلبي» هنّ كل الكتاب الذين يحبوننا ويحرّروننا من خلال كتاباتهم: رجالاً كانوا أم نساءً أم أي لون آخر في قوس القزح الجندري. وهنا أتاني التحرر على مستويين: أقرأ لآخرين وأُغرم بهم، فتنفتح نوافذ في دماغي؛ أشاهد أمي تصارع الكلام، فيتحسّن وضعها النفسي مع كل مقال منجز.
انسلخت أمي عن نفسها بعد وفاة جدتي ازدهار في الستينات من عمرها. ومنذ ذلك اليوم، ينتابني رعب من ذلك الفصام الذي يتولد عندما تموت الأم. كتبتْ أمي رواية عن امرأة خمسينية تتعرف لأول مرة على شهوتها في حمّام عمومي مقزّز في أحد مخيّمات لبنان. لم تعارض أمي يوماً شهوتي. كانت توارب في العطف عليها وحمايتها من تصلّب أبي في تربيتنا. أمي كأمها، تحب لحم الأطفال ولكنها لم ترغب يوماً في أن تصبح ساحرة. هي مثقفة، سلاحها العلم، ولا يليق بها تقمّص الأنماط القصصية. قررت أمي أنه إذا كان لا بدّ من نمط تتّبعه، فالنمط الأمومي هو الأفضل في إيجاد القوة اللازمة للبقاء على قيد الحياة (الكريمة). كان أبي يشجّع هذا النمط، ويردد علينا دوماً أن اللبؤة أقوى من الأسد، فترد ماما ورائه: نعم، فأنا قادرة على انتزاع قلب والتهامه إذا حاول إيذاء أطفالي أياً كان. كنا نصدّقها، فنحن نعرف أنّ لديها غضباً مكنوناً، ينفجر كالبركان حسب وتيرة العمليات العسكرية ضدّ المخيّمات الفلسطينية أيام الحرب الأهلية اللبنانية. كانت كلبؤة محبوسة في قفص المنزل، تعض علينا وعلى نفسها، تجول في القفص وتنظفه كالمهووسة، وتستشيط غضباً علينا عندما نرفض أن نجاري هوسها بالترتيب والنظافة. كانت أمي تردد دوماً: إياكِ أن تحبلي قبل إتمام الدكتوراه. كأن الأمومة سببت لها عائقاً لم تكن دائماً تعرف كيف تتخطاه. أما أنا وأختي فلم نسمع لها. حَبِلت أختي الصغرى، وبعدها بسنة تقريباً حَبِلت أنا. كنت في بداية الماجستير.
قالت لي معالِجة نفسية أن الأمومة مناقضة لعملية الكتابة، وأنني إذا كنت بالفعل أرغب بتطوير كتابتي فلا بد لي من التضحية بأمومتي قليلاً. كنت قد قرأت فرويد ولاكان بما يكفي لأعرف من أي إنجيل تستقي تلك المعالجة أفكارها الخنفشارية هذه. وعندما جادلتها، استحضرتْ كتاب إليف شافاك الحليب الأسود لتبرهن وجهة نظرها. بدأت أقرأ الكتاب، وسرعان ما ضجرت من شخصية تلك الكاتبة الهائمة بين الأمومة والكتابة. ولم أكمله. لمَ كل هذه الرومانسية حول العمل الكتابي؟ أليست الكتابة مهنة كغيرها من المهن؟ هل كانت معالِجتي ستقول لمهندسة أو كوافيرة (أو لمعالِجة زميلة مثلاً) أن الأمومة تناقض هذه المهن، وأنها إذا أرادت إحداهن أن تنجح في مهنتها فعليها التضحية بجزء من أمومتها؟ هل كانت ستظل تَعُدّ نفسها نِسوية لو أصدرت حكماً كهذا على نساء يزوالن مهناً أخرى؟
عقود قبل جلسات العلاج، كنت قد فهمت أن الكتابة هي ما سمح لأمي بأن تلعب دور اللبؤة في حياتنا. عندما اتخذتْ قرارها بأن تكون الكتابة مهنتها، كنت أنا أتحضر لصفوف البكالوريا. أخي الصغير كان ما يزال في الابتدائية، وأبي كان سيبدأ رحلة طويلة في سلسلة وظائف غير مستقرة في سوق عمل خليجي قائم على الاستغلال وهضم الحقوق. بدأت أمي تعمل كصِحافية، وأصبح مدخولها من الكتابة حيوياً في صحة البيت الاقتصادية. وكنا نفتخر كثيراً بها عندما نقرأ اسمها يذيّل مقالة في الجريدة. كانت تكتب أشياء أحبّ أن أقرأها، عن العالم خارج المنزل. كانت شجاعة وحانقة، ولم تكترث أبداً للرقابة. كانت جرأة مقالاتها تزيد الجو في المنزل تشويقاً، وكنت أفتخر بها في كل مرة كانت تكتب بدون خوف من الميليشيات السياسية الحاكمة، فتقول ما لم يتجرأ أغلب الصِحافيين على البوح به في ذلك الوقت. كانت أمومتها العمود الفقري لكتاباتها، فهي تحب الناس وتُسمّيهم في نصوصها كما تسمّي الأم أطفالها عند الولادة. لبؤة كانت، معهم ومعنا.

كما أمي، وجدت أمومتي في الكتابة. لم تسعفني قراءتي لفرويد كثيراً عندما قررت أن أصبح كاتبة. هذا الرجل كان يرى في القلم رمزاً للقضيب، يقذف حِبره كالمنْي ليَهَبَ الحياة. عَمَاه الجندري لم يلتفت إلى النساء وكتاباتهن. أما أنا فكنت قد أصبحت أمّاً عندما هربت من حبيبي إلى حبيب آخر. كان يعجبني في هذا الآخر حلمه بأن يصبح كاتباً، إلا أن هُيامي به تضاءل عندما انتبهت أنه يبدو، هو الآخر، لا يأخذ الكاتبات من النساء على محمل الجد. وفي يوم من الأيام، لم أعد أستحمل ترداده لترّهات فرويد، فجمعت كل الأقلام في المنزل ودحشتها في كسّي بغضب صارخة: «أنا الخلق يا خرا، مش القضيب والحبر اللي فيه!». نظر إلي بريبة، ونعتني بالمجنونة. تقرأ صديقتي زينة هذا النص و تطلب مني أن أقول شيئاً «عن الجنون كنوع من ’جنوح‘ في القول والكتابة؟». جملتها أهم مما ينبثق فيّ من فكرة: أصبحت مجنونة في عينيه لأنني أعدت الاعتبار لكسّي عبر هدم المجازات على بعضها والجنوح بكسّي إلى القول الكتابي.
انفتح شيء داخلي عندما وُلدت ابنتي نور، كأنني وَلَدتُ نفسي كاتبةً في نفس اللحظة. ليست كل النساء مثلي، فمنهن من تجد الكتابة في الكسّ نفسه، وأخرى في الأصابع، وأخرى في الحَلَمات، أو حلقة الشرج مثلاً. أمّا أنا فجاءتني الكتابة عند انفصامي إلى أنا وجنين: أختار اسماً لها، كما سأتعلم أن أختار كلمات لمعانٍ أريد أن أعبر عنها لكني لا أفقهها تماماً بعد. أختار اسماً كانت جدتها لأبيها أول من أوحت إليّ به. لم آخذ الاسم كما هو، بل حورته قليلاً ليلائم وجهة نظري في الأمور، كما هي الحال في الكتابة: يعطيني أستاذ مفهوماً ما فأذهب به إلى مفهوم مشابه ولكنه مفهوم خاص بي، كأن الكلمات لا تصبح كلماتي إلا إذا انتزعتها من فم شخص أكبر وأفهم مني. أخذت الاسم وحوَّرتُه لأنفخ فيه تشويشاً أرتجي أن أُحْدِثه في معاني الكلمات المتعارف والمتفق عليها.
في بادئ أمومتي، كنت أجد ضيق الوقت يساعدني على التركيز، فليس عندي أكثر من ساعتين أو ثلاث في النهار للكتابة، وباقي الوقت يستغرقه الترضيع والتحفيض والتنويم، وهذا بحاله دوام عمل كامل. إذاً، كنت أكتب كمن تُسابِق الزمن. كان علي أن أصبح أمّاً لألامس هذا السباق المُضْني مع الزمن.
هذا سباق سيتعقّد أكثر عندما أهاجر إلى النرويج وأجدني أمّيّة من جديد. الانتقال إلى محيط جديد ناطق بلغة لا أعرفها جعلني خارجة عن عقده الاجتماعي، وعاد بي إلى ما جبلتني عليه أمي. هابتني الهامشية التي وجدتُ نفسي فيها، فصُورتي عن نفسي لا مكان فيها لمثل هذا الضعف. كان أبي في دعمه لي في تلك الأيام يذكرني بأن اللغة وسيلة، «مفتاح» كما كان يسميها. وهذا المفتاح عثرت على السبيل إليه مع ابنتي، فهي التي علّمتني اللغة. كنت أقرأ لها قصصاً لا أفهم منها شيئاً، فأُضطر إلى علك أصوات جديدة وتقليبها على لساني من خلال تقليد ما تنطق به ابنتي. اللغة أم. اللغة وسيلة. وابنتي أصبحت أمي ووسيلتي للتأقلم في هذا العالم الجديد.
في إحدى القصص الشعبية الفلسطينية في كتاب قول يا طير، وُلِدتْ بنت لأم وحيدة لا يظهر زوجها أبداً في الحكاية. تتحول هذه الطفلة إلى طنجرة تستوعب كل ما رغبت الأم به. كنت أقرأ قصة «طُنجُر» مراراً لابنتي كأنني مسلوبة الإرادة. أقرأ القصة مع أنّ ابنتي لم تكن تهتم كثيراً لسماعها. كانت تصبر على قراءتي ويسوّغ لها ذلك قِصَر النص. أما أنا، فكنت أقرأها على نفسي فعلياً. في قراءاتي المتكررة لهذا النص، بدأتُ أدرك إحساس القرف الدفين الذي كانت تملؤني به هذه القصة، وأدرك أنّ إعادة قراءتها على ابنتي كانت محاولة مني لفهم كيف أصبحْتُ أنا ابنة لها. كنت أتمنى لو أنني أقوى من أن أجعل من ابنتي طنجرة لرغباتي.
جبلتني أُمّيّتي على أمي الأولى ازدهار، وكان التخلص من ازدهار ضرورياً إذا كنت أريد ألا أتحول إلى ساحرة. ازدهار كما كنت أصوّرها شريرة. كانت أمّيّتي تملأ قلبي خوفاً. في ذلك الوقت، كنت أتواصل مع أمي سامية كل يوم لأستفسر منها عن كيفية إعداد أطباق مختلفة أشتهيها منذ صغري. تعلمتُ إتقان المجدّرة والملوخية واللبن أمه. عندما كنا أنا وأمي في نفس البيت، لم يكن يروق لها أن تعلّمني الطبخ، بل كانت تفضّل أن أتقن أصنافاً من العلوم على أطباق الطعام. كان الطبخ، في زمني الأمّيّ في الغربة، الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن في الأدوار العائلية. أطبخ كأم توارثت الطبخ شفوياً عن أمها، لكي أتعلم الكلام من جديد من أمي الكبيرة في الوقت الذي أتحمل فيه واقعاً جديداً: ابنتي أصبحت أماً لي في هذا الأصقاع الغريبة (والصقيعية) عبر اللغة الجديدة. لم أكن قد فهمت بعد أن «الأدب» يُشتق إلى «مأدبة» في العربية، كما ستعلمني إحدى «أمهاتنا ذوات الجندرات المختلفة القريبات على قلبي» أحمد فارس الشدياق. اكتشفت العلاقة بالفطرة، فتقليب الكلام على اللسان كان يشبه مغامرتي في السوبرماركت في النرويج، حيث كانت تختلط علي أصناف الطعام فأشتري السمك عندما أكون قد نويت شراء الموزاريلا، فأخرب السلطة، فآكلها لأن كبّ الطعام حرام.
عندما قرّرت أن أحبل من جديد، كنت أفكّر أولاً بابنتي: فالعوالم النفسية التي لدى أمها وأبيها والأمراض الذاتية تعقّد دورها كأم لنا. لذلك هي بحاجة إلى أخت تشاركها حِملَها في هذا الدور، ويجب على هذا الجنين أن يُنسَب إلى نفس الأب لتسهيل الحِمل عليها، فنهاية هذا الزواج باتت محتومة وكنت قد تيقّنت من ذلك. عندما ردّدتُ هذا المنطق أمام أختي قالت: «جنون هذا، ولكن الحَبَل نفسه جنون، وأنت بالتأكيد لست المرأة الوحيدة المجنونة بهذه الطريقة». لغوياً، أختي محقة، فالجنين نابع من نفس الجذر الثلاثي ج-ن-ن، وبالتالي هو مربوط بجنون الأم التي قررت أن تجعل من جسمها طنجرة لجِبِلّة بشرية لا يعرف أحد بالضبط شكلها ولا ما ستكون عليه عندما تكبر. يكشف طارق العريس عن علاقة الجنون بالجنين وعلاقتهما بالسَّتر، فجَنَّ عنك أي سَتَرك. لذلك تسمّي العرب الحبل الرابط بين جنون الأم وجنينها بالحبل السُّرّي، وكذلك يسمونه حبل الخلاص، أي ذلك الذي قد يخلّصك من الحياة إذا التفّ حول عنقك ولم يتنبه الأطباء لفعل الخنق وتداركوه قبل فوات الأوان.
عندما أتى المخاض الذي أَذِن بقرب ولادة ابني حكيم وهو في شهره الثامن في بطني، تدفق مني ماء الرأس كشلال. لم يكن حكيم الجنين قد نضج في رحمي بما يكفي بعد. طلبوا مني في المستشفى أن أبقى في وضعية النائم ما استطعت ذلك، فبقيت كذلك ثلاثة أيام أنتظر اكتمال خلق رئيته قبل أن نباشر عملية الولادة. عندما خرج من بطني كان ضئيلاً. إلا أن ما لفتني فيما بعد كان خوفه العظيم من الماء. كان يكره أن يستحم، ويصرخ كالمستغيث من الغرق عند كل حمام. كان يكره المطر، ولا يحب السباحة أبداً. لم أجد أي تفسير علمي لرُهابه هذا، ولكني أكاد أجزم بأن خوفه من الماء وهو إنسان مستقل كان بمثابة ترجمة لخذلان جسدي له عندما كان في بطني. تلتف الكلمات على الأفكار، تارةً تُصيب المعنى، تارةً تخنقه. تأتي الصديقة المحرِّرة، تفتح بطن النص وتحرِّر المعنى من خذلان الجسد.
هكذا وُلد حكيم. أسمتْه أختي التي كانت دائماً تفطن لمَرامي. أسمتْه حكيم، وبذلك رمّمت أوصال العائلة بتمجيد ذكرى عمي حكيم الذي كان بمثابة الصمغ الذي يقي آل عيسى التفكّك – ولكنه توفي عندما لم يعد قلبه يتّسع لقساوة هذا العالم. تعلّمت مع حكيم أن أكون أماً من جديد. كانت الكتابة قد أصبحت من يوميات حياتي. وها هي النرويجية قد أصبحت إحدى لغاتي قراءةً ومحادثةً وحتى كتابة. كنت قد حَبِلت بحكيم قبل أن أقدّم مشروعي لرسالة الدكتوراه حول الترجمة والإنجيل واللغة العربية.
كان يكبر داخلي، وكانت إحدى أعزّ صديقاتي على قلبي حُبلى أيضاً. هذا الحمل لم يكن كالذي قبله. لست وحدي في هذه الأمومة الجديدة، وإنما صديقتي لينا تختبرها إلى جانبي. نذهب إلى البركة سوياً، نتناوب على السباحة، ونقرأ أخبار الثورات في تونس ومصر واليمن. تعلمنا أن نستعمل تويتر لمتابعة الأوضاع المتفاقمة على الأرض (الأرض بطبيعة الحال هي بلادنا العربية المنكوبة، وليست الأرض التي نمشي عليها كل يوم في أوسلو). معاً سنتعلم كيف نكون أمهات لصبيان. معاً سنوسّع حدود معتقداتنا النِّسوية ونتسائل سوياً عن أي مستقبل نتخيّله للذكور.
تقول ماغي نيلسون إن حَبَلها بصبي جعلها تعترف لنفسها بأن هذا الجنين الذي بداخلها سيكون شخصاً مستقلاً بذاته بعد أن يزحط إلى العالم، ولن يكون بإمكانها أن تجعله «طُنجُر» لتغذية معتقداتها النسوية السابقة على خلقه كما لو أنها وَلَدت بنتاً. اكتشفت أيضاً أنه يمكن للأم أن تجعله طنجرة إذا قررت أن تكسر حواجز الهوية الجندرية. جميلة نيلسون بأفكارها عن الأمومة الخارجة على أكثر القوالب ترسخاً. أجمل ما فيها أنها تحاول التفكير بالأمومة في زمن الاعتراف الموسَّع بالتحول الجندري على نحو غير مسبوق. حبيبها متحول، ولكنها هي التي تكون مضطرة إلى تقبّل الحقيقة البيولوجية لطفل في بطنها. وهذا الطفل يُرغمها على التخلي عن يقينها بقدرتها على السيطرة على وضع جسدها. فالأمومة تُخرج جسد الأم عن سيطرتها، مما يسبّب عند بعض الأمهات حالة مرضية من السيطرة التي تترجَم وسواساً في النظافة والمظهر والتربية الصارمة لأولادهن. يتجلى هذا النمط للأمومة خاصة عند جيل أمي. تضيف جين سعيد مقدسي في كتابها عن الحرب الأهلية في بيروت كلاماً عن عناد النساء للصمود أمام الخطر والعنف اللذين يعمّان المدينة. السيطرة على المنزل تعويض عن السيطرة على المدينة التي قد فُقدت.
أنا مقتنعة برأيها، ولكن أتساءل أيضاً هل الهوس بالسيطرة سببه الأمومة بحد ذاتها؟ ألا يفرضها منطق أمومي أساسي للتعاطي مع الأمور؟ فقدان السيطرة لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على الفعل، وإن كان فقدان السيطرة هذا يسبب عوارض مرضية عند بعض النساء، من اكتئاب ما بعد الولادة إلى وسواس النظافة. هنا لحظة الولادة قد تكون ذات دلالة: ندخل الطلق، أي تبدأ عملية الولادة، أي الولد في تلك اللحظة آتٍ لا محالة، ولكنه لن يزحط إلى الخارج إلا إذا قبلنا آلام المخاض وتعاملنا معها بدل مقاومتها، وسلّمنا بأن الطريقة الوحيدة للتخلّص من هذا المخاض هو استبداله بآلام أشدّ، أي نشدّ عضلات أكساسنا بكل ما أوتينا من قوة ليكتمل فعل الولادة؛ قوة لم نعرف أنها كامنة فينا. نشدّ، فنتنفّس، فنشهق فنزفر، فنشدّ فنتنفّس، إلى أن يزحط الولد.
عجيب أن أطباء التوليد (وهم بغالبيتهم ذكور) يشجّعون النساء على تقبل التخدير بواسطة الحقنة فوق الجافية («الإبيديورال») لتحمل الألم. لا يريدون النساء أن يعلمنَ ما في داخلهم من قوة لتحمل الأوجاع وقدرة على اجتراح الحياة من قلب قسوة الولادة. هذا لا يعني أن النساء اللواتي يقبلن بالإبيديورال فاتتهن معرفة هذه القوة، فالأمومة تظل تمتحننا في أكثر من موقف، حتى تلك المواقف التي تجعل بعض النساء يمتنعنَ عن الإنجاب البيولوجي. كتبت في هذا المضمار سارة مراد قصيدة جيدة عن بعض النساء اللواتي قررن ألا ينجبن، وهي محقة عندما تزعم أن الأمومة بحد ذاتها لا تجعلك ذات شأن، ولن تجعلك تلقائياً أقوى أو أضعف، أكثر مسؤوليةً أو أكثر إهمالاً. وينطبق هذا على الأم والابنة على حد سواء. فالأمومة بالتأكيد لن تجعل منك كاتبة، ولكن قد تكون آلام الولادة مساعِدة على تحمل آلام الكتابة. فللكتابة آلامها الرهيبة، تُرى من هو المحرّر القادر على تقوية الأمهات ذوات الجندرات المختلفة بدون فرض التخدير عليهم؟ وهل قد يكون مرادف التخدير في هذه الحالة فرض الفصحى الصارمة على النص؟
ولكن بالتأكيد مع أو بدون إبيديورال، ومع أو بدون فصحى صارمة، للدخول في مخاض الأمومة أو الكتابة وما يحمله من تحولات أثر باقٍ على المرأة التي تقرر خوض تجربة الأمومة (أو الكتابة)، سواءً عن طريق رحمها أو بطرق بديلة. فإذا كانت الأمومة موضوعاً يهم امرأة ما، ستدرك تلك المرأة تماماً بأن خوض تجربة الحمل سيغير نظرتها إلى جسدها إلى غير رجعة، حتى ولو قررتْ أن تتبنى طفلاً أو أن تعيش حياتها بدون أولاد. إنه الوعي على التحول في العلاقة مع الذات التي تنقسم على نفسها. يصبح فهمُنا للفضاء وللزمن خلال فترة الحمل فِصامياً. في بطننا يقبع المستقبل، ولا يعود جسدنا ملكنا حصراً، إذ الجنينُ هو أنا ونحن، وهو وهي، وصيغة الجمع أيضاً. كل الضمائر تسري على هذا الحبل الرابط بين الأم والجنين. والتناسل يفرض منطق الفِصام والتعددية على الأم. كذلك الكتابة: نقرأ فنكتب؛ يقرؤوننا ويكتبون، وهم كما نحن ضمائر مفتوحة على كافة الاحتمالات.
لقد كثر (وتكاثر) على الفيسبوك صور الأصدقاء الذين تبنَّوا القطط والكلاب، وتضاءلت أمامها أعداد الأطفال المولودين حديثاً بشكل رهيب. كأن المجازر المتتالية جعلت الناس تخاف من المستقبل. الجنين هو المستقبل بامتياز. واليوم تأتي الحيوانات لتسد حاجة البشر لأن يكونوا أمهات، ذكوراً كنَّ أم إناثاً. عاطفة الإزاحة هذه لم يكن فرويد ليستوعبها. الأمومة هي أن تنزاح عاطفة الحب عن المركز (الإيغو لدى فرويد) فنتعلم أن الحب هو ما يقذفنا في مدار الشخص-الكوكب الذي نحبه، فندور حوله ونهتم به: نُطعمه، نحفّضه، ننيمهم – فنجد القليل من الطمأنينة. أكتشف وأنا أليّك بالقلوب على صور الحيوانات هذه أن عاطفة الأمومة ليست حكراً على النساء، ولا هي متقصرة في توجّهها على البشر، وأننا اليوم بحاجة لتفعيلها فينا إذا أردنا ألا نفقد توازن عقولنا جرّاءَ الوحدة المفروضة على حياتنا حتى قبل علقة الكورونا. فالأمومة عاطفة سياسية بامتياز في قدرتها على ابتكار علاقات بين البشر، بل بينهم وبين سائر الكائنات. هكذا عشتُ الثورة اللبنانية العام الماضي: أدركت الأمومة كفعل مسيّس، فتبنّيت أشخاصاً وتبّناني آخرون، رضّعنا بعضنا، ونفخنا على الجروح، ونظرنا سوياً تحت التخت للتأكد أن ْلا أشباح تختبئ في تلك العتمة، وصرنا نغضب على بعضنا إذا ترك أحدنا غطاء معجون الأسنان مفتوحاً. إذاً، كيف لنا أن نتعاطى مع القوة السياسية الكامنة في الأمومة؟
نستعين هنا بالشدياق، وتحديداً نظريته حول الألفاظ والمعاني في العربية في ترسيم معالم هذه الطاقة. بحسب الشدياق، إذا ما قلبنا الأحرف في جذر كلمة ما، نصل إلى كلمة مرادفة لها أو مضادة لها. فلنقلب «الأم»: ماء، ومواء. لنبدأ بالكلمة الأخيرة التي ذكرتني بمقال للباحثة الأسترالية ديبورا روز تتناول فيه ملاك التاريخ لدى والتر بنيامين. تتساءل روز: إذا كان هذا الملاك كلباً (أو قطة)، يينبح أو يموء من أنين الوجع، ويبكي الخسارات في الليالي الموحشة، كما أنه أيضاً ينبح أو يموء ليبحث عن كلاب (أو قطط) رفاق له هائمين مثله على أنفسهم في البرية. أما لفظة الماء فتستحضر لنا تاريخاً طويلاً للربط بين الأم والبحر (وربما الخوف من الغرق أيضاً). اعتناؤنا بالماء – أمّ الحياة – هو اعتناؤنا بأنفسنا، بأجسادنا وشهواتنا وجروحنا. تكتب الشاعرة الأميركية-الأصلية ناتالي دياز أن الماء هو الجسد الأول:
نحمل النهر
جسد الماء في جسدنا.
اقطعي أذنك
تعيشي.
اقطعي يدك تعيشي.
اقطعي رجلك تعيشي.
اقطعي عنا الماء
لا تعيشي لأكثر من أسبوع.
اليوم عندي كل مياه العالم. تخرج المياه من الحنفية في أوسلو. أشربها وأرتاح لأنني أشرب أنظف ماء على الكرة الأرضية. أذهب مع حكيم إلى البحيرة التي هي مخزون مياه المدينة. أحقاً لا توجد أي سموم في هذه المياه؟ لا تصلني هذه الماء بماء المتوسط المالح والأقرب إلى قلبي – رغم كل السموم والخراء المرميّ فيه. خرجت من بيروت لأني أم تخاف على مستقبل أطفالها في مدينة مسمومة منكوبة بعنف الساسة المجرمين. لا تعوّض كل المياه في مخزون أوسلو عن المسافة التي تفصلني عن أمي. تركتها ورائي في منزلها الجميل، تكبر وحدها في تلك المدينة التي يهجرها أطباؤها وتجفّ مياهها وتذبل عافيتها.
كِبَر الأم يشبه كِبَر الولد، كلاهما يذكرنا بتقادم الزمن، بالوقت الذي يتبخر فيما نخسر السباق الذي ليس بسباق أصلاً. لا أعرف كيف أمحو هذه المسافة الهائلة التي أحدثتُها بيننا. وكأنه يترتب علي أن أخسر أمي في غياهب البُعد كي أتيح لأطفالي فرصة أفضل للعيش الكريم.