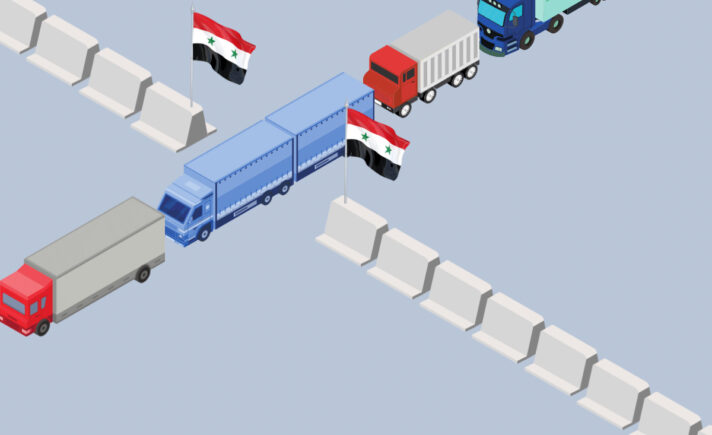أنهى مشهد العناق بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد خلافاً استمرّ لأكثر من ثلاث سنوات. وبينما كان الخلاف بين قطر والدول الأربعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مؤثراً للغاية على وضع المعارضة السورية، فإن نتائج هذا الصلح لن تظهر مباشرةً على الملف السوري، وهي لن تكون بالغة التأثير بأي من الأحوال طالما بقيت أنقرة تتحكم بالمعارضة السورية بشكل تام.
منذ العام 2017، ساهمت الخلافات الخليجية والعربية في تراجع دعم السعودية للمعارضة السورية، لصالح تبني أنقرة لمؤسسات المعارضة تلك بشكل كامل، واستخدامها لاحقاً في تقديم الغطاء السياسي اللازم للوجود العسكري التركي المباشر في ريف حلب الشمالي، ومن ثمّ في عفرين وبعدها في مناطق من الجزيرة السورية.
وضمن تلك المعادلة، استطاعت أنقرة التي تستقبل مقر الائتلاف السوري المعارض، أن تستقطب أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات في نسختها الثانية، بعد انسحاب شخصيات رئيسية أهمها المنسق العام السابق، رياض حجاب. وهو ما أدى عملياً إلى أن تستحوذ تركيا على النفوذ الأكبر ضمن الهيئة العليا للمفاوضات، وهي التي كانت في الأساس فكرةً سعودية، حاولت الأخيرة من خلالها تأسيس جسم سياسي جديد للمعارضة السورية، خارج إطار العلاقات القوية للغاية بين قطر وتركيا من جهة ومؤسسات المعارضة السورية من جهة أخرى مثل المجلس الوطني وائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، واستجابة لمزاج دولي لم يكن يرى في الائتلاف ممثلاً كافياً للمعارضة السورية.
مع تراجع التأثير السعودي في المعارضة السورية، أصبح الائتلاف السوري، الذي يمتلك فيه الإخوان المسلمون كفّة راجحة، هو التيار الأكثر حضوراً ضمن الهيئة العليا للمفاوضات، ما ساهم بأن يكون أعضاء الهيئة كما أعضاء الائتلاف القائمين بعملهم ورقة في يد تركيا، تستطيع التحكم بها بشكل شبه كامل، الأمر الذي انعكس على طريقة تسمية أعضاء اللجنة الدستورية، حيث قدمت أنقرة قائمة المعارضة للأمم المتحدة، بينما قدمت موسكو قائمة النظام.
على الصعيد الميداني، أدى الانسحاب السعودي والإماراتي من سوريا، ووقف دعمهم للفصائل العسكرية فيها، تحديداً فصائل الجبهة الجنوبية في درعا، إلى قطع أي أمل أمام تلك الفصائل بالحصول على دعم في مواجهة حملة عسكرية قادتها قوات النظام بدعم روسي، ما أفضى في النهاية إلى توقيع اتفاقات مصالحة في المنطقة، ساهمت في إدخال قوات النظام إلى مناطق حيوية من محافظة درعا وعودة مراكزه الأمنية في عدد من بلداتها. فيما كان الدعم السعودي في فترة من الفترات للكتلة العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، محاولة لا يبدو أنّها حققت أي نجاح للحصول على نفوذ في مناطق سيطرة قسد والتحالف الدولي شمال شرق البلاد.
أنهى بيان قمة العُلا الخليجية الخلافات بين قطر والسعودية بشكلٍ رسمي، وقد أكّد البيان على تمسك الدول الخليجية بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، وهو ما لا يعتبر تغييراً للسياسات المعلنة للدول الخليجية قبل المصالحة وبعدها، وإن كانت الإشارة إلى ضرورة وقف التدخل الإيراني في سوريا تحولاً في سياسات قطر، المهادنة لطهران منذ بدء الأزمة الخليجية نتيجة حاجتها إلى منافذ استراتيجية بديلة عن تلك التي أُغلِقَت في وجهها من قبل السعودية.
وفيما تراجع حضور سوريا في السياسات الخليجية منذ أعوام، لا يبدو حتى اللحظة أنّ المصالحة تلك ستغير شيئاً، خاصةً وأن دول الخليج تواجه تحدياً أكثر مصيرية بالنسبة لها، وهو الصراع مع إيران الذي بلغ خلال العامين الماضيين حدوداً جديدة من التوتر كادت تقود إلى حرب إقليمية في بعض المنعطفات. في الصراع مع إيران، ركزت كل من السعودية والإمارات معظم جهودهما على الساحة اليمنية في مواجهة حلفاء طهران هناك، وذلك لاعتبارات الحدود المشتركة مع اليمن، وامتلاكهم فيها أدوات فقدوها في سوريا، تساعد على التنافس ومحاربة النفوذ الإيراني في جارتهما الخليجية.
على الرغم من أنّ التقارب الخليجي يأتي اليوم بعد فقدان تلك الدول قدرتها المباشرة على التأثير في سوريا، إلّا أنّ هذه المصالحة قد تفتح الباب مجدداً على تبني الدول العربية مجتمعة لتيار أو تحالف في المعارضة السورية، يمكن أن يمكّنُه الدعم المشترك من امتلاك وزن أعلى على الساحة السياسية، خاصةً بعد أن أصبح الائتلاف ذراعاً محلياً لتركيا في البلاد التي تخضع اليوم لسيطرة مباشرة من عدّة دول.
لا ينتظر أحدٌ تغييراً جذرياً في تعامل الدول الخليجية مع الملف السوري، لكن بالتأكيد فإنّ خروج تلك الدول من أزماتها البينية سيساهم في تعزيز دورها من جديد في البلاد، دورٌ يمكن أن يكون قد استفاد من أخطاء الماضي الصغيرة منها والكارثية، علّهم «لا يتهاوشون على الصيدة» مرة أخرى.