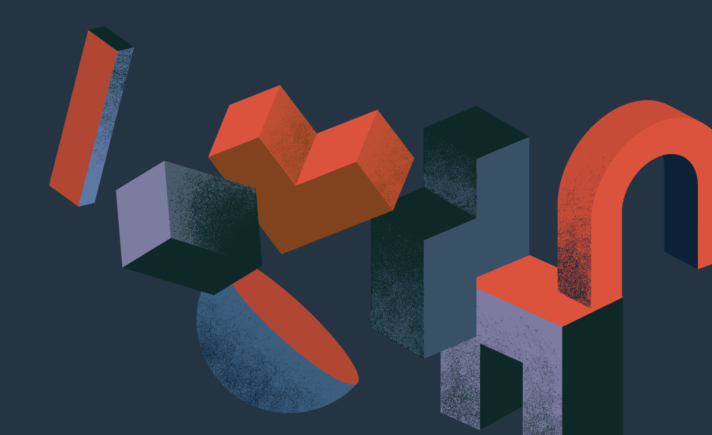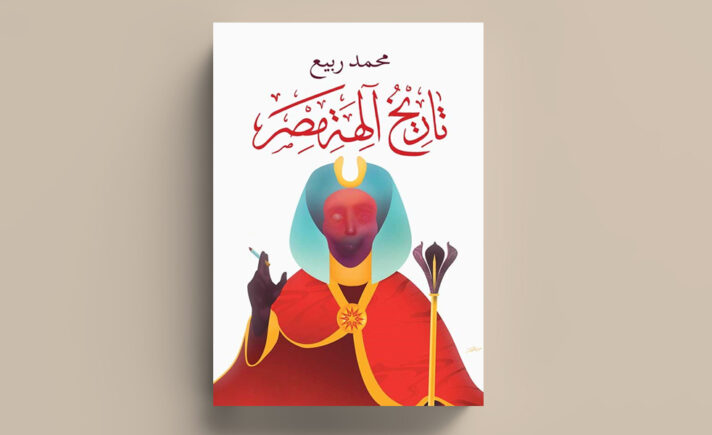- مؤتمر لعودة اللاجئين في دمشق. المغرب تهرول إلى حظيرة التطبيع وفلسطين تكاد تبتعد للأبد. ألمانيا تلغي حظر ترحيل اللاجئين السوريين، ورأس النظام يخطب من الجامع (المكان الذي أفزعه) عن فُسق المثليين وانحلال النظام الأخلاقي!! عالمٌ وَقِح بالفعل. كوكبٌ مسعور، بلا أدب أو لباقة. كذلك أفكر، وأحاول تجاوز الأمر ليوم اعتيادي، لكن كيف يمكن ذلك؟ ونحن نشهد نكسة أشد من نكبات منطقتنا الكثيرة، لكن بخبث، ودون ضجيج. سقوط دون دوي، وخسرانٌ بصمت. على الطريق بين برلين وأمستردام أتمنى أن يستمر القطار في مشيه نحو دمشق، بيروت، القدس. تلك هي المدن التي أريدها بحق، أليس من البدهي أن العودة إلى البيت/الوطن حق؟ ما هي هذه الهجرة السرمدية التي نعيشها أجيالاً تلو أجيال؟ وكيف لقدر اللجوء هذا أن ينتهي؟ ألا نريد نحن الفلسطينيين العودة؟ ألا نبغي نحن السوريين العودة؟ هل يوجد شروط متفق عليها للـ«العودة» في التغريبة السورية كما هو الحال مع الشتات الفلسطيني؟ ربما قبل الإجابة، يلزم الوقوف على ثلاثة مفاهيم مذكورة: الهجرة، واللجوء، والعودة. وهي مفاهيم أساسية تبدو للوهلة الأولى بديهية، ومتفق عليها، بينما هي في الواقع متباعدة ومركبة.
هجرة أم لجوء؟
يقبع مفهوم الهجرة في مكان قصي من التاريخ البشري، إذ لطالما انتقلت جماعات بشرية وهاجرت من مكان إلى آخر مذ بدء التاريخ، لأسباب مختلفة؛ أهمها الحروب، حين يُنتج الصراع مجاميع تُهاجر من أرضها قسراً نتيجة الحرب المباشرة؛ أو طوعاً نتيجة خراب الأراضي. لم يكن مفهوم الهجرة هذا يوماً على حاله، دائماً ما كانت تطرأ عليه تحولات وتغيرات حسب تقادم القرون، إلا أن تلك التغيرات لم تغير في جوهر المفهوم وتقلبه مثلما حصل في القرن العشرين.
بعد حربين عالميتين، أُقِر النظام الأممي الجديد، وستنشأ معه منظمة الأمم المتحدة التي ستكرس بدورها مفهوماً جديداً لهجرة البشر، سيسمى اصطلاحاً «لجوء»، وهو بتعريفه البسيط: حينما يلجأ فرد من بلد إلى آخر بسبب حرب أو خطر لقناعة سياسية أو معتقد. من هنا ستبدأ رحلة طويلة من تهديم مفهوم «الهجرة» بشبكته الكلاسيكية، وبناء مفهوم جديد على أنقاضه، مفهوم أكثر تعقيداً، يلائم عالماً يتوغل بعنصرية جواز السفر والجنسية. ستبدأ أنظمة الإدارة البشرية بالتفريق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وسيبدأ للمرة الأولى الحديث عن اللاجئين بدل الحديث عن المهاجرين وسيبدأ التاريخ المعاصر بخلق «نوع جديد من الكائنات البشرية، كالبشر الذين يوضعون في المحتشدات من قبل أعدائهم وفي مراكز الاحتجاز من قبل أصدقائهم»، على حد تعبير حنّا آرنت.
ولأن نكبتنا كانت بُعيد انتهاء الحرب، كان الفلسطينيون هم أول من وُسم بوسم «لاجئ» في المنطقة العربية، وربما كانت الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) من أوائل المنظمات الدولية المعنية باللاجئين التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، حينما اكتمل تحول العالم إلى نظام عنصري، لا مكان فيه للهجرة البشرية بشكلها الكلاسيكي، حين يهاجر البشر دون أوراق ثبوتية، ويختارون مكان إقامتهم وحياتهم الجديدة. وبينما سيُطلَق على القادمين الجدد إلى فلسطين مسمى (مهاجرين) سيسمي العالم الراحلين من فلسطين قسراً بـ«اللاجئين». وفي مقابل «الهجرة اليهودية» سيكون هناك «الشتات الفلسطيني». من هنا كانت بداية حكاية اللجوء في المنطقة، وستتبعها حروب ولاجئون في لبنان والعراق وغيرها، لكن لن يطاول سردية اللجوء الفلسطينية إلا حكاية اللجوء السوري، الحكاية المفتوحة منذ عقد ولم تزل. وأما فلسطينيو سوريا، فقد ورثوا لجوءاً فلسطينيا قاسياً وعاشوا لجوءاً سوريا أقسى لا يكفي لوصفه مِداد.
العودة بما هي واجب
ترقد العودة في الذهن الجمعي الفلسطيني كواجب. منذ البدء نتشرّبُ أن وجودنا مؤقت: سنعود يوماً، كلنا، إلى الفردوس المفقود. حين يكون ذلك ممكناً، علينا كفلسطينيين متمسكين بهويتنا، العودة إلى البلاد. هذا هو المنطق الذي تربّت عليه ثلاثة أجيال فلسطينية. كانت العودة كواجب بديهية. كيف لا وهي مؤجلة ومشتهاة، والإقامة، في أي من بلاد اللجوء العربي، هي مؤقتة مهما طالت.
رغم العقود العديدة التي قضاها الفلسطينيون في سوريا، بقيت مسألة العودة واجباً لا يتم نقاشه بالنسبة للضمير الفلسطيني. لا يكرسها الفلسطينيون بتوارث سرديتهم وحسب، بل أيضاً عملت منظومة البعث على تكريس فكرة «المؤقت» بالنسبة للوجود الفلسطيني في سوريا، فمهما استقر وتجذّر الفلسطينيون وتماهوا مع بلدهم السوري سيبقون «لاجئين مؤقتين»، وكل ذلك بالطبع كان تحت شعارات المقاومة والتمسك بالحق الفلسطيني. كذلك، بين الذات والآخر، تم صب مفهوم العودة كواجب، واجب أخلاقي محفور في كل ذات فلسطينية حرة.
هذا الواجب الأخلاقي، سيُلعب عليه ليعاد إنتاجه في الحالة السورية، وبدء الحديث عن «واجب» عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، والتنظير للعودة على اعتبار أنها واجب أخلاقي «وطني»، وقياسها بوجوب العودة الفلسطينية، رغم البون الشاسع بينهما. العودة الفلسطينية تشكلت كواجب أخلاقي ذاتي على مدى عشرات السنين، بينما ما زال مفهوم العودة في اللجوء السوري ملتبساً ومعلقاً بتعقيدات العملية السياسية والوضع المعيشي. لا يمكن فصل القول في مفهوم العودة السورية بعد، فهي موجودة بالطبع داخل الوازع الأخلاقي لكل اللاجئين السوريين، لكن فرض وجوبها من قبل أي منظومة سياسية أمر غير ممكن في السياق الحالي لسوريا. الواجب مزروع في جذر الحرية، ونحن -السوريين- لم نُحصِّل الحرية المنشودة إلى اليوم. كما إن صدع «داخل/ خارج» في سوريا ما زال في طور التكوّن، ولم يستقر بعد مثلما هو حال صدع «داخل/خارج» الفلسطيني الذي اختلف كثيراً على مدى العقود السابقة. بعبارة أخرى، تفرض الذات السورية (ذاتيَ السورية على أقل تقدير) وجوب العودة إلى سوريا يوماً ما: العودة إلى الوطن. لكن ليس من الممكن بعد الحديث عن العودة كواجب موضوعي على اللاجئين السوريين، واجب تفرضه المنظومة المسببة للتهجير، واجب قد يكون في حقيقة الأمر حقاً.
العودة بما هي حقّ
منذ اللجوء الفلسطيني الأول، كُرِّسَ مفهوم العودة إلى الديار كـ«حق إنساني»، إلا أن هذا الحق لم يُحقَّق ولم يتم، وربما أصبح اليوم أبعد من أي وقت مضى. وبعدما كان على مدى عقود من الثورة الفلسطينية بنداً أساسياً في الحل، يكاد لا يُحكى عنه اليوم وكأنه معلق، أو كأنه لم يعد موجوداً. لكن شعبياً، ما زال كل الفلسطينيين ينادون بـ«حق عودتهم». على امتداد شتاتهم في أصقاع الأرض، يطالبون بالعودة إلى فلسطين كحق لهم، كما كانت لآبائهم وستكون لأبنائهم. ولو أنهم يحتاجون الكثير من القوة المفتقدة لإقرار هذا الحق، إلا أن دوام الحديث عنه والمناداة فيه يفعل فعله بتكريس حق العودة الفلسطينية كحق إنساني ومطلب أساسي. وبالرغم من كل المحاولات السياسية لتمييع هذا الحق وتبديده وإرجائه ومحاولة محوه، بقي حق العودة محفوراً في الوجدان الفلسطيني وجذراً أساسياً في القضية الفلسطينية، ولعل أخطر ما في مراكب التطبيع المتلاحقة اليوم أنها تسعى لتدمير حق العودة وجعله حقاً بالياً، يسقط مع التقادم.

إلى الآن، وبعد عقد من التيه السوري، لم تتم المناداة بالعودة إلى سوريا كحق يُطالَب به ويُحكى فيه. بقيت العودة تتجلى كورقة سياسية تتبادلها الأنظمة السياسية الحاضنة للاجئين السوريين. تلك الأنظمة التي تعاملت مع اللاجئين كمخزون بشري فائض عن الحاجة، مُثقِل لكاهل الدولة، وهو ما قيل سابقاً عن الوجود الفلسطيني في بعض الدول العربية. باختصار، أُقصي اللاجئون السوريون، أصحاب هذا الحق، عن الحديث حول عودتهم/حقهم، وموعدها وشروطها. لم ينشأ أي حراك أو تنظيم أو حملة تطالب بالعودة كحق يجب الحصول عليه. ووقفت هيئات المعارضة المتشرذمة تتفرج على ملف اللاجئين دون أن تبادر بأي حراك لتمثيل هذا الحق، أو حتى الحديث عنه، وتذكير السوريين بـ«حقهم» في العودة إلى بلادهم. بل ما حصل كان أسوأ، فمن سرق من السوريين حقوقهم الأساسية ودفعهم إلى اللجوء في أصقاع الأرض، هو ذاته من يصادر حقهم في العودة اليوم، ويعيد تصديره على أنه واجب وفرض والتزام.
العودة بما هي خيار
عودٌ على بدء، وفي محاولة لقراءة حضور مفهوم اللجوء في قانون اللجوء والهجرة الأوروبي، نجد أنه خلف هذه الشبكة من القوانين والأنظمة المعقدة المتعلقة بمسألة اللجوء في أوروبا، تتخفى الكثير من التفاصيل العنصرية في التعامل مع هذه القضية الإنسانية. فالاتحاد الأوروبي يُعرّف اللجوء على أنه «حق إنساني»، بينما تلتف الاتفاقيات الأوروبية (وعلى رأسها اتفاقية دبلن) حول هذا الحق وتنحته على هواها: فليس للاجئ حق اختيار البلد التي سيلجأ إليه، بل هو مرهون بمكان بصمته الأولى، وذلك يعني عشرات الآلاف من عمليات الترحيل داخل القارة العجوز، وتبديد أحلام اللاجئين في الاستقرار والعيش بسلام في البلاد التي اختاروا المخاطرة للوصول إليها. عملية الترحيل هذه تقوم قانونياً على مسألة رفض اللجوء، فما إن رُفض طلب لاجئ حتى تبدأ دوائر المغادرة والترحيل بملاحقته لترحيله، إلى بلده الأصلي إن كان آمنا (حسب التصنيف الأوروبي للدولة الآمنة) أو إلى بلاد أوروبية أخرى. المسألة هنا تكمن في مفهوم «الرفض»، أليس اللجوء حقاً؟ كيف يُرفض منح هذا الحق؟ قانونياً، الإجابات كثيرة ومتشابكة. أما فكرياً: يهدم الرفضُ اللجوءَ كحق، ويحيله إلى امتياز. فعلياً لم يُرفَض حقك في اللجوء، لأن الحق لا يُرفض، ما يحصل أنه لم تتوافر فيك ميزات اللاجئ التي تمنحه ميزة اللجوء. لا يمكن أن يكون اللجوء حقاً إنسانياً وفي الوقت عينه يُرفض ويُقبل، يُمنح لأحد ويُمنع عن الآخر دون أن يُترك له الخيار/ الحرية، في البقاء أو الرحيل.
عند مقاربة فكرة الترحيل في حالة اللجوء السوري سنجد أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بمفهوم العودة، ودائماً ما عبّرت الأحزاب اليمينية المتصاعدة في أوروبا عن ضرورة «عودة» اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أو ترحيلهم، لا فرق لديها في ذلك، مع أن الاختلاف بين الاصطلاحين كبير جداً. فالعودة بجوهرها خيارية، فعل حر يقوم به الفرد بإرادته ويختاره، أما الترحيل فهو فعل إجباري ــ وهو في اللغة مختلف عن الرحيل ــ إلزامي لا خيار فيه للإنسان. لا يمكن القول اليوم بعودة اللاجئين السوريين من أوروبا. الأدق هو القول بترحيل السوريين، وهذا يقلب مفهوم العودة رأساً على عقب، يجرّده من الحرية ويضرب ماهيته كخيار، ويجعل مصطلح العودة ورقة تلوّح فيها الأنظمة الأوروبية في وجه اللاجئين السوريين تحت ذريعة سوريا «الآمنة». وهكذا لم تعد العودة حقاً أو واجباً، بل أصبحت خطراً محدقاً، تُدفع إليه لا تختاره.
كفلسطيني سوري، سوري فلسطيني، موسوم بـ«لاجئ» منذ التكوين، يومياً أفكرُ بالعودة. أشعرُ بالدوّار، وأحملُ إرثاً متراكماً من الهجرات واللجوء، ومطالبَ عودةٍ مختلفة المستويات. إلى أين أريد العودة؟ إلى فلسطين كمثال مُشتهى؟ إلى مخيم اليرموك في دمشق كوطن؟ أم إلى بيروت كملجأ قريب من القلبين؟ أي اللاجئين أنا؟ فلسطيني في سوريا؟ سوري في أوروبا؟ فلسطيني- سوري في لبنان؟ كثيرةٌ هي الصور التي علقت في ذاكرة اللجوء والهويات والثورات، لكن أكثفها وأكثرها وضوحاً هي صورة جدتي في يومنا الأخير في مخيم اليرموك. صباح النزوح الكبير من المخيم، وفي الوقت الذي يضج فيه أهل المخيم حاملين أمتعتهم وهائمين على وجوههم. العائلة، الأصدقاء، الأقارب، الجيران، كلهم يشكلون زوبعة هائلة، تدخل جدتي في يدها القهوة، بهدوء المرأة المقتدرة تخبرني أن أجلس: «يا ستي»، تطلب مني أن أصمت وأشرب قهوتنا قائلة :«اقعد يا ستي اقعد، اشرب فنجانك وانبسط فيه، هاد آخر فنجان رح نشربه بالمخيم». أفزعتني العبارة، حاولت الرد، فإذ بي أقول كليشيه: «لا ياحجة، يلا شهر زمان ومنرجع». ترشفُ من سيجارتها الطويلة ودون أن تنظر إلي وبلا أي ملامح للأسى تهمس بوقار: «قالولنا هيك وما رجعناش. الأرض اللي بتطلع منها بترجعلهاش يا ستي». ثم تُكمل بلهجة آمرة: «اشرب اشرب». جدتي السبعينية التي عاشت هجرات لا تحصى، من قريتها في حيفا وصولاً إلى منفاها اليوم في لبنان، كانت تقول وقتها عين الحقيقية. حتى هذه اللحظات يا ستي الطيبة، مازال فنجاني ذاك هو الفنجان الأخير.