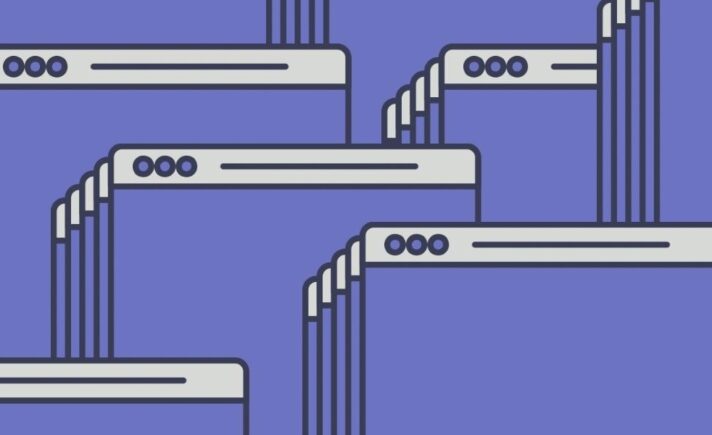«لو كسروا عضامي ماني زاحف، رح ألمّ عضامي وأصنع مقلاع وحجر»؛ كيف لبنت بعمر سبع سنوات أن تستوعب نشيداً كهذا. كان جزءاً من ذاكرة البلاد البعيدة التي يورثها الأجداد والآباء، في صُرّة محكمة الإغلاق، لأبناء الجيل الثالث من اللاجئين الفلسطينيين. حَفِظَت البنتُ أغاني فرقة العاشقين، واحتفظتْ بدُمى خشبيّة على هيئة «حنظلة»، وعلّقت شالاً فلسطينياً في غرفتها، لكن عنقها الغض لم يكن ليحتمل هذا الطوق الشائك وهو يضيق على شهيق يقتنص الأكسجين المؤقت في أرض مستأجرة، وبلاد مؤقَّتة. لا تريد أن تتكسر عظامها تحت المطر والغيم الأسود ثم تُشكِّلَ منها مقلاعاً، وهي تشاهد في التلفاز شباناً فلسطينيين يجابهون بالحجارة بنادق الجنود الإسرائيليين عند المسجد الأقصى.
أن تكون ابن فلسطين، وتعيش في دول «طوقها العربي»، يعني أن تحمل توصيفاً متفرداً عن جميع سكان العالم؛ أن تضيف جنسية لاحقة إلى فلسطيَّنيتك: مصري، أردني، لبناني، أو سوري. وقد تحار أيهما أقرب إلى هويتك، فلسطين، أم تلك الهوية الفرعية للدول التي ينسبونكَ إليها. وصف «الطوق» الذي أُطلق على البلدان المحيطة بفلسطين، تَحوَّلَ إلى أطواق حول أعناقنا نحن، ما دمنا لاجئين متحدرين من سلالة لاجئين. وأن يكون الفلسطيني فلسطينياً سورياً، يعني أن يكون سورياً اليوم، ما دام يسير في الطرق ذاتها التي يسلكها السوريون هرباً من الموت. لكن عمر حكاياته صار أكثر من ستين عاماً، ولا تزال نهاياتها مفتوحة. بعد أن هُجِّرَ من مخيمه، وعرف ألّا حدود لأوجاع فقدان المكان.
هنا مخيّم اليرموك. يفرض أطفالُه فرحهم اليومي فيه كحالة احتجاج دائمة تُعبّر عن حقهم الشرعي كأصحاب أرض، وكأنَّ المخيم جزءٌ من فلسطين. حجران على الأرض يعلنان بدء دوري الحارة لكرة القدم. ولأن البطولة ليست حكراً على الأولاد في عالم المخيم، فقد كان للفتيات أيضاً حقُّ المشاركة في لعب كرة القدم وركوب الدراجات الهوائية، ونصيبٌ من الخدوش والجروح في الأكواع والرُّكب، وحتى خوض الشجارات بين عصابات من الصبْية والبنات، بالحجارة أو بالـ«نُّقيفات».
فتاة بعمر سبع سنوات، لعبت بالـ«النُّقيفة» أو المقلاع لإصابة هدف ثابت بحجر، واستخدمتها كسلاح ضد أولاد الجيران المُزعجين، أو في محاولات فاشلة لاصطياد عصفور في حقول درعا، لكن هذه اللعبة ليست صالحة لمواجهة جندي إسرائيلي مدجَّج بالسلاح.. كان اضطراباً عميقاً في نفس الفتاة، هي ليست مشروع فدائية، ولم تُغرِها فكرة حمل السلاح أو قتل الإسرائيليين أو اختطاف الطائرات، بل وجّهت عينيها صوب تلك التجارب الجديدة والمثيرة التي قد يبدأُها طفل خلال نشأته. تجارب ترتبط بأماكن بعيدة، خارج مخيم اليرموك.
أيام نوى ودير العدس في ريف درعا تحفر الذاكرة عميقاً. تمشي بين حقول صفراء من الأشواك. حجارة البازلت مرصوفة فوق بعضها مُشكِّلةً نصف أسوار حول البيوت. محاولات القفز فوق الأسوار كانت مغامرة بحد ذاتها، تستطيع البنت أن تعرف من خلالها كم زاد طولها بين صيْفين. منازل متباعدة عن بعضها، وليس للأرض التي أمامها حدود تنتهي بها. تقترب الفتاة أكثر فأكثر من أهداف الكبار الذين يحملون بواريد تجعل أجسادهم أضخم، ويعلو إيقاع الطبول في رئتيها. أنظارهم تجوب السماء بحثاً عن نقطة سوداء يجب أن تسقط أرضاً، بالبواريد وليس بالحجارة. يقطفون نباتاً شوكياً اسمه الخرفيش، يقشِّرونه ويأكلون ساقه. تتجه رصاصة نحو عصفور بعيد جداً، يمشي العمالقة باتجاه طائر الفرّي الذي يهوي نحو الأرض، وهي تركض مع الصغار لترى عصفوراً مدمّى، بحجم كفِّها الصغيرة.
*****
من دوار البطيخة وحتى حي العروبة، ومن بساتين الثلاثين حتى التضامن. يتشارك فلسطينيون سوريون، وسوريون، السكن في مساحة كيلومترين مربعين تقريباً، شكّلت لهم جميعاً هوية واحدة؛ هوية أبناء المخيم. كانت القاف والكاف التي ميّزت كلمات المدن الفلسطينية عن بعضها، قد توحَّدت في لهجة خاصة بفلسطينيِّي مخيم اليرموك. كما اختزل المخيم لسكانه مسافات بعيدة جداً ليجمعه بالشامي والحلبي والديري والحوراني، وربما لا تُميّز فيه بين سوري وفلسطيني في الهيئة أو الكلام. لكن الفلسطيني السوري إذا مات، ينعيه «عموم آل الفقيد في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن والمهجر»؛ هذه جملةٌ لازمةٌ في جميع النعوات المعلقة عند الجوامع وعلى الجدران وأعمدة الكهرباء في الشوارع.
ترى في المخيم -الذي هو شارعا اليرموك وفلسطين والحارات المتفرعة عنهما- عشرات آلاف المصلّين أيام الجمعة، يفرشون الحارات المحاذية للجوامع بالسَّجاد. وقد تسمع أصوات تحطُّم زجاجات البيرة التي تُرمى بعد منتصف الليل من نوافذ المنازل. في السابعة صباحاً، تخرج جماعاتٌ من الموظفين والطلاب والمعلمين، ومعلمات المدارس المحجَّبات بغالبيّتهن، وبعد انتهاء الدوام «يُسوِّكُ» الشبان على زوايا الحارات وقرب مدارس البنات. في حارة ثانوية اليرموك، يلمّ عناصر الشرطة بين حين وآخر هؤلاء الشبان ويحتجزونهم لساعات قليلة، وتبكي بنات الثانوية على أحبَّائهنّ. قرب مفرق شارع لوبية شجرةٌ عملاقة تحط عليها مئات العصافير كل يوم، وعند غروب الشمس، تتعالى أصواتها مجتمعة في كرنفال.
في حارة تمتد لأربعمئة متر، قد تصادف محلاً لبيع الكاسيتات يصدح منه صوت الأغاني إلى درجة قد لا تستطيع أذناك تحملها. أمتار قليلة وتمرُّ قرب محل بقالة، فتسمع من داخله صوت عبد الباسط عبد الصمد يتلو مقطعاً من سورة ياسين. تخرج إلى الشارع لترتفع أصوات سائقي السرافيس خلال شجار. في غير أيام الأعياد، ترى مراجيح منصوبة في أمتار مربَّعة قليلة فارغة من البسطات. الأسواق توسَّعت إلى حد لا يُمكِّنُها من التوسّع أكثر، وظهرت أبنية جديدة مكسوَّة بالحجر الأبيض، تقف منتصبة لتعلن المخيم عاصمة للتَّائهين.
تكبر البنت وتمرُّ حيادية على كل شيء في ماراثونها اليومي بين المنزل والمدرسة الإعدادية. وقد تتجرَّأ قدماها فتصلان بها إلى شارع الثلاثين، حيث منزل إحدى صديقاتها. هذا الخرق يشبه أيَّ خرق لأيِّ شيء في حياة اللاجئ الفلسطيني، يمكن أن تؤَنَّب عليه، لكنها تكرره راضية بالتوبيخ المعتاد. هذا طوقٌ آخر يحزُّ عنق الفتاة كلما كبرت، ويتركها أغلبَ الساعات في غرفتها الصغيرة جداً، تتعلم وضع الكُحل وتراقب «كشاشي الحمام» من الطابق الرابع في حارة فرن حمدان.
كان الوطن/المخيم يكبر أيضاً، إلا أن طائرة حربية قصفت جامع عبد القادر الحسيني، وأعلنت توقف كل شيء. الطائرة الحربية تحلّق، وعلم البعث الذي يشبه علم فلسطين ما زال يرفرف في المدرسة الملاصقة للجامع، دماء الفلسطينيين والسوريين تنزف، والشبان في الشارع يصيحون: «خيَّا… النظام قصفنا».
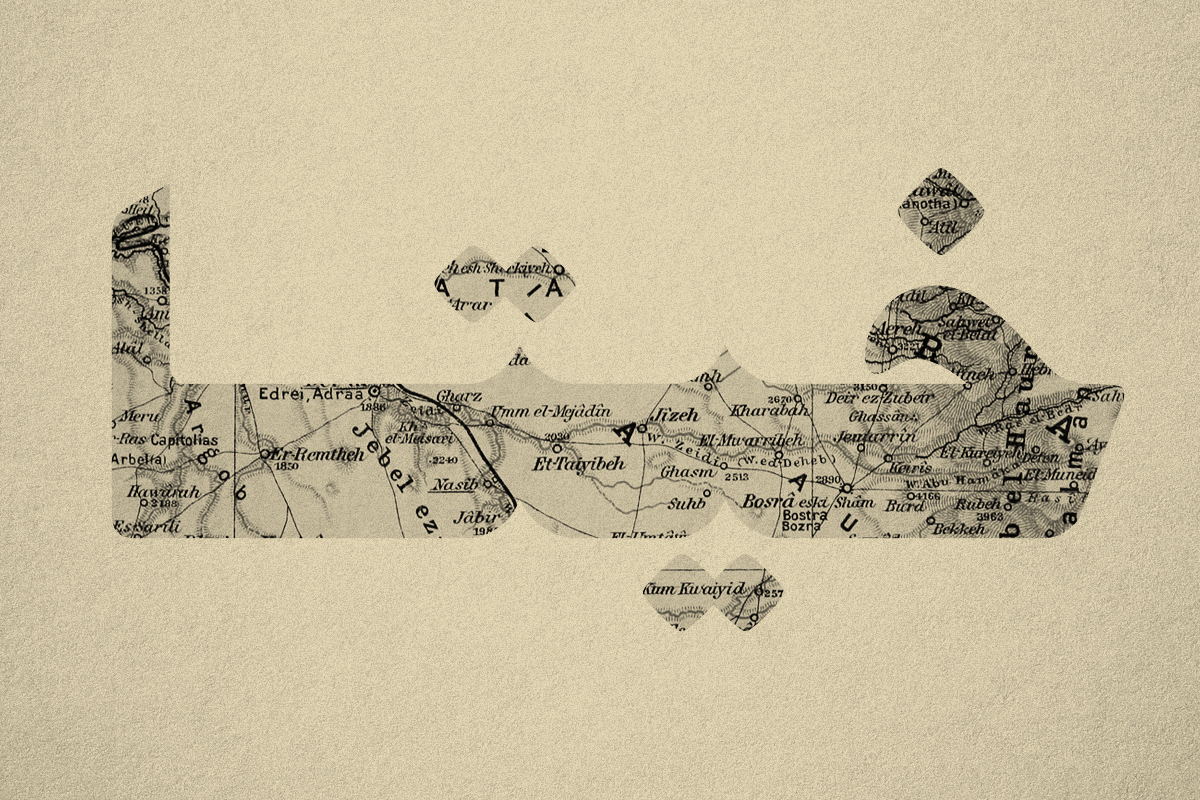
في المخيم كلمة سرّ قد تحلُّ أصعب المشكلات في الشجارات بين الشبان؛ «خيَّا». «خيَّا» كلمة يُنادَى بها كل الشبان في المخيم، وينادون بها كل من يعرفونهم خارجه أيضاً، أما «خيتا»، فتلك كلمة تحمل قصصاً أخرى.
أنا في المخيم «خيتا»، بالنسبة لأخويّ، ولأصدقائهما، ولأصدقائي الفلسطينيين السوريين في كلية الآداب. خرجتُ من المخيم قبل ثماني سنوات، وما زلت أُخاطَب بـ«خيتا» من هؤلاء.
أنا «خيتا»، رغم معرفتي بطرقات وشوارع قليلة في المخيم، في طريق يومي من وإلى المدرسة، أو أسبوعي إلى بيت جدتي، أو في زيارات معدودة إلى منازل الصديقات. حفظت أقلَّ مما يجب من شوارع المخيم على مدى أربعة وعشرين عاماً من سنوات عمري التي عشتها فيه. هل أنا حقاً جديرة بأن أكون «خيتا» وأنا أمشي في الطريق إلى شارع العروبة كي أصدر هويتي المؤقتة كلاجئة، وأستكشف عالماً غريباً من زحام لا أجرؤ على المرور فيه دون رجُل يصطحبني، ولا أعرف طريق الوصول إليه أو الخروج منه والعودة إلى منزلي الذي يبعد عنه خمس عشرة دقيقة مشياً على الأقدام؟
كانت حميميَّةُ المكان تتمثل بالناس الذين أعرفهم فيه. لم أتعرف على شوارع جديدة أو حارات إلا إذا سكنها أقارب أو صديقات لي. لم أمر يوماً في حارة المغاربة، ولا في عشرات الحارات المتفرعة عن شارع اليرموك يمنة إلى شارع الثلاثين ويسرة إلى مخيم فلسطين، وكأنني كنتُ أقي نفسي من تبعات تغيير المكان والمحيط لاحقاً.
سنوات الدراسة في المخيم كانت محطَّات انتظار يجب أن تمرَّ بسرعة لتصل بي إلى كلية الآداب في المزة. سيُعيدني سرفيس يرموك-مزة أتوستراد يومياً إلى منزلي في المخيم، وسيقلّني إلى جامعتي في اليوم التالي، لكن السرفيس بطيء، ناهيك عن تحرُّش محتمل الحدوث فيه. مواقف عدة كهذه تكررت، لأستبدله بالتكسي الذي كان يضطرني لأن أدفع ثلاثة أرباع مصروفي يومياً لقاء أن يلقي بي خلال عشرين دقيقة عند باب الكلية مباشرة، لتبدأ هناك الحياة التي أحبها.
طوال السنوات الخمس في الجامعة، كان السوريون شباناً وصبايا يشكلون غالبيَّة أصدقائي ومعارفي. في الجامعة فلسطينيون كثر، وإن كنتُ قد عرفتُ أحدهم، فيجب أن يكون قد عرَّفني عليه السوريون الذين يحفظون المخيم أكثر مني، وتقودهم أقدامهم فيه بتلقائية إلى أهداف صحيحة.
أعود مع أصدقائي السوريين إلى المخيم، وأزور المركز الثقافي الفلسطيني لأول مرة. وسوف تظهر ملامح شخصية الفتاة الفلسطينية عليَّ في واقعة أو مناسبة أو ذكرى؛ يموت أبو عمار، تُقصَف غزة، تُرتكبُ مجزرة ما. وأعرف أن العراق وغزة هما حزن وانكسار، وتشدني أيَّة أغنية كُتبت لفلسطين، وسوف أظلُّ أضمُّ خاء الخبز وأكسر باءها (خُبِز).
*****
هذه المرة، آخر سيارة أجرة أستقلُّها من كلية الآداب في المزة إلى مخيم اليرموك، تبدو دمشق جافلة منكمشة على نفسها. الألوان تنسحب من كل شيء كلما اقتربتُ من المخيم. عند دوار البطيخة دبابات ومدافع، أسطح بنايات الـ14 قبالة المخيم صارت منصات لإطلاق الصواريخ. إذا دخلت شارع الثلاثين، تبدو المباني وكأن جُذاماً أكل ملامحها. في حارة صغيرة قرب مجمع «كوسكو مارت» دبابةٌ محترقة. هنا قُتل تعذيباً محمود ابن سميرة موظفة المطبخ في مشفى فلسطين وأُحرقت جثته، بقيت سميرة التي أنهكها المرض وجرعات الكورتيزون في انتظار أي خبر عن ابنها أو أي فيديو يصوّر جثته، وحين تأخر الخبر كثيراً ماتت بعينين مفتوحتين. ابتسامة الدكتور أحمد الحسن تلتصق بالجدران أمام مشفى فلسطين كشهادة جريئة على الخيبة المضحكة المبكية التي لازمت الفلسطيني على هذه الأرض، قبل لحظات من سقوط القذيفة التي قتلته كان على موعد مع استلام معدات طبية أحضرتها أم العبد السورية، ابنة عقربا. وهذا شارع الـ15، أول حكاية حفظتُها ورَدَّدتُها على شرفة منزلي مع والدي. مشفى فايز حلاوة الذي وُلدتُ فيه، إلى جوار مدرسة درَّستُ فيها تلميذات في الصف الثالث، كتبوا لي عشرات الرسائل ورسموا قلوباً ملونة فيها، وبكوا عندما غادرتُهم.
بالقرب من جامع الحسن جثة لأبي أحمد طيروية، وإلى الأمام قليلاً قرب مركز فريج الطبي جثة أبو صهيب الحوراني، مقتولان برصاصات من ملثمين. من أقصى المخيم تهدر دراجة ذات عجلات ثلاث لأم محمود، تدور على بيوت المرضى والمسنّين وتعطيهم الدواء، تغسل أجسادهم وملابسهم وتُعدِّهم ليكونوا جديرين بالمخيم الذي رفضوا الخروج منه. الفلسطيني لا يشيخ ولا يتعب ولا يقعده المرض في الفراش، إنه إله العودة الأسطوري. ومن الاتجاه المعاكس تماماً، يدخل «أمير» داعش أبو صياح فرّامة على صهوة حصان معلناً «الفتح الإسلامي» لمخيم اليرموك. أم محمود وأبو صياح وجهان للمخيم، قبل وبعد قصف النظام لجامع عبد القادر الحسيني، كانا في المرحلة ذاتها والمكان ذاته، هي صورة أصيلة عن فلسطين المرأة والحبيبة والأم، وهو صورة دقيقة عن الجريمة البشعة بحق الفلسطيني ووطنه.
في آخر امتداد شارع الثلاثين مقبرة الشهداء، وهذا شارع العروبة، سوق الخضار، عربات مقلوبة وشوادر محروقة، وشجرة توت لم أنتبه لها قبل خمسة عشر عاماً. هنا كان الحصار، وهنا أكل الأطفال العشب، وهنا مررتُ ذات يوم لأحصل على هويتي الشخصية. لا هوية لي بعد الآن، ولن يستطيع الأوروبي أو التركي أن يكون سورياً للفلسطيني السوري، ونحن لن نكون فلسطينيين سوريين، إلا بالاسم، أو العادة، أو الرغبة. الطوق على عنق المخيم، وعلى عنق كل فلسطيني سوري وعلى عنقي.
الآن، خُطا السوريين هي الدليل إلى البلاد البعيدة.
المطر يهطل بغزارة. ماسحات زجاج السيارة لا تتوقف، والبخار يغطي الشبابيك. هاتفي الذي بين يدي يقطع غرقي في صور مخيم اليرموك، ويدلُّني صوت متحدث الخرائط على عنوان منزلي في اسطنبول، حيث لا جيران فضوليين ولا رائحة ميرميّة، ولا أحد يقول لي «خيتا»، ولا صديق سورياً يعيدني إلى المخيم. أغلق أقفال باب منزلي الأربعة، وألتجئ بملابسي إلى الفراش دون أن أنفض عنها غبار الدمار. وما زال شال فلسطيني في حارة فرن حمدان، يلقي التحية على المارين من نافذة في الطابق الرابع، ويبحث عن البنت التي ذهبت بسيارة أجرة إلى كلية الآداب ولم تَعُد.