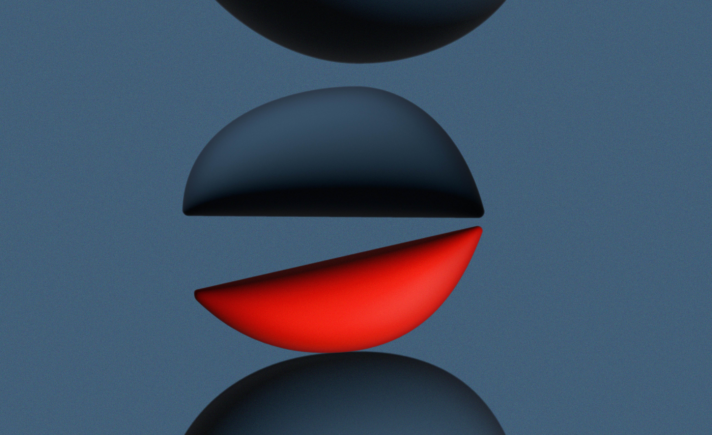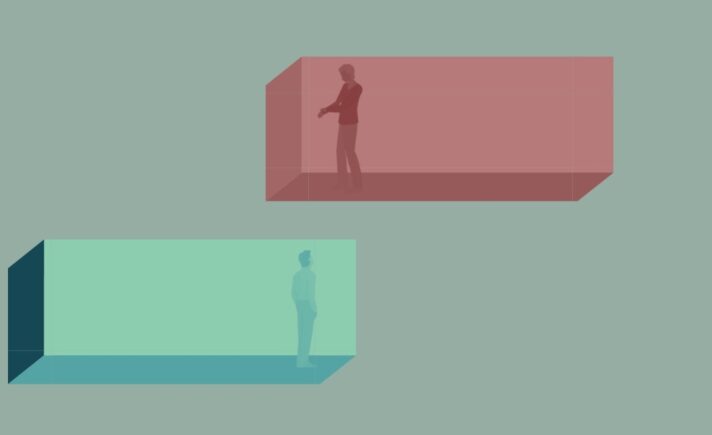بتنا مؤخراً ننظر إلى الرجال على أنهم هم ’المشكلة‘. هذا التصور الجديد عكسُ الميل الأزلي في الطب والدين والفن في أن نرى النساء – الجنس الآخر، الجنس الثاني، الجنس الغامض – على أنهنّ المشكلة التي يريد الرجال حلها. يوصف الرجال حالياً بأنهم مغتصبون ويمارسون العنف المنزلي، وكائنات تستغل الكوكب. لا شك أن هذا الكلام صحيح في بعض جوانبه. ولكن في الوقت نفسه ظهر خليطٌ مختلفٌ من التصورات، على الأقل في الغرب. ويتميز من بينها التصور الذي يتناول ’الرجل الجديد‘. هذا النوع من الرجال يدعم حقوق المرأة والأطفال، ولديه وعي بيئي كافٍ، وليس عنيفاً. من المنظار النفسي نحن أمام انقسام في التصور الثقافي للرجل.
– أنرديو صموئيل، من كتاب تصورات عن الأبوة.
«… لا يحق للرجال أن يبكوا»، هذا ما قاله رجل أثناء اجتماع عام لـ <مجتمع الرجل والمرأة>، المنظمة التي شكلت انطلاقة الموجة النِسوية الثانية في هولندا، وسمحت بمشاركة الرجال فيها. فأجابه رجل آخر: «يحق لكَ فعل كل شيء: صناعة الكاتو والبكاء، ولكنك ستُعامَل وقتها كأنثى، وهذا ما لا تريده». تغيرت أشياء كثير ة منذ ذلك الحين، وصار يحق للاعبي كرة القدم أن يبكوا أمام الشاشات حين يخسرون، وسوف يضمنون تَفهُّمَ الشعب الهولندي وتعاطفه. حتى أن 70 بالمئة من النساء يعتبرنَ الأمر مؤثراً، و45 بالمئة من الرجال يشعرون بغصة في الحلق حينما يجهش إدفين فاندر سار وفيليب كوكو بالبكاء أمام الكاميرا. كما أن رائحة الرجال أصبحت عطرة مقارنة مع الماضي، رغم أننا لا نطلق تسمية «العطور» على عطور الرجال، بل نسميها «كولونيا الحلاقة»، أو نمنحها أسماء قوية من قبيل بروت (فظ) أو إيغويست (أناني)، مع أن العطر الأخير رائحته منزلية وتشبه التفاح المشوي.
وقد أخذت النساء أشياء كثيرة عن الرجال: دخلن سوق العمل بأعداد كبيرة – رغم أنهن يعملن غالباً وفق دوام جزئي مقارنة مع الرجال – وصرنَ يُدخنَّ ويشربنَ الكحول أكثر من ذي قبل (وبهذا شاركن الرجال ببعض المخاطر الصحية)، ويقدن السيارة، ويلبسن البناطيل، ولم تعد كلمة «امرأة أعمال» شتيمة.
كما أخذ الرجال بعض الأمور عن النساء، وإن كان أكثر ترددًا: صرنا نرى الرجال يطبخون على شاشة التلفاز، ولم نعد نعتبر الاهتمام بالأطفال أمراً لا يليق بالرجولة، وصار الرجال يلبسون الأقراط، رغم أن ذلك ظلّ محصوراً بأذنٍ واحدة. ولكن تحت هذه المظاهر السطحية ثمة ثورة في التفكير حول الرجال والنساء والعلاقة فيما بينهم. كما بَطُل النموذج القديم، حيث يعمل الرجل خارج المنزل وتدير المرأة أمور البيت (رغم أنه ما زال موجوداً)، وصار النموذج المثالي ينزع إلى الشراكة وتقاسم المهام والمسؤوليات.
بمقدورنا أن نختلف حول أيهما جاء قبلاً: التغييرات في العلاقات الاجتماعية أم الحركة النِسوية. إذ تزعم باربرا إهرينرايش على سبيل المثال أن التغييرات في سوق العمل الأميركية هي المسؤولة عن هروب الرجال من الأعباء المنزلية. ولم تنشأ تصورات جديدة حول الرجولة، كزير النساء الذي لا يرتبط أبداً، إلا بعد أن صارت أمثولة الرجولة القديمة التي تحصر مهمة الرجل بالعمل خارج المنزل «فلا تحتاج زوجته أن تعمل»، غير قابلة للتحقق إلا في بعض البيئات النخبوية. كما ترى أن الحركة النِسوية نشأت كرد فعلٍ على هروب الرجال، أي كنتيجة وليس كسبب. ولكن كيفما كانت البدايات، فالموجة التحررية بين النساء والتصورات المثالية سوف تؤثر على الرجال. لذلك تحوّل الجدال غير المحسوم حول تقسيم العناية والمسؤوليات بين الجنسين إلى قضية شخصية وسياسية، ومن غير الممكن تجاوزها.
وقد استطاع بعض الرواد الرجال أن ينتفعوا من هذه التغييرات. هم ينظرون إلى تقسيم الأدوار بخصوص الدخل والرعاية كإثراء لحياتهم: ضغوطات أقلّ، وعلاقة أفضل مع الزوجة والأطفال والرجال الآخرين ومع أنفسهم. ولكن بعض الرجال يتمنون أن تنتهي الموجة على خير، كي يعود الزمن الجميل حينما كان الرجال رجالاً حقيقيين والنساء نساءً حقيقيات. كما أخذ جزء آخر من الرجال دور المقاومة على عاتقهم، فعلى الأغلب يعتقدون أن التغييرات لن تنفعهم في شيء.
وقد قال المحلل النفسي اليونغي أندريو صموئيل في حوارٍ أجريته معه: «أطلقت النِسوية ثورة في تفكيرنا حول الرجال. حيث أصبح ’الرجال‘ مجرد فئة، ولا يمثلون الشرفة التي يطل منها البابا من عليائه نحو البشرية. كما صارت الرجولة موضوعاً للنقاش، مثلها مثل الأنوثة. وإذا أضفتِ هذا الارتباك إلى تلك الحيرة التي نشأت في سوق العمل، أي بخصوص المستقبل الفردي – كم رجلاً ما زال متأكداً من أنه قادر على كسب ما يكفي من المال، ليكون ذلك مصدراً لهويته؟ – سوف تفهمين لماذا يشعر كثير من الرجال بالتهديد. وطبعاً سوف يعكسون مخاوفهم على النساء اللواتي، برأيهم، سوف يصادرنَ السلطة ويسرقن منهم وظائفهم. ولكنهم يتغافلون عن كون النساء يستلمن أسوأ الوظائف، وما زال الرجال يتقلدون زمام السلطة الاقتصادية. إن الرجال في أزمة، غير أن هذا ليس سيئاً على الإطلاق في حال نشأ وعي جديد حول معنى الرجولة».
لم تعد البطريركية كما كانت من قبل، أي النظام الأبوي الذي يضمن سلطة الرجال الكبار على الرجال الصغار، وسلطة الآباء على الأبناء ذكوراً وإناثاً، وسلطة الرجال على زوجاتهم. تقول إهرينرايش إن أمثولة الرجل الذي يكسب المال لم تعد قابلة للتحقق بالنسبة لكثير من الرجال، ولا حتى مرغوباً بها. ولم يعد الرجال بحاجة لعناية النساء كي يدبروا أمورهم، وبخاصة أن كثيراً من «الخدمات» انخفض سعرها في السوق الحرة، فأصبحت ربة البيت المعتمدة كلياً على الرجل تشكل عبئاً على كثير من الرجال. ومقارنة مع الماضي، صارت الزوجة غير المستقلة والأطفال غير المستقلين يكلّفون الرجل أكثر مما يمنحونه. من هنا جاء الهروب من الارتباط مدى الحياة، والهروب من المسؤولية الاقتصادية حيال الأطفال (نصف الرجال الأميركيين المطلقين لا يساهمون بمصاريف أطفالهم البيولوجيين)، والمحصلة هي ارتفاعٌ في عدد العوائل المؤلفة من والد واحد (أي الأم). برأيي، هذا هو سبب ارتفاع عدد الرجال «العصريين» الذين لا يمانعون أن تكسب زوجاتهم بعض المال، طالما أن ذلك لا يمس حقهم بتلقي الرعاية، إذ أني بخلاف إهرينرايش ألاحظ أن جزءًا كبيرًا منهم لا يفضل التخلي عن السند العملي والعاطفي والجنسي الذي تقدمه المرأة. ولكن لا شك أن ثمة أموراً قد تغيرت: تراجعت حاجة الرجال إلى السند الاقتصادي الذي تقدمه النساء والأطفال، كما تراجعت حاجة النساء لرعاية الأزواج المالية بعد تمكنهن من كسب المال بأنفسهن أو الحصول على راتب المعونة من الدولة، كما قلَّت حاجتهن للحماية (ولكن من ماذا، طالما أن الرجال داخل البيوت أخطر من الرجال خارجها؟). وكذلك تغيرت توقعات النساء من أبوة الرجال لأطفالهم بشكل كبير. نسبة لا بأس بها من النساء يفضلن أن يرعين الأطفال بمفردهن، طالما أنهن غير قادرات عملياً على تقاسم المهام اليومية. أما الأبوة كسلطة (انتظر حتى يعود أبوك إلى البيت)، والأب كشخص يعاقب وينظم النزهات ويمنح المصروف، فلم تعد من هذا الزمان.
بيد أن تآكل النظام الأبوي لا يعني بالضرورة نهاية التسلط الذكوري، وإنما مزيدًا من الفقر للنساء، وبخاصة للمسنات العازبات والأمهات العازبات، وتفاقم في ممارسة العنف نحوهن. أما بالنسبة للرجال، فإن الهروب من مهمة كسب المال، لا تعني فقط حرية ومغامرة ونموذج استهلاك كزير نساء، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو أين يبحث الرجال عن أمثولة الرجولة في حال فقدوا أدوارهم التقليدية؟
ويؤكد الكُتّاب الذين انشغلوا بموضوعة الرجولة والرجال على أن الرجال في أزمة. يقول رونالد ليفانت إن الرجال صاروا لأول مرة في التاريخ هدفاً للنكات على التلفاز وفي أفلام الرسومات المتحركة، كما لو أنهم يحاكَمون علانية بخصوص رجولتهم. ويحذرنا كونل ألا نبسّط الأمور عبر افتراض أن «الرجولة في أزمة»، كما لو أن «الرجولة» مؤسسة محددة وثابتة. بمقدورنا، في رأيه، أن نتكلم عن أزمة في العلاقات الجندرية سببها انهيار تاريخي لشرعية السلطة الذكورية، ممزوج بميل عالمي نحو تحرر المرأة. ويحدد البريطانيان تريفور ليود وتريستان وود في ما الذي سيحلّ بالرجال؟ أعراض الأزمة في بلدهم، والتي قد نعتبرها سبباً أو نتيجة:
1- ارتفاع البطالة بين الرجال: معظم الوظائف الجديدة هي مهن نسائية نمطية، منخفضة الأجر، دوام جزئي، ولا تحتاج إلى تكوين مهني. كما قلّ عدد الوظائف التي يكون دخلها كافياً لإعالة أسرة. والبطالة بين الرجال تؤدي إلى توترات وفقر ومرض. حيث أن الأمراض المزمنة تصيب الرجال الذين لا يعملون بنسبة 40 بالمئة أكثر من العاملين.
2- لم تنقص الفجوة في العمر الوسطي بين النساء والرجال، والتي سببها الحوادث وسلوك المخاطرة كالإدمان على الكحول والمخدرات.
3- ارتفاع نسبة الانتحار، وبخاصة بين الرجال الشباب، بينما قلّما تنتحر النساء. الفئات المعرضة للخطر هم ذوو الرواتب المنخفضة والعاطلون عن العمل (أعلى بمعدل مرتين إلى ثلاثة مرات)، والمطلقون والأرامل، والرجال الذين يشربون الكحول كثيراً أو يستخدمون المخدرات.
كما نرى علاقة بين اللامساواة الاجتماعية وعدم المقدرة على التخلي عن الأدوار الجندرية التي لم تعد صالحة. الرجال الذين يتمسكون بمعاني الرجولة «الحقيقية» هم المعرضون أكثر من غيرهم للمرض والمشاكل، وهم الذين يهملون صحتهم ولا يطلبون المساعدة عند الحاجة ويمارسون سلوكيات خطرة. ويُعتبر الزواج أو العلاقة الثابتة مع شريكة من العوامل التي تحمي الرجال. فالنساء هن اللواتي يدفعن الرجال إلى أخذ قسط من الراحة، أو التقليل من الأكل وشرب الكحول، ويُلاحظنَ الخطر قبل غيرهن. ففي البيئات الإيرلندية التقليدية كانت النساء هُنَّ اللواتي يُخرجن أزواجهن من المقاهي الليلية. وطبعاً لم يكن الأزواج ممتنين لذلك، بيد أن العازبين الذين ليس لديهم مشاكسات من هذا النوع أكثر تعرضاً للموت من كثرة الشرب. كما يُقدّر أنه يمكن إنقاذ حياة نصف المصابين بالسكتة القلبية في حال تمّ التعرف على الأعراض باكراً. الرجال ينتفعون من الزواج جسدياً ونفسياً أكثر من النساء، غير أنهم غالباً ما ينكرون هذا التعلق الجوهري. لذلك نلاحظ في البحوث حول العوامل المسببة للتوتر أن الرجال يشكون من فقدان العمل، والفشل الجنسي، والاضطرار لإظهار الضعف، ولكنهم لا يذكرون فقدان الشريكة. النساء قادرات أكثر من الرجال على إيجاد معنى للوجود عبر العلاقات الاجتماعية. وبدلاً من أن يستثمر الرجال في الشبكات العاطفية، يركزون على العمل والمناصب والجنس. وحين يخسرون عملهم أو يصابون بمرض عضال، يفقد معظمهم معنى الوجود، مما يرفع معدل المرض والاكتئاب والموت المبكر. كما يدفعون ثمن إهمالهم للشبكة العاطفية، فالرجال الذين يفقدون زوجاتهم فجأة يمرون بأزمة أكبر من النساء، وتطول فترة عجزهم وإنكارهم. هذا ما عدا أن نسبة طلب الطلاق، وبخاصة من قبل الزوجات، بارتفاع مستمر.
ويمكننا سبر آثار أزمة الرجال في إحصائيات الجرائم والعنف. أكثر من 90 بالمئة من سكان السجون هم من الرجال. كما أن نسبة ممارسي العنف، داخل المنزل وخارجه، أعلى بين الرجال. وبالنسبة للشجارات خارج المنزل وعنف الشوارع، نلاحظ أن معظم الضحايا هم من الرجال أيضاً.
وقد نجحت البنات باللحاق بالصبيان من ناحية المستوى التعليمي، في حين لا يشعر الصبيان بالسعادة في المدرسة، ويعانون من مشاكل تعليمية، ويتوقفون عن الدراسة قبل الحصول على الشهادة، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الدنيا أو بعض الجماعات الإثنية. هذا يعني، باختصار، أن ثمة فئة من الرجال ذوي الحظوظ الضعيفة، والذين يشكون من انعدام الأفق ومشاكل ذهنية جسيمة، هم المهددون بالدخول في حلقة مفرغة: عدم الحصول على عمل يضعف إمكانية الارتباط الدائم، وعدم الارتباط يشجع على التواصل مع الأقران، مما يؤدي إلى الإدمان والتهور والعنف والجريمة، وبذلك تتراجع إمكانيات الحصول على عمل. كما نلاحظ الآثار في سوق الزواج، فحينما تتحرر النساء، ويرتفع مستواهن التعليمي، ويبقى الرجال يرغبون بالنساء الأصغر سناً والأقل تعليماً، فسوف يفوت القطار كلاً من النساء المتعلمات والأكبر سناً، والشباب غير المتعلمين. أفترض أننا ما زلنا غير منتبهين كفاية إلى كون المشاكل التي يواجهها الشباب بالحصول على صديقة في السن الذي يؤهلهم للجنس والعلاقات هي من أسباب العنف «العدمي» ضمن الجماعة، وأن ذلك العنف لن يكون عدمياً في حال انتبهنا إلى أن الشباب المحبَط، والمُفتقد للأثر الحضاري للعلاقة مع المرأة، يبحث عن تعويض عبر التبجّح والسلوك الجريء حيال الأقران.
يمكننا البحث عن أسباب الأزمة لدى قسم من الرجال في الظروف الاقتصادية إذن، غير أن كُتّاب ماذا سيحل بالرجال؟ يرون أنه غالباً ما يتم إهمال عنصر«الرجولة». رفض القيام بـ«أعمال النساء» واعتبار العيش مع امرأة تكسب القدر نفسه من المال أو أكثر أمراً مهيناً، وعدم المقدرة على تحقيق التوقعات التي باتت النساء تفرضها على العلاقة، عدم القدرة على العيش من دون امرأة، وفي الوقت عينه رفضُ الاعتراف بالاعتماد عليها؛ كل هذا يُدخل الرجال في حلقة مفرغة من الفشل على جميع الأصعدة. ومن ليس لديه شيء يخسره، يشكل خطراً على نفسه والآخرين.
وقد لخّص هانس فان ميرلو الجدل قائلاً: «النساء غاضبات، والرجال خائفون». نحن على علم بأن النساء غاضبات، نعلم ذلك منذ أن انطلقت الموجة النِسوية الجديدة قبل خمسة وعشرين عاماً. ولكن هل الرجال خائفون؟ وممَ يخافون يا ترى؟ هل من المعقول أنهم خائفون من النِسوية؟ نحن لا ندعو سوى إلى «الشراكة العادلة»، ما المخيف في ذلك؟ ولكن ميشيل ميسنر يصف الأزمة كما يلي: «خائفون من عنف وضغط إنجازات الرجال الآخرين، خائفون من المستقبل الغامض، مرتابون من النساء اللواتي باتت حيواتهنّ تبدو أيسر من الرجال، وغير واثقين من أنفسهم».
التفكير حول الرجال ليس جديداً، فقد كتبتُ في 1978 في مجلة النصوص النِسوية الاشتراكية مقالة بعنوان: حول الوعي السياسي وقضية «الرجولة». وقد اعتبرتُ فيها أن الرجال المُستغَّلين في عملهم والذين يشعرون بالتبعية، ميالون أكثر من غيرهم إلى مطالبة زوجاتـ«هم» بالتبعية، كي يستردوا جزءاً من كرامتهم الضائعة. كما حاججتُ بأن «الرجولة» تمنع الرجال عن مطالبة النقابات بعلاقات مهنية صحية بدلاً من رفع الأجور، وأن «الرجولة» هي العنصر الخفي ولكن المؤثر في ما يسميه اليسار «الوعي السياسي». غير أن المقالة لم تحصد أي اهتمام، لأن الرجال كانوا حينها لا يقبلون أن يتعلموا حول مشاكلهم على يد نِسوية، والنساء (النِسويات) غير مستعدات أن يتعمقنَ بالرجال.
وحين جَمعنا، أنا وماريو فان سوست، حواراتنا مع عدد من الرجال في كتاب، تم انتقادنا بشكل لاذع: أليس لدينا شيء أهم نملأ فيه أوقات فراغنا؟ وألا تملك دار النشر النِسوية موضوعاً أفضل من الرجال، وبخاصة اللطفاء منهم؟
يبدو أننا كنا غير قادرات على تجاوز فكرة أن الاهتمام بالرجال سيكون على حساب النساء، وأي طاقة سنضعها في الرجال ستنقصنا للنساء. كما كان ضرورياً ألا نفرّط بصورة خصمنا في السنوات الأولى. ولكنني مع مرور الزمن صرتُ أفهم أن دوافعَ عاطفية كانت تتحكم بنا، لأننا تربّينا على فكرة أن تَفهُّمَ الرجل أهم من الدفاع عن احتياجاتنا. يبدو أن التفهُّمَ الفائض عبارة عن حالة ضعف نمطية لدى النساء، وقد كانت تطفئ غضبنا الذي نحتاجه لنشعر بالقوة.
والمحصلة هي صورة أحادية عن الرجال ونظرة خارجية إلى «الأبوية» من خلال تأثيرها على النساء فقط. كان شعارنا أن على الرجال أن يعتنوا بأنفسهم بدل أن يعتمدوا علينا طوال الوقت؟ كم حاولنا أن نشبع الضفدع تقبيلاً، على أمل أن يصبح أميراً. أفلا تركناه مع لعنته الضفدعية؟
من المفهوم أن تختلط المشاعر على الرجال في محيطنا، وأضرب على سبيل المثال الرجلين اللذين قررا أن يشكلا حلقة كلام مع بعضهما بعضاً:
سُئِلَ فيليب سخراماير عن تعامله مع حقيقة أن زوجته صارت ترسم حياتها بمفردها: «أكثر ما أذكر هو أن حياتي الجنسية تأثرت بالأمر، صرتُ عاجزاً جنسياً. يا لها من ردة فعل غبية ويائسة، ولكن هذا هو الواقع. فضلاً عن أن كثيرات ممن كنت أعرفهن رُحنَ يمارسن الجنس مع النساء والرجال على حد سواء – ولم تنته هذه المرحلة حتى الآن – إلى درجة صرت أقول لنفسي: قريباً سوف يعشنَ سوية وأبقى كرجل أقرع لوحدي. سنبقى نحن الرجال المقربون من الحركة النِسوية وحيدين».
وقال خيرت ماك، الرجل الآخر في حلقة الكلام ذاتها: «جميع صديقاتنا كن عضوات في حلقات كلام، وكنا مضطرين. فكرنا، ما علّنا فاعلون بحق السماء؟ لاحظتُ انتكاسة نحو الطفولة لدى كثير من الرجال، وأنا واحد منهم. يا إلهي! الحركة النسوية! بعد مشاغبة لمدة عشر سنوات جاءت الأمهات الغاضبات ليعاقبننا أخيراً، وليس أمامنا سوى الاحتماء تحت الطاولة. في البداية سوف ينهال كل شيء على رأسك. وحينما تكون تربيتك كالفينية محافظة، سوف تمزقك أحاسيس الذنب وتعترف مهاناً: نعم، لقد خنتكِ وتسلطتُ عليكِ. (…) نحن رجال وكم أخطأنا بحقكنّ، اهجُرننا. (…) جميعنا حاولنا التأقلم كالأرانب المذعورة واعتنقنا النِسوية. كما رأيتُ ابتهالات من قبل رجال لا يمكن الوثوق بهم، في رأيي لم يكونوا قادرين على تنفيذ وعودهم، لأن الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة. (…) حينما كانت الحركة النِسوية متحدة، كان يغيظني أن جميع الروايات تنطلق ضمنياً من فكرة أنه لا يوجد رجل بريء. ما هذا الجنون؟ لعلمكن، أنتن تتكلمن عني! وكم نشبت شجارات عاطفية بيني وبين النساء. (…) كما كان لدي اعتراضات على الجانب النخبوي للحركة النِسوية. على سبيل المثال: يعود الرجل إلى المنزل، ويجلس مباشرة على الكنبة، بعد أن يلبس خفّه المنزلي، ليتصفح الجريدة. لا مجال للكلام معه. يا لها من كارثة فعلاً. ولكن 90 بالمئة من الكتب والمقالات لم تطرح سؤال لماذا يتصرف الرجل هكذا؟ والجواب في غاية البساطة في 90 بالمئة من الحالات: لأنه يستيقظ الساعة السادسة صباحاً وينطلق مباشرة إلى عمله في البناء أو المصنع أو المدرسة وهو غير قادر الآن على تحريك فمه. لا تطرح الحركة النِسوية السؤال الثاني: لماذا؟».
لا شك أن عدم طرح السؤال حول السبب أدى إلى بعض النقاط العمياء في النظرية وتصور النساء حول الرجال. كالاعتراف مثلاً أن العمل خارج المنزل وجلب المال هو شكل من أشكال العناية بالأسرة. وفي حين لم يُعتبَر عمل المرأة في المنزل عملاً، بل حباً (ولذلك لا داع أن يكون مأجوراً)، لم يُعتبر ما يقوم به الرجل حباً، بل عملاً. كما أن كثيراً من الأقليات والجماعات المقهورة استمدت من تهميشها نوعاً من التفوق الأخلاقي، وكذلك فعلت النساء. فإذا كان الرجال يملكون سلطة سياسية واقتصادية، فنحن أستاذات في الحب. ونجد هذه الثيمة في عديد من الكتب النِسوية حول العلاقة بين الجنسين، من ليليان روبين إلى شير هايت.
هذا يعني أمرين. أولاً أننا كنا عاجزات أن ندرك إلى أي درجة قد يصل عذاب الرجال في عملهم من أجل جلب المال للأسرة، وإلى أي حد قد تؤذي العطالة شعورهم الرجولي بالقيمة. لذلك لم نفهم «لماذا» يشعر بعض الرجال الذين يقومون بأشغال نمطية أنهم مهددون جرّاء تقدّم النساء. كما أن الحكم على الرجال بأنهم أغبياء عاطفياً لن يساعد على تحسين مشاركتهم بالرعاية. وقد كانت هذه النقاط العمياء تنعكس على قطاع الرعاية، حيث نرى أن غالبية الذين يعرضون أنفسهم للعلاج الأسري والجلسات الكلامية هم من النساء. ولا ينافي هذا التوقعات، فالنساء تربين على الشعور بالمسؤولية حيال العلاقة، وبخاصة من الناحية العاطفية. بيد أن المختصة النفسية جوستين فان لويك تقول إن العلاج يعتمد على مناهج لا تناسب الرجال، كالاعتماد على التعبير اللغوي عن المشاعر، الأمر الذي تعلمته النساء بشكل أفضل من الرجال.
النقطة العمياء الثانية التي بودي ذكرها هي عنف الرجال. لا شك أن الفضل الأكبر يعود للحركة النِسوية في إخبار العالم عن نسبة حدوث العنف والاستغلال الجنسي، وحجم الأذى الذي يسببانه في العلاقات الشخصية والأسر. غير أننا لم ننشعل طويلاً بالبحث عن الأسباب التي جعلت (بعض) الرجال يتورطون. افترضنا أن الاغتصابات والضرب من أشكال استغلال السلطة، وهذا صحيح من منظور الضحايا. غير أننا اصطدمنا أثناء محاولة فهم الظاهرة بسوء فهم بنيوي. فالجُزء الأول من فرضيتنا هو أن النساء يملكن سلطة أقل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وغالباً ما يشعرن بالعجز. أما الجزء الثاني، فينطلق من أن سلطة الرجال أكبر، لذلك لا بد أنهم يشعرون بالقوة، وليس العنف ضد النساء سوى إحدى تمظهرات تلك القوة. ولكننا اكتشفنا بعد التعرف على تجارب الرجال العنيفين أن الأمر لم يكن كذلك. رغم الاختلافات الكبيرة بين أنواع العنف والدوافع خلفها (والتي لن أتطرق إليها)، إلا أنه ظهر أن عدداً كبيراً من الرجال يلجؤون إلى العنف في علاقاتهم حين يشعرون بالعجز وقلة الحيلة والعزلة والهجران أو يكونون على وشك فقدان زمام السيطرة. وما قالته حنة آرنت بخصوص السلطة السياسية، ينطبق كذلك على الرجال الأفراد: «السلطة والعنف ضدان، لا يوجد عنف حين تكون السلطة مطلقة. ينشأ العنف عندما ترتبك السلطة». والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو فيما إذا كانت السلطة والعنف ضدين على طول الخط، حيث يمكنني ذكر أنظمة سياسية لا ينطبق عليها ذلك، ولكن كلام آرنت ينسحب على الرجال الذين يباشرون الضرب عندما لا يعرفون ماذا يفعلون لاسترداد الإحساس بالقيمة، ومسك زمام الأمور من جديد، ولجم الخوف من الخسارة.
هذا يعني أنه لا يمكن أن تعتمد مكافحة العنف داخل العلاقات على تمكين النساء فقط، بل كذلك على توسيع فهمنا للأسباب التي تجعل الرجال يشعرون بالعجز إلى درجة اللجوء إلى الضرب واستغلال الضعفاء جسدياً. من دون ذلك لا يمكننا معرفة الظروف التي سوف تؤدي إلى ارتفاع وتيرة العنف. فالنساء يُضربن في المجتمعات الأبوية أكثر من المجتمعات المساواتية. ولكنه لا يوجد انخفاض مستمر حين يتحول المجتمع من أبوي إلى أكثر مساواتية، بل على العكس. إذ يؤدي التوتر بين التصورات القديمة حول خضوع النساء «الطبيعي» من جهة، والارتفاع الجديد لمكانة المرأة من جهة أخرى، إلى تفاقم عنف الرجال. للأسف، يبدو أن العنف أحد الظواهر الجانبية التي ترافق تحرر المرأة، حتى ولو كانت التغيرات في العلاقة بين الجنسين غير مقصودة، بل وليدة الظروف. هكذا نفهم لماذا تصاعد العنف في الأسر في بلدان من قبيل يوغسلافيا ما بعد الحرب، وجنوب أفريقيا بعد نهاية حكم العنصرية، وفي غزة بعد الاستقلال الجزئي، حيث فقد الرجال مكانتهم التقليدية، وازدادت قوة النساء اللواتي واصلنَ محاولات النجاة مع الأطفال.
والنقطة العمياء الثالثة في النظرية النِسوية تكمن في رؤيتنا إلى سلطة الرجال السياسية الأكبر وسطياً على أنها سلطة مطلقة يملكها جميع الرجال حيال جميع النساء، وبذلك نكون أنكرنا الاختلافات بين الرجال. ورغم أننا اضطررنا إلى الاعتراف ضمن الحركة النِسوية أن «النساء» لا يشكلن حالة واحدة، وأن ثمة تعددية كبيرة بخصوص الأوضاع والولاءات والمصالح حسب الانتماء الطبقي والقومي والميول الجنسية، إلا أننا تأخرنا كثيراً بسحب هذا الرؤية على الرجال. كنا نُعرِّفُ الأبوية على أنها بالدرجة الأولى سيطرة الرجال على النساء، وبدرجة أقل على أنها نظام تراتبي بين الرجال.

لذلك كان لا بد أن يباشر الرجال بأنفسهم (من خلال حركة الرجال، ودراسة الرجولة، ومؤسسات إرشاد الرجال) بسد ثغرات هذه النقاط العمياء. وقد تبدّى أن تجربة الرجال الداخلية تتضارب مع تصور النساء عنهم. وبينما استمرت النساء بوصف مشاعرهن في المجتمع الأبوي، شرع الرجال يصفون مدى صعوبة النشوء كأطفال صغار تحت ضغوطات أن يصبحوا أقوياء ولا يبكون، ومدى الألم لدى الرجل البالغ غير المسموح له وغير القادر على أن يظهر هشاشته. وقد كانت المنشورات الأولى، حسب رأي كولتران، أشبه بالشهادات الشخصية والاعترافات، ويغلب عليها الطابع العلاجي، كما كانت تهمل النظر إلى اختلال موازين السلطة بين الجنسين. وحتى الكتب الهولندية الأولى كانت تطفح بذلك النَفَس، على سبيل المثال يا زلمة للكاتب فان دي برخ، الذي كان عنوانه الفرعي يوحي أن تحرر الرجل عبارة عن كلام وشعور. كما تناولت بعض تلك الكتب والمقالات تجربة الأبوة أو فقدان الأب أو إحساس الرجال بعدم فهم النساء لهم. وقد ساعدت هذه الكتابات الشعبية الرجالَ على وعي تجاربهم الخاصة، ولكنها أهملت تأثير تجارب الرجال على النساء. أما الكتابات التي حاولت الربط بين تجارب الرجال الخاصة والتحليل السياسي لسيطرتهم وامتيازاتهم، فكانت أقل شعبية. يقول كولتران: «كان ثمة أسلوبان متضاربان لدى الرجال في وصف تجاربهم. يحتفي الأسلوب الأول بروابط الرجال فيما بينهم وأن الرجال لا بأس بهم، أما الأسلوب الثاني فيتلاقى مع التحليلات النِسوية الأكاديمية حول الفروقات في السلطة». بيد أن كلا الأسلوبين يؤكدان على أن تجربة الرجال «من الداخل» تختلف عن تصور النساء في بادئ الأمر. وقد وصف ميشيل كيمل، أحد رواد المعسكر المؤيد للنِسوية، سوء الفهم بخصوص السلطة قائلاً: «إن التعريف النِسوي للرجولة بكونها سعي الرجال إلى السلطة نابع من منظور النساء»، أي كيف تحسّ النساء بالرجولة. غير أن ذلك يفترض توازياً بين العام والخاص لا ينطبق على الرجال. كانت النِسويات يلاحظنَ أن السلطة الاجتماعية للنساء ضعيفة، وأنهن كأفراد يشعرن بالعجز والخوف والهشاشة، وأن زمام السلطة في يد الرجال كمجموعة. وانطلاقاً من ذلك التوازي، اعتقدت النِسويات أنه لا بد أن يشعر الرجال بالقوة كأفراد. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل الرجال يصمّون آذانهم عن النقد النِسوي للرجولة. فعندما يُجابَهون بالتحليل القائل أنهم يملكون كل السلطة، يستغربون: «ماذا تقصدين حين تقولين إن الرجال يملكون كل السلطة. عم تتكلمين؟ زوجتي تترأسني في البيت، ورئيس عملي في العمل. ليس لدي أي سلطة، بل على العكس!». هذا يعني أن دليلنا الموضوعي على امتلاك مجموعة الرجال للسلطة، لا يترجم نفسه إلى تجربة ذاتية فردية. وتنجم هذه الفجوة بين الموضوعية والتجربة الذاتية عن كون النساء لا يدركنَ بشكل كافٍ أن ثمة صراعاً على السلطة بين الرجال أنفسهم، وأن عدد الخاسرين أكبر من الرابحين. كما أن الرجال الأفراد يفهمون تعلقهم بالنساء على أنه سلطة (جنسية وعاطفية) للنساء على الرجال، على الأقل الغيريين منهم. انطلاقاً إذن من صراعهم مع الرجال الآخرين وتعلقهم غير المعترف به بالنساء، لا يعِ الرجال امتيازاتهم. وهذا ما يشتركون به مع المجموعات المسيطرة الأخرى، فقلّما انتبهت الطبقات الاجتماعية العليا لامتيازاتها، أو أدرك البيض مزايا الجلد الأبيض. فالصفة الأهم للامتيازات هي أنها لا تُعتبر امتيازات، بل أموراً عادية جداً. ويكتب كيمل: «يا له من ترف ألا تحتاج للتفكير بالعرق الذي تنتمي إليه، أو بطبقتك الاجتماعية أو جنسك. هكذا هي الامتيازات، كالهواء أو لا شيء. فقط المهمشون من قبل المجموعة الأخرى يفهمون كيف تُستخدم السلطة ضدهم».
يشعر الرجال إذن بقوة أقل مما تعتقد كثير من النساء. وقد تمنحهم الرجولة بعض الامتيازات، ولكن لكل شيء ثمنه. نلاحظ مثلاً اختلافاً بالغ الأهمية بينها وبين منظومات السيطرة والخضوع الأخرى، حيث يرتبط الرفاه والصحة النفسية والعقلية بشكل مباشر مع الطبقة الاجتماعية والانتماء العرقي. كلما انخفضت الطبقة الاجتماعية والاقتصادية، ارتفعت نسبة الأمراض والمشاكل النفسية، وانخفض العمر الوسطي. غير أن هذا لا ينسحب على مجموعتي الرجال والنساء إلا جزئياً. نرى اختلافاً في نموذج الأمراض والمشاكل، ولكن لا يمكننا القول إن حال الرجال أفضل على الدوام. بل على العكس، ذلك أن العمر الوسطي للرجال أقل من النساء، حتى عندنا في الغرب. وبحسب فان درلو، فقد وضّحت دراسات الرجولة ومؤسسات إرشاد الرجال أن الأسباب تكمن في ما يسمى بـ «تشفيرات الرجولة»:
– الحصول على عمل مأجور أهم شيء في حياة الرجل.
– يهتم الرجل بالفعل والإنجاز والمنافسة. وينبغي عليه كرجل أن يكون أفضل، وأسرع، وأقوى، وأكثر فعالية من الرجال الآخرين (ومن النساء طبعاً).
– الرجال مستقلون، غير تابعين، وقادرون على فعل كل شيء بأنفسهم.
-الرجال لا يحتاجون للمساعدة.
– الرجال يضبطون أنفسهم، ولا يخافون ولا يبكون.
– الرجال عدوانيون، وقادرون على مسك زمام أمورهم ولا يسمحون لأحد أن يتجاوز حدودهم.
– الرجل الحقيقي ليس ضحية.
إنكار الضعف والتعلق، وعدم طلب المساعدة، وصعوبة الاعتراف بالعجز، والاضطرار للإنجاز الدائم الذي يستدعي المغامرة، كل هذا يسبب أعراضاً خاصة بالرجال. ذلك أن نسبة وفاة الرجال بسبب أمراض القلب وسرطان الرئة وحوادث السير والانتحار أعلى من النساء، كما أنهم يدمنون أكثر على الكحول. وقد تعتبر الرياضة المعتدلة جيدة للصحة، إلا أنها تسبب الإعاقة في حال مورست بطريقة لا تأخذ حدود الجسد بعين الاعتبار. فمن معضلات الرياضة الجماعية المنظمة أنها تسبب كسوراً في العظام، وتمزقاً في الطحال، وارتجاجاً في الدماغ، وإصابة في الكلى، وكدمات في الخصيتين، وانزلاق الكتف عن مفصله، وتمزق الأربطة، والسكتات قلبية، وآلاماً مزمنة، واستئصال الكلى، والشلل، وتآكل المفاصل، وأعضاء جسد مثبتة بالبراغي المعدنية والأدوات الأخرى. ورغم أننا ننظر إلى كبار الرياضيين على أنهم أمثلة للياقة الجسدية والصحة، إلا أنهم ينتمون إلى الفئات المعرضة أكثر من غيرها للإصابات الدائمة والإعاقة. ذلك أن العقلانية الأداتية التي تُعلِّمُ الرياضي أن يعامل جسده كآلة، كسلاح لهزم الخصم، ترتد في آخر المطاف كهجوم خارجي ضده. وبينما تعاني النساء من إرهاب النحافة الذي يؤدي إلى اضطراب في عادات الأكل والهزال العصابي، نجد الموازي الرجالي في كمال الأجسام الذي مثله مثل الهزال العصابي قد ينتهي بالوفاة أو الآفات المزمنة. وطبعاً نحن لم نتكلم بعد عن الحروب التي توقع الرجال في فخ القتل والموت، كي لا يقول أحد عنهم أنهم جبناء.
باختصار، يكمن السبب الأساسي في الموت المبكر لدى الرجال في سلوكهم الخاص بجنسهم، والذي يعرضهم للإصابة بأمراض معينة. وكما قال كيمل: «تُعتبر الرجولة من أهم الأسباب التي تسبب الأمراض لدى الرجال». ولا تسبب الرجولة أمراضاً فحسب، بل إنها تقف كذلك في طريق معالجتها قبل فوات الأوان. ذلك أن الرجال الحقيقيين لا يمرضون، وفي حال مرضوا كما يمرض الجميع، فلن يشتكوا أو يلتمسوا العون حتى ينهاروا نهائياً. هذا يعني أن للرجال مشاكلهم أيضاً، وأن بعضهم، وبخاصة أولئك المهددين بالسقوط من القارب الاجتماعي قبل غيرهم، لديهم مشاكل أكثر، أو بالأحرى مشاكل من نوعٍ آخر.
كثير من الكُتّاب لا يقولون «رجولة»، وإنما «رجولات»، أي بصيغة الجمع. ذلك أن نمط الرجولة المسيطر صعب المنال لغالبية الرجال، على سبيل المثال بالنسبة للمثليين الذين لا يُعتبرون «رجالاً حقيقيين» أصلاً، والرجال السود والمعاقين والعاطلين عن العمل وغير المتعلمين. لدينا مروحة عريضة من تشفيرات الرجولة، والثقافات الفرعية، والصياغات القومية التي تحدد من هو الرجل الحقيقي ضمن ظروف معينة.
وينطلق العالم الأنثربولوجي ديفيد غيلمور من تواجد الضغوطات التي تطالب بتقديم «الإثباتات على كونك رجلاً» في جميع المجتمعات، غير أن ثمة تنوعاً في أساليب تقديم الأدلة. ولكن في جميع الأحوال ينبغي على الرجل أن يثبت أنه ليس امرأة. ونكون هنا قد وصلنا إلى نقطة أساسية: كيف نعلل تلك الضغوطات؟ سأحاول القيام بذلك جزئياً من خلال نظريات التأهيل الاجتماعي ومقاربات التحليل النفسي التي استخدمتها العالمة نانسي شودورو: يُربّى الصبيان على يد امرأة (أو أكثر من واحدة) وفي غياب نسبي للرجل (عاطفياً وجسدياً)، لذلك ينبغي على الصبيان، كي يصبحوا رجالاً، أن يقطعوا مع موضوع تماهيهم وتعلقهم الأول، ويتعلموا جراء الغياب العاطفي لموضوع التماهي الذكري أن يُعرِّفوا الرجولة على أنها معاكسة للأنوثة. وفي حال كان كلامها صحيحاً، فهذا يعني أن الرجال يواجهون معضلة أنهم يحتاجون إلى نساء كي يصبحوا رجالاً، كما أن الرجولة تعني أنهم لا يعتمدون على امرأة. ويلخص نيقولاي المسألة كما يلي: في حين تخشى النساء من انفكاك الروابط، يتجسد الخوف الأعظم لدى الرجال في فقدان الرجولة. ويصف فينيكس خوف الرجال من «الأنوثة» بـ«هلع الفساتين». وقد تم انتقاد نظرية كل من شودورو وغيلمور على حد سواء، حيث قيل أن شودورو لا تنظر إلى تجربة الرجولة «الداخلية»، ولا تأخذ كفاية نظرة الرجال بعين الاعتبار. إذ حتى ولو كان الرجال يخافون من الحميمية وسطياً أكثر من النساء، ولكن هذا لا يعني أن الحاجة إلى قرب الرجال الآخرين والارتباط بهم معدومة. بيد أن المحلل النفسي بولاك لا يبتعد كثيراً عن نظرية شودورو، ويلامس مع ذلك الجوانب المؤلمة لقطع تماهي الصبي مع أمه، ولإحساسه بالفقدان الذي يتفاقم حين يكون الأب ليس متاحاً. كما أنه يغوص أكثر من شودورو في عزلة الرجال الواقعين جراء عملية تأهيلهم الاجتماعي في فخ ما يسمى «الاستقلالية الدفاعية» أو«الاستقلالية المزيفة»: من ناحية يتوقون إلى العناية العاطفية من قبل الآخرين، ولكنهم ينكرون ذلك ويكبتونه كأمر «غير رجولي». في رأي نقاده، يركز غيلمور كثيراً على وجود أمثولات للرجولة خاصة بكل مجتمع، ولا يترك مجالاً كافياً لفكرة أن نماذج مختلفة من الرجولة تتصارع داخل المجتمع الواحد. كما أنه يرى الاختلافات بين المجتمعات، ولا يرى الاختلافات داخلها. حيث لا يملك كل رجل الإمكانيات ذاتها لاستيفاء شروط أمثولة الرجولة «المهيمنة»، فتظهر تنويعة من الرجولات «المقهورة». فعلى سبيل المثال، تتصارع في إسرائيل أنماط مختلفة من الرجولات اليهودية (وأحياناً على الحياة والموت). فضمن البيئات الأرثوذكسية تتحقق أمثولة الرجولة اليهودية في الرجل المعفي من العمل العضلي كي يتمكن من دراسة النصوص، وهي أمثولة جلبوها معهم من أوروبا القديمة. بيد أن مؤسسي دولة إسرائيل ابتكروا رجولة يهودية جديدة: المزارع والجندي اللذان لا يملكان رفاهية الانكباب على الكتب. وحتى ولو كان التطبيق معاكساً في كلتا الرجولتين، إلا أنهما تعتمدان على الإنجاز، والتمايز عن الآخرين، والتضحية من أجل هدف مجتمعي، وتفترضان اختلافاً جلياً عن النساء. وهكذا نجد في كل ثقافة اختلافات في تصورات الرجولة، وأشكال رجولة مهمشة كما في حالة المثليين أو المهاجرين أو العاجزين جسدياً أو المنتمين للطبقات الاجتماعية الدنيا. حيث يرى فيك سايدلر أن سبب ترك أبناء العمال مدارسهم في سن مبكرة يكمن في خوفهم من الفشل: يفضلون السخرية من رجولة المثقفين على الهزيمة، ويلجؤون إلى ألعاب الكمبيوتر والقمار والمشاغبة مع الأتراب. قد تشكل الهوية الجماعية للشباب الصغار خطراً، إلا أنها من الناحية الشعورية أقل سوءاً من احتمال الفشل في المنافسة. كما تشير روكستون إلى أنه من الأسهل على صبيان الطبقات الاجتماعية المتدنية أن يثبتوا رجولتهم عبر ثقافة القتال والصراخ والشتائم والتكبر على الفتيات والقمار والتسكع في الشوارع، من أن يحققوا إنجازات ترفعهم إلى الطبقة المتوسطة. كما تلعب صعوبة الوصول إلى أمثولة الرجولة المهيمنة دوراً لدى الأقليات القومية. ففي هولندا يبتكر الشباب ذوي الأصول السورينامية [مستعمرة هولندية] أسلوباً خاصاً بهم في الديسكوهات وأثناء الغزل مع الفتيات. ويكتب سانسون: «يعتقدون أنهم يجمعون رأسمال رمزي ليعوضوا عن ضعف رأسمالهم الاجتماعي والاقتصادي. رجولتك، المتضمنة لجسدك ولونك الأسود، هي رأسمالك الأكبر، ولا يمكن لأحد أن يسرقها منك. غير أنه ينبغي أن تمارس رجولتك كل مرة من جديد، وإلا فقدت قوتها». ويحاول الفتيان السود أن يثبتوا أنفسهم عبر الوقوف بشكل «استعراضي» (لن تؤثر بي، ولن أستسلم)، وعبر اتباع استراتيجية «أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم»، مما يؤدي إلى الرد العنيف على كل استفزاز مفترض. وقد يكون طريق رئيس العصابة أو التاجر بالمخدرات هو الوحيد السالك نحو الأعلى بالنسبة لرجال الطبقات الدنيا. والنتيجة هي ارتفاع معدل الإدمان، والحبس، والوفاة المبكرة. لذلك يمكن القول إن تَحوُّلَ بعض الرجال إلى خطرٍ على المجتمع يرتبط بضعف فرصهم، وكذلك بتنوع ترميزات الرجولة المتاحة. من دون مصطلح «الجندر»، لا يمكننا فهم سبب اختلاف (ولا أقول سهولة) مصير النساء المنتميات إلى الفئة الاجتماعية ذاتها. ومن ناحية أخرى: بدل أن نعرّف «الآخرين» (السود، والمدمنين، والسجناء) بشكل تبسيطي كخطر على المجتمع، بوسعنا أن نعترف أن هذا المجتمع يشكل خطراً على كل الرجال غير القادرين على استيفاء شروط الرجولة المثالية.
كم أنزعج من البرامج التلفزيونية التي تركز على ارتفاع معدلات عنف الشوارع، كما لو أننا مضطرات للشرح مجدداً أن عنف الشوارع مرتبط بعنف المنازل، وأن عنف المنازل ليس أقل أهمية لمجرد كونه غير مرئي. كما أتضايق لأن الحديث حيادي دائماً من الناحية الجنسانية، يتكلمون فقط عن «مشكلة صغار السن». ولم يتلعثم سوى نوردهولت الذي قال مرة بصراحة إنهم فتيان وليسوا صغار السن فحسب. فحين نتجاهل أن مشاكل المراهقة التي نعنيها هي مشاكل الفتيان بشكل رئيسي، كيف سنتمكن من ابتكار حلٍ مناسب إذن؟ تقول نساء منظمة «النواة الصلبة» إنه لا شك أن للبطالة والملل ومحدودية الآفاق دوراً ما، ولكنه لا يروي القصة كاملة. ذلك أن الفتيات يشتكينَ أيضاً من الملل والبطالة ومحدودية الآفاق، ولكنهنّ قلما يحولنَ إحباطهنّ إلى عنف. ويضفنَ متهكمات: «الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين هم أهم المسببين لحوادث السير. إنهم يحطمون الأشياء إلى درجة صارت ضريبتَي الإجرام والبيئة فرضاً عليهم. النساء لا يكلفن المجتمع كل هذا». من دون تفكير حول الجندر والرجولة تُطرح كثير من المشاكل كما لو كانت مشاكل عامة: «مشاكل المرور» و«الشباب المتهور». ما زال الجندر، أي التفكير من خلال الرجولة والأنوثة، ضرورياً، حتى في عصر «ما بعد النِسوية».
وسوف أقدم هنا مثالاً حول الإرشاد المؤسساتي. نعلم أن الرجال معرّضون بشكل كبير نسبياً للإدمان على الكحول، والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي درجة يرتبط شرب الكحول بالجندر؟ تعتبر القدرة على ابتلاع كمية كبيرة من الكحول دليلاً على أن الرجل قادر على الدفاع عن نفسه. وقد شرح توم دارديس كيف قتل هذا الترميز للرجولة بعض الكتاب الأمريكيين، من قبيل إرنست همينغواي، الذي كان يلبس فساتين في طفولته، والذي وجد نفسه مضطراً أن يثبت للعالم أنه ظل رجلاً رغم مهنته الأنثوية (كتابة الروايات)، وأنه قادر على «هزيمة أي رجل ينافسه بالشرب والجنس والشجار». وقد نجح في ذلك. ففي بعض البيئات يعتبر الإفراط بالشرب دليلاً على الرجولة، وقد بدأ عدد النساء المدمنات بالتزايد. إلا أن سُكر النساء ليس مقبولاً بالدرجة نفسها، لذلك يشربن في الخفاء، وطالما ما زلن في نظر أنفسهن لا يشبهن الصورة النمطية عن السكّير، بوسعهنّ إخفاء المشكلة عن أنفسهن.
وبالمقابل، نجد أن الاكتئاب مرض نسائي نمطي، ويصيب النساء ضعفَي الرجال. غير أن تيرانس ريل يتسائل فيما إذا كان الرجال يخفون «مرض الضعفاء» فترة طويلة عن محيطهم عبر إنهاك أنفسهم بالعمل أو الكحول. فمن خلال منظار جندري نرى أن إدمان النساء على الكحول يظل متخفياً (خلف أعراض الاكتئاب مثلاً)، واكتئاب الرجال يظل متخفياً (خلف الإدمان على الكحول مثلاً). أما حين تصل المشكلة إلى درجة لا يمكن إنكارها، سيُقيِّمُ الإرشادُ الرجل المكتئب بكونه مختلاً أكثر من المرأة المكتئبة، والمرأة المدمنة مختلة أكثر من الرجل المدمن. حين يكون الاكتئاب معاكساً للرجولة، والإدمان على الكحول معاكساً للأنوثة، فلا بد أن يكون الرجل المكتئب حالة خطرة، كذلك بالنسبة للمرأة المدمنة على الكحول.
غير أن طبيبة أسرة أخبرتني أنه منذ نزول البروزاك ومضادات الاكتئاب إلى الأسواق، ازداد عدد الرجال المكتئبين في عيادتها. حين يغدو الاكتئاب عرضاً تقنياً أكثر منه عاطفياً، وقابلاً للحل عبر حبة دواء بدلاً من جلسات نفسية، يسهل على الرجال أن يعترفوا بالأعراض. ونلاحظ حالياً أن الشيء نفسه يحصل مع موضة الفياغرا، مضاد العجز الجنسي. رغم أن جزءاً بسيطاً من المشاكل الجنسية تعود لأسباب جسدية «تقنية» حقاً، إلا أن فكرة الانتصاب المباشر في أي لحظة بعد ابتلاع الحبة، عوضاً عن التفكير بالعلاقة العاطفية، أو الاعتراف أنكَ تقدمتَ في السن، تزيل فجأة العقبات أمام زيارة الطبيب. نحن هنا أمام ترجمة لإحدى تشفيرات الرجولة: الجسد التابع الذي يتوجب عليه إطاعة المركز الرئيسي، الجسد كالآلة التي يفضل أن تكون مزودة برافعة تضبط الميكانيكية. وطبعاً لا أحد يتساءل فيما إذا كانت سعادة الزوجات تزداد حين يتم استدعاء الانتصاب في أي لحظة عند الطلب.
وقد قامت دراسات الرجولة ومؤسسات إرشاد الرجال بعمل عظيم بغية اكتشاف ماذا يعني أن تكون رجلاً في هذه الأيام. كما أنها اتبعت مثال النِسوية في التركيز على الصلة بين الشخصي والسياسي، وبين علم النفس والبنى الاجتماعية. ولكني مع ذلك ألاحظ نقاطاً عمياء، وهذا هو سبب فرضيتي أنه ينبغي عدم ترك التفكير بالرجولة للرجال فقط. طبعاً لا أجدها لدى جميع الكتّاب الرجال، فعلى سبيل المثال يثبت تيرنس ريل أن الرجل المكتئب، وبخاصة الذي لا يعترف بذلك أمام نفسه، لا يشكل كارثة لنفسه فحسب، بل لمحيطه أيضاً. ولكن من المؤكد أن بعض المؤسسات التي تقدم الإرشاد للرجال في هولندا، تركز بشدة على أن أولئك الرجال لديهم مشاكل، بحيث لا يبقى مجال لملاحظة أنهم يشكلون مشكلة بحد ذاتهم، وليس فقط لأنفسهم. ففي غمرة الجهود لإنقاذ الرجال من صورة العدو الأحادية التي شاركت النِسوية في خلقها، يتم إنكار أنه ما زال هناك خلل واضح في السلطة بين الجنسين. يبدو أننا أمام عداوة مبطنة، أو مسابقة بين الرجال والنساء على المظلومية ومن هو الذي يقاسي أكثر. يتم التغاضي عن الديناميكية البينية حين يُفترَض التوازي بالمعاناة جراء «التشفيرات الجندرية» لكلا الجنسين. ذلك أنه لم يعد هناك أدنى شك أن وضع النساء يتعلق بالمكانة التي يحتلها الرجال: إذا كانت النساء يكسبن أقل، فهذا لأن الرجال يكسبون أكثر، وإذا تعرضت النساء للخطر داخل منازلهن، فهذا لأن الرجال يشكلون خطراً عليهن، وإذا عانت النساء من الإجهاد جراء العمل داخل البيت وخارجه، فهذا لأن الرجال لا يأخذون قسطاً مساوياً من الرعاية على عاتقهم. كما لم يعد هناك أدنى شك أن الرجال لديهم مشاكلهم الخاصة أيضاً. ولكن مهما اقتنعنا بالضغوطات التي تسببها «تشفيرات الرجولة»، لماذا لا ينبذها الرجال إذا كانوا هم الوحيدين الذين يعانون منها؟ باختصار: حين ننكر «فوائد» الرجولة، لن نفهم لماذا يدفع كل هؤلاء الرجال «الثمن»، ولا يثورون كالنساء ضد الظلم.
بعض النِسويات ركَّزنَ فقط على الشر الذي يسببه الرجال، وتغاضينَ عن ثمن الرجولة الذي يتكبدونه. وكردة فعل صار بعض الرجال لا يتكلمون إلا عن معاناتهم. خذوا على سبيل المثال وارين فاريل، الرجل الأميركي الذي اشتهر في هولندا ككاتب الرجل المتحرر (1975) في بداية حركة الرجال. كان في بداياته مناصراً للنِسوية، ولكنه انقلب لاحقاً عليها. صار يقول إن سلطة الرجال مجرد وهم. هل يشعر الرجال بالعجز؟ نعم! في رأيه، تسلطت النساء عبر التمييز الإيجابي وحماية القانون لهن في مسائل حضانة الأطفال وحق النفقة، فراح معظم الرجال ضحية لذلك. حين تتمزق الأسرة، فالاحتمال الأكبر أن يخسر الرجال أطفالهم. كما أن الميزات الاقتصادية التي يملكها الرجال تتلاشى مع التزاماتهم المالية الكبيرة. وبينما لا شك أن النساء ضحايا العنف، إلا أن فاريل يزعم أن الرجال يعانون أكثر من هذه الناحية. وهكذا بوسعنا مواصلة الصراع بين الجنسين، ولكن انطلاقاً من سؤال: مَن هي الضحية الكبرى؟ ويتابع جيمس ستيربا من حيث توقف فاريل، ويتساءل فيما إذا كانت النِسوية جيدة للرجال: الرجال ضحايا النظام العنصري ذاته الذي تعاني منه النساء، ولكن بطريقة مختلفة. ويضيف قائلاً إن الرجال سوف يستفيدون في حال دعموا أهداف النِسوية. فحين يشاركون بالرعاية اليومية وتدبير المنزل، لن يكون هناك سبب لمنح النساء الأولوية بحضانة الأطفال بعد الطلاق. وحين لا يتقدمون على النساء اقتصادياً، لن يكون هناك داعٍ لتحميلهم أعباء أكبر. وحين يتمكنون من السيطرة على سلوكهم العنيف، سوف تستفيد النساء وبقية الرجال على حد سواء. وبدل أن نبحث عن الضحية الكبرى، دعونا ننظر إلى الأهداف المشتركة بين الرجال والنساء. المشكلة هي أن الرجال سوف يخسرون بعض الأمور، غير أن كثيراً من ردات أفعالهم على طموح النساء إلى التحرر توحي بأنهم يريدون الاثنين معاً: زوجة تشارك في كسب المال، وتحمل أعباء الرعاية على عاتقها.
وتكمن النقطة العمياء الثانية في إنكار الجدلية بين الأنوثة والرجولة، أو ديناميكية السلطة بينهما. ففي كتابه الرجال في جلسة التعارف الطبية لا يذكر فان درلو شيئاً عن علاقة الرجال بالنساء، فيكرس تشفيرات الرجولة التي تعتبر الرجال قادرين على الاستقلال بذاتهم. وسوف أفصح هنا عن أمر ما زال غير مثبت تماماً، وهو أن المرشدين الذين يقدمون المساعدة للرجال ما زالوا تحت تأثير تشفيرات الرجولة الذي تعتبر الرجال قادرين على الاستقلال بذاتهم، وقد يكون ذلك رداً على الإرشاد الموجه للنساء: إذا كانت مؤسسة إرشاد النساء لا تحتاجنا، فنحن أيضاً لسنا بحاجة إليكن!
ويقول يوب بيلن في أحد المؤتمرات إن مؤسسات إرشاد الرجال تحتاج إلى اعتراف مؤسسات إرشاد النساء، وإلى موقف بنّاء حيال الرجال والرجولة، موقف لا يؤكد على التنميطات ولا يرفض الرجال أو يحاكمهم. كما أنه يهاجم في ندوته المختصةَ النفسية نيلكه نيقولاي، لأنها في رأيه كتبت أن النساء يملكن حساً أخلاقياً أسمى (لقد بحثتُ عن الفقرة، ويبدو أن بيلن لم يلتقط أسلوب السخرية نهائياً). كما أكد أن مختصة العلاقات آلي فاندن بِرخ قالت إن غريزة الرجال الجنسية طبيعية وملزِمة (بحثتُ عن تلك الفقرة كذلك، ولكنها لم تكن أكثر من تعداد للخطابات المهيمنة في الغرب، وليس ما تؤمن به الكاتبة)، كما استنكر كلامها عن سيطرة الرجال النسبية وخضوع النساء. يفترض بيلن أن هذا الموقف يغلق آفاق التعاون بين الإرشاد الموجه للنساء، وذلك التي يستهدف الرجال، بمعنى آخر: يحق لمرشدي لنساء أن يتكلموا عما تشكو منه المرأة، على شرط ألا تدعي أنها تشتكي من الرجل، لأن ذلك قلبٌ للحقائق ومعادٍ للرجل. من المؤكد أن بيلن محق بنقده للحركة النِسوية في حال نظرت إلى الرجال كمُعنِّفين فقط. «إن العمل مع مجموعات الرجال جعلني أفهم أنه حتى ولو كان لأولئك الرجال صفات المُعنِّف، فهذا لا يعني أنهم مجرد معنِّفين، أو أنهم يملكون السلطة ليديروا الأمور في محيطهم على هواهم. بل أكثر من ذلك: ففي حال أردتُ فهم الرجال والاطلاع على عوالمهم وجذور شخصيتهم وسلوكهم، يتوجب علي تغيير منظور التحليل السلطوي الذي يعتبر أن الرجال دائماً ’فوق‘ والنساء دائماً ’تحت‘. إن الرجال الذين يقومون بالاستغلال الجنسي لا يدركون أن سلوكهم استغلالي. بل يرون أنفسهم ضحية الظرف، وضحية نزواتهم أو إهانة الآخرين». بيلن على حق حين يقول إن الرجال غالباً لا يشعرون بالسلطة، حتى ولو مارسوها. ولكن هل يعني ذلك أن علينا الصمت مجدداً بخصوص نتائج العنف الجنسي؟ ألا يمكن استنتاج أن «تشفيرات الرجولة» ليست مؤذية للرجال فحسب، بل للنساء كذلك؟ على سبيل المثال: إحدى مشاكل انتشار مرض الإيدز والأمراض الجنسية بين النساء هي أن بعض الرجال يرفضون تماماً استخدام الواقي المطاطي أثناء الجماع. كيف يمكننا تفسير ذلك؟ إحدى التفسيرات هي أنها أنانية تخصّ الرجال (من بعدي الطوفان!). أما الرجال فيقولون إن الواقي المطاطي يحدّ من متعة الجنس. غير أن ليندسي نيل تأتينا بتفسير قلّما سمعنا الرجال يتفوهون به: «الرجال الذين يخافون من القذف السريع أو من فقدان انتصابهم لا يحبذون مواجهة الصعوبات أثناء لبس ذلك الشيء». يمكننا الجزم إذن أن الجنس لدى الرجال، نظراً لتشفيرات الرجولة، أكثر هشاشة مما قد يعترفون به. لا شك أن ذلك مزعج للرجال، غير أن الأذية التي يتسببونها للنساء واقعية أيضاً.
هل من الضروري أن نبقى عالقات بتفكير إما/أو، أم بإمكاننا التعلم من جولدنر تفكير الـ و/و؟ فرجينيا جولدنر تعمل كمختصّة أسرة مع الحالات الزوجية التي يكون فيها الرجل عنيفاً. هل الرجل مذنب جراء ما فعله بزوجته، أم أنه ضحية، وبخاصة حين تفهمين ماذا جرى معه حتى وصل إلى هنا؟ الاثنان معاً، لا يمكن تعويض شيء بشيء آخر. هل يمكننا فهم سبب لجوء الرجل إلى العنف؟ نعم. ولكن هل يعني ذلك أنه لم يعد مسؤولاً عن أفعاله؟ لا. لقد حان الوقت لإعادة النظر في ثنائية المذنب والضحية، ومن دون إنكار تجربة الضحية، ومن دون رفع المسؤولية عن المذنب. تقول شارون لامب إن تفكير إما/أو هو التفكير الصفري، كما لو أن فهم المذنبين سوف يرفع عنهم جزءاً من المسؤولية، ويحمّل الضحايا مسؤولية أكبر لما نالهم من أذى، أي عودة إلى التقليد القديم «تأثيم الضحية».
ويسبر ميشيل ميسنر، الذي يعتبر نفسه مناصراً للنسوية، عدة توجهات في التفكير حول الرجولة، تماماً كاختلاف التوجهات الفكرية لكل من النِسوية ومؤسسات إرشاد المرأة بخصوص الجدل القائم حول نظرية الاختلاف والتماثل. هل نحسب الرجال والنساء متطابقين جوهرياً (والنتيجة الاستراتيجية هي التركيز على التساوي بالحقوق) أم مختلفين جوهرياً (والنتيجة الاستراتيجية هي التركيز على إعادة تقدير الأنوثة وحماية الحدود)؟ كنتُ قد شرحت في مكان آخر أن الاستراتيجيتين تفضيان إلى طريقٍ مسدود حين تُطبّقان بشكل أحادي مبالغ به: تركيز الصراع على السلطة يوحي أننا سوف نقلّد الرجال ونتجاهل الاختلافات، مما يؤدي إلى تذكير النساء والمجتمع ككل. بيد أن الاحتفاء بالاختلاف يعني أننا سنترك السلطة السياسية للرجال قانعات بالنتائج، ونحبس أنفسنا في جزر صديقة للمرأة. وهكذا يبقى الرجل هو المعيار في الحالتين، في حين أن هدفنا هو تغيير الخطوط الفاصلة بين مناطق النساء والرجال وبين الأنوثة والرجولة. جميعنا نعاني من التفكير القطبي، حتى ولو كانت طريقة الرجال تختلف عن النساء. ولطالما تناسينا أن التفكير حول النساء يوحي برؤية معينة حول الرجال والرجولة، كما لو أننا نقسم تفكيرنا إلى دفاتر حسابات مزدوجة. كثير من النِسويات يوافقن سيمون دوبوفوار على أننا لا نولد كنساء، بل نصبح كذلك، غير أنهن لا يسحبن الأمر نفسه على الرجال، كما لو أن الرجال لا يتغيرون من حيث المبدأ.
ويعرض ميسنر عدة توجهات فكرية بخصوص الرجولة، وكل منها لها محدوديتها الخاصة ودرجة صحتها:
1. يملك الرجال، كفئة، امتيازات مؤسساتية على حساب فئة النساء. ومن الممكن إثبات هذا التوجه الفكري، الذي تغذيه النِسويات بخاصة، وتتقبله مجموعة (صغيرة) من الرجال، عن طريق الحقائق.
2. يدفع الرجال ثمناً باهظاً – من خلال العلاقات السطحية، والصحة السيئة، والموت المبكر – من أجل التأقلم مع التعريفات الضيقة للرجولة التي تعدهم بامتيازات ومكانة مرموقة. ويعتمد كلٌ من مؤسسات إرشاد الرجال الهولندية وعدد من الكتّاب الرجال هذه الرؤية التي لا ينقصها هي الأخرى سند الحقائق.
3. لا يستفيد الرجال بالتساوي من ثمرات النظام الأبوي: الرجولة المهيمنة (بيضاء، طبقة وسطى وعليا، غيرية الجنسانية) توضع مقابل الأنوثة، ومقابل عدد من الرجولات الخاضعة (إثنياً وطبقياً وجنسانياً). ورغم أن فئة الرجال تملك سلطة كبيرة، إلا أنهم لا يشكلون مجموعة متماسكة. هذه الرؤية قابلة كذلك للإثبات من دون أدنى شك.
وتتبنى معظم «حركات الرجال» إحدى تلك التوجهات على حساب الأخرى. ولكن كما هو الحال في «الجدل بين نظريتَي الاختلاف والتماثل» الذي يفضي إلى طريق مسدود، فإن مناصري هذه التوجهات يقعون في المطب ذاته. فالمرأة التي تنظر فقط إلى الامتيازات التي تملكها فئة الرجال على حساب فئة النساء، سوف تنبذ الرجال كحُلفاء محتملين. وحين يتبنى الرجل تلك الرؤية، سوف تعتمد استراتيجيته على الإحساس بالذنب غير المجدي، وغير الفعال، وغير المغري لكثير من رجالِ التوجه الثالث الذين لا يشعرون أن لديهم سلطة وامتيازات. يشكل كثير من الرجال مشكلة في إحدى المجالات الثلاثة (الشعور، العنف، الواجبات المنزلية)، ولكن لن يتغير شيء إلا في حال نظروا إلى الموضوع على أنه مشكلة فعلاً.
على أن الذين يركزون فقط على ثمن الرجولة، سوف يستقطبون الرجال حولهم، ولكنهم سيعيقون التعاون مع النساء، ولن يساهموا في التغيير الفعلي للعلاقات الحالية بين الجنسين. التنافس حول من وضعه أصعب سوف يوسّع الفجوة بين الرجال والنساء.
حتى في هولندا ثمة أمثلة عن هذه التيارات: لدينا «الآباء الغاضبون» الذين يطالبون بحقوق متساوية بخصوص الأطفال، دون أن يحققوا التساوي في مستوى العناية بالأطفال قبل الطلاق. وقلما تذكروا أن العنف عنصر ثابت في كثير من حالات الطلاق. ولدينا كذلك «الرجال البرّيون» الذين يلجؤون إلى رجولة بدائية، بعيداً عن النساء، ودونما اهتمام بالأسئلة التي يطرحنها حول تقسيم الرعاية. بمعنى آخر: يريدون التخلص من ثمن الرجولة دون أن يتخلوا عن السلطة والنفوذ. كما لدينا مجموعات رجالية (لا تطلق على نفسها هذه التسمية) تركز على ثيمة واحدة لا غير، كحركة المثليين، فتعزل نفسها عن التحالفات مع الآخرين.
الرجال لديهم مشاكل. والرجال مشكلة. والرجال لا يشكلون مجموعة واحدة. يقول ميسنر: «في حال بدت هذه الثيمات الثلاثة متناقضة ومتنافرة فيما بينها، فلأن الأمر كذلك فعلاً. ولكني متأكد أننا سوف نقترب من رؤية صافية حول العلاقات الحالية بين الجنسين، في حال وضعناها في مركز تحليلاتنا». هل نحن قادرات فعلاً على تطوير رؤية تأخذ الثيمات الثلاث على محمل الجد، كما يدعونا ميسنر وكيمل والآخرون؟ نِسوية «شاملة» تتيح المجال للتجارب الذاتية لكل من الرجال والنساء (وكذلك تجارب العرق والطبقة والجنسانية)، وللتحليلات السياسية التي تتناول الهيمنة والخضوع؟ وهل سيقدر الرجال على تقبل نقد النسوية للبطريركية، وهل سنقدر على التعاطف مع وضع الرجال؟ وهل سنوازن ما بين إعادة الكرامة لإيجابيات الرجولة التقليدية من ناحية، ومد يد العون للرجال كي يتصالحوا مع التغييرات اللازمة؟