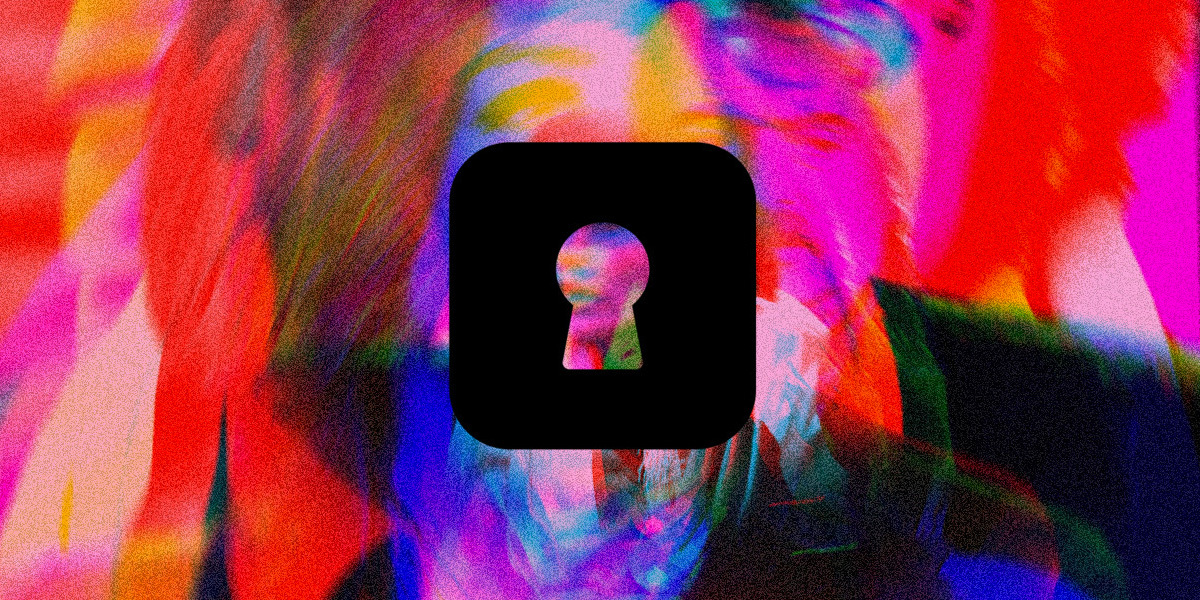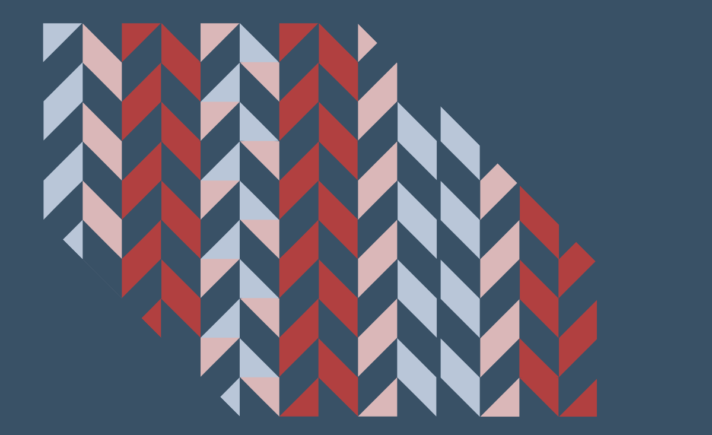قمتُ بتسيير ندوة عن حضور اللغة الإنكليزية في المسرح الألماني في مدينة ميونخ، ضمن فعالياتٍ أقامتها بعض المؤسسات والمسارح الألمانية بمناسبة استقبالها العديد من اللاجئين. كان النقاش باللغة الإنكليزية دون ترجمة. وتطرَّقَ أحد المتحدثين الأربعة، وهو ممثل سوري، إلى موضوعة الأدوار التي تُسنَد إلى الممثلين في ألمانيا، وتحدث بجرأة عن تفهّمه للذائقة العامة ودوره كممثل أجنبي. وفي معرض حديثه، ناقش الممثل جدلية القبول والرفض من جانب الطرفين المعنيين؛ الجهة الإنتاجية، والممثل نفسه. وإن تحفظت الجهات الإنتاجية ولم تغامر بإسناد دور كدور هاملت -يُسنَد بالعادة إلى الممثلين المحليين أو «الممثلين البيض»- إلى ممثل أجنبي، فإن الممثل الأجنبي لديه معاييره في القبول والرفض أيضاً.
أحد معايير القبول والرفض، بحسب الممثل، هو سياق العمل الفني نفسه، فأداؤه لشخصية هاملت في المسرح الألماني هو أمر أكثر منطقيةً من أداء الدور ذاته في الدراما الألمانية، ذلك أن جمهور المسرح منفتحٌ على الثقافات والتجريب على عكس جمهور الدراما. لاحظتُ حينها ارتباكاً ما في الصالة، وعلى الفور، قمت بتنويهٍ سريعٍ للجمهور في الندوة؛ نحن في سوريا نطلق كلمة الدراما على المسلسل التلفزيوني، وبالتالي فإن ما يريد قوله الممثل هو إن أداءه لدور هاملت في المسرح أكثر منطقية من القيام بالدور نفسه في مسلسل تلفزيوني ألماني.
لم تكن كلمة الدراما هي الوحيدة التي استولى عليها المسلسل التلفزيوني، فظاهرة المسلسل التلفزيوني في سوريا استولت على الكثير من مفاهيم الحياة السورية. ولعلّ هذه الظاهرة من أهم الظواهر التي التفت إليها الباحثون، وكان لا بدَّ من الإشارة إليها وتحليلها في الكتب والأبحاث المحلية والمترجمة المعنية بالشأن السوري العام. ولا أبالغ إن قلت إن الشعب السوري هو من يحضر المسلسل. فالجميع يحضر المسلسل، سواء كان تاريخياً، أو معاصراً، أو كوميدياً، أو فانتازياً، أو للأطفال. والجميع هنا تشمل جميع الفئات العمرية. أذكّر أن التلفزيون السوري قام بتأجيل مسلسل عدنان ولينا في عام 1996، بسبب تضارب وقت عرضه مع موعد الامتحانات الجامعية. وبعد الفوضى، ارتأى الجميع أن الوقت المناسب لعرض المسلسل الكرتوني هو أن يكون لاحقاً في الصيف، بعد أن ينتهي الطلاب الجامعيون من امتحاناتهم، كي لا يشغلهم المسلسل. وبعد الامتحانات تم عرض مسلسل عدنان ولينا، وتابعه الجميع صغاراً وكباراً، ومن ثم كاساندرا على ما أعتقد، وتابعه الجميع أيضاً.
التعلق بالمسلسل، ولنا أن نذكر مشهد الشوارع في سوريا خلال رمضان وهستيريا المسلسلات، أدى إلى نوعٍ معينٍ من المتابعة لمختلف تفاصيل الحياة. وبالطبع، باتت الأحاديث اليومية العامة متقطعة وسريعة التبدّل، كمن يُقلِّبُ بين المحطات التلفزيونية. تداعى الأمر إلى استقبال أي مادة معنية بالشأن العام السوري كمادة شبيهة بتلقي المسلسل التلفزيوني، والذي لا يكتفي بالمادة المعروضة، بل على المتابع أن ينتظر ما سيحدث فيما بعد (في الحلقة التالية أو نشرة الأخبار التالية). ويتكفل المسلسل التلفزيوني نوعاً ما بإرضاء المُشاهِد بالمادة المعروضة دون الحاجة إلى تدخل هذا المشاهد في تسلسل الأحداث وتفسيرها، وهو الذي يفسر الحالة المتعالية لبعض الآراء التي ترى أن المسلسل التلفزيوني يستدعي الكسل في المشاهدة، وضعف مهارات التأويل والمحاكمة، عدا عن تكريس عزلة العالم في بيوتها أمام شاشات التسلية. وقد يفسر هذا الكسلُ التراخيَ في الحكم على المسلسلات التلفزيونية، مقابل الشراسة في تناول أفلام السينما والعروض المسرحية.
وعلى مرّ العقود السابقة، جرى التمرّس على نوعية محددة من التلقي التلفزيوني واعتبارها المعيار العادي. واستدعى ربطُ القضايا العامة بذهنية المتابعة للمسلسل التلفزيوني تحويلَ أي نوعٍ من الأخبار إلى سلسلة ممطوطة من الأحداث، كما حدث مع قضية اغتيال الحريري، التي تبنّت لذة التشعّب بالتفاصيل وظهور أحداث أو شخصيات جديدة تؤثر على سير المعرفة بما يحدث، كي لا يفتر الخبر وتقل مشاهدته. ولعل الأمر ينطبق أيضاً على متابعي أخبار الشاعر أدونيس وجائزة نوبل، عدا عمّا تقوم به التلفزيونات بتحويل أي مادة يومية إلي سيناريو غير منتهٍ يستكشف فيه المتابع تفاصيل غراميات وخلافات المشاهير.
وقد يقدم هذا السياق أحد تفسيرات تخبط الحراك السوري عام 2011، بعد أن انكفأ كثيرون عن التشارك والتفاعل مع التظاهر والاحتجاجات السورية عام 2011، متقوقعين أمام التلفزيونات. تَحوَّلَ الأمر تدريجياً إلى شكل من المتابعة على طريقة متابعة المسلسل، يتنبى اللهفة لمعرفة ما حدث، والتشويق لمعرفة ما سيحدث غداً، وما هي الشخصيات الجديدة التي ستظهر على الساحة، ومَن المتكلم في التقارير الإخبارية، وما الأحداث الطارئة التي ستغذي تشويق الحدث السوري. وشيئاً فشيئاً عاد التقوقع للقول إنّ لا علاقة بالمشاهد بما سيحدث، بل تكفيه الفرجة المسلوبة على طريقة المسلسل التلفزيوني. وهنا يُلحّ عليّ السؤال مراراً: ما هو المصير المحتمل للاحتجاجات السورية لو كان «جمهور الثورة» أقلَّ تعلّقاً بالمسلسل التلفزيوني، وأقل تعوداً على هذا الحياد الذي يتابع به أحداث مدينة قريبة منه كما لو أنه يتابع حلقات مسلسل تلفزيوني؟
وهنا لا بد من الإشارة إلى التغيير الهائل في صناعة التسلية التلفزيونية بعد عام 2011. ففي العقود السابقة، استطاع نجم المسلسل التلفزيوني احتلال الساحات والفضاء العام، وبات المؤهلَ للحديث في الشأن العام واستراتيجيات الدول وأشكال التعليم وتحديد ماهية علاقتنا بالغرب، وإلى ما هنالك من قضايا مجتمعية وسياسية. ولكن في غضون أسابيع قليلة تم استبدال المتحدثين من نجوم المسلسلات السورية بنماذج شريف شحادة وخالد العبود والعرعور، ليتصدَّرَ أطراف النظام والمعارضة المشهدَ الترفيهي على التلفزيونات وفي البرامج الحوارية، ويكملوا مسيرة الحديث عن استراتيجيات الدول وأشكال التعليم وتحديد ماهية علاقتنا بالغرب.
يرى المسرحي الأميركي ريتشارد شكنر أن المسرح والسينما يخلوان في العقود السابقة من سؤال «ماذا»، لينصبّ اهتمامهما على سؤال «كيف». فسؤال «ماذا سيحدث في الحكاية؟» في المادة الفنية المُقدَّمة قد استحوذ عليه التلفزيون، وباتت الفرجة التلفزيونية متعلقة أساساً بسؤال ماذا سيحدث؟ فيما يقوم المسرح والسينما بتقديم حكايات معروفة سابقة، أو حكايات مبهمة بسرديتها، ولكن الأمرَ الأكثرَ إلحاحاً هو التمعن في سؤال كيف تداعت الأحداث بهذه الطريقة؟ وكيف سيقدم العاملون على المسرحية أو الفيلم مادتهم؟ وكيف سيؤدونها؟

سبقت العقود السابقة للاحتجاجات في سوريا أشكالٌ اعتباطية للتعاطي مع الفنون وتدرّجِ أهميتها، فتَصَدَّرَ المسلسل التلفزيوني المعايير وتفسيرات النجاح، وبات مصير من لا عمل له في المسلسل التلفزيوني انتظار فيلم سينمائي ما، أو التمثيل في المسرح، وتنتهي سلسلة الفشل عند العمل في الإذاعة، ومن بعدها تغيير المهنة. وأمام هذه الهرمية، كان لا بد من تبجيل المسلسل التلفزيوني والسعي لإبعاده عن كونه مصدر تسلية أساساً.
أحد أشكال هذا التعاطي الاعتباطي هو استسهال النجم التلفزيوني حصوله على صفة المثقف. فبعد أن سحب المعهد العالي للفنون المسرحية لقب المثقف من الجامعة ومن كلية الآداب بشكلٍ خاص، كما كان الأمر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، أصبح المعهد المسرحي هو واحة المثقفين. كان المعهد المسرحي مختلِفاً عن كل المؤسسات السورية من الناحية الأكاديمية، ومن ناحية ابتعاده عن الفساد وحصانته من تدخلات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وتمتّعه بأشكال حريات غير مألوفة في سوريا. أصبح المكان فعلاً مكاناً للمثقفين، رغم أن العديد من السوريين كانوا يطلقون هذا اللقب على المعهد من باب السخرية: «المثقفين تبع المعهد».
ولكنّ الاتفاق السوري على نعت المعهد المسرحي بمكان المثقفين كان له تفسيرات مختلفة داخل المعهد بين قسمي التمثيل والدراسات المسرحية. فبينما شدَّدَ قسمُ التمثيل على أن المثقف هو من يتمتع بتدريب احترافي وأكاديمي عال ونجاحات جماهيرية تمنحه مصداقية الكلام، تشبَّثَ قسم الدراسات بمقاربة مصطلح المثقف على أنه المعرفة الصافية التي لا تشوبها سقطات الممارسة، والتمتع بلغة ومفردات محصورة على القلائل ممن يفهمونها.
وفي النهاية، انتصر قسم التمثيل بمنابره وشعبيته، وأصبح المثقف من قسم الدراسات كاريكاتوراً: بشعره الأشعث، ومفرداته المبهمة، وقلّة استحمامه.
استولى المسلسل التلفزيوني على اهتمام جميع الشرائح، بِدءاً من ربات المنزل، ومروراً بالجامعيين، وانتهاءً بالسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال. وأغرت المسلسلات كثيراً من الروائيين والمسرحيين والصحفيين، كما جرى توفير التسهيلات للإنتاج التلفزيوني؛ كتخفيف الرقابة، وتسخير قطع من الجيش والشرطة كمجاميع في اللقطات العامة. ولكن معظم العاملين في المسلسل التلفزيوني يتفقون ضمنياً على أن هذه الهرمية مصطنعة، وأن المسلسل السوري يحتل صدارة الاهتمام في سوريا فقط.
وأمام إجادة اللعب في النقاشات السهلة والمريحة، والميوعة الكفيلة بتحويل حدثٍ عن كسوف الشمس في سوريا إلى كلام عن البط والطيور، وتحويل شعر لوركا إلى همسات آخر الليل، كان الجميع على دراية بأن المواقف السياسية والاجتماعية التي كان يطلقها العديد من النجوم الممثلين المثقفين على شاشات التلفزيون هي عرضة للتبدّل. فلا تستطيع المواقف المعلنة على التلفزيونات الصمود أمام السرعة التي ينقل بها التلفزيون أخباره، وآراءه أيضاً. فتارةً هوليوود عدوة، وتارةً أخرى محطّ اهتمام وجاذبية. وتارةً يُعتبر الخليج شريكاً، وبعدها متآمراً. وتارةً يصيحون للحريات، ثم يقفون ضدها (إن كانت على الطريقة الأميركية).
ولعل هذا التبدّل مرتبط بقيمة المسلسل التلفزيوني نفسه. فمسلسل تلفزيوني جميل ومرموق مثل هجرة القلوب إلى القلوب، من تأليف عبد النبي حجازي وإخراج هيثم حقي، سيبدو اليوم باهتاً أمام التطور الذي شهدته صناعة المسلسل التلفزيوني واختلاف أساليب التمثيل الراغبة بمواكبة السلوك الاجتماعي الآني. أما على صعيد المسرح والسينما، فلا ينطبق هذا الكلام على منجزاتها التي تم إنتاجها في الفترة نفسها، والتي ما تزال قادرةً على أن تكون مدهشةً على صعيد المعالجة والتمثيل، كما هو الحال في فيلم نجوم النهار للمخرج أسامة محمد أو مسرحية سكان الكهف للمخرج فواز الساجر.
ولكن هل يصل التفكير بالمسلسل إلى علاقتنا بالمأساة السورية؟ تميل الإجابة إلى الإيجاب، خاصةً وأن المسلسل السوري منذ عقود لم يستولِ على كلمتي دراما ومثقف فقط، بل أصبح هو «العمل» أيضاً. وفي معرض انذهاله من الحياة السورية والعلاقة مع المسلسل التلفزيوني، يشير الشاعر أمجد ناصر في كتاب تحت أكثر من سماء: رحلات إلى اليمن، لبنان، عُمان، سوريا، المغرب، وكندا إلى دهشته من هذا الاتفاق بين السوريين على ربط كلمة المسلسل التلفزيوني بالـ«العمل»: فإن قال الممثل أو الكاتب أو المخرج لدي «عمل»، فالمقصود بذلك هو المسلسل التلفزيوني حصرياً. أما السينما والمسرح، فيٌطلق عليهما السينما والمسرح.
قد يكون الإصرار على رفع شأن المسلسل السوري ليكون فناً راقياً ونخبوياً ضرباً من التورية والالتفاف حول قيمة المسلسل التلفزيوني. فلم يكن للمسلسل التلفزيوني هذا الاهتمام كلّه لولا تدفق المال الخليجي نحو سوريا بعد حرب الخليج عام 1991. حينها أرسلت سوريا قواتها للمشاركة، وتمنّعت الأردن، وبالتالي انحسرت المسلسلات البدوية الأردنية التي كانت سائدةً في الثمانينات، وانتعشت المسلسلات السورية مع بداية التسعينيات.
ومع وجود كوادر عديدة متمرّسة في مهنة التمثيل أساساً، والكتابة والإخراج بشكلٍ أقلّ، أصبحت المسلسلات السورية جاذباً للمشاهدين العرب على امتداد الوطن العربي وفي المهجر. وكان المعهد العالي للفنون المسرحية رافداً هاماً للحفاظ على حيوية المسلسلات السورية، عبر تخريج ممثلين استقطبوا شعبيةً هائلةً لجودة أدائهم وتنوع أدوارهم وخياراتهم ومشاريعهم. كما تحوَّلَ العديد من خريجي قسم التمثيل إلى مخرجين نافسوا الصناعة المصرية، مثل حاتم علي. واستطاعت مهارات الممثلين السوريين التخفيف من جمود الآداء في الأفلام السينمائية، والتجرؤ على فرد مساحات واسعة للّغة العامية على خشبات المسرح. أصبح الممثل السوري الحجر الأساس في ظاهرة المسلسل السوري.
بيدَ أن العديد من العاملين في المسلسلات السورية يشكُون غياب الصناعة الحقيقية لضمان الاستمرارية والجودة. وكان ثمة تمازجٌ غريبٌ وتخبطٌ في آليات العمل في المسلسل التلفزيوني، عبر وجود بذخ خليجي ولقاءات عمل في المقاهي (كانت قهوة الروضة وأوتيل الشام امتداداً لمكاتب الإنتاج التلفزيوني والتسويق والكاستينغ). كما رضخ العاملون في المسلسل التلفزيوني إلى الشرط الرمضاني، الذي ينصّ على أن يكون المسلسل ممتداً على ثلاثين حلقة، لتكون أي فكرة أو حكاية أقل أو أكثر من ثلاثين حلقة مشروعاً فاشلاً.
في عام 2005، قدمت قناة Channel 4 البريطانية برنامجاً وثائقياً عن موسيقى الراي في الجزائر وانتشارها في أوروبا، وعلّقَ أحد المتحدثين بأنّ الشمال الإفريقي أكثر انفتاحاً وألفةً مع العالم، فيما يبدو المشرق العربي كحلقة مقفلة على نفسها ومكتفية بذاتها. ولا يختلف أمر المسلسل التلفزيوني السوري عن هذا الانغلاق، فتباعاً بات توجّهُ الموسيقيين السوريين ومن ثم المسرحيين هو الانكفاء على المشرق العربي وفعاليات المسرح في الخليج، مع الحضور القليل في مصر وتونس. وهناك، أيضاً، يتم تدوير الأغاني والفيديو كليبات وبرامج التسلية التلفزيونية أو الإخبارية والحوارية بين دول المشرق العربي. هذا الاكتفاء كان كفيلاً بأن يقنع المنتجين والمتلقين بالرضا، وبالتالي عدم الحماس للخوض خارج حدود المشرق العربي، كما فعلت إيران بحضور سينماها عالمياً، أو كما فعل المغرب العربي بانفتاحه الموسيقي.
خلال فترة قياسية، أصبح النجم التلفزيوني صاحب ثروات وقريباً من النخب السياسية. وكان للعديد من نجوم التلفزيون أصوات مسموعة عند أصحاب القرار. ولكن لم تستطع الأصوات المسموعة في الأحاديث عن الشأن العام وضمان حريات الشعوب في تقرير مصيرها وسيادة الدول أن تقرر مصير مسلسلاتها، أو أن تغير شكل الثلاثين حلقة، أو أن تستعيد كأساً من الكحول في مشهدٍ كان قد حَرَّمَه التمويل الخليجي.
وأمام العلاقة المرتبكة مع الصناعة والمفاهيم، سيطرت آليات عملٍ متناقضة على إنتاج المسلسل التلفزيوني السوري واستهلاكه. يعتبر العديد من الاقتصاديين أن بناء المؤسسات لا يزال متبنياً الخطوات والآليات ذاتها التي سادت خلال القرون الخمسة الفائتة. وعلى الرغم من العديد من المحاولات للتحديث والتجديد، إلا أن البناء المؤسساتي بقي كما هو، مجرد نسخة عن نماذج سابقة. تقوم المؤسسات عامةً على ثلاثة هياكل: فتكون إما بيروقراطية، أو عائلية، أو مرتبطة بكاريزما شخص معين. وهذه الأخيرة هي الأكثر حضوراً في قطاعات الفنون والثقافة، والأسرع زوالاً لارتباطها بالحضور الفيزيائي للفرد المؤسّس ومصداقيته. وهنا شهدت مأسسة المسلسلات السورية حالاتٍ من التأرجح ضمن هذه الهياكل، فتارةً تتبنّى السلوك البيروقراطي، وتارةً تصبح إمبراطوريةً عائلية، وتارةً ترتبط بفردٍ يصبح الآمر الناهي بفرض القوة واصطياد الفتيات وإثبات الذات وبخس أجور الممثلين المُصنَّفين ضمن الدرجة الثانية والثالثة.
لعلَّ العلاقة المتوترة بين العاملين في التلفزيون والعاملين في القطاعات الفنية والثقافية الأخرى تُرَدُّ إلى سيطرة التلفزيون المطلقة على الحياة السورية، والاستيلاء على المفردات وعلى آليات التفكير والتلقي وتعميم قيم الربح المادي (والتي تم فرضها على المسرح والسينما، البعيدين عن شرط الربح المادي). ومع انحسار المسرح والسينما والقراءة وازدراء هذه النشاطات، بات المسلسل التلفزيوني المرجعَ الأساسي لاستنباط القيم وملامسة هوامش الحرية الاجتماعية والسياسية. واستمر هذا التأثير على الكتابة للمسرح والسينما، ونشرات الأخبار ربما. يمكننا رؤية تأثير غياب تقنيات الكتابة السينمائية والمسرحية على المردود الثقافي بعد 2011.
لا شكَّ في أن المسلسل التلفزيوني وَفَّرَ فرص عملٍ كثيرة لقطاعات وشرائح سورية واسعة بعد تدفق الأموال الخليجية والاستثمارات المحلية. ولكن الآن، مع تشظي العاملين في المسلسلات السورية في أصقاع الأرض، وانحسار الرغبة الخليجية في المسلسل السوري، بل ورغبتها في الابتعاد عن المسلسل السوري (وكل ما هو سوري)؛ ما مصير المفردات التي استولى عليها المسلسل لعقود، كالدراما والثقافة والعمل؟ وعندما يتوقف تدفق رأس المال إلى المسلسل السوري، أو «العمل»، ليتجه نحو برامج المسابقات أو الحوارات السياسية، ما العمل حينها؟