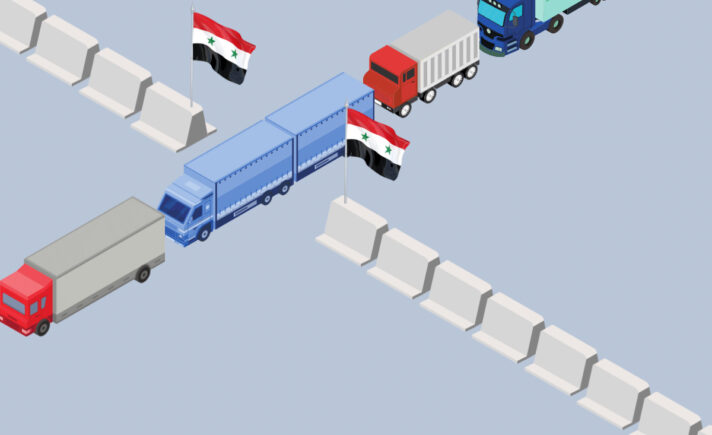في السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2019، كانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني تناقش فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، بعد أشهرٍ من تراجعٍ خطيرٍ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الدين العام إلى نسبة 150% من الناتج المحلي السنوي، ما أدى إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف سندات الحكومة اللبنانية. كان الاقتصاد قد وصل إلى حدود التحمل القصوى للفساد المستشري ضمن النظام السياسي.
سياسات التقشف والضرائب الجديدة التي أرادت حكومة سعد الحريري فرضها في السابع عشر من تشرين، كانت تنفيذاً لاتفاقٍ مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمملكة العربية السعودية، للحصول على حزمة قروض تقدر بحوالي 10.2 مليار دولار، ومنحٍ تزيد قليلاً على 800 مليون دولار. وهو ما كان ضرورياً لإنقاذ النظام المالي في لبنان، والحيلولة دون انهيار العملة المحلية. لكنّ ذلك كان يعني أيضاً إنقاذ النخب السياسية، التي كانت السبب الرئيسي وراء الأوضاع التي يعيشها لبنان؛ سياسات الاستدانة لتمويل الإنفاق على الإنشاءات منذ التسعينات، وسياسة ربط لبنان بالدور الإيراني والنظام السوري، وقبل ذلك كله الفساد المالي والإداري الذي كان يستمد شرعيته من المحاصصة الطائفية المكّرسة في اتفاق الطائف عام 1989. كل ذلك كان السبب الرئيس في السير نحو الانهيار، وهو ما تندّر به اللبنانيون قبل اندلاع الثورة خريف عام 2019، كانت نكتة الانهيار الأكثر رواجاً وقتها.
كانت الحكومة اللبنانية تنوي في جلسة 17 تشرين رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، بالإضافة إلى حزمة من الضرائب التي طالت حتى برامج التواصل عبر الإنترنت. مساءً، وبعد انتهاء الجلسة، كان عشرات من الناشطين المدنيين متجمعين أمام السراي الحكومي وسط العاصمة، ليحدث إشكالٌ بين المتظاهرين وموكب وزير التعليم العالي أكرم شهيب، نتج عنه إطلاق حراس الموكب النار على المتظاهرين دون أن يصاب أحد، وهو ما زاد الغضب في تلك الليلة. حينها، بدأ نزول الناس إلى الشوارع في معظم المناطق اللبنانية وليس العاصمة فقط. تظاهر الناس ضد الضرائب الجديدة، وضدّ الطبقة السياسية الحاكمة منذ الطائف. كان الوصول إلى الانهيار التام حتمياً بمثل هؤلاء السياسيين، وبمثل تلك الظروف.
لم يرجع الناس إلى بيوتهم بعدها. في الثامن عشر من تشرين الأول قام المتظاهرون في النبطية بتكسير لافتات مكاتب تابعة لحركة أمل وحزب الله. لم يكن ذلك احتجاجاً عرضياً، فقد كانت الأوضاع الصعبة لكل اللبنانيين قد وضعت الحزب السياسي الوحيد الذي يملك سلاحاً أمام ما كان يعتبره دوماً «بيئةً حاضنة». امتدت خلال الأيام التالية سلسلة بشرية من طرابلس في الشمال حتى صور في الجنوب بأيدي قرابة 170 ألف لبنانيةٍ ولبناني. لم يعد وسط بيروت يحتكر التظاهرات، كما كان في حراك عام 2015. بالتوازي مع ذلك، نظمت نقابة موظفي القطاع العام إضراباً شاملاً ضد عمليات التقشف الحكومي، التي استهدفت المتقاعدين بشكل أساسي.
خلال الأسبوع الأول من التظاهرات، أعلن الأمين العام لحزب الله مساندته للحكومة، كانت التشكيلة التي يرأسها سعد الحريري، بعد اتفاق لم يعجب الكثيرين، حكومة الحزب.
ابتداءً من اليوم التالي لبدء التظاهرات، كانت القوى السياسية اللبنانية الأبعد عن تحالف التيار الوطني الحر مع الثنائي الشيعي قد بدأت تتخذ موقفاً واضحاً. رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، طالب منذ اليوم التالي باستقالة الحكومة بعد أن أعلن وزراء القوات رفضهم الذهاب إلى جلسةٍ طارئة بعد ظهر يوم الثامن عشر من تشرين الأول.
ورغم أنّ شعارات المتظاهرين لم تستثنِ أحداً من الطبقة السياسية الحالية في البلاد، كان التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية الأقرب إلى التغاضي، بل وربما تشجيع مناصريهم وأعضاء أحزابهم للمشاركة في المظاهرات. لكن لم يكن لهذا الأمر أهمية كبيرة على أرض الواقع، إذ أظهرت الأعداد الكبيرة للمتظاهرين منذ الأيام الأولى مشاركة كثيفة للطبقة الوسطى اللبنانية، وللطبقات الأفقر. كان الجميع ثائراً.
انتقل المتظاهرون بسرعة إلى تقنيات الإضراب وإغلاق الشوارع والطرقات الرئيسية في البلاد. بدا لون السجاد، الذي استخدمه المعتصمون لفرش الأرض في بيروت وعلى طريق الساحل، تعبيراً مكثفّاً عن انتقال بيوتهم إلى الطريق حتى اسقاط النظام السياسي، أو هكذا كانت النية وقتها على الأقل.
في التاسع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن سعد الحريري استقالته من منصبه. كان من المفترض أن يعني ذلك الإعلان نهايةَ التفاهمات التي عقدها الحريري مع التيار الوطني الحر وحزب الله، والتي أمّنت انتخاب ميشيل عون رئيساً للجمهورية، لكن الوقائع التي تلت قالت غير ذلك.
شملت شعارات الثوار جميع السياسيين، وإن اختصّ هتاف الـ«هيلا هو» الشهير بجبران باسيل. كان هذا الهتاف ضرورياً للثوار، إذ أدى مهمة أساسية وهي كسر رهبة المواجهة المباشرة مع السياسيين، التي اكتسبها جزءٌ ليس صغيراً منهم عبر 15 عاماً دموياً من الحرب الأهلية، فيما اكتسبها الباقي من البلطجة والسلاح.
جنّدت أطراف السلطة على الفور بلطجيةً وموالين لها للصدام مع المتظاهرين والمحتجين في بيروت وخارجها. كانت البداية بالنسبة للثنائي الشيعي بالتركيز على الجنوب وبعلبك، حيث كان فرض سطوتهم التّامة امراً شديد الأهمية لإبقاء سيطرتهم على المناطق الشيعية في لبنان، لكن بيروت وباقي المدن اللبنانية شهدت أيضاً بلطجة هؤلاء أو اعتداءات حرس عناصر السلطة. في حين اهتّم بلطجية حزب الله بالهجوم المستمر والمتكرر على التجمعات في ساحة الشهداء ببيروت وحرقهم لنصب قبضة الثورة الذي أصبح رمزاً للحراك في المدينة.
ردّة الفعل السياسية من حزب الله كانت أسرع من موقفه في سوريا عام 2011. لقد خبر الحزب دور ميليشياته في قمع الاحتجاجات وقتل الناس جماعياً هناك، وأصبح من الواضح لديه أنّ القوة المفرطة التي استخدمها مع حلفائه ناجحة إلى حد بعيد بتثبيت سلطته، ليبدأ التلويح في كلمات الأمين العام للحزب من اللحظة الأولى بالحرب الأهلية والنزاع الداخلي، الذي يعني عملياً تهديداً باحتلال قوات الحزب كلّ لبنان بالقوة، وفرض سلطته بالجبروت والدماء. تهديدٌ يجب أخذه على محمل الجد بعد الجرائم في سوريا.
بالتوازي مع ذلك، أصبح من الواضح أنّ التردد أمام الحراك بات يميل أكثر نحو استخدام العنف بغية قمعه، وهو ما واجه المحتجين في أكثر من موقف من بيروت إلى طرابلس، حيث استشهد عدد من المتظاهرين برصاص الأمن والجيش أو رصاص حرس السياسيين.
مع استمرار الاحتجاجات دون توقف، حتى شهر كانون الثاني (ديسمبر)، أصبح واضحاً لدى سعد الحريري أنّ أي حكومة سيشكلها لن تنال قبول الشارع المنتفض. أعلن الحريري عزمه على عدم الترشح لتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد قرابة الشهرين من انطلاق الثورة، وتلا ذلك انسحابُ مرشحٍ غير رسمي للمنصب هو سمير الخطيب، بعد رفضٍ قاطعٍ من الشارع لتعيينه على رأس الحكومة الجديدة.
كان بديل تحالف الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) مع التيار الوطني الحر سريعاً، إذ جرت مشاورات نيابية أفضت إلى تسمية حسان دياب، الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت ووزير التربية السابق، رئيساً للوزراء. كان دياب الشخص المفضل لدى حركة أمل وحزب الله بين عددٍ من المرشحين، ويبدو أنّه كان كذلك لأنه يمثل بوضوح إهانةً للحراك بالمجيء بأكاديمي غير محبوب وتحوم حوله عدد من قضايا التزوير، وإهانةّ للسنة بتعيين دمية في المنصب المخصص لهم ضمن المحاصصة الطائفية.
كانت حكومة دياب، التي قيل إنها حكومة تكنوقراط، مُشكلةً من لونٍ واحد؛ هو لون التحالف الحاكم الذي يضمُّ بشكلٍ أساسي الثنائي الشيعي والتيار الوطني، وفي الوقت الذي لم تهدأ فيه مشاعر الغضب لدى اللبنانيين المنتفضين ضد الانهيار الاقتصادي في البلاد، وضد الطبقة السياسية المسؤولة عنه.
منذ عام 2019، بدأ انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اللبناني يؤثرُ على حركة الاقتصاد الذي يعتمد في كثيرٍ من نواحيه على الاستيراد، ونشأت سوقٌ موازية ارتفع فيها سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أضعاف السعر الذي طالما حافظت عليه الحكومة اللبنانية منذ التسعينات. في شهر حزيران (يونيو) 2020، وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 5000 مقابل الدولار الواحد، ما يعني خسارتها قرابة 70% من قيمتها التي هبطت من سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد بالنسبة إلى سعر البنك المركزي، والذي كان ثابتاً لسنواتٍ طويلة.
قامت المصارف، ومنذ خريف عام 2019، بتقييد المبلغ المسموح سحبه شهرياً من البنك، ما تسبب بخسارة نسبة كبيرة من اللبنانيين القدرةَ على الوصول إلى مدخراتهم أو رواتبهم الشهرية، وبالتالي عدم قدرتهم على دفع تكاليف المعيشة. كان ذلك الإجراء المجحف بحقّ الكثيرين من اللبنانيين بمثابة شرارةٍ أولى للحراك الذي ضمّ المصارف ورجال الاعمال الكبار إلى السياسيين كهدفٍ للهجوم، وكانت عبارة «احرقوا المصارف»، بما فيها من تعقيدات طبقية وطائفية عديدة، تعبيراً واضحاً عن هذا الغضب، وقد شارك ناشطون من أقصى اليسار إلى جانب فقراء من الضاحية الجنوبية بالهجوم وإحراق وتدمير واجهات عددٍ من المصارف. النظر إلى الطائفة ليس كافياً هنا لتفسير ما يجري، لكنّ غض النظر عنه ليس صحيحاً في بلدٍ مثل لبنان.
بعد أسابيع من المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش في جلّ الديب وساحة الشهداء وصيدا وطرابلس، اتجهت الأوضاع إلى الهدوء مع بداية العام الجديد، لكنّ الحراك عاد بعد فترةٍ قصيرةٍ من الإعلان عن تشكيلة حكومة حسان دياب، بيد أنّ الطبقة الوسطى اضطُرت للعودة إلى العمل والدراسة، وأصبحت تميل إلى ممارسة الاحتجاجات في أوقات العطل.
تعرضت خطة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد إلى الاعتراض الشديد من متظاهرين في شهر أيار (مايو)، بعد أن حاولت الحكومة فرض إجراءاتٍ للإغلاق ومنع التجوال بحجة منع انتشار فيروس كورونا، وقد أثرت الجائحة التي وصلت إلى لبنان على الحراك بالفعل خلال الأشهر التالية، ما سمح ببعض الراحة لأعضاء حكومة دياب، خاصةً وأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أصبح في عين الحدث مع استمرار الإجراءات القاسية من البنوك، والتي زادت من إفقار اللبنانيين ورفعت أسعار الدولار في السوق السوداء إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
لم تثمر مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي -التي تضررت باستقالة هنري شاول مستشار وزير المالية اللبناني في المفاوضات- شيئاً يمكن له أن يخفّف من حدة الأزمة في البلاد، خصوصاً أنّ الولايات المتحدة والدول الغربية قررت عدم دعم هذه الحكومة بشكلٍ يسمح بإنقاذ الطبقة السياسية.
عصر يوم الثلاثاء، الرابع من آب (أغسطس) 2020، تسبّب انفجارٌ هائلٌ في العنبر رقم 12 من مستودعات ميناء بيروت بدمارٍ هائلٍ في المدينة التي صدمت بانفجارٍ يشبه الإنفجارات النووية. قضى أكثر من 190 شخصاً نتيجة هذا الانفجار، في حين أصبح أكثر من 300 ألف شخص من سكان بيروت بلا مأوى.
استؤنفت الاحتجاجات الكبيرة إثر الانفجار الذي تسبّب به، حسب المعلومات الأولية، إهمال الإدارة اللبنانية لشحنة كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ. لم يمض أسبوعٌ على هذه الاحتجاجات حتى سقطت الحكومة واستقال دياب، الذي ينتظر تشكيل حكومة جديدة ليخرج من السرايا التي دخلها بداية العام.
المأساة التي تسبّب بها انفجار المرفأ استدعت تحركاً دولياً لمساعدة لبنان المنكوب. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور بيروت التي تعرّضت لدمارٍ لم تره منذ الحرب الأهلية، وافتتحت هذه الزيارة جهوداً فرنسية ليس لجمع المساعدات الإنسانية للبنان فقط، بل لطرح مبادرة سياسية تهدف إلى رفع العزلة عن البلاد التي أصبحت على القوائم السوداء للغرب؛ نتيجة هيمنة حزب الله على حكوماتها.
جاء الرد من الثنائي الشيعي بتعطيل تشكيل الحكومة، ما دفع رئيس الوزراء المُكلّف، بعيد المبادرة، مصطفى أديب إلى الانسحاب من تشكيلها. يبدو أن أمل وحزب الله ينتظرون نضوج حلٍّ آخر، اتضح أنه كان في الواقع امتثالاً للطلبات الأمريكية التي تضمّنت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يسمح لتل أبيب بتنفيذ عمليات تنقيب واكتشاف للنفط في المنطقة الاقتصادية التي تسيطر عليها في البحر المتوسط. إذاً، الحل الذي اختارته «كتلة الوفاء للمقاومة» كان التفاوض مع الإسرائيليين في الناقورة، لكن هل سينقذ هذا النظام السياسي اللبناني المتهالك؟ حيث أنّ الفرص الاقتصادية التي ستوفرها اكتشافات واعدة للنفط والغاز في حوض شرق المتوسط لن تكون حلاً سريعاً لأزمة لبنان الاقتصادية، بينما قد لا يعدو التوجه الحكومي اللبناني المدفوع من حزب الله في مفاوضات الناقورة سوى تلاعباً بالوقت، وذلك بانتظار تغييراتٍ في واشنطن بعد انتخابات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لا يمكن لأحدٍ توقّع شيءٍ في هذه الظروف، ولكنّ الأكيد هو أنّ اللبنانيين هم الذين يدفعون الفاتورة.